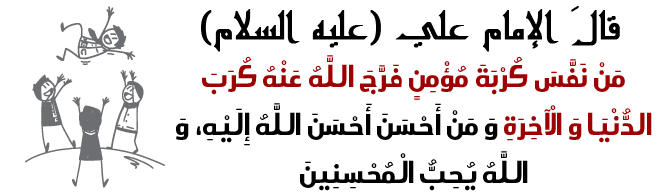
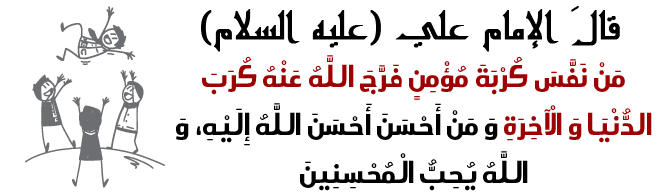

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها زكى الزرع كنصر وعلم في اللغة نمى وطهر، والزكاة صفوة الشيء وما تخرجه من مالك وفي مجمع البحرين: هي أما مصدر زكى إذا نمى لأنها تستجلب البركة في المال وتنمية، وأما مصدر زكي إذا طهر لأنها تطهر المال من الخبث والنفس البخيلة من البخل ،انتهى.
وفي النهاية أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث، ووزنها فعلة كصدقة فانقلب الواو ألفا وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل فتطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكى بها وعلى المعنى وهو التزكية فالزكاة طهرة للأموال وزكاة الفطرة طهرة للأبدان، انتهى.
أقول هذه معاني الكلمة بحسب اللغة وقد تحصيل أنها لمعان النمو والطهارة والبركة والمدح ولا يبعد رجوع الأخيرين إلى الأولين فإن البركة من مصاديق النمو والمدح تطهير للممدوح.
وأما بحسب الاصطلاح فهي هنا عبارة عن ضريب مالي خاص مجعول من الشارع في أموال خاصة لأشخاص معينين بشرائط معلومة، وجعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرب، فهي مع كونها من الضرائب الحكومية والماليات الدولية التي لها مصارف في المجتمع، وأخذها وصرفها في مصارفها من شؤون الدولة الإسلامية، من الواجبات التعبدية والعبادات الشرعية مشروطة بنية القربة تبطل بورود الخلل فيها من جهة النية أيضا.
وقد وقع البحث والتكلم عنها في الفقه فقسموها ابتداء إلى زكاة الأموال وزكاة الأبدان المسماة بزكاة الفطرة.
وقسموا الأول إلى مالية واجبة ومندوبة وهي زكاة مال التجارة، وتعرضوا في البحث عن الواجب لجهات، شرائط وجوبها، وما تجب فيه، ومقدارها، ومن يستحقها من الأصناف، وأوصاف المستحقين لها، أما الوجوب فقد ذكروا انه يشترط في تعلق وجوبها وتنجّزه أمور:
أولها: البلوغ بمعنى كون الشخص بالغا في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام، وبالغا حين تعلق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع.
ثانيها: العقل على النحو المذكور.
ثالثها: الحرية فلا زكاة على مال العبد وإن قلنا بملكه.
رابعها: الملكية لمتعلق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلق على التفصيل السابق.
خامسها: تمام التمكن من التصرف فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه والمسروق والمجحود والمدفون المنسي مكانه والمرهون.
سادسها: بلوغه حد النصاب.
وأما ما تجب فيه من الأجناس فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدان أي الذهب والفضة، والغلات الأربع أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فالأعيان الزكوية ثلاث طوائف :
أولها الأنعام فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشرائط العامة أربعة
شروط: النصاب، والسوم، وعدم كونها عوامل، ومضي الحول عليها جامعة للشرائط، والشرط الأول قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب، والثاني يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة ولو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة، وكذا الثالث فإنّه يشترط عدم كونها عوامل ولو في يوم أو يومين على الأحوط، والرابع يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر وبذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق.
وثانيها النقدان فذكروا انه يشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشروط العامة عدة شرائط خاصة، النصاب وقد أوضحناه تحت عنوان النصاب.
و كونهما مسكوكين بسكة المعاملة كانت سكة الإسلام أو الكفر، وكانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة، ومضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعي للشرائط.
وثالثها الغلات فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشروط العامة أمران أحدهما بلوغها النصاب وهو في جميعها مائتان وثمانية وثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا، تساوي 207- 847 كيلو غراما فلا تجب على الناقص من ذلك وقد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب.
ثانيهما التملك قبل وقت التعلق، بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو اتهاب أو غيرها، والتملك فيها يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث وشراء وبقائه إلى زمان التعلق أو تملك ثمره كذلك.
وأما المقدار المخرج منها الزكاة فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامة بين ذكر النصاب والمقدار المخرج منه فراجع هناك.
وأما من يستحقها وهو المسمى بمصارف الزكاة فالمذكور في فتاواهم والمستفاد من ظاهر الكتاب وصريح النصوص أنهم ثمانية أصناف:
الأول والثاني: الفقير والمسكين والمراد بهما من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلا ولا قوة، والثاني أسوأ حالا من الأول، فهو أخص منه، والصرف فيه أرجح، وهذا المقدار كاف في جعلهما قسمين تبعا للآية الشريفة، وهنا فروع كثيرة، نظير ان الدار والخادم والمركوب والألبسة وأثاث البيت والفروش والظروف والكتب العلمية وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الشخص بحسب حاله لا يمنع من أخذ الزكاة، كما انه يجوز تهيئة جميع ذلك من الزكاة لمن ليس له وغير ذلك فراجع الكتب الاستدلالية.
الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الحاكم للعمالة في أمر الزكاة.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم الكفار يعطون منها لألفتهم وميلهم إلى الإسلام أو إلى إعانة المسلمين في الحرب وغيره.
الخامس: الرقاب أي المماليك يصرف سهم منها في طريق إعتاقهم.
السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها.
السابع: سبيل اللّه وهو جميع سبل الخير.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته فلا يقدر على السير وإن كان غنيا في بلده، وهذا مما يقل مصداقه ويصعب إحراز موضوعه في زماننا هذا وله معنى آخر لا يبعد كونه المراد من الكلمة في هذا المورد ونظائره ذكرناه تحت عنوان ابن السبيل. ثم ان توضيح معنى كل واحد من الأصناف الثمانية وما أريد بها في الكتاب الكريم مذكور تحت عناوينها كالفقير والعامل والمؤلفة فراجع.
وأما أوصاف المستحقين فقد ذكروا انه يشترط اتصاف المستحقين بالأمور التالية:
الأول: الإيمان فلا يجوز إعطاؤها للكافر أي صنف كان من أصنافه، ولا للمخالف آية فرقة كانت من فرقة، إلّا من حصة المؤلفة في الجملة، وتعطى لأطفال المسلمين ومجانينهم، من غير فرق بين اليتيم وغيره والذكر والأنثى والمتولد بين مؤمنين أو من مؤمن، وأما المتولد من المؤمنة فقط والمتولد من الزنا من المؤمنين ففيهما إشكال.
الثاني: أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يصح دفعها لمن يصرفها في المعصية، ولا يشترط عدالته بل يجوز دفعها لمرتكبي الكبيرة أيضا.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالعمودين والزوجة الدائمة، فلا يجوز إعطاؤهم منها لأجل فقرهم ومن سهم الفقراء، وأما من سهم العاملين والغارمين وغيرهما إذا انطبقت عليهم فلا بأس.
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وسائر السهام على إشكال في بعضها، ويجوز للهاشمي زكاة الهاشمي من سهم الفقراء وغيرهم، كما يجوز لغير الهاشمي أن يعطي للهاشمي غير الزكاة وإن كان واجبا، والزكاة إذا كانت غير واجبة، فيجوز أن يدفع إليه الصدقات المنذورة، والكفارات الواجبة، والمظالم، وزكاة مال التجارة، والصدقات المستحبة.
تنبيه:
ذكر الأصحاب فيما يتعلق بالزكاة على النحو الكلي أمورا ينبغي الإشارة إلى بعضها، منها بيان ما هو المجعول في باب الزكاة من تكليف أو وضع بالنسبة لمالك المال أو لمستحق الزكاة وفيه وجوه أو أقوال:
الأول: ان المجعول هو التكليف المحض بأن أوجب اللّه تعالى على المالك إخراجها مع تحقق الشرائط المعتبرة، من دون تعلق حق لأحد بالمال كما أوجب للشخص الإنفاق على العمودين.
الثاني: ان المجعول اشتغال ذمة المالك بالزكاة، والأعيان الزكوية ليست متعلقة لملك أحد أو حقه، ومقتضى الوجهين بقاء التكليف والوضع على المكلف وان تلفت الأعيان إلا أن يدل دليل على السقوط.
الثالث: ان المجعول اشتغال ذمة المالك مع كون الأعيان الزكوية بجميعها أو بمقدار الزكاة منها رهنا عليها، فالشارع قد أنشأ في وقت تعلق الزكاة حكمين، اشتغال الذمة للمالك، وحق الرهانة للمستحق، وقد يقال إن المجعول هو الثاني فقط أي حق للمستحق مشابه لحق الرهانة فليس للمالك التصرف قبل أداء الزكاة. وهذا على فرض ثبوته يكون قولا آخر.
الرابع: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم من المال على نحو الإشاعة، فيترتب حينئذ على المال أحكام الإشاعة من عدم جواز تصرف الشركاء إلّا بإذن الجميع، وكون التلف عليهم والنماء لهم بنسبة الملك، وجواز المطالبة بالقسمة وغير ذلك.
الخامس: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم في المال على نحو الكلي في المعين، كملك مشتري الصاع من الصبرة، فالعين الخارجية للمالك، والمستحق مالك للكلي على ذمة المالك بشرط الأداء من العين، أو على ذمة العين فيخرجها المالك منها ولاية، وتعيين الكلي في الفرد حق للمالك وتلف الجميع يسقط الحق، وتلف البعض ما عدا الكلي لا يسقطه فيجب إخراجه.
السادس: ان المجعول حق للمستحق في المال نظير حق المجني عليه على العبد الجاني عمدا، فإن للمجنى عليه أو ورثته حقا في العبد تخييرا بين أن يقتصّ منه أو يسترقه، وحيث إنه لا معنى لأحد طرفي الحق هنا فالتشبيه في الجهة الثانية فللمستحق حق التملك، فالمجعول له في الحقيقة أنه ملك أن يملك.
السابع: ان المجعول حق للمستحق في المال نظير حق الغرماء في تركة الميت، فالغارم كان مالكا للمال على عهدة المدين وانتقل بعد موته إلى عهده التركة فصارت مشغولة الذمة به، فالمجعول حق أخذ مقدار الدين من التركة، وللورثة إبراء ذمة التركة بالإعطاء من نفسها أو من غيرها وكذلك حق الزكاة.
الثامن: ان المجعول للمستحق حق في مالية الأعيان الزكوية وقيمتها، نظير حق الزوجة في مالية الأبنية وأشجار البساتين فللمالك الأداء من نفس العين والأداء من مال آخر وكلاهما أداء من المالية وقد اعتبر الحق المالي هنا على نحو الإشاعة كما في إرث الزوجة فلو تلف نصف العين مثلا سقط نصف الزكاة.
التاسع: ان المجعول حق للمستحق كحق المنذور له في منذور التصدق بناء على أنه إذا نذر مالا لزيد مثلا تعلق له حق بالمال فللمستحق في المقام مطالبة الزكاة وهذا ضعيف والحق المزبور غير ثابت، ثم إن المسألة ذات شقوق على ما ترى وذات اختلاف وإشكال ولعل الأوجه الوجه الثامن ثم الوجه الرابع واللّه أعلم.
وأما الزكاة المندوبة فقد ذكروا انها تتعلق بأمور:
الأول مال التجارة فإذا تملك مالا بشراء وغيره بقصد الاتجار والاسترباح به، تعلق به هذا القسم من الزكاة بشروط أحدها بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين، ثانيها مضي الحول عليه من حين التملك بالقصد المزبور، ثالثها بقاء المال المذكور بعينه طول الحول، وقيل لا مانع من تبدله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح، رابعها عدم تنزّل قيمته عن رأس المال أي الثمن الذي بذل لتحصيله، والمتحصل أنه لو اشترى متاعا بمائة مثلا بقصد التجارة فبقي عنده سنة لم ينقص قيمته عن المائة أو زاد عليها تعلقت به الزكاة ومقدارها ربع العشر، ولو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول فصارت مائة وخمسين، تعلق في آخر الحول زكاة بالأصل وبعد حول من الربح زكاة بالربح والمسألة مورد اختلاف أغمضنا عن بيانها لعدم العامل بها فيما نعلم.
الثاني كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع والخضر، فيشمل جميع الحبوبات وحكم ذلك حكم الغلات في قدر النصاب وقدر ما يخرج منه وفي الزرع والسقي.
الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها وهي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران وهما مثقال ونصف صيرفي، وفي البرازين كل سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي.
الرابع حاصل العقارة المتخذة للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات مع النصاب والحول.
الخامس الحلي وزكاته إعارته للمؤمن.
السادس المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ان حال عليه حولان أو أحوال فيستحب بعد التمكن إخراج زكاته لسنة واحدة.
السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فيستحب إخراج زكاته.
زكاة الأبدان- زكاة الفطرة:
وأما القسم الثاني من الزكاة أعني زكاة الفطرة فهي أيضا عبادة مالية خاصة مشروطة بالنية مجعولة من ناحية الشرع مخترعة لمصالح المجتمع وحفظ أجسادهم ودفع الموت عنهم وقبول صيامهم وتطهيرهم قلوبهم، ولذلك أطلقت عليها اسم زكاة الفطرة أي الخلقة أو الإسلام أو الدين.
وقد وقع هذا العنوان أعني زكاة الفطرة مورد البحث في الفقه من جهة وجوبها، وشرائط وجوبها، والمكلف المخاطب بإخراجها، ومن تخرج عنه، وفي جنسها وقدرها ووقتها ومصرفها.
أما وجوبها الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو مشروط بالشروط التالية:
البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والحرية، والغنى، فيعتبر اجتماعها حين دخول ليلة العيد فيكون الواجد لها جميعا مكلفا مخاطبا بإخراجها، فلا تجب على من بلغ أو عقل أو أفاق أو تحرّر أو صار غنيا بلحظة أو لحظات بعد دخول الليلة، ولا يشترط في وجوبها الإسلام ولا الإيمان حين دخول الليلة فتجب على الكافر، وإن كان لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه لحديث الجب، وعلى المخالف، ولو استبصر بعده لم تسقط عنه.
وأما من تخرج عنه فقد ذكروا أنه كل من يعوله الشخص حين دخول ليلة العيد، كان من واجبي النفقة عليه أو غيره، كان من أرحامه أو غيره، حتى المحبوس عنده، وأجيره الذي ينفق عليه، ومن طلقها رجعية، والضيف الوارد عليه قبل الليلة، والمولود قبلها، والتي زوجها دائما قبلها، وكل من عد عيالا له كذلك.
وأما جنسها وقدرها فقد ذكروا أن الضابط في الجنس القوت الغالب للناس، من الغلات الأربع، والأرز والخبز والحبوب، كالعدس والماش والحمص ونحوها فكل ذلك يكفي، إذا كان لها شيوع ما في الناس ويجوز قيمة الجميع بنقد البلد، وقيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، وقيمة بلد المال لا وطنه ولا بلد آخر فلو كان له مال في بلد وهو في بلد آخر فالمراد قيمة بلد المال.
وأما مقدارها فالواجب صاع عن كل رأس من أي جنس كان والصاع أربعة أمداد تقرب من ثلاث كيلوات.
وأما وقت وجوبها فهو محدود جدا لأنه أول آنات دخول ليلة العيد، والوجوب يدور مداره مع اجتماع الشروط السابقة وجودا وعدما، وإن كان يستمر بعد تحققه إلى زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاته، أو إلى زمان إقامتها لمن صلاها أو إلى الأبد، على اختلاف فيه، وعليه يتبنى كون الإخراج بعد خروج الوقت أداء أو قضاء، ويجوز عزلها عينا أو قيمة ثم دفعها إلى من شاء، والنية حين العزل والأحوط ان ينوي حين الدفع أيضا.
وأما مصرفها فقد ذكروا انه مصرف زكاة المال، ولا يشترط عدالة المستحق مطلقا ويجوز أن يعطي إلى حد الغنى ويشترط فيها نية القربة والتعيين.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|