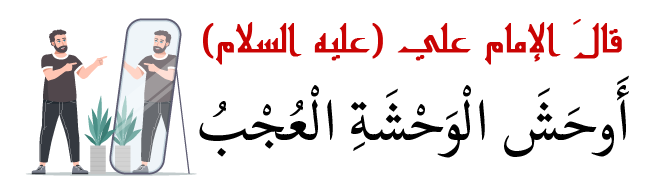
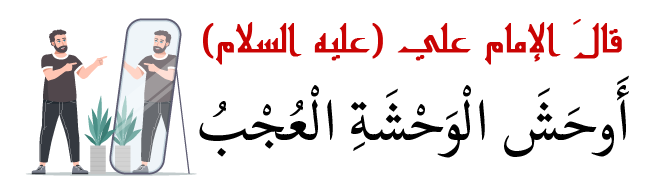

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-27
التاريخ: 22-12-2015
التاريخ: 17-12-2015
التاريخ: 9-06-2015
|
إن منكري الشفاعة – وهم جماعة من أهل السنة، لاسيما بعد ابن تيمية الذي شكل كلامه وأفكاره أرضيّة لنشوء الوهابية يقولون من خلال طرح بعض الشبهات العقليّة: بعد إثبات الاستحالة العقلية، وبالنظر إلى كون الآيات الواردة في هذا المضمار متشابهة لابد من تبرير الأحاديث الدالة على الشفاعة؛ وببيان ،آخر بما أنه قد أقيم الدليل العقلي على خلاف الشفاعة، فيتعيّن غض الطرف عن هذه الروايات، وإرجاع علمها إلى أهله؛ كما أنه عند عدم انسجام الآيات مع بعضها، وكونها بالنتيجة متشابهة، فلابد أيضاً من إرجاع علم هذه الآيات إلى أهله.
من هذا المنطلق، وبغية دفع الشبهة، يتعيّن أولاً: إخراج الآيات من تشابهها الظاهري وثانياً: الإجابة على الشبهات العقلية. وبالنظر إلى كفاية ما سبق التطرق إليه في المباحث التفسيرية بخصوص دلالة الآيات وعدم تشابهها، فإننا في غنى عن طرح القسم الأول من البحث.
وفي القسم الثاني، وهو الإجابة على الشبهات العقلية للشفاعة، لابد - بادئ ذي بدء من أن يُكشف الغطاء عن أصل الشفاعة وماهيتها، ليُعمد بعد ذلك إلى نقل الشبهات وإشكالاتها والإجابة عليها. بعد دفع الشبهات المتوهمة وإثبات "الإمكان العقلي"، ومن أجل إثبات "وقوعها" يتحتم الاستمداد من النقل؛ وذلك لأن الشفاعة ليست كالمعاد كي يتم إثبات ضرورة وقوعها من خلال العقل، بل إن ما يمكن إثباته بالعقل هو إمكانها ليس إلا.
في الحقيقة إن ماهية الشفاعة - كما سبق ذكره في المباحث التفسيرية هي تتميم قابلية القابل؛ أي إن الشفيع يقوم بعمل يتخلّص به القابل من نقصه ويبلغ كمال نصاب القبول. من مقتضى العقل أنه إذا كان موجود فاقداً لكمال ما فيتعين عليه أخذ هذا الكمال من مبدأ هو عين الكمال، وإذا افتقد النصاب اللازم لتلقي هذا الكمال فلابد له، بالاستمداد من الوسائط والوسائل من إيصال قابليته إلى حد النصاب، ومثل هذا العمل ليس أنه لا ينقض قانوناً فحسب، بل إنّه مقتضى القانون العقلي.
وبتعبير آخر، ليس المراد من الشفاعة بحق شخص ما أنها ستقبل بحقه حتى في الوقت الذي يشكوا فيه هذا الشخص النقص وعدم توفر شروط القبول، وفي مجال الشفاعة التشريعية لا تعني إبطال قانون الجزاء وعدم نفوذه في الشخص المجرم مع بقاء استحقاقه للعقاب، بل المراد من هو إيجاد التغيير والتحول في المجرم؛ بحيث يُسلب منه استحقاق العقاب، ويتم إخراجه تخصصاً من قانون الجزاء وشموليته له؛ مثلما أت التوبة من شأنها أن تُخرج الإنسان العاصي من استحقاقه للعقاب وتجعله مستحقاً لعفو الله عز وجل؛ إذ: "لا شفيع أنجح من التوبة"(1)؛ فبعد صلاة الاستسقاء مثلاً لا ينزل المطر من دون أي تغيير في الجو والطقس، بل إن الله عز وجل، ومن باب أنه تعالى إذا أراد أمراً هيأ أسبابه"(2)، يهيئ أسباب هطول المطر في إثر صلاة الاستسقاء؛ فمثلاً يأمر سبحانه الرياح لتسوق الغمام إلى أرض ملتهبة: {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ} [فاطر: 9] ، وإن كان هناك غمام لكنه يحتاج إلى تراكم فإنّه عز وجل يأمر الرياح حتى تراكم السحاب وتنقله من مكان إلى آخر: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا} [الروم: 48] على كل حال فكما تكون صلاة الاستسقاء سبباً لتهيئة ظروف هطول المطر، فإن التوبة وأمثالها من أسباب الشفاعة تبعث على تحوّل في حال المذنب كي يصل إلى نصاب قبول العفو أو التخفيف أو الرفع.
بهذا التوضيح المقتضب بخصوص ماهيّة الشفاعة، نتحول صوب الشبهات المطروحة حولها كي يتجلى بعد الإجابة عليها وإثبات الإمكان العقلي للشفاعة أن ما أخبر به القرآن الصادق المصدق والعترة الطاهرون الا هو حق وأن الإيمان به واجب.
الشبهة الأولى
الشفاعة هي سبب في رفع العقاب، وارتفاع العقاب هو إما عدل أو ظلم؛ فإن كان ارتفاع العقاب عدلاً فإن أصل جعل العقاب من جانب الله سبحانه وتعالى هو والعياذ بالله - ظلم والحال أن الله لا يظلم أحداً على الإطلاق: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49] ، وإذا كان ارتفاع العقاب ظلماً وكان وجود العقاب عدلاً فإن شفاعة الشافعين وسعيهم لرفع العقاب هو ظلم.
الجواب: هذه القضية المنفصلة المذكورة مبنية على أساس أن العدل والظلم هما نقيضا بعضهما كي تكون مانعة الجمع ومانعة الخلو، والحال أن تقابل العدل والظلم، إما هو من باب العدم والملكة أو من باب التضاد بين الاثنين، ورفعهما ممكن؛ أي إن رفع "العقاب الذي هو عدل" من الممكن أن يكون "فضلاً فلا يصدق عليه أي واحد من العنوانين "العدل" أو "الظلم". وبعبارة أخرى إن الشبهة تكمن في: أن رفع العقاب هو إما عدل وإما ظلم، لكن الجواب هو أن العقاب هو عدل، ورفعه هو فضل وهو أعلى من العدل، وليس ظلماً بحيث يكون أدنى منه.
فالله سبحانه وتعالى قد عيّن للمجرمين - على أساس عدله - عذاباً، لكن رفع العذاب من دون واسطة الآخر من باب "آخر من يشفع هو أرحم الراحمين"(3) أو بواسطة شفاعة الآخر من سائر الشفعاء هو فضل وإحسان. فقد علم الله عزّ وجلّ عباده بأن كونوا عدولاً، لكن مرحلة الإحسان هي فوق العدالة، فابذلوا جهودكم حتى تبلغوها: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: 90] ، كما أنه سبحانه قد علمهم أيضاً بقوله: إذا أساء إليكم أحد فبإمكانكم - تأسيساً على العدل أن تعاقبوه بمثل ذلك: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، بيد أنكم إن صفحتم عنه وفقاً لقاعدة الصبر والإحسان - فهذا أفضل من العدل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126] (4)
الشبهة الثانية
الشفاعة لا تنسجم مع السنة الإلهيّة؛ فديدن سيرة الله سبحانه وتعالى وسنته في الخليقة هو في جعل قانون ليتم تنفيذه، ويعين عقاباً لمخالفة هذا القانون، ثمّ يعاقب مخالفيه. فكل من أصل سن القوانين، وعقاب المتخلفين عن القانون هما من السنن الإلهية، ولما لم تكن السنن الإلهية قابلة للتغيير والتبديل فليس من الممكن تغيير جزاء المجرمين بالشفاعة؛ لأن آيات من قبيل: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر: 43] إنما تدل على ذلك.
الجواب: هذا الكلام هو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذلك العام. فالمعيار في تشخيص السنة عن غيرها ليس هو العقل، وإن الآية المذكورة لا تدل على ذلك. ومفاد هذه الآية هو أن كل ما كان سنة إلهية فهو غير قابل للتبديل والتحويل، لكنه لا يظهر من هذه الآية أن قبول الشفاعة تبديلاً للسنة، ولا يظهر منها أن عدم قبول أي شكل من أشكال الشفاعة هو من السنن الإلهية التي لا تقبل التحويل، وبعبارة أخرى: لا يظهر من الآية المذكورة أنه جملة السنن الإلهية هو التصرف دائماً على أساس العدل وعدم التعامل بالفضل والإحسان، ولم يتم إثبات هذا الأمر بدليل عقلي أو نقلي آخر، بل هناك دليل على خلاف ذلك؛ وذلك لأنه من السنن الإلهية هو أن تعمل سنة الباري تعالى على أساس أسمائه الحسنى، ومثلما أن صفة "العادل" من الأسماء هي الحسنى فإن أوصافاً من قبيل "الرؤوف"، و"الرحيم"، و"الغفار"، و"المحسن"، و"المفضل" من أسمائه الحسنى أيضاً. فإذا كانت: {إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ} [السجدة: 22] من سنن الله جلت أسماؤه، فالآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] تعتبر من سننه أيضاً. وإذا كانت: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] من السنن الإلهية، فإن الآيتين: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] و {وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] هما من سنن الله العصية على التغيير كذلك.
الشبهة الثالثة
الشبهة الثالثة التي طرحت في بعض التفاسير كالمنار هي: أن الشفاعة الشائعة عند العرف هي على واحدة من صورتين:
1- أن يكون الحاكم - الذي يُشفع عنده لمجرم ظالماً مستبداً وهو يحكم على أساس الروابط لا الضوابط فمن الممكن تغيير "رأيه" أو تبديل "دافعه"، ومن خلال تغيير علمه أو ميله يمكن تحويل إرادته وتصميمه على مجازاة المجرم. وبعبارة أخرى، فإن من الممكن إلفاته إلى خطئه في الحكم من ناحية، أو القول له من ناحية أخرى: إنّك وإن لم تخطئ في حكمك لكننا، بناءً على العلاقة الحميمة التي تربطنا بك، نطلب منك أن تغض الطرف عن حكمك، فإذا كان هناك حق للناس وما من مجال للعفو فهذا يكون من قبيل ما عُبّر عنه بالشفاعة السيّئة في: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً} [النساء: 85] ، وإلا فمن الممكن أن تكون مصداقاً للشفاعة الحسنة.
2- الحاكم عادل، ولذا لا يمكن النفوذ إلى "دافعه"، لكن من الممكن التصرف في "رأيه" من خلال إقامة بعض الأدلة والاثبات له بأن الحكم الذي تصدره أو الذي أصدرته ليس صواباً وحقاً.
ومما لا ريب فيه ولا شك أنّه لا يُتصور أي من هذين الفرضين بالنسبة للحاكم الذي هو عادل محض، والذي علمه لا يقبل الخطأ ولا التغيير من جهة كونه شهوديا من ناحية وشمولياً وأزلياً من ناحية أخرى؛ وذلك لأن إرادة مثل هذا الحاكم هي تابعة لعلمه، وإنه قهراً لا سبيل للشفاعة إلى محكمته (5).
الجواب: إن ما تبعث الشفاعة على تغييره هو الإرادات الجزئية والفعلية الزائدة على ذات الله تعالى؛ وبتعبير آخر، فإن المعلومات الفعلية هي التي ينتزع منها العلم الفعلي، ولا يُنتزع منها علمه وإرادته الذاتيتان والأزليتان.
ولمزيد من التوضيح نقول: إن علم الله سبحانه وتعالى هو أزلي لكن ما يعلمه من أمور فهي دائماً في تغيير؛ فهو عزّ اسمه يعلم منذ الأزل كيف أنه يريد المعلومات المتغيرة من خلال الإرادات الجزئية الحادثة والزائدة كذا على الذات. فهو يعلم أنه في زمن كذا سيوجد شخص، وفي حين سيبلغ الحلم، وفي ظروف خاصة سيُطيع أو يعصي بإرادته وميله، والحال أنه كان ولا يزال يستطيع أن يفعل خلاف ذلك، كما أنه يعلم أنه يستحق العقاب على ما اجترحه من المعصية، وهو يعلم أنه سيكون محط لطف ولي من أولياء الله ومشمولاً بشفاعته، ليتم التجاوز عن كل عقوباته أو بعض منها. كل ذلك يعلمه منذ الأزل، وسينفذه في ما لايزال.
فعلى سبيل المثال إن الله جل وعلا يعلم أنه سيولد شخص في زمن معين لينهمك في طلب العلم، ويهيّئ له مقدماته في حقبة زمنية خاصة، وفي فترة زمنية أخرى يقيّض له إمكانات دراسية أفضل واستاذاً مناسباً ورفاقاً صالحين. كل تلك البرامج إنّما هي أفعال جزئية تستند إلى الإرادات الجزئية الله تعالى، وهي تعد شأناً وفيضاً جديدين منه عزّ وجل: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] ، ومن صفات فعله، وإن ما يُطرح في الكتاب والسنة تحت عنوان إرادة الله تعالى هو غالباً تلك الإرادة الفعلية التي هي صفة الفعل (لا صفة الذات) وهي تنتزع من مقام فعله، وليست هي عين ذات الواجب.
وفيما يتعلق بالشفاعة فإن الأمر كذلك أيضاً؛ أي إنّه معلوم الله منذ الأزل أن الشخص الفلاني في الزمن الفلاني سيُشمل بالشفاعة، من دون أن تتعرض إرادته أو علمه الأزليان إلى أدنى تغيير.
وببيان آخر:
1- إن الأفعال الجزئيّة اليومية والشؤون والفيوض اليومية – حيث ان {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] – هي حادثة وهي تحدث بواسطة الإرادات الجزئية الزائدة على الذات الإلهية. أما العلم الذي ينظم ويرسم الخريطة لتلك الإرادات الجزئية فهو أزلي.
2- ما قدم في تحليل الشفاعة - حاله حال ما بين في الشبهة السابقة - غير تام؛ وذلك لأن الشفاعة عند الله لا هي بمعنى التصرف في علم الله تعالى ولا هي من قبيل التغيير في عدله وحكمه بل هي طلب ظهور صفة إحسانه وفضله مما هو فوق العدل، والتماس تجلّي عفوه وصفحه وتخفيفه مما هو أسمى من القسط.
الشبهة الرابعة
الشبهة الأخرى التي تُطرح عادة في مؤلفات الوهابيين هي أن الشفاعة تؤدي إلى نقض الغرض؛ لأن هدف خلق البشر هو العبادة: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ، وأن الأنبياء إنما جاؤوا من أجل التبشير والإنذار وإتمام الحجة: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42]. إذن فليس مجيؤهم من أجل الشفاعة؛ لأن الشفاعة تكون سبباً لتجرؤ المجرمين وهتك حرمة الأحكام وهو الأمر الذي ينقض الغرض المذكور.
الجواب: لقد مرّ الجواب على هذه الشبهة في أثناء النقطة السادسة (6) عند البحث في شروط وخصائص المشفوع لهم حيث قلنا: إن الله تعالى لم يقل على نحو الإيجاب الكلّي إن كل ذنب فهو معفو عنه أو إن كل مذنب فهو مغفور له بشفاعة الشافعين ولا هو قد بيّن خصوصية الذنب الذي يُعفى عنه بالشفاعة، ولا عين مواصفات الشخص أو الجماعة المشفوع لهم، بل إنه تكلم في كل الموارد المذكورة على نحو الإجمال والإيجاب الجزئي، فمثل هذه الشفاعة ليس أنها لا تؤدي إلى تجرؤ العاصي فحسب،
بل إنها تمنح الأمل وتمهد الأرضية لإصلاح الأمور والتعويض عن الماضي التعيس وتجعل الإنسان دوماً يعيش متأرجحاً بين حالتي الخوف والرجاء. روى المرحوم ابن بابويه وآخرون عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: "إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة؛ أخفى رضاه في طاعته؛ فلا تستصغرن طاعته فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته؛ فلا تستصغرن شيئاً من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته؛ فلا تستصغرن شيئاً من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده؛ فلا تستصغرن عبداً من عباد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم"(7):
1- فالله قد أخفى رضاه بين طاعاته؛ أي إنّه لا يُدرى أيّ طاعة يقبلها. من هذا المنطلق لا ينبغي استصغار أي طاعة الله سواء كانت واجبة أو مستحبة، فلربما تكون مما يوافق قبوله ورضاه.
2- وقد أضمر سخطه في معاصيه. لذا يتحتم على الإنسان أن يجتنب جميع المعاصي ولا يستصغرن أياً منها؛ لأنه لا يعلم على أي معصية يؤاخذ الله الإنسان العاصي.
فلعله يؤاخذه على نفس هذا الذنب الذي يهم بارتكابه.
3- وأخفى إجابته الأدعية. فلا يجب استصغار دعاء فلعله هو الذي يُجاب. 4. وقد أخفى وليه وجعله نكرة بين الناس؛ فلا يُعلم من هو وليه وبأي زي يظهر وكيف يعيش. لذا فليس لأحد تحقير شخص آخر؛ فلعله يكون ولياً لله.
فشفاعة بمثل هذا الخفاء ليس أنّها لا تؤدي إلى التجرؤ فحسب، بل تكون سبباً لرجاء العبد الصالح وانطلاقته وتنقله بين الخوف والرجاء. بالأخص عندما يضع في حسبانه أن الله الرحمن هو قهار أيضاً، وأن الله الذي هو " أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة" (8) هو أيضاً الله الذي يكون "أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة" (9)، ويلاحظ أيضاً أن ذات الله الذي يعد بالنجاة والشفاعة قد هدد بالقول: إن الشخص الغافل الذي يرى نفسه في مأمن من مكر الله وحيلته إنما هو الخاسر الذي فرط برأسمال روحه وإيمانه؛ {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99] ، وإلا فالإنسان الذي حافظ على رأسماله يعني العقل والإيمان، وهو موحد ومسلم فإنه دائم التذبذب بين الخوف والرجاء؛ فهو لا يحس بالأمان المحض من ناحية، ولا ييأس من ناحية أخرى بالنظر إلى أنه {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: 87] ؛ فهو من جانب يَحْذَرُ الآخرة ومن جانب آخر ﴿يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ} {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]. هو يعلم أنه على الرغم مما يُستفاد من الآية : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] من أن الله الغفور يتجاوز عن كل ما سوى الشرك من دون توبة (وذلك لأنه لو كان الغفران في هذه الآية مقيداً بالتوبة لما كان لاستثناء الشرك معني يُذكر؛ لأن إثم الشرك يُغفر أيضاً بالتوبة إلا أن قيد {لمن يشاء}، هو سبب للإبهام؛ إذ من غير المعلوم على وجه الدقة من هم مصاديق "من يشاء" من بين المليارات من المسلمين والموحدين.
وبعبارة أخرى فالشفاعة هي في حدود الله إنه لا يشجع أي إنسان عاقل على الإصابة بالمرض، وهي نظير القاعدة الفقهيّة "من أدرك" التي تخص الفوات القهري والسهوي والتي لا تشمل من يؤخر صلاته عمداً حتى فوات وقتها، بل إنّه وحسب قول العلامة الطباطبائي - فإن من سلم زمام نفسه للمعاصي اتكالاً على الشفاعة والتوبة والاستغفار وجعل من تلك الأمور ذريعة لتمرده وعصيانه، فإن ذلك سيجعله يُبتلى بذنب مضاعف أحياناً (10)، لاسيما إذا ما التفتنا إلى أن ارتكاب الذنب يكون أحياناً أرضيّة لارتكاب غيره، بل إن اقتراف الكبائر والإصرار عليها سيتبع بارتكاب أكبر الكبائر (ألا وهو الشرك): {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ} [الروم: 10]
من هذا المنطلق فإن القرآن الكريم ينذر المجتمعات البشرية بالقول: ألم يحن الوقت لأولئك الذين قبلوا بأصل المبدأ والمعاد والوحي أن يخشوا ويخشعوا ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين انحرفوا تدريجياً عن تعاليم السماء وابتلوا بقسوة القلب: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد: 16]
ومحصلة الأمر، إن الشفاعة ليست من عوامل الغرور، بل هي وسيلة لرجاء المتلوثين بالآثام والمعاصي، وهي كالدواء الذي لا يشجع أي إنسان عاقل على الإصابة بالمرض. بل هي تداوي المبتلين كي تقيهم من الإصابة بالمرض العضال وهو اليأس من رحمة الله، وهذا هو الكفر بعينه.
الشبهة الخامسة
الشفاعة المُستشفة من القرآن ليست هي الشفاعة المعروفة المتمثلة ب "رفع" العقاب الاخروي الثابت على المجرمين واللازم لهم، بل إن المستفاد من الآيات لا يعدو كونه وساطة الأنبياء والأولياء التي هي بمعنى "دفع" العقاب؛ وذلك بالتوضيح التالي: إن هؤلاء هم وسائط فيض الله وهم من يتسلمون أحكام الوحي من الله سبحانه وتعالى لإبلاغها إلى الناس فيتقي الناس جهنم ويدخلون الجنّة من خلال تعلمها والعمل بها، بناء على ذلك، فإن هي بمعنى دفع العقاب وليس رفعه بعد الاستحقاق.
الجواب: على الرغم من اندراج الوساطة بالمعنى المذكور تحت عنوان الشفاعة، بيد أن ما يُستشف من الآيات يفوق ذلك، بحيث يضم الشفاعة بمعنى رفع العقاب أيضاً، والشاهد على ذلك هو شفاعة التوبة؛ حيث: "لا شفيع أنجح من التوبة" (11) ؛ وذلك لأنه ما من شك في أن التوبة إنما تكون بعد ثبوت الجرم المقرر له العقاب، فهي ترفع العقاب المقرر. والشاهد الآخر على الآية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]
حيث إنه ليس المراد من المغفرة فيها ما كان عن طريق التوبة؛ لأن الشرك أيضاً هو ذنب يُغتفر بتوبة المشرك وإيمانه، بل المراد هو المغفرة التي تكون عن طريق وساطة وشفاعة أولياء الله والملائكة، وما من ريب في أن نتيجة المغفرة والعفو هي رفع العقاب الثابت وليس دفعه؛ أي إنّه إذا كان المجرم مستحقاً للعقاب، فإن أولياء الله الوجهاء عنده سبحانه، والمقربين من حضرته، والذين هم مجاري فيضه يقومون بعد إذنه بما شأنه أن يجعل من فضل الله شفعاً لعدالته ليستوي الحاكم على القضاء بعدله المشوب بالإحسان والفضل، ومن ناحية أخرى فإنّه تضم مسكنة العبد إلى معصيته فلا يرد ساحة محكمة الحق وحيداً فريداً، فتكون النتيجة الأخيرة هي أن يتعامل الرب العادل الغفور مع العبد المذنب المستكين بمقتضى الفضل والإحسان، لا من منطلق العدل.
الشبهة السادسة
الشبهة الأخرى، وهي ما ذكر في تفسير المنار، وما جاءت الإشارة إليه بإجمال في المباحث السابقة هي ما يدل عليه العقل لا يعدو إمكان الشفاعة وليس تحققها ووقوعها، ولا يمكن استخلاص مبحث واضح وجلي من الآيات القرآنية بخصوص ذلك؛ والسبب هو أن بعض الآيات الشفاعة بينما يثبتها البعض الآخر، وأن عدداً من الآيات قيد الشفاعة ببضعة قيود في حين بينها البعض الآخر بصورة مطلقة غير مقيدة. فنتيجة مثل هذا التهافت والاختلاف هي أن الآيات المرتبطة بالشفاعة تكون في عداد المتشابهات حيث لابد بعد الإيمان الإجمالي بها من إسناد علمها إلى أهله. إذن فليس هناك دليل عقلي قد أقيم على وقوعها، ولا دليل نقلي يدل على إمكانها (12).
الجواب: لابد للمفسر الخبير والمنهجي من أن يُرجع متشابهات القرآن إلى محكماته التي هي أم الكتاب ويعيد الفرع إلى الأصل، ويسلم الطفل لأمه (أم الكتاب). فالقرآن لم ينزل لكي يبيّن لنا آيات متشابهة عصية على التفسير، كما أنه لم يقل: إن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: قسم قابل للتفسير وآخر لا يقبله، بل هو يقول: إن كل آيات القرآن قابلة للتفسير والتحليل والاستدلال بعضها من دون واسطة كالمحكمات، والبعض الآخر بالواسطة؛ كالمتشابهات. فيتعيّن أولاً، التدبر الكامل فيها. وثانياً، فرز المحكم عن المتشابه. وثالثاً، معرفة كيفية إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. حينها سيتم إرجاع المتشابهات التي هي بمثابة الفرع والطفل إلى أم الكتاب التي هي بمنزلة أصل المتشابهات وامها ونظفر بتفسيرها. فإن تمت إعادة المتشابهات إلى المحكمات (أم الكتاب) فلن يبقى هناك إبهام؛ كما استنتج من المباحث التفسيرية لقوله : {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 48] بأنه ما من تشابه ولا تهافت ولا اختلاف بين آيات الشفاعة. والنتيجة هي:
1- الشفاعة هي بمعناها المعهود والمصطلح عليه، وإن إمكانها الذاتي والوقوعي هو أمر عقلي ونقلي في آن معاً.
2- آيات القرآن الكريم في هذا الخصوص هي محكمة وغير متشابهة.
3- على فرض تشابه بعض الآيات فإنه بإرجاعها إلى المحكم منها يزال أي احتمال للتشابه، والإبهام، والإجمال، وما إلى ذلك.
________________
(1) الكافي، ج 8، ص 19؛ وبحار الأنوار، ج6، ص 19.
(2) بحار الأنوار، ج 58، ص 154) (من كلام صاحب البحار).
(3) راجع الزهد، ص 97 - 98؛ وبحار الأنوار، ج 8، ص 361.
(4) هذه الآية تخص صفح المسلمين عن بعضهم البعض وإلا، ففيما يتعلق بالمنافقين والمشركين، لابد من أن يكونوا أشداء عَلَى الْكُفَّار، (سورة الفتح، الآية (29)؛ وذلك لأن العفو في حال ضرورة الانتقام لا يُعد مصداقاً للإحسان؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : "ردّوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر"، (نهج البلاغة، الحكمة 314).
(5) تفسير المنار، ج 1، ص 307.
(6) نفس هذا الكتاب (تفسير تسنيم، ج4)، ص 288.
(7) معاني الأخبار . 112؛ وبحار الأنوار، ج 68، ص 176.
(8) إقبال الأعمال، ص 322؛ وبحار الأنوار، ج 94، ص 337.
(9) إقبال الأعمال، ص 322؛ وبحار الأنوار، ج 94، ص 337.
(10) راجع الميزان، ج1، ص 166.
(11) الكافي، ج 8، ص 19؛ وبحار الأنوار، ج8، ص58
(12) راجع تفسير المنار، ج 1، ص 307.



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|