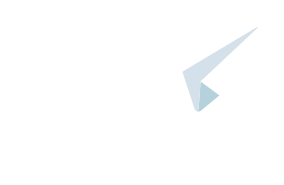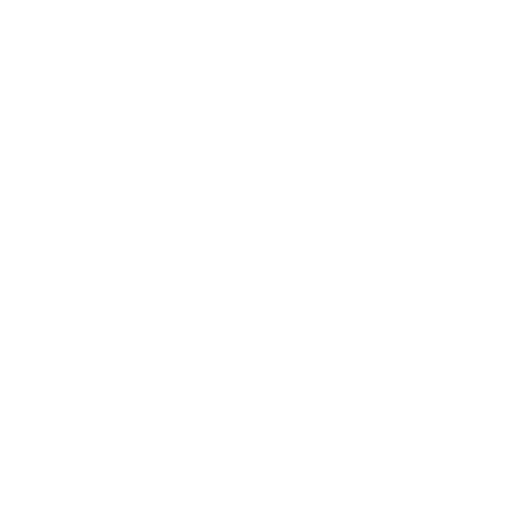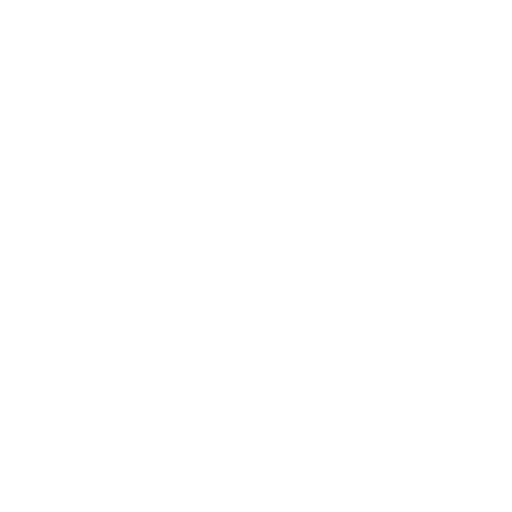علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
دور الحديث وألقاب المحدّثين
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 73 ــ 87
2025-09-08
46
الفصل الرابع: دور الحديث وألقاب المحدّثين:
في القرن الهجري السادس امتازت الحياة الإسلاميّة بظاهرة جديدة أضعفت بعض الشيء الرحلة في طلب الحديث: فحتّى أوائل هذا القرن لم تكن في المجتمع الإسلامي مدارس خاصة لتلقّي الحديث، فكان الطلبة يضطرون إلى الارتحال والتجوال، وإنّما كانت المدارس التي تتعمّق في الفقه ومذاهبه وآرائه والمجتهدين فيه تؤسّس في كلّ مكان، لتزوّد جهاز الدولة بالقضاة والمتشرّعين.
ولقد أنشئت أوّل دار للحديث في القرن الهجري السادس تحقيقًا لرغبة نور الدين محمود بن أبي سعيد زنكي (569 هـ) الذي خلد اسمه بإنشاء المدرسة النوريّة في دمشق. وكان ابن عساكر صاحب " تاريخ دمشق " من شيوخ هذه المدرسة (1).
وبعد عشرات السنين، قامت في القاهرة دار للحديث بأمر الملك الأيوبي الكامل ناصر الدين، وقد تمّ تأسيسها سنة 622 هـ، وكان أول أستاذ فيها أبا الخطاب بن دحية (2).
وبعد أربع سنوات من تأسيس المدرسة الكاملية، نشأت ني دمشق المدرسة الأشرفية سنة 626 هـ، فكان أول شيوخها أبا عمرو بن الصلاح (3) ودرس في هذه الدار أيضا الإمام النووي (4).
ولقد قامت في دمشق دور أخرى للحديث، ولكنّها لم تكن ذات شأن عظيم (5).
وهذه الدور جميعا لم تطل حياتها؛ لأنّها لم تكُ كمدارس الفقه والأحكام بل وسيلة إلى المناصب والقضاء، والحظوة عند الخلفاء، ثم هي - فوق ذلك - لم تكُ تشفي غلة الورعين من طلاب الحديث. الذين ظلّوا يؤثرون الرحلة والطواف بالأقاليم.
ألقاب المحدّثين: وكما أطلق العلماء على الرحّالين في طلب الحديث ألقابًا مختلفة، تبعًا لنشاطهم في الرحلة والتجوال، أطلقوا على الدارسين في بلدهم أو في الأقاليم المجاورة له ألقابا «رسميّة» كانوا يستحسنون إلحاقها بأسمائهم عند ترجمتهم لتعرف طبقاتهم ودرجاتهم وطرق تحمّلهم للحديث وأدائه.
وأشهر الألقاب التي نبّهوا على التمييز بينها ثلاثة: المسند والمحدّث والحافظ.
فالمسند هو من يروي الحديث بإسناده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلّا مجرّد روايته (6).
والمحدّث أرفع منه بحيث عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع "الكتب الستة" و "مسند أحمد بن حنبل" و"سنن البيهقي" و"معجم الطبراني"، وضمّ إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثيّة (7).
أمّا الحافظ فهو أعلاهم درجة وأرفعهم مقامًا: فمن صفاته أن يكون عارفًا بسنن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، بصيرا بطرقها، مميزا لأسانيدها، يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحّته، وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقلته، يعرف فرق ما بين قولهم: فلان حجّة، وفلان ثقة، ومقبول، ووسط، ولا بأس به، وصدوق، وصالح، وشيخ، ولين، وضعيف، ومتروك، وذاهب الحديث، ويميّز الروايات بتغاير العبارات: نحو عن فلان، وأن فلانا؛ ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين أن يكون المسمى صحابيا أو تابعيا، والحكم في قول الراوي: قال فلان، وعن فلان، وأنّ ذلك مقبول من المدلّسين دون إثبات السماع على اليقين، ويعرف اللفظة في الحديث تكون وهما وما عداها صحيحا، ويميّز الألفاظ التي أدرجت في المتون فصارت بعضها لاتّصالها بها، ويكون قد أنعم النظر في حال الرواة بمعاناة علم الحديث دون ما سواه؛ لأنّه علم لا يعلق إلّا بمن وقف نفسه عليه، ولم يضمّ غيره من العلوم إليه» (8).
ولعلّ أهمّ صفات الحافظ - كما يستنبط من أقوال العلماء وتعاريفهم - أنّه يتوسّع في أسماء الرجال حتّى يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه عن كلّ طبقة أكثر ممّا يجهله (9).
ويعتقد كثير من نقّاد الحديث أنّ الذين يجوز تسميتهم «بالحفّاظ»، قليلون في كلّ زمان ومكان وبما «يتعذّر وجودهم» (10)، لما يشترط لهم من نادر الصفات وسعة العلم. وحسبك أنّ الوصف بالحفظ على الاطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصّة، فلا يقول قارئ القرآن: لقنّني فلان الحافظ، ولا يقول النحويّ: علّمني فلان الحافظ (11).
وذهب الناس يغلون في الحفّاظ كلّ مذهب، فقد عدّت كتب الإمام أحمد في اليوم الذي مات فيه، فبلغت اثني عشر حملاً، ما على ظهر كتاب منها «حدّث فلان» ولا في بطنه «أخبرنا فلان»، وكلّ ذلك كان يحفظه من ظهر قلبه (12).
قال: يحيى بن معين (13): «كتبت بيديّ هذه ستّمائة ألف حديث» (14) ولا عجب في ذلك، فقد ترك يحيى أكثر من مائة قمطر وأربعة عشر قمطرًا مملوءة كتبًا (15). وأمر بن عقدة (16) ليس أقل عجبًا؛ لأنّ الأخبار تصوّره حافظًا أربعمائة ألف حديث أملاها من حفظه على إخوة أربعة، ولا يبعد أن يكون حافظًا غيرها. قال عبد الله القادسيّ - وهو أحد هؤلاء الأربعة -: «أقمت مع إخوتي بالكوفة عدة سنين فكتب عن ابن عقدة، فلمّا أردنا الانصراف ودّعناه، فقال ابن عقدة: قد اكتفيتم بما سمعتم، أقلّ شيخ سمعت منه، عندي عنه مائة ألف حديث. (قال): فقلت: أيّها الشيخ، نحن إخوة أربعة، قد كتب كلّ واحد منا عنك مائة ألف حديث!» (17).
وحين ينسب إلى أحد هؤلاء الحفاظ عدد عظيم من الأحاديث كتبه بيده أو أملاه على تلاميذه، فهو يحفظه غالبًا من ظهر قلبه. قال أبو زرعة (18): «ما في بيتي سواد على بياض إلّا وأحفظه» (19) وقال الشعبي: " ما كتبت سوادًا في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدّثني رجل بحديث قط إلّا حفظته» (20).
ومن الحفّاظ من كان يستعين على حفظ الحديث بكتابته، فإذا أتقن حفظه محاه أو دعا بمقراض فقرضه خوفًا من أن يتّكل القلب عليه، منهم سفيان الثوري (21)، وعاصم بن ضمرة (22)، وخالد الحذاء (23) وقد شاع على ألسنة الناس: بئس المستودع العلم القراطيس! (24).
وكان في العلماء من يميل إلى تحديد العدد المحفوظ من الحديث الذي يستحق جامعه أن يسمّى «حافظًا».
فقال الحاكم (25) في " المدخل ": «كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث» (26). ورأى غيره أنّ الحد الأدنى ينبغي ألّا يقلَّ عن عشرين ألفًا، ولكن فتح الدين بن سيد النّاس (27) يلاحظ أنّ هذه القضية نسبيّة، وأنّ لكلِّ زمن اصطلاحًا وتحديدًا، فيقول: «أمّا ما يحكى عن بعض المتقدّمين من قولهم: كنّا لا نعدّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم» (28).
وإذا كان العدد المحفوظ يتردّد بين مئات الألوف وعشراتها - وهو فرق عظيم جدًّا - فإنّ لهذا التردّد تعليلاً واضحًا، فحين تذكر المئات يشمل الحفظ المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي. نسب الإمام أحمد إلى أبي زرعة أنّه كان يحفظ سبعمائة ألف، ففسّر البيهقي (29) ذلك بقوله: «أراد ما صحّ من الحديث، وأقوال الصحابة والتابعين» (30).
وقد يشمل حينئذٍ الصحيح وغير الصحيح. قال الإمام البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح» (31).
وكأنّهم - حين يقتصرون على عشرات الألوف - لا يريدون إلا ما صحّ من الأحاديث المرفوعة.
والورعون من الحفّاظ ما كانوا ليرضوا عن غلوّ الناس في شأنهم لو كان لهم الخيرة من أمرهم، فإنّ واحدهم يكون عنده الحديث فيسوقه الناس بالقرعة حتّى يخرجه أو يرويه (32). ويكتب أحدهم أو يحفظ مئات الألوف فلا يروي إلّا عشراتها، أو يحفظ عشرات الألوف فلا يحدّث إلّا بآحادها، وهم يشترطون على أنفسهم - فوق هذا كلّه - التعمّق في العلم والفهم والدراية، لا مجرّد الإكثار والتوسّع في الرواية (33).
رواية الحديث بالحفظ:
ويزداد إكبارنا لهؤلاء الحفّاظ إذا عرفنا أنّ العلماء كانوا - ولا سيما في بادئ الأمر - يتشدّدون في الرواية باللفظ والنص، ولا يتساهلون حتّى بالواو والفاء.
فكانوا يرون أنّ على المؤدّي أن يروي ما تحمّله باللفظ الذي تلقّاه من شيخه دون تغيير ولا حذف ولا زيادة. واستدلّوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: «نضّر الله امرءًا سمع حديثًا فأدّى كما سمعه، فرُبَّ مبلّغ أوعى من سامع» (34)، وبتعليمه - عليه السلام - الصحابة الحرص على لفظه النبويّ، كما فعل مع البراء بن عازب حين أعاد أمامه قراءة الدعاء الذي علّمه إيّاه عند أخذ المضجع فأورده كما تعلّمه منه، إلا أنّه قال: «ورسولك» بدلاً من «ونبيّك» فنبّهه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قائلاً بيده في صدره: «ونبيّك» (35).
ولذلك آثر أكثر الصحابة التشدّد في الرواية باللفظ. قيل لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: ما لك لا تحدّث كما يحدّث فلان وفلان؟ فقال: «ما بي ألّا أكون سمعت مثل ما سمعوا، أو حضرت مثل ما حضروا، ولكن لم يدرس الأمر بعد، والناس متماسكون، فأنا أجد من يكفيني، وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -» (36).
وعلى هذا الأساس راح بعض الصحابة يصحّح ما يسمعه من الرواة من تغيير اللفظ النبوي بالتقديم والتأخير، أو استبدال كلمة بمرادفها، قال عبيد بن عمير وهو يقص: «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» فقال ابن عمر: ويلكم، لا تكذبوا على رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، إنّما قال - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» (37)، وسمع ابن عمر أيضًا رجلاً يردّد حديث الأركان الخمسة، فقدّم بعضًا مخالفًا بذلك الرواية التي سمعها ابن عمر بنفسه من رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - فقال له: «اجعل صيام رمضان آخرهن، كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» (38).
وفي عصر التابعين وأتباع التابعين ظلّ كثير من الرواة يؤدِّي حديث رسول الله بلفظه ونصّه، وإن كان آخرون منهم لا يرون بأسًا بالرواية على المعنى، قال ابن عون: «[أدركت ستّة]، ثلاثة منهم يشدّدون في الحروف، وثلاثة يرخّصون في المعاني، [وكان] أصحاب الحروف القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين،...»(39).
ولقد صوّر الأعمش تشدّد الرواة بالحروف، فحمد لهم هذا التشدّد وتغنّى به قائلا: «كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخرّ من السماء أحبّ إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا، وإنّ أحدهم اليوم يحلف على السمكة أنّها سمينة وإنّها لمهزولة»(40).
فلا غرو إذا حرص هؤلاء الورعون على قول النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: «ينتبذ» لا «ينبذ» (41)، ولا غرو إذا أظهروا شكّهم بعبارة صريحة، فقال الراوي: «أسلم وغفار أو غفار وأسلم» (42) أو «نمى خيرًا» أو «نمّى خيرًا» (43) بالتشديد أو التخفيف. وإنّ الأمر لأجدر بالحرص والعناية عند الرواة من هذا كلّه، فبعضهم يتحرّج من تغيير اللحن، ويبقي كلام الراوي صحابيا كان أو تابعيًا على حاله؛ لأنّ القوم حدّثوه هكذا، فلا ضير من استعمال «حوث» بدلاً من «حيث» (44) أو «لغيت» بدلاً من «لغوت» (45) و«عوثاء السفر» بدلاً من «وعثائه» (46).
ولذلك رووا عن ابن سيرين أنّه «كان يلحن كما يلحن الراوي» (47).
وفسّر الإمام أبو عبيد ظاهرة إبقاء اللحن على حاله بقوله: «لأهل الحديث لغة، ولأهل العربيّة لغة، ولغة أهل العربيّة أقيس، ولا تجد بدًّا من اتّباع لغة [أهل] الحديث لأجل السماع» (48).
ثُمَّ رأى العلماء أن يميّزوا في هذا الموضوع بين لحن يحيل المعنى وآخر لا يحيله فرأوا أنّه لا بُدَّ من تغيير اللحن الذي يفسد المعنى (49)، وقالوا بضرورة ردِّ الحديث إلى الصواب، إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب (50).
أمّا الطائفة التي لم ترَ بأسًا في رواية الحديث بالمعنى، فإنّها اشترطت لذلك شروطًا، منها أن يكون الراوي عالمًا بالنحو والصرف وعلوم اللغة عارفًا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها، بصيرًا بمدى التفاوت بينها، قادرًا على أن يؤدّي الحديث أداء خاليًا من اللحن؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أفصح من نطق بالضاد.
فمن الكذب عليه أن يضع المؤدّي في فيه لحنًا يستحيل أن يقع منه. قال الأصمعي: «أخشى عليه إذا لم يعرف العربيّة أن يدخل في قوله: "من كذب على متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النّار" فإنّ النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه» (51).
وإذ كانت علوم العربية متشعّبة، والإحاطة بها وبالفوارق الدقيقة بين ألفاظها ومدلولاتها شبه مستحيلة، منع بعض العلماء غير الصحابة من رواية الحديث بالمعنى، لأنّ «جبلّتهم عربية، ولغتهم سليقة». قال القاضي أبو بكر بن العربي (52): «إنّ هذا الخلاف إنّما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأمّا من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى؛ فإنّا لو جوّزناه لكلّ أحد لما كنّا على ثقة من الأخذ بالحديث؛ إذ كلّ أحد إلى زماننا هذا قد بدّل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما [رواه]؛ فيكون خروجًا من الإخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنّهم اجتمع فيهم أمران عظيمان:
أحدهما: الفصاحة والبلاغة؛ إذ جبلّتهم عربية، ولغتهم سليقة.
والثاني: أنّهم شاهدوا قول النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كلّه؛ وليس من أخبر كمن عاين.
ألا تراهم يقولون في كلّ حديث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بكذا"، و"نهى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - عن كذا"، ولا يذكرون لفظه؟ وكان ذلك خبرًا صحيحًا ونقلاً لازمًا؛ وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه» (53).
ووقف الإمام مالك من الرواية بالمعنى موقفًا وسطًا، فأجازها فيما لم يرفع إلى رسول الله، وتشدّد في منعها في الأحاديث المرفوعة، حتّى كان ورعا منه واحتياطًا - يتحفّظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كما روى عنه البيهقي في "مدخله" (54).
على أنّ ابن الصلاح لا يرى ضرورة للتشدّد في رواية الحديث بالمعنى في المرفوع دون سواه، وإنّما يشترط على من يريد الأداء بالمعنى في المرفوع وغيره اكتساب العلم بالعربيّة والقدرة على التصرّف الصحيح فيها على الوجه الذي ذكرناه، فإنّه يقول: «ومنعه بعضهم في حديث رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - وأجازه في غيره والأصحّ جواز ذلك في الجميع، إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنّه أدّى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأنَّ ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأوّلين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلّا لأنّ معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثُمَّ إنّ هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه النّاس - فيما نعلم - فيما تضمّنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنّف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه: فإنّ الرواية بالمعنى رخّص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، فليس يملك تغيير تصنيف غيره» (55).
والرواية بالمعنى ينبغي أن تظلّ مقيّدة ببعض العبارات الدالّة على الحيطة والورع، فعلى راوي الحديث إذا شكّ في لفظ من روايته أن يتبعه بقوله: «أو كما قال»، «أو كما ورد» (56).
وأكثر الرواة يحرصون على أن يؤدّوا الحديث تامًّا بجميع ألفاظه، ويرون في ذلك ضربًا من العناية باللفظ النبوي، إلّا أنّ بعض العلماء يتساهلون في اختصار الحديث، فيحذفون بعضه، ويقطّعونه، ويروونه تفاريق في مناسبات مختلفة، كما صنع البخاري في "صحيحه". ولم يرَ الأئمة في صنيع البخاري موضعًا للنقد؛ لأنّهم لاحظوا أنّه لا يتساهل في ذلك إلا إذا كان قد أورد الخبر تامًّا في رواية أخرى. ولذلك لم يجوّزوا اختصار الحديث إذا لم يرد تامًّا من طريق أخرى، لئلا يكون ذلك كتمانًا لما يجب تبليغه(57).
وهذا التساهل في أداء الحديث كان نتيجة طبيعية للتساهل عند تحمّله: فمن قبل أن يقدم بعض الأئمّة على إباحة الأداء بالمعنى، أو على الإذن باختصار المرويّ وتقطيعه، ترخّص كثير منهم في تحمّل الحديث بضروب جديدة من السماع في شيء، ولم يكن ترخّصهم هذا - في نظر الجمهور - سيء الأثر ولا شديد الخطر.
أخذت هذه الرحلة في طلب الحديث تضعف شيئا فشيئا، وبات الرحّالون أنفسهم لا يستطيعون أن يعوّلوا على المشافهة والتلقي المباشر، فقد يضربون أكباد المطي إلى إمام عظيم حتّى إذا أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا منه بكتاب يعرضونه عليه، أو بإجازة يخصّهم بها، أو بأجزاء حديثيّة يناولهم إيّاها مع إذنه لهم بروايتها، وقد يتطوّع هذا الإمام نفسه بإعلامهم بمرويّاته، أو الوصيّة لهم ببعض مكتوباته، فيتلقفونها تلقّفا ويروونها مطمئنّين كما لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا إبهام. بل لقد أمسى المتأخّرون لا يجدون حاجة للرحلة ولا لتحمّل مشاقّ مذ أصبح حقًّا لهم ولغيرهم أن يرووا كلّ ما يجدون من الكتب والمخطوطات سواء ألقوا أصحابها أم لم يلقوهم. وذلك كلّه يعني أنّ السماع لم يعد - كما في فجر الإسلام - الصورة الوحيدة لتحمّل الحديث وأدائه، وإنّما أضحى إحدى الطرق الثمان التي استقرأها نقّاد الحديث. وبحثنا التالي سيدور حول هذه الطرق الثمان، وبدراستها وتتبّع اصطلاحاتها ودقّة التمييز بين عباراتها سيجد القارئ نفسه على موعد مع المحدّثين لأوّل مرة، فليحضر القلب وليرهف السمع، فإنّ لهؤلاء العلماء لغتهم الخاصّة التي إن لم تطرب بإيقاعها الحلو كلغة الشعر والموسيقى، فهي تعجب بمحتواها العميق كلغة فذّة في فنّ النقد والتحليل!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ( Wustenfeld, die Akademien der Araber und ihr Lehrer, p.69 (ef. Tradit. Isla 231 note 1.
وكتاب وستنفلد المذكور من أطرف ما ألف في وصف دور العلم عند العرب والترجمة لشيوخها. أما ابن عساكر فهو أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي الشافعي خاتمة الجهابذة الحفاظ. توفي سنة 571 هـ.
(2) هو الحافظ عمر بن الحسن المشهور بابن دحية. وهو أندلسي بلنسي، نسبة إلى بلنسة مدينة شرق الأندلس. توفي بالقاهرة سنة 633 هـ. له " التنوير في مولد السراج المنير ". ويفهم من " خطط المقريزي ": 2/ 375 أن فتى ليس له من ابن آدم إلا الشكل خلف ابن دحية في التدريس بالكاملية.
(3) هو الحافظ المعروف أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. توفي سنة 643 هـ.
(4) هو الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. له في علوم الحديث تصانيف كثيرة أشهرها " شرح صحيح مسلم "، توفي سنة 676 هـ.
(5) وقد تناول هذه الدور بالدراسة الإحصائية الدقيقة ( Michael Meschaka's Cultur-Statistik von Damaskus (ef. Tradit. Islam, 232 note 1.
(6) "تدريب الراوي": ص 4.
(7) " تدريب الراوي ": ص 6. وعبارة القاسمي في " قواعد التحديث ": ص 53، مقتبسة من هنا بتصرف.
فقد ذكرت فيها المسانيد والمعجم والأجزاء دون تحديد. وليس هنا موضع الحديث في الفرق بين أنواع هذه الكتب والتصانيف. وسنتحدث عنها وعن أصحابها في باب خاص.
(8) " الجامع لأخلاق الراوي ": 8/ 150 وجه 2.
(9) " التدريب ": ص 7 وقارن بـ " قواعد التحديث ": ص 53.
(10) " الجامع لأخلاق الراوي ": 8/ 159 وجه 1.
(11) " الجامع ": 8/ 152 وجه 1.
(12) " الجامع ": 8/ 151 وجه 1.
(13) هو سيد الحفاظ، وإمام الجرح والتعديل، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني مولاهم، البغدادي، توفي بالمدينة سنة 233 هـ.
(14) " الجامع ": 8/ 151 وجه 2. وفي " التدريب ": ص 8 «أن ابن معين كتب بيده ألف حديث».
(15) " الجامع ": 8/ 151 وجه 2. وفي " التدريب ": ص 8 «أن ابن معين كتب بيده ألف حديث».
(16) هو الحافظ الجامع المصنف أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، أبو العباس، مولى بني هاشم، المعروف بابن عقدة. توفي عام 382 هـ (" الرسالة المستطرفة ": ص 84).
(17) " الجامع ": 8/ 152 وجه 1 و2.
(18) هو أبو زرعة الرازي، عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي بالولاء، الحافظ الثقة المشهور. توفي سنة 264 هـ (" الرسالة المستطرفة ": ص 48). وكان الإمام أحمد يقول: «صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - قد حفظ سبعمائة ألف» (" التدريب ": ص 8 ").
(19) " الجامع ": 8/ 152 وجه 1.
(20) " تدريب الراوي ": ص 8.
(21) انظر " سنن الدارمي ": 1/ 125.
(22) " المحدث الفاصل " للرامهرمزي: 4/ 5 وجه 1، وتوفي عاصم سنة 174 هـ.
(23) " تقييد العلم ": ص 59. والحذاء هو خالد بن مهران، المتوفى سنة 141 هـ. ومن الذين كانوا يكتبون ويمحون ابن شهاب (انظر " جامع بيان العلم ":1/ 66) وابن سيرين (" المحدث الفاصل ": 4/ 5 وجه 2).
(24) " جامع بيان العلم ": 1/ 69.
(25) هو أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المعروف بالحاكم النيسابوري وبابن البيع، صاحب التصانيف الشهيرة، وأهمها " المستدرك على الصحيحين " و " المدخل ". توفي سنة 405 هـ.
(26) " تدريب الراوي ": ص 8.
(27) هو أبو الفتح، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المشهور بابن سيد الناس، اليعمري الأندلسي الأصل، المصري الشافعي، أحد الأعلام الحفاظ، توفي سنة 734 هـ. له " عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ".
(28) " تدريب الراوي ": ص 7.
(29) سترد ترجمة البيهقي.
(30) " تدريب الراوي ": ص 8.
(31) " تدريب الراوي ": ص 8 أيضا.
(32) " الجامع ": 8/ 151 وجه 2.
(33) " الجامع ": 8/ 151 وجه 1.
(34) " الكفاية ": ص 173.
(35) " الكفاية ": ص 175. عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك» (قال): قلت: الله ورسوله أعلم، قال: " إذا أويت إلى فراشك طاهرا، فتوسد يمينك، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، [رغبة ورهبة إليك]، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت "، فقلت كما علمني غير أني قلت: ورسولك، فقال بيده في صدري: «وبنبيك».
(36) " الكفاية ": ص 172.
(37) " الكفاية ": ص 173.
(38) " الكفاية ": ص 176. وابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، توفي سنة 73 هـ.
(39) " الجامع لأخلاق الراوي ": 5/ 101 وجه 1.
(40) " الكفاية ": ص 178. والأعمش هو سليمان بن مهران (- 148 هـ).
(41) " الكفاية ": ص 178.
(42) " الكفاية ": ص 179.
(43) " الكفاية ": ص 180.
(44) " الكفاية ": ص 182.
(45) " الكفاية ": ص 183.
(46) " الكفاية ": ص 180.
(47) " الكفاية ": ص 186.
(48) " الكفاية ": ص 182. وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، أحد كبار الأئمة في الحديث واللغة، توفي سنة 223 هـ.
(49) " الكفاية ": ص 188.
(50) " الجامع لأخلاق الراوي ": 6/ 103 وجه 1.
(51) " اختصار علوم الحديث ": ص 162.
(52) هو محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي، من مشاهير فقهاء إشبيليّة. توفي سنة 544 هـ.
(53) " أحكام القرآن ": 1/ 10.
(54) " الباعث الحثيث ": ص 158، وقارن بـ "الكفاية": ص 179.
(55) " علوم الحديث " لابن الصلاح: ص 189.
(56) " الباعث الحثيث ": ص 161.
(57) " الباعث الحثيث ": ص 161.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













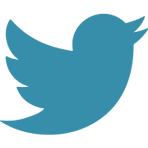

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)