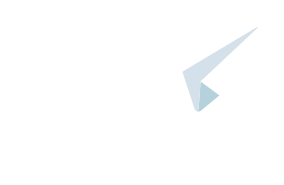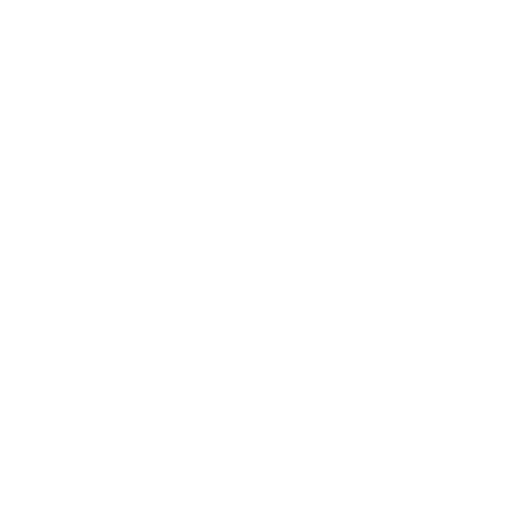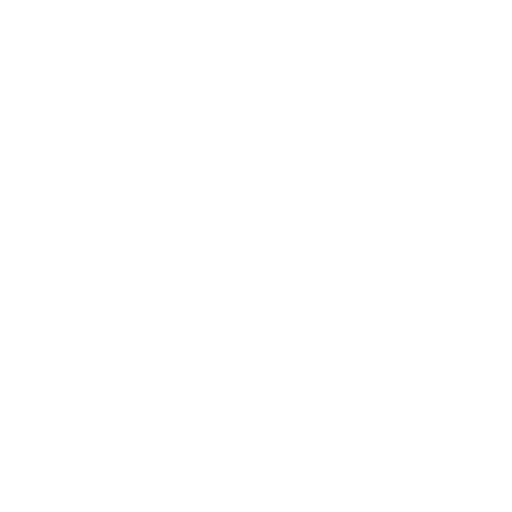علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
الرحلة في طلب الحديث
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 53 ــ 62
2025-09-06
102
الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ:
وما كان لِلْرُوَّاةِ - تجاه هذا التفرّد الإقليمي في الرواية - أنْ يقنعوا بأخذ العلم من أهل بلدهم (1)، ولا يأخذه من المدينة وحدها سواء أكانت بعيدة عن مصرهم أم قريبة منه، فأصبحت الرحلة في طلب الحديث إلى البلاد النائية أشهى أمانيهم، فبها استطاعوا أنْ يتلقّوا العلم من أفواه الرعيل الأول من الرُواة، وبها تحقّق لهم ما كانوا يعتقدونه من أنَّ «حُصُولَ المَلَكَاتِ عَنْ المُبَاشَرَةِ وَالتَّلْقِينِ أَشَدُّ اسْتِحْكَامًا وَأَقْوَى رُسُوخًا» (2).
ولقد بدأ طلب العلم بالمشافهة في القرن الهجري الأول، فكان الصحابي الجليل أبو الدرداء (3) يقول: «لَوْ أَعْيَتْنِي آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَفْتَحُهَا عَلَيَّ إِلاَّ رَجُلٌ بِبِرْكِ الغِمَادِ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ» (4).
والصحابي العليم جابر بن عبد الله (- 78 هـ) ابتاع بَعِيرًا فَشَدَّ عليه رحله وسار شَهْرًا حتّى قدم الشام ليسأل عبد الله بن أُنيْس عن حديث في القصاص (5).
وكانت الرحلة في حديث واحد مألوفة عند كثير من السلف، فعن سعيد بن المسيّب (- 105 هـ): «إِنْ كُنْتُ لأَرْحَلُ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِي فِي طَلَبِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ» (6)، وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (- نحو 104 هـ): «لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا مَا لِي حَاجَةً إِلّا رَجُلٌ عِنْدَهُ [حَدِيثٌ يَقْدمُ]، فَأَسْمَعُهُ مِنْهُ» (7).
والرواية التالية عن مكحول: (- نحو 112 هـ) تصلح مِثَالاً وَاضِحًا للرحلة في حديث واحد ربّما لا يلقي إليه أحدنا بالاً، ونحسبه هَيِّنًا وهو عند الله عظيم.
قَالَ مَكْحُولٌ: «كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ، حَتَّى [لَقِيتُ] شَيْخًا يُقَالُ لَه زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ (الْفِهْرِيَّ) يَقُولُ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ» (8). ولعلّ هذا الظمأ إلى طلب العلم أَنْ يكون السبب في سفر عبدان (9) إلى البصرة ثماني عشرة مَرَّةً ليسمع ما يرويه أهل هذا المصر من السُنَنِ التِي تَفَرَّدَ بها أيّوب (10).
واختلفت أشكال الرحلة وصورها باختلاف الأشخاص والأمصار والأجيال فكان في الراحلين من يمشي على رجليه (11)، ومن يرتحل وهو ابن خمس عشرة سَنَةً أو ابن عشرين (12)، ومن يوصف بأنّه أحد من رحل وتعب (13)، أو بأنَّ له رحلة واسعة(14)، أو أنّه أكثر وأكثر الترحال (15)، أو أنَّ له العناية التامّة بطلب الحديث والرحلة(16)، أو أنّه بقي في الرحلة بضع عشرة سنة (17)، وكان يقال في أمثال هؤلاء أَحْيَانًا: تُضرَب إليه آباط المطيِّ أو أكباد المطيِّ (18)، أو رحل الناس إليه(19)، أو كانت الرحلة إليه في زمانه (20).
وواضح أنَّ لقب «الرحَّال والرحَّالة، والجوَّال والجوَّالة» كان وقفاً على كبار المُحَدِّثِينَ أمثل من ذكرنا ممّن تحمَّل المشاق، وسافر إلى الآفاق، طلباً لأحاديث تقل أو تكثر، فكان الناس يسألون عن نوع المشقات التي مَرَّ بها هؤلاء المحدّثون، وكان الذي يوصف بأنّه «طوَّاف الأقاليم» موضع الإكبار والإجلال في جميع العصور.
ولا ريب أنَّ بعض هؤلاء الجوّالين قد طوَّفوا بالشرق وبالغرب مراراً.
وإنَّ المستشرق جولدتسيهر Goldziher - على ولوعه بإنكار أخبار القوم - لا يفوته أنْ يعترف بأنَّ «الرحَّالين الذين يقولون إنّهم طافوا الشرق والغرب أربع مرات ليسوا - مبعدين ولا مغالين» (21).
أثر هذه الرحلات في توحيد النصوص والتشريعات:
وإذا كان هؤلاء المشهورون بالطلب والرحلة (22) قد وثَّقُوا الأواصر بين بلدان العالم الاسلاميّ فذلك أمر واضح تفرضه طبائع الأشياء، وما كانت النتيجة لتتمّ على غير هذه الصورة؛ لأنَّ طواف الكثير منهم بالأقاليم ربط بين المشرق والمغرب (23)، وألغى السدود والحدود، وجعل هذا العالم الاسلاميّ أشبه بالمدينة الواحدة، تنطوي قلوب أبنائها جميعًا على مبادئ واحدة وتعاليم مماثلة. بيد أنَّ أثر هذه الرحلات كان في الحديث نفسه - نصّاً وروحاً - أبلغ منه في أمصار: فلقد كانت هذه الرحلات تمهيداً لطبع الحديث بطابع مشترك تتماثل فيه النصوص والتشريعات، وإنْ كانت أصول روايتها مختلفة المصادر حين تفرّد بها أول الأمر إقليم واحد لم يَشْرَكه أحد.
وكان أقل ما يفترض في هذا التفرّد الإقليميّ اختلاف العبارات باختلاف الرُّواة في الأقاليم، ولكن هذه الروايات المتباينة أخذت في التقارب شيئاً فشيئاً حتّى أمكن صهرها في قالب واحد، وخيَّل إلى سامعها أو قارئها للمرة الأولى أنّها رواية مصر واحد لا عدّة أمصار.
والأمثلة على هذا كثيرة، غير أنّنا نجتزئ منها بذكر حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى» لأهميته في نظر المُحَدِّثِينَ. فعبد الرحمن بن مهدي (- 198 هـ) يقول: «مَا يَنْبَغِي لِمُصَنِّفٍ أَنْ يُصَنِّفَ شَيْئًا مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ إِلّا وَيَبْتَدِئُ بِهَذَا الحَدِيثِ» (24).
وبمثل هذا صرَّح البخاري في قوله: «من أراد أنْ يصنِّف كتاباً فليبدأ بحديث "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"» (25)، وهو الحديث الذي افتتح به البخاري "صحيحه" - كما هو معلوم - فشرع بتطبيق هذا المبدأ على نفسه، وبه افتتح العلماء الكثير من مصنَّفات الحديث أخذاً بهذه الوصيّة الكريمة.
وحين يجد القارئ في كتب السُنن أنَّ حديث النية طليعة هذه الكتب، وأنَّ متنه يكاد يكون واحداً فيها جميعاً، يُخيَّلُ إليه أنَّ شروط التواتر متوافرة فيه، وأنّه لا بد أنْ يكون قد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير، والحق أنَّ هذا الحديث - كَمَا قَالَ البَزَّارُ (26) في " مُسْنَدِهِ " - «لاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - إِلّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَلاَ عَنْ عُمَرَ إِلّا مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ، وَلاَ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَلاَ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى» (27): فلا يكون متواترًا (28) لانفراد عمر به.
وهو - فوق هذا - لم يكن معروفًا إلّا في المدينة، ولكنّه استفاض بعد ذلك في سائر الأمصار بصيغته المشهورة، فكان دليلاً واضحًا على ما للرحلات من أثر في توحيد نص الأحاديث ونقلها من طابعها الإقليميّ الأصلي إلى الطابع العام المشترك: ولذلك تشابهت الروايات الماثلة في الكتب الصحيحة حول الموضوع الواحد إلّا في بعض الفروق الدقيقة اليسيرة التي لم يفت المُحَدِّثِينَ التنبيه عليها، ولم يكن سبب هذا التشابه النادر العجيب إلّا تلاقي الرُواة حي يرتحل بعضهم إلى بعض، أو يُلَقِّنَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَيُحَدِّثُونَ الناس في الذهاب والاياب (29).
ولم يقف أثر هذه الرحلات عند حد التشابه بين النصوص، أو التوحيد بينها أَحْيَانًا، كما في حديث النيّة هذا، بل تَعَدَّاهُ إلى وحدة التشريع ووحدة الاعتقاد: فمن هذا الحديث استنبط العلماء كَثِيرًا من المسائل الفقهيّة التي صدروا فيها عن سماحة الاسلام في معالجة الضمير البشري وتعويله على القلوب والسرائر لا على الصور والأشكال(30).
وإذا كان للرحلات مثل هذا الأثر في توحيد التشريع والاعتقاد، فلا بد من التشدُّدِ في الأسانيد، لمعرفة كل رجل ورد اسمه في سلسلة الإسناد، لأنَّ «مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ العِلْمِ» كما يقول علي بن المديني (31).
لذلك اشترطوا لقبول رواية الطالب الذي يزعم أنّه رحل في الحديث وتعب أنْ يسرد من حفظه أسماء سلسلة الإسناد جميعاً، ثم يضيف اليها في آخرها اسمه، لِيُعْلَمَ أنْ قد سمع حقّاً ما يرويه، وإلّا عُدَّ متساهلاً وترك الاحتجاج بحديثه (32)، ولو كان إماماً واسع العلم مشهوداً له بالفضل.
فالذهبي (33) يقول في ابن لهيعة (174 هـ) «الإمام الكبير قاضي الديار المصريّة» (34)، ويروي عن ابن حنبل أنّه قال فيه: «مَا كَانَ مُحَدِّثُ مِصْرَ إِلّا ابْنَ لَهِيعَةَ» وَلَكِنَّ هذا الإمام الكبير المُحَدِّثَ لا يلبث أنْ يُرْمَى بالتساهل في نظر الذهبي نفسه فيقول: «يُرْوَى حَدِيثُهُ فِي المُتَابَعَاتِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ»(35) ويقول: «وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ باِلمُتْقَنِ» (36)، ذلك بأنَّ ابن لهيعة - كما يقول الخطيب البغدادي - «وَكَانَ يَتَسَاهَلُ فِي الأَخْذِ وَأَيَّ كِتَابٍ جَاؤُوهُ بِهِ حَدَّثَ مِنْهُ فَمِنْ هُنَاكَ كَثُرَتِ المَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ» (37).
قال يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ: «جَاءَ قَوْمٌ وَمَعَهُمْ جُزْءٌ فَقَالُوا: سَمِعْنَاهُ مِنِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَجِئْتُ إِلَى ابْنِ لَهِيعَةَ فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي حَدَّثْتَ بِهِ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِكَ وَلاَ سَمِعْتَهَا أَنْتَ قَطُّ؟ فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ؟ يَجِيئُونِي بِكِتَابٍ فَيَقُولُونَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَأُحَدِّثُهُمْ بِهِ» (38).
ولا ريب أنَّ كَثِيرًا من المبالغات تحف أخبار الرحَّالين، وإنْ كان لا بُدَّ أنْ يكون لها في أصلها سندٌ صحيح. فهذا حجّاج بن الشاعر يقول: «جَمَعَتْ لِي أُمَّي مِائَة رَغِيفٍ فَجَعَلَتْهَا فِي جِرَابٍ، وَانْحَدَرْتُ إِلَى شَبَابَة بِالمَدَائِنِ، فأقمتُ بِبَابِهِ مِائَة يَوِمٍ، كُلَّ يَوْمٍ أَجِيءُ بِرَغِيفٍ فَأَغْمِسُهُ فِي دِجْلَةَ فَآكُلُهُ، فَلَمَّا نَفِدَتْ خَرَجْتُ» (39).
وهذا أحمد بن الفرات (40) يخبر بنفسه بأنّه «كَتَبَ عَنْ أَلْفٍ سَبْعٍ وَمِائَةَ شَيْخٍ» (41) على حين لم نعرف من أسماء شيوخ الإمام البخاري الذين تَلَقَّى عنهم وأخذ من أفواههم - عند جمع "صحيحه" - إِلاَّ أَلْفًا وزيادة قليلة (42).
وقالوا في أبي عبد الله بن منده (- 395 هـ): إنه ختام الرَّاحلين (43)؛ لأنّه «لَمَّا رَجَعَ مِنَ الرِّحْلَة الطَّوِيلَةِ كَانَتْ كُتُبُهُ عِدَّةَ أَحْمَالٍ حَتَّى قِيلَ: إِنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ حِمْلاً» (44).
وحين صُنِّفَتْ كتب الحديث لم تُغْنِ عن الرحلة في طلب العلم، فلقد كانت الكتب لتيسر التحصيل على المتساهل، أمّا الذي كان يلتمس شرف العلم وكرامته فلم يكن ليرضى بما يقرؤه في الكتب بل ظلّت أشهى أمانيه الرحلة في طلب الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وإن كان العلماء يستحبُّون للطالب الاقتصار على حديث بلده وتمهّره في معرفته إذا كان المقصود من الرحلة متحقِّقاً بين علماء عصره. قال الخطيب البغدادي: «المقصود في الرحلة في طلب الحديث أمران: أحدهما: تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم، فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى»" الجامع لأخلاق الراوي ": 9 / ورقة 167 وجه 2.
(2) " مقدّمة ابن خلدون ": ص 541 ط: مصطفى محمد بالقاهرة، بلا تاريخ.
(3) واسم هذا الصحابي الجليل عويمر بن زيد تُوُفِّيَ سَنَةَ 32 هـ.
(4) " معجم البلدان " لياقوت: 1/ 590. وبرك الغماد - بكسر الغين المعجمة، وقال ابن دُريد بضمها، والكسر أشهر - هو موضع وراء مكة بخمس ليال ممّا يلي البحر (معجم البلدان: 1/ 589).
(5) " الجامع لأخلاق الراوي ": 9 / ورقة 168 وجه 2، وانظر ترجمة جابر بن عبد الله في " تذكرة الحفاظ ": 1/ 43 رقم 21.
(6) " الجامع لأخلاق الراوي ": 9 / ورقة 169 وجه 1 وراجع ترجمة سعيد بن المسيّب في " تذكرة الحفاظ ": 1/ 54 رقم 38.
(7) " الجامع لأخلاق الراوي ": 9 / ورقة 169 وجه 1 وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري.
(8) " سنن أبي داود ": 3/ 106 رقم الحديث 2750 وأخرجه " ابن ماجه " بمعناه: 2/ 951 - 952 ومكحول هو عالم أهل الشام أبو عبد الله بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ. (انظر ترجمته في " تذكرة الحفاظ ": 1/ 107 رقم 96).
(9) عبدان هو أحمد بن موسى الجواليقي (- 306 هـ).
(10) " معجم البلدان ": 1/ 414 وأيوب هو العالم الثقة الكبير أيوب بن كيسان السختياني، أبو بكر (- 131 هـ)
(11) كما قيل في أبي موسى الفقيه الحافظ عبد الله بن عبد الغني (- 629 هـ). انظر " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1409.
(12) انظر ترجمة كل من أبي يعلى الموصلي الحافظ الثقة المشهور المتوفى 307 هـ (" تذكرة الحفاظ ": 2/ 708). ومحمد بن علي الملقب بأبي النرسي (- 510 هـ). " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1261.
(13) كالمفيد أبي البركات ابن المبارك السقطي (- 509 هـ) " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1260. أثناء الحديث عن الذين ماتوا سنة 509.
(14) كما في ترجمة الشيرازي أبي يعقوب يوسف بن أحمد إبراهيم الصوفي (- 585). " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1357. وابن متويه إبراهيم بن محمد الأصبهاني (- 302 هـ) " تذكرة الحفاظ ": 2/ 740.
(15) كما في ترجمة الترمذي الكبير المتوفى سنة بضع وأربعين ومائتين. " تذكرة الحفاظ ": 2/ 740.
(16) كما قالوا في البجيري: «الحافظ الإمام الكبير أبي حفص عمر بن محمد بن بجير الهمذاني السمرقندي. مُحَدِّثُ ما وراء النهر. تُوُفِّيَ سَنَةَ 311 هـ» " تذكرة الحفاظ ": 2/ 720.
(17) كأبي طاهر السِلفي - بكسر السين نسبة إلى جدّه سلفة - الحافظ العلاَّمة شيخ الإسلام عماد الدين أحمد بن محمد الأصبهاني الجرواني. تُوُفِّيَ سَنَةَ 576. انظر " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1298 رقم 1298.
(18) " معجم البلدان " لياقوت: 1/ 664.
(19) " تذكرة الحفاظ ": 2/ 807.
(20) كما قالوا في ابن حبيش أبي القاسم عبد الرحمن الأندلسي (- 584 هـ) انظر " تذكرة الحفاظ ": 4/ 1354.
(21) Goldziher Trad. 220.
(22) " معجم البلدان " لياقوت: 3/ 528 أثناء الحديث عن طرطوس ومن خرجت من مشاهير المُحَدِّثِينَ.
(23) لأنَّ العلماء - بتنقلهم في الأمصار الإسلاميّة - لم يجدوا الفرصة للاستقرار في بلدهم، فبينا يكون أحدهم في العراق إذا هو في الشام، وما يكاد يحل في الشام حتى يرحل إلى الأندلس، وفيما هو في الأندلس إذا هو في مصر. ويكثر في كتب الطبقات والتراجم نسبة الحافظ إلى بلده والإشارة إلى البلد الذي نزله: فنزار بن عبد العزيز بغدادي قدم مصر ("تاريخ بغداد": 13/ 437) ونائل بن نجيح الحنفي بصري ورد بغداد (" تاريخ بغداد ": 13/ 434) وعلي بن معبد الرقي نزيل مصر (" [تذكرة] الحفاظ ": 2/ 550). والجوزجاني نزيل دمشق ("[تذكرة] الحفاظ": 2/ 549) وابن واصل السدوسي البصري نزيل بغداد ("[تذكرة] الحفاظ": 1/ 313) وعلي بن سعد العسكري نزيل الري ("[تذكرة] الحفاظ": 2/ 749) وأحمد بن عبد الله العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب (" الحفاظ ": 2/ 560) ومكي بن إبراهيم البلخي قدم بغداد ("[تاريخ] بغداد": 13/ 118).
(24) " الجامع لأخلاق الراوي ": 10/ 193 وجه 2.
(25) المصدر نفسه، وفي الصفحة ذاتها.
(26) هو الحافظ الشهير أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. ويُكنَّى أبا بكر. تُوُفِّيَ سَنَةَ 292 وله مسندان: كبير وصغير. ويُسَمَّى الكبير "البحر الزخَّار" و"الكبير المُعلَّل". وفيه يتكلّم في تفرد بعض رُواة الحديث ومتابعة غيره عليه، كما رأينا في تفرَّد عمر بحديث النيّة. وانظر " الرسالة المستطرفة ": ص 51.
(27) ذكره السيوطي في " التدريب ": ص 83، غير أنَّ ابا القاسم بن منده يرى أنَّ حديث النيّة رواه سبعة عشر آخر من الصحابة (راجع أسماءهم في " التدريب ": ص 82) فعمر - في نظره - لم ينفرد به، ثم يرى أنّه رواه عن عمر غير علقمة وعن علقمة غير محمد، وغن محمد غير يحيى (أَيْضًا " التدريب ": ص 82).
وحسبنا الحافظ العراقي يرد مثل هذا الرأي ويُنَبِّهُ على أنَّ من سمّى من الصحابة لم يرووا ذلك الحديث بعينه، بل رَوَوْا حَدِيثًا آخر يصحّ إيراده في ذلك الباب. ولم يصح حديث النيّة من طريق عن عمر إلّا الطريق المتقدّمة. ذكره السيوطي في "التدريب": ص 83. ويحسن قراءة كلّ ما يتعلق بهذا الحديث في ص 82 - 83 في "التدريب".
(28) " التقريب ": ص 193.
(29) وعبارة «حَدَّثَ النَّاسَ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ» مألوفة في كتب التاريخ والتراجم. ومثالاً عليها اقرأ ما في " تاريخ بغداد ": 13/ 118 في ترجمة مكي بن إبراهيم البلخي (- 215 هـ).
(30) ومن أطرف ما نذكره - في هذا المجال - أنَّ المستشرق ابن الورد Ahlward استقصى في بعض مباحثه سبعين مسألة فقهية استنبطها الإمام الشافعي من حديث النيّة. وانظر: Ahlwardt,II, 165.no. 162 وقد وفّق في هذا البحث؛ لأنّه جمع واستقصاء لما ورد عن الإمام الشافعي من غير مناقشة. ولو بدأ يناقش لوقع فيما يقع فيه إخوانه المستشرقين من الخطأ والزلل.
(31) راجع قوله في " الجامع لأخلاق الراوي ": 9/ 164 وجه 1.
(32) وتجد في " الكفاية للخطيب البغدادي ": ص 152 باباً خاصاً في ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث.
(33) هو الحافظ شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني الفارقي الأصل الذهبي، من أشطر كتبه " ميزان الاعتدال " و " تذكرة الحفاظ " تُوُفِّيَ سَنَةَ 748.
(34) " تذكرة الحفاظ ": 1/ 238.
(35) " تذكرة الحفاظ ": 1/ 239.
(36) " تذكرة الحفاظ ": 1/ 238.
(37) " الكفاية ": ص 152.
(38) المصدر نفسه، والصفحة ذاتها.
(39) " طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 106 (بتحقيق أحمد عبيد، مطبعة الاعتدال بدمشق، سنة 1350 هـ).
(40) هو الحافظ الحُجَّة أبو مسعود الرازي مُحَدِّثُ أصبهان وصاحب التصانيف. تُوُفِّيَ سَنَةَ 258 هـ.
(41) " تذكرة الحفاظ ": 2/ 544.
(42) وقد عرفنا ذلك من قول الإمام البخاري نفسه: «كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ نَفَرٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَزِيَادَةٍ» ثم يُؤَكِّدُ أنّه لم يكتب إلّا عمَّنْ قال: «الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ». انظر حوادث سَنَةَ 256 في "شذرات الذهب": 2/ 134 وانظر " تذكرة الحفاظ ": 2/ 555. وسماعات البخاري من البلدان المختلفة.
(43) "تذكرة الحفاظ": 3/ 1032. وفيها ترجمته.
(44) "تذكرة الحفاظ": 3/ 1032.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













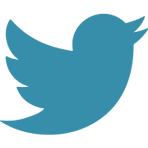

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)