


 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-5-2017
التاريخ: 12-5-2017
التاريخ: 12-5-2017
التاريخ: 12-5-2017
|
قال تعالى : { وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجاثية: 32 - 37].
{وإذا قيل إن وعد الله حق} أي إن ما وعد الله به من الثواب والعقاب كائن لا محالة {والساعة لا ريب فيها} أي وأن القيامة لا شك في حصولها.
{قلتم} معاشر الكفار {ما ندري ما الساعة} وأنكرتموها {إن نظن إلا ظنا} ونشك فيه {وما نحن بمستيقنين} في ذلك {وبدا لهم سيئات ما عملوا} أي ظهر لهم جزاء معاصيهم التي عملوها {وحاق بهم ما كانوا به يستهزءؤن} أي جزاء استهزائهم {وقيل اليوم ننساكم} أي نترككم في العقاب {كما نسيتم لقاء يومكم هذا} أي تركتم التأهب للقاء يومكم هذا عن ابن عباس وقيل معناه نحلكم في العذاب محل المنسي كما أحللتم هذا اليوم عندكم محل المنسي {ومأواكم النار} أي مستقركم جهنم {وما لكم من ناصرين} يدفعون عنكم عذاب الله {ذلكم} الذي فعلنا بكم {بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا} أي سخرية تسخرون منها {وغرتكم الحياة الدنيا} أي خدعتكم بزينتها فاغتررتم بها.
{فاليوم لا يخرجون منها} أي من النار وقرأ أهل الكوفة غير عاصم يخرجون بفتح الياء كما في قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها {ولا هم يستعتبون} أي لا يطلب منهم العتبي والاعتذار لأن التكليف قد زال وقيل معناه لا يقبل منهم العتبي ثم ذكر سبحانه عظمته فقال {فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين} أي الشكر التام والمدحة التي لا يوازيها مدحة لله الذي خلق السماوات والأرض ودبرهما وخلق العالمين {وله الكبرياء} أي السلطان القاهر والعظمة القاهرة والعلو والرفعة {في السماوات والأرض} لا يستحقهما أحد سواه وفي الحديث يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في جهنم {وهو العزيز} في جلاله {الحكيم} في أفعاله وقيل العزيز في انتقاله من الكفار والحكيم فيما يفعله بالمؤمنين والأخيار .
_________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج9،ص134-135.
{ وإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ والسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ }. ما زال الحديث عن المجرمين ، وقوله تعالى : {والسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها} بيان وتفسير لوعد اللَّه ، والمعنى ان المجرمين كانوا إذا قال لهم المؤمنون : ان البعث لحق ، والحساب والجزاء حق قالوا :
لسنا على يقين من البعث ، ولا نعرف عنه شيئا سوى الظن ، فأتونا بما يدل عليه .
وتسأل : ان اللَّه سبحانه حكى عنهم في الآية 24 من هذه السورة انهم نفوا البعث بلسان الجزم كما يدل قولهم : {ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا} ثم حكى عنهم هنا انهم يظنون ظنا وما هم بمستيقنين أي انهم لا يجزمون في أمر البعث سلبا ولا إيجابا ، فكيف تجمع بين الآيتين ؟ .
قال الرازي : يغلب على الظن انهم كانوا فريقين : فريقا كان جازما بنفي البعث ، وآخر كان شاكا فيه . . أما نحن فيغلب على ظننا انهم فريق واحد ، وان معنى الآيتين واحد أيضا ، وهوانهم لا يؤمنون بالبعث لأنه لا دليل بزعمهم يوجب اليقين به ، وانما هو غيب في غيب .
{وبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ }. زرعوا في الدنيا الجرائم والآثام ، فحصدوها وجنوا ثمارها في الآخرة ، وسخروا من جهنم وعذابها فكانوا لها حطبا{ وقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا ومَأْواكُمُ النَّارُ وما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ } جحدوا يوم القيامة وسخروا منه وممن آمن به ، فأمهلهم اللَّه في ذلك ولم يشملهم برحمته ، بل أذاقهم عذاب ذاك اليوم ، وأراهم سبحانه من قدرته وسطوته فيه ما كانوا به يمترون . وتقدم مثله في الآية 51 من سورة الأعراف ج 3 ص 336 .
{ ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا} . ذلكم إشارة إلى العذاب ، والمعنى ان السبب الموجب لعذابهم هو كفرهم باليوم الآخر ، وإعراضهم عن القرآن ، واستخفافهم بآياته حين يتلى عليهم ، واطمئنانهم إلى الدنيا وزينتها{ فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ } . ضمير منها يعود إلى النار ، والمعنى انهم خالدون فيها ، ولا يطلب منهم أن يسترضوا اللَّه بقول أو فعل ، لأن الآخرة دار حساب وجزاء لا دار عمل واسترضاء .
{ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ ورَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ } . احمدوا اللَّه وحده لأنه خالق كل شيء { ولَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ والأَرْضِ } . والمراد بكبريائه تعالى انه لا كبير يخاف ويرجى إلا هو وحده ، وقد وصف الإمام علي ( عليه السلام ) العارفين باللَّه ، وصفهم بقوله : عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ( وهُو الْعَزِيزُ ) الذي لا يقهره شيء { الْحَكِيمُ } في تدبير خلقه .
_____________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7،ص32-33.
قوله تعالى: {وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة} إلخ، المراد بالوعد الموعود وهوما وعده الله بلسان رسله من البعث والجزاء فيكون قوله: {والساعة لا ريب فيها} من عطف التفسير، ويمكن أن يراد بالوعد المعنى المصدري.
وقولهم: {ما ندري ما الساعة} معناه أنه غير مفهوم لهم والحال أنهم أهل فهم ودراية فهو كناية عن كونه أمرا غير معقول ولوكان معقولا لدروه.
وقوله: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} أي ليست مما نقطع به ونجزم بل نظن ظنا لا يسعنا أن نعتمد عليه، ففي قولهم: {ما ندري ما الساعة} إلخ، غب ما تليت عليهم من الآيات البينة أفحش المكابرة مع الحق.
قوله تعالى: {وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون} إضافة السيئات إلى ما عملوا بيانية أو بمعنى من، والمراد بما عملوا جنس ما عملوا أي ظهر لهم أعمالهم السيئة أو السيئات من أعمالهم فالآية في معنى قوله: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} [آل عمران: 30].
فالآية من الآيات الدالة على تمثل الأعمال، وقيل: إن في الكلام حذفا والتقدير: وبدا لهم جزاء سيئات ما عملوا.
وقوله: {وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون} أي وحل بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا إذا أنذروا به بلسان الأنبياء والرسل.
قوله تعالى: {وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين} النسيان كناية عن الإعراض والترك فنسيانه تعالى لهم يوم القيامة إعراضه عنهم وتركه لهم في شدائده وأهواله، ونسيانهم لقاء يومهم ذاك في الدنيا إعراضهم عن تذكره وتركهم التأهب للقائه، والباقي ظاهر.
قوله تعالى: {ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا} إلخ، الإشارة بقوله: {ذلكم} إلى ما ذكر من عقابهم من ظهور السيئات وحلول العذاب والهزء السخرية التي يستهزأ بها والباء للسببية.
والمعنى: ذلكم العذاب الذي يحل بكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله سخرية تستهزءون بها وبسبب أنكم غرتكم الحياة الدنيا فأخلدتم إليها وتعلقتم بها.
وقوله: {فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون} صرف الخطاب عنهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويتضمن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم من العذاب يومئذ وهو الخلود في النار وعدم قبول العذر منهم.
والاستعتاب طلب العتبى والاعتذار، ونفي الاستعتاب كناية عن عدم قبول العذر.
قوله تعالى: {فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين} تحميد له تعالى بالتفريع على ما تقدم في السورة من كونه خالق السماوات والأرض وما بينهما والمدبر لأمر الجميع ومن بديع تدبيره خلق الجميع بالحق المستتبع ليوم الرجوع إليه والجزاء بالأعمال وهو المستدعي لجعل الشرائع التي تسوق إلى السعادة والثواب ويتعقبه الجمع ليوم الجمع ثم الجزاء واستقرار الجميع على الرحمة والعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه فلم يدبر إلا تدبيرا جميلا ولم يفعل إلا فعلا محمودا فله الحمد كله.
وقد كرر {الرب} فقال: رب السماوات ورب الأرض ثم أبدل منهما قوله: {رب العالمين} ليأتي بالتصريح بشمول الربوبية للجميع فلوجيء برب العالمين واكتفي به أمكن أن يتوهم أنه رب المجموع لكن للسماوات خاصة رب آخر وللأرض وحدها رب آخر كما ربما قال بمثله الوثنية، وكذا لو اكتفي بالسماوات والأرض لم يكن صريحا في ربوبيته لغيرهما، وكذا لو اكتفي بإحداهما.
قوله تعالى: {وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم} الكبرياء على ما عن الراغب: الترفع عن الانقياد، وعن ابن الأثير: العظمة والملك وفي المجمع، السلطان القاهر والعظمة القاهرة والعظمة والرفعة.
وهي على أي حال أبلغ معنى من الكبر وتستعمل في العظمة غير الحسية ومرجعه إلى كمال وجوده ولا تناهي كماله.
وقوله: {وله الكبرياء في السماوات والأرض} أي له الكبرياء في كل مكان فلا يتعالى عليه شيء فيهما ولا يستصغره شيء وتقديم الخبر في {له الكبرياء} يفيد الحصر كما في قوله: {فلله الحمد}.
وقوله: {وهو العزيز الحكيم} أي الغالب غير المغلوب فيما يريد من خلق وتدبير في الدنيا والآخرة والباني خلقه وتدبيره على الحكمة والإتقان.
___________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج18، ص148-150.
يوم تبدو السيئات:
الآية الأولى من هذه الآيات توضيح لما ذكر في الآيات السابقة بصورة مجملة، توضيح لمسألة استكبار الكافرين على آيات الله ودعوة الأنبياء، فتقول: {وإذا قيل إنّ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إنّ نظن إلاّ ظناً وما نحن بمستيقنين}.
التعبير بـ {ما ندري ما الساعة} في حين أنّ معنى القيامة لم يكن غامضاً عليهم أو مبهماً، وإن كان شك كلّ لديهم ففي وجودها، ممّا يوحي بأنّهم كانوا في موضع تكبر وعدم اهتمام، ولو كانت لدى هؤلاء روح تتبع الحق وطلبه لرأوا أنّ ماهية يوم القيامة أمر واضح، كما أنّ الدليل عليها بيّن جلي. ومن هنا يتّضح الجواب عن سؤال طرح هنا، وهو: أنّ هؤلاء إنّ كانوا ـ حقاً ـ في شكّ الأمر، فلا تثريب عليهم ولا إثم؟ لكن الشك لم يكن ناشئاً من عدم وضوح الحق، بل ناتج عن الكبر والغرور والعناد التعصب.
ويحتمل أيضاً أن يكون هدفهم من تهافت كلامهم وتناقضه السخرية والإستهزاء.
وتتحدث الآية التالية عن جزاء هؤلاء وعقابهم، ذلك الجزاء الذي لا يشبه عقوبات المحاكم الدنيوية، فتقول: {وبد لهم سيئات ما عملوا} فستتجسد القبائح والسيئات أمام أعينهم، وتتّضح لهم، وتكون لهم قريناً دائماً يتأذون من وجوده إلى جانبهم ويتعذبون من صحبته: {وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون}(2).
والأشد ألماً من كلّ ذلك هو الخطاب الذي يخاطبهم به الله الرحمن الرحيم، فيقول سبحانه: {وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا}.
لقد ورد هذا التعبير بصيغ مختلفة في القرآن الكريم مراراً، ففي الآية (51) من سورة الأعراف: {فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا} [الأعراف: 51].
وجاء هذا المعنى أيضاً بأُسلوب آخر في الآية (14) من سورة ألم السجدة.
لاشك أنّ النسيان لا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه الذي يحيط علمه بكلّ عالم الوجود، لكنّه هنا كناية لطيفة عن احتقار الإنسان المجرم العاصي وعدم الإهتمام به، ويلاحظ هذا التعبير حتى في محادثاتنا اليومية، فنقول: انسَ فلاناً الذي لا وفاء له، أي عامله كإنسان منسي، ولا تمنحه المحبة والعطف والوداد، واترك تفقد أحواله، ولا تذهب إليه أبداً.
ثمّ إنّ هذا التعبير تأكيد آخر ـ بصورة ضمنية ـ على مسألة تجسم الأعمال، وتناسب الجريمة والعقاب، لأنّ نسيانهم يوم القيامة في الدنيا يؤدي إلى أن ينساهم الله يوم القيامة، وما أعظم مصيبة نسيان الله الرحمن الرحيم لفرد من الأفراد، وحرمانه من جميع ألطافه ومننه.
وذكر المفسّرون هنا تفاسير مختلفة للنسيان تتلخص جميعاً في المعنى المذكور أعلاه، ولذلك لا نرى حاجة لتكرارها.
ثمّ إنّ المراد من نسيان لقاء يوم القيامة، نسيان لقاء كلّ المسائل والحوادث التي تقع في ذلك اليوم، سواء الحساب أم غيره، حيث كانوا ينكرونها.
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد نسيان لقاء الله سبحانه في ذلك اليوم، لأنّ يوم القيامة قد وصف في القرآن المجيد بيوم لقاء الله، والمراد منه الشهود الباطني.
وتتابع الآية الحديث، فتقول: (ومأواكم النّار) وإذا كنتم تظنون أنّ أحداً سيهب لنصرتكم وغوثكم، فاقطعوا الأمل من ذلك، واعلموا أنّه (وما لكم من ناصرين).
أمّا لماذا ابتليتم بمثل هذا المصير؟ فـ(ذلكم بأنّكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا).
وأساساً فإنّ «الغرور» و «الإستهزاء» لا ينفصلان عن بعضهما عادة، فإنّ الأفراد المغرورين والمتكبرين الذين ينظرون إلى الآخرين بعين الإحتقار يتخذونهم هزواً ويسخرون منهم، ومصدر الغرور في الواقع هو متاع الدنيا وقدرتها وثروتها الزائلة المؤقتة، والتي تدع الأفراد الضيقي الصدور في غفلة تامة لا يعيرون معها لدعوة رسل الله أدنى اهتمام، ولا يكلفون أنفسهم حتى النظر فيها للوقوف على صوابها من عدمه.
وتكرر الآية ما ورد في الآية السابقة وتؤكّده بأُسلوب آخر، فتقول: {فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون}(3)، فقد كان الكلام هناك عن مأواهم ومقرهم الثابت، والكلام هنا عن عدم خروجهم من النّار.. حيث قال هناك: ما لهم من ناصرين، وهنا يقول: لا يقبل منهم عذر، والنتيجة هي أنّ لا سبيل لنجاتهم.
وفي نهاية هذه السورة، ولإكمال بحث التوحيد والمعاد، والذي كان يشكل أكثر مباحث هذه السورة، تبيّن الآيتان الأخيرتان وحدة ربوبية الله وعظمته، وقدرته وحكمته، وتذكر خمس صفات من صفات الله سبحانه في هذا الجانب، فتقول أولاً: {فلله الحمد} لأنّه {ربّ السماوات وربّ الأرض ربّ العالمين}.
«الرّب» بمعنى المالك والمدبر، والحاكم والمصلح، وبناء على هذا فكلّ خير وبركة تأتي منه سبحانه ولذلك، ترجع إليه كلّ المحامد والثناء، فحتى الثناء على الورد، وصفاء العيون، وعذوبة النسيم، وجمال النجوم، حمد له وثناء عليه، فإنّها جميعاً تصدر عنه، وتنمو بفضله ورعايته.
والطريف أنّه يقول مرّة: ربّ السماوات، وأُخرى: ربّ الأرض، وثالثة: ربّ عالم الوجود والعالمين، ليفند الإعتقاد بالآلهة المتعددة التي جعلوها للموجودات المختلفة، ويدعو الجميع إلى توحيد الله سبحانه والإعتقاد بأحديته.
وبعد وصف ذاته المقدسة بمقام الحمد والربوبية، تضيف الآية في الصفة الثالثة: {وله الكبرياء في السماوات والأرض} لأنّ آثار عظمته ظاهرة في السماء المترامية الأطراف، والأرض الواسعة الفضاء، وفي كلّ زاوية من زوايا العالم.
لقد كان الكلام في الآية السابقة عن مقام الربوبية، أي كونه تعالى مالكاً لأُمور عالم الوجود ومدبراً لها، والكلام هنا عن عظمته، فكلما دققنا النظر في خلق السماء والأرض وتأملناه، سنزداد معرفة بهذه الحقيقة، وتزداد بصيرتنا بها.
وأخيراً تقول الآية في الوصفين الرابع والخامس: (وهو العزيز الحكيم) وبذلك تكمل مجموعة العلم والقدرة والعظمة والربوبية والمحمودية، والتي هي مجموعة من أهم صفات الله، وأسمائه الحسنى.
___________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي، ج12، ص526-529.
2 ـ «حاق» من مادة (حوق)، وهي في الأصل بمعنى الورود، والنّزول، والإصابة، والإحاطة. وقال البعض: إنّ أصلها (حق) ـ بمعنى التحقيق ـ فأبدلت القاف الأولى إلى واو، ثمّ إلى ألف.
3 ـ أعطينا التوضيح اللازم حول معنى (يستعتبون) وأصلها في ذيل الآية (57) من سورة الروم.

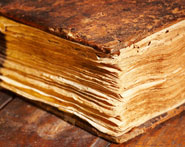
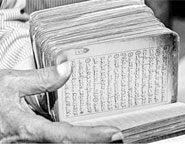
|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|