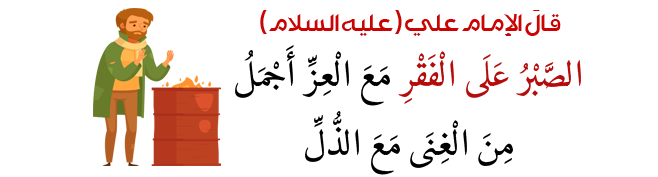
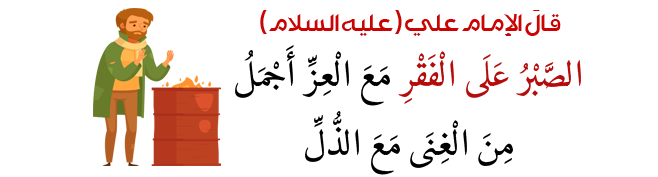

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-5-2020
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 1-8-2016
التاريخ: 23-8-2016
|
قد يكون المستصحب من الاُمور الثابتة القارّة وقد يكون من الاُمور التدريجيّة غير القارّة كالحركة والزمان، فهل يختصّ الاستصحاب بالقسم الأوّل، أو يجري في القسم الثاني أيضاً؟
فلابدّ لتفصيل الكلام فيه من البحث في مقامات ثلاث:
الأوّل: في الاستصحاب في نفس الزمان كاليوم والليل.
الثاني: في الاستصحاب في التدريجيّات المشابهة للزمان، أي ما تكون طبيعتها سيّالة كالحركة في المكان أو سيلان الدم والتكلّم وقراءة القرآن وسيلان الماء من العيون.
الثالث: في الاستصحاب في الاُمور الثابتة المقيّد بالزمان كزيد في يوم كذا فيما إذا صار زيد موضوعاً لحكم من الأحكام مقيّداً بالزمان.
أمّا المقام الأوّل: فاستشكل في جريان الاستصحاب فيه باُمور ثلاثة:
أوّلها: أنّه يعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء، والبقاء معناه وجود الشيء في الزمان ثانياً، وهو لا يتصوّر لنفس الزمان، وإلاّ يستلزم أن يكون للزمان زمان آخر، وهكذا ... فيتسلسل.
ثانيها: الإشكال بتبدّل الموضوع، لأنّ الساعة المتيقّنة غير الساعة المشكوكة، مع أنّ المعتبر في حجّية الاستصحاب بقاء الموضوع، أي وحدة القضية والمشكوكة.
ثالثها: رجوعه إلى الأصل المثبت غالباً، لأنّ المراد من استصحاب النهار مثلا إمّا إثبات وقوع الإمساك في النهار، وهو لازم عقلي لبقاء النهار، أو إثبات أنّ الصّلاة وقعت أداءً، وهو أيضاً لازم عقلي له.
وقبل الورود في الجواب عن هذه الإشكالات لا بأس بالإشارة إجمالا إلى حقيقة الزمان، فقد دارت حوله أبحاث كثيرة ضخمة، وصدرت من الأعلام في هذا المجال مطالب معقّدة، مع أنّه بإجماله من الضروريات البديهيات.
وكيف كان، فإنّ عمدة الآراء فيه ثلاثة:
1 ـ أنّه بُعد موهوم يتوهّم الإنسان بوقوع الأشياء فيه.
2 ـ أنّه ظرف خاصّ كالمكان، وله بعد حقيقي في الخارج، وهو مخلوق قبل الأشياء الزمانيّة.
3 ـ ما هو مختار الفلاسفة المتأخّرين (وهو الحقّ) من أنّ الزمان ليس إلاّ مقدار الحركة في العرض أو الجوهر، فلولا الحركة لما كان هناك زمان، فهى في الحقيقة مخلوقة بعد خلق الأشياء المادّية لا قبلها، وهكذا المكان فإنّه أيضاً ينتزع بعد خلق الأشياء المادّية ونسبة بعضها إلى بعض كما ذكر في محلّه.
إذا عرفت هذا فلنرد في الجواب عن الإشكالات الثلاثة المذكورة فنقول:
أمّا الإشكال الأوّل ففيه: أنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب إنّما هو اعتبار وجود يقين سابق وشكّ لاحق في شيء واحد، ولا دليل على اعتبار عنوان البقاء فيه.
وأمّا الإشكال الثاني فالجواب عنه:
أوّلا: أنّ المعتبر وجود الوحدة بنظر العرف لا بالدقّة العقليّة، والوحدة العرفيّة موجودة في الزمان بلا ريب.
وثانياً: أنّ الوحدة موجودة فيه حتّى بالدقّة العقليّة، ودليلها وجود الإتّصال الحقيقي بين أجزاء الزمان، وإلاّ يلزم الاجزاء غير المتناهية في المتناهي (بين الحاضرين) بعد عدم صحّة الجزء الذي لا يتجزّى، فالموجود في الخارج في الاُمور المتّصلة ليس إلاّ شيئاً واحداً، وإنّما التجزئة في الذهن.
ثالثاً: أنّه يمكن أن يستصحب عدم حصول المنتهى، فيستصحب مثلا عدم حصول آن الغروب أو آن الطلوع.
نعم أنّه يجري فيما إذا ترتّب في الشرع أثر على آن الغروب أو الطلوع، وإلاّ يكون الأصل مثبتاً كما لا يخفى.
أمّا الإشكال الثالث: فاُجيب عنه: باُمور لا تخلو عن مناقشة، ونشير إلى بعضها:
1 ـ أنّه يمكن استصحاب نفس الحكم وهو وجوب الصيام مثلا، ومعه لا حاجة إلى استصحاب الموضوع حتّى يكون مثبتاً.
وفيه أوّلا: أنّ هذا تسليم للإشكال.
وثانياً: أنّ الاستصحاب الحكمي هنا لا يفيد، لأنّ المطلوب في المثال إنّما هو إثبات وجوب صيام شهر رمضان مثلا لا مطلق الصيام، وإثبات وجوب صيام شهر رمضان يحتاج إلى استصحاب الموضوع فيعود الإشكال.
2 ـ ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) في بعض الأبحاث القادمة بقوله «الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآن كما كان».
ولا يخفى أنّ قوله هذا يرجع إلى استصحاب الموضوع لأنّ المستصحب فيه إتّصاف هذا الصيام بأنّه كان في رمضان قبل هذا الآن.
ويرد عليه أيضاً: أنّ هذا الجواب على فرض تماميته إنّما يتمّ في الصيام فقط، لأنّه في مثل الصّلاة يكون استصحاباً تعليقياً بهذا النحو: لو كنت أُصلّي الظهر سابقاً كانت صلاتي واقعة في النهار والآن كما كان، والاستصحاب التعليقي في مثل هذه الموارد ليس بحجّة (لو سلّمت حجّيته في غيرها) لأنّ التعليق هنا تعليق عقلي، والتعليق الملحوظ في الاستصحاب التعليقي إنّما هو التعليق الشرعي كما في قولنا: «العصير إذا غلى ينجّس».
3 ـ أنّه يمكن أن يجعل المستصحب ما لا يكون تدريجياً وهو آن الغروب، لأنّ المستفاد من قوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ثمّ أنت في وقت حتّى تغرب الشمس» إنّ الواجب مركّب من جزئين: وقوع الصّلاة الذي هو ثابت بالوجدان، وعدم الغروب الذي يثبت بالاستصحاب.
ويرد عليه أيضاً: أنّ هذا جمود على ظاهر الدليل، لأنّ المستظهر من مجموع أدلّة الأوقات أنّ للصلاة أو الصيام وقتاً محدّداً، وأنّ الواجب وقوعهما في وقت من الأوقات كالنهار وشهر رمضان، وهذا يعني أنّ الواجب وقوع الصّلاة في النهار أو وقوع الصيام في شهر رمضان لا مجرّد عدم الغرب أو عدم طلوع هلال الشوّال.
فقد ظهر أنّ كلّ واحد من هذه الأجوبة غير تامّ.
والحقّ في الجواب أن يقال: إنّ الواسطة في ما نحن فيه خفيّة فلا يكون الأصل مثبتاً وإلاّ فليكن الاستصحاب مثبتاً حتّى في مورد أدلّة الاستصحاب لأنّ ما هو معتبر في الصّلاة إنّما هو تقيّد أفعالها بالوضوء، لمكان معنى الشرط، وهو من اللوازم العقليّة لاستصحاب بقاء الوضوء كما لا يخفى، مع أنّ جواز هذا الاستصحاب مصرّح به في نفس الصحيحة المعتبرة الدالّة على حجّية الاستصحاب.
أضف إلى ذلك أنّ من روايات الباب رواية علي بن محمّد القاساني المذكور سابقاً (صم للرؤية وافطر للرؤية) ولا إشكال في أنّ المستصحب في موردها هو الزمان.
بقي هنا شيء:
وهو أنّ الشكّ في الزمان قد يكون من قبيل الشبهة المصداقيّة كما إذا شككنا في أنّ غروب الشمس تحقّق أم لا؟ أو شككنا في تحقّق طلوع الفجر أو شهر رمضان، وقد يكون من قبيل الشبهة المفهوميّة كما إذا شككنا في مفهوم المغرب وأنّه هل وضع لاستتار القرص أو لذهاب الحمرة؟
لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهة المصداقيّة لتماميّة أركانه فيها، وأمّا الشبهة المفهوميّة فالصحيح عدم جريانه فيها، لأنّ المستظهر من أدلّة الاستصحاب أنّ متعلّق الشكّ إنّما هو الوجود الخارجي للشيء لا مفهمه، وبتعبير آخر، لابدّ أن يكون الشكّ في عمر المستصحب في الخارج والاستصحاب يزيد على عمره شرعاً وتعبّداً، بينما في الشبهات المفهوميّة لا شكّ في الوجود الخارجي، لأنّ الخارج معلوم عندنا فنعلم بأنّ قرص الشمس إستترت والحمرة لم تزل، إنّما الشكّ في المراد من لفظ المغرب الوارد في الأحاديث.
نعم، يمكن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى وضع اللفظ، بأن يقال: إنّ الشارع أو العرف لم يضع لفظ المغرب سابقاً في استتار القرص، والآن شككنا في وضعه، فيجري استصحاب عدم وضعه للإستتار.
ولكن فيه أوّلا: إنّه معارض باستصحاب عدم وضعه لذهاب الحمرة.
وثانياً: إنّه مثبت، لأنّ المقصود منه إثبات وضع اللفظ لذهاب الحمرة أوّلا ثمّ إثبات ظهور اللفظ فيه عند فقدان القرينة لأصالة الحقيقة، ولا يخفى أنّ الواسطة فيه عقلية جلية توجب كون الاستصحاب مثبتاً.
هذا كلّه في المقام الأوّل أي الاستصحاب في نفس الزمان.
أمّا المقام الثاني ـ أي جريان الاستصحاب في غير الزمان من التدريجيات ـ فإنّ الاُمور التدريجية غير الزمان على أقسام:
منها: ما لا يدركه العرف بل لا يعرفه إلاّ العلماء والفلاسفة، وهو تدريجية تمام الموجودات لأنّ وجودها يترشّح من المبدأ الفيّاض آناً فآن، سواء كانت له حركة جوهرية كما في الماديات، أو لم تكن كما في المجرّدات.
ومنها: ما يكون العرف غافلا عنه ولكن يدركه عند الدقّة كالحركة الموجودة في السراج، سواء كان سراجاً كهربائياً أو دهنياً.
ومنها: ما يكون ظاهراً ومحسوساً عند العرف كجريان الماء وسيلان دم الحيض ونبع ماء العين وحركة الإنسان من مبدأ إلى منتهى.
ومنها: ما يكون في الواقع من الموضوعات المقطّعة، ولكن تكون لها وحدة اعتبارية كالقراءة والتكلّم.
فهذه أقسام أربعة للأمور التدريجية غير الزمان.
أمّا القسم الأوّل: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه لو كان له أثر شرعي، وهكذا القسم الثاني والثالث، لأنّ شرطيّة وحدة الموضوع حاصلة في كلّ واحد منها، والدليل عليها وجود الإتّصال فيها.
إنّما الكلام في القسم الرابع فهل يجري فيه الاستصحاب مطلقاً (لأنّ الوحدة العرفيّة موجودة فيه أيضاً ولو كانت اعتبارية) كما ذهب إليه جمع كثير من المحقّقين، أو لا يجري مطلقاً، لأنّ وحدتها تكون بالتسامح العرفي ولا اعتبار بالمسامحات العرفيّة، أو فيه تفصيل بين ما إذا اتّحد الداعي فلا يجري، كما إذا كان زيد مريداً للذهاب من النجف إلى بغداد من أوّل الأمر، وما إذا تعدّدت الدواعي فيجري، كما إذا كان زيد مريداً للذهاب من النجف إلى كربلاء وشككنا في حصول داع جديد له للذهاب من كربلاء إلى بغداد، وكما إذا لم نعلم أنّه هل كان مريداً من أوّل الأمر للذهاب من النجف إلى بغداد، أو كان مريداً من أوّل الأمر للذهاب إلى كربلاء ثمّ تجدّد الداعي له إلى بغداد، وهذا ما ذهب إليه المحقّق النائيني(رحمه الله) فيما حكى عنه في تقريرات بعض الأكابر من تلامذته (1)، ففيه وجوه بل أقوال ثلاثة، الحقّ والصحيح منها هو القول الأوّل.
أمّا القول الثاني فيرد عليه: أنّ الوحدة في القسم الرابع كالقراءة والتكلّم حاصلة حتّى عند العرف الدقّي، وليست الوحدة فيه من المسامحات العرفيّة.
وأمّا القول الثالث: فيرد عليه أيضاً: أنّ مجرّد تعدّد الداعي لا يكون موجباً للتعدّد في الفعل، لأنّ الحافظ للوحدة ليس هو الداعي بل هو الإتّصال.
هذا كلّه في المقام الثاني.
أمّا المقام الثالث: ـ أي الاُمور الثابتة المقيّدة بالزمان في لسان الدليل كالإمساك المقيّد بالنهار أو الجلوس المقيّد بيوم الجمعة وكالصلاة المقيّدة بإتيانها في داخل الوقت ـ فهل يجري استصحاب بقاء وجوب الصّلاة مثلا بعد انقضاء الزمان المقيّد به فعل الصّلاة أو لا يجري؟ فيه وجهان بل قولان:
ذهب كثير من الأعاظم إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا المقام، وذلك لتبدّل الموضوع، لأنّ المفروض أنّ الزمان كان مقوّماً له عرفاً، نعم إذا لم يكن الزمان مقوّماً للموضوع عند العرف كما في مثل خيار الغبن وخيار العيب كان الاستصحاب فيه جارياً، فإذا شككنا في أنّ خيار الغبن مثلا كان فوريّاً فانقضى زمانه أو لم يكن فورياً فلم ينقض زمانه كان استصحاب بقاء الخيار جارياً بلا إشكال (بناءً على جريانه في الشبهات الحكميّة) لكنّه ليس حينئذ من الاُمور الثابتة المقيّدة بالزمان لأنّ الزمان ليس قيداً فيه.
وإن شئت قلت: إذا كان الزمان قيداً في الواجب فلا يجري الاستصحاب لتبدّل الموضوع، ولذلك يقال بأنّ القضاء يكون بأمر جديد، وإذا لم يكن الزمان قيداً في الواجب بل كان ظرفاً له كما في مثل الخيار فيكون الاستصحاب جارياً، ولكن المستصحب حينئذ ليس زمانياً فليس داخلا في محلّ النزاع.
إن قلت: إنّ الزمان وإن أخذ في لسان الدليل ظرفاً للحكم ولكنّه ممّا له دخل في أصل المناط قطعاً، لأنّ المفروض أنّ وجود الفعل زماني فالزمان مقوّم لوجوده فيكون مؤثّراً في المناط بالواسطة.
واُجيب عنه بما حاصله: أنّ الزمان وإن كان لا محالة من قيود الموضوع ولكنّه ليس من القيود المقوّمة له بنظر العرف على وجه إذا تخلّف لم يصدق عرفاً بقاء الموضوع بل من الحالات المتبادلة له، والمعتبر في الاستصحاب هو بقاء الموضوع في نظر العرف لا في نظر العقل.
بقي هنا شيء:
وهو كلام حكاه الشيخ الأعظم هنا عن المحقّق النراقي وتبعه غيره مع أنّه ليس مرتبطاً بالمقام، بل هو تفصيل في حجّية الاستصحاب بين الشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّة فذهب المحقّق النراقي(رحمه الله) إلى جريان الاستصحاب في الاُولى دون الثانية، لمعارضته دائماً باستصحاب عدم الجعل، وقد تكلّمنا عن هذا تفصيلا فيما سبق، وأجبنا عن إشكال المعارضة باُمور عديدة، ومنها: أنّ الاستصحابين ليسا في عرض واحد بل أحدهما وهو استصحاب وجود الحكم حاكم أو وارد على الآخر وهو استصحاب عدم الجعل، فإنّ استصحاب بقاء الحكم بنفسه حكم ظاهري يوجب زوال الشكّ الذي هو مأخوذ في موضوع استصحاب عدم الجعل.
والعجب من المحقّق الخراساني(رحمه الله) حيث ناقش في مثال خروج المذي بعد الوضوء الذي ذكره المحقّق النراقي(رحمه الله) مثالا للمسألة، وقال: أنّ مقتضى الاستصحاب الوجودي هو بقاء الوضوء، وهو يعارض مع مقتضى الاستصحاب العدمي، وهو عدم جعل الشارع الوضوء رافعاً للحدث لما بعد خروج المذي، فناقش فيه المحقّق الخراساني(رحمه الله) بأنّ رافعية الوضوء للحدث ليست محدودة بحدّ زماني، بل هى كسائر الأحكام التي تجعل من جانب الشارع كالملكية باقية إلى الأبد حتّى يثبت ما يكون ناقضاً، له كما أنّ الملكية دائمية حتّى يثبت الفسخ.
كما يمكن أن يناقش فيه أيضاً بأنّه قد يكون الاستصحاب العدمي معاضداً وموافقاً للاستصحاب الوجودي كما في هذا المثال، فإنّ مقتضى عدم جعل المذي ناقضاً للوضوء أيضاً بقاء الطهارة بحالها.
ولكنهما مناقشتان في خصوص هذا المثال لا في الحكم على نحو العموم وللمحقّق النراقي(رحمه الله) تبديله بمثال آخر، وهو ما إذا شككنا بعد انقطاع دم الحيض وقبل الغسل في حرمة الوطيء فاستصحاب الحرمة قبل الإنقطاع معارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد الإنقطاع، ولا يجري فيه جواب المحقّق الخراساني ولا المناقشة التي ذكرناها، فالصحيح في الجواب ما ذكرناه من الأجوبة السابقة، ولا حاجة لتكرارها.
_______________
1. راجع مصباح الاُصول: ج3، ص128، طبع مطبعة النجف.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|