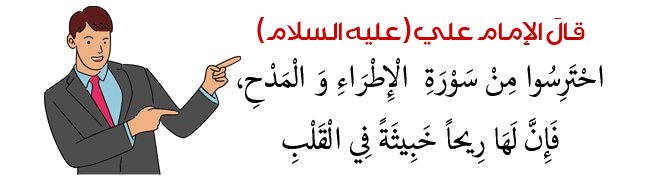
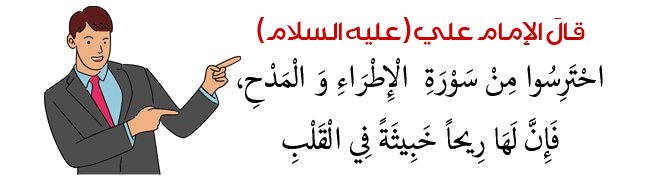

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
التاريخ: 29-8-2016
التاريخ: 8-8-2016
التاريخ: 9-8-2016
|
إنّ المخصّص قد يكون مبيّن المفهوم وقد يكون غير مبيّنة ، وعلى الثاني تارة يكون دائراً بين الأقلّ والأكثر واُخرى بين المتباينين . وعلى جميع التقادير فهو إمّا متّصل أو منفصل . ثمّ إنّه إمّا لبّي أو غير لبّي ، وأيضاً الشبهة إمّا مفهومية أو مصداقية .
فهذه صور المسألة ، ولنقدّم البحث عن المفهومية على البحث عن المصداقية :
التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية:
فنقول : يقع البحث في الشبهة المفهومية في مقامين :
المقام الأوّل : فـي المخصّص المتّصل المجمل مـن حيث المفهوم ، وهـو على قسمين :
الأوّل : ما كان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا شكّ في أنّ الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منها والصغيرة .
فالحقّ : سريان إجماله إلى العامّ ، ولا يكون العامّ المخصّص حجّة في موارد
الشكّ ; لأنّ اتصال المخصّص المجمل يوجب عدم انعقاد ظهوره من أوّل إلقائه إلاّ في العالم غير الفاسق أو العالم العادل ، وليس لكلّ من الموصوف والصفة ظهور مستقلّ حتّى يتشبّث بظهور العامّ في الموارد المشكوكة ، فيشبه المقام بباب المقيّد إذا شكّ في حصول قيده ; أعني العدالة أو عدم الفسق فيمن كان مرتكباً للصغيرة .
وبعبارة ثانية : أنّ الحكم في العامّ الذي استثني منه أو اتّصف بصفة مجملة متعلّق بموضوع وحداني عرفاً ، فكما أنّ الموضوع في قولنا : «أكرم العالم العادل» هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا : «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» ; ولذا لا ينقدح التعارض حتّى التعارض البدوي بين العامّ والمخصّص ، كما ينقدح بينه وبين منفصله .
فحينئذ : كما لا يجوز التمسّك بالعامّ ، كقولنا : «لا تكرم الفسّاق» إذا كان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد ، كذلك لا يجوز في العامّ المتّصف أو المستثنى منه بشيء مجمل بلا فرق بينهما .
الثاني : ما إذا دار مفهومه بين المتباينين مع كونه متّصلاً ، كما إذا استثنى منه زيداً ، واحتمل أن يكون المراد هو زيد بن عمرو وأن يكون هو زيد بن بكر .
والحقّ : سريان إجماله أيضاً بالبيان المتقدّم في الأقلّ والأكثر ; لأنّ الموضوع يصير بعد الاستثناء العالم الذي هو غير زيد ، وهو أمر وحداني لا يكون حجّة إلاّ فيما ينطبق عليه يقيناً ، والمفروض أ نّه مجمل من حيث المفهوم ، فكيف يمكن الاحتجاج بشيء يشكّ في انطباقه على المشكوك ؟
وأمّا المقام الثاني ـ أعني المخصّص المنفصل المجمل من حيث المفهوم ـ فهو أيضاً على قسمين:
الأوّل : ما إذا دار بين الأقلّ والأكثر ، فلا يسري أصلاً ، ويتمسّك به في موارد الشكّ ; لأنّ الخاصّ المجمل ليس بحجّة في موارد الإجمال ، فلا ترفع اليد عن الحجّة بما ليس بحجّة ، ولا يصير العامّ معنوناً بعنوان خاصّ في المنفصلات .
وبعبارة أوضح : أنّ الحكم قد تعلّق بعنوان الكلّ والجميع ، فلا محالة يتعلّق الحكم على الأفراد المتصوّرة إجمالاً ، والأصل العقلائي حاكم على التطابق بين الإرادتين في عامّة الأفراد ، فلا يرفع اليد عن هذا الظهور المنعقد إلاّ بمقدار قامت عليه الحجّة ، والمفروض أنّ الحجّة لم تقم إلاّ على مرتكب الكبائر ، وغيرها مشكوك فيه .
ولا يقاس ذلك بالمتّصل المردّد بين الأقلّ والأكثر ; إذ لم ينعقد للعامّ هناك ظهور قطّ ، إلاّ في المعنون بالعنوان المجمل ، والمرتكب للصغائر مشكوك الدخول في العامّ هناك من أوّل الأمر ، بخلافه هنا ; فإنّ ظهور العامّ يشمله قطعاً .
كيف ، فلو كان المخصّص المجمل حكماً ابتدائياً من دون أن يسبقه العامّ لما كان حجّة إلاّ في مقدار المتيقّن دون المشكوك ، فكيف مع ظهور العامّ في إكرام المشكوك ؟
وأمّا ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ من أ نّه يمكن أن يقال : إنّه بعد ما صارت عادة المتكلّم على ذكر المخصّص منفصلاً فحال المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره(1)، لا يخلو عن نظر ; فإنّ وجوب الفحص عن المخصّص باب ، وسراية إجمال المخصّص إليه باب آخر . ومقتضى ما ذكره عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص ، لا سراية الإجمال ; لأنّ ظهور العامّ لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة ، كما أنّ الأصل العقلائي بتطابق الاستعمال والجدّ حجّة بعد الفحص عن المخصّص وعدم العثور إلاّ على المجمل منه ، لكنّه ـ قدس سره ـ رجع في الدورة الأخيرة عمّا أفاده في متن كتابه(2) .
نعم ، لو كان الخاصّ المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر وارداً بلسان الحكومة على نحو التفسير والشرع ـ كما في بعض أنحاء الحكومات ـ فسراية إجماله وصيرورة العامّ معنوناً غير بعيدة ، كما إذا قال المراد من العلماء هو غير الفسّاق ، أو أنّ الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم . ومع ذلك فالمسألة بعد محلّ إشكال .
القسم الثاني : ما إذا دار المخصّص المنفصل بين المتباينين :
فالحقّ : أنّه يسري الإجمال إليه حكماً ; بمعنى عدم جواز التمسّك به في واحـد منهما ; وإن كان العامّ حجّـة في واحـد معيّن واقعاً ، ولازمـه إعمال قواعـد العلم الإجمالي .
وإن شئت قلت : إنّ العلم الإجمالي بخـروج واحـد منهما يوجب تساوي العامّ في الشمول لكلّ واحد منهما ، ولا يتمسّك به في إثبات واحد منهما إلاّ بمرجّح ، وهو منتف بالفرض .
وبتعبير آخـر : أ نّه بعد الاطّلاع بالمخصّص لا متيقّن في البين حتّى يؤخـذ به ويترك المشكوك، كما في الأقلّ والأكثر ، بل كلاهما في الاحتمال متساويان ، فلا محيص عـن إجراء قواعـد العلم الإجمالي .
فلو كان المخصّص رافعاً لكُلفة الوجـوب عـن مـورد التخصيص وكان مقتضى العامّ هـو الوجـوب فلازمـه إكرام كـلا الرجلين حتّى يستيقن بالبراءة .
ولو كان المخصّص ظاهـراً في حرمـة مورده فيكون المقام مـن قبيل دوران الأمـر بين المحذورين ، ولكلّ حكمه .
التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل اللفظي:
محطّ البحث في الاشتباه المصداقي لأجل الشبهة الخارجية إنّما هو فيما إذا اُحرز كون فرد مصداقاً لعنوان العامّ ; أعني العالم قطعاً ، ولكن شكّ في انطباق عنوان المخصّص ; أعني الفاسق عليه .
وبعبارة اُخـرى : البحث فيما إذا خصّ العامّ ولم يتعنون ظهور العامّ بقيد زائـد سوى نفسه ، لا في تقييد المطلق الـذي يوجب تقييده بقيد زائـد ، سوى ما اُخـذ في لسان الدليل .
وبما ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم ; حيث قال : إنّ تمام الموضوع في العامّ قبل التخصيص هو طبيعة العالم ، وإذا ورد المخصّص يكشف عن أنّ العالم بعض الموضوع وبعضه الآخر هو العادل ، فيكون الموضوع واقعاً هو العالم العادل . فالتمسّك في الشبهة المصداقية للخاصّ يرجع إلى التمسّك فيها لنفس العامّ ، من غير فرق بين القضايا الحقيقية وغيرها(3) .
وجه الخلط : أنّ ما أفاده صحيح في المطلق والمقيّد ، وأ مّا العامّ فالحكم فيه متعلّق بأفراد مدخول أداته ، لا على عنوان الطبيعة ، والمخصّص يخرج طائفة من أفراد العامّ ، كأفراد الفسّاق منهم .
وما ربّما يتكرّر في كلامه من أنّ الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما أ نّه مرآة لما ينطبق(4) عليه غير تامّ ; لأنّ العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات الفردية .
مع أنّ لازم ما ذكره أن يكون الأفراد موضوعاً للحكم ; لأنّ المحكوم عليه هو المرئي دون المرآة ، فلا يصحّ قوله : إنّ تمام الموضوع في العامّ قبل التخصيص هو طبيعة العالم . . . إلى آخره . بل التحقيق كما تقدّم(5) : أنّ العنوان لم يكن مرآة إلاّ لنفس الطبيعة الموضوع لها ، وأداة العموم تفيد أفرادها ، والقضية الحقيقية متعرّضة للأفراد .
فتحصّل : أنّ الكلام إنّما هو في العامّ المخصّص ، لا المطلق المقيّد .
وكيف كان : فقد استدلّ لجواز التمسّك بأنّ العامّ بعمومه شامل لكلّ فرد من الطبيعة وحجّة فيه ، والفرد المشكوك فيه لا يكون الخاصّ حجّة بالنسبة إليه ; للشكّ في فرديته ، فمع القطع بفرديته للعامّ والشكّ في فرديته للخاصّ يكون رفع اليد عن العامّ رفع اليد عن الحجّة بغير حجّة(6) .
والجواب : أنّ مجرّد ظهور اللفظ وجريان أصالة الحقيقة لا يوجب تمامية الاحتجاج ما لم تحرز أصالة الجدّ .
توضيحه : أنّ صحّة الاحتجاج لا تتمّ إلاّ بعد أن يسلّم اُمور : من إحراز ظهوره ، وعدم إجماله مفهوماً ، وعدم قيام قرينة على خلافه ; حتّى يختتم الأمر بإحراز أنّ المراد استعمالاً هو المراد جدّاً . ولذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعابة ; وإن اُحرز ظهوره وجرت أصالة الحقيقة ; لعدم جريان أصالة الجدّ مع أنّ ديدنه على خلافه .
فعليه : ما مرّ مـن أصالـة التطابق بين الإرادتين إنّما هـو فيما إذا شكّ في أصل التخصيص ، وأنّ هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان آخر هل خـرج عن حكم العامّ أو لا ؟ وأمّا إذا علم خروج عـدّة أفراد بعنوان معيّن ، وشكّ في أنّ هـذا العنوان هل هـو مصداق جدّي لهذا العنوان أو ذاك العنوان فلا يجري أصلاً ، ولا يرتفع به الشكّ عندهم .
وبالجملة : إذا ورد المخصّص نستكشف عن أنّ إنشائه في مورد التخصيص لم يكن بنحو الجدّ ، ويدور أمر المشتبه بين كونه مصداقاً للمخصّص حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم المخصّص ، وبين عدم كونه مصداقاً له حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم العامّ المخصّص . ومع هذه الشبهة لا أصل لإحراز أحد الطرفين ; فإنّها كالشبهة المصداقية لأصالة الجدّ بالنسبة إلى العامّ والخاصّ كليهما .
ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الشيخ الأعظم(7) والمحقّق الخراساني(8) ، قدّس الله روحهما .
نعم ، بعض أهل التحقيق فسّر كلام الشيخ بما لا يخلو عن إشكال ، قال في «مقالاته» : الذي ينبغي أن يقال : إنّ الحجّية بعدما كانت منحصرة في الظهور التصديقي المبني على كون المتكلّم في مقام الإفادة والاستفادة فإنّما يتحقّق هذا المعنى في فرض تعلّق قصد المتكلّم بإبراز مرامه باللفظ ، وهو فرع التفات المتكلّم بما تعلّق به مرامـه ، وإلاّ فمع جهله به واحتمال خروجه عن مرامه كيف يتعلّق قصده بلفظـه على كشفه وإبرازه ؟ ومن المعلوم : أنّ الشبهات الموضوعية طرّاً من هذا القبيل .
ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما أفاد في وجه المنع بمثل هذا البيان ، ومرجع هذا الوجه إلى منع كون المولى في مقام إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان هو بنفسه مشتبهاً فيـه ، فلا يكون الظهور حينئذ تصديقياً ; كي يكون واجداً لشرائط الحجّية(9) ، انتهى .
ولا يخفى : أنّـه لا يلزم على المتكلّم في الإخبار عـن موضوع واقعي الفحص عن كلّ فرد فرد حتّى يعلم مقطوعه ومشكوكه ، بل ما يلزم عليه في جعل الحكم على عنوان كلّياً إحراز أنّ كلّ فرد واقعي منه محكوم بهذا الحكم ، كما في قولك : «النار حارّة» ، وأمّا تشخيص كـون شيء ناراً فليس متعلّقاً بمرامـه ولا مربوطاً بمقامه .
وببيان أوضح : أنّ الحجّية وإن كانت منحصرة في الظاهر الذي صدر من المتكلّم لأجل الإفادة، ولابدّ له أن يكون على تيقّن فيما تعلّق به مرامه ، لكن ذلك في مقام جعل الكبريات لا في تشخيص الصغريات .
فلو قال المولى «أكرم كلّ عالم» فالذي لابدّ له إنّما هو تشخيص أنّ كلّ فرد من العلماء فيه ملاك الوجوب ; وإن اشتبه عليه الأفراد .
ولو قال بعد ذلك «لا تكرم الفسّاق من العلماء» لابدّ له من تشخيص كون ملاك الوجوب في عدولهم . وأمّا كون فرد عادلاً في الخارج أو لا فليس داخلاً في مرامه ; حتّى يكون بصدد بيانه.
ويرشدك إليه : أنّـه لو صحّ ما أفاده : مـن أنّ المولى لم يكن بصدد إفادة المراد بالنسبة إلى ما كان بنفسه مشتبهاً فيه ، لابدّ مـن التزامه بعدم وجـوب إكرام من اشتبه عند المولى أ نّه عادل أو لا ولكن العبد أحرز كونه عالماً عادلاً ، مع أنّ العبد لا يعدّ معذوراً في ترك إكرامه ; وإن اعتذر بأنّ المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك .
وأمّا نسبة ما أفاده إلى الشيخ الأعظم ففي غير محلّه ; فإنّ كلامه في تقريراته آب عن ذلك ، وملخّصه : أنّ العامّ الواقع في كلام المتكلّم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه أيضاً قد يكون مثل العبد فيها ، فالعامّ مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية(10) .
وأنت ترى : أنّ كلامه آب عمّا نسب إليه ، بل يرجع إلى ما فصّلناه وأوضحناه ، ولولا تشويش عبائر القائل وإغلاقها لجاز حملها على ما أفاده الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ ، كما قد يظهر من ذيل كلامه .
ثمّ إنّ شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ نقل تقريباً لجواز التمسّك عن المحقّق النهاوندي ـ طيّب الله رمسه(11) ـ وهو : أنّ قول القائل «أكرم العلماء» يدلّ بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كلّ واحد من العلماء ، ويدلّ بإطلاقه على سراية الحكم إلى كلّ حالة من الحالات ، ومن جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق والعدالة ، وقد علم من قوله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم ، فمقتضى أصالة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحته(12)، انتهى .
والجواب أوّلاً : أنّ ما فسّر به الإطلاق غير صحيح ; لأنّ الإطلاق ليس إلاّ كون الشيء تمام الموضوع كما تقدّم(13) ، لا أخذ جميع الحالات والعناوين في الموضوع ، فإنّ ذلك معنى العموم . فما اصطلح به من الإطلاق الأحوالي باطل من رأس .
وثانياً : أنّ البحث إنّما هو في العامّ المتضمّن لبيان الحكم الواقعي ، والمفروض أنّ الموضوع له إنّما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبّاً ، فكيف يحكم بوجوب إكرام المشتبه مع كونه فاسقاً واقعياً ؟
وما ذكره مـن أنّ العامّ وإن كان غير شامل له بإطلاقـه الأفرادي إلاّ أ نّـه شامل له بإطلاقه الأحوالي ـ بمعنى أنّ العالم واجب الإكرام في جميع الحالات ; ومنها كونه مشكوك الفسق ـ يستلزم اجتماع حكمين في موضوع واحد بعنوان واحد ; لأنّ ما ذكره من الإطلاق الأحوالي موجـود في الخاصّ أيضاً ; فإنّ قولـه «لا تكرم الفسّاق» شامل لمشتبه الفسق ومعلومـه إذا كان فاسقاً واقعياً ، فهذا الفرد بما أ نّه مشتبه الفسق واجب الإكرام ومحرّمه ، ولو التجأ ـ قدس سره ـ إلى أنّ العامّ متكفّل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه أخذ الشكّ في الحكم في جانب موضوع نفس ذلك الحكم .
وفيه ـ مضافاً إلى أن أخذ الشكّ في الموضوع لا يصحّح الحكم الظاهري ـ أنّ مجرّد أخذه فيه لا يرفع الإشكال ; إذ كيف يمكن تكفّل العامّ بجعل واحد للحكم الواقعي على الموضوع الواقعي ، وللحكم الظاهري على مشتبه الحكم ، مع ترتّبهما ؟ وهل هذا إلاّ الجمع بين عدم لحاظ الشكّ موضوعاً ولحاظه كذلك ؟ !
القول في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي:
ما ذكرناه في المخصّص اللفظي جار في اللبّي ، لكن بعد تمحيض المقام في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي ، كما إذا خرج عنوان عن تحت العامّ بالإجماع أو العقل ، وشكّ في مصداقه ، فلا محالة يكون الحكم الجدّي في العامّ على أفراد المخصّص دون المخصِّص ـ بالكسر ـ ومعه لا مجال للتمسّك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعية ; لما مرّ(14) .
ومنه يظهر النظر في كلام المحقّق الخراساني ـ رحمه الله ـ ; حيث فصّل بين اللبّي الذي يكون كالمخصّص المتّصـل وغيره(15) ، مع أنّ الفارق بين اللفظي واللبّي من هذه الجهة بلا وجه . ودعوى بناء العقلاء على التمسّك في اللبّيات(16) عهدتها عليه .
كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين ، كالعالم الفاسق والعالم غير الفاسق فلا يجوز ، وغيره كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في العامّ ـ وإن علمنا بأنّه لو فرض في أفراد العامّ من هو فاسق لا يريد إكرامه ـ فيجوز التمسّك بالعامّ وإحراز حال الفرد أيضاً . ثمّ فصّل في بيانه بما لا مزيد عليه(17) .
ولكن يظهر من مجموعه خروجه عن محطّ البحث ووروده في واد الشكّ في أصل التخصيص، مع أنّ الكلام في الشكّ في مصداق المخصّص ، فراجع كلامه .
وأمّا توجيه كلامه بأنّ المخصّص ربّما لا يكون معنوناً بعنوان ، بل يكون مخرجاً لذوات الأفراد، لكن بحيثية تعليلية وعلّة سارية فإذا شكّ في مصداق أنّه محيّث بالحيثية التعليلية يتمسّك بالعامّ(18) فغير صحيح ; لما تقرّر في محلّه من أنّ الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في الأحكام العقلية ; بحيث تصير تلك الجهات موضوعاً لها .
وعليه : فالخارج إنّما هو العنوان مع حكمه عن تحته لا نفس الأفراد ; لأنّ الفرض أنّ المخصّص لبّي عقلي . ولو سلّمنا أنّ الخارج هو نفس الأفراد وذواتها دون عنوانها يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصّص والنزاع هنا فيها .
وأوضح حالاً ممّا ذكـراه : ما عـن بعض أعاظم العصر مـن الفرق بين ما إذا كان المخصّص صالحاً لأن يؤخـذ قيداً للموضوع ولم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر ، كقيام الإجماع على اعتبار العدالـة في المجتهد ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما في قوله ـ عليه السلام ـ : «اللهمّ العن بني اُمية قاطبة» ; حيث يعلم أنّ الحكم لا يعمّ مـن كان مؤمناً منهم ، ولكن إحـراز أن لا مؤمن في بني اُمية مـن وظيفة المتكلّم ; حيث لا يصحّ له إلقاء مثل هـذا العموم إلاّ بعد إحرازه .
ولو فرض أنّا علمنا من الخارج أنّ خالد بن سعيد كان مؤمناً كان ذلك موجباً لعدم اندراجه تحت العموم ، فلو شككنا في إيمان أحد فاللازم جواز لعنه ; استكشافاً من العموم ، وأنّ المتكلّم أحرز ذلك ; حيث إنّه وظيفته(19) ، انتهى .
وفيه : أنّ خروج ابن سعيد إن كان لخصوصية قائمة بشخصه ـ لا لأجل انطباق عنوان عليه ـ فالشكّ في غيره يرجع إلى الشكّ في تخصيص زائد ، فيخرج عن محلّ البحث ; لأنّ البحث في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وإن كان لأجل انطباق عنوان المؤمن عليه فالكلام فيه هو الكلام في غيره ; من سقوط أصالة الجدّ في المؤمن لأجل تردّد الفرد بين كونه مصداقاً جدّياً للعامّ أو لغيره .
تنبيهات:
التنبيه الأوّل : التمسّك بالعامّ مع كون الخاصّ معلّلا:
لو قال المولى «أكرم كلّ عالم» ، ثمّ قال منفصلاً عنه «لا تكرم زيداً وعمراً وبكراً ; لأ نّهم فسّاق» فهل يجوز التمسّك هنا بالعامّ في الفرد المشكوك أو لا ؟
الظاهر ، بل التحقيق : هو الثاني ; لأنّ تعليله بكونهم فسّاقاً يعطي أنّ المخرج هو العنوان دون الأشخاص مستقلّة ، ويأتي فيه ما قدّمناه .
وما ربّما يقال : من جواز التمسّك بالعامّ فيه ; لأنّه من قبيل التخصيص الزائد لا الشبهة المصداقية(20) غير تامّ ، كما مرّ وجهه .
التنبيه الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم : إذا تعلّق الحكم على عنوانين بينهما عموم من وجه :
فتارة : يكون أحدهما حاكماً على الآخر ; فلا شبهة في كونه من قبيل المخصّص ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ المحكوم في الشبهة المصداقية في دليل الحاكم ; لعين ما مرّ .
ومع عدم الحكومة : فإن قلنا بأنّ العامّين من وجه يشملهما أدلّة التعارض وقواعد الترجيح وقدّمنا أحدهما مع الترجيح ، أو قلنا : إنّهما من قبيل المتزاحمين ، وقلنا : إنّ المولى ناظر إلى مقام التزاحم ، وكان حكمـه إنشائياً بالنسبـة إلى المرجوح يكون حاله أيضاً حال المخصّص في عدم جواز التمسّك مع الشبهة المصداقية في الراجح .
وأمّا إن قلنا : بأنّ الحكمين في المتزاحمين فعليان على موضوعهما ، والتزاحم الخارجي وعدم قدرة العبد على إطاعتهما لا يوجب شأنية الحكم في المرجوح ، بل العقل يحكم بكونه معذوراً في امتثال كليهما ، من غير تغيير في ناحية الحكم فالظاهر جواز التمسّك في مورد الشكّ في انطباق الدليل المزاحم الذي هو أقوى ملاكاً ; لأنّ الحكم الفعلي على موضوعه حجّة على المكلّف ما لم يحرز العذر القاطع ، ولا يجوز عقلاً رفع اليد عن الحكم الفعلي بلا حجّة ، نظير الشكّ في القدرة ; حيث لا يجوز التقاعد عن التكليف الفعلي مع احتمال العجز .
التنبيه الثالث : في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي :
بعد البناء على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية يقع الكلام في أ نّه هل يمكن إحراز المصداق بالأصل وإجراء حكم العامّ عليه مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو تفصيل بين المقامات ؟ أقوال :
حجّة النافي : أنّ شأن المخصّص هو إخراج الفرد الخاصّ مع بقاء العامّ على تمامية موضوعه بالنسبة إلى الباقي ، من دون انقلاب الموضوع عمّا هو عليه ; إذ إخراج الفرد نظير موته . فحينئذ لا يبقى مجال لجريان الأصل ; إذ الأصل السلبي ليس شأنه إلاّ نفي حكم الخاصّ عنه لا إثبات حكم العامّ له ، ونفي أحد الحكمين لا يثبت الآخر . نعم ، في مثل الشكّ في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب أمكن دعوى أ نّه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة ، الذي كان أمر رفعه بيد المولى ، وفي مثله لا بأس بالتمسّك بالعامّ ، من غير احتياج إلى الأصل(21)، انتهى .
وفيه : أ نّه إن أراد من قوله إنّ التخصيص لا يعطي عنواناً زائداً على الموجود في نفس العامّ ، عدم حدوث انقلاب في موضوع العامّ بحسب الظهور فهو حقّ لا غبار عليه ; إذ هذا هو الفرق بين التخصيص بالمنفصل وبين المتّصل منها والتقييد ; فإنّ شأن الأخيرين إعطاء قيد زائد على الموجود في الدليل الأوّل ، ولكن ذلك لا يمنع عن جريان الأصل .
وإن أراد أنّ الموضوع باق على سعته بحسب الواقع والإرادة الجدّية أيضاً فهو ممنوع جدّاً ; إذ التخصيص يكشف عن أنّ الحكم الجدّي تعلّق بالعالم غير الفاسق أو العادل . وقياس المقام بموت الفرد غريب ; لعدم كون الدليل ناظراً إلى حالات الأفراد الخارجية . واخترام المنية لبعض الأفراد لا يوجب تقييداً أو تخصيصاً في الأدلّة ، بخلاف إخراج بعض الأفراد
وأغرب منه : ما ذكره في ذيل كلامه من جواز التمسّك في الشبهة المصداقية لمخالفة الكتاب ; مستدلاًّ بأنّ رفعها بيد المولى ; إذ لو كان الشكّ راجعاً إلى الشبهة المصداقية فليس رفعها بيد المولى ; لأنّ الشبهة عرضت من الاُمور الخارجية .
أضف إليـه : أنّ المثالين من باب المخصّـص المتّصـل ; لاتّصال المخصّص في قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «المؤمنون عند شروطهم إلاّ ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»(22) ، وفي قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»(23) ولا يجوز التمسّك فيه بالعامّ بلا إشكال .
حجّة القائل بجريانه مطلقاً : أنّ القرشية والنبطية من أوصاف الشيء في الوجود الخارجي ; لأنّها التولّد من ماء من هو منتسب إليهم ، فلك أن تشير إلى ماهية المرأة وتقول : إنّ هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها ، فيستصحب عدمها ويترتّب عليه حكم العامّ ; لأنّ الخارج من العامّ المرأة التي من قريش ، والتي لم تكن منه بقيت تحته ، فيحرز موضوع حكم العامّ بالأصل(24)، انتهى .
وعن بعض آخر في تقريبه أيضاً : أنّ العامّ شامل لجميع العناوين ، وما خرج منـه هو عنوان خاصّ وبقي سائرها تحته ، فمع استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش أو عدم قرشيتها ينقّح موضوع العامّ(25) ، انتهى .
وربّما يقال في تقريبه أيضاً ما هذا ملخّصه : إن أخذ عرض في موضوع الحكم بنحو النعتية ومفاد كان الناقصـة لا يقتضي أخـذ عدمـه نعتاً في موضوع عـدم ذلك الحكم ; ضرورة أنّ ارتفاع الموضوع المقيّد بما هـو مفاد كان الناقصـة إنّما يكون بعدم اتّصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصّلة لا على نحو ليس الناقص .
فمفاد قضية «المرأة تحيض إلى خمسين إلاّ القرشية» هو أنّ المرأة التي لا تكون متّصفة بكونها من قريش تحيض إلى خمسين ، لا المرأة المتّصفة بأن لا تكون من قريش .
والفرق بينهما : أنّ القضية الاُولى سالبة محصّلة والثانية مفاد ليس الناقص ، فلا مانع من جريان الأصل لإحراز موضوع العامّ(26) .
هذا ، ولكن التعرّض لكلّ ما قيل في المقام أو جلّه يوجب السأمة والملال ، والأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو المختار على وجه يظهر الخلل في كثير من التقريبات التي أفادها الأعلام الكبار ، وسيوافيك تفصيل القول في مباحث البراءة والاشتغال ، بإذنه وتوفيقه سبحانه .
مقتضى التحقيق في المقام:
فنقول : تمحيص الحقّ يتوقّف على بيان مقدّمات نافعة في استنتاجه :
الاُولى : في أقسام القضايا بلحاظ النسبة:
تقدّم القول في أنّ القوم قد أرسلوا اشتمال القضايا على النسبة في الموجبات والسوالب بأقسامها إرسال المسلّمات ، وبنوا عليه ما بنوا ، ولكن التحقيق ـ كما مرّ ـ خلافه ; إذ الحملية ـ كما سلف ـ على قسمين : حملية حقيقية غير مأوّلة ; وهي ما يحمل فيها المحمول على موضوعه بلا أداة تتوسّط بينهما ، نحو «الإنسان حيوان ناطق» وقولك «زيد قائم» ، وحملية مأوّلة ; وهي على خلاف الاُولى تتوسّط بينهما الأداة ، نحو «زيد في الدار» .
والقسم الأوّل : لا يشتمل على النسبة مطلقاً ; لا على الكلامية ولا على الخارجية . ولا فرق بين أن يكون الحمل أوّلياً أو شائعاً صناعياً ، أو يكون الحمل على المصداق بالذات أو بالعرض ، كما لا فرق بين الموجبات والسوالب . غير أنّ الهيئة تدلّ في الموجبة على الهوهوية التصديقية وفي السالبة على سلب الهوهوية كذلك ، وقد تقدّم براهين ذلك كلّه عند البحث عن الهيئات(27).
وأمّا القسم الثاني : فلا محالة يشتمل على النسبة ; خارجية وكلامية وذهنية ، لكن في الموجبات تدلّ على تحقّق النسبة خارجاً ، نحو قولك «زيد على السطح» أو «زيد في الدار» ; فإنّهما من الحمليات المأوّلة ، كما أنّ السوالب منها باعتبار تخلّل أداة النسبة وورود حرف السلب عليها تدلّ على سلب النسبة ، وتحكي عن عدم تحقّقها واقعاً .
فظهر : أنّ الكون الرابط أو النسبة يختصّ من بين القضايا بموجبات هذا القسم ـ أعني الحملية المأوّلة ـ وأمّا السوالب من هذا القسم والقسم الأوّل بكلا نوعيه فلا تشتمل عليها ; لما تقدّم في محلّه(28) من امتناع تحقّق النسبة بين الشيء ونفسه والشيء وذاتياته كما في الأوّليات ، والشيء وما يتّحد معه كما في الصناعيات . وأمّا السوالب فهي لسلب النسبة أو نفي الهوهوية ـ بناءً على التحقيق ـ فلا محالة تكون خالية عنها ، كما لا يخفى .
الثانية : في بيان ما يوجب كون الكلام محتملا للصدق والكذب ومناطهما وفيها نتعرّض لأمرين:
الأوّل : بيان ما هـو مناط احتمال الصدق والكذب ، ومـا يوجب كـون الكلام محتملاً لهما :
فنقول : إنّ المناط في ذلك هو الحكاية التصديقية لا التصوّرية ; سواء تعلّقت بالهوهوية إثباتاً ونفياً أم بالكون الرابط كذلك .
توضيحه : أنّ الحكاية التصديقية التي تفيد فائدة تامّة :
تارة : تتعلّق بالهوهوية وأنّ هذا ذاك تصديقاً ، أو سلب الهوهوية ونفي أنّ هـذا ذاك بنحو التصديق .
واُخرى : تتعلّق بالكون الرابط بنحو الإثبات ، نحو «زيد له البياض» ، أو «زيد في الدار» ، أو بنحو النفي ، نحو «ليس زيد في الدار» ، فالمناط في احتمال الصدق والكذب هذه الحكاية . وأمّا إذا خلى الكلام عن تلك الحكاية التصديقية فينتفي مناط الاحتمال ; سواء دلّ على الاتّحاد التصوّري نحو زيد العالم ، أو على النسبة التصوّرية كما في الإضافات .
الثاني من الأمرين : بيان مناط صدق القضايا وكذبها :
فنقول : ليس مناطه ما دارج بينهم من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية ; ضرورة عدم إمكان اشتمال الحمليات غير المأوّلة على النسبة مطلقاً ، وكذا السوالب من المأوّلة مع وجود الصدق والكذب فيهما ، بل مناطه هو مطابقة الحكاية لنفس الأمر وعدمها .
فلابدّ أن يلاحظ الواقع بمراتبه وعرضه العريض ; فإن طابق المحكي فهو صادق وإلاّ فهو كاذب . فقولنا : «الله تعالى موجود» صادق وقولنا : «الله تعالى له الوجود» كاذب ; فإنّ الأوّل يحكي حكاية تصديقية عن الهوهوية بينهما ، والمحكي أيضاً كذلك ، والثاني يحكي تصديقاً عن عروض الوجود ونفس الأمر على خلافه .
وأمّا السوالب : فبما أ نّها ليس للأعدام مصداق واقعي فمناط الصدق والكذب مطابقة الحكاية التصديقية لنفس الأمر ; بمعنى لزوم كون الحكاية عن سلب الهوهوية أو سلب الكون الرابط مطابقاً للواقع ، لا بمعنى أنّ لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الأمر ; ضرورة عدم واقعية للأعدام ، بل بمعنى خلوّ صحيفة الوجود عن الهوهوية والنسبة وعدم وجود لواحد منهما في مراتب نفس الأمر .
فعدم مصداق واقعي للهوهوية والنسبة مناط لصدقها ، واشتمال الوجود على واحد منها مناط كذب ما يدلّ على نفيه .
فلو قلت : «ليس شريك البارئ بموجود» لكان صادقاً ; لخلوّ صحيفة الوجود عنه ، والمفروض أنّ الحكاية عن خلوّه عنه . فالحكاية مطابقة لنفس الأمر . ولو قلت «شريك البارئ غير موجود» أو «لا موجود» بنحو الإيجاب العدولي لصار كاذباً ; لأنّ الموجبة ـ محصّلة كانت أو معدولة ـ تحتاج في صدقها إلى وجود موضوع في ظرف الإخبار ، وهو هنا مفقود ، إلاّ أن يؤوّل بالسالبة المحصّلة . كما أنّه لا محيص عن التأويل في قولنا «شريك البارئ معدوم» أو «ممتنع» .
وأمّا مناط الصدق والكذب في لوازم الماهية فليس معناه أنّ لكلّ من اللازم والملزوم محصّلاً مع قطع النظر عن الوجود ، بل معناه أنّ الإنسان عند تصوّر الأربعة يجد معه في تلك المرتبة زوجيتها ، مع الغفلة عن وجود الأربعة في الذهن ، ويرى بينهما التلازم مع الغفلة عن التحصّل الذهني ، فيستكشف من ذلك أنّ الوجود الذهني دخيل في ظهور الملازمة ، لا في لزومها حتّى يكون من قبيل لازم الوجودين .
الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع:
وهي من أهمّ المقدّمات ، ثمّ أنّ القضية تنقسم إلى الموجبة والسالبة وكلّ واحدة منهما إلى البسيطة والمركّبة ، والكلّ إلى المحصّلة والمعدولة . وحينئذ فبما أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فلا محيص في الموجبة من وجود موضوع في ظرف ثبوت الحكم حتّى يصحّ الحكم ويحكم بالصدق .
وما ذكرنا من القاعدة الفرعية حكم بتّي لا يقبل التخصيص ، فلا فرق بين أن يكون الثابت أمراً وجودياً كما في الموجبة المحصّلة ، أو أمراً غير وجودي كما في الموجبة المعدولة ، نحو «زيد لا قائم» والموجبة السالبة المحمول ـ وهو ما يجعل فيه السالبة المحصّلة نعتاً للموضوع ـ نحو زيد هو الذي ليس بقائم .
وجه عدم الفرق هو أ نّه كما اعتبر الاتّحاد والهوهوية بين زيد وقائم في الموجبة المحصّلة كذلك اعتبرت الهوهوية بين زيد وعنوان اللاقيام ; إذ لابدّ من نحو تحقّق للمتّحدين في ظرف الاتّحاد.
ولهذا قلنا في محلّه : أنّ القضية المعدولة لا تعتبر إلاّ إذا كانت الأعدام فيها من قبيل أعدام الملكات ; حتّى يكون لملكاتها نحو تحقّق ، فيقال : «زيد لا بصير» أو «أعمى» ، ولا يقال : «الجدار لا بصير» أو «أعمى» ; لتحقّق ما به الاتّحاد في الأوّل دون الثاني .
وقس عليه الموجبة السالبة المحمول ; إذ هي ترجع إلى نحو اتّحاد أو توصيف وله نحو ثبوت ، فلابدّ من نحو وجود حتّى يصحّ ذلك .
فظهر : أنّ الموجبات تفتقر في صدقها إلى وجود الموضوع في جميع أقسامها ، وهو واضح .
الرابعة : ضرورة كون الموضوع في الجملة الخبرية والإنشائية مفرداً:
إنّ موضوع الحكم في الجملة الخبرية والإنشائية لابدّ أن يكون مفرداً أو في حكم المفرد ; حتّى أنّ الشرطية التي تتألّف من قضيتين تخرجان بذلك عن التمامية وتصيران كالجمل الناقصة .
والسرّ في ذلك : أنّ الحكاية عن موضوع الحكم فقط أو محموله كذلك لابدّ أن تكون حكاية تصوّرية ، كما أنّ الحكاية عن اتّحادهما أو حصول أحدهما في الآخر لابدّ أن تكون حكاية تصديقية ، وهي الملاك لكون الجملة قضية تامّة . والحكاية التصوّرية متقدّمة على التصديقية ; أعني جعل الحكم على الموضوع .
وعليه : لا محيص عن كون الموضوع أمراً مفرداً أو مأوّلاً به ; إذ لا تجتمع الحكاية التصوّرية مع التصديقية ، ولا يجتمع النقص والتمام في جملة واحدة وفي حال واحد ; ولو بتكرّر الاعتبار.
فلو قلت : «زيد قائم غير عمرو قاعد» لا تكون الحكاية التصديقية فيه إلاّ عن مغايرة جملتين لا عن قيام زيد وقعود عمرو ، فلو قال المتكلّم «ليس زيد بقائم غير ليس عمرو بقاعد» فكلّ من الموضوع والمحمول جملة ناقصة بالفعل ، وإذا انحلّت القضية خرج كلّ واحدة منهما من النقص ، وصار قضية تامّة موجبة محصّلة أو سالبة محصّلة ، كما في المثالين .
وربّما صار سالبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول ، مثل «المرأة غير القرشية حكمها كذا» أو «المرأة التي ليست بقرشية حكمها كذا» .
الخامسة : في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص:
إنّه قد مرّ سابقاً(29) أنّ التخصيص ـ سواء كان متّصلاً أم منفصلاً ـ يكشف عن تضيّق ما هو موضوع للعامّ بحسب الإرادة الجدّية ، ولا يمكن تعلّق الحكم الجدّي على جميع الأفراد ، مع أ نّه خصّصه بالإرادة الجدّية على أفراد مقيّدة بالعدالة . وليس ذلك الامتناع لأجل تضادّ الحكمين حتّى يقال : إنّ الغائلة ترتفع بتكثّر العنوان ، بل لأجل أنّ الإرادة الجدّية إذا تعلّقت بحرمة إكرام كلّ واحد من الفسّاق منهم يمتنع تعلّق إرادة اُخرى على إكرام كلّ واحد من العلماء جدّاً بلا تخصيص ، مع العلم بأنّ بعض العلماء فاسق ، ويؤول ذلك الامتناع إلى امتناع نفس التكليف .
وإن شئت قلت : إنّ المولى الملتفت بموضوع حكمه لا تتعلّق إرادته الجدّية على الحكم به إلاّ بعد تحقّق المقتضي وعدم المانع ، فإذا رأى أنّ في إكرام عدول العلماء مصلحة بلا مفسدة ، وفي إكرام فسّاق العلماء مفسدة ملزمة أو ليست فيه مصلحة فلا محالة تتضيّق إرادته وتتعلّق بإكرام عدولهم أو ما عدا فسّاقهم .
ولا يقاس المقام بباب التزاحم ; إذ المولى لم يحرز في الأفراد المخصّصة مصلحة ، بل ربّما أحرز مفسدة في إكرامهم ، فلا يعقل ـ حينئذ ـ فعلية الحكم في حقّهم ، بخلاف باب المتزاحمين . وحينئذ يسقط ما ربّما يقال من أنّ المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعلية الحكم عن موضوعه .
وكيف كان : أنّ موضوع العامّ بحسب الإرادة الجدّية بعد التخصيص يتصوّر على وجوه ثلاثة :
الأوّل : أن يكون على نحو العدم النعتي على حذو لفظ العدول ، كالعلماء غير الفسّاق ، وكالمرأة غير القرشية .
والثاني : أن يكون العدم النعتي على حذو السالبة المحمول ، كـ «العلماء الذين لا يكونون فسّاقاً أكرمهم» و«المرأة التي لا تكون قرشية ترى الدم إلى خمسين» .
والثالث : أن يكون موضوع العامّ على حذو السالبة المحصّلة التي تصدق مع عدم موضوعها ، كما إذا قلت : «إذا لم يكن العالم فاسقاً فأكرمه» .
فالموضوع ـ أعني السالبة المحصّلة ـ مع قطع النظر عن حكمه الإيجابي ـ أي أكرم ـ يصدق فيما إذا لم يكن للعالم وجود أصلاً ، كما إذا قلت : «إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين» ، فيصدق موضوعه مع قطع النظر عن حكمه ـ أعني ترى ـ فيما إذا لم تكن المرأة موجودة رأساً .
هذه هي الوجوه المتصوّرة ، ولكن لا سبيل إلى الثالث ; إذ جعل الحكم الإيجابي على المعدوم بما هو معدوم غير معقول ، والحكاية بالإيجاب عن موضوع معدوم حكاية عن أمر محال .
فالسالبة المحصّلة بما أ نّها تصدق بانتفاء الموضوع أيضاً يمتنع أن يقع موضوعاً لحكم إيجابي ; إذ قولنا : «إذا لم تكن المرأة قرشية ترى الدم إلى خمسين» لو كان بنحو السلب التحصيلي الصادق مع سلب موضوعه يرجع مغزاه إلى أنّ المرأة التي لم توجد أيضاً ترى الدم ، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع ، فيكون الحكم متعلّقاً بالمرأة الموجودة إذا لم تكن من قريش .
فالاعتبارات التي يمكن أخذها قيداً لموضوع العامّ المخصّص أحد هذه الاُمور : العدم النعتي العدولي ، والسالبة المحمول ، والسالبة المحصّلة ، بشرط أمرين : اعتبار وجود الموضوع وإلاّ يلزم جعل الحكم على المعدوم ، وعدم إرجاعه إلى التقييد والنعت وإلاّ يرجع إلى السالبة المحمول .
إذا عرفت ما مهّدناه فاعلم : أنّه إذا كان الفرد الموجود متّصفاً بعنوان العامّ وغير متّصف بعنوان الخاصّ سابقاً ; بحيث كان عالماً غير فاسق ، فشكّ بعد برهة من الزمن في انقلاب أحد القيدين إلى ضدّه فلا إشكال في أ نّه يجري الأصل ويحرز به عنوان العامّ بما هو حجّة ; أعني «العالم العادل» أو «العالم غير الفاسق» . وهذا فيما إذا كان العلم بعدالته مقارناً للعلم بأ نّه عالم، بأن نعلم أ نّه كان قبل سنة عالماً وعادلاً .
وأمّا لو علمنا أنّ زيداً كان غير فاسق ، وشككنا في بقاء عدمه النعتي ، ولكن لم يكن علمه في حال عدم فسقه متيقّناً حتّى يكون المعلوم عندنا كونه العالم غير الفاسق ، بل علم أ نّه عالم في الحال فلا يمكن حينئذ إحراز موضوع العامّ بالأصل والوجدان ، إلاّ على القول بحجّية الاُصول المثبتة ; لأنّ استصحاب عدم كون زيد فاسقاً أو كونه غير فاسق ، مع العلم بأنّه عالم في الحال يلزمه عقلاً أنّ زيداً العالم غير فاسق على نحو النعت والتقييد .
وبعبارة اُخرى : أنّ موضوعه هو العالم المتّصف بعدم كونه فاسقاً ، فجزؤه عدم نعتي للعالم بما هو عالم ، وهو غير مسبوق باليقين ، وما هو مسبوق به هو زيد المتّصف بعدم الفسق لا العالم، وهو ليس جزءه .
واستصحاب العدم النعتي لعنوان لا يثبت العدم النعتي لعنوان متّحد معه إلاّ بحكم العقل ، وهو أصل مثبت . وتعلّق العلم بأنّ زيداً العالم في الحال لم يكن فاسقاً بنحو السلب التحصيلي لا يفيد ; لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعاً للحكم .
ومن هذا ظهر : عدم إمكان إحراز جزئي الموضوع بالأصل إذا شكّ في علمه وعدالته مع العلم باتّصافه بهما سابقاً في الجملة ، لو لم يعلم اتّصافه بهما في زمان واحد ; حتّى يكون العالم غير الفاسق مسبوقاً باليقين . فالمناط في صحّة الإحراز هو مسبوقية العدم النعتي لعنوان العالم ، لا العدم النعتي مطلقاً ، فتدبّر .
هذا كلّه في الأوصاف العرضية المفارقة ، وقد عرفت مناط جريانه .
وأمّا إذا كان الاتّصاف واللااتّصاف من العناوين التي تلزم وجود المعنون ـ كالقابلية واللاقابلية للذبح في الحيوان ، والقرشية واللاقرشية في المرأة ، والمخالفة وعدمها للكتاب في الشرط ـ فهل يجري فيه الأصل لإحراز مصداق العامّ أو لا ؟
الحقّ : امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصوّرة .
بيان ذلك : أ مّا إذا كان الوصف من قبيل العدم النعتي بنحو العدول أو بنحو الموجبة السالبة المحمول فواضح ; لأنّ كلاًّ منهما يعدّ من أوصاف الموضوع وقيوده ; بحيث تتّصف الموضوع بهذه الصفة . والاتّصاف والصفة فرع كون الموضوع موجوداً في الخارج ; لما مرّ من القاعدة الفرعية ; حتّى يتقيّد بأمر وجودي .
وعليه : فلو قلنا إنّ الموضوع بعد التخصيص عبارة عن المرأة غير القرشية والشرط غير المخالف على نحو الإيجاب العدولي ، أو عبارة عن المرأة التي ليست بالقرشية ، والشرط الذي ليس مخالفاً للكتاب بنحو السالبة المحمول ، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع حتّى يصحّ في حقّه هذه الأوصاف .
ولكنّه مع هذا الفرض غير مسبوق باليقين ; إذ الفرد المشكوك كونها قرشية أو لا ، أو مخالفاً للكتاب أو لا لم تتعلّق به اليقين في زمان بأنّه متّصف بغير القرشية ، أو بأنّها ليست بقرشية ; كي يجرّ إلى حالة الشكّ ; لأنّ هذه الأوصاف ملازمة لوجود الفرد من بدو نشوه لا ينفكّ عنه أصلاً ، فهي إمّا تولدت قرشية أو غير قرشية .
والحاصل : أنّك لو تأمّلت في أمرين يسهل لك التصديق للحقّ :
أحدهما : أنّ الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ـ مع كونهما جملة ناقصة لأجل أخذهما قيداً للموضوع ـ يحتاجان إلى الموضوع ; فإنّه في كلّ منهما يكون الموضوع متّصفاً بوصف . فكما أنّ المرأة غير القرشية تتّصف بهذه الصفة كذلك المرأة التي لم تتّصف بالقرشية أو لم تكن قرشية موصوفة بوصف أ نّها لم تتّصف بذلك أو لم تكن كذلك .
والفرق بالعدول وسلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه ; إذ المرأة قبل وجودها كما لا تتّصف بأنّها غير قرشية ـ لأنّ الاتّصاف بشيء فرع وجود الموصوف ـ كذلك لا تتّصف بأنّها هي التي لا تتّصف بها ; لعين ما ذكر .
وتوهّم : أنّ الثاني من قبيل السلب التحصيلي ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول وبين السالبة المحصّلة ، والقيد في العامّ بعد التخصيص يتردّد بين التقييد بنحو الإيجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ، ولا يكون من قبيل السلب التحصيلي ; لأنّه لا يوجب تقييداً في الموضوع ، والمفروض ورود تقييد على العامّ بحسب الجدّ .
ثانيهما : عدم حالة سابقة لهذا الموضوع المقيّد بأحد القيدين ; لأنّ هذه المرأة المشكوك فيها لم يتعلّق بها العلم بكونها غير قرشية في زمان بدو وجودها حتّى نشكّ في بقائه ، بل من أوّل وجودها مجهولة الحال عندنا .
وأمّا إذا كان القيد من قبيل السلب التحصيلي الذي لا يوجب تقييداً في الموضوع فهو وإن كان لا يحتاج في صدقه إلى وجود الموضوع ; لعدم التقييد والاتّصاف حتّى يحتاج إلى المقيّد والموصوف إلاّ أ نّه يمتنع أن يقع موضوعاً لحكم إيجابي ; أعني حكم العامّ ـ وهو قوله «ترى» ـ لأنّ السلب التحصيلي يصدق بلا وجود موضوعه ، فلا يعقل جعله موضوعاً لحكم إثباتي .
ولا معنى لتعلّق الحكم الإيجابي على العالم ; مسلوباً عنه الفسق بالسلب التحصيلي الذي يصدق بلا وجود للعالم . فلابدّ من أخذ الموضوع مفروض الوجود ، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقاً موضوعاً .
ويرد عليه : ما ورد على القسمين الأوّلين من انتفاء حالة سابقة .
أضف إلى ذلك : أنّ القول بأنّ هذه المرأة لم تكن قرشية قبل وجودها قول كاذب ; إذ لا ماهية قبل الوجود ، والمعدوم المطلق لا يمكن الإشارة إليه ; لا حسّاً ولا عقلاً ، فلا تكون هذه المرأة قبل وجودها هذه المرأة ، بل تلك الإشارة من مخترعات الخيال وأكاذيبها ، فلا تتّحد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوك فيها .
وصحّـة الاستصحاب منوطة بوحدتهما ، وهذا الشرط مفقودة في المقام ; لأنّ المرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضية المتيقّنة الحاكية عن ظرف العدم ; لما عرفت أنّ القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة والوجود الرابط ، ولا عن الهوهوية بوجه .
فلا تكون للنسبة السلبية واقعية حتّى تكون القضيـة حاكية عنها .
فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا ، بمعنى مسلوبية كلّ واحد من أجزاء القضية ـ أعني هذه المرأة وقريش والانتساب ـ لا بمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة إلى قريش ، وإلاّ يلزم كون الأعدام متمايزة حال عدمها .
وإن شئت قلت : فالقضية المتيقّنة غير المشكوك فيها ، بل لو سلّم وحدتهما يكون الأصل مثبتاً .
وبالجملة : فالقضيتان مختلفتان ; فما هو المتيقّن قولنا : «لم تكن هذه المرأة قرشية» ولو باعتبار عدم وجودها ، والمشكوك قولنا : «هذه المرأة كانت متّصفة بأنّها لم تكن قرشية» وكم فرق بينهما .
وإن شئت قلت : إنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع ، أو الأعمّ منه ومن سلب المحمول ، واستصحاب ذلك وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخصّ مثبت ; لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ في ظرف الوجود عقلي ، وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار ، وإثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار .
فظهر : أنّ السالبة المتقيّدة بالوجود أخصّ من السالبة المحصّلة المطلقة ، واستصحاب السلب المطلق العامّ الذي يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاصّ المقيّد بالوجود ويعدّ من لوازمه .
وأنت إذا أمعنت النظر في أحكام القضايا الثلاث ـ من المعدولة والسالبة المحمول والسالبة المحصّلة ـ وفي أنّ الأوّلين باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العامّ لابدّ فيهما من وجود الموضوع ، لقاعـدة «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» ، وأنّ الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه لا يمكن أخذه موضوعاً لحكم إيجابي ، وهو حكم العامّ .
يسهّل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الأعدام الأزلية في أمثال المقام مطلقاً ; لعدم الحالة السابقة لهذا الأصل تارة ، وكونه مثبتاً اُخرى .
وبما ذكـرنا يظهر الإشكال فيما أفاده بعض الأجلّـة في تعاليقـه على تقريراتـه ، فراجع(30) .
التنبيه الرابع: إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية:
لا يجوز التمسّك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شكّ في صحّة الوضوء بمائع مضاف ; فضلاً عن دعوى كشف حال الفرد والحكم بصحّته مطلقاً ; لأنّ إطلاقات أدلّة النذر أو عموماتها مقيّدة بأنّه «لا نذر إلاّ في طاعة الله» ، أو «لا نذر في معصية الله» . فحينئذ يصير متعلّق الإرادة الجدّية مقيّدة بعنوان الطاعة أو بكون النذر في غير المعصية .
فالتمسّك بأدلّة النذر مع الشكّ في أنّ التوضّي بمائع مضاف هل هو طاعة أو غيرها تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية . وأغرب منه : كشف حال الموضوع ; أي إطلاق الماء به .
والعجب من المحقّق الخراساني(31) ; حيث أيّد تلك الدعوى بما ورد من صحّة الإحرام قبل الميقات(32) ، والصوم في السفر إذا تعلّق بهما النذر(33) ، وأضاف إليه شيخنا العلاّمة ـ قدس سره ـ نذر النافلة قبل الفريضة(34) .
ولكنّك خبير : بأنّ الأمثلة غير مربوطة بالدعوى ; لأنّ المدّعى هو التمسّك بالعامّ المخصّص لكشف حال الفرد ، وهي ليست من هذا القبيل ; فإنّ الإحرام قبل الميقات حرام وبعد النذر يصير واجباً ; لدلالة الأدلّة ، وكذا الصوم في السفر . وصيرورة الشيء بالنذر واجباً بدليل خاصّ غير التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد .
التنبيه الخامس: في التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد:
إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص فهل يمكن التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد ، وأنّ حرمة إكرامه لأجل كونه غير عالم ، لا لخروجه عن حكم العلماء مع كونه داخلاً فيهم موضوعاً ؟
ربّما يقال : بجواز التمسّك ، وهو ظاهر كلام الشيخ الأعظم أيضاً في باب الاستنجاء لإثبات طهارة مائه ; متمسّكاً بأصالة عموم كلّ نجس منجّس ، والمفروض أنّ ماء الاستنجاء ليس بمنجّس ، فهو ليس بنجس ، وإلاّ لزم التخصيص(35) .
وربّما يتمسّك به لإثبات أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح بطريق عكس النقيض ، بدعوى أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وأنّ ما لا تنهى عن الفحشاء ليست بصلاة ; لأصالة عموم الدليل(36) .
ولكن الحقّ : عدم صحّته ; لأنّ المتيقّن من حجّية تلك الاُصول وجريانها إنّما هو إذا جعلت عبرة لتشخيص المراد مع الشكّ فيه لا في مثل المقام ، فلو علمنا مراد المتكلّم وعلمنا أنّ زيداً عنده محرّم الإكرام ، وشككنا في أنّ خروجه من العامّ أهو بنحو التخصّص أو التخصيص فلا أصل عند العقلاء لإثباته ، وهذا نظير أصالة الحقيقة الجارية لكشف المراد لا لكشف الوضع بعد العلم بالمراد .
والسرّ فيه : أنّ هذه الاُصول للاحتجاج بين العبيد والموالي ، لا لكشف حال الوضع والاستعمال مطلقاً .
وأمّـا ما قرّره بعض أهل التحقيق ـ مؤيّداً مقالة اُستاذه المحقّق الخراساني(37) ـ من أنّ أصالة العموم وإن كانت حجّة لكنّها غير قابلة لإثبات اللوازم ، ومثبتات هذا الأصل كسائر الاُصول المثبتـة في عدم الحجّية ، مع كونه أمارة في نفسه ، فلا مجال للتمسّك بعكس نقيض القضية الذي يعدّ من لوازم الموجبة الكلّية عقلاً ; لأنّ ذلك اللازم إنّما يترتّب في فرض حجّية أصالة العموم لإثبات لازم المدلول .
ووجه التفكيك بين اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم ; نفياً وإثباتاً ، وإنّما نظره إلى إثبات الكبرى ، كما هو المبنى في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وما نحن فيه أيضاً مبني على هذه الجهة(38) ، انتهى بأدنى تصرّف وتوضيح .
قلت : إنّ عكس النقيض لازم لكون الكبرى حكماً كلّياً ، ولا يلزم أن يكون العامّ ناظراً إلى تعيين الصغرى في لزومه له ، فلو سلّم أنّ أصالة العموم جارية وأنّها كالأمارات بالنسبة إلى لوازمها فلا مجال لإنكار حجّيتها بالنسبة إلى لازمها الذي لا ينفكّ عنها .
فلا يصحّ أن يقال : إنّ العقلاء يحكمون بأنّ كلّ فرد محكوم بحكم العامّ واقعاً ، ومعه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه ، إلاّ أن يلتزم بأ نّها أصل تعبّدي لا أمارة ، وهو خلاف مفروضة .
التنبيه السادس: في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملا:
لو دلّ الدليل على إكرام العلماء ، ودلّ دليل منفصل على عدم وجوب إكرام زيد ، لكنّه تردّد بين زيد العالم والجاهل فالظاهر جواز التمسّك بأصالة العموم هنا ; للفرق الواضـح بين هذا المقام والمقام السابق ; لأنّ الغرض مـن جريانها هناك لأجـل تشخيص كيفيـة الإرادة دون تعيين المراد ، وهاهنا الأمر على العكس ; إذ هـو لأجل تشخيص المراد وكشف أنّ الإرادة الاستعمالية هل هي في زيد العالم مطابقة للجدّ أو لا ؟
وبتقريب آخر : أنّ المجمل المردّد ليس بحجّة بالنسبة إلى العالم ، ولكن العامّ حجّة بلا دافع ، فحينئذ لو كان الخاصّ حكماً إلزامياً ـ كحرمة الإكرام ـ يمكن حلّ إجماله بأصالة العموم ; لأ نّها حاكمة على أنّ زيداً العالم يجب إكرامه ، ولازمه عدم حرمة إكرامه ، ولازم ذلك اللازم : حرمة إكرام زيد الجاهل ، بناءً على حجّية مثبتات الاُصول اللفظية ، فينحلّ بذلك حكماً ، الحجّة الإجمالية التي لولا العامّ يجب بحكم العقل متابعتها ، وعدم جواز إكرام واحد منهما .
وأمّا الشيخ فقد سوّى بين القسمين ; قائلاً بأنّ ديدن العلماء التمسّك بالعامّ في المباحث الفقهية في مثله(39).
___________
1 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 215 .
2 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 215 ، الهامش 1 .
3 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 525 .
4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 171 و 186 و 525 .
5 ـ تقدّم في الصفحة 155 .
6 ـ اُنظر كفاية الاُصول : 258 .
7 ـ مطارح الأنظار : 193 / السطر3 .
8 ـ كفاية الاُصول : 259 .
9 ـ مقالات الاُصول 1 : 443 .
10 ـ مطارح الأنظار : 193 / السطر3 .
11 ـ تشريح الاُصول : 261 / السطر7 .
12 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 216 .
13 ـ تقدّم في الصفحة 159 و 160 .
14 ـ تقدّم في الصفحة 181 .
15 ـ كفاية الاُصول : 259 .
16 ـ نفس المصدر .
17 ـ مطارح الأنظار : 194 / السطر24 .
18 ـ لمحات الاُصول : 323 .
19 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 536 ـ 537 .
20 ـ لمحات الاُصول : 324 ـ 325 .
21 ـ مقالات الاُصول 1 : 444 ـ 445 .
22 ـ سنن الترمذي 2 : 403 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 79 و7 : 249 .
23 ـ الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 .
24 ـ أفاده المحقّق الحائري ـ قدس سره ـ في مجلس درسـه . اُنظر معتمد الاُصـول 1 : 290 ،
تنقيح الاُصول : 2 : 361 .
25 ـ كفاية الاُصول : 261 .
26 ـ أجود التقريرات 1 : 468 ، الهامش .
27 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 47 .
28 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 47 .
29 ـ تقدّم في الصفحة 170 .
30 ـ أجود التقريرات 1 : 466 ، الهامش .
31 ـ كفاية الاُصول : 262 .
32 ـ راجع وسائل الشيعة 11 : 326 ، كتاب الحج ، أبواب المواقيت ، الباب 13 .
33 ـ راجع وسائل الشيعة 10 : 198 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10، الحديث 7 .
34 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 220 .
35 ـ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 346 ، مطارح الأنظار : 196 / السطر12 .
36 ـ كفاية الاُصول : 45 .
37 ـ نفس المصدر : 264 .
38 ـ مقالات الاُصول 1 : 450 ـ 451 .
39 ـ مطارح الأنظار : 196 / السطر14 .



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|