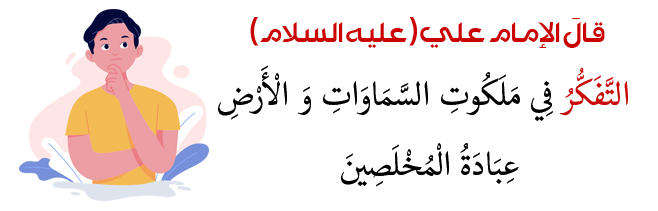
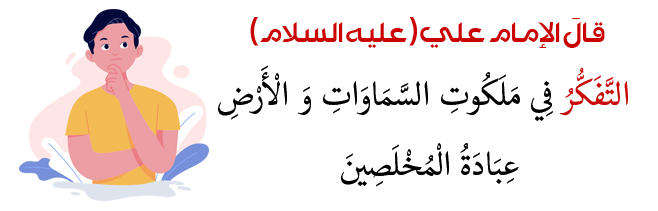

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
التاريخ: 11-6-2020
التاريخ: 16-10-2016
التاريخ: 26-8-2016
|
تعريف المطلق والمقيّد :
عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه والمقيّد بخلافه ، وهذا التعريف وإن اشتهر بين الأعلام(1) إلاّ أ نّه يرد عليه اُمور :
منها : أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ ، مع أنّهما من صفات المعنى ; ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون متقيّدة.
وإن شئت قلت : إنّ الداعي لتعلّق الأحكام بعناوينها هو اشتمالها على مصالح ومفاسد ملزمة أو غير ملزمة ، وهي قد تترتّب على نفس الطبيعة وقد تترتّب على المقيّد بشيء ، فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقاً واُخرى مقيّداً .
بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الإطلاق والتقييد ; إذ الإنسان الأبيض مقيّد والإنسان مطلق ، مع قصر النظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك .
ومنها : أنّ الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ ، كما أنّ الذات جزء آخر ، فالمطلق يدلّ على المعنى والشيوع .
ولكنّه بعيد غايته ، بل غير صحيح ; إذ لا يدلّ أسماء الأجناس على ذات الطبيعة ومفهوم الشيوع . كيف ، والمطلق ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد يمكن تقييده به ، من غير دلالة على الخصوصيات والحالات وغير ذلك .
الثاني : أن يراد من الشيوع كونه لازماً لمعنىً بحسب الواقع ، لا جزء مدلول منه ; فالمطلق دالّ على معنى لكن المعنى في حدّ ذاته شائع في جنسه ; أي مجانسـه وأفراده .
وعليه : يصير المراد مـن الشيوع في الجنس هـو سريانه في أفـراده الذاتية ; حتّى يصدق بوجـه أ نّـه شائـع في مجانسـه ، وإلاّ فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له .
ولكنّه يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور ، مثل إطلاق أفراد العموم في قوله سبحانه : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وكذا الإطلاق في الأعلام الشخصية ، كما في قوله تعالى : {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ، وكذا الإطلاق في المعاني الحرفية ، على أ نّه غير مطّرد لدخول بعض المقيّدات فيه ، كالرقبة المؤمنة ; فإنّه أيضاً شائع في جنسه .
وما عن بعض أهل التحقيق في إدراج الأعلام تحت التعريف المشهور مـن أنّ المـراد سنخ الشيء المحفوظ في ضمن قيود طارئـة ، سواء تحقّق بين وجـودات متعدّدة أو في وجـود محفوظ في ضمن الحالات المتبادلـة(2) ، لا يخلو عن تعسّف بيّن .
فقد ظهر من هذا البيان عدّة اُمور :
الأوّل : أنّ مصبّ الإطلاق أعمّ مـن الطبائع والأعلام الشخصية ، وتجـد الثاني فـي أبواب الحـجّ كثيراً في الطواف على البيت واستلام الحجر والوقـوف بمنى والمشعر .
فما ربّما يقال : من أنّ المطلق هو اللابشرط المقسمي أو القسمي ، ليس بشيء ، وهناك قسم ثالث ; وهو الإطلاق الموجود في ناحية نفس الحكم ، كما تقدّم في باب الواجب المشروط ، وتقدّم أنّ القيود بحسب نفس الأمر تختلف بالذات ، بعضها يرجع إلى الحكم ولا يعقل إرجاعها إلى المتعلّق ، وبعض آخر على العكس(3) ، وعرفت أنّ معاني الحروف قابلة للإطلاق والتقييد(4) ; فمصبّ الإطلاق قد يكون في الطبائع وقد يكون في الأعلام وقد يكون في الأحكام وقد يكون في الأشخاص والأفراد .
الثاني : أنّ الإطلاق والتقييد من الاُمور الإضافية ، فيمكن أن يكون شيء مطلقاً ومقيّداً باعتبارين .
الثالث : أنّ بين الإطلاق والتقييد شبه تقابل العدم والملكة ، فالمطلق ما لا قيد فيه ممّا شأنه أن يتقيّد بذلك ، وما ليس من شأنه التقييد لا يكون مطلقاً ، كما لا يكون مقيّداً . والتعبير بشبه العدم والملكة لأجل أنّ التقابل الحقيقي منه ما إذا كان للشيء قوّة واستعداد يمكن له الخروج عن القوّة إلى مرتبة الفعلية بحصول ما يستعدّ له ، والأمر هنا ليس كذلك .
الرابع : أنّ مفاد الإطلاق غير مفاد العموم ، وأنّه لا يستفاد منه السريان والشيوع ـ ولو بعد جريان مقدّمات الحكمة ـ بل الإطلاق ليس إلاّ الإرسال عن القيد وعدم دخالته وهو غير السريان والشيوع .
بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق :
اسم الجنس وعلمه وغيرهما:
غير خفي على الوفي : أنّ البحث عنهما وعن توضيح الحال في الماهية اللابشرط وأقسامها ومقسمها والفرق بين القسمي والمقسمي أجنبي عن مباحث الإطلاق والتقييد ; خصوصاً على ما عرفت من أنّ الإطلاق دائماً هو الإرسال عن القيد ، وليس المطلق هو الماهية اللابشرط القسمي أو المقسمي ، غير أنّا نقتفي أثر القوم في هذه المباحث ، فنقول :
وأمّا أسماء الأجناس كالإنسان والسواد وأمثالهما ، فالتحقيق : أ نّها موضوعة لنفس الماهيات العارية عن قيد الوجود والعدم وغيرهما ; حتّى التقييد بكونها عارية عن كلّ قيد حقيقي أو اعتباري ; لأنّ الذات في حدّ ذاتها مجرّدة عن كافّة القيود وزوائد الحدود .
نعم ، الماهية بما هي وإن كان لا يمكن تصوّرها وتعقّلها مجرّدة عن كافّة الموجودات لكن يمكن تصوّرها مع الغفلة عن كافّة الوجودات واللواحق ، واللاحظ في بدو لحاظه غافل عن لحاظه ، غير متوجّه إلاّ إلى مراده ومعقوله ; إذ لحاظ هذا اللحاظ البدوي يحتاج إلى لحاظ آخر ، ولا يمكن أن يكون ملحوظاً بهذا اللحاظ . فلا محالة تصير لحاظ الماهية مغفولاً عنه ، وبما أنّ غرض الواضع وهدفه إفادة نفس المعاني يكون الموضوع له نفس الماهية ، لا بما هي موجودة في الذهن .
هذا ، واللفظ موضوع لنفس الماهية بلا لحاظ السريان والشمول ; وإن كانت بنفسها سارية في المصاديق ومتّحدة معها ، لا بمعنى انطباق الماهية الذهنية على الخارج ، بل بمعنى كون نفس الماهية متكثّرة الوجود ، توجد في الخارج بعين وجود الأفراد .
وممّا يقضى منه العجب : ما أفاده بعض الأعيان من المحقّقين في «تعليقته» وملخّص كلامه : إنّه لا منافاة بين كون الماهية في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمي وكون الموضوع له هو ذات المعنى فقط ، فالموضوع له نفس المعنى ، لا المعنى المطلق بما هو مطلق ; وإن وجب لحاظه مطلقاً تسرية للوضع . ومثله قوله : اعتق رقبة ; فإنّ الرقبة وإن لوحظت مرسلة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعه إلاّ أنّ الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة ، لا عتق أيّة رقبة(5) .
وفيه : أنّ الموضوع له إذا كان نفس المعنى لا يعقل سراية الوضع إلى الأفراد ، ويكون لحاظ الواضع لغواً بلا أثر ، إلاّ أن يجعل اللفظ بإزاء الأفراد ، وكذا إذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة لا يعقل سرايته إلى خصوصيات الأفراد ; سواء لاحظ الحاكم أفرادها أم لا . فما أفاده في كلا المقامين منظور فيه .
تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة إنّ من التقسيم الدائر بينهم انقسام الماهية إلى لا بشرط وبشرط شيء وبشرط لا .
ثمّ إنّه اختلف كلمات الأعاظم في تعيين المقسم ، وأنّ الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي ما هو ؟
ويظهر من بعضهم : أنّ المقسم هو نفس الماهية ، وهذه الاعتبارات واردة عليها ، كما يفصح عنه قول الحكيم السبزواري ـ قدس سره ـ (6) ، ومحصّل هذا الوجه : أنّ انقسام النوع والجنس والفصل إلى الثلاثة بالاعتبار ، وكذا افتراق الثلاثة باللحاظ أيضاً ، وأنّ الماهية إذا لوحظت مجرّدة عمّا يلحق بها تكون بشرط لا ، وإذا لوحظت مقترنة بشيء تكون بشرط شيء ، وإذا لوحظت بذاتها لا مقترنة ولا غير مقترنة تكون لا بشرط شيء .
والفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي هـو كون اللابشرطيـة قيداً في الثاني دون الأوّل ، كما هـو الفرق بين الجنس والمادّة والنوع ، فإن لوحـظ الحيوان لا بشرط يكون جنساً ، وإن لوحظ بشرط لا تكون مادّة ، وإن لوحظ بشرط شيء يكون نوعاً .
وقـد اغترّ بظاهـر كلماتهم أعاظم فـنّ الاُصـول ، ووقعوا في حيص وبيص في أقسام الماهيـة ، والفرق بين المقسمي والقسمي ; حتّى ذهب بعضهم إلى أنّ التقسيم للحاظ الماهية لا لنفسها(7) .
هذا ، لكن حسن ظنّي بأهل الفنّ في هذه المباحث يمنعني أن أقول : إنّ ظاهـر هـذه الكلمات مرادة لهم ، وأنّهم اقترحـوا هـذا التقسيم ومـا شابهه في مباحث الجنس والفصل ، من غير نظر إلى عالم الخـارج ونظام الكون ، وكأنّ غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم والاعتبارات الذهنية ، من دون أن يكون لهذه الأقسام محكيات في الخارج .
أضف إلى ذلك : أنّ ملاك صحّة الحمل وعدم صحّتها عندهم هو كون الشيء المحمول لا بشرط وبشرط لا ، ولو كان هذا الملاك أمراً اعتبارياً لزم كون اعتبار شيء لا بشرط مؤثّراً في الواقع، ويجعل الشيء أمراً قابلاً للاتّحاد والحمل ، ولزم من اعتباره دفعة اُخرى بشرط لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه .
والحاصل : أ نّه يلزم من اعتبار شخص واحد شيئاً واحداً على نحوين اختلاف نفس الواقع ، كما يلزم من اعتبار أشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفاً بحسب اختلاف اعتبارهم ، فتكون ماهية واحدة متّحدة مع شيء ولا متّحدة معه بعينه .
هذا ، مع أنّ الغرض من هذه التقسيمات وكذا الحمل هو حكاية الواقع ونفس الأمر لا التلاعب بالمفاهيم واختراع اُمور ذهنية .
ومن ذلك يظهر : ضعف ما ربّما يقال من أنّ المقسم ليس هو نفس الماهية ، بل لحاظ الماهية أو الماهية الملحوظة(8) . ويقرب عنه ما أفاده بعض الأعيان في تعليقته الشريفة ، فراجع(9) .
وليت شعري أيّ فائدة في تقسيم لحاظ اللاحظ ، ثمّ أيّ ربط بين تقسيمه وصيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل وعدمها .
والذي يقتضيه النظر الدقيق ـ ولعلّه مراد القوم ـ هو أنّ كلّ المباحث المعنونـة في أبواب الماهية من المعقولات الثانية إنّما هي بلحاظ نفس الأمر ، وأنّ الماهية بحسب واقعها ـ الأعمّ من حدّ الذات أو مرتبة وجودها ـ لها حالات ثلاثـة ، لا تتخلّف عن واقعها ولا يرجع قسم منها إلى قسم آخر ; وإن لوحظ على خلاف واقعه ألف مرّات ; حتّى أنّ الاختلاف الواقع بين المادّة والجنس والنوع واقعي ، لا اعتباري .
أمّا انقسام الماهية بحسب نفس الأمر إلى أقسام ثلاثـة : فلأنّها إذا قيست إلى أيّ شيء :
فإمّا أن يكون ذلك الشيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها ، كالتحيّز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، وهذه هي الماهية بشرط شيء .
وإمّا أن يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها ، كالتجرّد عـن المكان والزمـان بالنسبة إلى الجسم ، والفرديـة إلى الأربعـة ، وهـذه هي الماهية بشرط لا .
وإمّا أن يكون ممكن الالتحاق ، كالوجود بالنسبة إلى الماهية ، والبياض إلى الجسم الخارجي ، فهذه هي الماهية اللابشرط .
فالماهية بحسب نفس الأمر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام ، ولا يتخلّف عمّا هو عليه بورود الاعتبار على خلافه . وبهذا يخرج الأقسام عن التداخل ; إذ لكلّ واحد حدّ معيّن لا ينقلب عنه إلى الآخر . ويتّضح الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي ; لأنّ المقسم نفس ذات الماهية ، وهي موجودة في جميع الأقسام ، واللابشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر ومضادّ لهما .
والحاصل : أنّ مناط صحّـة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر ; فالماهية إن امتنع تخلّفها عن مقارنها في واحد من مراتب الواقع فهي بالنسبة إليه بشرط شيء ، وإن امتنع لها الاتّصاف به فهي بالنسبة إليه بشرط لا ، وإن كان له قابلية الاتّصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهي بالنسبة إليه لا بشرط ، كالأمثلة المتقدّمة .
وما ذكرنا وإن لم أر التصريح به ، بل مخالف لظواهر كلماتهم ، إلاّ أ نّه تقسيم صحيح دائر في العلوم ، لا يرد عليه ما أوردناه على ظواهر أقوالهم .
نعم ، هذا التقسيم إنّما هو للماهية بحسب نفسها ، ولكن يمكن أن يجري في الماهية الموجودة ، بل يمكن إجراؤه في نفس وجودها ، وقد أجراه بعض أهل الذوق في بعض العلوم في حقيقة الوجود(10) ، ولا يقف على مغزاه إلاّ من له قدم راسخ في المعارف الإلهية .
وأمّا كون الاختلاف بين المادّة والجنس والنوع أمراً واقعياً : فتفصيله وإن كان موكولاً إلى محلّه وأهله إلاّ أنّ مجمله ما يلي ; وهو أنّ تقسيم الماهية إلى الأجناس والفصول بلحاظ الواقع ونفس الأمر ، وأنّ الاختلاف بين المادّة والجنس والنوع واقعي ، والمادّة متّحدة مع الصورة التي تبدّلت إليها ، والتركيب بينهما اتّحادي ، وتكون المادّة المتّحدة بالصورة ، والصورة المتّحدة معها نوعاً من الأنواع ، والمادّة التي قابلة لصورة اُخرى تكون منضمّة إلى الصورة الموجودة ، والتركيب بينهما انضمامي لا اتّحادي .
وتكون تلك المادّة بالنسبة إلى الصورة المتحقّقة بشرط لا ; لعدم إمكان اتّحادها بها ، وبالنسبة إلى الصورة التي تستعدّ لتبدّلها إليها لا بشرط شيء ; لإمكان تبدّلها بها .
مثلاً : المادّة التي تبدّلت بصورة النواة وصارت فعليتها متّحدة معها تركيبهما اتّحادي ، بل إطلاق الاتّحاد أيضاً باعتبار ظرف التحليل والتكثّر ، وإلاّ فبعد صيرورة القوّة النواتية فعلية لا تكون في الخارج إلاّ فعليتها ، والقوّة ليست بحدّها موجودة فيها ، وإن كانت الفعلية واجدة لها وجدان كلّ كمال للضعيف .
والمادّة المستعدّة في النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمّة إلى الصورة النواتية وتركيبهما انضمامي لا اتّحادي ، وتكون لا بشرط بالنسبة إلى الصورة الشجرية ; لإمكان اتّحادها بهما ، وبشرط لا بالنسبة إلى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحقّقة ; لعدم إمكان اتّحادها معها .
فتحصّل : أنّ في النواة مادّة متّحدة ومادّة منضمّة ، ومأخذ الجنس والفصل والنوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الأمر ، فلا يكون شيء من اعتبارات الماهية لا في باب الأجناس والفصول والموادّ والصور ، ولا في باب الأقسام الثلاثة لها ; اعتباراً جزافاً وتلاعباً محضاً .
هذا، ولكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقارّه وعند أهله . وقد مرّ ما ينفعك في المقام في بحث المشتقّ(11) .
البحث في علم الجنس وهو كـ «اُسامة» و«ثعالة» ، فلا إشكال في أ نّه يعامل معه معاملة المعرفة ، فيقع مبتدأ وذا حال ويوصف بالمعرفة .
والمنقول هنا في إجراء أحكام المعرفة عليه وجهان :
الأوّل : أنّ تعريفه تعريف لفظي ، كالتأنيث اللفظي ، ومفاده عين مفاد اسم الجنس بلا فرق بينهما .
الثاني : أنّه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متصوّرة ومتعيّنة بالتعيّن الذهني .
وأورد عليه المحقّق الخراساني : من أ نّه يمتنع حينئذ أن ينطبق على الخارج ويحتاج إلى التجريد عند الاستعمال ويصير الوضع لغواً(12) .
وأجاب عنه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ بأنّ اللحاظ حرفي لا اسمي ، وهو لا يوجب امتناع انطباقه على الخارج(13) .
وفيه : أنّ كون اللحاظ حرفياً لا يخرجه عن كون موطنه هو الذهن ، فلا محالة يتقيّد الطبيعة بأمر ذهني وإن كان مرآة للخارج ، ولكن ما ينطبق على الخارج هو نفس الطبيعة لا المتقيّدة بأمر ذهني .
وكون اللحاظ مرآتياً ليس معناه عدم تقيّدها به أو كون وجوده كعدمه ; إذ بأيّ معنى فسّر هذا اللحاظ فلا محالة يكون علم الجنس متقوّماً به حتّى يفترق عن اسمه ، والمتقوّم بأمر ذهني لا ينطبق على الخارج .
ويمكن أن يقال : إنّ الماهية في حدّ ذاتها لا معرفة ولا نكرة ، لا متميّزة ولا غير متميّزة ، بل تعدّ هـذه مـن عوارضها كالوجـود والعدم ; لأنّ التعريف في مقابل التنكير عبارة عن التعيّن الواقعي المناسب لوعائه ، والتنكير عبارة عن اللاتعيّن كذلك .
على أنّ واحداً من التعريف والتنكير لو كان عين الطبيعة أو جزئها يمتنع عروض الآخر عليها. فحينئذ لا بأس بأن يقال : إنّ اسم الجنس موضوعة لنفس الماهية التي ليست معرفة ولا نكرة ، وعلم الجنس موضوع للماهية المتعيّنة بالتعيّن العارض لها ; متأخّراً عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها .
وبالجملة : اسم الجنس موضوع لنفس الماهية ، وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متميّزة من عند نفسها بين المفاهيم ، وليس هذا التميّز والتعيّن متقوّماً باللحاظ ، بل بعض المعاني بحسب الواقع معروف معيّن ، وبعضها منكور غير معيّن .
وليس المراد من التعيّن هو التشخّص الذي يساوق الوجود ; حتّى يصير كالأعلام الشخصية ، بل المراد منه التعيّن المقابل للنكارة . فنفس طبيعة الرجل لا تكون نكرة ولا معرفة ، فكما أنّ النكارة واللاتعيّن تعرضها ، كذلك التعريف والتعيّن ; فالتعريف المقابل للتنكير غير التشخّص .
فظهر : أنّ الماهية بذاتها لا معروف ولا منكور ، وبما أ نّها معنى معيّن بين سائر المعاني وطبيعة معلومة في مقابل غير المعيّن معرفة .
فـ «اُسامة» موضوعة لهذه المرتبة ، واسم الجنس لمرتبة ذاتها ، وتنوين التنكير يفيد نكارتها ، واللاتعيّن ملحق بها كالتعيّن .
ثمّ الظاهر : أنّ اللام وضعت مطلقاً للتعريف ، وأنّ إفادة العهد وغيره بدالّ آخر ، فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وأفادت الاستغراق ; لأنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّناً ، والتعريف هو التعيين ، وهو حاصل مع استغراق الأفراد لا غير .
وما ذكرنا في عَلم الجنس غير بعيد عـن الصواب ; وإن لم يقم دليل على كونـه كذلك ، لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عـن الأذهان .
الكلام في النكرة :
فالظاهر : أنّها دالّة بحكم التبادر على الطبيعة اللامعيّنة ـ أي المتقيّدة بالوحدة بالحمل الشائع ـ لكن بتعدّد الدالّ ; فالمدخول دالّ على الطبيعة والتنوين على الوحدة . وعليه فهي كلّي قابل للصدق على الكثيرين ; سواء وقع في مورد الإخبار ، نحو «جاءني رجل» أم في مورد الإنشاء ، نحو «جئني برجل» .
وما يقال : من أنّ الأوّل جزئي ; لأنّ نسبة المجيء إليه قرينة على تعيّنه في الواقع ; ضرورة امتناع صدور المجيء عن الرجل الكلّي(14) ، غير تامّ ; لأنّ المتعيّن الذي يستفاد عن القرينة الخارجية ـ كما في المقام ـ لا يخرج النكرة عن الكلّية .
ومن هنا يظهر النظر في كلمات شيخنا العلاّمة ، أعلى الله مقامه(15) .
مقدّمات الحكمة:
قد عرفت : أنّ الإطلاق في مقام الإثبات عبارة عن كون الشيء تمام الموضوع للحكم إذا كان مصبّ الإطلاق نفس المتعلّق أو الموضوع ، أو كون الحكم مرسلاً عن القيد إذا كان مصبّه نفس الحكم .
وعلى أيّ حال : لا يحتاج إلى لحاظ السريان والشياع ; إذ فيه ـ مضافاً إلى أ نّه أمر غير مفيد في حكاية الطبيعة عن الأفراد كما مرّ(16) ـ أ نّه لا وجه لهذا اللحاظ ، بل الإطلاق ينعقد بدونه، ويتمّ الحجّة ; وإن لم يكن المقنّن لاحظاً سريانه .
فلا مجـال لما أفاده المحقّق الخـراساني مـن أنّ مقـدّمات الحكمـة تثبت الشياع والسريان(17) .
وما ربّما يتوهّم : من لزوم لحاظ حالات الطبيعة بمعنى ثبوت الحكم عند كلّ حالة وحالة ; لامتناع الإهمال الثبوتي ، مدفوع بما حقّقناه في مبحث الترتّب ، فراجع .
والأولى : صرف عنان البحث إلى مقدّمات الحكمة المعروفة ; وهي ثلاثة نبحث عن كلّ واحدة مستقلاًّ .
الاُولى : إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد ، والظاهر لزوم وجود هذه المقدّمة في الإطلاق ; ضرورة أنّ الدواعي لإلقاء الحكم مختلفة ; فربّما يكون الداعي هو الإعلان بأصل وجوده مع إهمال وإجمال ، فهو حينئذ بصدد بيان بعض المراد ، ومعه كيف يحتجّ به على المراد ؟ وربّما يكون بصدد بيان حكم آخر .
وعليه : لابدّ من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها ومحطّ وروده وأنّه في صدد بيان أيّ خصوصية منها ; فربّما يساق الكلام لبيان إحدى الخصوصيات دون الجهات الاُخر ، فلابدّ من الاقتصار في أخذ الإطلاق على المورد الذي أحرزنا وروده مورد البيان ، ولذلك يجب إعمال الدقّة في تشخيص مورد البيان .
هذا ، وقد خالف في لزوم هذه المقدّمة شيخنا العلاّمة ـ قدس سره ـ ; حيث ذهب إلى عدم لزوم إحراز كونه في مقام بيان مراده ; مستدلاًّ بأنّه لو كان المراد هو المقيّد تكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وإنّما ينسب إلى الطبيعة بالتبع . وظاهر قول القائل «جئني برجل» هو أنّ الإرادة متعلّقة بالطبيعة أوّلاً وبالذات ، وليس المراد هو المقيّد(18) ، انتهى .
وفيه : أنّه غير تامّ ; لأنّ ما ذكره من ظهور الإرادة في الأصلية لا التبعية مستفاد من هذه المقدّمة ; إذ لولاها فما الدليل على أنّ المقيّد غير مراد ، وأنّ المراد بالأصالة الطبيعة ; إذ يحتمل لولا هذه المقدّمة أنّ هنا قيداً لم يذكره المولى . فإحراز كون الطبيعة وارداً مورد الإرادة بالأصالة فرع إحراز كونه في مقام البيان دون الإهمال والإجمال ; لأنّ هذا ليس ظهوراً لفظياً مستنداً إلى الوضع ، بل هو حكم عقلائي بأنّ ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا بعضه ، ولا يحكم العقلاء به ولا يتمّ الحجّة إلاّ بعد تمامية هذه المقدّمة ; فيحتجّ العقلاء عليه بأنّ المتكلّم كان في مقام البيان ، فلو كان شيء دخيلاً في موضوعيته له كان عليه البيان . فجعل هذا موضوعاً فقط يكشف عن تماميته .
المقدّمة الثانية : وهي عدم وجود قرينة معيّنة للمراد ، ولا يخفى أ نّها محقّقة لمحلّ البحث ; لأنّ التمسّك بالإطلاق عند طريان الشكّ ، وهو مع وجود ما يوجب التعيين مرتفع ، فلو كان في المقام انصراف أو قرينة لفظية أو غيرها فالإطلاق معدوم فيه بموضوعه .
وبالجملة : فهي محقّقة لموضوع الإطلاق ، لا من شرائطه ومقدّماته .
المقدّمة الثالثة : عدم وجود قدر متيقّن في البين حتّى يصحّ اتّكال المولى عليه .
والظاهر : أنّ هذه المقدّمة غير محتاجة ; سواء فسّرنا الإطلاق بما تقدّم ذكره أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة مرآة لجميع أفرادها :
أمّا على المختار : لأنّ القدر المتيقّن إنّما يضرّ في مورد يتردّد الأمـر بين الأقلّ والأكثر ; بأن يتردّد بين تعلّق الحكم ببعض الأفراد أو جميعها ، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق ليس كذلك ، بل هو دائر بين تعلّق الحكم بنفس الموضوع مـن غير دخالة شيء آخر فيه ، أو بالمقيّد . فيدور الأمر بين كون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيّد تمامه .
فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلاً ، ومع دخالته يكون الموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد ، ولا يكون ذات الموضوع محكوماً والقيد محكوماً آخر حتّى يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، وكذا لو جعل المتقيّد موضوعاً وشكّ في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما . فلا يدور الأمر بين الأقلّ والأكثر في شيء من الموارد حتّى يعتبر انتفاء القدر المتيقّن .
هذا كلّه على المختار في باب الإطلاق ; من عدم كون الطبيعة مرآة للأفراد ، ولا وسيلة إلى لحاظ الخصوصيات وحالاتها وعوارضها .
وأمّا إذا قلنا بمقالة المشهور ; من جعلها مرسلة ومرآة لجميع الأفراد ، والمقيّد عبارة عن جعلها مرآة لبعضها فلاعتبار انتفائه من المقدّمات وجه .
ولكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال ، وتوضيحه : أنّ مبنى الإطلاق ـ لو كان ـ هو لحاظها مرآة للكثرات ، فلا معنى لجعلها مرآة لبعض دون بعض مع كون جميع الأفراد متساوية الأقدام في الفردية ، وعدم قيام دليل صالح لقصر المرآتية على المتيقّن غير الانصراف القطعي . فلو فرضنا سبق السؤال عن المعاطاة قبل الجواب : بأنّ الله أحلّ البيع لما يضرّ هذا المتيقّن بالإطلاق .
وبالجملة : كونها مرآة لبعضها لا يصحّ إلاّ مع القيد ، وإلاّ فيحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق لا المتقيّدة ; ولهذا ترى أنّ العرف والعقلاء لا يعتنون بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب وغيره ما لم يصل إلى حدّ الانصراف ، فتدبّر .
إشكال ودفع :
ربّما يتوهّم : أنّ ورود القيد على المطلق بعد برهة من الزمن يكشف عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان ، وانخرام هذه المقدّمة ـ التي قد عرفت أ نّها روح الإطلاق ـ يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيهما .
والجواب : أنّ المطلق كالعامّ مستعمل في معناه الموضوع له لأجل ضرب القانون وإعطاء الحجّة ، والأصل هو التطابق بين الإرادتين .
فكما أنّ خروج فرد من حكم العامّ بحسب الجدّ لا يوجب بطلان حجّية العامّ في البواقي فهكذا باب المطلق بحسب القيود ; لأنّ جعل الطبيعة في مقام البيان موضوعاً لحكمه إعطاء حجّة على العبد عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه ، لأجل أصالة التطابق بين الإرادتين .
فحينئذ : لو عثرنا على قيد لا يوجب ذلك سقوطه عن الحجّية ، وكون الكلام وارداً مورد الإجمال والإهمال بالنسبة إلى سائر القيود ; ولذلك ترى العقلاء يتمسّكون بالإطلاق ; وإن ظفروا على قيد بعد برهة من الزمن ، وإنّما العثور على القيد يوجب انتهاء أمد حجّية الإطلاق بالنسبة إلى نفي القيد المعثور عليه ، لا جميع القيود المشكوك فيها .
حلّ عقدة :
ربّما يقال : إنّ التمسّك بالإطلاق في نفي دخالة القيود إنّما يصحّ إذا وقع المطلق في كلام من عادتـه إلحاق قيود الكلام بأصوله ، كمـا هو الحـال في الموالي العرفية ، وأمّا المطلقات الواردة في محاورات من استقرّت عادته على تفريق اللواحق عن الاُصول وتفكيك المطلق عن مقيّده فساقطة عن مظانّ الاطمئنان ; لأنّا علمنا أنّ دأب قائله جار على حذف ما له دخالة في موضوع الحكم عن مقام البيان .
والجواب : أنّ ما ذكره لا يوجب إلاّ عدم جواز التمسّك بالإطلاق قبل الفحص عن مقيّده ، وأمّا التمسّك به بعد الفحص بمقدار لازم فلا يمنع عنه هذا الدليل .
تتميم : في الأصل عند الشكّ في مقام البيان:
لا شكّ : أنّ الأصل في الكلام كون المتكلّم في مقام بيان كلّ ما له دخل في حكمه بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم ، وعليه جرت سيرة العقلاء في المحاجّات . نعم لو شكّ أ نّه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر فلا أصل هنا لإحراز كونه في مقام بيان هذا الحكم .
والحاصل : أنّ الأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم هو أ نّه بصدد بيان كلّ ما له دخالة في موضوع حكمه ، في مقابل الإجمال والإهمال ، وأمّا كونه بصدد بيان هذا الحكم أو غيره فلا أصل فيه ، بل لابدّ أن يحرز وجداناً أو بدليل آخر ، كشواهد الحال وكيفية الجواب والسؤال .
حمل المطلق على المقيّد : الصور المتصوّرة في ورود المطلق والمقيّد :
إذا ورد مطلق ومقيّد : فإمّا أن يكونا متكفّلين للحكم التكليفي أو الوضعي .
وعلى التقديـرين : فإمّـا أن يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين .
وعلى التقادير : فإمّـا أن يعلم وحـدة التكليف أو لا .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم وحدتـه مـن الخارج أو مـن نفس الـدليلين .
وعلى التقادير : فإمّـا أن يـذكر السبب فيهما أو في واحـد منهما أو لا يـذكر .
وعلى الأوّل : فإمّـا أن يكون السبب واحـداً أو لا .
ثمّ الحكم التكليفي إمّا إلزامي في الـدليلين أو غير إلـزامي فيهما أو مختلف .
وعلى التقادير : قـد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلّقـه وموضوعـه وقد يكونان في اثنين منها وقـد يكونان في واحد منها .
فهذه جملـة الصور المتصوّرة في المقام .
تحرير محطّ البحث :
وقبل الشروع في أحكام الصور نشير إلى نكتة : وهو أنّ محطّ البحث في الإطلاق والتقييد وحمل أحدهما على الآخر إنّما هو فيما إذا ورد المقيّد منفصلاً عن مطلقه ، وأمّا المتّصلين فلا مجال للبحث فيهما ; لأنّ القيد المتّصل يمنع عن انعقاد الإطلاق حتّى يكون من باب تعارض المطلق والمقيّد ; لما عرفت أنّ عدم القرينة من محقّقات موضوع الإطلاق(19) .
وبما ذكرنا : يظهر الخلط في كلام بعض الأعاظم ; حيث عمّم البحث إلى الوصف والحال ، وقال : إنّ ملحقات الكلام كلّها قرينة حاكمة على أصالة الظهور في المطلق ، وقاس المتّصلين بالقرينة وذي القرينة في أنّ ظهور القرينة حاكمة على ذي القرينة ، ثمّ قاس المقيّد المنفصل بالمتّصل(20) .
قلت وفيه أ مّا أوّلاً : فلأنّ باب الإطلاق ليس باب الظهور اللفظي حتّى يقع التعارض بين الظهورين أو يقدّم ظهور المقيّد على ظهور المطلق بالحكومة ، بل الإطلاق دلالة عقلية ، والحكومة ـ كما سيوافيك بإذنه تعالى ـ من حالات لسان الدليل بأن يتعرّض لحال دلالة الدليل الآخر(21) .
وثانياً : فإنّ حكومـة ظهور القرينة على ذي القرينـة ممّا لا أساس لها ; ضرورة أنّ الشكّ في ذي القرينة لا يكون ناشئاً من الشكّ في القرينة ; إذ في قوله :
«رأيت أسداً يرمي» لا يكون الشكّ في المراد من الأسد ناشئاً من الشكّ في المراد من يرمي ، كما ادّعى القائل ، بل الشكّان متلازمان ، فلا حكومة بينهما .
وثالثاً : فإنّ قياس المقيّد المنفصل بالمتّصل ممّا لا وجه له ; إذ القياس مع الفارق ; لأنّ الإطلاق ينعقد مع انفصال القيد إذا اُحرز كونه في مقام البيان ، وأمّا القيد المتّصل فهو رافع لموضوع الإطلاق ، فلا يقاس متّصله بمنفصله .
وأمّا وجه التقديم في المنفصلين فليس لأجل الحكومة ، بل المطلق إنّما يكون حجّة إن لم يرد من المتكلّم بيان ، وبعد ورود البيان ينتهي أمد الحجّية لدى العقلاء .
وإن شئت قلت : ظهور القيد في الدخالة أقوى من المطلق في الإطلاق ، وهذه الأظهرية ليست لفظية بل أمراً يرجع إلى فعل المتكلّم إذا جعل شيئاً موضوعاً ثمّ أتى بقيد منفصل ، كما أنّ تقديم ظهور القرينة على ذي القرينة للأظهرية أو مناسبات المقام لا للحكومة ، وسيوافيك حقيقة القول في هذه المباحث في التعادل والترجيح(22) ، فتربّص حتّى حين .
إذا عـرفت ذلك : فنشرع في بيان مهمّات الصور وأحكـامها حتّى يتّضـح حال غيرها :
أحكام الصور المهمّة في المسألة :
الصورة الاُولى : ما إذا كانا مختلفين بالنفي والإثبات وكان الحكم تكليفياً ، وهي على قسمين :
الأوّل : ما إذا كان المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً ، نحو قولك : «لا تعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة» بناءً على أنّ قولـه : «لا تعتق رقبـة» مـن قبيل المطلق لا العامّ ،كما هو المختار . فلا ريب في حمله على المقيّد ; لتحقّق التنافي بينهما عرفاً ; وذلك لما عرفت أنّ ترك الطبيعة إنّما يحصل عند العرف بترك جميع أفرادها ; وإن كان النظر الدقيق الفلسفي يقتضي خلافه ، كما مرّ(23).
وعليه : فالتنافي بين حرمة مطلق الرقبة أو كراهتها ، وبين وجوب المؤمنة منها أو استحبابها ظاهر جدّاً ، والجمع العقلائي إنّما هو حمل مطلقها على مقيّدها .
الثاني : عكس القسم الأوّل ; أي يكون المطلق مثبتاً ومتعلّقاً للأمر والمقيّد نافياً ومتعلّقاً للنهي .
فحينئذ : تارة نعلم أنّ النهي تحريمي أو نعلم أ نّه تنزيهي ، واُخرى لا نعلم . فلو علمنا كون النهي تحريمياً فلا ريب في حمله على المقيّد ; لكونه طريقاً وحيداً إلى الجمع في نظر العرف . ولو علمنا أنّ النهي تنزيهي فهل يحمل على المقيّد أو لا ؟ وجهان : أقواهما عدمه ; لأنّ الموجب للحمل هو تحقّق التنافي في أنظار العرف حتّى نحتال في علاجهما ، ومع إحراز كون النهي تنزيهياً ـ أي مرخّصاً في إتيان متعلّقه ـ فلا وجه لتوهّم التنافي ، بل غاية الأمر يكون النهي إرشاداً إلى أرجحية الغير أو مرجوحية متعلّقه بالإضافة إلى فرد آخر .
فلو قال : «صلّ ولا تصلّ في الحمّام» وفرضنا أنّ النهي تنزيهي فلا شكّ أنّ مفاد الثاني هو ترخيص إتيانها فيه ، وأ نّه راجح ذاتاً وصحيح لمكان الترخيص ، لكنّه مرجوح بالإضافة إلى سائر الأفراد ، ولا يلزم من ذلك اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد ; لما عرفت أنّ المرجوحية لأجل قياسها إلى سائر الأفراد وفي المكان الخاصّ ، لا في حدّ ذاته .
وبذلك يظهر النظر فيما أفاده شيخنا العلاّمة ، أعلى الله مقامه ، فراجع(24) .
وأمّا إذا كان كيفية دلالته مجهولة ولم نعلم أ نّه للتنزيه أو للتحريم فللتوقّف فيه مجال ; فإنّ كلّ واحد يصلح أن يقع بياناً للآخر ; إذ النهي كما يمكن أن يكون بياناً لإطلاق المطلق ويقيّد متعلّق الأمر بمقتضى النهي ، كذلك يصلح أن يكون المطلق بياناً للمراد من النهي ، وأنّه تنزيهي .
والحاصل : أنّ الأمر دائر بين حمل النهي على الكراهة وحفظ الإطلاق ، وبين رفع اليد عن الإطلاق وحمله على المقيّد .
هذا ، ولكن الأظهر هو حمل المطلق على المقيّد وإبقاء النهي على ظهوره ; لأنّ التنافي كما هو عرفي كذلك الجمع عرفي أيضاً ، ولا شكّ أنّ لحاظ محيط التشريع يوجب الاستئناس والانتقال إلى كونهما من باب المطلق والمقيّد ; لشيوع ذلك الجمع وتعارفه بينهم .
وأمّا جعل المطلق بياناً للنهي وأنّ المراد منه هو الكراهة فهو جمع عقلي لا يختلج بباله ; لعدم معهودية هذا التصرّف .
ويمكن أن يقال : إنّ الهيئات بما هي معان حرفية لا يلتفت إليها الذهن حين التفاته إلى المطلق والمقيّد والجمع بينهما . وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة .
وأمّا ما ربّما يقال في ترجيح ما اخترناه : من أنّ ظهور النهي في التحريم وضعي مقدّم على الظهور الإطلاقي ، غير تامّ ; لما عرفت(25) أنّ الوجوب والتحريم خارجان عن الموضوع له ، وأنّ الهيئة لم توضع فيهما إلاّ للبعث والزجر ، فأين الظهور اللفظي ؟ !
فإن قلت : إنّ هنا وجهاً آخر للجمع بينهما ، وقد أشار إليه بعض الأعاظم ، وجعل المقام من باب اجتماع الأمر والنهي(26) ـ على القول بكون المطلق والمقيّد داخلين في ذاك الباب ـ فلو قلنا بالجواز هناك يرفع التعارض بين المطلق والمقيّد .
قلت : الفرق بين المقامين واضح ; فإنّ التعارض هنا عرفي كجمعه ، والتعارض هناك عقلي ، وجمعه أيضاً كذلك .
والحاصل : أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية غير مربوطة بالجمع بين الأدلّة ; لأنّ مناط الجمع بينها هو فهم العرف ، ولا شبهة في وقوع التعارض بين المطلق والمقيّد عرفاً ، وطريق الجمع عرفي لا عقلي ، فلا يكون أحد وجوه الجمع بين الأدلّة الجمع العقلي ، وهذا واضح .
الصورة الثانية : ما إذا كان الدليلان مثبتين إلزاميين ، نحو قولك : «اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة» فحينئذ إذا اُحرزت وحدة الحكم فلا محيص عن الحمل ; لإحراز التنافي بإحراز وحدة الحكم ، ووجود الجمع العرفي .
نعم ، إذا كانت وحدة الحكم غير محـرزة : فتارة يحـرز كـون الحكم في المطلق على نفس الطبيعة ، ولا نحتمل دخالـة قيد آخـر في الموضوع ، غير القيد الذي في دليل المقيّد ، واُخرى : نحتمل دخالة قيد آخر .
فعلى الأوّل : يحمل المطلق على المقيّد ، لا لما ربّما يتراءى في بعض الكلمات من أنّ إحراز التنافي لأجل أنّ الحكم في المقيّد إذا كان إلزامياً متعلّقاً بصرف الوجود فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق ، ومفاد دليل المطلق هو الترخيص بعتقه . وبعبارة اُخرى : أنّ مفاد دليل المقيّد دخالة القيد في الحكم ومفاد دليل المطلق عدم دخالته ، فيقع التنافي بينهما(27) ، انتهى .
لأنّ التنافي بين الترخيص واللاترخيص ودخالة القيد ولا دخالته فرع كون الحكم في المقام واحداً ، فلو توقّف إحراز وحدته عليه لدار .
بل وجه التقديم هو أنّ ملاحظة محيط التشريع وورود الدليلين في طريق التقنين توجب الاطمئنان بكونهما من هذا القبيل ; خصوصاً مع تكرّر تقييد المطلقات من الشارع . نعم ، الأمر في المستحبّات على العكس ; فإنّ الغالب فيها كون المطلوب متعدّداً وذا مراتب .
وهناك وجه آخر ; وهو أنّ إحراز عدم دخالة قيد آخر غير هذا القيد عين إحراز الوحدة عقلاً ; لامتناع تعلّق الإرادتين على المطلق والمقيّد ; لأنّ المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد عينية اللابشرط مع بشرط شيء ، فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع ، فيقع التنافي بينهما ، فيحمل المطلق على المقيّد ، ولا ينافي ذلك ما مرّ من أنّ ميزان الجمع بين الأدلّة هو العرف ; لأنّ إحراز وحدة الحكم إنّما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين ، والفرق بينهما ظاهر .
وأمّا على الثاني ـ أي ما لم نحـرز عـدم دخالـة قيد آخـر ـ فيدور الأمر بين حمل المطلق على المقيّد ورفع اليد عن ظهور الأمر في استقلال البعث ، وبين حفظ ظهور الأمر وكشف قيد آخـر في المطلق ; حتّى يجعلـه قابلاً لتعلّق حكم مستقلّ به .
هذا ، ولكن الصحيح هو الأوّل لضعف ظهور الأمر في الاستقلال ، ولا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد آخر .
نعم ، لو اُحرز تعدّد الحكم واستقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد آخر ; لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق والمقيّد ، وقد تقدّم شرحه في مبحث النواهي .
الصورة الثالثة : ما إذا كان الدليلان نافيين ، كقوله : «لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر» ، ولا ريب في عدم حمل مطلقه على المقيّد ; لعدم التنافي بينهما عرفاً ـ على القول بعدم المفهوم ـ والحجّة لا يرفع اليد عنها إلاّ بحجّة مثلها ، ولكن يمكن أن يقال بأ نّه يأتي فيها ما ذكرناه في الصورة السابقة ، فتدبّر .
هذه الصور تشترك في أنّ الوارد إلينا ذات المطلق والمقيّد بلا ذكر سبب .
وأمّا إذا كان السبب مذكوراً فلا يخلو :
إمّا أن يذكر في واحد منهما أو كليهما ، وعلى الثاني : إمّا أن يتّحد السببان ماهية أو يختلفا كذلك، وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما : إمّا إيجابي أو غير إيجابي أو مختلف .
فهنا صور نشير إلى مهمّاتها :
منها : ما إذا كان السبب مذكوراً في كلا الدليلين ، وكان سبب كلّ غير سبب الآخر ماهية ، نحو قوله : «إن ظاهرت أعتق رقبة» ، و«إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» ، فلا شكّ أ نّه لا يحمل; لعدم التنافي بينهما ; لإمكان وجوب عتق مطلق الرقبة لأجل سبب ووجوب مقيّدها لأجل سبب آخر .
نعم لو أعتق رقبة مؤمنة ففي كفايتها عنهما أو عدم كفايتها كلام مرّ تحقيقه في مباحث تداخل المسبّبات والأسباب .
ومنها : ما إذا ذكر السبب في كلّ واحد أيضاً ، ولكن سبب المطلق عين سبب المقيّد ماهية فيحمل ; لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة مسبّبه .
ومنها : ما إذا كان السبب مذكوراً في واحد منهما ، فالتحقيق عدم الحمل . وعلّله بعض الأعاظم بأنّ الحمل يستلزم الدور ; لأنّ حمل المطلق على المقيّد يتوقّف على وحدة الحكم ، ففي المثال تقييد الوجوب يتوقّف على وحدة المتعلّق ; إذ مع تعدّدهما لا موجب للتقييد ، ووحدة المتعلّق تتوقّف على حمل أحد التكليفين على الآخر ; إذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقّق وحدة المتعلّق ; لأنّ أحد المتعلّقين عتق الرقبة المطلقة ، والآخر عتق الرقبة المؤمنة(28) ، انتهى .
وفيه : أنّ وحدة الحكم وإن كانت تتوقّف على وحدة المتعلّق لكن وحدة المتعلّق لا تتوقّف على وحدة الحكم ; لا ثبوتاً ولا إثباتاً :
أ مّا الأوّل : فلأنّ وحدة الشيء وكثرته أمر واقعي في حدّ نفسه ; تعلّق به الحكم أو لا ، وبما أنّ المقيّد في المقام هو المطلق مع قيد فلا محالة لا يمكن أن يقع متعلّقاً للإرادتين وموضوعاً للحكمين .
وأمّا الثاني : فلأنّ تعلّق الحكم في المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم، فإذا تعلّق حكم بالمقيّد ـ والفرض أ نّه نفس الطبيعة مع قيد ـ يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالإطلاق والتقييد ، من غير أن يتوقّف على إحراز وحدة الحكم .
بل التحقيق : أنّ عدم الحمل إنّما هو لأجل أنّ المطلق حجّة في موارد عدم تحقّق سبب المقيّد ، فقوله : «اعتق رقبة» حجّة على العبد على إيجاد العتق مطلقاً ، ولا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله : «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» عند تحقّق سببه .
وبعبارة اُخرى : أنّ العرف يرى أنّ هنا واجباً لأجل الظهار ، وواجباً آخر من غير سبب ولا شرط ; حصل الظهار أم لا .
هذا كلّه راجع إلى الحكم التكليفي .
وأمّا الوضعي : فيظهر حاله من التدبّر فيه ; فربّما يحمل مطلقه على مقيّده ، نحو قوله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ، ثمّ قال : «صلّ في وبر السباع ممّا لا يؤكل» ، وقوله : «اغسل ثوبك من البول» ، وقوله : «اغسله من البول مرّتين» .
وقد لا يحمل ، كما إذا قال : «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» ، ثمّ قال منفصلاً : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ; لعدم المنافاة بين مانعية مطلق أجزائه ومانعية خصوص وبره بعد القول بعدم المفهوم في القيد المأخوذ فيه حتّى يجيء التنافي من قِبَله ، وعليك بالتأمّل في الصور الاُخرى واستخراج حكمها ممّا ذكر .
هذا كلّه في الإلزاميين ، وأمّا غيرهما فيختلف بحسب الموارد ، ولا يهمّنا تفصيله .
_____________
1 ـ معالم الدين : 150 ، قوانين الاُصول 1 : 321 / السطر16 ، الفصول الغروية : 217 / السطر 36 .
2 ـ نهاية الأفكار 1 : 559 .
3 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 313 .
4 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 317 ـ 318 .
5 ـ نهاية الدراية 2 : 493 ـ 494 .
6 ـ مخلوطة ، مطلقة ، مجرّدة عند اعتبارات عليها واردة
شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 95 .
7 ـ لمحات الاُصول : 337 .
8 ـ نفس المصدر .
9 ـ نهاية الدراية 2 : 492 ـ 494 .
10 ـ شرح فصوص الحكم ، القيصري : 22 .
11 ـ تقدّم في الجزء الأوّل : 166 .
12 ـ كفاية الاُصول : 283 ـ 284 .
13 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 232 .
14 ـ كفاية الاُصول : 285 .
15 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 233 .
16 ـ تقدّم في الصفحة 262 .
17 ـ كفاية الاُصول : 287 .
18 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 234 .
19ـ تقدّم في الصفحة 273 .
20 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 579 .
21 ـ راجع الاستصحاب ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 234 .
22 ـ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ : 73 ـ 78 .
23 ـ تقدّم في الصفحة 11 .
24 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 236 .
25 ـ تقدّم في الصفحة 10 .1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 582 .
26 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 581 ـ 584 .
27 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 580 ـ 581 .



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|