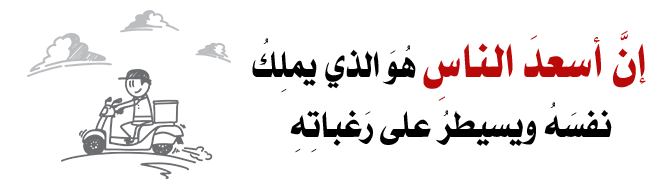
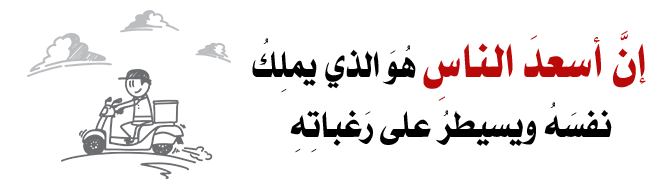

 القانون العام
القانون العام
 القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري و القضاء الاداري
 المجموعة الجنائية
المجموعة الجنائية
 قانون العقوبات
قانون العقوبات 
 القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية 
 القانون الخاص
القانون الخاص
 قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات و الاثبات
 المجموعة التجارية
المجموعة التجارية
 علوم قانونية أخرى
علوم قانونية أخرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30/9/2022
التاريخ: 7-4-2016
التاريخ: 25-3-2017
التاريخ: 2023-11-08
|
لا تنتهي مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية عند التوقيع عليها ، إذ إن الأخير لا يمنح الاتفاقية الدولية صفة إلزامية ، إلا إذا نصت الاتفاقية أو إذا اتفقت الأطراف على ذلك ، أو في حالة الاتفاقيات الدولية ذات الشكل المبسط ، لذا يتبع مرحلة التوقيع مرحلة التصديق ، إذ تعد المرحلة التي تمنح الاتفاقية صفتها الإلزامية على الصعيد الدولي ، وبعدها يتم تسجيل الاتفاقية الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأورد الفقهاء عدة تعريفات للتصديق، إذ يقول اللورد ما كنير: إن كلمة تصديق تستعمل في معان عديدة هي "الإجراء" الذي تقوم به الجهة المختصة في الدولة سواء كان الملك أو الرئيس أو المجلس الاتحادي والتي يعني موافقة الدولة التي ترتبط بالمعاهدة ، وهذا ما يعرف أحيانا بالتصديق بالمعنى الدستوري ، أو هو الإجراء الدولي الذي تنفذ به المعاهدة أي بتبادل أو بإيداع وثائق التصديق " ، في حين يعرفه اوبنهايم بأنه : " الموافقة النهائية التي يعطيها الأطراف المعاهدة دولية معقودة بواسطة ممثلين " (1).
ويعرفه شارل روسو بأنه : " الإقرار الصادر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة التي تعطيها السلطات الداخلية والذي يجعل الدولة ملزمة بها دولياً " (2) ، ويعرفه الدكتور حامد سلطان بأنه : "إجراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي يتم التوقيع عليها "(3)، إما الدكتور محمد حافظ غانم فيعرف التصديق بأنه : " قبول المعاهدة بصفة رسمية من الشخص أو الهيئة التي تمتلك اختصاص الإبرام نيابة عن الدولة (4) ، ويورد الدكتور محمد سعيد الدقاق تعريفاً للتصديق بأنه: " الإجراء النهائي الذي تقبل به الدولة الالتزام بصورة نهائية بإحكام المعاهدة وفقاً للإجراءات الدستورية لكل دولة " (5).
مما تقدم يلاحظ ، أنَّ كُلُّ من الدكتور حامد سلطان ، والدكتور محمد حافظ يغلب المدلول الدستوري على المدلول الدولي في تعريفه التصديق ، ولعل ذلك يرجع إلى أهمية الإجراء الدستوري في تصديق الاتفاقيات الدولية .
أما لجنة القانون الدولي فقد ركزت في تعر فيها للتصديق على المعنى الدولي ، إذ عرفته على انه : " الإجراء الذي يحمل هذا الاسم والذي تنشئ الدولة بمقتضاه على الصعيد الدولي رضاها إن تلتزم بالمعاهدة "
وعلى صعيد القضاء الدولي ، سبق لمحكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية امباتييلوس ( اعتراض اولي ) في 1 تموز ،1952 ، إذ أوضحت أن الاتفاقية لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها، ما لم يكن هناك حكم صريح بخلاف ذلك (6) .
مما تقدم يتضح ، إن التصديق له معنيان ، معنى دستوري خاص بالسلطات الداخلية، ومعنى دولي وهو صورة من صور الارتباط النهائي بالاتفاقيات الدولية ، لذلك يمكن أن نعرف التصديق بأنه: إجراء صادر من الدولة يفيد التزامها النهائي بالاتفاقية الدولية وفقاً لإجراءاتها الدستورية .
ويستند التصديق عادة إلى مسوغات ، يمكن تصنيفها الى مسوغات ذات طبيعة دستورية، وأخرى عملية، فالمسوغات الدستورية، ترجع الى ظهور المجالس النيابية وما تمارسه من رقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في إشراك المجالس التشريعية بعلم مسبق من قبل السلطة التنفيذية بما تعقده من الاتفاقيات الدولية ، بالإضافة إلى تطور الوعي القانوني لدى الرأي العام والقيمة التي تعطيها الدول والحكومات إلى هذا الرأي ، إذ تركت صداها لدى الدول في إحاطة الشعب بالاتفاقيات الدولية قبل عقدها (7) .
أما فيما يتعلق بالمقتضيات العملية للتصديق فيمكن إجمالها بما يأتي :-
1 - لأهمية الاتفاقيات المعقودة فقد تكون لها ارتباط وثيق بالسياسة العامة للدولة ، لذا لابد أن يكون للسلطات العامة في الدولة ( رئيس الدولة، البرلمان ) أن يبدي رأيه بصدد المسائل التي تهم المصلحة العامة للدولة قبل إن تلتزم بها بصورة نهائية.
2- لغرض تجنب الخلافات التي تحدث حول أبعاد التفويض الممنوحة للمفوضين عن الدولة بالتفاوض والتوقيع، إذ يُعد التصديق بمثابة إجازة لعمل المفوضين في حالة تجاوز المفوضين اختصاصاتهم الممنوحة لهم . وبشأن موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بشأن التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها، إذ نصت في المادة ( (13) على أن تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ او
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر. اما بشأن موقف الاتفاقية من التصديق فقد نصت المادة (14) (8) بشأن التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها
1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو
(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو
(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.
ومن دراسة هذا النص يتبين ما يأتي :-
1- عدت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التصديق هو تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالاتفاقية ، ولكنه ليست الصورة الوحيدة للتعبير النهائي للإرتضاء بالاتفاقية، وهذا ما يتضح من نص المادة (11) من الاتفاقية ذاتها التي بينت (وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة إذ نصت على ان ( يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها) ، ولعل السبب وراء ذلك ، يعود إلى التخفيف من مساوئ التصديق إذا جعلته الاتفاقية الصورة الوحيدة للالتزام بالمعاهدة خصوصا إذا تأخرت أو امتنعت الدولة عن التصديق مما يفوت الغرض من الاتفاقية .
2- إن نص المادة (14) من الاتفاقية فرق بين التصديق بشكله الصريح والضمني ، وهو ما يستفاد من الفقرتين (أ و ج) من هذه المادة التي أشارك إلى التصديق بشكله الصريح ، أما التصديق الضمني ما يشار إليه في الفقرتين ب، د ) من المادة ذاتها
3- يلاحظ ان الاتفاقية قد استخدمت في فقرتها الثانية من المادة (14) تعبيري القبول أو الموافقة في مجال الكشف عن الإرادة النهائية للدولة للالتزام بالاتفاقيات الدولية ، ويمكن القول ، بأنهما لا يمثلان اختلافا من الناحية الدولية عن إجراء التصديق.
والتساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، إذا جاءت الاتفاقية الدولية خالية مما يفيد اشتراط التصديق وخالية كذلك من نص يقرر نفاذها بمجرد التوقيع ، أ يُشترط التصديق في مثل هذه الأحوال أم تعد الاتفاقية نافذة بمجرد التوقيع ؟ . للإجابة عن هذا التساؤل ، أن اتفاقية فينا في المادة (14) قد سكتت عن ذلك ، وقد انقسم الفقه إلى رأيين بصدد ذلك ، الرأي الأول ، يذهب إلى القول بوجوب التصديق نزولا إلى المقتضيات المسوغة للتصديق والرجوع إلى القواعد العامة التي تعلق نفاذ الاتفاقية الدولية على استيفاء إجراء التصديق (9) ، أما الرأي الثاني فيرى انه إذا لم يتضح من إرادة الدولة الصريحة أو الضمنية وجوب التصديق فإن الأمر يعني بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها (10).
ونميل إلى الأخذ بالرأي الأول للأسباب الأتية :-
1- إن التصديق له مدلولان دولي ودستوري ، فإذا كانت الاتفاقية المعقودة بين الأطراف لا تنص على وجوب التصديق ، فالأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل يجب الرجوع إلى دساتير الدول الأطراف للتأكد من مدى اشتراط التصديق من عدمه ، ومن ثم يصبح التصديق اجراء داخلياً لابد من استيفاء.
2- إن نفاذ الاتفاقيات الدولية فور التوقيع عليها ما هو إلا استثناء يرد على القاعدة العامة ، الذي يظهر في الاتفاقيات الدولية في شكلها المبسط ، والاستثناء لا يعلو على القاعدة ، ولا يجوز التوسع في تفسيره.
وبعد اتمام تصديق الاتفاقيات الدولية يتم تسجيلها وهو نظام أوجدته المنظمات الدولية ، إذ بدا التسجيل في عهد عصبة الأمم ثم أخذ ينمو حتى ظهر في ميثاق الأمم المتحدة . ويُتوخى من التسجيل ، غرض ان ، الأول ذو طابع سياسي لمنع الاتفاقيات السرية التي تعقدها الدول (11) والثاني ، غرض فني ، هو تدوين الاتفاقيات لغرض الرجوع إليها (12) ، وخصوصا عندما تمارس السلطات الداخلية رقابتها ، أضف إلى ذلك لما للتسجيل من أثر في إنماء قواعد القانون الدولي وتطويرها (13).
واستجابة إلى تلك الأغراض ، وضرورة أن تأخذ الاتفاقيات المعقودة طابعا علنيا ، وبخاصة الاتفاقيات المهمة كالاتفاقيات العسكرية لما في ذلك من آثار سيئة على المجتمع الدولي ، جاءت عصبة الأمم المتحدة في مادتها الثامنة عشر ، بالنص على ما يأتي ( كل معاهدة أو اتفاق يبرمه أي عضو في العصبة بعد العمل بهذا العهد يجب تسجيله فوراً في الأمانة ونشره في اقرب فرصة ممكنة ، ولا تكون مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات ملزمة إلا بعد التسجيل ).
ومن خلال دراسة هذا النص يمكن إن نورد الملاحظات الآتية :-
1- إن النص المذكور أوجب على الدول الأعضاء تسجيل الاتفاقيات الدولية ، ومن ثم يمكن القول : إن هذا النص ذو طبيعة أمره لا تجوز مخالفته
2- إن المادة (18) ألقت على عاتق الدول الأطراف التزامين، أولهما التسجيل ، وثانيهما النشر إلا انهما ليسا ذَوَي طبيعة واحدة من ناحية قوة الإلزام، إذ أن التزام التسجيل يجب إن يكون فورا بحسب ما عبرت عنه المادة المذكورة ، ويفهم من ذلك عدم منح سلطة تقديرية للدول في مجال التسجيل ، بعكس النشر الذي جعل للدول سلطة تقديرية في تقدير الوقت الملائم بحسب ما عبر عنه النص ( اقرب فرصة ممكنة ).
3- إن محل التسجيل ، هو كل اتفاقية تعقد بين أي طرف من اطراف عصبة الأمم المتحدة ، ولكن لا يشترط أن يكون كلا الطرفين أعضاء في العصبة .
إلا إن المادة (18) من العصبة أصبحت في ذاكرة التاريخ، ولكنها تركت صداها لتظهر في ميثاق الأمم المتحدة ، إذ أشار الاخير، إلى أن ( كل معاهدة وكل اتفلق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب إن يسجل في أمانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن 2- ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة ، إن يتمسك بتلك المعاهدة ، أو ذلك الاتفاق إمام أي فرع من فروع الامم المتحدة) (14).
ومن تحليل هذا النص يتضح ما يأتي :-
1- أوجب الميثاق على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تسجيل الاتفاقيات الدولية ، وهذا يعني أن النص قد تبنى الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (18) من عهد عصبة الأمم .
2- إن هذا النص ليس حكرا على أعضاء الأمم المتحدة ، فمن الممكن لأي دولة أخرى إن تسجل الاتفاقية التي تعقدها باسمها لدى الأمانة العامة ، وهذا ما يتضح من نصوص ميثاق الأمم المتحدة إذ أشارت المادة (2) في فقرتها السادسة ( تعمل الهيئة على إن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين ) .
3- غلب على النص طابع العمومية ، لأنه شمل جميع الاتفاقيات الدولية المعقودة بين أشخاص القانون الدولي ، إلا إنه يخرج عن نطاقها الاتفاقيات المعقودة بين الشركات، إما بش أن إعلان القبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية ، وكذلك وثائق الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة فيتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة (15)
4- إن التغييب المهم في المادة (102) عن المادة (18) ، هو عدم تجرد الاتفاق غير المسجل على وفق المادة (102) عن الصفة الإلزامية ، بعكس المادة (18) التي تجرده من تلك الصفة (16).
5- إن الفقرة الثانية من نص ميثاق الأمم المتحدة كانت أوسع من فقرتها الأولى ، إذ أنها شملت الدول الأطراف في الأمم المتحدة والدول غير الأطراف ، بعدم جواز الاحتجاج أمام أجهزة الأمم المتحدة بالاتفاقيات الدولية غير المسجلة .
أما بخصوص التسجيل في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 فقد نصت المادة (80) على ما يأتي تسجيل ونشر المعاهدات) 1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحس ب الحال، وكذلك لنشرها 2- يشكل تحديد جهة الإيداع تفويضاً لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة (17) .
ويفهم من هذا النص ، هو تعبير عن الصفة العلانية الإبرام الاتفاقيات الدولية لغرض التخلص من الاتفاقيات التي تحمل طابعا سريا .
وبعد اكتمال التسجيل يتم النشر في اقرب وقت ممكن في مجموعة واحدة باللغة أو اللغات التي حررت بها الاتفاقية الدولية، ويقع على عاتق الأمانة العامة التزام بإرسال تلك المجموعة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة كما ترسل إليهم لائحة بالاتفاقيات المعقودة أو التي تم تسجيلها في الشهر الماضي (18).
وبشأن الجزاء المترتب على عدم التسجيل في ظل عصبة الأمم المتحدة ، أشار بعض من الفقه ، بلن الاتفاقية التي لم تسجل تكون نافذة بين اطرا فها فقط، ولكن لا يمكن أن يتمسكوا بها أمام أية جهة من أجهزة العصبة ، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى إن لا يجوز التمسك بالاتفاقية غير المسجّلة طبقا للمادة (18) من عهد العصبة أمام الغير ، ولكن الرأي المجمع عليه بين هؤلاء هو إن الاتفاقية لا تعد باطلة (19).
أما في ظل ميثاق الأمم المتحدة ، فقد كان نص المادة (102) اخف وطأة من نص المادة (18) من عصبة الامم المتحدة ، إذ عد الميثاق عدم تسجيل الاتفاقيات الدولية لا يحول دون إضفاء الصفة الرسمية على نصوص الاتفاقية الدولية ، لكنه لا يجيز الاحتجاج بتلك الاتفاقيات غير المسجلة إمام أي جهاز من أجهزة الامم المتحدة بما فيها محكمة العدل الدولية (20)، وبمفهوم المخالفة جواز الاحتجاج أمام أية هيأة أو منظمة غير منظمة الأمم المتحدة .
____________
1- نقلاً عن د. طاهر ،شاش (التصديق على المعاهدات الدولية الاتجاهات الحديثة وما جرى عليه العمل في مصر) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد (20) ، 1964 ، ص2.
2- شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987، ، ص 43.
3- د. حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص214.
4- ينظر، د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام (دراسة لضوابطه الأصولية ولأحكامه العامة ) ، طرح مطبعة نهضة مصر، القاهرة ، 1959 ، ص 62-64.
5- د. محمد سعيد الدقاق ، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية من دون سنة طبع ، ص 92. ولمزيد من التفاصيل حول تعريف التصديق ينظر كل من د. محمد المجذوب : القانون الدولي العام ، 6 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007 ، ص 600ود . محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007 ،ص 192
6- ينظر ، موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 29.
7- د. طاهر ،شاش (التصديق على المعاهدات الدولية الاتجاهات الحديثة وما جرى عليه العمل في مصر) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد (20) ، 1964 ، ص 7-9 و شارل روسو، مرجع سابق، ص 44 ود. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ، ص 222.
8- تقابلها المادة (14) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 1986.
9- ينظر ، د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 220.
10- د. محمد سعيد الدقاق ، مرجع سابق، ص 43.
11- من المعروف إن الحرب العالمية الأولي أفرزت العديد من الاتفاقيات السرية ومن أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية التحالف بين روسيا وفرنسا في سنة 1891 واتفاقية التحالف المبرمة بين ألمانيا وفرنسا سنة 1905 وكذلك الاتفاقية الفرنسية الروسية سنة 1912. أشار إلى ذلك د. السيد مصطفى احمد ابو الخير ، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ط1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2006 ، ، ص 81 .
12- لقد تم تدوين العديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة في عهد عصبة الأمم المتحدة، ومن بين تلك الاتفاقيات الاتفاق العسكري الدفاعي المبرم بين بلجيكيا وفرنسا سنة 1920، وكذلك الاتفاق الفرنسي الأمريكي المبرم في سنة 1950 بشأن التنازل عن القواعد العسكرية الموجدة في المغرب العربي . ينظر ، د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص 243، الهامش رقم (2).
13- تنص المادة (13) من ميثاق الأمم المتحدة على إن تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد : أ- إنماء التعاون الدولي في الم بيان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه).
14- المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
15- د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ، ص 212، الهامش رقم (4).
16- أثارت هذا الموضوع المكسيك التي لم تكن عضو آنذاك في عصبة الأمم في سنة 1928 في قضية (بالوناجير) إذا أكدت إن ميثاق التعويضات الفرنسي المكسيكي المعقود سنة 1924 ليس ملزما للطرفين لأن فرنسا لم تسجل هذا الميثاق لدى عصبة الأمم . د. جيرهارد فان غلان ، القانون بين الامم مدخل الى القانون الدولي العام)، ترجمة عباس عمر ، الجزء الثاني، دار أفاق الجديدة ، بيروت، من دون سنة طبع، ص 183.
17- تقابلها المادة (81) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لسنة 1986.
18- ينظر ، د. حسني محمد جابر : القانون الدولي العام ، ط 1 دار النهضة العربية، القاهرة ، من دون سنة طبع ، ، ص 194-195. و د. عدنان طه الدوري وعبد الأمير عبد العظيم العكيلي : القانون الدولي العام (الاحكام المنظمة للعلاقات الدولية وقت السلم والحرب) ، الجزء الثاني، منشورات الجامعة المفتوحة ، الجامعة المفتوحة ، 1994 ، ص 239
19- ينظر ، د. سعيد محمد احمد باجة : المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية ، ط 1 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1985، ص71-72 بود. صلاح الدين عامر : مرجع سابق ص245 .
20- د. سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام ، ط 1 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009، ص 75.



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|