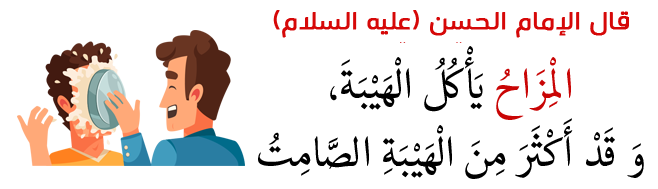
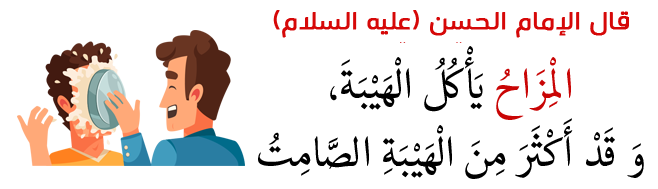

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-6-2022
التاريخ: 5-4-2019
التاريخ: 20-2-2019
التاريخ: 1-2-2023
|
المدرسة الإلهية في التربية
ثمة فارق جوهري بين مدرسة الأنبياء والأئمّة ومنهاجها في التربية، وبين غيرها من مدرسة الفلاسفة النظريين والمفكّرين والمنظّرين، فالمدرسة الأولى تتعامل مع الجانب الإنساني والروحي في البشر كما تعزّز تعاملها مع عواطفهم وقلوبهم، دون الاقتصار على الأفكار المجرّدة والنظرية في الإنسان. وذلك لأن الجانب القلبي والروحي هو المميز للإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى فيعطيه هويته الخاصة به ولا يشاركه فيها أي كائن آخر سواء كان من الحيوانات أو الجان أو الملائكة، ولذلك تركز المدرسة الإلهية وفق منهج أهل البيت عليهم السلام في تربيتها للإنسان على هذه الجنبة من كيانه...
ولهذا أيضاً يلاحظ أنّ القرآن الكريم يشير دائماً في مجال وصفه للعلاقة القائمة بين الله سبحانه وبين المؤمنين بالرسالة الإسلامية إلى مرتكزات هذه العلاقة، حيث يستعمل هذه الألفاظ الخاصة في دلالتها على جانب العاطفة والقلب والوجدان، وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾[1].
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾[2]. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾[3]. ﴿وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾[4].
فمن الواضح أنّ هذه الآيات وأمثالها مما يصف الله سبحانه فيه ويشرح سنخ العلاقة بالبشر وطبيعة العناية الإلهية بهم، تركز على مقولات عالم القلب والروح، لا عالم المصطلحات البشرية والأفكار المجردة، وما ذلك إلا لأنّ هذه المدرسة تسعى لأن تربّي الإنسان وتكمّل إنسانيته وكمالاته التي لا تقوم في أساسها ومجراها إلّا على جانب القلب والروح والوجدان، فمن خلال هذا الجانب يستطيع الإنسان أن يتكامل ويسعى إلى الصالحات والخيرات، والصفات الأخلاقية والوجدانية الحميدة.
أما كيف ولماذا يكمل الإنسان عن طريق هذا الحب؟ فذلك لأنّ الكمال الحقيقي للإنسان إنّما يكون باقترابه من الكمال المطلق وهو الله سبحانه، والقلب هو باب هذا الاقتراب من الكمال المطلق، وليس الباب إليه هو الذهن وحده، بداهة أنّ الإنسان قد يدرك وجود الله سبحانه ولكنه لا يتكامل.
منهج الأنبياء التربوي
فلا يتصوّر أحد أنّه مع وجود المنطق والاستدلال، فما هي الحاجة للحديث عن الموعظة والتربية والتوجيه؟ وما هي الحاجة للبحث في قضايا وجدانية وعاطفية من هذا القبيل؟ إنّ هذا النوع من التفكير بيّن البطلان، لأنّ لكلّ واحدة من هذه الأمور دوراً في بناء شخصية الإنسان وتكامله. فالعواطف لها دورها والمنطق والبرهان لهما دورهما المهم أيضاً.
فالعاطفة لها دور في حلّ كثير من المشاكل والمعضلات التي يعجز المنطق والاستدلال عن حلّها. ولذلك حينما نراجع تاريخ الأنبياء (عليهم السلام) سوف نرى أنّه في أوائل بعثتهم كان يلتفّ حولهم أناس لم يكن المنطق والبرهان هما الدافع الأساسي لإيمانهم ولالتفافهم حول أولئك الأنبياء (عليهم السلام)، لذا كان عملهم ودعوتهم في المرحلة الأولى يقوم على أساس كسب المشاعر والعواطف الصادقة لدى الناس.
ففي هذه المرحلة كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخاطب الكفّار مبيناً ضعف آلهتهم (الأصنام) وعجزها، وأنها ليست سوى أحجار لا تضرّ ولا تنفع. من دون الحاجة إلى ذكر الدليل العقلي والمنطقي على بطلان عبادتهم لتلك الأصنام. ولم يكن يستدلّ للناس بالأدلّة العقلية والفلسفية على وجود الله ووحدانيته، بل كان يكتفي بالقول: "قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا"[5]، فلم يبرهن للناس عقلياً أو فلسفياً أنّ الاعتقاد بـ (لا إله إلاّ الله) يؤدّي إلى فلاح الإنسان وسعادته، بل إنّ هذه العبارة تخاطب مشاعر الإنسان وأحاسيسه الصادقة.
طبعاً إنّ كلّ مشاعر وأحاسيس صادقة وسليمة تنطوي على برهان فلسفي واستدلال عقلي. لكنّ المسألة هي أنّ كلّ نبي عندما كان يريد البدء بالدعوة لم يكن يطرح الدليل العقلي والفلسفي من أجل هداية الناس، بل إنّه كان يبدأ بتحريك العواطف والأحاسيس الصادقة والسليمة التي تحمل المنطق والاستدلال في ذاتها. وهذه الأحاسيس والعواطف توجّه أنظار الإنسان إلى ما يعيشه المجتمع من انحراف وظلم واضطهاد وتمايز طبقي، وما يمارسه أنداد الله من البشر (شياطين الأنس) من ضغط وإرهاب ضدّ أبناء ذلك المجتمع. أمّا طرح البراهين العقلية والمنطقية فكان يبدأ حينما تستقر الدعوة وتأخذ مجراها الطبيعي.
المعرفة العقلية والقلبية
وانطلاقاً من هذا المبدأ نقول: إنّ منابع المعرفة لدى الإنسان، وطرق التعرف إلى حقائق الوجود، ثلاثة وهي: منبع الحس، ومنبع العقل، ومنبع القلب. ومدرسة أهل البيت عليهم السلام تولي اهتماماً كبيراً بمنبع القلب ولكن من دون التقليل من أهمية الحس والعقل، فلكل منبع خصوصيته وأثره.
ومعنى معرفة الله سبحانه عن طريق القلب، أن يجد الإنسان ربه وخالقه في وجوده ونفسه، ويتحسس وجوده في باطنه، تماماً كسائر الإحساسات القلبية الأخرى، فهو كما يشعر بالعاطفة تجاه ولده، وكما يشعر بالجوع والعطش، كذلك يشعر بالله سبحانه في وجوده، ويتلمس قربه والاقتراب منه في كل آن.
الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية:
ومن الواضح أنّ هناك اختلافاً بين المعرفة العقلية والمعرفة القلبية، وهو نفس الاختلاف بين الإحساس والعلم، أو بين المعرفة الفردية والمعرفة العامة. ويمكننا هنا أن نشير إلى الفرق بين المعرفتين من خلال النقاط التالية:
أولاً: إنّ معرفة الله سبحانه عن طريق القلب هي شهود وحضور المعلوم عند العالم مباشرة، أما معرفته عن طريق العقل فهي تحصيل وإدراك المعلوم بواسطة الحواس والصور الذهنية. فالعالم يعرف الله ولكنّ العارف يرى الله. كما ورد في الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): "... إلهي فاجعلنا من الذين ترسّخت أشجار الشّوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبّة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافاة يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الرّيب عن عقائدهم من ضمائرهم وانتفت مُخالَجة الشّك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم..."[6].
ثانياً: أحد الاختلافات الأخرى بين معرفة الله عن طريق العقل وعن طريق القلب التي تتفرع عن الفرق الأوّل هي أنّ معرفة الله عن طريق القلب إحساس فهي طريق فردي تماماً، ولا تقبل النقل للآخرين والتعليم والتعلم، على خلاف معرفة الله عن طريق العقل فهي ليست فردية وهي قابلة للتعليم والتعلم ويمكن نقلها للآخرين. إنّ معرفة الله عن طريق القلب لا يمكن إبرازها في قالب الاستدلال، وهي ليست أمراً قولياً بل هي أمر ذوقي، ونوع من التجربة الباطنية لا يمكن نقلها للآخرين، كما أنّ المبصر لا يستطيع أن يبين للأعمى اللون وإدراكه له ومعرفته به، وكما أنّ الإحساس بالجوع والعطش لا يقبل النقل للآخرين فكذلك الشخص الذي يستطيع أنْ يحسّ بالله عن طريق القلب لا يستطيع أن ينقل إحساسه إلى من كان بصر قلبه أعمى.
ثالثاً: ومن الاختلافات بين معرفة الله عن طريق القلب ومعرفة الله عن طريق العقل هي أنّ المعرفة القلبية توأم للعمل والالتزام والتقوى، ولكن المعرفة العقلية يمكن أن تكون مع التقوى ويمكن أن لا تكون مع التقوى، بل يمكن أن تكون أحياناً مترافقة مع الكفر، كما يتضح ذلك من قوله سبحانه في القرآن الكريم في عدم إيمان قوم فرعون: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾[7].
وعليه فيمكن أن يصدق العقل بالله سبحانه، ولكن اللسان ينكره، ويعمل الإنسان خلاف ما يعلم، إلّا أنّ الأمر الذي لا يمكن هو أن يؤمن القلب بالله ثم ينكر اللسان، فلا يمكن أن توجد المعرفة القلبية من دون أن يوجد الالتزام العملي، وقد أشار الإمام الباقر (عليه السلام) إلى هذا المعنى بقوله: "لا يُقبَل عمل إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل ومن عرف دَلَّتهُ معرفته على العمل ومن لم يعرف فلا عمل له"[8].
هذه المعرفة هي المعرفة القلبية التي هي توأم الالتزام والعمل، والتي لها الدور الأساسي في تكامل الإنسان وتساميه المعنوي والروحي.
مخاطر فصل المعرفة العقلية عن القلبية
ومن الأمور الهامة التي يجب الالتفات إليها هو أن بعض العرفاء قد أفرط في هذا المجال واعتبر أن البرهان والدليل لا أثر له، وأن أرجل الاستدلاليين خشبية: أرجل الاستدلاليين خشبية والأرجل الخشبية ليست قوية
إنّ هذا الموقف من المعرفة العقلية والفلسفية غير صحيح وغير منطقي، لأنّ المعرفة العقلية إذا طرحت منفصلة عن المعرفة القلبية، والعلم دون العمل، فهي ليست فقط لا دور لها في السلوك إلى الله وفي تكامل الإنسان، بل هي توجب الابتعاد أكثر عن الله سبحانه. أما إذا كانت المعرفة العقلية إلى جانب المعرفة القلبية، والفلسفة إلى جانب العرفان والعلم توأم العمل، فإنّ أقدام البرهان لا تكون خشبية بل أقداماً طبيعية تماماً أنعم الله سبحانه بها على الإنسان للوصول إلى معرفته. فكيف يمكن أن نرمي عصا البرهان بعيداً في حال أنه لا طريق للتعليم والتعلم إلا الاعتماد على هذه العصا. وبناءً على هذا فإنّ إبقاء هذه العصا بيدنا هو أمر ضروري لحمل رسالة الأنبياء الإلهية.
بعد أن تبين معنى معرفة الله عن طريق القلب والتفاوت بينها وبين المعرفة العقلية نصل إلى المبحث الأصلي لهذا الدرس وهو عبارة عن إثبات حسّ معرفة الله عند الإنسان.
وبما أنّ المعارف القلبية وكلّ الإحساسات الأصلية عند الإنسان لها جذور في فطرته فيجب في هذا المجال أن نبدأ بحثنا بفطرة معرفة الله ثم نبحث في شرائط وموانع تفتّح براعم هذه الفطرة الإلهية.
معرفة الله وتوحيده من الأمور الفطرية
إنّ معرفة الله والاعتقاد بوجوده سبحانه من الأمور الفطرية. فمن القضايا الفطرية التي جبلت عليها سلسلة بني البشر بأكملها كما ذكرنا بحيث لا أحد يخالفها ولا يمكن لأي جهة أن تبدلها أو أن تحدث خللا فيها، هي الفطرة التي تعشق الكمال، بمعنى أنك لو تجولت في الأدوار التي مر بها الإنسان ولو استنطقت كل فرد من الأفراد وطائفة من الطوائف وملة من الملل، فإنك ستجد هذا العشق والحب قد جبل في طينته وأنّ قلبه دائماً متوجّه نحو الكمال، بل إنّ كل ما يصدر عن الإنسان من سكنات وحركات وعناء وجهد إنما هو نابع من حب الكمال، ولكن الخطأ الكبير الذي وقع به أفراد الإنسانية أنهم لم يتعلقوا بالكمال الحقيقي بل اعتمدوا في ذلك على ما توهموه وتخيلوه كمالاً فعشقوه كالسلطان والنفوذ والمال واتساع الملك، فضلّوا بذلك ضلالاً بعيداً.
كان على هؤلاء أن تتّجه قلوبهم، وبمقتضى الفطرة، إلى الكمال الذي لا نقص فيه، فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه ولا كمال بعده، ويعشقون العلم الذي لا جهل فيه، والقدرة التي لا تعجز عن شيء والحياة التي لا موت فيها. وهذا هو الكمال المطلق، وهو الله الذي ينبغي أن يكون معشوق الجميع بحكم الفطرة الواحدة لدى الجميع، فإلى متى نوجه هذه الفطرة المقدسة التي وهبنا الله إياها، نحو الخيالات الباطلة من هذا وذاك من المخلوقات أو من متعلقات عالم المادة؟ إن علينا أن نتوجّه إلى الكمال المطلق وهو الله سبحانه من خلال هذه الفطرة التي لا شك فيها، ﴿أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾[9].
وأما بيان أن توحيد الله تعالى وصفاته الأخرى هي فطرية، فنقول: إن من الأمور الفطرية التي فطر الله الناس عليها هو النفور من كل نقص وعيب، فالفطرة تنفر من النقص والعيب كما أنها تنجذب إلى الكمال. ومن هنا كان لا بد لهذه الفطرة أن تتوجه إلى الواحد الأحد وذلك لأن كل كثير ومركب يعتبر ناقصا.
توضيح ذلك: أن الكثرة لا تكون إلا بمحدودية، والمحدودية نقص وكل ناقص مرغوب عنه من جانب الفطرة وعليه فينتج من هاتين المقدمتين الفطريتين وهما: "فطرة حب الكمال" و "فطرة النفور من النقص" ينتج إثبات التوحيد، بل إن استجماع الله لجميع الكمالات وخلو ذاته المقدسة من كل نقص، قد ثبت ذلك كله بالفطرة.
قال الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ...﴾[10]: "فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته"[11].
وفي تفسير البرهان ذكر في ذيل الآية المذكورة خمس عشرة رواية فسرت جميعها الفطرة في هذه الآية بمعنى فطرة معرفة الله والتوحيد[12].
وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الله تعالى فأجاب (عليه السلام): "يا عبد الله... هل ركبت سفينة قط ؟ قال: بلى، قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى، قال عليه السلام: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى، قال عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة حين لا مغيث"[13].
ويلاحظ أن في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الصورة، وذلك في قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾[14].
فالله عزّ وجلّ موجود، وفطرة التدين له موجودة. والإنسان مفطور على حبه ومعرفته والتعلّق به، وكلّ المقدمات مهيئة لمشاهدة جماله وجلاله، لكن الأنفس الأمارة والسرائر الخبيثة وتدخلات إبليس واتّباع الهوى وطغيان الأنا والابتعاد عن طريق الهدى والانغماس في عالم المادة، كلها موانع تمنع من هذا الشعور والإحساس به وتلمس نورانياته.
وباستطاعة الإنسان أن ينكر ما يشاء من الحقائق، ولكنّ إنكارها لا يحولها إلى زيف أو وهم كما لا يعدمها بل تبقى حقائق. وهل تنعدم الشمس عندما ينكرها الأعمى؟! وهل تتوقف عن إضاءة الكون عندما يغطيها السحاب؟
فالله تعالى كائن في نفسك، وهو موجود في نبضك وسكونك، لا تراه ولكنك تحسّه، وقد تحسّه ولكنك لا تعرفه. وكونك لا ترى ربك أو لا تعرفه، فذلك لا يعني أنه غير موجود ولا محسوس، ولكنه يعني أن التراب في نفسك طغى على القبس المضيء فيها، فاختلط عليك الأمر وظننت أنك خلقت من فراغ وتعيش في فراغ، وتظلّ في حيرة وضلال إلى أن يطلع عليك ومن داخلك نور الله سبحانه ليهديك بعد أن ضللت، ويرشدك إلى الطريق وكانت قد عمت عليك.
ولعلك في حياتك رأيت الله مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أكثر، لا رؤية العين التي تجسّد أمامك المرئيات، ولكن رؤية الوجدان الذي يوحي إليك أنّ الله في داخلك، ورؤية القلب الذي يأخذك بكلك إلى الله سبحانه.
أوليس أنّ الله هو الخير والجمال والحب والفضيلة والإحسان والتسامح والتسامي والطهارة والصفاء؟ ففي كل مرة أحسست فيها أنك تترفع عن الحقد إلى حيث الصفح والمغفرة والرحمة، وفي كل مرة أحسست فيها أنك تترفع عن الكراهية والبغضاء إلى حيث الحب والتسامح، فاعرف أنّ الله هو الذي يرعاك ويوجهك. وفي كل مرة أوشكت أن تسقط، وأحسست أن يداً خفية تقيمك وتثبتك، فاعلم أنها يد الله.
وفي كل مرة تقاطرت عليك الخطوب وادلهمّت عليك المسالك، وشارفت على التعب واليأس أو الألم والحزن، وأضحى الظلام يحيط بك من كل مكان، وأحسست نوراً يشعّ في الظلام، وصوتاً يهبك الراحة والعزاء والسكون والصفاء، فاعلم أنّه الله.
[1] سورة البقرة، الآية: 222.
[2] سورة الفتح، الآية: 18.
[3] سورة الحجرات، الآية: 7.
[4] سورة هود، الآية: 90.
[5] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج18، ص202.
[6] الإمام زين العابدين عليه السلام، الصحيفة السجادية، مناجاة العارفين.
[7] سورة النمل، الآية: 14.
[8] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج75، ص174.
[9] سورة إبراهيم، الآية: 10.
[10] سورة الروم، الآية: 30.
[11] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج3، ص278.
[12] السيد هاشم البحراني، تفسير البرهان، ج4،ص261.
[13] العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج3، ص41.
[14] سورة يونس، الآية: 22.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|