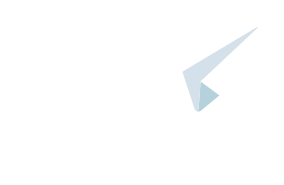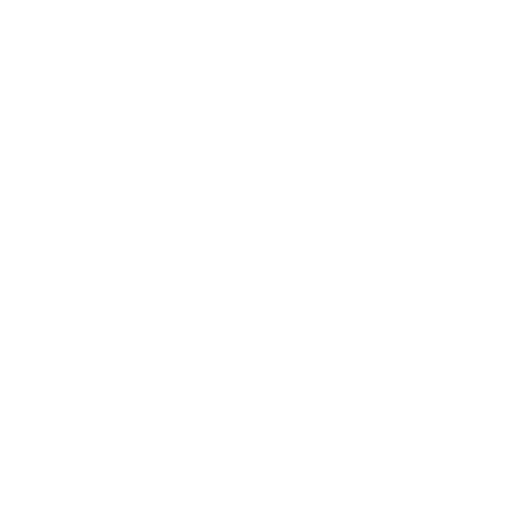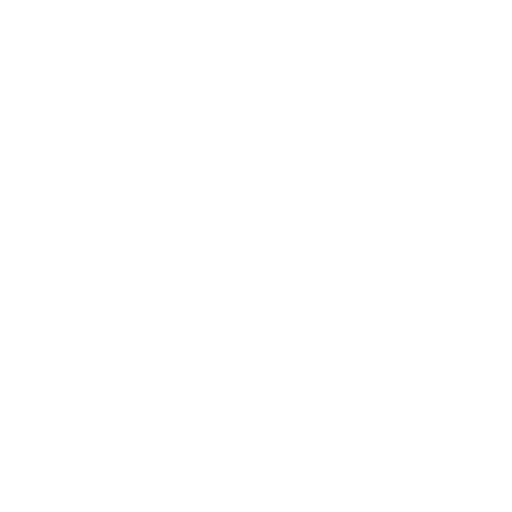تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الولاية للّه ذاتيّة ولغيره عَرَضيّة
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج5/ص111-115
2025-12-20
474
إنّ وَلاية الله من الصفات والأسماء من لوازم ذاته؛ وهي ولاية بالاصالة والحقيقة؛ بَيدَ أنّ الولاية الإلهيّة الكلّيّة والعامّة والمطلقة لرسول الله والأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم تَبَعيّة وعَرَضيّة؛ ومرآتيّة وآيتيّة، وهي من الله، وقد تجلّت في هذه المرايا المتلالئة والآيات المتألّقة.
وما لم تكن الولاية موجودة، فلن يتحقّق العالم ولن يقرّ له قرار، ولن يكون له وجود وثبات، بل هو معدوم فان.
ذلك لأنّ نزول نور الهويّة الإلهيّة في اسم الله وسائر صفات الجمال والجلال يتحقّق بواسطة انعكاس نور الذات والمرايا المختلفة؛ لكي تتحقّق الكثرة في عالم الإمكان وتتّصل الموجودات بعضها ببعض، ويرتبط الحادث بالقديم؛ وهذا الأمر محال بغير الولاية.
كما أنّ الخلق والمخلوقيّة بدون صفة الخلّاقيّة واسم الله الخلّاق محال، وكذلك المرزوق والمطعوم بدون صفة الرازقيّة والطاعميّة لله محال؛ والمعلوم بدون العلم؛ والرحمة بدون الرحمن والرحيم محال؛ وكذلك إيجاد الموجودات وتربيتها فإنّه محال بدون ولاية؛ لأنّ الإيجاد والإحياء والإماتة والتربية كلّها في ظلّ الاسم وصفة الوليّ والولاية؛ ولا إمكان لتحقّقها بدون ذلك.
الولاية قائمة في كلّ كائن وموجود وفقاً لسعة هويّته الوجوديّة وضيقها، لأنّ الولاية هي عبارة عن عدم وجود حجاب ومسافة بين الخلق والخالق؛ وإذا ما وجد الحجاب والمسافة، فالخلقة ممتنعة.
فكلّ موجود هو مع الولاية ولها اعتباراً من التبنة إلى الجبال الراسيات؛ ومن الذرّة إلى الشمس ومنظومتها؛ أي: على ارتباط بحت بالله القادر، والموجِد، والعالم، والرازق.
غاية الأمر، أنّ الموجودات الضعيفة هي تحت ولاية الموجودات القويّة؛ وهذه أيضاً تحت ولاية الموجودات التي هي أقوى؛ إلى أن تصل إلى نقطة، توجِد فيها الولاية الإلهيّة الكلّيّة والمطلقة والعامّة جميع الموجودات تحت هذه الصفة والاسم، وترزقها؛ وتميتها وتحييها؛ وتفيض عليها بالعلم، والسمع، والبصر، والقدرة.
وما يلزم خلقة كافّة الموجودات الكثيرة على اختلاف درجاتها في الوجود هو الارتباط بالولاية الكلّيّة ذات السعة والإحاطة الأكثر، والقدرة والتناهي الأوسع من جميع الجهات.
وهي التي يقال لها أوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ، وهي الحجاب الأقرب والمرآة التامّة للذات، وصفات الجمال والجلال لله جلّ وعلا. ومنها ينطلق عالم الكثرة من المُلك والملكوت، والعقول، والنفوس، وعالم الطبع؛ وبواسطة اتّساع الولاية في شبكات عالم الإمكان المختلفة تتقمّص الموجودات لباس الوجود تدريجاً، من الأعلى إلى الأسفل، ومن القويّ إلى الضعيف، ومن الوسيع إلى الماهيّة الضيّقة.
وأنّ أوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ التي مرآتها أوسع من الموجودات كلّها، يمكنها أن تعبّر عن الذات والصفات بدون نقص وبخس، وهي الولاية المطلقة والكلّيّة؛ لأنها- وفقاً للافتراض- الحجاب الأقرب، وأقرب موجود إلى ساحة الكبرياء المقدّسة من حيث القرب.
وفرقها عن ذات البأرى تعالى هو أنها عَرَضِيّة ومجازيّة، والذات المقدّسة ذاتيّة وحقيقيّة، وذلك لعدم وجود أيّ مؤثّر في عالم الوجود غير الذات الإلهيّة. فالفرق بين أوَّلِ مَا خَلَقَ، وبين الموجودات الأخرى هو أنّ سعة ذلك أكثر، لا أنّ له وجوداً من ذاته؛ لا، ليس الأمر كذلك.
أنّ الكائنات والموجودات جميعها اعتباراً من أوَّلِ ما خَلَقَ إلى آخر درجة في الماهيّات الإمكانيّة الضعيفة والوضعيّة، كلّها فقيرة ومحتاجة إلى الله؛ بل هي عين الفقر والحاجة. والروح الأمين وسائر الملائكة المقرّبين كلّهم على هذه الشاكلة أيضاً. ولا يستثنى من هذه القاعدة شيء في عالم الإمكان. وكلّ شيء في العالم هو ممكن الوجود غير ذات واجب الوجود.
أنّ أوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ، في الوقت الذي يتفوّق على الكائنات والموجودات جميعها إنشآءً وإعداداً وقدرة، إلّا أنه يظلّ مرآة. غير أنها مرآة أوسع وأتمّ وأدلّ. ولن تنفصل عنها صفة الآيتيّة والمرآتيّة أبداً.
إذَنْ، الولاية الإلهيّة الكلّيّة هي ولاية الله عينها. فالأصل واحد، إلّا أنّ لها أصالة في الله، وتبعيّة في الوَلِيّ. الله يدلّ على نفسه؛ والوليّ يدلّ على الله.
ومعاذ الله أن يخال أحد أنّ الولاية تتمّ بإعطاء الله والاستقلال في وجود وَليّ الله، فهذا الكلام خاطئ وهو الشرك عينه.
ومن هذا المنطلق ما جاء في الرسالة 28 من رسائل الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام في «نهج البلاغة»، وهي رسالته التي كتبها إلى معاوية، يقول فيها: "فَإنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا والنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا".[1]
يقول المجلسيّ رحمة الله عليه في الجزء الثامن من «بحار الأنوار»، ص 536، طبع كمباني: هذا كلام مشتمل على أسرار عجيبة من غرايب شأنهم التي تعجز عنها العقول. ولنتكلّم على ما يمكننا إظهاره والخوض فيه، فنقول: صَنِيعَةُ الْمَلِكِ مَنْ يَصْطَنِعُهُ ويَرْفَعُ قَدْرَهُ. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَإلى:
{وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} أي: اخْتَرْتُكَ وأخذْتُكَ صَنيعِتي لِتَتَصَرَّفَ عَنْ إرَادَتِي ومَحَبَّتِي.
فالمعنى أنه ليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل الله تعالى أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنايعنا، فنحن الوسائط بينهم وبين الله سبحانه.
ويقول ابن أبي الحديد في شرح «نهج البلاغة» المطبوع في عشرين جزءاً، وذلك في ج 15 ص 194: «هذا كلام عظيم، عال على الكلام، ومعناه عال على المعاني؛ وصَنِيعَةُ الْمَلِكِ مَنْ يَصْطَنِعُهُ ويَرْفَعُ قَدْرَهُ. يقول الإمام: ليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل الله تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى. وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت، وباطنه أنهم عبيد الله وأنّ الناس عبيدهم- انتهى».
ويقول الشيخ محمّد عبده في هامش ص 32: آلُ النَّبِيّ اسَرَاءُ إحْسَانِ اللهِ عَلَيْهِمْ والنَّاسُ اسَرَاءُ فَضْلِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ.
[1] «نهج البلاغة» ج 2، طبعة عبدة ص 32، و«الاحتجاج» للطبرسيّ، طبعة النجف ج 2 ص 260.
 الاكثر قراءة في التوحيد
الاكثر قراءة في التوحيد
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












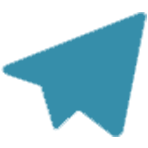
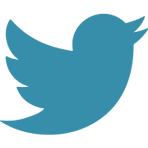

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)