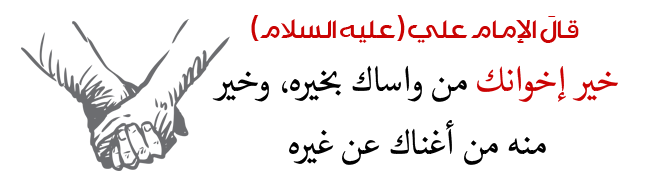
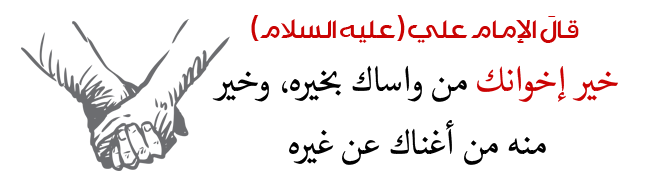

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06
التاريخ: 16-9-2016
التاريخ: 2024-09-06
التاريخ: 2024-09-06
|
اذا خالف [احد] مقتضى التقيّة فهل يصحّ عمله أم لا، فتارة يخالفها ويخالف صورة العمل بحسب الوظيفة الأولية و أخرى يوافق الوظيفة الأولية:
أما الفرض الأول:
فلا وجه للصحّة لعدم مطابقته للوظيفة الاضطرارية ولا للوظيفة الأولية سواء بنى في تصحيح عمل التقية على السيرة أو على أدلّة الرفع العامّة أو الوجوه الأخرى، وتوهّم أن مقتضى أدلّة الرفع هي رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية من دون اثبات جزئية أو شرطية الفعل الذي يتّقى به المماثل لصورة عملهم، و مقتضى ذلك هو الصحّة في هذا الفرض، مندفع بأن أدلّة الرفع وان كان مقتضاها الرفع دون الاثبات إلا انّه لا تحقق لموضوعها وهو الاضطرار لغير العمل المماثل للعامّة، فالعمل في الفرض لا يصدق بلحاظه تحقق الاضطرار، وذلك نظير الدخول الى الدار الغصبية لانقاذ الغريق فإن الدخول مع عدم التوصّل به للانقاذ لا يرفع الحرمة لعدم الاضطرار الى ذلك الدخول والتصرف- بغض النظر عن القول بالمقدمة الموصلة- لأن الضرورات تقدّر بقدرها .
اما الفرض الثاني:
فوجه البطلان يتصور على نحوين:
الاول: انقلاب الوظيفة الأولية وضعا الى الوظيفة الثانوية من حيث الاجزاء والشرائط، وهذا ليس بتام لما ذكرنا مرارا من أن الأدلّة الرافعة الثانوية لبّا ليست مخصصة للاحكام الأولية كما ذهب اليه المحقق النائيني (قدس سره) وتلاميذه- بل من باب التزاحم الملاكي، فالوظيفة الأولية باقية على مشروعيتها وانّما المرفوع عزيمتها .
الثاني: النهي التكليفي لمخالفة التقيّة المستفاد إما من مثل التعبير الوارد (لا دين لمن لا تقيّة له)، أو من حرمة الضرر المترتّب سواء على الشخص نفسه أو غيره من المؤمنين أو على المذهب والطائفة، وقد يدعم المنشأ الأول الصحيح إلى أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث- أنّه قال: (يا أبا عمر، أبى الله إلا أن يعبد سرّا، أبى الله عزّ وجل لنا ولكم في دينه إلا التقيّة) (1) ، مما يظهر منه عدم قبول العبادة الجهرية في مورد لزوم التقيّة .
لكن قد تقدم- في الأمر الثاني- أن حقيقة الحكم في التقيّة يؤول الى عدّة وجوه والنهي راجع الى حرمة الضرر، وقد يؤول الحكم الى وجوب الحفظ، ويراد به الحيطة في معرض الضرر سواء الشخصي أو على نوع المؤمنين، وهو المراد مما لسانه الوجوب وان تاركها كتارك الصلاة، وربّما يشكل بأن جعل الحكمين على الضدين لغو، لا حاجة له، حيث يتوسّل بأحدهما عن الآخر، فلا محصّل لحرمة العقوق مع وجوب صلّة الرحم أو حرمة الهتك للشعائر أو للمقدسات الدينية مع وجوب تعظيمها، أو حرمة الفواحش مع وجوب حفظ الفرج، أو مانعية النجاسة وشرط الطهارة أو مانعية الغصب و شرطية اباحة المكان، أو مانعية ما لا يؤكل لحمه وشرطية ما يؤكل لحمه .
وفيه: انّ اللغوية أو الامتناع إن تمّت ففي الموانع والشرائط للمركب الواحد وأما الأفعال ذات الأحكام التكليفية المجردة المستقلة كما في العقوق وصلّة الرحم وفي الهتك والتعظيم وفي الفواحش والحفظ منها، ونحوها من الأفعال التكليفية، فلا مجال لدعوة اللغوية أو الامتناع، وذلك نظير الأفعال في الأحكام العقلية في باب التحسين والتقبيح العقلي فإنّه كما يحكم العقل بحسن فعل ما يحكم بقبح ضده فحكمه على فعل فضيلي لا يمنع على حكمه على فعل مضاد له رذيلي بعد واجدية كل من الفعلين المتضادين لملاك الحكم، فيحسّن الأول ويقبّح الثاني، ولا يعترض حينئذ على ذلك بأن اللازم حصول مثوبتين على الموافقة وعقوبتين على المخالفة وذلك لما حرر في محلّه في الأحكام العقليّة أن المثوبة هي على المصلحة و الكمال الذي في الفعل والعقوبة على المفسدة التي في الفعل، فليست المثوبة على عدم ارتكاب المفسدة بل على حصول المصلحة وليست العقوبة على ترك المصلحة بل على الوقوع في المفسدة، ولا يتوهّم انّ اللازم على ذلك عدم الاثابة على ترك المحارم وعدم العقوبة على ترك الفرائض، وذلك لما
تبيّن من تلازم ترك المحارم لحصول افعال كمالية كحفظ وعفّة الفرج وكصدق اللسان و الأمانة في تأدية حقوق الآخرين، و نحوها فمن ثم تقع المثوبة، وكذلك في ترك الفرائض فانّه يلازم حصول أفعال ذات مفسدة كالوقوع في المنكرات، والتسبب للضرر ومخالفة أمر المولى والتجري ونحو ذلك مما يوجب العقوبة، ويكفي في المقام الالتزام بهذا التقريب في خصوص الأفعال المتضادة الواجدة لملاك المصلحة في أحدها و المفسدة في الضد الآخر، وان لم يلتزم به في كلّ الواجبات والمحرّمات، وهذا سواء بنينا في العقوبة والمثوبة على كونها جزائية أو تجسم أعمال أو غير ذلك من المسالك، فانّه عدا المسلك الأول هي مقتضية للتفصيل المتقدم، وأما الاول فلا ينافيه بعد لزوم مطابقة الاعتبار للواقع التكويني وكون الأحكام الشرعية ألطافاً في الأحكام العقلية .
فتحصّل عدم منافاة حرمة الضرر لوجوب الحفظ في موارد التقيّة، وعليه تكون مخالفة التقيّة- التي في مورد خوف الضرر لا المداراة والمجاملة- محرمة هذا مضافا الى انّه يكفي في المقام في بطلان العمل العبادي كونه سببا توليديا لمخالفة وعصيان وجوب التقيّة، إذ يكون بذلك تجريا لا تعبدا وطوعانية، فهذا نحو وجه ثالث للبطلان .
ثم انّ المخالفة للتقيّة قد تكون جزءاً من العمل العبادي كالجهر بالبسملة وبأذكار السجود وكالسجدة على التربة وكالمسح على الرجلين، و قد تكون بكلها كما لو صلّى منفردا في مورد اقتضاء التقيّة الصلاة جماعة، وقد تكون بالترك كترك قول آمين و ترك التكتّف. أما الصورة الأولى فانّ ذلك الجزء أو الشرط لا يؤدي به الامتثال لحرمته أو كونه تجريا، فحينئذ إن اعاده بنحو التقيّة، ولم تكن زيادة مبطلة فيه صحّ مجموع العمل، وإلا كما لو لم يعد أو كانت زيادته مبطلة كالسجدة الواحدة فإنه يبطل مجموع العمل، ولو سحب جبهته الى الأرض أو الفراش، فإن كان مما يصحّ السجود عليه أمكن تصحيحه صلاته، لا مكان منع صدق زيادة السجدة حينئذ بل هي من السجدة الواحدة التي تمّت شرائطها بقاء، وأما إن كان مما لا يصح السجود عليه لكنّه يوافق العامّة فقد يتخيّل تصحيحها أيضا، لكنه ضعيف لانتفاء موضوع التقيّة حينئذ .
وأما الصورة الثانية فقد يتخيل انّ المخالفة هي بترك الصلاة جماعة لا الصلاة فرادى ولكنه أيضا ضعيف لأن اظهار المخالفة تحقق بالصلاة فرادى، لا الترك بما هو هو ولو لم يكن في مكان واحد معهم، نظير عنوان الهتك الحاصل بسبب صلاة الفرادى مع وجود صلاة الجماعة بإمام عادل- في بعض الأوقات- ولك أن تقول انّ الكون في ذلك المكان مع ترك الجماعة وان كان مخالفة للتقيّة أو هتكا إلا أن الصلاة فرادى أشدّ وأبين في المخالفة وأوغل في الهتك .
وأما الصورة الثالثة فلا يضر بالعمل العبادي بعد كون الترك لا صلة له به، إلا أن يتفقّ تسبب جزء من العمل لذلك الترك نظير الصورة الثانية .
________________
(1) وسائل، ج 16، ص 206، باب 24 من ابواب الجماعة، ح 11 .



|
|
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|