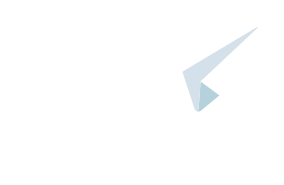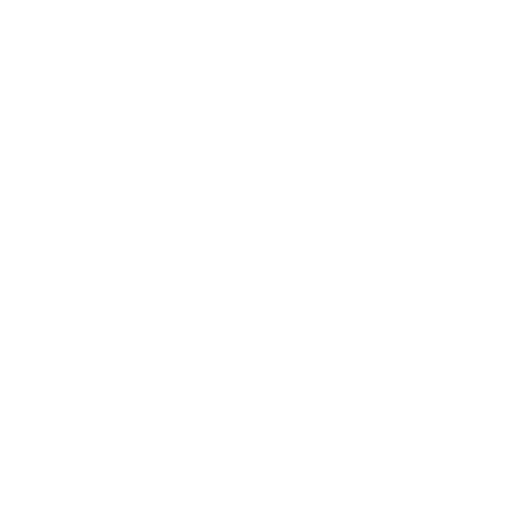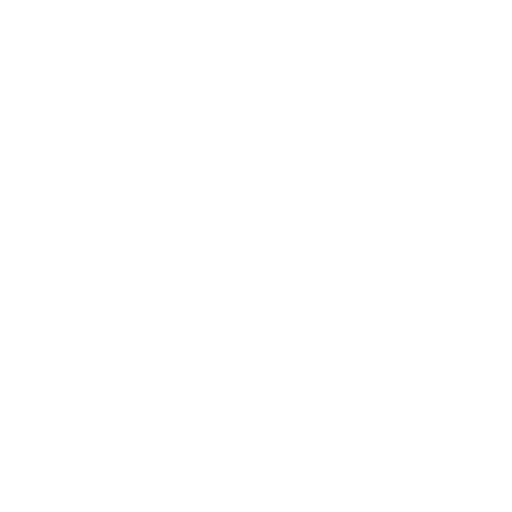النحو

اقسام الكلام

الكلام وما يتالف منه

الجمل وانواعها

اقسام الفعل وعلاماته

المعرب والمبني

أنواع الإعراب

علامات الاسم

الأسماء الستة

النكرة والمعرفة

الأفعال الخمسة

المثنى

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

العلم

الضمائر

اسم الإشارة

الاسم الموصول

المعرف بـ (ال)

المبتدا والخبر

كان وأخواتها

المشبهات بـ(ليس)

كاد واخواتها (أفعال المقاربة)

إن وأخواتها

لا النافية للجنس

ظن وأخواتها

الافعال الناصبة لثلاثة مفاعيل

الأفعال الناصبة لمفعولين

الفاعل

نائب الفاعل

تعدي الفعل ولزومه

العامل والمعمول واشتغالهما

التنازع والاشتغال

المفعول المطلق

المفعول فيه

المفعول لأجله

المفعول به

المفعول معه

الاستثناء

الحال

التمييز

الحروف وأنواعها

الإضافة

المصدر وانواعه

اسم الفاعل

اسم المفعول

صيغة المبالغة

الصفة المشبهة بالفعل

اسم التفضيل

التعجب

أفعال المدح والذم

النعت (الصفة)

التوكيد

العطف

البدل

النداء

الاستفهام

الاستغاثة

الندبة

الترخيم

الاختصاص

الإغراء والتحذير

أسماء الأفعال وأسماء الأصوات

نون التوكيد

الممنوع من الصرف

الفعل المضارع وأحواله

القسم

أدوات الجزم

العدد

الحكاية

الشرط وجوابه


الصرف

موضوع علم الصرف وميدانه

تعريف علم الصرف

بين الصرف والنحو

فائدة علم الصرف

الميزان الصرفي

الفعل المجرد وأبوابه

الفعل المزيد وأبوابه

أحرف الزيادة ومعانيها (معاني صيغ الزيادة)

اسناد الفعل الى الضمائر

توكيد الفعل

تصريف الاسماء

الفعل المبني للمجهول

المقصور والممدود والمنقوص

جمع التكسير

المصادر وابنيتها

اسم الفاعل

صيغة المبالغة

اسم المفعول

الصفة المشبهة

اسم التفضيل

اسما الزمان والمكان

اسم المرة

اسم الآلة

اسم الهيئة

المصدر الميمي

النسب

التصغير

الابدال

الاعلال

الفعل الصحيح والمعتل

الفعل الجامد والمتصرف

الإمالة

الوقف

الادغام

القلب المكاني

الحذف


المدارس النحوية

النحو ونشأته

دوافع نشأة النحو العربي

اراء حول النحو العربي واصالته

النحو العربي و واضعه

أوائل النحويين


المدرسة البصرية

بيئة البصرة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في البصرة وطابعه

أهم نحاة المدرسة البصرية


جهود علماء المدرسة البصرية

كتاب سيبويه

جهود الخليل بن احمد الفراهيدي

كتاب المقتضب - للمبرد


المدرسة الكوفية

بيئة الكوفة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الكوفة وطابعه

أهم نحاة المدرسة الكوفية


جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود الكسائي

الفراء وكتاب (معاني القرآن)


الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف اسبابه ونتائجه

الخلاف في المصطلح

الخلاف في المنهج

الخلاف في المسائل النحوية


المدرسة البغدادية

بيئة بغداد ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في بغداد وطابعه

أهم نحاة المدرسة البغدادية


جهود علماء المدرسة البغدادية

المفصل للزمخشري

شرح الرضي على الكافية

جهود الزجاجي

جهود السيرافي

جهود ابن جني

جهود ابو البركات ابن الانباري


المدرسة المصرية

بيئة مصر ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو المصري وطابعه

أهم نحاة المدرسة المصرية


جهود علماء المدرسة المصرية

كتاب شرح الاشموني على الفية ابن مالك

جهود ابن هشام الانصاري

جهود السيوطي

شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك


المدرسة الاندلسية

بيئة الاندلس ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الاندلس وطابعه

أهم نحاة المدرسة الاندلسية


جهود علماء المدرسة الاندلسية

كتاب الرد على النحاة

جهود ابن مالك


اللغة العربية

لمحة عامة عن اللغة العربية

العربية الشمالية (العربية البائدة والعربية الباقية)

العربية الجنوبية (العربية اليمنية)

اللغة المشتركة (الفصحى)


فقه اللغة

مصطلح فقه اللغة ومفهومه

اهداف فقه اللغة وموضوعاته

بين فقه اللغة وعلم اللغة


جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى

جهود المحدثين


اللغة ونظريات نشأتها

حول اللغة ونظريات نشأتها

نظرية التوقيف والإلهام

نظرية التواضع والاصطلاح

نظرية التوفيق بين التوقيف والاصطلاح

نظرية محاكات أصوات الطبيعة

نظرية الغريزة والانفعال

نظرية محاكات الاصوات معانيها

نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية


نظريات تقسيم اللغات

تقسيم ماكس مولر

تقسيم شليجل


فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

لمحة تاريخية عن اللغات الجزرية

موطن الساميين الاول

خصائص اللغات الجزرية المشتركة

اوجه الاختلاف في اللغات الجزرية


تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللغات الشرقية

اللغات الغربية


اللهجات العربية

معنى اللهجة

اهمية دراسة اللهجات العربية

أشهر اللهجات العربية وخصائصها

كيف تتكون اللهجات

اللهجات الشاذة والقابها


خصائص اللغة العربية

الترادف

الاشتراك اللفظي

التضاد


الاشتقاق

مقدمة حول الاشتقاق

الاشتقاق الصغير

الاشتقاق الكبير

الاشتقاق الاكبر

اشتقاق الكبار - النحت

التعرب - الدخيل

الإعراب

مناسبة الحروف لمعانيها

صيغ اوزان العربية


الخط العربي

الخط العربي وأصله، اعجامه

الكتابة قبل الاسلام

الكتابة بعد الاسلام

عيوب الخط العربي ومحاولات اصلاحه


أصوات اللغة العربية

الأصوات اللغوية

جهود العرب القدامى في علم الصوت

اعضاء الجهاز النطقي

مخارج الاصوات العربية

صفات الاصوات العربية


المعاجم العربية


علم اللغة

مدخل إلى علم اللغة

ماهية علم اللغة

الجهود اللغوية عند العرب

الجهود اللغوية عند غير العرب


مناهج البحث في اللغة

المنهج الوصفي

المنهج التوليدي

المنهج النحوي

المنهج الصرفي

منهج الدلالة

منهج الدراسات الانسانية

منهج التشكيل الصوتي


علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة وعلم النفس

علم اللغة وعلم الاجتماع

علم اللغة والانثروبولوجيا

علم اللغة و الجغرافية


مستويات علم اللغة

المستوى الصوتي

المستوى الصرفي

المستوى الدلالي

المستوى النحوي

وظيفة اللغة

اللغة والكتابة

اللغة والكلام


تكون اللغات الانسانية

اللغة واللغات

اللهجات

اللغات المشتركة

القرابة اللغوية

احتكاك اللغات

قضايا لغوية أخرى


علم الدلالة

ماهية علم الدلالة وتعريفه

نشأة علم الدلالة

مفهوم الدلالة


جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود الجاحظ

جهود الجرجاني

جهود الآمدي

جهود اخرى

جهود ابن جني

مقدمة حول جهود العرب


التطور الدلالي

ماهية التطور الدلالي

اسباب التطور الدلالي

تخصيص الدلالة

تعميم الدلالة

انتقال الدلالة

رقي الدلالة

انحطاط الدلالة

اسباب التغير الدلالي

التحول نحو المعاني المتضادة

الدال و المدلول

الدلالة والمجاز

تحليل المعنى


المشكلات الدلالية

ماهية المشكلات الدلالية

التضاد

المشترك اللفظي

غموض المعنى

تغير المعنى

قضايا دلالية اخرى


نظريات علم الدلالة الحديثة

نظرية السياق

نظرية الحقول الدلالية

النظرية التصورية

النظرية التحليلية

نظريات اخرى

النظرية الاشارية

مقدمة حول النظريات الدلالية

موضوعات أخرى
ابن السيد البطليوسي
المؤلف:
د. محمد المختار ولد أباه
المصدر:
تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب
الجزء والصفحة:
ص240- 243
29-03-2015
4186
من مشاهير علماء الأندلس، أبو محمد عبد اللّه بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسي، لقد تنقل هذا العالم بين حواضر الجزيرة، من بطليوس، إلى طليطلة عند بني ذي النون، و في السهلة مع بني رزين، ثم لجأ إلى بني هود في سر قسطة، ثم عاد إلى قرطبة في عهد ابن الحاج، و أخيرا استقر ببلنسية و عكف على الإقراء و التأليف.
أخذ ابن السيد عن شيوخ عصره أمثال اللغوي أبي بكر عاصم بن أيوب، و المحدث أبي علي الغسافي، و عبد الدايم بن خير القيراوني، و ألف مصنفات عدة أكثرها في علوم اللغة، فمنها ما يتناول علاقة اللغة بمسائل أصول الفقه. مثل كتابه في أسباب الخلاف بين المسلمين، الذي جعل مرده إلى ثمانية أوجه:
الأول: اشتراك الألفاظ و المعاني.
الثاني: الحقيقة و المجاز.
الثالث: الإفراد و التركيب.
الرابع: الخصوص و العموم.
الخامس: الرواية و النقل.
السادس: الاجتهاد فيما لا نص فيه.
السابع: الناسخ و المنسوخ.
الثامن: الإباحة و التوسيع.
أما كتبه في اللغة و النحو، فمن أشهرها إصلاح الخلل الواقع في الجمل، و الحلل في شرح أبيات الجمل كما شرح فصيح ثعلب، و مثلثات قطرب و أبيات المعاني. و شرح أدب الكاتب لابن قتيبة، و ديوان المتنبي، و سقط الزند للمعري و الفروق بين الحروف الخمسة.
و من خلال هذه المؤلفات نلاحظ نزعة ابن السيد اللغوية و الأدبية، فكان من أولئك الأندلسيين الذين جمعوا بين الشعر و اللغة و النحو و الأصول. و كانت المسحة الشعرية تطبع نهجه في التأليف، و لا ننسى أنه كان شاعرا مجيدا يمدح الأمراء على طريقة المتنبي، و ينشئ الخمريات على منوال أبي نواس فيقول:
ص240
غير أن عنايته بكتاب سيبويه، جعلته يختار ما يراه أقرب إلى القياس، و هذا مثال على ذلك، ففي إعمال خبر «إن» فيما قبلها، يورد الخلاف بين المبرد و المازني. فالمبرد يجيزه مع «أما» و يمنعه مع غيرها. و يقول ابن السيد (و أما سيبويه فإنه قال في كتابه قولا مشكلا
ص241
يمكن أن يتناول مذهب أبي العباس و هو الأظهر فيه، و يمكن أن يناول مذهب المازني) (10). و قد اختار هو مذهب المبرد.
أما نزعته المنطقية فإنها تظهر في طرق احتجاجه، و أسلوبه الجدلي في تقرير رأيه، و دفع اعتراض من يفترض أنه غير مقتنع بقوله. فأكثر من قوله: فإن قال قائل. . . فالجواب. . . و فيما يلي أمثال على هذا النهج من شرحه لشواهد الجمل.
فعند قول جرير:
و مذهب المبرد أن «تيما» الأول مضاف إلى محذوف دل عليه ما يعده كأنه قال يا تيم عدي. و ذهب الفراء إلى نحو هذا، فتكون في تيم الأول حركة إعراب، و في تيم الثاني حركة بناء على مذهب سيبويه و الحركتان على مذهب أبي العباس حركة إعراب.
و من اعتقد أن الاسمين معا جعلا اسما واحدا بمنزلة حضر موت و بعلبك و أضيفا إلى عدي كانت حركة تيم الأول حركة بناء و حركة تيم الثاني حركة إعراب. و أجاز السيرافي أن تكون بمنزلة يا زيد بن عمر. و جعل الموصوف مع صفته بمنزلة اسم واحد، فيجري زيد في هذا الرأي مجرى عطف البيان الجاري مجرى الصفة.
و قوله «لا أبالكم» : «لا» تبرئة حذف خبرها، كأنه قال «لا أبالكم موجود في الدنيا» فإن قلت: فما الذي يمنع أن يكون «لكم» و الخبر فلا يحتاج إلى إضمار؟ فالجواب أن المانع في ذلك هو ظهور الألف في الأب، لأن حروف المد و اللين في الأب و أخواته أصول، إنما تثبت في حال الإضافة، فوجب من أجل أن الألف تكون مضافا إلى الضمير، و تكون اللام مقحمة تأكيدا للإضافة، و إذا كان الأمر على ما وصفناه يبطل أن يكون «لكم» الخبر، و إنما يكون المجرور هو الخبر إذا حذفت الألف، و قلت لا أب لك، كقول نهار بن تولعة اليشكري.
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
ص242
(فإن قيل كيف يصح أن يقال في شيء واحد إنه معتد به، و غير معتد به و هل هذا إلا بمنزلة الجمع بين النقيضين؟ فالجواب أنه إنما كان يعد جمعا بين نقيضين لو قلنا إنه معتد به من جهة واحدة بمعنى واحد و إذا اختلفت الجهتان لم يلزم هذا الذي اعترضت له لأنه لا ينكر أن يكون الشيء معتدا به من جهة ما و غير متعد به من جهة أخرى) .
(فإن قال قائل فإذا قلتم لا أبا لزيد، بم تخفضون زيدا؟ بإضافة الأب؟ أو باللام؟ فالجواب أن الاختيار عندنا أن يكون مخفوضا باللام لا بالإضافة، و العلة في ذلك أنه لما اجتمع عاملان، و لم يجز أن يجر زيد بهما جميعا-إذ لا يعمل عاملان في معمول واحد في حالة واحدة، من جهة واحدة-لم يكن بد من تعليق أحدهما عن العمل و إعمال الآخر، فكان تعليق الاسم أولى لوجهين:
أحدهما: أنا قد وجدنا الأسماء تعلق عن العمل في نحو قولهم: مررت بخير و أفضل من ثم، و قطع يد و رجل من قاله. و قال الفرزدق:
الوجه الثاني: أن الاسم أقوى من الحرف، و الأقوى يحتمل من التعليق و الحذف ما لا يحتمله الأضعف، كذلك قال ابن جني، و أجاز القول الأول و هو تعليق الاسم. و يمكن من علق الحرف أن يقول إنا قد وجدنا الحروف تعلق في الحكاية كقول الراجز:
_________________________
(1) المقري: أزهار الرياض،3 / 109.
(2) المقري: أزهار الرياض، 3 / 112.
(3)) القفطي: انباه الرواة، 3/ 142.
(4) الاقتضاب، ص 15.
(5) الخلاف، ص 113.
(6) السيوطي: الأشباه و النظائر، 1/ 228.
(7) الاقتضاب، ص 31.
(8) السيوطي: الأشباه و النظائر، 2/ 113.
(9) ابن هشام المعتز، 1/ 172.
(10) الاقتضاب، ص 15.
(11) الحلل في شرح أبيات الجمل، ص215.
 الاكثر قراءة في أهم نحاة المدرسة الاندلسية
الاكثر قراءة في أهم نحاة المدرسة الاندلسية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













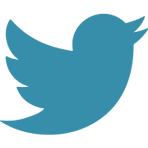

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)