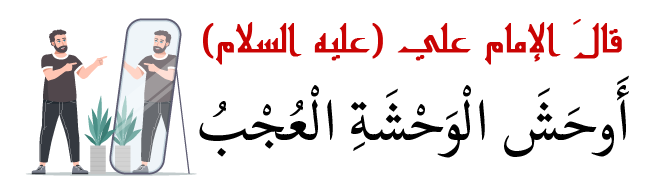
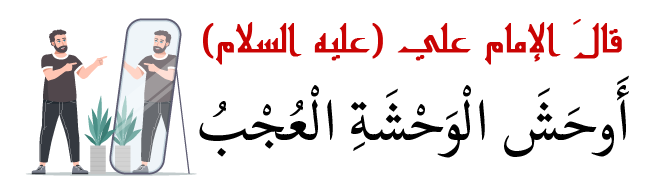

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-24
التاريخ: 30-9-2016
التاريخ: 4-2-2022
التاريخ: 24-2-2022
|
هو : انخداع الإنسان بخِدعةٍ شيطانيّة ورأيٍ خاطئ ، كمَن ينفق المال المغصوب في وجوه البرِّ والإحسان ، معتقداً بنفسه الصلاح ، ومؤمّلاً للأجر والثواب ، وهو مغرورٌ مخدوع بذلك .
وهكذا ينخدع الكثيرون بالغرور ، وتلتبس به أعمالهم ، فيعتقدون صحّتها ونُجحها ، ولو محصوها قليلاً ، لأدركوا ما تتّسم به مِن غرورٍ وبطلان .
لذلك كان الغرور مِن أخطر أشراك الشيطان ، وأمضى أسلحته ، وأخوَف مكائده .
وللغرورِ صِوَرٌ وألوانٌ مختلفة باختلاف نزَعات المغرورين وبواعث غرورهم ، فمنهم المغترّ بزخارف الدنيا ومباهجها الفاتنة ، ومنهم المغترّ بالعلم أو الزعامة ، أو المال ، أو العبادة ونحو ذلك من صِوَر الغرور وألوانه .
وسأعرض في البحث التالي أهمّ صور الغرور وأبرَز أنواعه ، معقّباً على كلّ نوع منها بنصائح علاجيّة ، تجلو غبش الغرور وتخفّف مِن حدّته .
( أ ) الاغترار بالدنيا
وأكثر مَن يتّصف بهذا الغرور هُم : ضُعَفاء الإيمان ، والمخدوعون بمباهج الدنيا ومفاتنها فيتناسَون فناءها وزوالها ، وما يَعقبها مِن حياة أبديّة خالدة ، فيتذرّعون إلى تبرير اغترارهم بالدنيا ، وتهالكهم عليها ، بزعمَين فاسِدَين ، وقياسَين باطِلَين :
الأوّل : أنّ الدنيا نقد ، والآخرة نسيئة ، والنقد خيرٌ من النسيئة .
الثاني : أنّ لذائذ الأُولى ومتعها يقينيّة ، ولذائذ الثانية - عندهم - مشكوكة ، والمتيقّن خيرٌ مِن المشكوك .
وقد أخطأوا وضلّوا ضلالاً مبيناً ، إذ فاتهم في زعمهم الأوّل ، أنّ النقد خيرٌ من النسيئة إنْ تعادلا في ميزان النفع ، وإلاّ فإنْ رجُحت النسيئة كانت أفضل وأنفع من النقد ، كمَن يُتاجر بمبلغٍ عاجلٍ من المال ، ليربح أضعافه في الآجل ، أو يحتمي عن شهَوات ولذائذ عاجلة توخّياً للصحّة في الآجل المديد .
هذا إلى الفارق الكبير ، والبون الشاسع ، بين لذائذ الدنيا والآخرة ، فلذائذ الأُولى فانية ، منغّصة بالأكدار والهموم ، والثانية خالدة هانئة .
وهكذا أخطأوا بزعمهم الثاني في شكّهم وارتيابهم في الحياة الأخرويّة .
فقد أثبتها الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) والعلماء ، وكثيرٌ من الأُمم البدائيّة الأُولى وأيقنوا بها يقيناً لا يُخالجه الشكّ ، فارتياب المغرورين بالآخرة والحالة هذه ، هَوَس يستنكره الدين والعقل .
ألا ترى كيف يؤمن المريض بنجع الدواء الذي أجمع عليه الأطباء ؟! وإنْ كذّبهم فصبيّ غِر أو مُغفّلٌ بليد .
وبعد أنْ عرَفت فساد ذَينك الزعمَين وبطلانهما ، فاعلم أنّه لم يُصوِّر واقع الدنيا ، ويَعرِض خدعها وأمانيها المُغرِّرة كما صوّرها القرآن الكريم ، وعرّفها أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإذا هي برْقٌ خلّب وسرابٌ خادِع .
أنظر كيف يُصوّر القرآن واقع الدنيا وغرورها ، فيقول تعالى {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [الحديد : 20].
وقال تعالى : {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [يونس : 24].
وقال عزّ وجل : { فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات : 37 - 41] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( ما ذئبان ضاريان في غنمٍ قد فارقها رعاؤها ، أحدُهما في أوّلِها ، والآخر في آخرها ، بأفسَدَ فيها ، من حُبِّ الدنيا [المال] والشرف في دين المسلم ) (1) .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : ( مَثَلُ الحريص على الدنيا ، مثل دودة القز كلّما ازدادت مِن القزِّ على نفسها لفّاً ، كان أبعَد لها من الخروج ، حتّى تموتَ غمّاً ) (2) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( مَن أصبح وأمسى ، والدنيا أكبر همّه ، جعل اللّه تعالى الفقر بين عينيه ، وشتّت أمره ، ولم ينَل مِن الدنيا إلاّ ما قُسِم له ، ومَن أصبح وأمسى والآخرة أكبرُ همّه ، جعل اللّه تعالى الغنى في قلبه ، وجمَع له أمره ) (3) .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إنّما الدنيا فناءٌ وعَناء وغِيَرٌ وعِبَر : فمِن فنائها : أنّك ترى الدهر موتِراً قوسه ، مفوقاً نبله ، لا تُخطئ سهامه ، ولا يشفى جراحه ، يرمي الصحيح بالسقم ، والحيَّ بالموت .
ومِن عنائها : أنّ المرء يجمَع ما لا يأكُل ، ويبني ما لا يَسكن ، ثُمّ يخرج إلى اللّه لا مالاً حمَل ولا بناءً نقَل .
ومن غِيَرِها أنّك ترى المغبوط مرحوماً ، والمرحوم مغبوطاً ، ليس بينهم إلاّ نعيمٌ زلّ ، وبؤسٌ نزَل .
ومن عِبَرها : إنّ المرء يشرف على أمله ، فيتخطّفه أجله ، فلا أمَل مدروك ، ولا مؤمّل متروك ) (4) .
وقال الإمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ( يا هشام ، إنّ العُقلاء زهدوا في الدنيا ، ورغبوا في الآخرة ؛ لأنّهم علموا أنّ الدنيا طالبة مطلوبة ، والآخرة طالبة ومطلوبة : فمَن طلَب الآخرة طلبته الدنيا ، حتّى يستوفي منها رزقه ، ومَن طلَب الدنيا طلبته الآخرة ، فيأتيه الموت ، فيفسد عليه دنياه وآخرته ) .
القانون الخالد :
تواطأ الناس بأسرهم ، على ذمّ الدنيا وشكايتها ، لمعاناة آلامها ، ففرحها مُكدَّر بالحزن وراحتها منغصّة بالعَناء ، لا تصفو لأحد ، ولا يهنأ بها إنسان . وبالرغم مِن تواطئهم على ذلك تباينوا في سُلوكهم وموقفهم من الحياة : فمنهم مَن تعشّقها ، وهام بحبّها ، وتكالَب على حُطامها ، ما صيَرهم في حالة مُزرية ، مِن التنافس والتناحر .
ومنهم مَن زهِد فيها ، وانزوى هارباً مِن مباهجها ومُتعها إلى الأديِرَة والصوامع ، ما جعلَهُم فلولاً مُبعثَرة على هامش الحياة .
وجاء الإسلام ، والناس بين هذين الاتّجاهين المتعاكسين ، فاستطاع بحكمته البالغة ، وإصلاحه الشامل ، أنْ يشرّع نظاماً خالداً ، يؤلّف بين الدين والدنيا ، ويجمَع بين مآرب الحياة وأشواق الروح ، بأُسلوبٍ يُلائم فطرة الإنسان ، ويضمن له السعادة والرخاء .
فتراه تارة يحذّر عشّاق الحياة من خُدعها وغرورها ، ليحررهم من أسرها واسترقاقها ، كما صورته الآثار السالفة .
وأخرى يستدرج المتزمتين الهاربين من زخارف الحياة إلى لذائذها البريئة وأشواقها المرفرفة لئلاّ ينقطعوا عن ركب الحياة ، ويصبحوا عرضة للفاقة والهوَان .
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس منّا مَن ترَك دنياه لآخرته ، ولا آخرته لدُنياه ) (5) .
وقال العالم ( عليه السلام ) : ( اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً ) (6) .
وبهذا النظام الفذ ازدهرت حضارة الإسلام ، وتوغل المسلمون في مدارج الكمال ، ومعارج الرقيّ الماديّ والروحي .
وعلى ضوء هذا القانون الخالد نستجلي الحقائق التالية :
1 - التمتّع بملاذ الحياة ، وطيباتها المحلّلة ، مُستحسن لا ضير فيه ، ما لم يكن مشتملاً على حرام أو تبذير ، كما قال سُبحانه : {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [الأعراف : 32].
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اعلموا عباد اللّه أنّ المتّقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة ، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم ، سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكِنَت ، وأكلوها بأفضل ما أُكِلَت ، فحظُوا مِن الدنيا بما حظى به المُترفون ، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبّرون ، ثُمّ انقلبوا عنها بالزاد المُبلّغ والمتْجر الرابح ).
2 - إنّ التوفر على مقتنيات الحياة ونفائسها ورغائبها ، هو كالأوّل مستحسن محمود ، إلاّ ما كان مختَلساً مِن حرام ، أو صارفاً عن ذكر اللّه تعالى وطاعته .
أمّا اكتسابها استعفافا عن الناس ، أو تذرّعاً بها إلى مرضاة اللّه عزَّ وجل كصلة الأرحام وإعانة البؤَسَاء ، وإنشاء المشاريع الخيريّة كالمساجد والمدارس والمستشفيات ، فإنّه من أفضل الطاعات وأعظم القُرُبات ، كما صرّح بذلك أهل البيت ( عليهم السلام ) :
قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا خير فيمَن لا يجمع المال مِن حلالٍ ، يكفّ به وجهه ويقضي به دينه ، ويصِل به رحمه ) (7) .
وقال رجل لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : واللّه إنّا لنطلب الدنيا ونحبُّ أنْ نُؤتاها .
فقال : ( تحبُّ أنْ تصنع بها ماذا ؟ ) قال : أعُود بها على نفسي وعيالي ، وأصِلُ بها ، وأتصدّق بها ، وأحجُّ ، وأعتمِر .
فقال أبو عبد اللّه : ( ليس هذا طلَب الدنيا ، هذا طلب الآخرة ) (8) .
3 - إنّ حبَّ البقاء في الدنيا ليس مذموماً مطلقاً ، وإنّما يختلف بالغايات والأهداف ، فمن أحبّه لغاية سامية ، كالتزود من الطاعة ، واستكثار الحسنات، فهو مستحسن. ومن أحبّه لغاية دنيئة كممارسة الآثام ، واقتراف الشهوات ، فذلك ذميم مقيت ، كما قال زين العابدين ( عليه السلام ) : ( عَمّرني ما كان عمري بِذلةً في طاعتك ، فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك ) .
ونستخلص ممّا أسلفناه أنّ الدنيا المذمومة هي التي تخدع الإنسان ، وتصرفه عن طاعة اللّه والتأهب للحياة الأخرويّة .
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكُفر والإفلاس في الرجل
مساوئ الاغترار بالدنيا :
1 - من أبرز مساوئ الغرور أنّه يُلقي حجاباً حاجزاً بين العقل وواقع الإنسان ، فلا يتبيّن آنذاك نقائصه ومساويه ، من جشعٍ ، وحرصٍ ، وتكالبٍ على الحياة ، ممّا يُسبّب نقصه وذمّه .
2 - إنّ الغرور يُشقي أربابه ، ويدفعهم إلى معاناة الحياة ، ومصارعتها ، دون اقتناعٍ بالكفاف أو نظرٍ لزوالها المحتوم ، ممّا يُظنيهم ويُشقيهم ، كمّا صوّره الخبَر الآنف الذكر : ( مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ ، كلّما ازدادت على نفسها لفّاً ، كان أبعد لها مِن الخروج ، حتّى تموت غماً ) .
3 - والغرور بعد هذا وذاك ، مِن أقوى الصوارف والمُلهيات عن التأهّب للآخرة والتزوّد من الأعمال الصالحة ، الموجبة للسعادة الأخرويّة ، ونعيمها الخالد .
وقال تعالى : {فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات : 37 - 41].
علاج هذا الغرور :
وهو كما يلي مجملاً :
1 - استعراض الآيات والنصوص الواردة في ذم الغرور بالدنيا وأخطاره الرهيبة .
2 - إجماع الأنبياء والأوصياء والحكماء على فناء الدنيا ، وخلود الآخرة ، فجديرٌ بالعاقل أنْ يؤثّر الخالد على الفاني ، ويتأهّب للسعادة الأبديّة والنعيم الدائم {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى : 16 - 19] .
3 - الإفادة من المواعظ البليغة ، والحكم الموجهة ، والقصَص الهادفة المعبرة عن ندم الطغاة والجبارين ، على اغترارهم في الدنيا ، وصرف أعمارهم باللهو والفسوق .
ومِن أبلغ العِظات وأقواها أثراً في النفس كلمة أمير المؤمنين لابنه الحسن ( عليه السلام ) : ( أحي قلبَك بالموعظة ، وأمِته بالزهادة ، وقوّه باليقين ، ونوّره بالحكمة ، وذلّله بذِكر الموت وقرّره بالفناء ، وبصّره فجائع الدنيا ، وحَذّره صَولة الدهر ، وفُحش تقلّب الليالي والأيّام واعرض عليه أخبار الماضين ، وذكّره بما أصاب مَن كان قبلَك مِن الأوّلين ، وسِر في ديارهم وآثارهم ، فانظر فيما فعلوا ، وعمّا انتقلوا ، وأين حلّوا ونزَلوا ، فإنّك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبّة ، وحلّوا ديار الغربة ، وكأنّك عن قليلٍ قد صِرت كأحدِهم ، فأصلح مثواك ، ولا تبِع آخرتَك بدُنياك ) .
ومن روائع الحِكَم التشبيه التالي :
( فقد شبّه الحُكماء الإنسان وانهماكه في الدنيا ، واغتراره بها ، وغفلته عمّا وراءها ، كشخصٍ مُدلىً في بئر ، ووسَطه مشدودٌ بحبل ، وفي أسفل ذلك البئر ثُعبانٌ عظيم ، متوجّه إليه ، منتظرٌ لسقوطه ، فاتحٌ فاهُ لالتقامه ، وفي أعلى ذلك البئر جرذان أبيضٌ وأسود ، لا يزالان يقرِضان ذلك الحبل ، شيئاً فشيئاً ، ولا يفتران عن قرضِه آناً ما ، وذلك الشخص مع رؤيته ذلك الثعبان ومشاهدته لانقراض الحبل آناً فآناً ، قد أقبل على قليلِ عسلٍ ، قد لُطِخ به جِدارُ ذلك البئر وامتزج بترابه ، واجتمع عليه زنابيرٌ كثيرة ، وهو مشغولٌ بلطعه ، منهمكٌ فيه ، متلذّذٌ بما أصاب منه ، مخاصمٌ لتلك الزنابير التي عليه ، قد صرف جميعَ باله إلى ذلك ، فهو غير ملتفتٍ إلى ما فوقه وما تحته .
فالبئر هو الدنيا ، والحبل هو العمر ، والثعبان الفاتح فاه هو الموت ، والجرذان هُما الليل والنهار القارضان للأعمال ، والعسَل المختلط بالتراب هو لذات الدنيا الممزوجة بالكدَر والآثام والزنابير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها ) .
ومِن العِبر البالغة في تصرّم الحياة وإنْ طالت : ما رُوي أنّ نوحاً ( عليه السلام ) عاش ألفَين وخمسمِئة عام ، ثمّ إنّ ملَك الموت جاءه وهو في الشمس ، فقال : السلام عليك .
فرّد عليه نوح ( عليه السلام ) وقال له : ما حاجتك يا ملك الموت ؟ .
قال : جئت لأقبض روحك .
فقال له : تدَعني أتحوّل من الشمس إلى الظلّ .
فقال له : نعم .
فتحوّل نوح ( عليه السلام ) ، ثمّ قال : يا ملك الموت ، فكأنّ ما مرّ بي في الدنيا مثل تحوّلي من الشمس إلى الظلّ !! فامضِ لما أُمِرت به .
فقبض روحه ( عليه السلام ) .
ومِن عِبَر الطُّغاة والجبّارين ما قاله المنصور لمّا حضرته الوفاة : ( بعنا الآخرة بنومة ) .
وردّد هارون الرشيد وهو ينتقي أكفانه عند الموت : {أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} [الحاقة : 28، 29].
وقيل لعبدِ الملك بن مروان في مرَضه : كيف تجدك يا أبا مروان ؟ قال : أجدُني كما قال اللّه تعالى : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [الأنعام : 94].
ورأى زيتون الحكيم رجُلاً على شاطئ البحر مهموماً محزوناً ، يتلهّف على الدنيا ، فقال له : يا فتى ، ما تلهفك على الدنيا ! لو كنت في غاية الغنى ، وأنت راكبٌ لجّةَ البحر ، وقد انكسرت بك السفينة ، وأشرفت على الغرَق ، أما كانت غاية مطلوبك النجاة ، وإنْ يفوتك كلّ ما بيدك .
قال : نعم .
قال : ولو كنت ملِكاً على الدنيا ، وأحاط بك مَن يريد قتلك ، أما كان مرادك النجاة مِن يده ، ولو ذهب جميع ما تملك .
قال : نعم .
قال : فأنتَ ذلك الغنيُّ الآن ، وأنت ذلك الملكُ ، فتسلّى الرجل بكلامه .
وقال بعض العارفين لرجلٍ مِن الأغنياء : كيف طلبك للدنيا ؟.
فقال : شديد .
قال : فهل أدركت منها ما تريد ؟.
قال : لا .
قال : هذه التي صرَفت عُمرك في طلبِها لم تحصَل منها على ما تريد فكيف التي لم تطلبها !!.
ولا ريب أنّ تلك العِظات لا تنجع إلاّ في القلوب السليمة ، والعقول الواعية ، أما الذين إسترقّتهم الحياة ، وطبعت على قلوبهم ، فلا يجديهم أبلغ المواعظ ، كما قال بعض العارفين : إذا أُشرب القلبُ حبَّ الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ ، كما أنّ الجسَد إذا استحكم فيه الداء ، لم ينجع فيه كثرة الدواء .
( ب ) غرور العلم
ومن صوَر الغرور ومفاتنه ، الاغترار بالعلم ، واتّساع المعارف ، ممّا يثير في بعض الفضلاء الزهو والتيه ، والتنافس البشِع على الجاه ، والتهالك على الأطماع ، ونحوها من الخلال المقيتة التي لا تليق بالجُهّال فضلاً عن العلماء .
وربّما أفرط بعضهم في الزهو والغرور ، فَجُنَّ بجنون العظَمَة ، والتطاول على الناس بالكِبَر والازدراء .
وفات المغترّين بالعِلم ، أنّ العِلم ليس غايةً في نفسه ، وإنّما هو وسيلةٌ لتهذيب الإنسان وتكامله وإسعاده في الحياتين الدنيويّة والأُخروية، فإذا لم يحقّق العِلم تلك الغايات السامية ، كان جُهداً ضائعاً ، وعَناءً مُرهِقاً ، وغروراً خادعاً : {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة : 5] .
وقد أحسن الشاعر حيث يقول :
ولو أنّ أهل العلم صانوه صانهم ولـو عَظّموه في النفوس لعَظُما
ولـكن أهـانوه فـهان وجهّموا مـحيّاه بـالأطماع حتّى iiتجهّما
فالعلم كالغيث ينهلّ على الأرض الطيبة ، فيحيلها جناناً وارفة ، تزخر بالخير والجمال ، وينهلّ على الأرض السبخة فلا يجديها نفعاً .
وهكذا يفيء العلم على الكرام طيبةً وبهاءً ، وعلى اللئام خُبثاً ولُؤماً .
وكيف يغترُّ العالِم بعلمه ، ولم يكن الوحيد في مضماره ، فقد عرَف الناس قديماً وحديثاً عُلماءً أفذاذاً جَلّوا في ميادين العلم ، وحَلّقوا في آفاقه ، وكانت لهم مآثرهم العلميّة الخالدة .
ومسؤوليّة العالم خطيرة ، ومؤاخذته أشدّ من الجاهل ، والحجّة عليه ألزَم ، فإنْ لم يهتَدِ بنور العلم ، ويعمل بمقتضاه ، كان العلم وبالاً عليه ، وغدا قدوة سيّئة للناس .
أنظر كيف يصوّر أهل البيت ( عليهم السلام ) جرائر العلماء المنحرفين ، وأخطارهم : فعن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ( قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : صنفان مِن أُمّتي إذا صلُحا صلُحت أُمّتي ، وإذا فسَدا فسدت أُمّتي ) قيل : يا رسول اللّه ومَن هما ؟ قال : الفقهاء والأمراء ) (9) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( يُغفر للجاهل سبعون ذنباً ، قبل أنْ يُغفَر للعالم ذنبٌ واحد ) (10) .
وقال النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) : ( يطلع قومٌ من أهل الجنّة إلى قومٍ مِن أهل النار ، فيقولون : ما أدخلَكم النار وقد دخلنا الجنّة لفضلِ تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون : إنّا كنّا نأمر بالخير ولا نفعله ) .
فجديرٌ بالعلماء والفُضلاء أنْ يكونوا قدوةً حسنةً للناس ، ونموذجاً للخُلق الرفيع ، وأنْ يتفادوا ما وسعهم مزالِق الغرور ، وخلاله المَقيتة ، وأنْ يستشعروا الآية الكريمة : { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص : 83].
( ج ) غرور الجاه
ويُعتبَر الجاه والسُّلطة مِن أقوى دواعي الغرور ، وأشدَّ بواعثه ، فترى المتسلّطين يتيهون على الناس زهواً وغروراً ، ويستذلّون كراماتهم صَلَفاً وكِبراً .
وقد عاش الناس هذه المأساة في غالب العصور ، وعانوا غرور المتسلّطين وتحدّيهم ، بأسىً ولوعةٍ بالِغَين .
وفات هؤلاء المغرورين بمفاتن السُّلطة والرِّعَة ، أنّ الإسراف في الغرور والأنانيّة أمرٌ يستنكره الإسلام ويتوعّد عليه بصنوف الإنذار والوعيد ، في عاجل الحياة وآجلها ، كما يعرّضهم لمقت الناس وغضبهم ولعنهم ، ويخسرون بذلك أغلى وأخلَد مآثر الحياة : حبَّ الناس وعطفَهم ، وكان عليهم أنْ يستغلّوا جاههم ، ونفوذهم في استقطاب الناس ، وتوفير رصيدهم الشعبي ، وكسب عواطف الجماهير وودّهم .
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبَد الإحسان إنسانا
وأقوى عامل على تخفيف حدّة هذا الغرور ، وقمع نَزَواته العارمة ، هو التأمّل والتفكّر فيما ينتاب هؤلاء المغرورين مِن صروف الدهر ، وسطوة الأقدار ، وتنكّر الزمان . فصاحب السلطان كراكب الأسد ، لا يدري أمَدَ غضَبه وافتراسه .
وقد زخَر التاريخ بصنوف العِبَر والعِظات الدالّة على ذلك : ومنها : ما ذكره عبد اللّه بن عبد الرحمان صاحب الصلاة بالكوفة ، قال : دخلت إلى أُمّي في يوم أضحى ، فرأيت عندها عجوزاً في أطمارٍ رثّة ، وذلك في سنة (190)، فإذا لها لسانٌ وبيان ، فقلت لأُمّي : مَن هذه ؟ .
قالت : خالتك عباية أُمّ جعفر بن يحيى البرمكي .
فسلّمت عليها ، وتحفّيت بها ، وقلت : أصارك الدهر إلى ما أرى ؟!.
فقالت : نعم يا بني ، إنّا كنّا في عواري ارتَجَعها الدهر منّا .
فقلت : فحدّثيني ببعض شأنك .
فقالت : خذه جملة ، لقد مضى عليّ أضحى ، وعلى رأسي أربعمِئة وصيفة ، وأنا أزعم أنّ ابني عاق ، وقد جئتك اليوم أطلب جلدَتَي شاة ، اجعل إحداهما شِعاراً ، والأُخرى دِثاراً .
قال فرَفَقت لها ، ووهبْت لها دراهم ، فكادت تموت فرحاً (11) .
ودخل بعض الوعّاظ على الرشيد ، فقال : عِظني ، فقال له : أتراك لو مُنِعتَ شربةً من ماء عند عطشِك ، بِمَ كنت تشتريها ؟.
قال : بنصف مُلكي .
قال : أتراها لو حُبِسَت عند خروجها بِمَ كنت تشتريها ؟ .
قال : بالنصف الباقي .
قال : فلا يغرّنّك مُلك قيمته شربة ماء .
فجديرٌ بالعاقل أنْ يدرك أنّ جميع ما يزهو به ، ويدفعه على الغرور من مال ، أو علم ، أو جاه ونفوذ ، إنّما هي نِعَمٌ وألطافٌ إلهيّة أسداها المنعم الأعظم ، فهي أحرى بالحمد ، وأجدر بالشكر منها بالغرور والخُيَلاء .
الجاه بين المدح والذم :
ليس طلب الجاه مذموماً على الإطلاق ، وإنّما هو مختلف باختلاف الغايات والأهداف ، فمن طلبه لغايةٍ مشروعة ، وهدَفٍ سامٍ نبيل ، كنصرة المظلوم ، وعون الضعيف ، ودفع المظالم عن نفسه أو غيره ، فهو الجاه المحبّب المحمود .
ومَن توخّاه للتسلّط على الناس ، والتعالي عليهم ، والتحكّم بهم ، فذلك هو الجاه الرخيص الذميم.
وقد تلتبس الغايات أحياناً في بعض صور الجاه ، كالتصدّي لإمامة الجماعة ، وممارسة توجيه الناس وإرشادهم ، وتسنّم المراكز الروحيّة الهامّة .
فتتمّيز الغايات آنذاك بما يتّصف به ذووها من حسن الإخلاص ، وسموّ الغاية، وحُبّ الخير للناس ، أو يتّسمون بالأنانيّة ، والانتهازيّة ، وهذا مِن صور الغرور الخادعة ، أعاذنا اللّه منها جميعاً .
(د) غرور المال
وهكذا يستثير المال كوامن الغرور ، ويعكِس على أربابه صوَراً مَقيتة من التلبيس والخداع .
فهو يفتن الأثرياء من عشّاق الجاه ، ويحفّزهم على السخاء والأريحيّة ، بأموالٍ مشوبةً بالحرام ويحبسون أنّهم يحسنون صنعاً ، وهُم مخدوعون مغرورون .
وقد يتعطّف بعضهم على البؤساء والمعوزين جهراً ويشحّ عليهم سرّاً ، كسباً للسمعة والإطراء وهو مغرورٌ مفتون .
ومنهم مَن يمتنع عن أداء الحقوق الإلهية المحَتّمة عليه بُخلاً وشُحّاً ، مكتفياً بأداء العبادات التي لا تتطلّب البذل والإنفاق ، كالصلاة والصيام ، زاعماً براءة ذِمّته بذلك ، وهو مفتونٌ مغرور إذ يجب أداء الفرائض الإلهيّة ماديّة وعباديّة ، ولكلِّ فرضٍ أهميّته في عالم العقيدة والشريعة .
ومِن أجل ذلك كان المال من أخطر بواعث الغرور ومفاتنه .
فعن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يُعييني منه واحدة من ثلاثة : أخذُ مالٍ من غير حلّه ، أو مَنعه من حقّه ، أو وضعِه في غير وجهه ) .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) : إنّ الدينار والدرهم أهلَكا مَن كان قبلكم ، وهُما مهلكاكم ) (12) .
المال بين المدح والذم :
للمال محاسنه ومساوئه ، ومضارّه ومنافعه ، فهو يُسعِد ويُشقي أربابه تبَعاً لوسائل كسبه وغايات إنفاقه .
فمن محاسنه : أنّه الوسيلة الفعّالة لتحقيق وسائل العيش ، ونيل مآرب الحياة ، وأشواقها الماديّة والسبب القويّ في عزّة ملاكه واستغنائهم عن لئام الناس ، والذريعة الهامّة في كسب المحامد والأمجاد , كما قال الشريف الرضي رحمه اللّه :
اشـتر الـعِزّ بما iiبِيع فـمـا الـعز iiبـغالي
بـالقصار الصفر iiإنْ شِئت أو السمر الطوالِ
لـيس بالمغبون iiعقلاً مَـن شرى عزَّاً iiبمالِ
إنـما يُـدَّخَر iiالـمالُ لـحـاجاتِ iiالـرجالِ
والـفتى مَـن iiجَـعل الأموال أثمان iiالمعالي
كما أنّ المال مِن وسائل التزوّد للآخرة ، وكسب السعادة الأبديّة فيها .
ومِن مساوئ المال : أنّه باعثٌ على التورّط في الشُّبُهات ، واقتراف المحارم والآثام ، كاكتسابه بوسائل غير مشروعة ، أو منع الحقوق الإلهيّة المفروضة عليه ، أو إنفاقه في مجالات الغواية والمنكرات ، كما أوضحت غوائله النصوص السالفة .
وهو إلى ذلك من أقوى الصوارف والملهيات عن ذكر اللّه عزّ وجل ، والتأهّب للحياة الأخرويّة الخالدة .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } [المنافقون : 9] .
فليس المال مذموماً إطلاقاً ، وإنّما يختلف باختلاف وسائله وغاياته ، فإنْ صحّت ونَبُلَت كان مَدعاة للحمد والثناء ، وإنْ هبطت وأسفّت كان مَدعاة للذمّ والاستنكار .
ولمّا كانت النفوس مشغوفةً بالمال ، ومولعةً بجمعه واكتنازه ، فحريٌّ بالمؤمن الواعي المستنير أنْ لا ينخدع ببريقه ، ويغترّ بمفاتنه ، وأنْ يتّعظ بحرمان المغرورين به ، والحريصين عليه من كسب المثوبة في الآخرة ، وإفلاسهم ممّا زاد عن حاجاتهم وكفافهم في الدنيا ، فإنهم خزّان أمناء يكدحون ويشقون في ادخاره ، ثمّ يخلّفونه طعمة سائغة للوارثين ، فيكون عليهم الوزر ولأبنائهم المُهنّى والاغتباط .
( هـ ) غرور النسب
وقد يغترُّ بعضهم برفعة أنسابهم ، وانحدارهم من سلالة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحسبون أنّهم ناجون بزلفاهم ، وإنْ انحرفوا عن نهجِهم ، وتعسّفوا طُرق الغواية والضلال .
وهو غرور خادع حيث إنّ اللّه تعالي يُكرم المطيع ولو كان عبداً حبشيّاً ، ويهين العاصي ولو كان سيّداً قرشيّاً .
وما نال أهل البيت ( عليهم السلام ) تلك المآثر الخالدة ، ونالوا شرف العزّة والكرامة عند اللّه عزَّ وجل ، إلاّ باجتهادهم في طاعة اللّه ، وتفانيهم في مرضاته .
فاغترار الأبناء بشرف آبائهم وعراقتهم ، وهُم منحرفون عن سيرتهم ، من أحلام اليقظة ومفاتن الغرور .
أرأيت جاهلاً غدا عالماً بفضيلة آبائه ؟ أو جباناً صار بطلاً بشجاعة أجداده ؟ أو لئيماً عاد سخيّاً معطاءً بجود أسلافه ؟ كلا ، ما كان اللّه تعالى ليساوي بين المطيع والعاصي ، وبين المجاهد والوادع .
أنظر كيف يقصّ القرآن الكريم ضراعة نوح ( عليه السلام ) إلى ربِّه في استشفاع وليده الحبيب ونجاته من غَمَرات الطوفان الماحق ، فلم يُجده ذلك لكفر ابنه وغوايته : {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود : 45 - 46] .
واستمع إلى سيّد المرسلين ( صلّى اللّه عليه وآله ) كيف يُملي على أسرته الكريمة درساً خالداً في الحثِّ على طاعة اللّه تعالى وتقواه ، وعدم الاغترار بشرف الأنساب والأحساب ، كما جاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : ( قام رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) على الصفا فقال : يا بني هاشم ، يا بني عبد المطّلب ، إنّي رسول اللّه إليكم ، وإنّي شفيقٌ عليكم ، وإنّ لي عملي ، ولكلِّ رجلٍ منكم عملُه ، لا تقولوا إنّ محمّداً منّا ، وسنُدخَل مُدخله ، فلا واللّه ، ما أوليائي منكم ، ولا مِن غيركم ، يا بني عبد المطّلب إلاّ المتّقون ، ألا فلا أعرفكم يوم القيامة تأتون تحملون الناس على ظهوركم ، ويأتي الناس يحملون الآخرة ، ألا إنّي قد أُعذِرت إليكم فيما بيني وبينكم ، وفيما بيني وبين اللّه تعالى فيكم )(13) .
فجديرٌ بالعاقل أنْ يتوقّى فتنة الغرور بشرف الأنساب ، وأنْ يسعى جاهداً في تهذيب نفسه وتوجيهها وجهة الخير والصلاح ، متمثّلاً قول الشاعر :
إنّ الفتى مَن يقول ها أنذا ليس الفتى مَن يقول كان أبي .
____________________
1- ، 2- الوافي : ج 3 , ص 152 , عن الكافي .
3- الوافي : ج 3 , ص 154 , عن الكافي .
4- سفينة البحار : ج 1 , ص 467 .
5- ، 6- الوافي : ج 10 , ص 9 , عن الفقيه .
7- الوافي : ج 10 , ص 9 , عن الكافي .
8- الوافي : ج 10 , ص 9 , عن الكافي .
9- البحار : م 1 , ص 83 , عن خصال الشيخ الصدوق .
10- الوافي مجلّد العقل والعلم : ص 52 , عن الكافي .
11- سفينة البحار : م 2 , ص 609 .
12- الوافي : ج 3 , ص 152 , عن الكافي .
13- الوافي : ج 3 , ص 60 , عن الكافي .



|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|