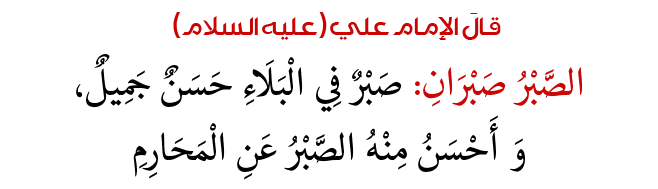
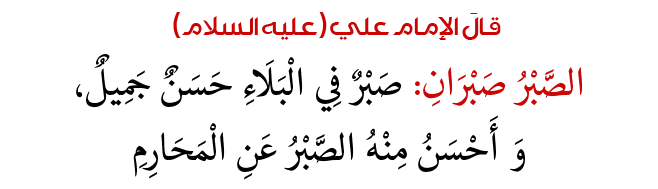

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2016
التاريخ: 26-8-2016
التاريخ: 29-8-2016
التاريخ: 31-8-2016
|
..المطلق ... ما دل على شايع في جنسه، والظاهر ان المراد من الجنس في المقام هو السنخ، لا الجنس المصطلح عند المنطقيين: أي الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، قبال النوع، ولا ما هو المصطلح منه عند النحويين: أي الماهيات الكلية المقصورة بأسامي الاجناس، كيف وان من المعلوم صحة اطلاقه على الافراد المعينة الشخصية بلحاظ الحالات الطارئة عليها، كما في زيد، حيث انه مع شخصيته يكون مطلقا بلحاظ حال القيام والقعود والمجيء وغيره من الحالات، فكان ذلك حينئذ شاهدا على ان المراد من الجنس المأخوذ في تعريفه هو مطلق السنخ الصادق على الذوات الشخصية الخارجية ولو بلحاظ تحليل الذوات الشخصية إلى حصص سارية في ضمن الحالات المتبادلة، وعلى الحصص السارية في ضمن افراد الطبيعي كالحيوان والانسان مثلا، غير ان الفرق بينهما هو استقلال كل حصة من حصص الطبيعي فيعالم الوجود، بخلافه في الحصص السارية من الذوات الشخصية بلحاظ الحالات المتبادلة حيث انها موجودات بوجود واحد ومجتمعات تحت حد واحد في الخارج، ولا يكون التعدد فيه الا بحسب التحليل، ولكن مجرد هذا المقدار من الفرق لا يضر بما هو المطلوب من شمول تعريف المطلق لمثله، كما لا يخفى، فكان المراد من المطلق حينئذ في المقام ما هو المعبر عنه بالفارسية ب (رهاى در مقام انطباق) الغير الممنوع عن الصدق على ما هو من سنخه، في قبال المقيد المعبر عنه بالفارسية ب (بسته در مقام انطباق) الممنوع على الصدق على هو من سنخه، فان تقيد الشيء ببعض القيود كتقيد زيد بالقيام يمنع عن شيوع الحصة المحفوظة
في ضمنه بالنسبة إلى ما كان من سنخه من بقية الحصص، ومن ذلك لا يصدق زيد القائم بلحاظ توصيفه بالقيام على زيد القاعد، وان كان هو ايضا مطلقا باعتبار ما في ضمنه من الحصص بلحاظ الحالات المتبادلة الطارئة كالضحك والتكلم والكتابة وغيرها، وهو واضح. واما الشياع فالمراد به تارة هو سريان الطبيعة في ضمن جميع الافراد، وهو المعبر عنه في اصطلاح بعضهم بالعموم السرياني، واخرى قابلية الطبيعي للانطباق على القليل والكثير انطباقا عرضيا. والمطلق بالمعنى الاول يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي النواهي النفسية، كقوله: لا تشرب الخمر، وفي طي الاحكام الوضعية، كقوله: احل الله البيع ونحوه، حيث انه وان كان نحو ضيق في الطبيعة حينئذ باعتبار عدم الانطباق الا على الكثير، والا انه من جهة لحاظ سريانها في ضمن الافراد كان له اطلاق، في قبال المقيد بقيد خاص غير قابل للانطباق الا على المقيد. وبالمعنى الثاني يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي كثير من الاوامر، والمطلق بهذا المعنى اوسع دائرة من المطلق بمعنى السريان، من جهة عدم اعتبار تقيده بشيء من الخصوصيات حتى خصوصية السريان، فكان من جهة ارساله وعدم تقيده بشيء من الخصوصيات الوجودية والعدمية مجامعا مع كل خصوصية ونقيضها وقابلا للانطباق على القليل والكثير، ومثل هذا المعنى هو المعروف عندهم باللابشرط المقسمي.
ثم انه بعد ما اتضح لك هذه الجهة، يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع في مداليل اسماء الاجناس بين المشهور من القدماء وبين السلطان في انها هل هي الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال؟ أو هي الطبيعة المهملة المجامعة مع التقيد والاطلاق كما عليه السلطان؟ وفي ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو؟ وقبل الخوض في المقصود ينبغي بيان امرين لكي ينكشف بهم الحجاب عن جه المرام:
الاول انه لا شبهة في ان للماهية تصورات بحسب التعقل الاولى: منها: تعلقها مقيدة ومع الضميمة والشرط، كالانسان الملحوظ معه خصوصية الزيدية وكالرقبة الملحوظ معها خصوصية الايمان مثلا ونحو ذلك من الخصوصيات والضمائم، وقد شاع التعبير عن ذلك بالمهية بشرط شيء، وربما عبر عنه ايضا بالمخلوطة قبال المجردة.
ومنها: تعلقها مجردة وبلا شرط وضميمة، وهذا على قسمين: تارة اعتبارها بقيد التجرد عن جميع القيود والخصوصيات، واخرى اعتبارها بنفسها مجردة من غير اعتبار قيد التجرد عن الخصوصيات فيها، فكان تجردها حينئذ من جهة عدم تعدى اللحاظ عن ذات المهية إلى شيء آخر معها، وبعبارة اخرى: الملحوظ في هذا القسم عبارة عما هو مصداق المجرد لا الطبيعة متقيدة بقيد التجرد عن الخصوصيات، بخلاف سابقه فانه قد اعتبر فيه قيد التجرد عن الخصوصيات، وقد عبروا عن الاول باللابشرط القسمي وعن الثاني باللابشرط المقسمي، وقالوا بامتناع صدق الاول وانطباقه على الخارجيات لكونه كليا عقليا لا موطن له الا في الذهن، بخلاف الثاني فانه من جهة عدم اعتباره مقيدا بقيد التجرد كان قابلا للانطباق على الخارج وللصدق على القليل والكثير. ومنها اعتبارها بنحو السريان في ضمن جميع الافراد الملازم لعدم انطباقها الا على الكثير دون القليل. ولكن من الواضح ايضا لزوم ان يكون في البين امر واحد في هذه الاعتبارات يكون هو الجامع، والمقسم لهذه الاقسام في قولك: الماهية اما ان تكون كذا واما ان تكون كذا، وان لم يكن تصوره مستقلا، وذلك من جهة وضوح مبائنة كل واحدة من هذه الاعتبارات في الذهن مع الاعتبار الآخر حتى المهية المجردة على النحو الثاني، فانها ايضا في ظرف اعتبارها كذلك تباين المهية المقيدة والمأخوذة بنحو السريان بحيث لا يكاد انطباقها في ظرف اعتبارها كذلك على المقيدة، وان كانت تنطبق على مصداقها وما بازائها خارجا، ومن ذلك ايضا ترى بناء المشهور على كون استعمال لفظ المطلق في المقيد مجازا، وليس ذلك الا من جهة ما ذكرنا من تبائن كل من المطلق والمقيد بحسب الاعتبار مع الآخر، وعليه فلا يمكن ان تكون المهية المجردة المعبر عنها في مصطلحهم باللابشرط المقسمي هي المقسم حقيقة في هذه الاعتبارات، بل لابد وان يكون ما هو المقسم لها عبارة عن القدر المشترك بين تلك الاعتبارات. والمرجع للضمير في التقسيم في قولك المهية اما ان تكون كذا واما ان تكون كذا، وان لا يمكن تعلقه مستقلا ولا كان له وجود في الذهن بحسب التعقل الاولى الا في ضمن تلك الاعتبارات المختلفة، نظير المادة المأخوذة في المشتقات المحفوظة فيضمن الصيغ الخاصة والهيئات المخصوصة، وذلك لان كلما يتصور ويوجد في الذهن من الصور حسب التعقل الاولى لا يخلو من كونها اما صورة واجدة للقيد والخصوصية أو فاقدة لها، فلا صورة ثالثة في البين مستقلا في ذلك الوعاء تكون هي الجامع والقدر المشترك بين الواجد والفاقد الا بالتحليل العقلي حسب التعقل الثانوي، بتحليل كل صورة إلى ذات وخصوصية، ولو كانت الخصوصية هي خصوصية التجرد والفقدان.
ولئن شئت فاستوضح ذلك بالطبيعي في الخارج، فانه كما لا يكون للطبيعي وجود مستقل في الخارج، بل كان وجوده في ضمن افراده، كذلك الجامع في المقام، فلا يكون له في الذهن ايضا وجودا الا في ضمن الصور الخاصة، ولا يكون له وجود مستقل الا بالتحليل العقلي حسب التعقل الثانوي، بتحليل كل صورة إلى ذات وخصوصية، كتحليل الموجود الخارجي إلى ذات وهو الطبيعي وخصوصية، غايته ان الفرق بينهما هو ان التحليل في الموجود الخارجي كان بحسب التعقل الاولى وفى الصور الذهنية بحسب التعقل الثانوي، كما هو واضح. وعلى ذلك فما افادوه في الطبيعة المجردة المطلقة من التعبير عنها باللابشرط المقسمي ،بجعله مقسما لهذه الاعتبارات، وجعل القسمي هي الطبيعة المتقيدة بقيد التجرد عن جميع الخصوصيات منظور فيه، من جهة ما عرفت من عدم كون المجردة مقسما حقيقة لتلك الاعتبارات، وان المقسم لها حقيقة انما هو القدر المشترك المحفوظ في ضمن المجردة وغيرها الذي لا يكون له في الذهن وجود منحاز مستقل الا بحسب التعقل الثانوي. الامر الثاني لا اشكال ظاهرا في ان المراد من المهية المطلقة لدى المشهور في نحو مداليل اسامي الاجناس انما هو القدر المشترك بين المهية المجردة المعبر عنها عندهم باللابشرط المقسمي وبين الطبيعة المأخوذة بنحو السريان في ضمن جميع الافراد كالمواد المأخوذة في طي النواهي، لا ان المراد هو خصوص الطبيعة المجردة التي من شأنه قابلية الانطباق على القليل والكثير، كيف ولازم ذلك هو المصير إلى المجاز في موارد ارادة الساري منها، مع انه كما ترى لا يظن منهم الالتزام به، فان المشهور كما بنو على كونها حقيقة في الطبيعة المطلقة المعبر عنها باللابشرط المقسمي كذلك بنوا على كونها حقيقة في المأخوذة بنحو السريان في ضمن جميع الافراد، وانما خصصوا المجازية في خصوص المقيدة ببعض الخصوصيات، في قبال السلطان القائل بوضعها للطبيعة المهملة وكونها حقيقة مطلقا حتى في المقيدة. وعلى ذلك فبعد اختلاف الاعتبارين: اعتبار المجردة والسارية وبطلان الاشتراك اللفظي لابد لهم من الالتزام بوضعها للقدر المشترك بينهما، كما لا يخفى. وإذا عرفت ذلك نقول: ان المراد من المهية المهملة لدى السلطان ومن تبعه انما هو القدر المشترك بين ما يقبل الانطباق على القليل والكثير كالطبيعة المطلقة وبين مالا يقبل الانطباق الاعلى الكثير أو القليل كالطبيعة السارية والمقيدة، فكان دعوى السلطان على ان اسامى الاجناس كالرقبة مثلا كانت موضوعة للقدر المشترك المحفوظ في جميع تلك الاعتبارات المختلفة الذي هو المقسم الحقيقي لها من دون دخل شيء من تلك الخصوصيات حتى خصوصية التجرد والاطلاق في الموضوع له فيها اصلا وان استفادة الخصوصيات انما كانت بدوال أخر، في قبال المشهور القائلين بوضعها للطبيعة المجردة القابلة للانطباق على القليل والكثير أو للقدر الجامع بينها وبين الطبيعة السارية. ومن ذلك يحتاج مثل السلطان ومن تبعه في هذا المسلك إلى التشبث بقرينة الحكمة في استفادة معنى الشياع والاطلاق عند الاطلاق، باعتبار ملائمة قضية الوضع مع ارادة كل من المطلق والمقيد، بخلاف المشهور فانهم يغنيهم قضية وضع اللفظ للمعنى الاطلاقي عن التشبث بقرينة الحكمة.
وحينئذ فحيث اتضح ذلك نقول بانه لا ينبغي التأمل في ان التحقيق هو ما عليه السلطان من الوضع لنفس المهية المهملة والقدر الجامع المحفوظ بين جميع تلك الصور المختلفة من المجردة والمقيدة والمأخوذة على نحو السريان، كما يشهد له قضية الارتكاز والوجدان في كونها على نحو الحقيقة في جميع الموارد، عند ارادة الخصوصيات بدوال أخر لا من نفس اللفظ باستعماله في الخصوصية، حيث يرى ان استعمال الرقبة مثلا في الرقبة المؤمنة مع ارادة الخصوصية بدال آخر، بعينه كاستعمالها في المجردة عن قيد الايمان، من دون احتياج إلى رعاية عناية في البين اصلا، وان المقصود من الرقبة في قولك: اعتق رقبة، هو المراد والمقصود منها في استعمالها في المقيدة في قولك الرقبة المؤمنة، بلا ارتكاب تجوز وعناية في البين، حيث ان ذلك كاشف ان الموضوع له هو المعنى الجامع والقدر المشترك بين المطلقة والمقيدة، كيف وقد عرفت ان المشهور لابد لهم ايضا من الالتزام بالوضع للقدر المشترك بين الطبيعة الشائعة بنحو السريان وبين الطبيعة الصرفة القابلة للانطباق على القليل والكثير، من جهة ما عرفت من مباينة المهية بكل واحد من الاعتبارين في عالم اعتبارها مع الآخر. وعليه فبعد لابدية الالتزام بالقدر الجامع بين نحوى الاعتبارين المزبورين:
أي اعتبار الشياع، بمعنى السريان، والشياع بمعنى القابلية للانطباق على القليل والكثير، يتوجه الاشكال بانه لِم لمْ يحدد دائرة الجامع بما يعم المقيد بل يقتصر في تحديده بما هو في ضمن الشياعين فتدبر. فلابد حينئذ بعد عدم وجه وجيه للتخصيص بذلك من الالتزام بما عليه السلطان (قدس سره) من الوضع للمهية المبهمة والقدر المحفوظ بين المقيدة وبين الشياعين.
هذا كله في اسامي الاجناس كالانسان والاسد.
واما علم الجنس كأسامة فهو ايضا من هذه الجهة كاسم الجنس، فعند المشهور كان موضوعا للطبيعة المطلقة، وعند السلطان ومن تبعه للطبيعة المهملة، وانما الكلام في انه هل فيه مزية زائدة على اسم الجنس من حيث التعين بالإشارة الذهنية كما عليه المشهور ايضا، بشهادة المعاملة معها معاملة التعريف ولو بدون اداته؟ ام لا، بل كان كاسم الجنس وكان التعريف فيه لفظيا لا معنويا؟ فيه وجهان ثانيهما مختار الكفاية، حيث قال ما محصله:
ان التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بل لحاظ كونه متعينا بالتعين الذهني، وان التعريف فيه كان لفظيا، محضا لا معنويا، كالتأنيث اللفظي في غيره، والا لما صح حمله على الافراد وانطباقه على الخارجيات، من جهة رجوع التقيد المزبور حينئذ إلى التقيد بالوجود الذهني المانع عن الصدق على الخارجيات، فيحتاج حينئذ إلى التجريد في مقام الحمل على الافراد عن تلك الخصوصية والمصير إلى المجاز، مع انه كما ترى، حيث يرى بالوجدان صحة حمله على الافراد وصدقه على الخارجيات من دون تجريد ورعاية عناية مجاز اصلا، خصوصا مع بعد الوضع لمعنى يحتاج إلى التجريد عن الخصوصية دائما عند الاستعمال، فان مثل هذه الجهة مما لا ينبغى صدوره عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم، هذا.
ولكن فيه انه بعد كون الاشارة الذهنية إلى الشيء غير وجوده في الذهن لكون الاشارة الذهنية إلى الشيء عبارة عن توجه النفس إليه في ظرف الفراغ عن وجوده في الذهن، بشهادة صحة تصور امور متعددة في الذهن والاشارة إلى بعضها بانه احسن من ذلك نقول بانه من الممكن حينئذ الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس بحسب المعنى، بدعوى ان الاول موضوع لنفس الطبيعة المطلقة أو المهملة على اختلاف المسكين، والثاني موضوع للطبيعة بما انها معروضة للإشارة الذهنية ولو؟ متقيدة بها، وبعبارة اخرى الموضوع له في علم الجنس هو حصة من الطبيعي تعلقت بها الاشارة الذهنية بلا اخذ جهة التقيد بها في مدلوله ومعناه، وعليه فالفرق بين اسم الجنس وعلمه كان بحسب المعنى حيث انه كان لاسم الجنس سعة اطلاق يشمل ما يشار إليه من الحصص وما
لا يشار إليه منها، بخلافه في علم الجنس، فانه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعي وقعت معروضة للإشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل مال يشار إليه من الحصص، بل يختص بالحصص المعروضة للإشارة، كما انه من جهة عدم اخذ التقيد بالإشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات.
وبالجملة فعلى هذا البيان امكن دعوى الفرق بين علم الجنس واسمه بالمصير إلى ما عليه المشهور من اهل العربية من كون التعريف في علم الجنس معنويا. ثم ان ذلك كله بحسب مقام اصل الثبوت. واما في مقام الاثبات والتصديق بأحد المسلكين فهو راجع إلى اللغة ويتبع التبادر ونحوه، مع انه لا يكون البحث فيه بمهم ايضا في كون التعريف فيه لفظي أو معنويا، من جهة عدم ترتب ثمرة مهمة عليه، كما هو واضح. ثم انه مما ذكرنا ظهر الحال في الجنس المحلى باللام ايضا، حيث انه يمكن دعوى كون اللام فيه موضوع للتعريف ومفيدا للتعين من دون اقتضائه للمنع عن صحة انطباقه على الخارج كي يلزمه التجريد في مقام الحمل على الافراد، كما لا يخفى. نعم في مثل (هذا الرجل) لا باس بدعوى كون اللام فيه للزينة، كما في الحسن والحسين، وذلك ايضا انما هو من جهة ما يلزمه من لزوم تحقق الاشارتين في آن واحد إلى الطبيعة، الذى هو من المستحيل، بملاك استحالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، فتأمل.
فلابد حينئذ من جعل اللام لمحض الزينة، ولكن لا يلزمها كونها للزينة على الاطلاق حتى في غير مورد تعين المدخول بمثل هذا ونحوه، حيث انه من الممكن حينئذ الالتزام بكونها مفيدة للتعريف وتعين المدخول عند عدم تعينه من جهة اخرى. وحينئذ فاللازم هو اثبات هذه الجهة من وضع اللام لغة للتعريف وتعين المدخول، ولا يبعد دعوى كونه كذلك بحسب اللغة من جهة ما هو المتبادر والمنساق منه في مثل قولك: الرجل، والاسد، والحيوان. والامر سهل.
ومن مصاديق المطلق النكرة، وهى عبارة عن الطبيعة المتقيدة بإحدى الخصوصيات، على ان يكون الاحد بيانا ومقدرا لكم القيد، وانه احدى الحصص قبال التمام والبعض والعشرة والعشرين ونحوها، من دون ان يكون عنوان الاحد بنفسه قيدا للطبيعة بوجه اصلا، وإلى ذلك ايضا نظر من عبر عنها بالفرد المنتشر حيث كان المقصود منه هو الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد، لا ان القيد هو هذا العنوان كما يظهر من الكفاية، من حيث ارجاعه النكرة إلى الطبيعة المتقيدة بعنوان الواحد بم هو هذا المفهوم، كيف وان لازمه هو عدم خروجها عن قابلية الانطباق بانطباق عرضي على القليل والكثير، لان مثل هذا العنوان ايضا عنوان كلى كأسامي الاجناس، وتقيده بمفهوم الواحد لا يوجب خروجه عن القابلية للانطباق عرضا على القليل والكثير، وان كان قضية التقيد المزبور تضيق دائرته من جهة اخرى، مع انه كما ترى، فان شان النكرة انما هو عدم الانطباق على المتكثرات الا بانطباق تبادلي.
وهذا بخلاف مالو كان الاحد بيان ومقدرا لما هو كم القيد، وانه احدى الحصص، وكان القيد نفس الحصص والخصوصيات، فان لازم ذلك هو عدم صلاحيتها للانطباق على المتكثر الا بنحو البدلية دون العرضية. وبالجملة فرق واضح بين ان يكون عنوان الواحد بنفسه قيدا للطبيعة وبين ان يكون مقدر لكم القيد وكان القيد هي الخصوصيات، حيث انه على الاول يصدق الطبيعة المتقيدة بالواحد على الكثيرين بانطباق عرضي، بخلافه على الثاني من فرض كونه مقدرا لكم القيد، فانه عليه لا يصدق على الكثيرين الا بانطباق تبادلي، والنكرة المعبر عنه بالفرد المنتشر في قوله (رجل) بنحو التنكير انما كانت من قبيل الثاني دون الاول كم هو واضح.
ثم انه مما يترتب على المسلكين هو تحقق الامتثال على مسلك اخذ عنوان الوحدة قيدا للطبيعة بازيد من واحد فيما لو اتى في مقام الامتثال بعشر واحدات دفعة واحدة، فانه على هذا المسلك يتحقق الامتثال بالجميع، بخلافه على مسلك اخذ عنوان الواحد مقدرا لكم ما هو القيد، فانه عليه لا يتحقق الامتثال الا بواحد منها. ومن لوازم ذلك ايضا هو دخول الخصوصيات طرا تحت الطلب دونه على المسلك الاول حيث كانت الخصوصيات عليه من لوازم المطلوب وخارجة عنه. وربما يثمر هذه الجهة فيما لو قصد الخصوصية في مقام الامتثال، فانه على المسلك الاول يكون تشريعا في قصده من جهة خروجها عن جيز المطلوبية، بخلافه على المسك الثاني، فانه لا يكون فيه تشريع، بل ويتحقق القرب به ايضا وعلى كل حال فالنكرة التي قلنا برجوعها إلى الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد لا يفرق فيها ولا يختلف مدلولها بين وقوعها في حيز الطلب كقوله: جئني برجل وبين وقوعها في حيز الاخبار كقوله: جاء رجل من اقصى المدينة، بل هي في الموردين كانت مستعملة في معناها الحقيقي، غايته انه في الثاني قد علم المراد منه بدال آخر خارجي، وانه حبيب النجار مثلا.
ثم اعلم ان الحمل على الاطلاق لا يختص بالألفاظ المطلقة الغير المقيدة بشيء من الخصوصيات، بل يجرى في كل ما يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال ولو بجهة من الجهات، وعليه فيجرى مقدمات الاطلاق في النكرة ايضا، فانها وان كانت مقيدة بإحدى الخصوصيات، ولكنها من غير تلك الجهة لما كانت يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال، فعند الشك في مدخلية بعض الخصوصيات الاخر فيه تجرى فيها مقدمات الاطلاق، بل وقد عرفت جريان اطلاقات حتى في نحو الاعلام الشخصية ايضا بلحاظ ما يفرض لها من الاطلاق والارسال بلحاظ الحالات، كما لا يخفى.
وكيف كان فبعد ان اتضح وجه الفرق بين المسكين نقول بانه على مسلك المشهور من وضع الالفاظ للطبيعة المطلقة لابد بمقتضى الوضع من الحمل على الاطلاق والارسال عند عدم القرينة على التقييد، من دون احتياج إلى التمسك بقضية مقدمات الحكمة، واما على مسلك السلطان ومن تبعه من الوضع للطبيعة المهملة والجامع المحفوظ بين تلك الصور المجردة الفاقدة للخصوصية والواجدة لها، فحيث ان وضع اللفظ بنفسه غير مقتض للحمل على الاطلاق والارسال من جهة ملائمته مع التقيد ايضا بنحو تعدد الدال والمدلول، فيحتاج في استفادة الاطلاق والشياع إلى ضم قرينة الحكمة التي هي مؤلفة على التحقيق كما سنذكرها ان شاء الله من امور: منها:
كون المتكلم بمدلول لفظه في مقام البيان على مرامه لا في مقام الاهمال والاجمال.
ومنها: عدم نصبه قرينة على التقييد وارادة الخصوصية.
ومنها: عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب أو مطلقا ولو من الخارج على وجه ياتي ان شاء الله تعالى.
حيث انه باجتماع هذه الامور يتم امر الاطلاق ويستكشف منها عدم تقيد موضوع طلبه بشيء من الخصوصيات وانه مأخوذ في اعتباره على نحو الاطلاق والارسال، وبانتفاء بعضها ينتفى امر الاطلاق. نعم ربما يختلف تلك المقدمات بحسب اللوازم ايضا فان المقدمة الاولى مما ينتفي بانتفائها موضوع الاطلاق بحيث لا يكاد وقوع المعارضة بينه وبين ما في القبال من مطلق آخر ولو مع احراز وحدة المطلوب، بل يقدم ذلك المطلق الاخر عليه بلا كلام، بخلاف المقدمة الثانية، فان انتفائها موجب لوقوع المعارضة بينه وبين ما في القبال من مطلق آخر، فينتهي الامر فيهما إلى مقام الجمع أو الترجيح.
وكيف كان فقبل الشروع في شرح مقدمات الاطلاق ينبغى بيان ان نتيجة تلك المقدمات هل هي الحمل على الطبيعة المطلقة الصرفة التي من شانها عدم قابلية انطباقها الا على اول وجود الطبيعي، كما قيل؟ أو الحمل على الطبيعة المهملة وما هو المقسم للطبيعة الصرفة والمقيدة والمأخوذة بنحو السريان في ضمن جميع الافراد التي من شانها سعة قابلية الانطباق على القليل والكثير من الافراد العرضية والطولية؟ حيث ان فيه وجهين اظهر هما الثاني، فان غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الوجه الاول هو دعوى ان كون المتكلم في مقام بيان المراد وعدم نصبه للقرينة على الخصوصية والتقييد يقتضى ان ما اعتبره في لحاظه هو تلك الصورة المجردة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيات حتى خصوصية السريان في ضمن الافراد اعني الطبيعة الصرفة التي من شانه قابلية الانطباق على القليل والكثير عرضيا، ومن لوازمها سقوط الطلب والامر عنه بأول وجودها كما في اغلب المواد المأخوذة في حيز الاوامر، من غير مدخلية في ذلك في مقام طلبه ايضا لشيء من الخصوصيات، والا كان اللازم عليه البيان على مدخلية الخصوصية بمقتضى برهان استحالة نقض الغرض. ولكن يدفعه ان كينونة المتكلم في مقام بيان مراده بعد ان كانت بتوسيط لفظه واظهار ان مدلوله تمام مراده، فلا جرم قضية ذلك بعد عدم نصب القرينة على دخل الخصوصية هو الاخذ بما هو مدلول لفظه الذى هو عبارة على هذا المسلك عن الطبيعة المهملة والمعنى اللابشرط المقسمي المحفوظ في ضمن جميع الاقسام من الصور والاعتبارات المتقدمة التي من شأنها سعة الانطباق على الافراد العرضية والطولية، لا الحمل على الطبيعة المطلقة الصرفة التي من شانها عدم قابلية الانطباق الا على اول وجود كما هو واضح، كيف وان لازم ذلك هو المصير إلى اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعي في حيز الامر أو النهي، والالتزام بكونها منتجة في الاوامر لصرف الطبيعي المنطبق على اول وجوده وفي النواهي للطبيعة السارية من جهة ما هو المعلوم من انحلالية التكليف غالبا فيها خصوصا في النواهي النفسية الشرعية فانه لم يوجد فيها مورد يكون النهي فيه من قبيل صرف الوجود مع انه كما ترى يبعد الالتزام به جدا.
وهذا بخلافه على ما ذكرنا فانه لا يلزمه اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعي في حيز الامر أو النهي، بل النتيجة على هذا المسلك في جميع الموارد عبارة عن معنى وحداني، وهو ذلك المعنى اللابشرط المقسمي المحفوظ في ضمن جميع الاقسام والصور المتقدمة الذى من شانه الانطباق على الافراد العرضية والطولية ولو بتوسيط انطباقه على الطبيعة الصرفة والمأخوذة بنحو السريان.
غاية ما هناك ان الفرق حينئذ بين الاوامر والنواهي من حيث سقوط التكليف بأول وجود في الاول، وعدم سقوطه وانحلالية التكليف إلى تكاليف متعددة في الثاني واقتضائه لامتثالات متعددة انما كان من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعي من حيث الشخصية والسنخية، فحيث ان الغالب في الاوامر هو كون المصلحة فيها على نحو الشخص، وكان من لوازم شخصيتها عقلا حصولها وتحققها بتمامها بأول وجود الافراد، بخلافه في طرف النواهي، فان الغالب في المفاسد فيها هو كونها على نحو السنخ الموجب لمبغوضية الطبيعي مهم وجد وفي ضمن أي فرد تحقق من الافراد العرضية والطولية بالبغض المستقل، اوجب ذلك الفرق المزبور بين الاوامر والنواهي.
وبالجملة فتمام الفرق على هذا المسلك انما هو من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعي من حيث الشخصية والسنخية، والا ففي طرف معروض المصلحة والمفسدة لا يكاد اختلاف نتيجة الحكمة بحسب الموارد، فانه على كل تقدير وفي جميع الموارد عبارة عن ذاك المعنى اللابشرط المقسمي المحفوظ في جميع الاقسام من الاعتبارات المتقدمة الذى عرفت انطباقه على القليل والكثير وعلى الافراد العرضية والطولية، غاية الامر في فرض كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص يسقط التكليف عن الطبيعي بامتثال واحد فعلا أو تركا، من جهة تحقق تمام المصلحة حينئذ بإيجاد واحد. واما في فرض قيام سنخ المصلحة والمفسدة بالطبيعي فلا يسقط التكليف عن الطبيعي رأسا بامتثال واحد، بل لابد من امتثالات متعددة، من جهة اقتضاء المصلحة السنخية لمطلوبية الطبيعي مهما وجدت ولو في ضمن الافراد الطولية.
ففي الحقيقة الاكتفاء بأول وجود في موارد قيام شخص المصلحة أو المفسدة انما هو من جهة القصور في التكليف والمصلحة عن الشمول للوجود بعد الوجود،
لا من جهة القصور في ناحية المتعلق في قابلية الانطباق على ثاني الوجود وثالثه ورابعه، وبينهما فرق واضح.
وهذا بخلافه على المسلك الاول فانه عليه لا مجال للتفرقة بين الاوامر والنواهي من جهة المصلحة والمفسدة من حيث الشخصية والسنخية، وذلك لان مقتضى الطبيعة الصرفة بعد ان كان هو الانطباق على خصوص اول وجود فلازمه انما هو سقوط التكليف رأسا باتيان اول وجود، من غير فرق فيه بين كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص أو السنخ، من جهة حصول تمام السنخ حينئذ تبعا للمتعلق بأول وجود، فلابد حينئذ من المصير في الفرق المزبور بين الاوامر والنواهي إلى اختلاف نتيجة الحكمة وانها في الاوامر هي الطبيعة الصرفة وفي النواهي بملاحظة القرينة النوعية هي الطبيعة السارية كما هو واضح، فتدبر.
وحيثما اتضح هذه الجهة فلنشرع في شرح مقدمات الاطلاق فنقول:
اما المقدمة الاولى التي هي عمدتها وهى كون المتكلم في مقام البيان فتارة يراد به كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية بأعم من كلام به التخاطب وبكلام آخر له ولو منفصلا عن ذلك، في مقابل السلب الكلي، وهو ما إذا لم يكن في مقام البيان رأسا بل في مقام الاهمال والاجمال، وبعبارة اخرى كون المتكلم في مقام بيان مرامه الواقعي بلفظه أو به وبكلام آخر منفصل عن هذا الكلام، واخرى يراد به كون المتكلم في مقام بيان مراده بإعطاء الحجة إلى المخاطب على المراد بلفظ به التخاطب أو به وبما يتصل به من كلام آخر على نحو يعد المجموع عرفا كلاما واحدا، لا مجرد كونه في مقام الجد لبيان المرام الواقعي النفس الأمري، في قبال اهماله من رأس ولو لم يكن في مقام اعطاء الحجة والظهور على المراد إلى المكلف. وربما يختلف هذان المعنيان بحسب اللوازم ايضا، فانه على الاول لو ورد في قباله عام وضعي منفصل يلزمه تقديم ذلك العام الوضعي عليه بلا كلام ورفع اليد به عن اصل ظهوره الاطلاقي وذلك بلحاظ ان اصل ظهوره في الاطلاق وفي كونه تمام المراد حينئذ منوط ومعلق بعدم بيان المتكلم جزء مرامه بكلام آخر فيما بعد، والا فمع وجود البيان على بعض مرامه فيما بعد لا يكاد يكون له هذا الظهور الاطلاقي، فكان اصل ظهوره في الاطلاق وكونه تمام المراد حينئذ من لوازم عدم مجيء القيد ولو بالأصل، وفي مثله من المعلوم انه بالظفر بكل بيان وحجة على القيد يرتفع هذا الاصل بالمرة، كارتفاع اللابيان الذى هو موضوع حكم العقل بالقبح بوجود البيان على التكليف، وعليه فلا يبقى مجال توهم المعارضة بينهما بوجه اصلا، وهذا بخلافه على الثاني فان قضية كون المتكلم في مقام اعطاء الحجة حينئذ انما كان ملازما مع ظهور لفظه في الاطلاق الكاشف عن كونه تمام المراد، بظهور فعلى تنجيزي، من جهة ان اعطاء الحجة على المراد حينئذ لا يكون الا بإعطاء الظهور الكاشف عنه، والا فلا يكون في البين حجة غيره، وحينئذ فمتى لم ينصب في كلام به التخاطب قرينة على القيد والخصوصية، فلاجرم يلزمه استقرار الاطلاقي للفظه، ومع استقرار الظهور الاطلاقي فيه يقع لا محالة التعارض بينه وبين ما في القبال من المقيدات المنفصلة، وفي مثله لا يلاحظ قضية وضعية الظهور اللفظي في المقيدات المنفصلة في تقديمها على ظهوره الاطلاقي، بل بعد استقرار الظهور الاطلاقي فيها ايضا لابد من ملاحظة اقوى الظهورين منهما وتقديمه على الاخر، وهذا بخلافه على الاول فانه عليه لا مجال لتوهم المعارضة بينهما بل لابد من تقديم الظهورات الوضعية في المقيدات المنفصلة على ظهوره الاطلاقي من جهة صلاحيتها للبيانية عليه ورافعيته لأصل ظهوره الاطلاقي، والوجه فيه ما عرفت بان عدم البيان على القيد فيما بعد على ذلك كان مقوم اصل انعقاد الظهور الاطلاقي فيه، فمع مجيء البيان بالوجدان والظفر بالحجة على القيد يرتفع هذا الاصل بالمرة، وبارتفاعه لا يكاد يكون ظهور الاطلاقي لكلامه بوجه اصلا حتى يلاحظ التعارض بينهما، كما لا يخفى.
لا يقال بان ذلك كذلك لول ظهور حال المتكلم في المشي على طبق ما اقتضته الجبلة الاولية والفطرة الارتكازية من ابرازه تمام مقاصده بلفظ به التخاطب لابه وبكلام آخر منفصل عن هذا الكلام، فانه لا اشكال في ان الجبلة والفطرة في كل متكلم بكلام به التخاطب تقتضي كونه بصدد ابراز تمام مرامه الواقعي بمدلول لفظه الملقى إلى المخاطب على نحو كان مدلول لفظه تمام مراده بوصف التمامية، لا في مقام الاهمال رأسا، ولا في مقام بيان مجرد ان المدلول هو المراد ولو لم يكن تمام المراد بوصف التمامية بل كان ذلك جزء مراده، وجزئه الآخر شيء يذكره فيما بعد بكلام آخر غير هذا الكلام، فان ذلك كله وان امكن في نفسه، حيث لا محذور في ذكر المتكلم جزء مرامه بهذا الكلام وجزئه الآخر بكلام منفصل آخر فيما بعد، وبعبارة اخرى لا محذور في كينونة المتكلم في بيان تمام مرامه لكن بأعم من هذ الكلام وكلام آخر فيما بعد، الا انه خلاف ما تقتضيه الجبلة الاولية والارتكاز الفطري، ومن ذلك ترى بانه لا يرتاب احد في الخطابات الشفاهية في الحمل على الاطلاق في قوله: ادخل السوق واشتر اللحم ونحو ذلك، والكشف عن كون مدلول اللفظ تمام المراد، من دون اعتناء باحتمال كون المدلول جزء المراد في حكمه وان جزئه الآخر شيء يذكره فيما بعد بكلام آخر، وعلى ذلك فإذا كان الظاهر من حال المتكلم كونه على طبق تلك الجبلة من كونه بصدد بيان تمام مراده بكلام به التخاطب في قوله: اعتق رقبة مثلا، ولم متصلا بكلامه ذلك ما يدل على اعتبار قيد فيها من الايمان أو الكتابة أو غيرها، فلاجرم في مثله الجبلة المسطورة تقتضي ظهور لفظه في الاطلاق الكاشف عن كونه تمام المراد، من دون احتياج في ذلك إلى التشبث بأصالة عدم مجيء القيد فيما بعد، بل نفس ظهور الحال يكفى في اطلاق المرام، وحينئذ فمع استقرار الظهور الاطلاقي لكلامه بمقتضى المقدمات المزبورة عن الجبلة المسطورة قهرا يلزمه التعارض بينه وبين ما في القبال من المقيدات المنفصلة، من جهة كشف ذلك حينئذ عن كون المدلول تمام المرام وكشف المقيدات المنفصلة عن كون المدلول من الاول جزء المرام لإتمامه الملازم لعدم كون المتكلم من اول الامر على طبق الجبلة من بيان مرامه بلفظ به التخاطب، وعليه فلا فرق بين التقريبين من جهة انه على كل تقدير يستقر الظهور الاطلاقي للفظه، ولا ينثلم ظهوره بقيام دليل منفصل فيما بعد على القيد، سواء فيه على تفسير البيان بإعطاء الحجة والظهور على المراد أو تفسيره ببيان المرام الواقعي النفس الأمري بلفظ به التخاطب.
فانه يقال بعد الفرق الواضح في المقام بين مسلك المشهور من وضع اللفظ للإطلاق كسائر الحقائق، وبين مسلك السلطان (قدس سره) من حيث استتباع المقدمة المزبورة بالجبلة المسطورة على الاول لمطابقة اللفظ الظاهر في نفسه لواقع مرامه لا لأصل انعقاد الظهور، من جهة اقتضاء الوضع فيه لأصل انعقاد الظهور، بخلافه على مسلك السلطان حيث كانت الجبلة المزبورة مقومة لأصل انعقاد الظهور الاطلاقي للفظ.
نقول بان من المعلوم حينئذ ان احراز هذا الظهور وجدانا فرع احرا الجبلة المسطورة كذلك، والا فمع عدم احراز الجبلة واحتمال عدم كون المتكلم فعلا في مقام بيان تمام مرامه بهذا الكلام واحتمال مجيء القيد فيما بعد لا مجال لانعقاد الظهور الاطلاقي على هذ المسلك، وعليه فمرجع احراز تلك الجبلة بظهور حال المتكلم، مع احتمال كونه على خلاف الجبلة والارتكاز وجدانا، بعد ان كان إلى اصالة عدم المانع عن الجبلة، الراجعة إلى اصالة عدم كونه في مقام بيان تمام مرامه بكلام آخر غير هذا الكلام فلا جرم بمجرد مجيء البيان على القيد يلزمه لا محالة ارتفاع هذا الاصل بالمرة، لان مرجع اصالة عدم البيان على القيد التي يناط بها ظهور اللفظ انما هو إلى عدم الحجة عليه ولو بلفظ آخر منفصل عن هذا اللفظ، فمع الظفر بكل بيان وحجة على القيد فيما بعد يرتفع لا محالة هذا الاصل الحاكم بكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بهذا اللفظ، ومع ارتفاعه لا يبقى مجال للظهور الاطلاقي في طرف المطلق حتى يعارض الظهور التنجيزي في طرف المقيدات المنفصلة، وذلك ايضا من غير فرق بين فرض احراز القيد بالكشف القطعي أو احرازه بالكشف الظني، فانه على كل تقدير يكون الظفر بكل بيان وحجة على القيد رافعا حقيقة للأصل المزبور الذى به قوام الظهور المزبور. نعم لو كان الارتكاز والجبلة المزبورة في المقام كسائر الحقائق وعلى مسلك المشهور مستتبعا لمطابقة اللفظ الظاهر في نفسه لواقع مرامه ورافعا لاحتمال ارادة خلاف الظاهر لا مقوما لأصل الظهور، أو كان ظهور اللفظ في مقام اناطته منوطا بعدم وجود القيد واقعا لا بعدم الحجة والبيان عليه الذى هو موضوع قبح العقاب بلا بيان لكان لدعوى المعارضة بين ظهور حال المتكلم الكاشف عن عدمه واقعا مع دليل القيد الكاشف عن وجوده كذلك كمال مجال، والا فمع فرض تسليم اناطة اصل ظهوره بعدم الحجة وبيان القيد ولو فيما بعد فلا يبقى مجال دعوى المعارضة بين ظهور الحال مع دليل القيد، بل مهما ظفر بالحجة على القيد فيما بعد يقطع بمخالفة الظهور للواقع.
وبالجملة نقول: ان موضوع حكم العقل بعدم نقض الغرض الذى هو مفاد مقدمات الحكمة انما هو كون المتكلم في مقام البيان وعدم اقامة حجة على مدخلية قيد في مرامه، إذ لو اقام حجة عليه لا يلزم عليه نقض غرض بوجه اصلا، وحينئذ فمهما ظفرنا بحجة على القيد فيما بعد يلزمه ارتفاع موضوع حكم العقل، من جهة انقلاب اللابيان بوجود البيان، كما هو واضح. وعليه فلابد من تنقيح هذه الجهة بان البيان الذى هو عمدة تلك المقدمات عبارة عن اعطاء الحجة والظهور على المراد، كي يلزمه المعارضة مع المقيدات المنفصلة بالتقريب المتقدم، أو هو عبارة عن كون المتكلم في مقام الجد لبيان تمام مرامه الواقعي بلفظ به التخاطب حتى يلزمه تقديم المقيدات المنفصلة عليه.
ثم ان من لوازم هذين المعنيين ايضا هو عدم اضرار القدر المتيقن الخارجي بالإطلاق على الاول واضراره به على الثاني، من جهة عدم محذور نقض غرض عليه في فرض ارادة التقييد واتكاله عليه بيانا وحجة على القيد، بخلافه على الاول فانه لما كان لا يوجب مثله انثلاما لظهور اللفظ كما في كلية القرائن المنفصلة لا يكاد يصح له الاكتفاء بذلك القدر المتيقن الخارجي في فرض عدم ارادة الاطلاق من لفظه، كما هو واضح.
وحيث ان بنائهم طرا على عدم الاعتناء بوجود القدر المتيقن الخارجي في المضربة بالإطلاق. فالأقوى منهما هو المعنى الاول، مضافا إلى كونه هو الغالب في هذه الخطابات خصوص الخطابات الشرعية المتكفلة للأحكام الشرعية، فانها طرا بصدد اعطاء الحجة على المراد إلى المكلف ليكون له بيانا وحجة في الموارد المشكوكة في نفى ما شك في اعتباره وجود ام عدما في المأمور به إلى ان يظهر الخلاف، كما كان ذلك هو الشأن ايضا في القاء العمومات اللفظية وسائر الحقائق، فان المقصود منها طرا انما هو مجرد اعطاء الحجة على المراد إلى المكلف، لان يتكل بها بيانا على التكليف وجودا وعدما في مقام العمل عند الشك في القرينة أو التخصيص فتدبر.
واما المقدمة الثالثة وهى انتفاء القدر المتيقن مطلقا ولو من الخارج أو في خصوص مقام التخاطب فالاحتياج إليها في صحة الاخذ بالإطلاق وعدمه ايضا مبني على ان المراد من البيان في المقدمة الاولى هو كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده على وجه يعلم المخاطب ايضا بان المدلول تمام المراد، أو مجرد كونه في مقام بيان تمام مراده بنحو لا يشذ عنه شيء، بلا نظر إلى فهم المخاطب بانه تمام المراد، فعلى الاولى لا يحتاج إلى تلك المقدمة ولا يكاد يضر وجود القدر المتيقن ولو في مقام التخاطب بقضية الاطلاق، ما لم يصل إلى حد الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية في المطلوب، فان مجرد القطع بكونه مرادا لا يقتضى عدم كون غيره مرادا ايضا، بل على فرض ارادة المتكلم للقيد لابد بمقتضى برهان نقض الغرض من نصب البيان على مدخلية الخصوصية، والا فليس له الاكتفاء بمحض كونه القدر المتيقن في مقام التخاطب، واما على الثاني من كونه في مقام بيان تمام مرامه من دون تعلق غرضه بفهم المخاطب ايضا بان مدلول اللفظ تمام المراد بوصف التمامية فلازمه الاحتياج إلى عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وعدم جواز التعدي عنه مع وجوده إلى غيره، فانه على تقدير ارادة المقيد حينئذ لا يلزم من عدم بيانه نقض غرض في البين كما يلزم في الصورة الاولى، ومعه لا طريق إلى احراز الاطلاق حتى يتعدى عن القدر المتيقن إلى غيره، كما هو واضح. ولكن التحقيق حينئذ هو الثاني، ذلك من جهة ان غاية ما تقتضيه تلك المقدمات بمقتضى برهان نقض الغرض انما هو عدم اخلال المتكلم بما هو واقع مرامه في خطابه، واما من حيث فهم المخاطب ايضا بانه تمام المراد فلا، لان ذلك امر زائد قلما يتفق تعلق الغرض به، وعليه فمع احتمال ارادة المتكلم للمقيد وهو المتيقن واتكاله في ذلك على حكم العقل بلزوم الاخذ به لا مجال للأخذ بالإطلاق، حيث لا يلزم من ارادته بالخصوص محذور نقض غرض في البين، وهذ بخلافه في الفرض الاول فانه بعد فرض تعلق غرضه بمعرفة المخاطب ايضا بكون المدلول تمام المراد لابد له في فرض ارادته للمقيد من نصب بيان عليه، والا فمجرد القطع بدخول القدر المتيقن في المطلوب وكونه مرادا للمتكلم لا يقتضى القطع بكونه تمام المراد بوصف التمامية الا مع بلوغه إلى حد الانصراف الكاشف عن دخل الخصوصية، فعلى ذلك فلا اشكال في الاحتياج إلى المقدمة الثالثة، وهى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.
واما اضرار القدر المتيقن الخارجي وعدم اضراره فقد عرفت ابتنائه ايضا على كون البيان في المقام بمعنى اعطاء الحجة على المراد أو بمعنى كون المتكلم في مقام الجد بإبراز مرامه الواقعي.
وقد عرفت ايضا ان التحقيق هو الاول وانه لا يضر مجرد وجود القدر المتيقن ولو من الخارج بالأخذ بالإطلاق. ثم لا يخفى عليك انه مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وان كان لا مجال للأخذ بالإطلاق، بل كان اللازم هو الاقتصار عليه وعدم التعدي عنه إلى غيره، الا انه لا يوجب التقيد بالخصوص حتى يلزمه معارضته مع مطلق آخر في قباله، بل وانما غايته هو مانعيته عن الاخذ بإطلاق ذلك، وهو واضح.
ثم ان من القرائن المانعة عن الاخذ بالإطلاق كما عرفت هو الانصراف، ولكنه لا مطلقا بل البالغ منه إلى حد مبين العدم أو المضر الاجمالي دون ما يوجب التشكيك البدوي، وتوضيح ذلك هو ان للانصراف مراتب متفاوتة شدة وضعفا، حسب زيادة ما يوجبه من انس الذهن الناشئ من كثرة الاطلاق وغلبة الاستعمال وغير ذلك. فمن تلك المراتب ما يوجب التشكيك البدوي الزائل بالتأمل والتدقيق كما في انصراف الماء في الكوفة مثلا إلى الفرات، فانه لا يوجب الا مجرد التشكيك البدوي الذى يزول بأدنى تأمل وتدبر.
ومنها: ما يكون انس الذهن بمرتبه يوجب الشك المستقر بنحو لا يزول بالتأمل والتدبر ايضا، كما في القدر المتيقن.
ومنها: ما يكون انس الذهن بمثابة يكون كالتقيد اللفظي، فهذه مراتب ثلاثة:
فالمرتبة الاولى: منها هي المعبر عنه بالتشكيك البدوي وهى لا توجب شيئا ولا تمنع عن الاخذ بالإطلاق.
والثانية: هي المضرة الاجمالية فتمنع عن الاخذ بالإطلاق خاصة كما في القدر المتيقن في مقام التخاطب.
والثالثة: هي المعبر عنها بمبين العدم، باعتبار اقتضائها لتحديد دائرة المطلوب وتقيده بالخصوصية الموجبة لصلاحيته للمعارضة مع ما في القبال من مطلق آخر، فيفترق حينئذ هذه المرتبة مع المرتبة السابقة وهى المضرة الاجمالية، من حيث عدم اقتضاء المضر الاجمالي الا مجرد الاضرار بالإطلاق والمنع عن التمسك به، بخلاف هذه المرتبة، فانها مضافا إلى منعها عن الاطلاق توجب تحديد دائرة المراد والمطلوب وتقيده بالخصوصية كالتقييدات اللفظة.
ثم ان الانصراف إلى الخصوصية ايضا تارة يكون على الاطلاق من دون اختصاصه بحال دون حال، واخرى يكون مخصوصا بحال دون حال آخر كحال الاختيار والاضطرار وغير ذلك، كما لو كان من عادة المولى مثلا اكل البطيخ في الحضر واكل ماء اللحم في السفر، فان المنصرف من امره حينئذ بإحضار الطعام في حضره شيء وفي سفره شيء آخر، لا انه كان المنصرف إليه شيئا واحدا في جميع تلك الاحوال.
ومن ذلك ايضا انصراف وضع اليد مثلا على الارض، حيث ان المنصرف منه في حال الاختيار والتمكن ربما كان هو الوضع بباطن الكف لا بظاهرها، وفي حال الاضطرار وعدم التمكن من وضع باطن الكف كان المنصرف منه الوضع بظاهر الكف، ومع عدم التمكن من ذلك هو الوضع بالساعد، وهكذا، كل ذلك بملاحظة ما هو قضية الجبلة والفطرة من وضع الانسان باطن كفيه على الارض في حال القدرة في مقام الوصول إلى مقاصده، وبظاهرهما عند العجز وعدم التمكن من ذلك، وبالساعدين عند العجز من ذلك ايضا. وعليه فلا بأس بالتمسك بإطلاقات اوامر المسح باليد في وجوب المسح بظاهر الكفين مع عدم التمكن عن المسح بباطنها، بل وجوبه ببقية اليدين عند تعذر المسح بظاهر الكفين ايضا كما هو المشهور.
فلا يرد عليه حينئذ ان المنصرف من الامر بالمسح باليد لو كان هو المسح بباطن الكفين بحيث كان بمنزلة التقييد اللفظي لما كان وجه لدعوى وجوبه بظاهرهما مع العجز عن المسح بباطنهما، من جهة ان مقتضى الانصراف المزبور بعد كونه بمنزلة التقييد اللفظي حينئذ انما كان سقوط وجوب المسح رأسا، فيحتاج اثبات وجوبه بظاهر الكفين إلى دليل خاص، والا فلا يجديه اطلاقات اوامر المسح باليد.
إذ نقول بان ذلك انما يتم فيما لو كان الانصراف المزبور اولا بنحو الاطلاق، والا فمع فرض اختصاصه بحال القدرة وعدم العجز لا مجال لهذا الاشكال، بل حينئذ كما يتمسك بإطلاق اوامر المسح عند التمكن لوجوب المسح بباطن الكفين، كذلك يتمسك به ايضا لوجوبه بظاهرهما في حال عدم التمكن من المسح بباطنهما، من دون احتياج في اثبات وجوبه بظاهر الكفين إلى قيام دليل خاص عليه، كما لا يخفى.
ثم اعلم انه إذا كان للمطلق جهات فلابد في الاخذ بالإطلاق من كل جهة من احراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة والا فلا يكفي مجرد كون المتكلم في مقام البيان من جهة من الجهات في الاخذ بالإطلاق مطلقا ولو من غير تلك الجهة، بل بعد امكان كونه في مقام الاهمال لابد من الاقتصار في الاخذ بالإطلاق على الجهة المعلومة التي كان المتكلم بالنسبة إليها في مقام البيان وعدم التعدي عنها إلى غيرها، الا إذا كانت الجهة المهملة من اللوازم الغالبية للجهة المعلومة التي كان المتكلم بالنسبة إليها في مقام البيان، بحيث يوجب الحكم بالإهمال فيها من هذه الجهة صرف الاطلاق إلى الموارد النادرة، فانه في مثل ذلك ربما يلازم الاطلاق من هذه الجهة الاطلاق من غير تلك الجهة ايضا فيؤخذ حينئذ بإطلاقه من الجهتين، وعلى ذلك فيمكن الاخذ بإطلاق ما دل على طهارة سؤر الهرة حتى من جهة الحالات من حيث طهارة فم الهرة وعدم طهارة فمها وتلطخها بالنجاسة، بدعوى ان سوق الكلام وان كان من جهة افراد السؤر دون الحالات ولكنه لما كان الاهمال من جهة نجاسة فم الهرة وطهارته موجبا لحمل اطلاق طهارة سؤرها على المورد النادر، بملاحظة انه قلم يتفق خلو في الهرة عن النجاسة ولو في زمان، فيوجب حينئذ حمل اطلاق طهارة سؤرها على الموارد النادرة التي لم يتلطخ فمها بالنجاسة أو تلطخ بها ولكنه صار طاهرا بالماء الكر أو الجاري ونحوهما، فقهرا في مثله يلازم الاطلاق من تلك الجهة الاطلاق في الجهة المهملة فيؤخذ حينئذ بإطلاق الطهارة من الجهتين.
وحينئذ فلابد اولا من ملاحظة جهات القضية وان الكلام مسوق لبيان أي واحدة من الجهات، ثم بعد ذلك ملاحظة تلك الجهات المهملة التي لم يحرز كون المتكلم بالنسبة إليها في مقام البيان بانها من اللوازم الغير المنفكة العقلية أو الغالبية للجهات المطلقة ام لا، هذا كله في اصل كبرى المسألة. واما تشخيص صغريات ذلك فموكول إلى نظر الفقيه حيث لا ضابط كلى لذلك يؤخذ به في جميع الموارد، وانما ذلك يختلف باختلاف خصوصيات الموارد حسب ما تقتضيه القرائن الخاصة ومناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك، فمن ذلك لابد للفقيه من بذل الجهد في تشخيص صغريات ذلك بملاحظة خصوصيات الموارد أو القرائن الخاصة فيها من مناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك، فتدبر.
تتمة :
إذا ورد مطلق ومقيد فأما ان يكونا متوافقين في الايجاب والسلب أو متخالفين. اما إذا كانا متوافقين وكانا مثبتين كقوله: اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فاما ان يحرز ولو من الخارج كونهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدده، واما ان لا يحرز شيء منهما.
فعلى الاول فان احرز كونهما على نحو وحدة المطلوب فلا اشكال في المعارضة بينهما، فلابد حينئذ اما من حمل المطلق على المقيد واما من حمل المقيد على بيان افضل الافراد برفع اليد عن ظهوره في دخل الخصوصية، وان احرز كونهم على نحو تعدد المطلوب على معنى كون مطلق الرقبة الجامع بين الواجدة للإيمان والفاقدة له مطلوبا، والرقبة المتقيدة بقيد الايمان مطلوبا آخر فلا تعارض بينهما، حيث يؤخذ بكل واحد منهما، ونتيجة ذلك هو سقوط كلا التكليفين بإيجاد المقيد في مقام الامتثال، وبقاء التكليف بالمقيد في صورة الاقتصار على المطلق. واما على الثاني من عدم احراز احد الامرين من وحدة المطلوب وتعدده والشك في ذلك فلا اشكال ايضا في ان مقتضى الاصل هو الحمل على تعدد المطلوب، لانه مع احتمال كونهما بنحو تعدد المطلوب لم يحرز التنافي بينهما حتى يحتاج في مقام العلاج إلى حمل المطلق على المقيد، فكان نفس الشك في كونهما على نحو وحدة المطلوب واحتمال كونهم بنحو تعدد المطلوب كافيا في عدم ترتيب آثار وحدة المطلوب بينهما، وهذا مما لا اشكال فيه ظاهرا.
وانما الكلام في ان طبع ظهور القضية في مثله يقتضى أي الامرين منهما؟ وفي مثله نقول: بان كل واحد من الامرين في قوله: اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، لم كان له ظهور في ارادة مستقلة محدودة بحد خاص متعلقة بصرف وجود الشيء الذى هو غير قابل للتعدد والتكرر، وكان الجمع بين ظهور الامرين في الاستقلال وبين ظهور المتعلق فيصرف الوجود غير ممكن عقلا، من جهة استحالة توارد الحكمين المتماثلين كالضدين على موضوع واحد، فلابد في مقام العلاج من رفع اليد عن احد الامور الثلاثة : اما عن ظهور المتعلق في الصرف بحمله على وجود ووجود ليختلف متعلق الحكمين.
واما عن ظهور الامرين في الاستقلال والتعدد بجعل المنكشف منهما ارادة واحدة لا ارادتين، ليكون النتيجة وحدة المطلوب، فيجمع بينهما اما بحمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على افضل الافراد، فيكون المنكشف في الامر بالمطلق على الاول عين الارادة الضمنية في طرف الامر بالمقيد، وعلى الثاني يكون المنكشف في الامر بالمقيد عين الارادة المكشوفة في طرف المطلق مع زيادة الندبية مثلا.
واما من رفع اليد عن استقلال الامرين في الحد خاصة مع حفظ اصل ظهورهما في تعدد الارادة والطلب، فيحمل بعد الغاء الحدود الخاصة فيهما على التأكد في المجمع. ولكن في مقام الترجيح لا ينبغى اشكال في ان ارد الوجوه هو الوجه الاول، حيث ان رفع اليد عن ظهور المتعلق فيهما في صرف الوجود والمصير إلى لزوم تعدد الوجود في مقاما لامتثال بعيد جدا، وحينئذ فيدور الامر بين الوجهين الآخرين: من رفع اليد اما عن اصل ظهور الامرين في الاستقلال ذاتا والمصير إلى كون المنكشف من الانشائين ارادة واحدة فينتج وحدة المطلوب، واما من رفع اليد عن خصوص الحدود مع ابقاء اصل ظهور الامرين في الاستقلال على حاله كي ينتج تعدد المطلوب والتأكد في المجمع، وفي مثله لا يبعد دعوى تعين الاخير من جهة أهونية التصرف في الحد من التصرف في ظهور الامرين في تعدد الارادة، خصوصا مع امكان منع اصل ظهور الامرين في استقلالهما في الحد من جهة ان غاية ما يقتضيه الظهور المزبور انما هو الكشف عن تعدد اصل الارادة والطلب واما محدوديتهما بحدين مستقلين فلا.
وبالجملة نقول بان التصرف في ظهور الامرين في تعدد الارادة وان كان ممكنا في نفسه، من حيث انه يكون الانشاء في باب التكاليف كالإنشاء في باب العقود في اقتضائه السببية لتحصل مضمونه في الخارج حتى يلزمه تعدد المسبب عند تعدد السبب، بل وانما ذلك كان من قبيل الاخبار كاشفا عن الارادة وحاكيا عنها، فامكن ان يقال حينئذ بعدم كشف الانشائين في المقام عن ازيد من ارادة واحدة. ولكنه مع ذلك كله عند الدوران بين التصرفين كان التصرف الاخير وهو التصرف في الحد اهون من التصرف في ظهور الامرين في تعدد الارادة.
ثم ان ما ذكرنا من الدوران بين الوجوه المزبورة انما هو على المبنى المختار من استقرار الظهور للمطلق وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف، والا فبناء على المبنى الآخر الذى تقدم شرحه فلا محالة يكون دليل المقيد حاكما عليه، فلابد من التقييد، ومعه فلا ينتهي النوبة إلى مقام الدوران بين الوجوه المتقدمة، اللهم الا ان يقال بانه كذلك فيما لو كانت الدلالة في المقيد المنفصل وضعيا الا فبناء على كون الدلالة فيه ايضا من جهة الاطلاق وقرينة الحكمة فلا، من جهة ان التعليق حينئذ كان من الطرفين ومعه لا وجه لتقديم دليل المقيد وتحكيمه على المطلق، والمقام انما كان من قبيل الثاني، حيث انه كما كان ظهور المطلق في استقلال الطلب من جهة مقدمات الحكمة كذلك ظهور دليل المقيد ايضا:
في قوله اعتق رقبة مؤمنة، في اول مرتبة الارادة كان من جهة الاطلاق، بحيث لو تم ظهور الاول لابد من حمل الثاني على المرتبة الاكيدة من الارادة، ومعه لا وجه لتقديم دليل المقيد وتحكيمه على ظهور المطلق وحمل الامر المتعلق به على الامر الضمني.
اللهم الا ان يدفع ذلك ويقال بان ظهور كل امر في اول مرتبة الطلب ظهور وضعي لا اطلاقي، فتدبر. ثم ان هذا كله بناء على عدم ثبوت المفهوم للمقيد واما بناء على ثبوت المفهوم له فقد يقال بانه لا اشكال حينئذ في التقييد.
ولكن فيه اشكال: إذ نقول بانه انما يلزم التقييد فيما لو كان القيد بحسب ظهور القضية راجعا إلى اصل الوجوب، والا فبناء على ظهور رجوعه إلى المرتبة الاكيدة من الوجوب أو احتمال رجوعه إليه فلا يلزم التقيد، من غير فرق في ذلك بين القول بثبوت المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول: بانه على فرض ظهوره في رجوع القيد إلى اصل الحكم لابد من التقييد، قلنا بالمفهوم ام لم نقل، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة الاكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم، فعلى كل تقدير لا ينفع قضية القول بالمفهوم في اثبات التقييد، كما هو واضح.
وعلى كل حال فهذا كله فيما لو كان لسان دليل المقيد بنحو قوله: اعتق رقبة مؤمنة.
واما لو كان لسانه بنحو قوله: يجب ان تكون الرقبة مؤمنة أو ما يفيد ذلك، فلا يبعد في مثله دعوى ظهوره في مطلوبية الايمان فيها مستقلا من باب المطلوب في المطلوب.
كما انه لو كان بلسان الاشتراط كقوله: فليكن الرقبة مؤمنة، لابد من التقييد من جهة ظهوره حينئذ في مدخلية قيد الايمان في المطلوب. وعلى ذلك لابد حينئذ من ملاحظة كيفية لسان دليل المقيد في انه بنحو قوله: اعتق رقبة مؤمنة، أو بنحو قوله: يجب ان تكون الرقبة مؤمنة، الظاهرة في كونه من باب المطلوب في المطلوب، أو بنحو الارشاد إلى الاشتراط، فعلى الاول يتأتى فيه الوجوه المتقدمة، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل واحد من المطلق والمقيد ولاتعارض ولا تنافى بينهما، وعلى الثالث لابد من التقييد وحمل المطلق على المقيد فتدبر.
هذا كله في المثبتين.
واما المنفيان كقوله: لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة، فلا اشكال في عدم التنافي بينهما بل في مثله ربما كان ذلك مؤكدا في الحقيقة للإطلاق لا منافيا له، الا على فرض القول فيه بالمفهوم، فيلحق حينئذ بالمتخالفين من جهة اقتضائه حينئذ بمفهومه لعدم حرمة المطلق، ومثله ما لو كانا بنحو قوله: لا يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة، فان ذلك ايضا على فرض المفهوم كان ملحقا بالمتخالفين، وعلى فرض عدم المفهوم كان مؤكدا للإطلاق لا منافيا له، هذا، ولكن في عد المثال الاول مثال للمنفيين نحو خفاء ينشأ من كونه اشبه بالمثبتين، كما هو ظاهر.
وعلى كل حال فهذا كله في المتوافقين في الايجاب والسلب.
واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين:
الاول ما كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله: اعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة، وذلك ايضا بأحد النحوين:
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفي كما في المثال المزبور، واما بعكس ذلك كقوله: لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة.
فان كان الاول ففيه احتمالات: احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف، واحتمال نفى الوجوب الاكيد لا نفي اصل الوجوب، واحتمال رجوع النفي إلى خصوص القيد، ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد، وان كان الثاني فالمتعين كان هو التقييد. الثاني ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله: اعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة، أو بالعكس كقوله: يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة، وحكم هذا القسم في الصورتين ايضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الاولى بما عدا الافراد الكافرة والحرمة في الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة.
نعم يحتمل ايضا رجوع الحكم في هذا القسم في الصورتين إلى ذات القيد على معنى اختصاص الحكم في طرف المقيد بذات القيد، نظير الامر بالجامع مع النهى عن بعض الخصوصيات أو بالعكس، وعليه فيبتنى على مسألة الاجتماع، فعلى القول بالجواز خصوصا في الفرض فلا تنافي بينهما اصلا، من جهة اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في الامر والنهي وكونه في احدهما هو الطبيعي والجامع وفى الآخر هو القيد والخصوصية، واما على القول بعدم الجواز حتى في مثل الفرض يقع بينهما التنافي.
ولكن قد عرفت ان الجمع العرفي في نحوه هو التقييد لا غير.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|