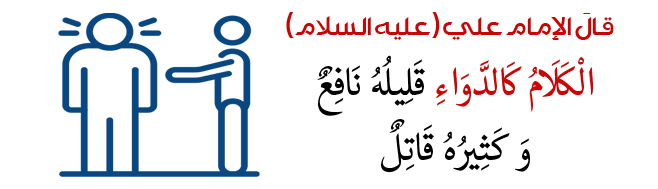
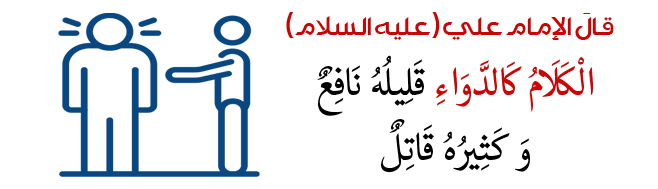

 التاريخ والحضارة
التاريخ والحضارة
 اقوام وادي الرافدين
اقوام وادي الرافدين 
 العصور الحجرية
العصور الحجرية 
 الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق 
 العهود الاجنبية القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق 
 احوال العرب قبل الاسلام
احوال العرب قبل الاسلام 
 مدن عربية قديمة
مدن عربية قديمة
 التاريخ الاسلامي
التاريخ الاسلامي 
 السيرة النبوية
السيرة النبوية 
 الخلفاء الاربعة
الخلفاء الاربعة
 علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
علي ابن ابي طالب (عليه السلام)
 الدولة الاموية
الدولة الاموية 
 الدولة الاموية في الشام
الدولة الاموية في الشام
 الدولة الاموية في الاندلس
الدولة الاموية في الاندلس
 الدولة العباسية
الدولة العباسية 
 خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى
 خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
خلفاء بني العباس المرحلة الثانية
 عصر سيطرة العسكريين الترك
عصر سيطرة العسكريين الترك
 عصر السيطرة البويهية العسكرية
عصر السيطرة البويهية العسكرية
 عصر سيطرة السلاجقة
عصر سيطرة السلاجقة
 التاريخ الحديث والمعاصر
التاريخ الحديث والمعاصر
 التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
التاريخ الحديث والمعاصر للعراق
 تاريخ الحضارة الأوربية
تاريخ الحضارة الأوربية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2016
التاريخ: 25-10-2016
التاريخ: 24-10-2016
التاريخ: 18-7-2018
|
لا نزاع في أن الدولة الكوشية التي قامت في بلاد كوش في مدينتي «الكورو» «ونباتا» وغيرهما من مدن السودان كان أساسها على ما يقال نزوح طائفة كهنة «آمون رع» الذين هاجروا من مصر إلى «نباتا» واعتصموا في معبدها القديم في جبل «برقل» المقدس الذي يرجع عهده إلى زمن ملوك الأسرة الثامنة عشرة وبخاصة التحامسة، وقد كانت هجرتهم أو فرارهم خوفًا من عدوان «شيشنق الأول» الذي استولى على ملكهم في «طيبة» عنوة حوالي 950ق.م، ونصب ابنه كاهنًا أكبر هناك، وبذلك هدم سلطانهم وقوض عرشهم الذي كان حصنهم الحصين طوال عهد الدولة الحديثة.
أسس هؤلاء الكهنة الفارون لهم سلطانًا في إقليم «نباتا» ثم أخذ سلطانهم يعظم في هذه الجهة وغيرها من بلاد كوش، وظلوا بمعزل عن مصر، لم نسمع عنهم شيئًا حتى طالعتنا الكشوف الحديثة بقيام دولة في هذه الأصقاع كان لهم فيها شأن عظيم، وتدل شواهد الأحوال على أن حكامها كانوا يرقبون عن كثب سير الحوادث في مصر في العهد اللوبي حتى حانت الفرصة ولمسوا جانب الضعف في تلك الدولة الهرمة في مصر؛ فانقضوا عليها وعلى رأسهم ملكهم «كشتا» واستولوا على إقليم «طيبة» مقر عبادة الإله «آمون رع» الذي كانوا يعظمونه ويتعبدون إليه بقلوب ملؤها الورع والخشية والتقى العميق في معبد «جبل برقل»، ولا غرابة في ذلك؛ فقد شاهدنا أن أفراد هذه الأسرة قد أقاموا له المعابد والمحاريب في طول بلادهم وعرضها وبخاصة في «نباتا» «وصنم» «ومروي».
وقد كان أول عمل قام به «كشتا» بعد فتح إقليم «طيبة» أن نصب ابنته «أمنردس» متعبدة إلهية «أي بمثابة كاهنة عظمى لطيبة» وبذلك استرد «كشتا» ما كان قد فقده كهنة «آمون» من سلطان في هذه البلدة، وقد لعبت المتعبدات الإلهيات أو زوجات «آمون» في «طيبة» دورًا هامًّا في خلال هذه الأسرة والتي تلتها، وكان لهن من النفوذ والسلطان ما خول لهن حمل لقب الملك ومميزاته، والواقع أنهن كن ملكات متوجات في إقليم «طيبة» وذلك بفضل ما كان لهن من مكانة دينية عظيمة، وقد فصلنا القول في ذلك فيما سبق (1).
وتدل النقوش التي تركها لنا ملوك الأسرة الكوشية على أن دولتهم في مصر قد قامت بالدعوة إلى عبادة «آمون رع» والتمسك بعقائدها وشعائرها، يشد عضدهم في ذلك حماس رجال دولة فتية لم تكن المدنية قد أفسدت أخلاق رجالها، وذلك في وقت كانت الحالة فيه في شبه فوضى؛ أي العهد اللوبي الذي انتهى به الأمر أن قسمت البلاد فيه عدة مقاطعات يقوم على رأس كل واحدة منها أمير يدين بديانة معبود مقاطعته ويعده الحامي لذمارها والمدافع عنها.
هذا؛ ونشاهد التفاف الكوشيين حول عبادة «آمون رع» وتمسكهم بها وعلى رأسهم مليكهم فيما نجده في الكلمات التي حث بها «بيعنخي» جنوده على حرب الأمير «تفنخت»، عندما أراد الأخير أن يطرد الكوشيين من مصر عنوة، وكان صاحب قوة وعزم، ولكن «بيعنخي» تغلب عليه بما كان يتصف به هو ورجال جيشه من حماس ديني واعتقاد راسخ في قوة «آمون» الذي يمنح النصر لمن يشاء، لدرجة أنه أمر قواده أن يعطوا العدو اختيار الزمان والمكان لأجل الحرب وكل الفرص الملائمة، وقد كان السر في ذلك ما فاه به لقائده: «عليك أن تعرف أن «آمون» هو الإله الذي أرسلنا، فهو كفيل بالنصر». ولعمري فإن ذلك يذكرنا بالحماس الديني الذي كان يتصف به المسلمون في بادئ أمرهم، وقد كفل لهم الظفر والنصر في كل الميادين أو الجنة، وكلاهما مغنم.
وكذلك نجد «بيعنخي» يأمر جنوده عند الاقتراب من «طيبة» التي يقيم فيها «آمون» إلهه العظيم بقوله: وعندما تصلون إلى «طيبة» قبالة «الكرنك» فانزلوا إلى الماء وطهروا أنفسكم في النهر، وأظهروا أنفسكم في ملابس كتان نظيفة، وشدوا القوس وارموا بالسهم، ولا تفخروا بأنكم أرباب القوة؛ لأنه بدونه (أي «آمون») لا تكون لشجاع قوة؛ إذ قد يجعل القوي ضعيفًا، وبذلك تفرُّ الكثرة أمام القلة كَمْ من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ، وإن رجلًا واحدًا قد يستولى على ألف رجل، اغسلوا أنفسكم بماء قربانه، وقبلوا الأرض قبل محياه وقولوا له: «امنحنا سواء السبيل حتى نستطيع أن نحارب تحت ظل سيفك القوي … إلخ.» وهذا لا يحتاج إلى تعليق. ولا غرابة بعد ذلك في أن نرى «بيعنخي» كان كلما فتح مدينة من مدن مصر الوسطى أو السفلى كان يسلم ما فيها من مخازن وغلال قربانًا للإله «آمون رع» رب «طيبة» وإله «بيعنخي» الأعظم وصاحب «الكرنك».
وعندما حاصر «بيعنخي» «منف» واستعصت عليه جمع مجلسه الحربي غير أنه لم يأخذ برأيه، بل اتبع رأيه هو الذي كان ينحصر في الاستيلاء عليها بالهجوم متكلًا في ذلك على الإله «آمون» الذي كان يناصره في كل المواطن (وهو في ذلك شبه «تحتمس الثالث» أمام «مجدو»)، ولذلك قال: «إني أقسم بحب «آمون رع» لي وبحظوة والدي «آمون» الذي أوجدني أن ذلك لا بد أن يصيبها على حسب ما أمر به «آمون»، وهذا ما سيقوله الناس بعد، إن الأرض الشمالية ومقاطعات الجنوب قد فتحت له أبوابها من بعيد؛ لأنهم لم يضعوا «آمون» في قلوبهم ولم يعرفوا ما الذي أمر به، فإن «آمون» قد جعله يظهر شهرته كما جعله يرى جبروته وسأستولي عليها كالفيضان …»
والواقع أنه يمكن تشبيه هذه الفترة من تاريخ مصر بأنها كانت عصر انحلال ديني صارخ، كما يمكن تشبيه ملوك كوش في نهضتهم بملوك الوهابيين في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في حماسهم الديني والتمسك بأهداب العقائد الدينية القديمة مع بعض الفروق.
وعلى الرغم من أن «بيعنخي» وأخلافه كانوا يميلون كل الميل لعبادة «آمون» فإنهم كانوا في الوقت نفسه يمجدون آلهة المصريين الآخرين كما كانت الحال في عصر الإمبراطورية، ولا ريب في أن ما جاء في لوحة «بيعنخي» قد أوضح لنا تمامًا كيف كان ملوك كوش يتبعون بكل دقة شعائر الدين المصري، فقد عمل «بيعنخي» كل ما في وسعه ليظهر تمسكه بالعقيدة الشمسية القديمة في «هليوبوليس» وإنه بدون اتباعها ومراعاة ما جاء فيها لن يكون ملكًا على مصر، كما وجدناه في مشهد آخر من مشاهد هذه اللوحة قد رفض التسليم التام لأولئك الأمراء المصريين الأنجاس الذين كانوا يسمحون لأنفسهم بأكل السمك الذي كان في عقيدته محرمًا.
وقد اتخذ «بيعنخي» سياسة حكيمة في غزوه لمصر، فقد كان من دأبه أن يزور معابد الآلهة المحليين في كل بلدة يخضعها، ويقدم للآلهة القرابين في كل الأحوال، وقد فعل ذلك في «الأشمونين» «وأهناسية المدينة» «والفيوم» وسائر مدن المقاطعات الأخرى فضرب بذلك مثالًا رائعًا في السماحة وحسن السياسة، وتلك كانت السياسة الرشيدة لكل من كان يريد السيطرة على نفوس الشعب المصري في كل أطواره القديمة والحديثة.
هذا؛ ولا ننسى أن «بيعنخي» وغيره من ملوك كوش كانوا يستعينون كذلك بآلهة آخرين في جلب رضى الشعب ونيل النصر، فقد رأيناه يستميل أهالي «منف» للتسليم دون سفك الدماء، وقد وعدهم بأنه سيقرب القربان للإله «بتاح» القاطن جنوبي جداره وللإله «سكر» في مكانه السري (انظر فصل الملك بيعنخي) كما أغدق على آلهة المدينة جميعًا مع الإله «آمون» كل ثروتها بعد فتحها، وسنرى بعد أن الإله «بتاح» كان له مكانة خاصة عند ملوك كوش.
ومما يلفت النظر كذلك أن «بيعنخي» قد وصف في هذه اللوحة بأنه استمد قوته من قوة الإله «ست» الذي كان يعبد في بلدة «برسخم خبر رع» الواقعة بجوار «اللاهون» الحالية، ومن ثم نفهم أن الإله «ست» كان لا يزال حتى الآن ينظر إليه بأنه إله شديد القوى ويشبه به الملوك لا إله شر وحسب، ولكن يجوز أنه كان ينظر إليه بهذه الصفة في البلدة التي كان يعبد فيها وحدها (انظر فصل الملك بيعنخي)، كذلك نشاهد في نفس اللوحة أن «تفنخت» بعد هزيمته عندما أراد أن يطنب في قوة «بيعنخي» وشدة بطشه وصفه بقوله: «حقًّا أنك الإله «ست» (نوبتي) المسيطر على الأراضي الجنوبية وفي آن واحد الإله «منتو» ذلك الثور صاحب الساعد القوي، في حومة الوغى.» وهذا يؤكد لنا أن الإله «ست» كان وقتئذٍ مثله كمثل الإله «منتو» إله الحرب العظيم لا إله شر وحسب.
وتدل النقوش والآثار على أن الإله «آمون رع» كان يعبد في صورة بولهول برأس كبش، ولم يكتف «بيعنخي» بصنع تماثيل إلهه هذا على هذه الصورة، بل اغتصب بعض التماثيل الجميلة التي صنعها ووضعها «أمنحتب الثالث» في معبده بمدينة «صلب» (انظر فصل الملك بيعنخي)، ولا يزال منها اثنان في مكانهما الأصلي، وكان بطبيعة الحال يمثل مع «آمون» أحيانًا الإلهة «موت» زوجه والإله «خنسو» ابنهما وهما المكملان لثالوثه العظيم، هذا؛ ونجد «لبيعنخي» منظرًا في معبد الإلهة «موت» ربة «أشرو» «بالكرنك» غير أنه تذكاري على ما يظن (انظر فصل الملك بيعنخي).
وكذلك نشاهد «بيعنخي» في لوحة له عثر عليها في معبده العظيم بجبل «برقل» وقد مثل مع ثالوثه (انظر فصل الملك بيعنخي)، وتدل نقوش هذه اللوحة على أن «بيعنخي» كان في حرج عند بداية ملكه وأن «آمون» وثالوثه قد ثبتاه على العرش.
وفي عهد الملك «شبكا» الذي تولى الملك بعد «بيعنخي» حوالي 716 ق.م، تكشف لنا النقوش عن صفحة جديدة في تاريخ الحياة الدينية في عهد هذه الأسرة الكوشية، وأول ما يلحظ هنا عن هذا الملك أنه كان أول من اتخذ مقر ملكه بمصر في مدينة «طيبة» بدلًا من «نباتا» التي كانت العاصمة الكوشية لسلفه، ولذلك نجده اهتم بالآثار الدينية القائمة في «طيبة» باسم والده «آمون»، فقد أصلح البوابة الرابعة «بالكرنك» وزينها بالذهب والفضة؛ وذلك اعترافًا منه بالجميل لوالده «آمون» الذي أمده بنصر من عنده على الأعداء (انظر فصل الملك شبكا) وكذلك أقام آثارًا له بمعبد «الكوة»، غير أنه بجانب ذلك نراه قد اهتم اهتمامًا بالغًا بإحياء ما كان قد عفا عليه الدهر ودثر من معالم الآثار الدينية في العهود السابقة لعصره، هذا بالإضافة لما قام به من إصلاحات ونهضة في النواحي الأخرى من نواحي الحياة المصرية.
والواقع أنه وصل إلينا من عهده المتن الحقيقي لوثيقة يقال إنها دونت في عهد بداية الاتحاد الثنائي للمملكة المصرية من عهد الملك «مينا»، وقد وصلت إلينا نسخة من هذه الوثيقة منقوشة على حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف المصري، غير أنه قد أصاب بعض أجزائه الكثير من العطب، ويدعي الملك «شبكا» أنه نسخ هذا الحجر عن بردية كانت قد أكلها الدود وبذلك أنقذ المتن من العدم، ويدل ما جاء في المتن على أنه نقل من جديد في بيت والده «بتاح» القاطن في «منف»، وهي المدينة التي كان يقطنها وقتئذٍ «شبكا» بوصفها عاصمة ملكه، وقد قال عنه إنه من تأليف الأجداد، ومن ثم نفهم اهتمام هذا الفرعون بإحياء الآثار القديمة، وفي الوقت نفسه ينسب نفسه إلى السلالة المصرية، والواقع أن ذلك العصر كان الفترة التي قامت فيها نهضة جديدة لإحياء مجد مصر القديم في شمالها وجنوبها من كل النواحي (انظر فصل الملك شبكا «سبكون» … إلخ) ولا غرابة في ذلك فإن المصريين والكوشيين هم من أصل حامي واحد.
ومتن الوثيقة يشبه كل الشبه القصص المقدسة التي مثلت في المسرحيات الرمزية في القرون الوسطى، والمسرحية المنفية التي نحن بصددها (انظر فصل الملك شبكا «سبكون» … إلخ) تعد أقدم سلف لها، وقد وجدنا أن الإله «بتاح» إله «منف» يقوم في كل من الجزء المسرحي والجزء الفلسفي الذي يحتويه هذا المتن بدور إله الشمس الذي يعد إله مصر الأعلى، وذلك يفسر لنا ما كان يرمى إليه «شبكا» من جعل «بتاح» هذا الإله المحلي يحصل على عظمة إله الشمس «رع» وما كان له من سلطان، وذلك بأن يتقلد سلطته العالمية، ويستولي على الدور الذي لعبه في تاريخ مصر الأسطوري.
وتدل شواهد الأحوال على أن هذه المسرحية الفلسفية هي من تأليف كهنة «منف»، وأن الذي أمر بإنشائها هو «شبكا» حينما اتخذ هذه المدينة عاصمة له، مريدًا بذلك أن يجعل إلهها المحلي في القمة مشرفًا على الآلهة المصريين جميعًا بما فيهم الإله «رع» نفسه، ويمكن تلخيص محتويات هذه المسرحية بأنها محاولة لتفسير الأشياء على حسب نظرية كهنة «منف»، ويدخل في ذلك نظام العالم الخلقي، وكذلك لتدل على أن أصلها يرجع إلى «بتاح» إله «منف»، أما كل العوامل التي ساعدت على خلق العالم أو المخلوقات التي كان لها نصيب في ذلك فلم تكن إلا مجرد صور أو مظاهر «لبتاح» إله «منف» المحلي المسيطر على أصحاب الحرف والصناعات، والذي يعد إله كل حرفة، وأنه هو الإله الأحد الفرد الصمد وخالق «رع» نفسه الذي كان يعد على حسب نظرية كهنة «عين شمس» هو الإله خالق العالم كله، وقد أسهبنا في هذا الموضوع في مكانه(2).
على أن ما قام به «شبكا» من تعظيم «بتاح» والرفع من شأنه للدرجة القصوى لم يجعله يغفل أمر إله بلاده العظيم «آمون»، فقد رأيناه ينصب أحد أبنائه وهو «حورمأخت» كاهنًا أكبر «لآمون» في «طيبة» على الرغم من وجود المتعبدة الإلهية التي كانت تسيطر فعلًا على شئون إقليم «طيبة»، غير أن الكاهن الأعظم «لآمون طيبة» وقتئذٍ كان لقبًا يكاد يكون فخريًّا وحسب؛ إذ لم يكن لحامله أي سلطان في تلك الفترة من تاريخ البلاد «فصل الملك شبكا «سبكون» … إلخ»؛ لأن كل السلطان كان في يد المتعبدة الإلهية أو زوجة «آمون» أو يد الإله.
هذا وقد استمر تمجيد عبادة «بتاح» في عهد الملوك الذين خلفوا «شبكا» حتى في بلاد النوبة، فقد وجد له تمثال في بلدة «جمأتون» (الكوة) بوصفه إلهها (انظر فصل الملك تهرقا) وسمى «بتاح»، رب «جمأتون» (الكوة).
ولما استقر الملك للملك «تهرقا» في مصر وبلاد السودان أخذ أولًا في إصلاح المعابد القديمة وإقامة أخرى جديدة، وقد حبا الإله «آمون» صاحب «جمأتون» بإقامة معبد فاخر (انظر فصل الملك تهرقا) وزينه بصور للإله «آمون» على هيئة كباش، وأقام معبدًا آخر لهذا الإله في بلدة «صنم» على غرار المعبد السابق، وهذا المعبد الأخير كان يسمى معبد «آمون رع» ثور أرض القوس «النوبة».
ولم ينسَ «تهرقا» أن يزين نقوش معبده في «الكوة» بصور آلهة نوبية، فنقش صورة الإلهة «عنقت» إحدى آلهة ثالوث «الشلال» بشكلين مختلفين فكان تجديدًا طريفًا (انظر فصل الملك تهرقا).
ومما هو جدير بالذكر هنا أن الإله «آمون» قد مثل في معبد «الكوة» في المحراب مع الإلهتين «ساتيس» «وعنقت» مكونًا معهما ثالوثًا، وبذلك يكون قد حل محل الإله «خنوم» الذي كان يمثل في صورة كبش وكان يعتبر الإله الحارس لإقليم «الشلال»، وهاتان الإلهتان هما زوجتاه، وقد كان الإله «خنوم» منذ زمن بعيد الإله الحارس للمستعمرات المصرية التي في أقصى الجنوب، ولا نزاع في أن التغير هو من فعل كهنة «آمون» الذين كانوا يقصدون من وراء ذلك سيادة إلههم العظيم «آمون»، هذا ويلحظ أن في كل من معبدي «الكوة» «وصنم» قد أقام «تهرقا» محرابًا صغيرًا خاصًّا أو مقصورة للإله «آمون» داخل أربعة أعمدة في الجنوب الشمالي لقاعة العمد، وقد قلده فيما بعد الملك «أسبلتا» أحد ملوك كوش المتأخرين بإقامة محراب في الجنوب الشرقي من القاعة نفسها.
هذا؛ ونجد أن «تهرقا» كذلك قد اهتم بمدينة «منف» وإلهها «بتاح»، ولا غرابة في ذلك؛ فقد توج فيها ملكًا على البلاد، ومن المرجح أنه قد اتخذها عاصمة لملكه، وفي لقبه إشارة إلى ذلك، فقد لقب «رع حافظ نفر تم»؛ وذلك لأن الإله «نفر تم» كما هو معلوم أحد أفراد ثالوث مدينة «منف» وهم «بتاح» «وسخمت» زوجه ثم ابنهما «نفر تم»، هذا بالإضافة إلى أن اسم «تهرقا» محبوب «بتاح» كان شائعًا في نقوشه، ومن ثم نفهم أن أعظم إلهين كانا يعبدان في العهد الكوشي هما الإله «آمون» أولًا ثم الإله «بتاح» ثانيًا، وقد أقام «تهرقا» للأخير معبدًا خاصًّا «بالكرنك» ولكن خارج أسواره وأهداه له باسمه «أوزير بتاح» (انظر فصل الملك تهرقا).
ومما يلفت النظر أن الإله «آمون» كان يسمى «آمون نباتا» في بلاد السودان، وكذلك كانت تسمى «موت» زوجه «موت صاحبة نباتا»، وقد أقام «تهرقا» لها ولزوجها «آمون» معبدًا في جبل «برقل»، وقد جاء في إهدائه: لقد عمله «أي المعبد» أثرًا له لأمه «موت صاحبة نباتا»، فقد أقام لها معبدًا من جديد من الحجر الرملي الجميل … إلخ (انظر فصل الملك تهرقا).
وكذلك يشاهد في هذا المعبد أن الملك يقدم البخور للإله «أنحور» (أونوريس) إله الحرب، والظاهر أن هذا الإله قد لعب دورًا هامًّا في حياة الملك «تهرقا» بوصفه ملكًا محاربًا، وكذلك في حياة غيره من ملوك كوش، والواقع أننا نجد أن الملوك في هذا العهد كانوا يرتدون ملابس هذا الإله بوصفه إله حرب، وقد كان الملك يدعى في هذه الحالة ابن «رع» مثل الإله «أونوريس» كما جاء على اللوحة الرابعة السطر الثالث، وهذا المنظر يوحي إلينا اعتقاد وجود عبادة لهذا الإله في بلاد النوبة، وهذه العبادة على أية حال قد شوهدت في معابد «جبل برقل»، من ذلك أن هذا الإله «أونوريس» قد مثل في مناظر عدة في معبد «جبل برقل» رقم 300 (3)، وكذلك مثل على عمود في قاعة العمد العظيمة في المعبد رقم (500 ب) (4) حيث نجد ذكر الإلهين «شو» «وتفنت»، وكذلك نجد في نقوش الملك «حرسيوتف»(5) أن الإله «أونوريس» كان يعبد في مدينة «أرتيناي»، وفضلًا عن ذلك نشاهد عبادة هذا الإله على تعاويذ وجدت في معبد «صنم» (6) وتدل الكشوف الحديثة على أن الإله «أونوريس» كان يرافق الملك «تهرقا» في حروبه الخارجية، كما تدل على ذلك النقوش التي وجدت على تماثيله التي عثر عليها حديثًا في خرائب «الموصل» (نينوة).
الإله «ددون»: ومن أهم التجديدات الدينية التي نشاهدها في معبد «جبل برقل» الكبير إعادة الإله «ددون» الذي ينسب إلى أصل نوبي محض، بل هو الإله القومي لبلاد النوبة، فقد جاء ذكره في متون الأهرام بوصفه إله النوبة، وهذا الإله قد بقي يُذكر في النقوش المصرية القديمة حتى عهد الملك «سيتي الأول» في بلاد النوبة، حتى جاء عهد «تهرقا» فوجدناه مذكورًا بين آلهة معبد «جبل برقل»، غير أن المنظر وجد مهشمًا، وقد شرحنا هذا المنظر شرحًا وافيًا (انظر فصل الملك تهرقا).
وخلاصة القول إن الآلهة المصرية كانت تعبد في بلاد النوبة بصورة بارزة، وبخاصة الإله «آمون» الذي كان يظهر بوصفه الإله الرئيسي في العواصم الدينية الأربع في بلاد النوبة، فقد وجدنا في النقوش أن الملك «أنلاماني» قد وهب أخواته البنات الأربع للإله «آمون» القومي الذي ظهر في العواصم الأربع بصور مختلفة، وهي «نباتا» «وبنوبس» «وصنم» الذي ظهر فيها «آمون» بوصفه ثور النوبة وأخيرًا «الكوة» (جمأتون) وقد تحدثنا عنها طويلًا ولدينا له آثار عدة، وخاصيات «آمون جمأتون» هي جزئيًّا كخاصيات «آمون طيبة» «وآمون نباتا» فنجده ممثلًا في صورة أسد ومتوجًا بقرص الشمس وكذلك بالريشتين، ومعبده مزين بالكباش(7) ، وكان يقدم له أوانٍ وتعاويذ(8)، ومحلى برؤوس كباش، وكذلك كان ينذر له صورة الإوزة وهي مظهر من مظاهر هذا الإله، وقد كان «آمون» منذ الدولة الحديثة يحمل النعت الخاص «الأسد» كما كان ينادي بوصفه «الذي يتعرف على الموالين له، ومَن قربُه عُلو، ومَن يأتي إلى من يدعوه» وكذلك كان يدعى «آمون العظيم أو القديم».
وكان القيام على خدمته مضمونًا بأعطيات عدة ملكية في «جمأتون»، فقد كان له كهنة يتقاضون أجورًا، كما كان له مغنيات عديدات، وكانت تقام له الأحفال الرهيبة في خلال الزيارات الملكية تصحبها قربات من الأطعمة، وتدل الهبات التي قدمها «تهرقا» لهذا الإله في «جمأتون» على ما كانت عليه البلاد في عهده من رخاء وثراء يذكرنا بعهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة.
ومما يلفت النظر في مناظر معبد «بتاح» الذي أقامه «تهرقا» خارج أسوار معبد «الكرنك» (انظر فصل الملك تهرقا) المنظر الذي مثل فيه أربعة الآلهة الذين في الجهات الأربع أو أركان العالم الأربعة وهم: «ددون» ويمثل الجنوب، والإله «سيد»؛ أي إله الشرق «آسيا»، والإله «سبك» في صورة تمساح وهو إله الغرب «أي التحنو أو الليبيين»، والإله «حور» محبوب والدته، وقد مثل في صورة صقر ويمثل مصر، ويلحظ أن الإله «ددون» قد مثل هنا بلباس رأس بسيط وهو كوفية ولحية طويلة مستعارة ويزين رقبته قلادة كبيرة، ويغطي جسمه قميص ضيق ويتدلى من حزامه ذيل الحيوان المعروف الذي يلبسه الملوك.
والمتن الذي يتبع هذا الإله مهشم، ولكن يمكن أن نقرأ منه اسم هذا الإله وهو «ددون» الذي على رأس بلاد النوبة، هذا؛ وقد نقش تحت كل من هؤلاء الآلهة سطر جاء فيه مثلًا: «نطق: إن الإله «ددون» قد نصب فوق حامله لأجل أن يعمل …» ومعنى هذا المتن أن إلهًا من هؤلاء الآلهة الأربعة كان يمثل الملك نفسه، وإذا كان «تهرقا» قد ظهر في صورة كل من هؤلاء الآلهة وهم «ددون» «وسبد» «وسبك» «وحور محبوب والدته» فإن ذلك يرجع إلى أن هؤلاء الآلهة كانوا يمثلون الجهات الأربع الأصلية؛ أي الجنوب والشرق والغرب والشمال، وبعبارة أخرى العالم المعروف للمصري وقتئذٍ ويحتوي بلاد كوش وآسيا ولوبيا ومصر، وكان «تهرقا» يقصد من ذلك أنه سيحكم أركان العالم الأربعة بوصفه متقمصًا صور هؤلاء الآلهة الذين يحكمون هذه الجهات، ولا غرابة في ذلك؛ فإن هذا يتفق وأطماع الملك «تهرقا» الذي عُدَّ من أقطاب العالم الفاتحين في نظر الكتاب الإغريق.
وخلاصة القول في هذا المنظر أنه يدل على اتساع أفق هذا الملك، وما كان يرمى إلى الوصول إليه عن طريق الآلهة والدين، ولكن على الرغم من كل ذلك كان الإله «آمون رع» هو الإله الأعظم في نظر الدولة (انظر فصل الملك تهرقا)، وتدل شواهد الأحوال على أن «تهرقا» كان يقلد في ذلك الملوك الفاتحين أمثال «تحتمس الثالث» وغيره (انظر فصل الملك تهرقا).
وتدلنا الآثار الباقية على أن «تهرقا» قد عُني عناية خاصة بعبادة الإله «أوزير»، فأقام له المحاريب في معبد «الكرنك»، فلدينا معبد «أوزير نب زت» (أي أوزير رب الأبدية) (انظر فصل الملك تهرقا) كما أقام مقصورة لنفس هذا الإله في نفس المعبد، وأطلق عليها اسم مقصورة «أوزير رب الجبانة»، وقد آزره في إقامة هذين المعبدين المتعبدات الإلهيات اللائي كن قد اتخذن «طيبة» عاصمة لملكهن.
أما عن كيفية إقامة الشعائر في هذا العهد فكانت تقام في معابد أقيمت على غرار معابد الدولة الحديثة، غير أنها زينت ببعض المناظر المستعارة من مناظر الدولة القديمة؛ وذلك لأن ملوك هذه الأسرة كانوا قد أرادوا إحياء مجد البلاد القديم من كل الوجوه، ولكن المناظر الهامة الخاصة بإقامة الشعائر الدينية لا تختلف كثيرًا عن مناظر الدولة الحديثة في جملتها من حيث الشكل (انظر وصف معبد «جمأتون» فصل الملك تهرقا) هذا؛ وقد تحدثنا في الجزء العاشر عن التغيرات التي حدثت في التعابير الشعيرية وفي الصيغ الجنازية «انظر الجزء العاشر».
أما طرق الدفن في هذا العهد فقد قدمت لنا المقابر التي كشف عنها في جبانتي «الكورو» «ونوري» عن صفحة جديدة في طرق الدفن، وبخاصة تطور المصاطب إلى أهرام في تلك الفترة، وتتميز بخاصيات معينة عن الأهرام المصرية بعض الشيء، وقد فصلنا القول فيها فيما سبق، ولكن يجب أن نفهم أن الشعائر الدينية كانت مصرية محضة، ولا غرابة في ذلك؛ فإن الذين قاموا بأدائها كانوا من المهاجرين من مصر في بداية العهد اللوبي.
.................................................
1-راجع مصر القديمة الجزء التاسع.
2- راجع فصل الملك شبكا «سبكون».
3- راجع: L.D, Text. V, 259; Ibid, 261.
4- راجع: L. D, Text. V, 271.
5- راجع: Urk, III, 136, 7.
6- راجع: A.A.A, 9 Pl. 62 (10) ; P. 124; Ibid, 10, Pl. 26 (25) cf. P. 121.
7- راجع: Ibid, Pl. XXXVIII–XLI.
8- راجع: Ibid, Pl. III, XII, XIII.



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|