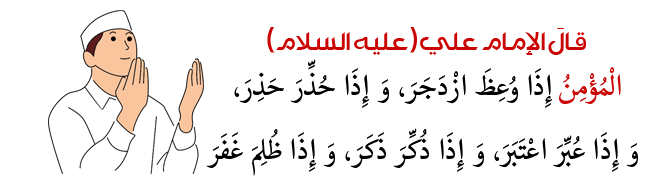
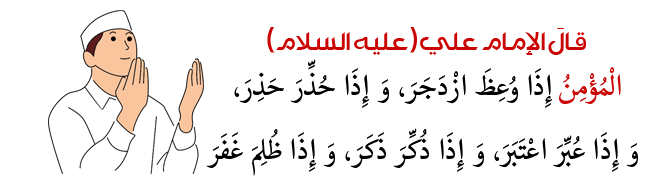

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-5-2020
التاريخ: 21-3-2021
التاريخ: 15-12-2020
التاريخ: 18-8-2020
|
قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة : 178، 179].
ما ورد في الآيتين من التشريعات الكلية النافعة في النظام الفردي والاجتماعي للإنسان ، وقد لوحظ فيهما بقاء النوع وتهذيبهم بالأخلاق الفاضلة ، ونبذ الانتقام والعدوان ، وقد اعتبر في القصاص المساواة بين القاتل ومن يراد الاقتصاص له.
وفيهما إشارة إلى بعض العادات السيئة التي كانت متبعة قبل هذا التشريع ، ولذلك كله لا تخلو من الارتباط بالآيات السابقة.
قال تعالى : { يا أيها الذين امنوا}.
تقدم الكلام في مثل هذا الخطاب في آيتي 104 و 153 . وكتابة هذا التشريع على المؤمنين لأجل الشرف ، لا يدل على نفيه عن غيرهم.
قال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة : 178].
الأصل في مادة (كتب) هر الجمع والتثبت في جميع موارد استعمالاتها ، سواء لوحظ ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى ، أو اللوح المحفوظ ، أو الكتب النازلة من السماء، أو الإيجاب على العباد - تكليفا أو وضعاً - أو التحقق العيني الخارجي ، فالكل كتاب ، والجميع يدل على الثبوت والدوام ، والتحفظ.
والمارد به في المقام هو الفرض والإيجاب.
ومادة (ق ص ص) تأتي بمعنى تتبع الأثر ، وحيث إن ولي المقتول ، يتبع أثر القاتل ليأخذ منه جريمة ما فعله ، وكذا المجروح يتبع أثر الجارح كذلك ، يقال له القصاص.
ومنه القصة والقصاص ، لأنها فيها تتبع أثر ما وقع في الخارج ، كما أن منه القاص، لأنه يتبع الآثار والأخبار.
والمراد بالقصاص شرعاً، هو أخذ الجاني بمثل جنايته إن أراد ولي المقتول ذلك ، وهو مطلق لا بد من تقييده بما إذا كانت الجناية عمدية ، لخروج الجناية الخطابية عن تحت هذه الآية بقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء : 92].
والآية تبين أصل تشريع القصاص ؛ وقوله تعالى : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } [البقرة : 179] ، يبين حكمة هذا التشريع.
وفي الآية إشعار بأنه لا بد من التساوي بين المقتول ومن يراد القصاص منه ، وأنه لا بد من العدل في القصاص وملاحظة المثلية.
وفي ذلك رد على ما كان يفعل في الجاهلية من المغالاة في سفك الدماء وقتل الأبرياء ، كالاقتصاص من رئيس القبيلة والسيد في قتل العبد ظلماً وعدوانا .
والقتلى : جميع القتيل بمعنى المقتول ، والقتل زوال الروح إذا أضيف إلى المتعدي إليه (أي من وقع عليه القتل) ، وإذا أضيف إلى ذات الشخص ، فهو موت ، فلا فرق بينهما إلا بالإضافة والاعتبار ، كما يقال : مات بالشهادة ، أو مات بالقتل ، ومات بالمرض.
نعم ، يصح اعتبار التغائر بينهما بلحاظ السبب ، كما قال تعالى :
{أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ} [آل عمران : 144] ، والجامع هو زوال الروح.
وعموم الخطاب يشمل الوضعي والتكليفي ، كما في جملة من الخطابات المتعلقة بإتلاف الأموال ، ففي المقام بالأولى ، والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المعروفة.
وأما الأحكام الوضعية ، فهي ما تعلق بها غرض الشارع المقدس ، ولم تكن من الخمسة التكليفية ، وهي كثيرة كالضمان، والولاية ، والطهارة ، والنجاسة، وقد يجتمع الحكمان في شيء واحد ، كاشتغال الذمة بعوض ، فهو وضعي، ووجوب تفريغها تكليفي ، وقد ذكر التفصيل في محله فراجع كتابنا (( تهذيب الأصول )).
ثم إنه ذكر سبحانه وتعالى بعض موارد المساواة والتكافؤ بين المقتول ، ومن يراد الاقتصاص منه.
قال تعالى : {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } [البقرة : 178].
الحر : خلاف العبد لخلوصه عن الرقية ، والحر من كل شيء خالصه ، وأحرار البقول ما يؤكل غير مطبوخ.
والعبد من فيه الرقية ، وفي اصطلاح الكتاب والسنة هي المملوكية للغير بالملكية الظاهرية.
وعند جمع من أهل العرفان : كل من كان له علاقة بغير الله تعالى فهو عبد له ، وقالوا : إن عبد الشهوة والهوى أشد رقية من العبد المملوك للغير ، واستشهدوا لذلك بأدلة عقلية ونقلية ، لعلنا نتعرض لذلك في محله.
وكيف كان ، والمراد منه هنا المعنى الاول.
وفي الاية من البلاغة ما لا يخفى ، وفيها إشارة إلى بيان ذكر المثلية إجمالا.
قال تعالى : {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة : 178].
كان في أهل الجاهلية بغي وحمية ، وكانت القبائل تتحكم بحسب القوة والمنعة ، فإن قتل من حي أهل منعة وعز أحد ، لا بد لهم من الاقتصاص ، وكانوا لا يكتفون من القاتل فقط ، وإذا قتل منهم أنثى ، لا يقتصون من أنثى مثلها ، بل يقتصون من الذكر.
وقد أنكر الشارع هذه العادة ، وحكم بالمساواة بين القاتل والمقتول ، فإذا كان القاتل أنثى ، فلا بد وأن يقتص منها لا من غيرها ، وفيها بيان للمثلية أيضاً ، أي الحرة بالحرة ، والأمة بالأمة.
قال تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة : 178].
بعد أن ذكر وجوب القصاص ، وأنه أساس العدل في الجنايات ، وأنه الأصل في ردع الجاني من الاستمرار في الجناية ، بين هنا جواز العفو ، بل رجحانه ، وهو تعالى ينظر إلى الجانب الأخلاقي في هذا التشريع ، ويعطي أهمية خاصة إلى التراحم والتعاطف بين أفراد البشر ؛ في ظرف تسيطر على النفس الغرائز الدفينة والعادات السيئة الموروثة من الجاهلية ، فكان هذا التشريع موقفاً في الجمع بين الجانب العاطفي في الإنسان، والجانب الغريزي والشهوي فيه.
ومادة عفو : تأتي بمعنى المحو والزوال ونفي الأثر ، والتجافي عن الذنب ، ولها استعمالات كثيرة في القرآن الكريم ، قال تعالى : {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف : 199]
وقال تعالى : {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة : 95]
وقال تعالى : {وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25].
والعفو - بالتشديد - من أسماء الله الحسنى ، وفي بعض الدعوات : (( اللهم إني أسألك العفو ، والعافية ، والمعافاة )) .
والأول محو الذنب ، والثاني الصحة من الأسقام والأمراض ، والأخير الحفظ عن أن يظلم أحداً ، أو أن يظلمه أحد.
والفرق بين العفو والغفران ، أن الثاني يختض استعماله بالله تعالى غالباً ، وإن استعمل في غيره تعالى أحياناً ؛ قال سبحانه : {وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [التغابن : 14] ، بخلاف الأول فإنه يستعمل في غيره عز وجل كثيراً ، قال تعالى : {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237] ، وقال تعالى : { إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } [البقرة : 237].
ويقال : عفت الدار إذا انمحت آثارها.
ويمكن الفرق بينهما باعتبار المورد أيضاً ، فإن العفو يصح استعماله بالنسبة إلى مطلق سوء الأخلاق ، وإن لم يكن من الذنب الشرعي ، كما يصح استعماله بالنسبة إليه أيضاً ، بخلاف الغفران.
والتعبير بالأخ ، ترغيب إلى العفو ، والمراد به ولي الدم.
و" شيء " صفة للمفعول المطلق النائب عن الفاعل ، أي بعض العفو وشيء منه ، وهو حق الاقتصاص أولا ، ويشمل البدل والمبدل أيضاً.
والمعنى : ومن عفا لأخيه عن جنايته ، ولم يرد القصاص ، ورضي بالدية ، فهو خير له.
قال تعالى : { فاتباع بالمعروف}.
المعروف: ضد المنكر ، ومعناه كلفظه ؛ والمراد به كل ما حسن عند العقلاء ولم ينه عنه الشرع ، سواء كان واجباً ، أو مندوباً ، أو مباحاً.
وهو يختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
وقد وقع هذا اللفظ في القرآن الكريم والسنة الشريفة كثيراً ، قال تعالى : {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة : 180]
وقال تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]
وقال تعالى : { قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263]
إلى غير ذلك مما يقرب من أربعين مورداً.
وعن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " كل معروف صدقة ".
والمعنى : إن رغب في العفو عن القصاص ، لا بد له من اتباعه بالمعروف على الجاني ، بأن لا يرهقه في الدية ، أو ينظره إلى الميسرة إن كان ذا عسرة ، أو الطلب منه بالرفق ، أو يعفو عن بعض ، ونحو ذلك مما لا يستنكره العرف ، وذلك مرغوب فيه ، لا سيما في هذه الحال التي يكون الإنسان فيها أقرب إلى قوى البطش والانتقام منها إلى العقل.
قال تعالى : { وأداء إليه بإحسان}.
أي أداء من الجاني إلى الولي بالإحسان ، كما أحسن إليه بالعفو وإتباعه بالمعروف.
قال تعالى : { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}.
أي : أن تشريع القصاص والعفو عنه ، والانتقال إلى الدية والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان ، كلها تخفيف على الأولياء والجانين ورحمة لهم ، لأنه جل شأنه قادر أن يشرع عليكم بما يكون أشد من ذلك ، فقد راعى عز وجل الوسط بين الإفراط والتفريط.
مع أن في هذا التشريع الجديد تخفيفاً بالنسبة إلى ما كانوا قد اعتادوا عليه في الجاهلية ، فقد كان ذلك ثقلا كبيراً عليهم ، ورحمة عليكم في الامتناع عن إراقة الدماء ظلماً وعدواناً ، فلا يبقى بعد ذلك مجال للظلم والاعتداد .
قال تعالى : { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة : 178].
أي : فمن اعتدى وانتقم من الجاني بعد العفو ، أو تعدى عن الحد الذي قرره الله تعالى ، له عذاب أليم ، لأنه متعد عن القانون الإلهي ، وكل متعد كذلك لا بد وأن يعاقب عقلا وشرعاً ، فيكون مصيره إلى النار.
قال تعالى : {ولكم في القصاص حياة}.
بعد أن شرع تعالى القصاص ، وحكم بأنه لا بد من التساوي والتكافؤ بين الدماء ، ذكر هنا حكمة هذا التشريع الجديد وعلته بأفصح بيان وأبلغه ، وأوجز عبارة تفي بالمطلوب.
فكان أحسن كلام يقرع الأسماع ، وأباغ نظم يؤديه البيان ، قرن فيه بين التلطف والعتاب ، فما أجمل هذا الخطاب ، فاح نسيم الوحي من السماء فانفتح الكمام وتواضع كل من يدعي الفصاحة أمام حسنه ، واعيى كل من جهد نفسه في البلاغة ، ولو قورنت هذه العبارة مع ما قيل في مثل المقام ، كقولهم : ( القتل أنفى للقتل ) ، وقولهم : ( قتل البعض إحياء للجميع )، وقولهم ( أكثروا القتل ليقل القتل ) ، لكان ما ورد في القرآن كالدور في الظلماء ، والدار على الحار من حيث البلاغة والفصاحة ، وسيأتي في البحث الأدبي ما يتعلق بذلك.
والمعنى : أن في القصاص المذكور الحياة للفرد والمجتمع ، أما بالنسبة إلى المجتمع ، فإنه أحسن رادع عن الإقدام على قتل النفوس ، وإن فيه حفظ الناس عن اعتداء بعضهم على بعض ، وأما بالنسبة إلى الفرد فإن فيه حفظ نفسه ومن أراد قتله ، ولو فعله كان ذلك عبرة لغيره ممن يرد الإقدام على ذلك ، ففي القصاص حياة الناس والأفراد ، بل فيه تسلية لولي المقتول ، حيث يخفف عنه لوعة المصاب ، فكانت الغاية من القصاص وما يجتنى من عواقبه حميدة ، يعرفها كل من أعطي حق التأمل في هذا الحكم .
قال تعالى : { يا أولى الالباب}.
الألباب جمع اللب ، وهو العقل الخالص عن الشرائب ، لأن لب الشيء خالصه وصفوته ، ولذا جعل الله تعالى أولي الألباب مورد خطابه وعنايته في جملة كثيرة من الآيات القرآنية ، لأن ذا اللب هو الذي يعرف حقائق الأشياء وموازينها ، وآثارها وما يترتب عليها.
قال تعالى : {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } [البقرة: 197] وقال تعالى : { إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الرعد : 19] وقال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ } [الزمر : 21] ، إلى غير ذلك من الآيات المباركة.
وقد فسر سبحانه اللب في توله تعالى : {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر : 18].
ولم يرد لفظ اللب مفرداً في القرآن الكريم ، كما لم يرد لفظ العقل كذلك.
والمتأمل في الآيات المتضمنة لذكر أولي الألباب ، يعلم أنها وردت في مدحهم ، بخلاف العقل ، فإنه ليس كذلك ، قال تعالى : {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء : 67]
وقال تعالى : {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [النور : 61].
ولعل السر في عدم ورود المفرد لهذين اللفظين ، الإشارة إلى أنهما من الحقائق التي لا تحصل إلا من الاجتماع ، إما بعضهم مع بعض ، أو مع الأنبياء والإيمان بهم والعمل بما جاؤوا به ، مع أن مثل هذه الخطابات نوعية اجتماعية ملقاة إلى المجتمع ، لا إلى الفرد المعين.
واللب والعقل هما من أسرار الله تعالى التي أودعها في الإنسان ، وقد قال عز وجل حين خلقه - كما في الحديث : " وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي منك ، إياك آمر ، وإياك أنهى ، وبك أثيب وأعاقب " ، وهو أصل الإنسان وما سواه من القشر ، وهو مبدأ الاستكمالات وإليه المنتهى ، وبالعمل والتقوى والصلاح ، يرتقي العقل واللب ، ومنهما ينشأ الخير ، فيصغ أن يقال : قد اجتمعت العلة الفاعلية والغائبة فيهما.
والحاصل : أن اللب والعقل والفلاح والصلاح والتقوى ، كلها مفاهيم مختلفة لمعنى واحد ، إذا لوحظت المنشآت فإنها مرتبطة بعضها مع بعض ؛ فإن " الدنيا مزرعة الآخرة " كما قال نبينا (صلى الله عليه واله) خصوصاً بناء على الحركة الجوهرية التي أثبتها بعض أعاظم الفلاسفة.
نعم ، أصل هذه المزرعة وأساس العمل ، وبه يرتقي العقل ، ثم منه ينشأ الخير الذي يرجع بالآخرة إلى العقل أيضاً.
وإنما ذكرهم في المقام للتنبيه على أن هذا الحكم بما فيه من المصالح والآثار لا يعلمها إلا أولوا الألباب ، الذين يفقهون سر هذا الحكم باستعمال عقولهم.
ولذلك فمن ينكر هذا الحكم ، فهو متن ليس له لب وعقل ، فكان هذا كالدليل لما تقدم.
قال تعالى : { لعلكم تتقون}.
أي لعلكم تتقون الله في كل أموركم حيث شرع لكم هذا التشريع العقيم ، الذي ينبئ عن الحكمة والعلم ، أو تتقون الظلم خوفاً عن القصاص ، فتكفون عن سفك الدماء ، أو يتقي بعضكم بعضاً حرماً على الحياة.
ومنه يستفاد أن اللب السليم يرشد إلى التقوى ، وسبب استكمال ذوي الألباب .



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|