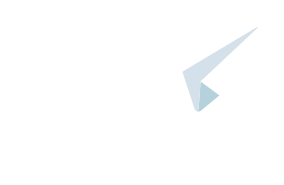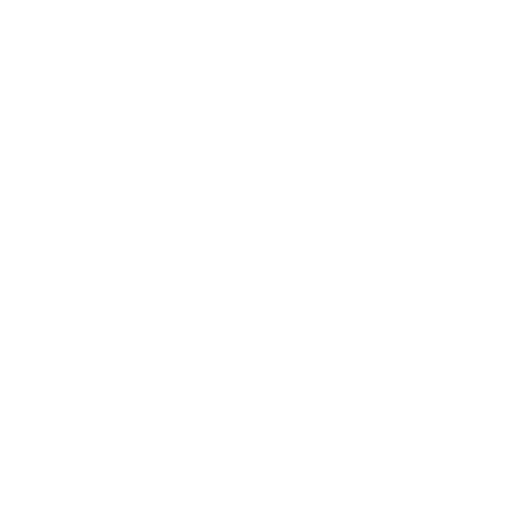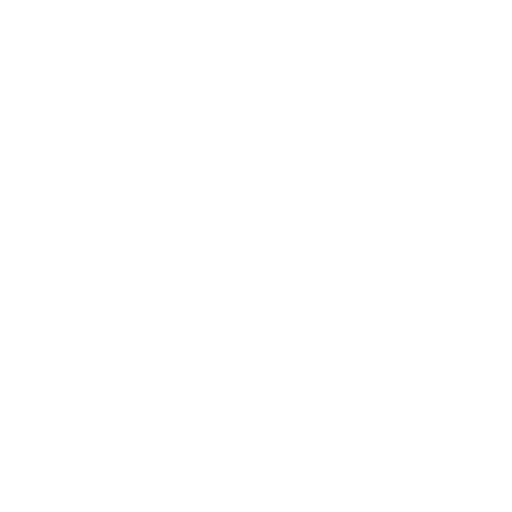تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
نظرية الإمام الخميني في المعاصرة القرآنية
المؤلف:
جواد علي كسار
المصدر:
فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية
الجزء والصفحة:
ص 483- 499 .
5-05-2015
4304
لا نستطيع أن نزعم بأنّ فكر الإمام الخميني ونصوصه القرآنية قدّما معالجة للمعاصرة القرآنية تنطلق من تعامل مباشر مع الإشكالية. فمسائل من قبيل حقيقة القرآن، ومراتب الفهم وموانعه، والتفسير والمفسّر، والتفسير بالرأي، والظاهر والباطن، والتأويل، والمحكم والمتشابه، وحجّية الظهور، والإعجاز، ومعنى الوحي وكيفية نزول القرآن، والحروف المقطعة ونفي التحريف وما إلى ذلك توفّر النص الخميني على عنونتها كمسائل قائمة بذاتها في علوم القرآن، ومبادئ التفسير، وتعامل معها مباشرة بأسمائها وعناوينها فضلا عن مضامينها.
أمّا في قضية المعاصرة القرآنية فما خلا بضعة إشارات إلى مضمونها، لا ندّعي أنّ الإمام خصّص لها عنوانا مستقلا، بحيث عمد من خلال ذلك إلى تحليل المشكلة وتفكيك عناصرها من خلال الموروث الفكري والنظري المتراكم من حولها، بغية إعادة تركيبها في تشييد نظري جديد يعبّر عن موقفه منها. وإنّما بين أيدينا موروث مهم من النصوص والأفكار والنظريات التي تعود إلى الإمام مباشرة أو تنتمي إلى مدرسته العرفانية، تسمح لنا باستنباط رؤية تعالج إشكالية المعاصرة على ضوء ما تقتضيه المنظومة العرفانية التي يتبنّاها ومذهبها الوجودي الذي ينتمي إليه.
على هذا ستكون المحاولة في هذا المحور أقرب إلى الاجتهاد في استنباط النظرية وبناء مكوّناتها، لكن على ضوء ما تسمح به نصوص الإمام خاصّة وفكر المدرسة العرفانية عامّة، وفي إطار ما تقتضيه المنظومة ذاتها.
الحقيقة بمقدورنا ردم عدد من الثغرات وسدّ ما نواجهه من نقاط فراغ في الرؤية القرآنية للإمام، عبر اللجوء إلى هذا الأسلوب. فليست قضية المعاصرة القرآنية وحدها هي ما يمكن تغطيته على هذا النحو، بل المجال مفتوح لممارسة الاجتهاد واستنباط الرؤى وبنائها وتشييدها بإزاء غير واحدة من القضايا الأخر الشبيهة بهذه القضية، والخروج بصياغة نظرية تتجاوب مع ما يقتضيه مذهب الإمام الفكري وانتمائه المدرسي.
لنأخذ مثلا قضية ديمومة القرآن واستمراره في أداء رسالته على مرّ العصور دون انقطاع، وكيف يمكن أن نخرج بهذه النتيجة من أحشاء الرؤية الوجودية التي تجعل القرآن الكريم مظهرا لاسم اللّه الأعظم أي الذات مأخوذا فيها الأسماء والصفات. فالإمام هنا لا يلجأ إلى علم الكلام وحججه المعروفة في إثبات دوام القرآن وخلوده، انطلاقا من مقولة أنّ الإسلام هو الدين الخاتم، ومن ثمّ فهو بحاجة إلى معجزة دائمة، والقرآن هو هذه المعجزة، بل يؤسّس لذلك من خلال النظرية الأسمائية نفسها لتكون هي بمنزلة الأساس أو المقدّمة، ودوام القرآن وخلوده بمنزلة النتيجة أو كلازمة من لوازم النظرية. يكتب مدللا على ذلك : «لا يعدّ هذا الكتاب قابلا للنسخ والانقطاع، لأنّ الاسم الأعظم ومظاهره أزليان وأبديان» (1). فما دام القرآن مظهرا للأزلي؛ للاسم الأعظم وتجليا تاما له، فلا معنى لبلائه أو انقطاعه أو اقتصاره على عصر دون آخر، بل هو حضور دائم متدفّق دون انقطاع تبعا لديمومة الاسم الأعظم ذاته وأزليته.
هكذا الحال في المعاصرة القرآنية، فنحن بإزاء عملية استنباط لتكوين الرؤية وبنائها. على أنّ من النافع أن نكرّر القول بأنّ فكر الإمام ونصوصه لا يخلوان تماما من إشارات مباشرة إلى المعاصرة القرآنية في بعض وجوهها، على ما سنلحظ ذلك لاحقا.
على ضوء ذلك كله، ستبدو الآفاق أمامنا مشرعة لاستخلاص رؤية الإمام في المعاصرة القرآنية، من خلال المستويات الثلاثة التالية :
أ- الرؤية الوجودية وما تقتضيه حصيلتها المعرفية.
ب- نظرية المقاصد القرآنية وما يترتب عليها من لوازم.
ج- مداخل متفرّقة اخرى، وخاصّة مدخل تجدّد المعاني بتعدّد التلاوات.
أ- المعاصرة على ضوء الرؤية الوجودية
لن نستحضر النصوص في هذه الفقرة، بل سنسوق مبادئ الرؤية العرفانية للوجود والإنسان والقرآن كاصول موضوعة، صحيحة وثابتة، استنادا إلى ما مرّ علينا فيما سلف لا سيّما في الفصول الخامس والسادس والسابع.
مرّ معنا أنّ التصوّر العرفاني عن نشآت الوجود يستند إلى شبكة من الروابط الوجودية والسنن التكوينية الحقيقية. وللواقع في هذا التصوّر مراتب، إذ لكلّ شيء مراتب : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}[ الحجر: 21]. فكلّ ما يصحّ عليه شيء حقيقة فله مراتب، والمقصود بالشيء هو الشيء التكويني كالإنسان والحيوان والأنهار والأشجار مثلا وليس الصناعي كالطائرة والدرّاجة.
فلو أخذنا القرآن الكريم- حيث يدور عنه الكلام- فإنّ له نشأة وجودية قبل هذا العالم أسوة بغيره من موجودات عالم الإمكان، كما له مراتب تنزّل عبرها إلى أن بلغ صورته التي بين أيدينا، وكلّ مرتبة هي قرآن. كذلك الإنسان وأيّة حقيقة وجودية اخرى.
هكذا يخلص هذا التصوّر إلى أنّ لكلّ مفردة من مفردات الوجود الإمكاني مراتب طولية متعدّدة، وباللغة العلمية فالواقع ليس متواطئا وإنّما مشكّك له مراتب.
والسرّ من وراء هذا التصوّر أو المرتكز الذي يقوم عليه هو إدخال العرفاء للأسماء والصفات في هذه المنظومة، فعند ما تدخل الأسماء والصفات على الخط تقود إلى تعدّد مراتب الواقع، بعكس ما لو أغضينا عن هذه النظرية، إذ لن يكون ثمّ معنى لتعدّد المراتب. فأيّما حقيقة تدخل عليها مقولة تعدّد مراتب الواقع، فإنما يكون ذلك بسبب فاعلية نظرية الأسماء والصفات، وكأثر لها.
المدلول المعرفي وانتاج المعاصرة
هذا التصوّر الوجودي الذي يفتح كلّ شيء على تعدّد مستويات الواقع ومراتبه، يفتح بابا عميقا للعصرية حين ننطلق به من القرآن، ونأخذ بنظر الاعتبار دلالته المعرفية. فالنصّ القرآني الذي يعدّ التعبير اللفظي للوجود الواقعي التكويني للقرآن، يغدو قادرا معرفيا على استيعاب معطيات العصور في كلّ اتجاه، بدءا من الإنسان نفسه وما يحرزه من عمق وانتهاء بالواقع المعاش وما يفرزه من معطيات.
لكن ينبغي أن ننتبه بأنّ القرآن لا يحقّق المعاصرة هنا من زاوية كونه نصّا ذا بنية لغوية متميّزة، وإن كان هذا أمر لا ينكر له مدخليته الخاصّة في توليد المزيد من المعاني، والسماح باستيعاب المعاصرة في أحد أوجهها، وإنّما المعني به هنا، هو :
بوصف هذا النص تعبيرا عن واقع ذي مراتب.
معرفيا تعدّ كلّ رؤية بافتراض صحّة منطلقاتها وسلامة قواعدها هي تعبير عن الواقع، أو على نحو أدقّ تعبير عن درجة من درجات الواقع، ومن ثمّ فهي حقّ وواقع ولكن بحسب تلك الدرجة التي انكشفت للعارف أو بلغها ذلك الإنسان وأصابها بنظره. وبذلك فالخطّ مفتوح لإنتاج صيغ عصرية ومعان جديدة للنص القرآني باستمرار، تأخذ بحسبانها جميع أبعاد النموّ في قابليات الإنسان العقلية والكشفية، وما تنتجه تحوّلات الحياة من حوله وما تحرزه من ازدهار وتقدّم.
المرتكز الملحوظ هنا في تعدّد القراءات وتوالدها هو الواقع وليس الفهم.
فالواقع هو الذي ينطوي على مراتب لا أنّ لفهمي مراتب، فالفهم مرتبط بالواقع، وعلى نحو أدقّ بمرتبة من مراتب الواقع. وهذا الفهم صحيح من هذه الزاوية، مطابق للواقع ولا إشكال. والطريق مفتوح إلى ما هو أرقى منه وأكمل، مرتبط بقدرة الإنسان نفسه على تجاوز المرتبة التي بلغها إلى ما هو أعلى منها وهكذا. فعلى قدر ما يعمّق الإنسان مرتكزاته العقلية أو الكشفية بأي طريق كان بالرياضة العقلية أو بالتهذيب والتزكية أو بالالتحام مع الواقع الحياتي المعاش من حوله والإفادة من معطياته، بمقدوره أن يصيب درجة أعلى من الواقع ويحقّق فهما جديدا وأرقى للنص القرآني.
مثال توضيحي
تفترض النظرية السائدة في تفسير تعدّد الأفهام والقراءات وحدة الواقع وتعدّد الفهم، ومن ثمّ لا خيار للإنسان إلّا أن يصيب ذلك الواقع الأوحد ويتطابق معه ليكون قد أصاب الحقيقة نفسها، أو أن يخطئه ويزيغ عنه ليكون قد أخطأ الحقيقة.
أمّا في النظرية العرفانية فالأمر مختلف، إذ الأفهام والقراءات تصيب الواقع بأجمعها بافتراض صحّة الضوابط الاخرى، ولكن غاية ما هناك أنّ كلّ فهم أو قراءة تصيبه في درجة أو في مرتبة من مراتبه.
فلو افترضنا وجود لوحة متعدّدة الألوان من عشرة أمتار ممتدّة من أسفل نحو الأعلى، وهي موزّعة على عدّة ألوان لنفترض أنّها ثلاثة، هي من تحت إلى أعلى :
الأبيض والأحمر ثمّ الأخضر. ولنفترض أيضا أنّه وقف أمام هذه اللوحة ثلاثة أشخاص بطريقة بحيث لا يستطيع كلّ واحد منهم أن يرى إلّا لونا واحدا من ألوانها، فعند ما يسأل الشخص الأوّل عن لون اللوحة ويجيب أنّه أبيض بلحاظ ما هو موجود أمامه فإنّ جوابه صحيح، وكذلك الثاني حين يقول إنّ لونها أحمر، وأيضا الثالث الذي يقول إنّه أخضر. فكل إجابة من هذه الإجابات الثلاث صحيحة في نفسها وهي تعبّر عن الواقع نفسه وليست هي قراءة عنه. فمن أجاب بأنّ لون اللوحة أبيض لم يكن يرى سوى البياض، والبياض هو الواقع بالنسبة إليه، وهكذا بالنسبة إلى اللونين الباقيين.
طبيعي أنّ القول بأنّ للقرآن مراتب، لا يعني أنّ كلّ فهم هو تعبير عن مرتبة من مراتب القرآن هكذا مطلقا، بل قد تكون بعض الفهوم مخطئة غير مصيبة للواقع بأية مرتبة من مراتبه. إنّما القصد هو إثبات أنّه ليس ثمّ ضرورة في أن يكون فهما ما هو وحده المصيب للواقع، وبقية الفهوم خطأ.
المراد اثباته، هو : بعد أن ثبت أنّ الواقع متعدّد، إذن يمكن أن يكون فهمنا عن الواقع متعدّدا أيضا، وأنّ جميع الفهوم صحيحة ومصيبة للواقع بشرط رعاية بقية الجوانب، لا أنّ واحدا منها مصيب للواقع والبقية مخطئة.
عند ما نقبل على ما بين أيدينا من اتجاهات ومدارس فالعرفاء هم الذين يقولون بتعدّد الواقع. وهذا ما يدفعهم لعدم تخطئة الآخرين من ذوي النحل النقلية والكلامية والفلسفية، بعكس بقية الفرقاء. فالفيلسوف المشّائي مثلا بحكم انتظامه داخل الإطار الأرسطي الذي يقول بوحده الواقع، تراه من المستحيل أن ينبلج أمامه خيار ثالث يضاف إلى خياري إصابة الواقع الواحد أو عدمه، فإمّا إنّك تصيب ذلك الواقع فنظرك صحيح، وإمّا إنّك تخطئة فنظرك خاطئ بالتبع له.
لذلك حين يسجّل المشّائي أنّه أصاب الواقع بحسب مقاييسه الخاصّة، ستكون الحصيلة هي إلغاء الآخرين عرفاء وفقهاء ومتكلّمين.
لقد عشنا هذه النظرة الرحيبة في نصوص الإمام الخميني كما مرّت علينا في الفصول السابقة، وهي تسجّل أنّ القرآن الكريم مائدة ممتدّة للجميع ومفتوحة على قراءات وفهوم لا تنتهي يأخذ منها كلّ إنسان على قدر سعته الوجودية وقابلياته الفكرية (2). وعند ما مرّ سماحته على بعض الآيات الكريمة ممّا له دلالة على توحيد الذات والصفات (3) ، نراه قد سجّل نصا بأنّ «علماء الظاهر والمحدّثين والفقهاء رضوان اللّه عليهم فسروا هذه الآيات على نحو مخالف بل مباين بالكامل لما فسّرها به أهل المعرفة وعلماء الباطن» (4) ليخلص من وراء ذلك إلى أنّ رأيه يقوم على تصحيح تفسير الفريقين كليهما، وبنص تعبيره : «ما يذهب إليه الكاتب أنّ المنحيين التفسيريين صحيحان كلا في محله». هذا التصحيح لنمطين من التفسير يسجّل الكاتب أنّهما متباينين بالكامل، لا يمكن توجيهه على ضوء دواع أخلاقية أو اجتماعية تحرص على الألفة ووحدة الصف برغم سلامة مثل هذه الدواعي، وإنّما يجد تعليله المنطقي في نظرية تعدّد مراتب الواقع التي يؤمن بها الإمام.
وهذا بالضبط ما ينقلنا إلى مشروع الإمام في التوحيد بين العارف والفيلسوف والفقيه (5)، الذي خصّصنا له القسم الثاني من هذا الكتاب. فمثل هذا المشروع التوفيقي لا يمكن تفسيره على أساس دواع أخلاقية أو ضرورات اجتماعية للامّة أو للمجتمع المسلم، وإنّما يحتاج إلى أساس منطقي يسوّغه ويبرّره. ونظرية تعدّد مراتب الواقع هي التي تقدّم الأساس المنطقي المنشود والبناء المعرفي التحتي المطلوب لمثل هذا المشروع، على ما سيأتينا ذلك تفصيلا في القسم الثاني من الكتاب إن شاء اللّه.
هكذا نخلص إلى أنّ مشكلة المعاصرة تنحلّ على ضوء تعدّد مراتب الفهم بتبع تعدّد مراتب الواقع، إذ سيفرز كلّ عصر فهمه، وهذا الفهم معاصر لعصره وهكذا.
بكر أبدا
على رغم الآفاق الممتدّة التي تشقّها هذه الرؤية، على النحو الذي تجعل القرآن قادرا على امتصاص عناصر المعاصرة في كلّ زمن وتحقيق عصريته في كلّ وقت بل في كلّ لحظة، فإنّها مع ذلك تومئ إلى معنى كبير يفيد أنّ القرآن يأتي بكرا يوم القيامة لم تستنفده النظريات والرؤى والأفكار والمناهج والتفاسير، ولم تبله العصور ولم تخلقه الأزمنة، بل تراه يعلو فوق الأزمنة والعصور ويسمو عليها، لكن لا على نحو القطيعة والانفصال وإنّما من خلال الاستنفاد والتجاوز. فكتاب اللّه يستوعب في كلّ عصر متغيّرات عصره وما يبلغه مستوى الإدراك العقلي للإنسانية من نموّ وما تحقّقه اطر الحياة من ازدهار، عبر التفاعل مع الإنسان والالتحام مع الحياة، ثمّ يتخطّى ذلك ويتجاوزه لما بعده ليبقى متدفّقا بالمعاني منتجا ما لا ينتهي من الفهوم والقراءات، ثمّ يأتي يوم القيامة بكرا.
وبقاؤه جديدا أبدا هو ممّا ينسجم مع الدليل ويتجاوب مع رؤية هذه المدرسة، التي ترى في كتاب اللّه تجليا للاسم الأعظم وما تحته من أسماء وصفات، وبتعبير الإمام نفسه : «هذا الكتاب الشريف هو صورة أحدية جمع جميع الأسماء والصفات، ومعرّفا لمقام الحقّ المقدّس بتمام الشئون والتجليات. بعبارة اخرى إنّ هذه الصحيفة النورية صورة (الاسم الأعظم)» (6)، فحين يكون القرآن الكريم بهذه المثابة وهو تعبير عن علم اللّه سبحانه بل أنّ «الحقّ تعالى بجميع شئونه الأسمائية والصفاتية هو مبدأ هذا الكتاب الشريف» (7)، فلا معنى موضوعيا لتجاوزه وتخطّيه وهو تعبير عن المطلق. فمهما أوتي الإنسان من قوّة في الكشف والعمق الإدراكي ومن سعة في الفكر ودقّة في الاستدلال، ومهما بلغت بالحياة أشواط التقدّم والرقي فلن يكون بمقدور ذلك كله استنفاد المطلق فضلا عن تخطّيه وتجاوزه.
الخلاصة
يمكن تلخيص حصيلة الرؤية، بما يلي :
1- تؤسّس المدرسة العرفانية للمعاصرة استنادا لتصوّرها الوجودي الذي يقول بتعدّد مراتب الواقع، وما يترتب على ذلك من مدلول معرفي يتمثّل بتعدّد الأفهام والقراءات، حيث تتعامل مع القرآن بوصفه حقيقة ذات مراتب.
2- ترفض المدرسة في مقام الإثبات مبدأ القراءة استنادا إلى الوجدان الشخصي أو الكشف أو التجربة الذاتية وما شابه، بل لا بدّ لكلّ قراءة أن تؤسّس لمشروعيتها على اصول ومبادئ واسس ومرتكزات، وتتواصل مع الذخيرة العقلية المشتركة عند البشر ولا تتعارض مع ثوابت الدين. أي أنّ الناظم العقلي هو المعيار في اصول المعارف والمعتقدات، والديني ولا سيّما التشريعي هو المعيار في العمليّات.
3- تعدّ كلّ قراءة صحيحة بشرط المحمول، أي هي صحيحة لمن هو في مرتبة خاصّة من المراتب، أمّا إذا تجاوزها إلى ما هو أرقى منها، فالأدنى لن تعود صحيحة بالنسبة إليه.
4- يتعانق العصر والواقع المعاش مع هذه الرؤية ويدخلان في تكوين بنيانها.
فمعطيات كلّ عصر تسند خلفية الإنسان ووعيه وعقله في إثراء قدراته على التعامل مع القرآن، بحيث لو لم تكن هذه الوقائع منكشفة له لما اتجه ذهنه صوب أغوار القرآن ومعانيه.
العالم في هذه الرؤية يفتح الآفاق ويثير العقول، والدعوة العرفانية تحثّ على التفاعل مع الواقع ولا تدعو إلى الانعزال والانفصال، بل تصرّ على الجدية وبذل
الجهد في اكتشاف علائق الواقع وقوانينه، لأنّ مع كلّ كشف في الواقع وتعمّق فيه، يتحوّل ذلك إلى منشأ لاكتشاف حقائق من نظام التكوين، وبالتفاعل بين عالمي التكوين والتدوين (القرآن) تتفجّر معاني القرآن وتتوالد باستمرار.
على هذا لا تعدّ النظرية العرفانية في وجهها المعرفي هذا حائلا يصدّ عن الواقع، بل هي تدفع إلى اكتشاف أنظمته واستبدل القطيعة بالمعايشة الدائبة الفاعلة، ذلك أنّ العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس.
5- تتّسم نظرية العرفاء بالرحابة الخصبة ليس في التعامل المعرفي مع القرآن وحده، بل ومع الآخر أيضا. فالعارف لا يرفض الآخر بل يصحّح له، لأنّ الواقع عنده متعدّد، على عكس الفقيه والمتكلّم والفيلسوف إذ تختفي الرحابة بحكم الارتكاز إلى نظرية وحدة الواقع، وإن كان ابتناء الاجتهاد الفقهي على الحكم الظنّي وليس إصابة الحكم الواقعي يسمح بالتعدّد أيضا، لكن في مضماره وحسب.
6- تعدّ هذه الرؤية التي تستند إلى حق الإنسان في كلّ عصر بإنتاج قراءاته وفق الضوابط والاصول، أوصل بفلسفة الدين الخاتم، وأقدر على تفسير ديمومة القرآن والتجاوب مع هاجس المعاصرة، خاصّة وأنّه لا دليل على أنّ المطلوب هو اجتماع الجميع على نظرية أو قراءة واحدة في فهم القرآن والتعاطي معه.
ب- المعاصرة على ضوء النظرية المقاصدية
المقصد الأساس للقرآن في نظرية الإمام أو المدرسة العرفانية عامة، هو فتح باب معرفة اللّه، و«دعوة العباد إلى معرفة اللّه وبيان المعارف الإلهية من الشئون الذاتية والأسمائية والصفاتية والأفعالية، والأهمّ من ذلك كلّه في هذا المقصد، هو
الدعوة إلى توحيد الذات والأسماء والأفعال» (8)، حين يكون هذا هو المقصد الرئيسي للقرآن، فإنّ هذه الرؤية في التعاطي مع القرآن عبر هذا الأفق تسمح لنا بمدخل آخر لولوج قضية المعاصرة.
على أساس هذه الرؤية لمقاصد القرآن التي مرّت علينا بمضامينها ونصوصها تفصيلا في الفصل الثالث من القسم الأوّل من الكتاب، تنحسر الجوانب العملية وتضيق المتغيّرات حتّى تتحوّل إلى ما يشبه الهامش بالقياس مع هذه المقاصد الأساسية. وعندئذ يحقّ لنا السؤال عن معنى المعاصرة بمفهومها الزمني والاجتماعي ومدى فاعليتها في المعارف الأساسية والاصول الاعتقادية؟ لا أظنّ أنّ هناك متّسعا كبيرا يبقى للمعاصرة بمفهومها الحياتي المتغيّر، إذا انتبهنا إلى أنّ القرآن هو كتاب معرفة لاصول المعتقد في ظلّ النظرية المقاصدية التي يتبنّاها الإمام والمدرسة العرفانية، وتجعل توحيد اللّه (جل جلالهـ) هو المقصد الأعلى.
أجل، هذه الرؤية المقاصدية التي تركّز على المعرفة ومعرفة الحقّ سبحانه في الطليعة، لا تتصادم مع المعاصرة بمفهومها المعرفي الذي يسمح بتعدّد القراءات أو مراتب فهم اصول المعتقد، خاصّة مع التزام التمييز بين التكوينيات والاعتباريات. توضيح ذلك، أنّ المعتقدات هي امور وحقائق مرتبطة بنظام التكوين، ومن ثمّ فهي ليست من سنخ الاعتباريات بحيث تتأثّر أو تزول بزوال المبرّرات التي أملت اعتبارها. وحيث تعدّ المعتقدات من الحقائق الوجودية، فهي لا تتأثّر بالبعد التأريخي والبيئي الثقافي واللغوي تماما كالمعادلات الرياضية.
من المعقول جدّا أن يؤثّر البعد البيئي والثقافي واللغوي والاجتماعي في تكوين وصياغة الأطر الاجتهادية التي نفهم من خلالها هذه المعتقدات، لكن لا على النحو الذي ينقلها من دائرة الإثبات إلى النفي أو بالعكس. وهذه هي المساحة التي تتحرّك بها المعاصرة بمفهومها الزمني والاجتماعي المتحرّك، حيث يمكن أن تؤثّر في الأطر دون المضمون.
لكن هل يعني ذلك أنّ مضمون المعتقدات التي عرض لها القرآن الكريم، هو مضمون واحد جامد لم يتغيّر؟ كلا، فلا واقع المسلمين وتاريخهم يؤيّد ذلك ولا منطق القرآن. ما تذهب إليه المدرسة الوجودية أو العرفانية أنّ للتوحيد والنبوة والمعاد وبقية اصول المعتقد الإسلامي وما يرتبط بها من فروع (أقصد فروع المعتقد لا الفروع العملية) مراتب متعدّدة في الواقع ونفس الأمر، وليس مرتبة واحدة. هذا التعدّد هو الذي يسمح بدور فاعل للمعاصرة المعرفية إذا صحّ المصطلح، بحيث يكون للناس في كلّ عصر، بل في العصر الواحد، أكثر من تصوّر للمعتقد كلّها صحيحة إذا توافر لها التأسيس السليم وصحّت قواعدها ومنطلقاتها تبعا لتعدّد مراتب الواقع نفسه.
مرّة اخرى، هذا لا يعني أنّ كلّ قراءة صحيحة لمجرّد أنّها شيّدت لنفسها مجموعة قواعد واطر، بل لا بدّ أن تستند إلى اصول واسس ومرتكزات يذعن لصحتها الجميع، وهذه الاسس لا يمكن إلّا أن تكون عقلية ما دام الحديث يدور في المعتقدات، وإن كان للنقل دوره في إثارة التفاصيل وإشباعها.
استنادا إلى ما مرّ يمكن أن نخلص إلى ما يلي :
1- المقصد الأساسي للقرآن في نظرية الإمام لمقاصد القرآن، هي اصول الاعتقاد وبالأخصّ التوحيد.
2- حين يكون القرآن كتاب معرفة اصول المعتقد، وحين تكون المعتقدات حقائق وجودية في متن التكوين، فإنّ ذلك كلّه يضيّق من دائرة المعاصرة بمعناها الاجتماعي والثقافي أو الزمني بتعبير أدقّ، لأنّ تغيّر العصور وتوالي الأزمنة واطّراد التقدّم، كلّ ذلك لا أثر له في التأثير على هذه الحقائق الوجودية التكوينية فضلا عن تغييرها.
3- هناك دور فاعل للمعاصرة المعرفية وإنتاج المزيد من الفهوم تترتب معرفيا على التصوّر الوجودي الذي يقول بتعدّد مراتب الواقع، بما في ذلك اصول المعتقد. ومن ثمّ تفتح هذه الرؤية نافذة واسعة لقراءات أو فهوم مستجدّة لاصول المعتقد القرآني، من دون أن يكون ثمّ أمد لتصوّر نهاية لسعي الإنسان على هذا الخطّ. فمع كلّ عمق يحرزه الإنسان، يحقّق في مقابله فهما أرقى للمعتقدات يتجاوب مع مرتبة أعلى لها على خطّ الواقع المتعدّد المراتب، من دون أن يعني ذلك تصحيح جميع الفهوم والقراءات أو غياب الضوابط المؤسّسة لها.
4- يتجه دور المعاصرة الزمنية إلى اطر الفهم وقواعد الاجتهاد في التعاطي مع النص القرآني، كما سيكون لها مداها على صعيد المتغيّرات التي ترتبط بالامور العملية وبالنظم الحياتية، ممّا يمكن أن نلمس فيه رؤى الإمام ومواقفه منها تفصيلا خلال الأقسام الآتية من الكتاب ولا سيّما القسم الثالث الذي يتحدّث عن القرآن في النهضة وواقع الحياة.
ج- مداخل متفرّقة
تتضمّن نصوص الإمام عددا آخر من المداخل إلى قضية المعاصرة القرآنية، سواء باسمها وعلى نحو مباشرة، أو بشكل غير مباشر.
وفيما يلي إشارة إلى بعضها (9) :
1- يلجأ الإمام إلى المنهج الكلامي في إثبات عصرية القرآن، حينما يصوغ دليل الإحاطة، على النحو التالي :
«1- اللّه هو مصدر القانون الإسلامي.
2- اللّه محيط بجميع العصور.
3- ومن ثمّ فإنّ القرآن هو كتاب جميع العصور» (10). وبذا فهو في كلّ عصر جديد، له كلمته إلى البشرية ورسالته التي ينهض بها في الحياة.
2- في مقاربة اخرى يستند الإمام إلى عدم تناهي القرآن، بحكم صدوره عن المطلق، ليجعل من ذلك مرتكزا لتلبيته حاجات البشر في كلّ وقت. يقول سماحته :
«القرآن غير محدود» (11)، و«القرآن يشتمل على جميع المعارف، وكلّ ما يحتاج إليه البشر» (12) وبالتالي فإنّ لديه ما يعطيه للإنسانية في كلّ عصر وزمان.
تجدّد المعاني بتعدّد التلاوات
3- ثمّ مدخل للمعاصرة غالبا ما يستند إليه العرفاء في التدليل على طراوة كتاب اللّه وتفجّره بالعطاء في كلّ وقت وعصر، وقد رأيت إعجابا به من قبل الدارسين المعاصرين من مختلف الاتجاهات.
يتحدّث هذا المدخل صراحة عن تجدّد المعاني وتواليها بتعدّد القراءات، فمع أنّ المتلوّ واحد إلّا أنّ المعاني تتجدّد على الدوام، بتبع اختلاف الأشخاص بل حتّى الشخص الواحد نفسه، وتبدّل الأوضاع والأزمان والحالات، ممّا يسمح بإدخال المعاصرة الزمنية ذات البعد الاجتماعي والثقافي والحياتي بجميع عناصرها. فكلّ العناصر الذاتية التي يعيشها الإنسان، والعوامل الموضوعية التي يلامسها في واقع الحياة تؤثّر في خلق حالة للتلاوة تختلف من إنسان لإنسان، بل تختلف عند الإنسان نفسه بين حال وحال، وكذلك تختلف من زمن لآخر ومن عصر لعصر، بما يفضي إلى تجدّد المعاني. وبتعبير الإمام فإنّ التلاوات والمعاني المترتبة عليها «تختلف باختلاف الأشخاص وفي شخص واحد، باختلاف الحالات والواردات والمقامات، وتختلف باختلاف المتعلّقات» (13).
وهذا يحصل مع كلّ آية، حتّى لآية تتكرّر مع كلّ سورة هي آية البسملة، فضلا عن بقية الآيات والسور، وعن القرآن برمّته.
بيد أنّ هذه الفكرة في تجدّد المعاني وتنوّعها، تبعا لمكوّنات الإنسان وحالاته وعلاقته مع الواقع الذي يعيش، بحيث يترك كلّ ذلك أثره على النص وعلاقة القارئ بالنص؛ هذه الفكرة تعود بذروها إلى الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي تماما كما في بقية أفكار الإمام العرفانية وبقية العرفاء. فابن عربي هو الذي وضع بذار هذه الفكرة وتابعه عليه الإمام كما غيره، حيث يكتب في «الفتوحات المكّية» بأنّ الإنسان الفهم المراقب أحواله يتلو «القرآن فيجد في كلّ تلاوة معنى لم يجده في التلاوة الاولى، والحروف المتلوّة هي بعينها ما زاد فيها شيء ولا نقص، وإنّما الموطن والحال تجدّد، ولا بدّ من تجدّده فإنّ زمان التلاوة الاولى ما هو زمان التلاوة الثانية» (14).
علاقة الانسان مع القرآن علاقة مفتوحة على قراءات متدفّقة متنوّعة تتجدّد باستمرار بتجدّد الزمن نفسه، فلكلّ آن تلاوته ومن ثمّ للنص معناه الذي يختلف عن معنى التلاوة الاولى، بشرط أن نلحظ القيود التي ذكرها ابن عربي للقارئ من كونه فهما أي متّصفا بالفهم، مراقبا لأحواله، وإلّا فإنّ تلاوة الغفلة التي يغيب عنها التوجّه والتدبّر لا تورث هذا التجدّد الخصب في المعاني.
ربما استطعنا أن نضيف الى هذا المدخل مفهوم العرفاء بما فيهم الإمام الخميني عن التنزّل، وقيمة هذا المفهوم في استيلاد معان لكتاب اللّه لا تنتهي. للقوم كما يذكر الإمام مفهوم واسع لتنزّل القرآن، إذ للقرآن تنزّلات وليس تنزّلا واحدا، منها تنزّله على القلوب. وفي تنزّل القلوب نحن في الحقيقة بمواجهة تنزّلات لا تنتهي، فمنذ التنزّل الأوّل على قلب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والقرآن «لا يزال ينزل على قلوب أمّته الى يوم القيامة» ومن ثمّ «فنزوله في القلوب جديد لا يبلى» وله مع كلّ نزول مع كلّ إنسان معنى، والمعاني متوالية دائمة إلى أن ينتهي شوط الإنسان على الأرض وفي الحياة، عندئذ فقط تتوقّف عملية التلاوة لتوقّف النزول، ويرفع كلام اللّه «من الصدور ويمحى من المصاحف» لأنّه لا يبقى «مترجم [أي إنسان] يقبل نزول القرآن عليه» (15).
هكذا يبقى القرآن مع الإنسان يؤدّي دوره في الهداية على الدوام، الى أن تقف الحياة بالإنسان وينتهي شوطه على الأرض، فيرتفع القرآن. ومع ذلك يأتي كتاب اللّه يوم القيامة غضّا جديدا، والحمد للّه ربّ العالمين.
(2)- راجع مثلا : صحيفه امام 14 : 387.
(3)- مثل قوله سبحانه : {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ} (الحديد : 3)، وقوله : {اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ والْأَرْضِ} (النور : 35)، وقوله : {وَهُوَ مَعَكُمْ}، (الحديد : 4)، وقوله : {فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}، (البقرة : 115) في توحيد الذات.
و قوله سبحانه : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ}، (الفاتح : 2)، وقوله : {يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ}، (الجمعة : 1) ، وقوله : {وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكِنَّ اللَّهَ رَمى}، (الأنفال : 17) في توحيد الأفعال. (راجع : آداب الصلاة : 185- 186)
(4)- آداب الصلاة : ص 185.
(5)- تنظر خطوطه العريضة : تفسير سورة حمد : 175- 193. على أنّ بذور هذا المشروع في التوفيق بين المشهود والمعقول والمنقول أو بين العرفان والفلسفة والبيان (القرآن) كانت واضحة في كتاب الإمام «شرح دعاء السحر».
(6)- آداب الصلاة : 321.
(7)- نفس المصدر.
(8)- نفس المصدر : 185.
(9)- ستأتينا مضامين اخرى عن المعاصرة القرآنية خلال الأقسام الآتية وخاصة القسمين الثالث والرابع من الكتاب.
(10)- صحيفه امام 8 : 171.
(11)- نفس المصدر 12 : 420.
(12)- نفس المصدر 20 : 249.
(13)- شرح دعاء السحر : 91.
(14)- الفتوحات المكّية 4 : 258.
(15)- نفس المصدر 3 : 108.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












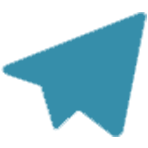
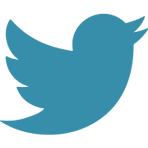

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)