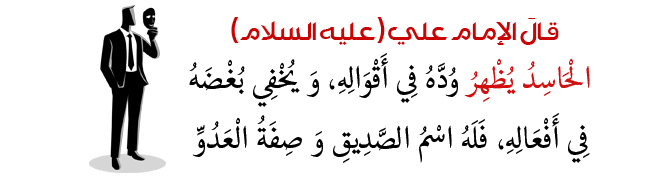
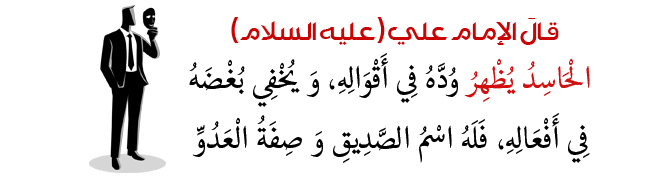

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-11-2014
التاريخ: 19-09-2014
التاريخ: 18/12/2022
التاريخ: 10-06-2015
|
لقد تحدّى القرآن بالبلاغة كقوله تعالى : { أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [هود : 13، 14], والآية مكيّة، وقوله تعالى : {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} [يونس : 38، 39] ، والآية أيضا مكيّة وفيها التحدّي بالنظم والبلاغة فإنّ ذلك هو الشأن الظاهر من شئون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ، فالتاريخ لا يرتاب أنّ العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدّمة عليهم والمتأخرة عنهم ووطئوا موطئا لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق. وقد تحدّى عليهم القرآن بكلّ تحدّ ممكن ممّا يثير الحمية ويوقد نار الأنفة والعصبيّة، وحالهم في الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم ممّا لا يرتاب فيه، وقد طالت مدّة التحدّي وتمادى زمان الاستنهاض فلم يجيبوه إلّا بالتجافي ولم يزدهم إلّا العجز ولم يكن منهم إلّا الاستخفاء والفرار، كما قال تعالى : {يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} [هود : 5]
و قد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرنا ولم يأت بما يناظره آت ولم يعارضه أحد بشيء إلّا أخزى نفسه وافتضح في أمره. وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات والمناقشات، فهذا مسيلمة عارض سورة الفيل بقوله : «الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل» وفي كلام له في الوحي يخاطب السجاح النبية «فنولجه فيكن إيلاجا، ونخرجه منكن إخراجا» فانظر إلى هذه الهذيانات واعتبر، وهذه سورة عارض بها الفاتحة بعض النصارى «الحمد للرحمن ربّ الأكوان، الملك الديان لك العبادة وبك المستعان اهدنا صراط الإيمان» إلى غير ذلك من التقوّلات.
فإن قلت : ما معنى كون التأليف الكلامي بالغا إلى مرتبة معجزة للإنسان ووضع الكلام ممّا سمحت به قريحة الإنسان؟ فكيف يمكن أن يترشّح من القريحة ما لا تحيط به والفاعل أقوى من فعله ومنشئ الأثر محيط بأثره ؟.
وبتقريب آخر، الإنسان هو الذي جعل اللفظ علامة دالّة على المعنى لضرورة الحاجة الاجتماعيّة إلى تفهيم الإنسان ما في ضميره لغيره فخاصّة الكشف عن المعنى في اللفظ خاصّة وضعيّة اعتباريّة مجعولة للإنسان، ومن المحال أن يتجاوز هذه الخاصّة المترشّحة عن قريحة الإنسان حد قريحته فتبلغ مبلغا لا تسعه طاقة القريحة، فمن المحال حينئذ أن يتحقّق في اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة وإلّا كانت غير الدلالة الوضعيّة الاعتباريّة، مضافا إلى أن التراكيب الكلاميّة لو فرض أن بينها تركيبا بالغا حد الإعجاز كان معناه أنّ كل معنى من المعاني المقصودة ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص والكمال والبلاغة وغيرها، وبين تلك التراكيب تركيب هو أرقاها وأبلغها لا تسعه طاقة البشر، وهو التركيب المعجز، ولازمه أن يكون في كلّ معنى مطلوب تركيب واحد إعجازي مع أنّ القرآن كثيرا ما يورد في المعنى الواحد بيانات مختلفة وتراكيب متفرّقة، وهو في القصص واضح لا ينكر ولو كانت تراكيبه معجزة لم يوجد منها في كلّ معنى مقصود إلّا واحد لا غير.
قلت : هاتان الشبهتان وما شاكلهما هي الموجبة لجمع من الباحثين في إعجاز القرآن في بلاغته أن يقولوا بالصرف، ومعنى الصرف أنّ الإتيان بمثل القرآن أو سورة واحدة منه محال على البشر لمكان آيات التحدّي وظهور العجز من أعداء القرآن منذ قرون، ولكن لا لكون التأليفات الكلاميّة التي فيها في نفسها خارجة عن طاقة الإنسان وفائقة على القوّة البشريّة، مع كون التأليفات جميعا أمثالا لنوع النظم الممكن للإنسان، بل لأنّ اللّه سبحانه يصرف الإنسان عن معارضتها والإتيان بمثلها بالإرادة الإلهيّة الحاكمة على إرادة الإنسان حفظا لآية النبوّة ووقاية لحمى الرسالة.
وهذا قول فاسد لا ينطبق على ما يدلّ عليه آيات التحدّي بظاهرها كقوله : {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ} [هود : 13، 14]، الآية، فإنّ الجملة الأخيرة ظاهرة في أنّ الاستدلال بالتحدّي إنّما هو على كون القرآن نازلا لا كلاما تقوّله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإنّ نزوله إنّما هو بعلم اللّه لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى : {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} [الطور : 33، 34]، وقوله تعالى : { وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ } [الشعراء : 210 - 212] والصرف الذي يقولون به إنّما يدلّ على صدق الرسالة بوجود آية هي الصرف، لا على كون القرآن كلاما للّه نازلا من عنده، ونظير هذه الآية الآية الأخرى، وهي قوله : {قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ } [يونس : 38، 39]، الآية، فإنّها ظاهرة في أنّ الذي يوجب استحالة إتيان البشر بمثل القرآن وضعف قواهم وقوى كل من يعينهم على ذلك من تحمّل هذا الشأن هو أنّ للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه فكذّبوه، ولا يحيط به علما إلّا اللّه فهو الذي يمنع المعارض عن أن يعارضه لا أنّ اللّه سبحانه يصرفهم عن ذلك مع تمكّنهم منه لو لا الصرف بإرادة من اللّه تعالى.
وكذا قوله تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82]، الآية، فإنّه ظاهر في أنّ الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن إنّما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظاً ومعنى ولا يسمع لمخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف، لا أنّ اللّه صرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذي فيه هذا، فما ذكروه من أنّ إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي الركون إليه.
وأمّا الإشكال باستلزام الإعجاز من حيث البلاغة المحال بتقريب أنّ البلاغة من صفات الكلام الموضوع ووضع الكلام من آثار القريحة الإنسانيّة فلا يمكن أن يبلغ من الكمال حدّا لا تسعه طاقة القريحة وهو مع ذلك معلول لها لا لغيرها، فالجواب عنه أن الذي يستند من الكلام إلى قريحة الإنسان إنّما هو كشف اللفظ المفرد عن معناه وأمّا سرد الكلام ونضد الجمل بحيث يحاكي جمال المعنى المؤلف وهيئته على ما هو عليه في الذهن بطبعه حكاية تامّة أو ناقصة وإراءة واضحة أو خفيّة، وكذا تنظيم الصورة العلمية في الذهن بحيث يوافق الواقع في جميع روابطه ومقدّماته ومقارناته ولواحقه أو في كثير منها أو في بعضها دون بعض فإنّما هو أمر لا يرجع إلى وضع الألفاظ بل إلى نوع مهارة في صناعة البيان وفن البلاغة تسمح به القريحة في سرد الألفاظ ونظم الأدوات اللفظيّة ونوع لطف في الذهن يحيط به القوّة الذاهنة على الواقعة المحكيّة بأطرافها ولوازمها ومتعلّقاتها.
فههنا جهات ثلاث يمكن أن تجتمع في الوجود أو تفترق فربّما أحاط إنسان بلغة من اللغات فلا يشذّ عن علمه لفظ لكنّه لا يقدر على التهجي والتكلّم، وربّما تمهّر الإنسان في البيان وسرد الكلام لكن لا علم له بالمعارف والمطالب فيعجز عن التكلّم فيها بكلام حافظ لجهات المعنى حاك لجمال صورته التي هو عليها في نفسه، وربّما تبحّر الإنسان في سلسلة من المعارف والمعلومات ولطفت قريحته ورقّت فطرته لكن لا يقدر على الإفصاح عن ما في ضميره، وعيّ عن حكاية ما يشاهده من جمال المعنى ومنظره البهيج.
فهذه أمور ثلاثة : أوّلها راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الاجتماعية والثاني والثالث راجعان إلى نوع من لطف القوّة المدركة، ومن البيّن أنّ إدراك القوى المدركة منا محدودة مقدّرة لا تقدر على الإحاطة بتفاصيل الحوادث الخارجيّة والأمور الواقعيّة بجميع روابطها، فلسنا على أمن من الخطأ قط في وقت من الأوقات، ومع ذلك فالاستكمال التدريجي الذي في وجودنا أيضا يوجب الاختلاف التدريجي في معلوماتنا أخذا من النقص إلى الكمال فأي خطيب أشدق وأي شاعر مفلق فرضته لم يكن ما يأتيه في أوّل أمره موازنا لما تسمح به قريحته في أواخر أمره؟ فلو فرضنا كلاما إنسانيّا أي كلام فرضناه لم يكن في مأمن من الخطأ لفرض عدم اطلاع متكلمه بجميع أجزاء الواقع وشرائطه (أولا) ولم يكن على حدّ كلامه السابق ولا على زنة كلامه اللاحق بل ولا أوّله يساوي آخره وإن لم نشعر بذلك لدقّة الأمر، لكن حكم التحول والتكامل عام (ثانيا) وعلى هذا فلو عثرنا على كلام فصل لا هزل فيه (و جدّ الهزل هو القول بغير علم محيط) ولا اختلاف يعتريه لم يكن كلاما بشريّا، وهو الذي يفيده القرآن بقوله : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82] الآية، وقوله تعالى : {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ } [الطارق : 11 - 14]، انظر إلى موضع القسم بالسماء والأرض المتغيرتين والمعنى المقسم به في عدم تغيّره واتكائه على حقيقة ثابتة هي تأويله (و سيأتي ما يراد في القرآن من لفظ التأويل) وقوله تعالى : { بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج : 21، 22]، وقوله تعالى : {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الزخرف : 3، 4] وقوله تعالى : {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة : 77 – 79] ، فهذه الآيات ونظائرها تحكي عن اتكاء القرآن في معانيه على حقائق ثابتة غير متغيّرة ولا متغيّر ما يتكي عليها.
إذا عرفت ما مرّ علمت أن استناد وضع اللغة إلى الإنسان لا يقتضي أن لا يوجد تأليف كلامي فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع له، وليس ذلك إلّا كالقول بأنّ القين الصانع للسيوف يجب أن يكون أشجع ممن يستعملها وواضع النرد والشطرنج يجب أن يكون أمهر ممن يلعب بهما ومخترع العود يجب أن يكون أقوى ممن يضرب بها.
فقد تبيّن من ذلك كلّه أنّ البلاغة التامّة معتمدة على نوع من العلم المطابق للواقع من جهة مطابقة اللفظ للمعنى ومن جهة مطابقة المعنى المعقول للخارج الذي تحكيه الصورة الذهنيّة.
أمّا اللفظ فأن يكون الترتيب الذي بين أجزاء اللفظ بحسب الوضع مطابقا للترتيب الذي بين أجزاء المعنى المعبّر عنه باللفظ بحسب الطبع فيطابق الوضع الطبع كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز.
وأمّا المعنى فأن يكون في صحّته وصدقه معتمدا على الخارج الواقع بحيث لا يزول عمّا هو عليه من الحقيقة، وهذه المرتبة هي التي تتكي عليها المرتبة السابقة، وكم من هزل بليغ في هزليّته لكنّه لا يقاوم الجد، وكم من كلام بليغ مبني على الجهالة لكنّه لا يعارض ولا يسعه أن يعارض الحكمة، والكلام الجامع بين عذوبة اللفظ وجزالة الأسلوب وبلاغة المعنى وحقيقة الواقع هو أرقى الكلام.
وإذا كان الكلام قائما على أساس الحقيقة ومنطبق المعنى عليها تمام الانطباق لم يكذّب الحقائق الأخر ولم تكذبه فإن الحق مؤتلف الأجزاء ومتّحد الأركان لا يبطل حق حقا، ولا يكذب صدق صدقا، والباطل هو الذي ينافي الباطل وينافي الحق، انظر إلى مغزى قوله سبحانه وتعالى :
{ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس : 32]، فقد جعل الحق واحدا لا تفرق فيه ولا تشتت، وانظر إلى قوله تعالى : {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ} [الأنعام : 153]، فقد جعل الباطل متشتّتا ومشتّتا ومتفرّقا ومفرقا.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يقع بين أجزاء الحق اختلاف بل نهاية الائتلاف، يجر بعضه إلى بعض، وينتج بعضه البعض كما يشهد بعضه على بعض ويحكي بعضه البعض.
وهذا من عجيب أمر القرآن فإن الآية من آياته لا تكاد تصمت عن الدلالة ولا تعقم عن الإنتاج، كلما ضمت آية إلى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق ثمّ الآية الثالثة تصدقها وتشهد بها، هذا شأنه وخاصّته وسترى في خلال البيانات في هذا الكتاب نبذا من ذلك على أنّ الطريق متروك غير مسلوك ولو أنّ المفسّرين ساروا هذا المسير لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة.
فقد اتّضح بطلان الإشكال من الجهتين جميعا فإنّ أمر البلاغة المعجزة لا يدور مدار اللفظ حتّى يقال إنّ الإنسان هو الواضع للكلام فكيف لا يقدر على أبلغ الكلام وأفصحه وهو واضح، أو يقال إن أبلغ التركيبات المتصوّرة تركيب واحد من بينها فكيف يمكن التعبير عن معنى واحد بتركيبات متعدّدة مختلفة السياق والجميع فائق قدرة البشر بالغ حد الإعجاز بل المدار هو المعنى الحافظ لجميع جهات الذهن والخارج «1» ...
لا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة وتحققها بمعنى الأمر الخارق للعادة الدالّ على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادّة لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل.
وما تمحله بعض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالّة على ذلك توفيقا بينها وبين ما يتراءى من ظواهر الأبحاث الطبيعيّة «العلميّة» اليوم تكلّف مردود إليه.
والذي يفيده القرآن الشريف في معنى خارق العادة وإعطاء حقيقته نذكره في فصول من الكلام.
_____________________________
(1) راجع المبحث في الميزان المجلد الأول ص 61.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|