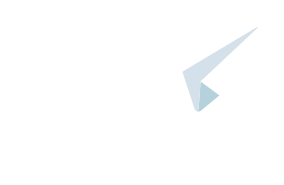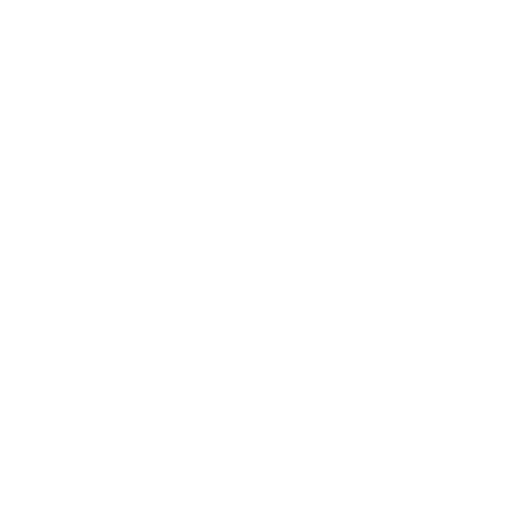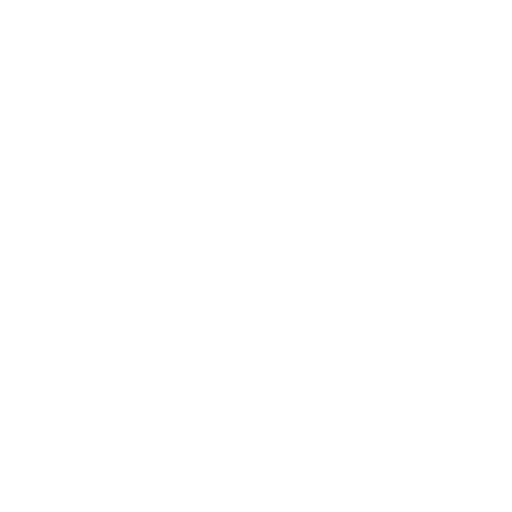تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تطوّر نظرية العلاقة بين النصّ والسياق
المؤلف:
خلود عموش
المصدر:
الخطاب القرآني
الجزء والصفحة:
ص28-35.
2-03-2015
7789
وقف الدرس اللّساني منذ القديم عند حدود الجملة، فبيّن مكوّناتها ومختلف القواعد التي تحكمها، لكنّ الجمل تنجز في مقامات، ويبدو (نحو الجملة) قاصرا عن الإحاطة بكثير من الملابسات التي تتوافر في هذه المقامات، والتي يقوم عليها الفهم والإفهام ؛ ولذا أصبحت الحاجة ماسّة لظهور علم النصّ. وقد ساهم في هذا الظهور جهود عديدة بدأت منذ دو سوسير «1» ، كما اقتحم الشكلانيّون في حلقة براغ مجال النص «2»، وكان لفقه اللغة أثره الواضح في البحث عن قواعد لعلم النصّ وخاصّة عند هنري فايل «3» (Fyle) ، وهارفنج «4» (Harving) ، وهايدولف «5» (Heidolve) ، وعلماء اللّسان مثل هاريس وجوناثان كيلر (J. Keller) . وقد درس الأخير مقتطفات من رواية تشارلز ديكنز (الآمال العريضة)، وفي الحوار الذي اختاره حذف الكاتب أجزاء من الكلام ، وأظهر أجزاء يمكن أن تحذف ، ومع أنّ الكلام يظهر وكأنّه غير متّسق إلّا أنّ الشخصينيتفاهمان، وحاول كيلر تفسير هذا التواصل عبر علاقة النصّ بالسياق «6».
كما أدّى النقد دورا كبيرا في مساندة علم اللسان بالكشف عن آفاق العلاقة بين النصّ والسياق ، وأدّى هذا الدور إلى ظهور ما يعرف ب (علم اللّغة الأدبي) وأبرز باحثيه ويدسون «7» (Weddson). كما أسهمت البلاغة الجديدة في تطوير علم النصّ؛ لأنّها نظرت للأدب على أنّه خطاب نصّي كلّي وليس وحدات مشتّتة، كما أنّ قدرا كبيرا من الدراسات الأسلوبيّة للخطاب قد أجري خارج نطاق اللّغة خاصّة في علوم مثل الأنثرولولوجيا والاجتماع، وكلّ هذا له علاقة بالسّياق المقامي العام المحيط بالنصوص.
ومهّدت هذه الدراسات الطريق لإغناء بحوث دارسي السرديّات مثل إمبرتو إيكو، الذي حاول أن يطبّق مفاهيم نظريّة (الظرف والسياق) على بعض الروايات «8».
ومع استفادة علم النصّ من كلّ هذه الجهود إلّا أنّ علم اللّغة بقي الميدان الأرحب لدراسة الخطاب، وقدّم علماء مثل بلومفيلد «9» (Bloomfield) ، وفان ديك نظرات جديدة في هذا المجال. كما أفاد علم النصّ من التداوليّة (Pragmatics) وهي من أحدث فروع العلوم اللّغوية، وتعنى بتحليل عمليّة الكلام والكتابة، ووصف وظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراءات التواصل بشكل عام «10». وبينما يهتمّ علم الدلالة بالشروط التي تجعل هذه الأقوال مفهومة أو قابلة للتفسير، فإنّ التداوليّة هي العلم الذي يعنى بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللّغويّة" مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التواصلي «11»" ؛ فهي معنيّة إذن بالشروط والقواعد اللازمة للملاءمة بين أفعال القول ومقتضيات الموقف الخاصة به ؛ أي للعلاقة بين النصّ والسياق.
وفي هذا الإطار أيضا تعدّ اللسانيات الاجتماعية تطوّرا نوعيّا في نظرية العلاقة بين النصّ والسياق، وتدرس في إطارها جميع العلاقات الموجودة بين الظواهر اللّغويّة والاجتماعيّة، فاللّغة كما يعرّفها سوسير" إنتاج اجتماعي لقوى الكلام" «12»، وتظهر هذه اللّسانيّات العلاقات بين لغة ما ومجتمع يتواصل بها، كما تظهر العلاقات الموجودة بين علم اللّسان وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا والإثنولوجيا «13». وتأخذ اللّسانيّات الاجتماعيّة بعين الاعتبار حالة المتكلّم كمعطى اجتماعي ، من حيث : أصله السلالي، ووضعه الاجتماعي، ومستواه المعيشي والثقافي، وربط هذه الحالة بنوع اللّغة التي يستعملها انطلاقا من مجموع القواعد التي نضبطها «14»، كما تعالج اللّسانيّات الاجتماعيّة التغيّرات اللّغويّة وأسبابها. ومن العناصر الرئيسة التي يلاحظها اللّساني الاجتماعي البيئة الاجتماعيّة وحالة المتكلّم ونوع الخطاب اللّغوي الذي يستعمله، ووظيفة الأفراد المخاطبين ومستوياتهم.
ومن أبرز علماء اللّسانيات الاجتماعيّة هايمز «15» (Haimes)، وفيرث الذي أبرز طريقة اللّغة في التكيّف مع عدد من المواقف الاجتماعيّة المتنوعة «16» ، ومالينوفسكي (Malowinsky) الذي اهتمّ كثيرا بالمعطيات الاجتماعيّة في عملية التحليل اللّغوي ، ودور التأثير الاجتماعي في اللّغة «17». كما شخّص سابير (Sapir) عناصر الإطار الاجتماعي الذي تستعمل اللّغة ضمنه ، وهي :
1- العنصر البشري (المتكلّم والسامع) ويتأثّر أسلوبهما بعوامل تتعلّق بالبيئة الاجتماعيّة والثقافيّة، وعلاقة المتكلّم بالمستمع.
2- عنصر الموضوع.
3- عنصر الهدف «18».
وتنظر هذه اللّسانيّات كذلك إلى خصائص الشخوص في الموقف اللّغوي من خلال وجودهم أعضاء في الجماعة اللّغويّة «19». كما تهتم هذه اللّسانيّات بالموضوعات (الأشياء) المتّصلة بالموقف الكلامي، مثل : المكان ، وحالة الجوّ، كما يدرس أثر النصّ الكلامي في المشاركين كالإقناع، أو الضحك، أو الألم. ويعدّ باحثو اللّسانيّات الاجتماعيّة اللّغة علامة فرديّة مميّزة للأفراد والجماعات؛ فلغة النجّارين تختلف عن لغة الصيّادين، ولغة الكبير تختلف عن الصغير، ولغة الإناث تختلف عن لغة الذكور «20»؛ وفي ضوء الربط بين التغيّرات اللّغويّة والمعطيات الاجتماعيّة يتمّ تحليل أنواع مختلفة من الخطاب الإنساني؛ مثل لغة الانتخابات والثورات، وانعكاسات الحياة الاقتصاديّة في اللّغة، والحياة الدينيّة واللّغة، واللائق وغير اللائق في لغة الخطاب «21».
و في علم الدلالة يبدو السّياق عالما متشابكا شديد الأهميّة؛ فالدلالات تنشأ كما يقول علماء الدلالة " بطريقة سياقية تتحكّم فيها القرائن الحاليّة التي تصاحب عمليّة الكلام إلى جانب القرائن الخاصّة بنظام اللغة التي يدركها المتلقّي عبر معرفته بذلك النظام" «22». وفي هذا الإطار دعا (فيرث) إلى دراسة أبعاد الحديث الكلامي من جميع جوانبه، ويقوم منهجه في دراسة الخطابات المختلفة من خلال قراءتها في سياقها الحالي والمقامي والثقافي. ويشمل سياق الحال عند (فيرث) تجربة المتكلّم والسامع، وسياق الفعل والصوت، وأيّ عنصر آخر يقع في نصّ الخطاب، وكذلك عناصر أخرى مثل حركات اليدين والوجه وطريقة الجلوس وتقديم الكأس؛ فالسياق يمثّل المفتاح الذي يفسّر- في رأي (فيرث)- الكثير من العمليّات المصاحبة لأداء اللّغة لدى كلّ من منتج الكلام ومتلقّية ضمن الوظيفة التواصليّة للّغة. ولعلّ عبارته المشهورة تلخّص مجمل نظريّته حين يقول:" الافتراض الأساس أنّ كل نصّ يعتبر مكوّنا من مكوّنات سياق ظرف معيّن" «23». أمّا تحليل الخطاب بالعودة إلى هذا المنهج فيقتضي عمليّة ترتيب سياقي لكلمات الخطاب وتراكيبه، بحيث يوضع المعنى المعجمي لكلمات الخطاب في مستوي وسط بين المستويين:
المواقفي والنحوي، ثمّ وضع هذا الترتيب السياقي في موضعه المناسب داخل سياق الثقافة.
وأمّا المعنى المعجمي لديه فهو ذلك الجزء من معنى الكلمات الذي يتعلّق بميلها (أي الكلمات) إلى أن يقف بعضها جنبا إلى جنب في النصوص، فمثلا (اللّيل) يميل إلى الترتّب سياقيّا مع (أسود) «24».
وقد كانت بحوث (فيرث) حافزا لباحثين آخرين تابعوا هذا الدرس السياقي فأصدر هايمز وغيمبرز(Gimbers) عام (1964) كتابا عنوانه (إثنوجرافيا الاتّصال) وشرحا فيه رؤيتهما لعمليّة الاتّصال وأطرافها، وأهميّة دراسة العناصر غير اللّغوية المؤثّرة في دلالات الرسالة اللّغوية، وأثر وسيلة الاتّصال على الأسلوب الذي صيغ به الحدث الكلامي ضمن الإطار النفسي للحديث؛ لأنّ الأسلوب يخضع لمقتضيات السياق المقامي «25». كما فصّل عالمان آخران هما كريستال ودافي (Crystal Davy) في كتابهما (Style English lnvestigating) الذي صدر عام (1965) معالم النسق المقترح في دراسة الخطاب، وحدّداه بدراسة الخصائص الأسلوبيّة للمتكلّم، والفترة الزمنيّة (التاريخيّة) التي ينتسب إليها الخطاب، ودراسة وسيلة التوصيل، ونوعيّة الخطاب، ونوعيّة العلاقة بين المتكلّم والسامع، ودراسة نوع الموقف وهل هو جدل أم محاضرة أم شعر «26». ويقترب هدسون (Heddson) في بحوثه من هذا النسق مع تركيزه على وسيلة التواصل «27».
وقد طوّر دلاليّون آخرون هذه النظرات فوسّع أولمان(Ulmann) السياق ليشمل لا الكلمات والجمل الملاصقة للّفظ المعنيّ فحسب بل والقطعة كلّها، والكتاب كلّه وكل ما يحيط بالكلمة من ظروف وملابسات «28». ويشترك أولمان وكوهين(Cohen) وكرايس (Crysse) في توضيح علاقة السياق بالمجاز، وفصّل كرائس في هذا، ورأى أنّه لحدوث المجاز وتفسيره لا بدّ من خلفيّة ثقافيّة مشتركة بين المخاطب والمخاطب تضمن إدراك المخاطب للملاءمة السياقية للمجاز، وتضمن فهمه للقيود التي تفرضها بعض الاستخدامات اللّغوية في أطر سياقيّة معيّنة دون غيرها «29».
ويركّز (جون لاينز) في بحوثه على دور الإشارة والضمائر والتعريف والتنكير وعلاقتها بالسياق، فالإشارات تمثّل لديه نسق العلاقة القائمة وتربط الإشارة بين التعابير اللّغويّة وما تمثّله هذه التعابير في عوالم الحديث، كما أنّ الضمائر تعدّ جزءا من السياق التشخيصي على اعتبار أنّه تمّ تحديد هذه الضمائر بواسطة العلاقات المتبادلة بين الأفراد، وأنّ هذا التغيير قد يشير إلى تغيّر مزاج المتحدّث أو موقفه «30». ويصوغ لاينز فرضيّات أساسيّة في نظرية النصّ والسياق وهي :
1- فرضيّة الجمل والوحدات الكلاميّة؛ ومضمونها أنّ معنى الجملة يعتمد جزئيّا على معنى الكلمات التي تتكوّن منها تلك الجملة، وأنّ معنى الجملة يعتمد على تركيبها النحوي وعلى صيغ كلماتها.
2- فرضيّة النصّ المتّسق؛ فالنصّ المتّسق هو حيث تأخذ كلّ كلمة مكانها المناسب لتسهم في إسناد الكلمات الأخرى.
3- موافقة السياق . ويقول (لاينز) في شرحها: " إنّ علينا أن لا نعدّ استقامة النحو مطابقا لقبول الجملة؛ فالجمل جميعها سليمة التركيب نحويّا ، والتركيب الدلالي السليم شرط في القبول، وكذلك موافقة الجملة للسياق شرط أساسي أيضا «31».
وأضاءت بحوث علماء مدرسة أكسفورد في التحليل اللّغوي جوانب في نظرية السياق، ويمكن أن نعدّ جهود (أوستن) ممثّلا لهذه المدرسة، وخلاصة نظريّته أنّ أفعال الكلام محدّدة ثقافيّا ، أي أنّها تعتمد على التقاليد الشرعيّة أو الدينيّة أو الخلقيّة أو العرفية السائدة في المجتمعات ، وحتّى تلك التعابير الجاهزة ذات الصيغ الثابتة مثل : (يا للسماء) و(هلمّ جرا) لا يمكن فهمها خارج سياقها. وقد تنطق جمل مختلفة ويكون نقش الكلام فيها غامضا نحويّا أو معجميّا ؛ فيكشف السياق عن القراءة الأمثل ؛ ويمثّل (أوستن) لذلك بالجملة التالية في الإنجليزيّة :
* (They Passed the Port at mid night) .
وهذه الجملة تحتمل معنيين هما :
- لقد مرّوا بالميناء عند منتصف اللّيل.
- لقد ناولوا الخمر المعتّق عند منتصف اللّيل.
و يتضح من خلال السياق أيا من المعنيين هو المقصود «32». ويقترح لغويّو اكسفورد مجموعة من الوسائل التي يمكن استعمالها في التحليل اللغوي للسياق، ومنها: دراسة الصيغة، والتنغيم، والوقوف عند العبارات الظرفيّة مثل (حتما) و(على الأرجح) وأدوات الربط، ولواحق المنطوق كالإيماءة أو الغمز أو هزّ الكتفين أو العبوس أو التصفيق، ودراسة ظروف التلفّظ بالمنطوق. ومن آرائهم المعروفة" إنّ المنطوق الأدائي لا يكون عرضة للنقد في حدود الصدق والكذب، بل في حدود الملاءمة للسّياق" «33».
و يمضي النقد خطوة إضافية في مسيرة هذه النظريّة من خلال عناية النقّاد بما يعرف ب (سوسيولوجيا النصّ)، ومن أبرز النقّاد في هذا المجال بييرزيما (P. V. Zima)
الذي ينطلق في رصده للعلاقة بين النصّ والسياق من الفكرة القائلة بأنّ القيم الاجتماعيّة لا توجد مستقلّة عن اللّغة، وأنّ الوحدات المعجميّة والدلاليّة والتركيبيّة في النصّ لا تنفصل عن المصالح الاجتماعيّة. ويقوم تحليله للنصّ على دراسة البنية اللّسانيّة والبنية الاجتماعيّة المكوّنة له «34». وفي دائرة النقد كذلك تظهر دراسات المهتميّن بتفسير النصّ وعلى رأسهم شلير ميشر(Missher) مؤسّس علم التفسير، الذي رفع شعار العودة إلى النصّ بحثا عن سياقه ومعناه «35». ويقع اختلاف الناقدين كلينث بروكس (Brooks) وباتسون(Batson) حول نص ل (وردز ورث) في هذا المجال، وذلك بسبب قراءة النص في سياقين مختلفين حتّى قيل :" إنّنا لسنا أمام جدل حول النص، وإنّما الجدل حول السياق" «36».
و من جانب آخر فقد أسهمت البلاغة الجديدة في قراءة الموضوعات التقليديّة المختلفة في البلاغة، كالتشبيه والاستعارة وغيرها قراءة جديدة، من خلال توجيه النظر إلى العلاقات الداخلية في النص وتفاعلها مع السياقات المختلفة، كما هو الحال في بحوث ريتشاردز «37» (Rechards) البلاغي المعروف، ومورو (MORO) في كتابه (الصورة الأدبية) الذي صدر عام (1982)، ويبرز ماكس بلاك (maks blak) آليّة هذا التفاعل بين السياقات المختلفة والذي ينتج عنه الاستعارة مثلا؛ ففي قولنا (أنت ذئب)، إنّ كلمة البؤرة وهي (ذئب) لا تعمل على أساس معناها المعجمي العادي، وإنّما بفضل نظام التداعيات المشتركة؛ أي وفقا للآراء والأحكام التي تنظّم رؤية المتحدّث للعالم وهذا هو السياق «38». وطوّر الأسلوبيّون فكرة السياق فدعوا إلى دراسة ما يسمّى بنسبيّة السياق، وهي مجموعة السمات السياقيّة التي تحيط بالنصّ لتمنحه أسلوبا ذا وظيفة «39». كما في دراسات سبيتزر وبالي (Spitzer Bally) وإينكفيست (Encfist).
_________________________
(1) الأزهر الزناد، نسيج النص، ص 14.
(2) بيوغراند ودرسلر، ص (18- 19).
(3) نفسه، ص 20.
(4) نفسه.
(5) صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص 42.
(6) إبراهيم خليل، الأسلوبيّة ونظرية النصّ، ص 88.
(7) صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص 38
(8) إمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية : التعاضد التأويلي في النصوص الحكائيّة، ترجمة أنطوان أبو زيد، ص 18.
(9).13 . Pioomfield, Linguistics P
(10) بيوغراند ودرسلر، ص 43.
(11).97 .Van KJID, Text and Context, P
(12) دوسوسير، محاضرات في علم اللّغة العام، ص 23.
(13) المسدّي، اللّسانيّات من خلال النصوص، ص 171.
(14) مصطفى لطفي، اللّغة العربيّة في إطارها الاجتماعي، ص 41.
(15) نفسه.
(16) نفسه.
(17) نفسه.
(18)42 . Sapeir, Language , P
(19).42 . Sapeir, Language , P
(20) مازن الوعر، الاتّجاهات اللّسانيّة المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبيّة، مجلة عالم الفكر، ع (3- 4) يونيو 1994، المجلد الثاني، ص (140- 141).
(21) نفسه، ص 142.
(22).68 . Firth, Papers in Linguistics , P
(23) جون لاينز، اللّغة والمعنى والسياق، ص 215.
(24) عدنان بن ذريل، اللّغة والدلالة، ص 166.
(25) مصطفى لطفي، اللّغة العربيّة في إطارها الاجتماعي، ص 51.
(26) هدسون، علم اللّغة الاجتماعي، ص 42.
(27) نفسه، ص 53.
(28) أولمان (ستيف)، دور الكلمة في اللّغة، ترجمة الدكتور كمال بشر، 1962، ص (88- 90).
(29) الولي محمد، الصورة الشعريّة في الخطاب البلاغي والنقدي، 1990، ص 239.
(30) نفسه، ص 193.
(31) جون لاينز، اللّغة والمعنى والسياق، ص 133.
(32) صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد، ص 242.
(33) نفسه ، ص 163.
(34) جميل الحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا: من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النصّ الروائي، ص 72.
(35) محمد عبد المطّلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، سلسلة أدبيّات، ص 151.
(36) د. عاطف جودة نصر، النصّ الشعري ومشكلات التفسير، ص 155.
(37) إ. إ. ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة مصطفى بدوي ، ص 130.
(38) صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ، ص 199.
(39) مازن الوعر، الاتّجاهات اللّسانية المعاصرة ودورها في الدراسات الأسلوبيّة، ص 154.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













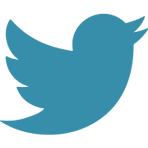

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)