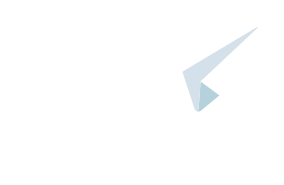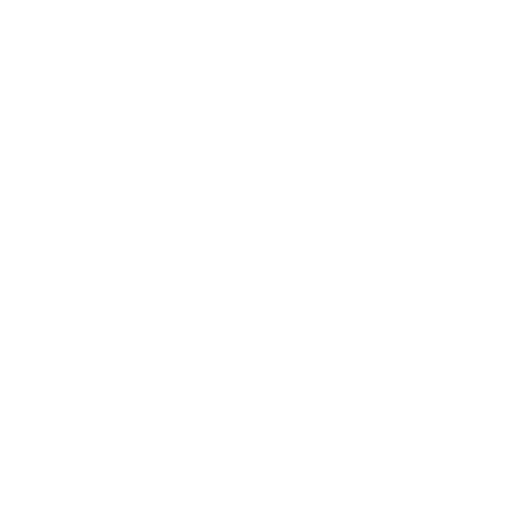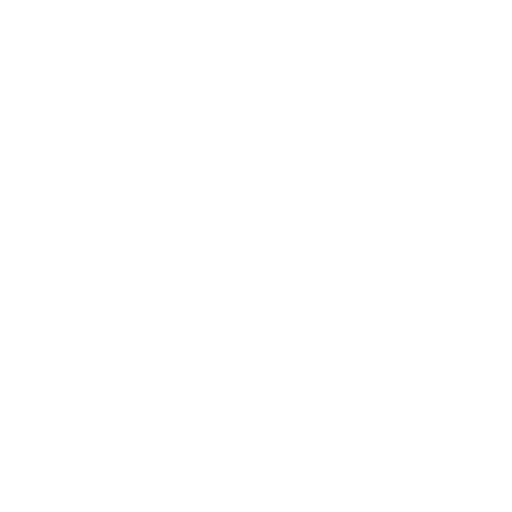تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
نصر حامد أبو زيد في (مفهوم النصّ) و (النصّ : السلطة الحقيقيّة)
المؤلف:
خلود عموش
المصدر:
الخطاب القرآني
الجزء والصفحة:
ص138-142.
27-02-2015
6698
إنّ دراسات " نصر حامد أبو زيد " في معظمها تصلح أن تكون في مجموعها تجربة في المنهج ، ولكنّنا سنحاول أنّ نركّز العرض من خلال كتابه " مفهوم النّص : دراسة في علوم القرآن " الذي صدرت طبعته الأولى عام (1994)، وكتابه (النّص : السلطة الحقيقية) الذي صدرت طبعته الأولى عام (1995)، وكتابه (الخطاب الديني : رؤية نقدية) الذي صدرت طبعته الأولى عام (1992).
إنّ أبا زيد يرى أنّ النصوص الدينيّة ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغويّة، بمعنى أنّها نصوص تنتمي إلى بنية ثقافة محدّدة، تمّ إنتاجها طبقا لقوانين تلك الثقافة التي تعدّ اللّغة نظامها الدلالي المركزي. وليس معنى ذلك أنّ النصوص تمثّل صورة سلبية عن البنية الثقافيّة من خلال النظام اللّغوي، فهي تمتلك فعاليتها الخاصّة الناشئة عن خصوصيّة بنائها اللّغوي ذاته. إنّ النصوص لا تنفكّ عن النظام اللّغوي العام للثقافة، ولكنّها من ناحية أخرى تبدع شيفرتها الخاصّة التي تعيد بناء عناصر النظام الدلالي الأصلي من جديد. وتقاس أصالة هذه النصوص، وتتحدّد درجة إبداعيّتها بقدر ما تحدثه من تطوّر في النّظام اللّغوي، وبمقدار ما تحقّقه نتيجة لذلك من تطوّر في الثقافة والواقع معا.
إنّ النصوص ترتبط بواقعها اللغوي الثقافي فتتشكّل به من جهة، وتبدع شيفرتها الخاصة التي تعيد بها تشكيل اللّغة والثقافة والواقع من جهة أخرى. وهناك منطقة تماسّ بين الجهتين، هي التي تمكّن النصوص من أداء وظيفتها داخل البنية الثقافيّة في مرحلة إنتاج النصوص، أي تجعل النصوص دالّة ومفهومة للمعاصرين لإنتاجها، وهي المنطقة المترعة بالدلالات المشيرة إلى الواقع والتاريخ، وخارج تلك المنطقة تكون الدلالات مفتوحة وقابلة للتجدّد مع تغيّر آفاق القراءة المرتهن بتطوّر الواقع اللّغوي والثقافي «1». ويدافع أبو زيد عن منهجه من حيث توهّم حدوث تعارض وتضاد بين الإلهي والإنساني في النصّ الديني إذا أخضع لهذا المنهج، فيقول بأنّ النصوص الدينيّة نصوص بشريّة بحكم انتمائها للّغة والثقافة في فترة تاريخيّة محدّدة هي فترة تشكّلها وإنتاجها؛ فهي بالضرورة نصوص تاريخيّة، ومن هذه الزاوية تمثّل اللّغة ومحيطها الثقافي مرجع التفسير والتأويل، وتدخل في مرجعيّة التفسير والتأويل تلك كلّ علوم القرآن، وهي علوم نقليّة تتضمّن كثيرا من الحقائق المرتبطة بالنصوص بعد إخضاعها لأدوات الفحص والتوثيق «2».
وفي كتابه (مفهوم النّص) يطبّق أبو زيد هذا المنهج، فيتناول علوم القرآن بالتحليل والفحص والتوثيق ليدلّل بها على صحّة منهجيّته في التعامل مع النّص القرآني.
ويعيد التأكيد فيه على أنّ النّص منتج ثقافي والمقصود بذلك أنّه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما. كما أنّ القرآن يصف نفسه بأنّه رسالة، والرسالة تمثّل علاقة اتّصال بين مرسل ومستقبل من خلال شيفرة أو نظام لغوي. وهو في الوقت نفسه منتج للثقافة، حيث كوّن حضارة لها شخصيّتها وهويّتها الواضحة في تاريخ الحياة. إنّ اللّغة هي مدخل الدراسة لهذا النصّ، وهذه اللّغة تعيد تقديم العالم بشكل رمزي، إنّها وسيط من خلاله يتحوّل العالم الماديّ والأفكار الذهنيّة إلى رموز، والنصوص اللغويّة ليست إلّا طرائق لتمثيل الواقع والكشف عنه بفعاليّة خاصّة. وهي كذلك رسالة لها وظيفتها الاتّصالية التي تقوم على مرسل ومخاطب. ومن ثمّ يعرض أبو زيد في الباب الأول من كتابه وهو تحت عنوان (النصّ في الثقافة/ التشكّل والتشكيل) مفهوم الوحي، والمتلقّي الأوّل للنصّ، والمكّي، والمدني، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ. وأمّا في الباب الثاني وهو بعنوان : (آليات النصّ) فيعرض علاقة النصّ بالنصوص الأخرى في الثقافة من جهة، وآلياته في إنتاج الدلالة من جهة أخرى، ويندرج تحت هذا الباب مسائل : الإعجاز، والمناسبة بين الآيات والسور، والغموض والوضوح، والعامّ والخاصّ، والتفسير والتأويل. وفي الباب الثالث يحاول أبو زيد الكشف عن التحوّل الذي أصاب مفهوم النصّ ووظيفته، والذي صارت له السيادة في الثقافة العربيّة الإسلاميّة حتّى عصورها الحديثة. مع وقفة خاصّة عند فكر أبي حامد الغزالي ودوره في الكشف عن آليّة التعامل مع الخطاب الديني.
وجملة أفكار هذا الكتاب أنّ الوحي عمليّة اتّصال من اللّه إلى الرسول عبر الملك ثمّ يتحوّل الرسول - عليه السلام - بعد ذلك إلى مرسل للمخاطبين (الناس) باعتباره المتلقّي الأوّل للرسالة، وأنّ تصنيف القرآن إلى مكّي ومدني هو ثمرة للتفاعل مع الواقع الحيّ التاريخي، وأنّ التنجيم يتضمّن معنى الواقعيّة والتدرّج بالإنسان، وإنّ استيعاب النصّ للوقائع الجديدة يستند إلى دوال إمّا في بنيته وإمّا في السياق الاجتماعي لخطابه، أي في أسباب النزول وهي، كما يرى أبو زيد، من أهمّ العلوم الكاشفة عن علاقة النصّ بالواقع كما أنّ الناسخ والمنسوخ دليل آخر على جدليّة العلاقة بين الوحي والواقع. وإذا كان انصراف العلماء موجّها إلى البحث عن إعجاز القرآن في تأليفه، فإنّ له إعجاز آخر خارج النّص من حيث تعامله مع الواقع ومعالجته له، وأما إعجازه في داخله فنراه في المناسبة والتأليف والنظم، وآلياته في التعبير عن الثقافة عبر مباحث الغموض والوضوح التي آثارها علماء القرآن، وعبر العموم والخصوص، فهذه هي آليّات النصّ في إنتاج الدلالة، ويتحدّث بعد ذلك عن آليّات التأويل وهي الاستناد إلى اللّغة وإلى أدوات الفقه وكذلك إلى مصلحة المخاطبين باعتبار النّص جاء معبّرا عنها «3».
وأمّا في (النصّ : السلطة الحقيقيّة) فيذهب أبو زيد إلى أنّ النصّ القرآني نصّ يمتلك كلاما وليس نصّا تنطقه اللّغة وإنّ كان يستمدّ مقدرته القوليّة أساسا من اللّغة.
والمقصود بمقدرته القوليّة مقدرته من حيث هو نصّ موجه للناس في ثقافة معيّنة، وليس المقصود مقدرته من حيث طبيعة المتكلم به سبحانه وتعالى ويؤكّد على تشكّل النّص ضمن
إطار الثقافة واللّغة، ثمّ تشكيله بعد للثقافة، بحيث أصبح الإطار الذي تقاس عليه النصوص الأخرى وتتحدّد به مشروعيّتها.
وتحت عنوان (النّص ومشكلات السياق) يرى أنّ تأويل النصّ يتطلّب اكتشاف الدلالة من خلال تحليل مستويات السياق جميعا. ويعيب على التيّارات الدينيّة تجاهلها وإهدارها للسياق في تأويل الخطاب الديني، ثمّ يتناول التفسير العلمي للنصوص الدينيّة، وهو الموضوع الكاشف عن أهميّة السياق الثقافي وخطورة إهداره، وموضوع الحاكميّة وهو الموضوع الكاشف عن خطورة إهدار السياق التاريخي (سياق أسباب النزول) إلى جانب خطورة إهدار السياق السردي اللّغوي للنصوص موضوع التأويل، ثمّ يعرض الآثار الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة لتجاهل الخطاب الديني لهذا المستوى أو ذاك من مستويات السياق. «4»
ويقترح أبو زيد مجموعة من مستويات السياق التي يجدر الوقوف عندها في عمليّة التأويل، وهي : السياق الثقافي والاجتماعي، والسياق الخارجي (سياق التخاطب)، والسياق الداخلي (علاقات الأجزاء)، والسياق اللّغوي (تركيب الجملة والعلاقات بين الجمل)، وأخيرا سياق القراءة أو سياق التأويل «5».
وإنّ الوقوف عند هذه المستويات باعتبار النصّ الديني نصّا لغويّا لا يعني إغفال الطبيعة النوعيّة لخصائص النصّ؛ فالنصّ القرآني يستمدّ خصائصه النصيّة المميّزة له من حقائق بشريّة دنيويّة اجتماعيّة ثقافيّة لغويّة في المحلّ الأوّل. إنّ السياق الثقافي يستدعي الاجتماعي بما هو مؤسّس عليه، وإنّ كان له استقلاله وسياقه وقوانينه المستقلّة نسبيّا عنه.
ويقصد بالسياق الثقافي للنصوص اللغويّة كلّ ما يمثّل مرجعيّة معرفيّة لإمكانيّة التواصل اللّغوي، وبعبارة أخرى إذا كانت اللّغة تمثّل مجموعة من القوانين العرفيّة الاجتماعيّة بدءا من المستوى الصوتي وانتهاء بالمستوى الدلالي، فإنّ هذه القوانين تستمدّ قدرتها على القيام بوظيفتها من الإطار الثقافي الأوسع بالمعنى الذي شرحناه، لذلك لا يكفي المتلقّي معرفة قوانين اللّغة لضمان عمليّة التواصل، ولا بدّ بالإضافة إلى ذلك أنّ يكون هناك إطار معيشي حياتي يمثّل مرجعيّة التفاهم والتواصل، وهذه المرجعية المعرفية هي الثقافة بكلّ مواضعاتها وأعرافها وتقاليدها، وهي التي تتجلّى في اللّغة وقوانينها بطريقة لم يتمكّن (علم اللّغة الاجتماعي) رغم إنجازاته الهامّة من رصدها رصدا دقيقا بعد.
وتعدّ التصوّرات والمفاهيم جزءا من منظومة الثقافة، ولذا فإنّ اللّغة تشير إليهما بطريقة رمزيّة. وتزداد درجة كثافة الإحالة الرمزيّة في اللّغة إذا انتقلنا من مستوى الألفاظ المفردة إلى مستوى التركيب المنتج للدلالة، وإنّ النصوص لا تفصح عن نفسها إلّا من خلال السياق الثقافي «6». وإنّ الفرق بين النظام اللّغوي ونظام النصّ هو المحدّد لخصائص الرسالة، وهو نابع أساسا من أيديولوجيّة المرسل، ويمثّل النظام اللّغوي للمتلقّي الإطار التفسيري للرسالة، ويرى أنّه لا يمكن فهم النّص الديني والقرآن خاصّة خارج إطار السياق الثقافي المعرفي للوعي العربي في القرن السابع «7».
وبالنسبة للقرآن الكريم، فإنّ سياق التخاطب الأساسي فيه، وهو أهمّ مستويات السياق الخارجي، يجعل محور الخطاب (أعلى/ أدنى). وعلى أساس هذا المحور تتحدّد الوظيفة التعليميّة بوصفها سمة أساسيّة للنّص، ويؤكّد هذه السمة أنّ محور التركيز غالبا هو المتلقّي، وإن لم يمنع هذا من وجود المتكلّم بشكل يطغى على المخاطب في بعض الأجزاء. ويرى أنّ سياق التنزيل راعى أحوال المخاطبين خلال حقبة زمنيّة تربو على العشرين عاما. وأنّ سياق التنزيل يمكن قراءته في موضوعات علوم القرآن (المكّي والمدني) وأسباب النزول، وهو ما يميّز الخطاب القرآني خلال مرحلتي الدعوة الإسلاميّة. ثمّ يسير إلى السياقات الداخليّة للنصّ القرآني من حيث سياق الترتيب والمناسبة والروابط
والعلاقات وأنّ هذا النصّ من خلال تركيبه يقدّم رؤية للعالم تحتاج إلى بحث ينطلق من تحليل مستويات السياق، وليس من خلال القفز عنها «8».
________________________
(1) نصر حامد أبو زيد، الخطاب الديني : رؤية نقدية ، ص : (136- 137).
(2) نفسه ، ص : (143- 144).
(3) نصر حامد أبو زيد ، مفهوم النّص : دراسة في علوم القرآن، ط 3، المركز الثقافي الملكي، بيروت/ 1996.
(4) نصر حامد أبو زيد، النصّ : السلطة الحقيقية ، ص (4- 92).
(5) نفس ، ص 96.
(6) نصر حامد أبو زيد ، النص : السلطة الحقيقية ، ص 98.
(7) نفسه ، ص 100.
(8) نصر حامد أبو زيد ، النصّ : السلطة الحقيقة ، ص : 107.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













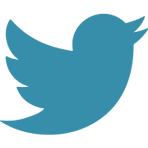

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)