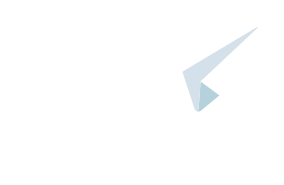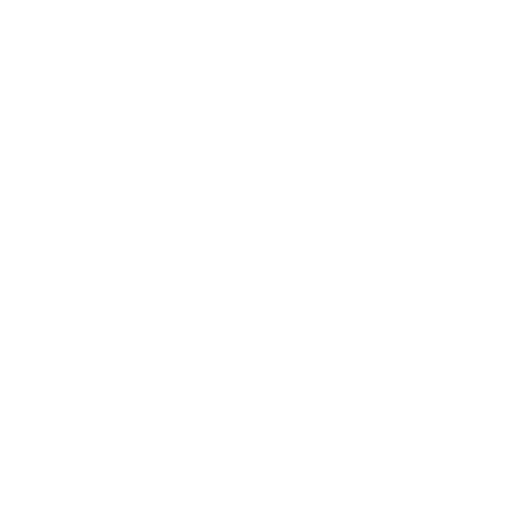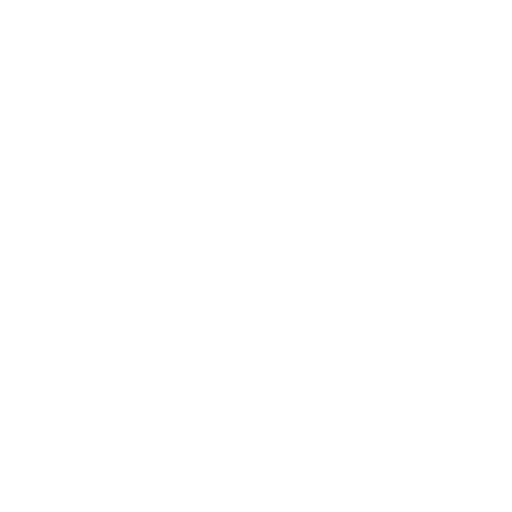التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
عقائد الديانة المصرية القديمة
المؤلف:
عبد العزيز صالح
المصدر:
الشرق الأدنى القديم في مصر والعراق
الجزء والصفحة:
ص324-339
12-1-2017
6441
في عقائد الدين والآخرة
عقائد التأليه:
نشأتها:
أخذت الديانة المصرية حين نشأتها وفي مراحل طويلة من تاريخها بتعدد المعبودات شأنها في ذلك شأن مثيلاتها من الديانات الوضعية القديمة. ولكنها ظلت أغنى من غيرها في وفرة نصوصها، ووضوح قضاياها، وثباتها على مبادئها، ثم رقي تطوراتها التي انتقلت فيها من عقائد التعدد إلى صور مختلفة من أفكار التوحيد. ورد المصريون الأوائل كل ظاهرة حسية تأثرت دنياهم بها إلى قدرة علوية أو علة خفية تحركها وتتحكم فيها وتستحق التقديس من أجلها، الأمر الذي أفضى إلى تعدد ما قدسوه من العلل والقوى الربانية المتكلفة بالرياح والأمطار وظواهر السماء، وبجريان النيل وتعاقب الفيضانات، وتجدد خصوبة الأرض ونمو النبات، وخصائص الخصب النوعي في الإنسان والحيوان، بل والمتسببة فيما اتصفت به كل بيئة محلية في أرضهم من صفات، والمقدرة لما تميزت به حضارتهم في مجملها من خصائص سمت بها عن بقية الحضارات، كمزايا التبكير بالكتابة والحساب والحكمة والفنون وما يشبهها من آيات أكبروها فردوا خلقها ورعايتها إلى قدرات علوية سامية فاقت قدرات البشر.
وربط المتدينون بين تصوراتهم العقائدية الذهنية وبين علامات كثيرة من عالم الواقع والمحسوسات، فرمزوا إلى كل قوة عليا وعلة خفية تخيلوها برمز حسي يعبر عن سر من أسرارها ويحمل صفة من صفاتها، والتمسوا أغلب رموزهم هذه فيما عمر بيئتهم من حيوانات وطيور وأشجار وزواحف، لاحظوا أنه يتأتى عن بعضها كثير من الخير ويتأتى عن بعضها كثير من الشر، ويظهر أثر البعض منها في جهات بعينها وفي ظروف بعينها أكثر مما يظهر أثر بعضها الآخر، وهو الأمر الذي لم يكن يخلو من إعجاز كبير في نطاق تصوراتهم القديمة التي كانت في عصورها الأولى لا تزال قليلة التجارب محدودة الآفاق. وبوحي هذه التصورات رمزوا بحيوية الكبش الطلوق إلى بعض أرباب الإخصاب الطبيعي والنوعي، ورمزوا بقوة الفحل إلى شيء من ذلك وإلى قوة البأس في مجملها. ورمزوا بنفع البقرة ووداعتها إلى حنو السماء وأمومتها، ورمزوا بقسوة السباع واللبوءات إلى أرباب الحرب ورباتها، ورزمزوا بفراسة القرد واتزان طائر أبي منجل إلى إله الحكمة. ورمزوا بالحيات والضفادع إلى أرباب الأزل، ورمزوا بخصائص الصقر إلى رب الضياء وحامي الملكية، وهلم جرًّا.
وصاحبت ذلك عومل أخرى ارتبطت في أذهان الجماعات البدائية الأولى بصور فطرية من الرغبة والرهبة والخيال. كالرغبة في استمرار النفع والاستزادة من الخير من أجناس معينة من الحيوان والطير عن طريق تقديس القوى الخفية التي تخيلوها تتولى أمرها وتوجهها لغاياتها. ثم صور الرهبة المختلفة:
رهبة الخوف، ورهبة العجب، ورهبة الاستعظام، التي كانوا يستشعرونها أمام أجناس معينة من الحيوان والطير، وبالتالي تجاه القوى الخفية التي أوجدتها وزكت فيها قدراتها. وأخيرًا عامل الخيال الديني المتمثل في إيمان عامة الناس بالمعجزات والكرامات وحرفية الأساطير(1).
خصائصها:
في ضوء ما أسلفناه من تصورات وتأويلات، قد يهضم منطقنا الحالي أقلها، ويأبى أكثرها، يمكن أن نرتب لديانة مصريي العصور التاريخية، والمثقفين منهم بخاصة، الخصائص التالية(2):
أولًا:
يلحظ أنه ما من معبد من المعابد المصرية الكبيرة الباقية، مما خلفته العصور الممتدة من الدولة القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة على أقل تقدير، أي خلال ما يقرب من ألفي عام، قد تضمن مكانًا معدًّا لحيوان. وذلك مما يعني أن مزار الحيوان المختار إذا وجد لم يكن مقرًّا لعبادة فعلية مفروضة. وإن أضفنا من ناحية أخرى، بناء على نصوص وصور قليلة، وعادات أخرى تتعلق بالثور أبيس وغيره "من عصور متأخرة"، أنه إذا قضت الظروف بالعناية بحيوان معبود ما، وضع الكهنة الحيوان المختار في مزاره منفصلًا عن مكان العبادة، بحيث إن شاء المتعبد زاره وإن شاء تجاوزه.
ثانيًا:
أنهم لم يقدسوا حيوانًا لذاته، ولم يقروا تمامًا لأربابهم بالتجسد المادي في هيئة حيوان أو طير، وإنما كان اهتمام المتدينين منهم بما تخيروه من هيئات الحيوان والطير يستهدف رغبتين، وهما: رغبة الرمز إلى صفات إله خفي ببعض المخلوقات الظاهرة التي تحمل صفة من صفاته أو آية من آياته، ثم رغبة التقرب إليه عن طريق الرعاية التي يقدمونها ضمنًا لما رمزوا به إليه من مخلوقاته.
ثالثًا:
ترتب على التفرقة بين كل إله وبين رموزه الحية من الحيوانات والطيور، أن اختلف وضع هذه الكائنات عندهم عنه لدى شعوب أخرى، فلم يكن اختيار المصريين لرمز أو فرد من الحيون يؤدي إلى تقديس كل أفراد نوعه، ولم يكن من بأس على قرية ترمز إلى ربها بهيئة الفحل مثلًا أن تستخدم الفحول في الحقل والنقل والذبح وتضربها. وإنما هو مجرد حيوان واحد منها يتخيره الكهنة إذا توافرت فيه علامات حددها لهم الدين ونواميسه، ثم يتركونه في مزاره آية مشهودة حتى ينفق. وذلك على العكس من شعوب أخرى قدست أنواعًا من الحيوانات بكافة أفرادها أو حرمت على الأقل ذبحها وإيذاءها.
رابعًا:
قلت أهمية الدور الذي لعبته الهيئات الحيوانية الخالصة لرموز الأرباب شيئًا فشيئًا منذ أوائل العصور التاريخية، وأصبحت الهيئة البشرية هي أكرم ما تصور المصريون به أربابهم. وجرت العادة تبعًا لذلك على تمثيلهم على هيئة الإنسان في أغلب الأحوال، مع تميزهم عنه بأزليتهم وأبديتهم ومطلق قدرتهم. ولو أن ضرورة تمييز كل معبود منهم عن الآخر، دفعت أتباعهم إلى تمثيل كل واحد منهم بجسم إنسان ورأس الحيوان أو الطير الذي رمزوا به إليه، وذلك ما نفذه الفنانون المصريون في صورهم وتماثيلهم في توافق عجيب لم يستطعه فنان آخر قديم. أو تمثيلهم بهيئة الإنسان كاملة مع تمييز كل منهم بشارة تدل عليه، وكان من هؤلاء الأرباب الأخارى الذين احتفظوا بالهيئة البشرية الخالصة: أتوم، وبتاح، وعنجتي، ومين، وجب، ونوت، وأوزير، وإيسة، ونبت حت، وحشات، وخنسو ...
خامسًا:
ندر أن قدس المصريون معبودًا ذا رمز حيواني باسم الحيوان المادي الذي يرتبط به، فهم لم يقدسوا رمز الصقر مثلًا باسمه الحيواني "بيك"، ولكن باسم رباني وهو "حور"، ولم يقدسوا هيئة البقرة باسمها الحيواني وهو "إحة"، وإنما باسم "حتحور"، ولم يقدسوا رمز التمساح باسمه الحيواني وهو "مسح"، ولكن باسم رباني وهو "سوبك"، ولم يقدسوا رمز الكبش باسمه الحيواني وهو "با"، ولكن بأحد اسمين ربانيين وهما: "خنوم" و"آمون" .. وهكذا كان الشأن بالنسبة لبعض رموزهم الطبيعية الأخرى، ومن أمثلتها أنهم لم يقدسوا السماء باسمها الطبيعي وهو "بت"، ولكن باسم ربتها "نوت".
سادسًا:
كانت بعض أسماء معبوداتهم التي أسلفناها، صفات في جوهرها أكثر منها أسماء، فاسم "حور" يعني العالي أو البعيد، واسم "سخمة" يعني القادرة أو المقتدرة، واسم "أتوم" يعني الكامل والأتم المتناهي، واسم "آمون" يعني الحفيظ والخفي، وما إلى ذلك من أسماء يعز علينا تفسير معانيها بالتحديد.
تلك إذن هي بعض الخصائص التي أخذت الطوائف المتنورة بها في تعليل ما بين المعبودات وبين رموزها، وتوضيح صفاتها. غير أنه ينبغي أن نقدر إزاءها أن العجز البشري، وعجز الإنسان القديم من طوائف العامة بخاصة، لم يكن يسمح بتحكيم المنطق والأليق دائمًا فيما يأتيه جمهرة الناس من أمور العبادة، فالشخص العادي قد يؤمن فعلًا بوجود إله عظيم في السماء يدعى "رع" أو يدعى "حور"، وإله خفي يدعى "آمون"، ولا يتردد في أن يعظم اسمه ويسلم بقدرته على العطاء والمنع والخير والشر، ولكنه إذا فجأه البؤس والضر وجد نفسه أقرب إلى التوجه إلى المحسوس الملموس من المقدسات المادية في بيئته، منه إلى التوجه إلى رع في علاه أو آمون في خفائه، وحينئذ قد يجد هذا المحسوس الملموس في ضريح مقدس في حيه. أوفي تمثال لا ينادي رع في علاه أو آمون في خفائه، وحينئذ قد يجد هذا المحسوس الملموس في ضريح مقدس في حيه. أو في تمثال بساحة معبد قريب منه، أو في حيوان بمزار ما، أو في شيء وهمي لا صلة له إطلاقًا بمعبد، وحينذاك لا ينادي رع العالي في سماه، بقدر ما يضرع إلى الروح التي تسكن شجرة الجميز في قريته، أو الحية التي تسكن قمة الجبل في منطقته. حتى إذا اشتد الضر به أو انصرف عنه لا يجد بأسًا من ثم في أن يتوجه بقربانه ونذرة إلى شجرة الجميز أو قمة الجبل، وليس إلى معبد الرب كما ينبغي أن يكون(3).
في سبيل الترابط:
افترض المصريون أواصر القربى والتشابه بين بعض معبوداتهم وبعض آخر، بناء على دوافع عدة يمكن تخمين أقدمها زمنًا بما مر به مجتمعهم القديم من ظروف الاتصال المكاني والترابط المعيشي، وإيحاءات السياسة، ثم اتساع آفاق التفكير. وعلى هذا يمكن أن يفترض أن أولى خطواتهم للربط بين معبوداتهم قد بدأت عندهم منذ أدت دوافع السلم والحرب بقراهم وبلدانهم القديمة المتفرقة إلى التضام مع بعضها البعض على هيئة أقاليم عدة خلال فترات متقاربة من فجر تاريخهم القديم، الأمر الذي شجع الفريق الأقوى في كل إقليم على أن يسود معبوده. كما يسود حاكمه، على بقية الجماعات المشتركة معه في نطاق إقليمه، وعلى أن يجعل هذا المعبود ممثلًا لإقليمه ورأسًا لمعبودات قومه في آن واحد. وعندما أدت الظروف مرة أخرى إلى ترابط مجموعات الأقاليم على هيئة ممالك صغيرة، تحت تأثير تقارب المصالح حينًا وتحت ضغط القوة والغلبة حينًا آخر، تكررت العملية السابقة بصورة تلقائية، فكفل الفريق الحاكم في كل مملكة نوعًا من الهيمنة لمعبوده على من سواه من معبودات الأقاليم الخاضعة للواء مملكته. ولما أفضت الحوادث إلى انتظام هذه الممالك المتفرقة في ظل مملكة واحدة، لفترات متقطعة فيما قبل الأسرات، ثم للمرة الأخيرة منذ بداية العصور التاريخية، أصبح لمعبود الملك في المملكة المتحدة سيادته الواسعة على بقية معبودات دولته، وهو أمر يمكن افتراض مثله لكل من المعبودين أوزير ورع على التوالي فيما قبل الأسرات، ثم المعبود حور معبود أوائل ملوك العصور التاريخية وراعيهم والذي غدا من ثم معبودًا رسميًّا للدولة كلها وراعيًا لها. وذلك مع ملاحظة أن الاعتراف به وبمن سبقه من المعبودات الكبار لم يقض على معبودات الممالك الصغرى القديمة ومعبودات الأقاليم، كما أن هذه بدورها لم تجب معبودات القرى القديمة التي سادتها، وإنما استمرت تعبد جمعيها جنبًا إلى جنب، فيما عدا ما تناساه أتباعها من تلقاء أنفسهم أو نقلوا صفاته إلى معبودات أخرى من تلقاء أنفسهم. وذلك بحيث لم يأب أبتاع الإله الأكبر أن يتركوا أصحاب المعبودات الصغرى وشأنهم. ولم يأب أصحاب المعبودات الصغرى أن يشاركوا في تمجيد الإله الأكبر والاتجاه إليه في الجليل من شئونهم. وأدت إلى هذا الوضع الديني أو هذا الخلط الديني عوامل عدة نذكر منها: غلبة روح المحافظة على القديم الموروث في أمور الدين والعبادات، وغلب روح التسامح التي احترمت تعدد المعبودات، وحرص الفراعنة على عدم تركيز السلطة الدينية في أيدي كهنة معبود واحد، وعملهم على توكيد روابطهم بجميع الدوحات الإلهية التي تخيلها رعاياهم، ثم اتجاه المصريين إلى افتراض روابط الأبوة والبنوة والزيجة بين أربابهم المتقاربين في الصفات وفي أماكن العبادة، وذلك أمر بدت منطقيته بعد أن تخيلوا لأربابهم هيئات إنساينة وافترضوا لهم حياة تماثلها حياة البشر لولا أنها سرمدية عالية، تزاوجوا فيها وأنسلوا، وأحبوا فيها وغضبوا، وحكموا وتحاكموا، وعلاهم فيها إله أكبر ذو عرش وصولجان ووزير وكاتب وسجلات وديوان، ولهم مجامع يتداولون الأمور فيها. وقد يسرت هذه الأخيلة افتراض أسر إلهية ثلاثية تكونت من أب وأم وولد، ومن زوج وزوجتين، ثم أسر تساعية كبيرة في عين شمس وغيرها تضمنت الجد وجد الجد والابن والحفيد. وترتب على ذلك كله أن الإله الأكبر للدولة لم يعد رئيسًا لآلهة متنافرين، وإنما غدا رئيسًا لآلهة متقاربين، لأغلبهم صلة بمن سواه، ولأغلبهم نصيب من صفات غيره، ولكل منهم نصيب من رعاية الدولة وفراعنتها.
وتغير اسم الإله الأكبر للدولة مرات قليلة خلال العصور التاريخية القديمة، وترتب هذا التعبير في معظم الشخصي والفكري للفرعون أحيانًا، ثم ازدياد نفوذ كهنة معبود معين على من سواهم. وهكذا بينما انعقدت الهيمنة للإله حور في بداية الأسرات، انعقدت الأولوية للإله رع منذ أواسط الدولة القديمة "مع ظهور إرهاصات سابقة بأهميته"، ثم انتقلت الرئاسة إلى آمون في الدولة الوسطى، وآمون رع في بداية الدولة الحديثة، ثم إلى آتون في عهد آخناتون، وعادت بعده إلى آمون رع حتى نهاية العصور الفرعونية. وقد كانوا جميعهم يرتبطون بألوهية الشمس بسبب صريح أو ضمني، وإن تغيرت أسماؤهم من عصر إلى عصر.
في سبيل التوحيد:
جنبًا إلى جنب مع التطورات البطيئة السابقة لأفكار التأليه ظلت فكرة الوحدانية تراود أذهان المفكرين المصريين من حين إلى حين. وقد بدأت معهم على صورة الإيمان بوحدة الخالق. ثم انتقلوا بها إلى الاعتقاد بوحدة الربوبية، وأرهصوا بعدها بما يشبه عقائد الحلول والتشبيه، ثم انتهوا أخيرًا إلى الإيمان بوحدة المعبود(4). وإذا انتقلنا بهذا من الإجمال إلى التفصيل ألفينا الاعتراف بوحدة الإله الخالق قائمة في مذهبي عين شمس ومنف القديمين لتفسير نشأة الوجود، حين رد أصحاب كل مذهب منهما الوجود بطبيعته وأربابه وناسه وبقية كائناته، إلى خالق واحد دعوه في عين شمس باسم أتوم، بمعنى الأتم المتناهي، ودعوه في منف باسم بتاح ربما بمعنى الصانع أو الفتاح أو الخلاق.
وظهرت بوادر الإيمان بوحدة الربوبية منذ اتجه أهل الفكر فيما بين أواخر الدولة القديمة وبين أوائل الدولة الوسطى، إلى إله الشمس باعتباره إلهًا خالقًا وإلهًا أكبر من آن واحد. وجعلوا اسمه قاسمًا مشتركًا مع أسماء بقية المعبودات ولكن دون أن يحاولوا إفناءهم فيه. فأطلقوا عليه أسماء: سوبك رع، وآمون رع، وتحوتي رع، وبتاح رع، وهلم جرًّا ... ، وكأنهم أرادوا بذلك اعتبارهم مجرد صور منه، أو هم بمعنى آخر قد اعتبروا الربوبية التي تجمعهم جوهرًا واحدًا مركزه رع، ولكنه جوهر له أوجه عدة يعبر كل وجه منها عن قدرة ربانية متميزة باسم إلهي خاص، وكان في اقترابهم من هذه الفكرة، فكرة وحدة الربوبية، ما جعلهم قريبين من الاعتراف بوحدة الخلق في الوقت نفسه، فقال قائلهم وهو يسبح ربه الخالق القديم "أتوم" "وقد غدا صورة الإله الشمس":
أتوم، خلقت البشر جميعًا ... ونوعـــت هيئــاتهم
ووهبت الحياة لهم جميعًا ... وفرقت بين ألوانهم
يا سميعًـــا لرجـاء الأسير... يا لطــيفًا بمن دعاه... (5)
ومضى تيار الفكر الديني في طريقه، ووجد أصحابه في اتساع آفاق الدولة الحديثة ما جعلهم يتشوقون غلى الوحدانية الكاملة ويرهصون بها، وبدأها بعضهم بما يشبه عقائد الحلول، فصوروا ربهم "آمون" على أنه فرد مطلق خفي، ولكنه حفاظ لكل شيء، حال في كل شيء، موجود في كل الوجود. ووصفه قائلهم بأنه "أكبر من السماء، وأسن من في الأرض، رب الكائنات، حفاظ كل شيء، وباق في كل شيء"(6).
وهكذا آمن القوم بخفاء جوهر ربهم، وتفرده بقدرته العليا، واطمأنوا إلى وجوده في كل الوجود، وإلى رعايته لكل من في الوجود "وإن كانوا قد تخيلوا هذا الوجود في مصر وتوابعها أكثر من غيرها". ولكن عزت عليهم للأسف عدة أمور، أهمها: أنهم لم يكتفوا له باسم واحد، ولم ينزهوه تمامًا عن التشبيه، ولم ينكروا تعدد المعبودات إلى جانبه، فوصفوه فردًا وكبيرًا لجماعة الأرباب في آن واحد ونزهوه عن المادية وتخيلوا له صورًا كثيرة في آن واحد. وتمثلت علل هذا الخلط فيما مهدنا به لنشأة الدين، أي في صعوبة التخلص من القديم الموروث، وفي سماحة المتعبدين، وفي تشابه سبل الدعوة إلى المعروف عند أبتاع كل معبود، وفي افتراض القرابة الوثيقة بين الأرباب المختلفين، وفي منطقة التبرير بأن الإله الأكبر هو الذي خلقهم بأمره ومن نفسه أو من رشحه وأمر برعايتهم، ثم في مرونة الفكر الديني التي لم تأب أن تتقبل الجديد وتضعه جنبًا إلى جنب مع القديم، مع استغلال الفراعنة لكل هذه العوامل لكي يحولوا بها دون تركيز النفوذ الديني في أيدي كهنوت معبود واحد، ولكي يوهموا أبتاع كل معبود أنهم معهم، ولا يأبون عليهم حرية عقائدهم.
وضاقت بكل ذلك صدور بعض المؤمنين في أواسط عصر الأسرة الثامنة عشرة، وتمنوا لو اهتدوا إلى التعبير عن ربهم باسم واحد، والرمز إلى آيات قدرته برمز واحد، وإعلان وحدانيته صريحة واضحة. وأراد المجددون أن يبدؤوا بتحديد اسم معبودهم وتحديد رمزه، وأوحى الحذر عليهم أن يربطوا بين الجديد الذي يودونه وبين القديم الذي تعوده أغلب معاصريهم، فبشروا باسم "آتون"، وهو اسم قديم اتجه به أسلافهم أدباء البلاط الفرعوني منذ الدولة الوسطى وجهتين: وجهة لفظية يدل فيها على معنى "الكوكب" ويعني كوكب الشمس بخاصة، ووجهة أخرى لاهوتية ينم فيها عن الإله المتحكم في هذا الكوكب(7).
ومنذ عهد تحوتمس الرابع رأى المجددون في اسم آتون ما يفي بغرضهم للتعبير عن اسم ربهم ورمزه، وأقنعوا أنفسهم بأنه لا يقلل من جلال ربهم المطلق أن يرمزوا إليه بآية الشمس كبرى آياته، فما من شك في أن من يتحكم في كوكبها وينظم مسيرته قادرًا على أن يدبر المخلوقات كلها. وسلكت هذه الدعوة سبيلها في حذر وهوادة وتقبلها الكهان بمرونتهم التقليدية.
واتخذ أمنحوتب الثالث منهاجًا وسطًا بين آمون وبين آتون، فحابى آمون وكهنته الأقوياء وأعلن أنه ولي العرش بناء عن بنوته له وبناء عن أمره، وأغدق العطايا على معباده وكهنتها. ثم ساير في الوقت نفسه دعوة آتون وسمح بعبادته جهرة في طيبة، وتقبل إطلاق اسمه على بعض أركان قصره ومحتوياته. وهكذا استمر اللبس بين القديم والجديد، وبين آمون وآتون، خلال عهده.
وبقيت علة العلل بين طرفين: الفرعون الذي كان بيده حسم الأمر لو أراد ... ، لولا أنه جرى على سنة أسلافه، وآثر الإبقاء على تعدد المذاهب خشية أن تتركز سيطرة الدين كاملة في جانب مذهب واحد. ثم كبار كهنة آمون الذين تهيأ لهم من الشهرة والثراء العريض وسلطان المناصب ما أرهب الناس منهم وجعل التغاضي عن عقائهم أمرًا غير ميسور. ولم يعد من سبيل إلى اكتمال دعوة التوحيد إلا إذا اختصم الطرفان أصحاب الزمام: الفراعنة وكبار الكهان، أو تهيأ حوافز جديدة عنيفة لإصلاح الدين كله.
وللمرة الأولى، تهيأ العاملان في عهد أمنحوتب الرابع منذ عام 1367ق. م. وكان ذا نفس حساسة مرهفة، وانجذب منذ صغره إلى تيارات الدين الذي كان خاله من كبار كهنته. وانتوى لنفسه منهاجًا يتزعم به دعوة آتون دعوة التوحيد، وبدأ التبشير به على حذر، فشيد معبدًا باسم آتون في رحاب الكرنك معقل آمون، وأعلن أن العبادة ينبغي أن تتجه إلى "الوالد آتون الحي"، وأن آتون ما هو إلا "رع حر آختي يتهلل في الأفق باعتباره النور الذي في الكوكب آتون"(8). واستهدف أمنحوتب من هذه البداية ثلاثة أمور، وهي: أن يحدد رأس عقيدته الجديدة، وألا يفاجئ الناس بأسماء جديدة لم يألفوها، وأن يوحي إليهم بأنه لم يطلب منهم غير العودة إلى معبود الفطرة، معبود أجدادهم الأولين، رع حر آختي، وهو نفس آتون، ذلك الذي رغب الناس فيه بتسميته باسم "الوالد"، وربط بينه وبين آية النور المعجزة المستحبة في كوكبه.
وعلى الرغم من بساطة هذا الاستهلال البارع الذي بدأ أمنحوتب دعوته به، أوجس كهنة آمون خيفة منه، وقدروا أن يافعًا مثله يستطيع أن يتزعم مذهبًا في الدين ويفتي بالرأي فيه، خليق بأن يتأتى على يديه تغيير كبير، فأضمروا له العداء وجافوه، وبادلهم هو جفاء بجفاء، وسارت الأمور بينهما من سيئ إلى أسوا، وأبدت عين البغض بين الفريقين كثيرًا من مساوئ خافية، ومساوئ أخرى كانت تتغاضى عنها عين المجاملة. وبدا للفرعون ما ذكرناه له حين بحثنا تاريخ السياسة في عهده. وما يتمثل في ضيقه بانصراف الولاء الديني لأرباب عديدين، وانصراف أموال الدولة إلى معبادهم الكثيرة، وضيقه بثراء كبار كهنة آمون واتساع تدخلهم في شئون الدولة، وضيقه بروح المحافظة التي تعللت بالدين وقيدت حرية الناس، ثم أمله في أن يجد من شيوع دينه الجديد خارج مصر ما يحقق رابطة متينة توثق الصلات بينها وبين أتباعها وجيرانها.
وفي العام السادس من حكمه جهر أمنحوتب بعقيدته، وأعلن التوحيد خالصًا، فنادى بإله واحد لا شريك له، ولا محل لتعدد الأرباب والربات إلى جانبه، ليس هو آمون، ولكنه آتون. وليس هو ممن تقوم عبادته خلف أستار وأسرار، ولكنه إله يشهد الناس آياته دون حجاب، ولهم أن يعبدوه حيثما سقط من كوكبه على الأرض شعاع، ونزه فنانوه ربهم عن أن يرمزوا إليه بهيئة إنسان أو جسم إنسان ورأس حيوان، وآثروا له رمز كوكب الشمس بكل ما فيه من قدرة ربانية مستترة وجسم ظاهر مضيء تصدر عنه أشعة عدة، وبمعنى أصح أيد عدة بأكف مبسوطة تمتد على الأرض لتهبها الحياة، وكان رمزًا قديمًا جديدًا في آن واحد، قديمًا في هيئة قرص الشمس، جديدًا بهيئة الأيدي التي بدأ تصويرها منذ عهد تحوتمس الرابع. ويبدو أن الفنانين لم يروا في تصوير أكف الإله المبسوطة انتقاصًا من روحانيته، واعتبروا تصويرها نوعًا من التعبير الفني يغني عن الوصف والكتابة، وشابههم في ذلك فنانو عصر النهضة المسيحيون فيما بعد حين صوروا يد الله بين الغمام ونحتوا لها التماثيل ..
وبدأ أمنحوتب بنفسه، فتبرأ من لفظ آمون في اسمه، وسمى نفسه آخناتون، ربما بمعنى المخلص لآتون أو النافع لآتون أو المجد لآتون، وتختلف هذه الترجمات المقترحة عن الترجمات الأخرى الشائعة. وهاجر بأهله وأتباعه من العاصمة القديمة "طيبة" إلى أرض وصفها بأنها أرض بكر طهور لم يدنسها شرك في العبادة، ولم يعبد فيها من قبل إله أو إلهة، تتوسط أراضي القطر، وتقوم على أنقاضها بلدة العمارنة الحالية، وسماها "آخيتاتون" بمعنى أفق آتون أو مشرق آتون.
وخرجت أناشيد الدين الجديد تناجي ربها بالود والحب والتبجيل، وقالت فيما قالت: "تجليك في أفق السماء بديع، وآتون الحي أصل الحياة... أنت البهي، أنت الجليل، أنت المنير، أنت العلي فوق كل أرض ... ".
وعرضت الأناشيد منن الإله الظاهرة في حجج فطرية مقنعة، استخدمت المقابلة فيها بين حال الأرض وأهلها حين غياب نور كوكب الرب وحين ظهروه، فكلما غاب أظلم الكون وأصبح كالموات. وهجع الخلق، وخيف النهب، واستشرى الوحش، ودبت الزواحف. فإذا أشرق آتون بدل الحال غير الحال، فشتت الظلمة وبسط الأشعة وكفل الأمن ويسر السعي. "وظهرت نفس الحجج ضمن ما رددته فيما بعد مزامير العبرانيين، مما دعا ببعض الباحثين الغربيين مثل برستد وجريفث وغيرهما إلى الربط بينهما واعتبار الأناشيد المصرية أصلًا لها".
وكانت مذاهب الدين القديم قد ربطت بين الإله وعباده بروابط شتى، فتخيرت الدعوة الجديدة من هذه الروابط، روابط العطف والحب، وأعلنت أن ربها عظيم المحبة، وأنه أم وأب لكل من خلق، وله يسبح البشر والحيوان والطير والنبات، كل منهم بطريقته وتسبيحه، وقالت: "الزهر ونبت الأرض ينفتح لمرآك، وتتملكه النشوة لمحياك، والأنعام تتراقص على أقدامها، والطيور في أوكارها تطوي أجنحتها وتنشرها تسبيحًا لآتون الحي خالقها .. ، الأرض بأسرها عامرة بحبك، والعشب والشجر يتمايل لمطلع وجهك، وأسماك الماء تتراقص لرؤيتك .. ".
وبلغت الدعوة غايتها حين خرجت بدينها عن الإقليمية إلى العالمية، ونادت بإله رحيم في كل أمره، محبوب في كل أمره، خلق الكون عن حب ورغبة، واقتضت عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بفضله، وتنبسط آلاؤه بانتشار أشعته في أقطار الدنيا بأسرها، دون تفرقة فيها بين أبيض وأسود، فلم لا يجتمع الناس إذن على عبادته كما اجتمعوا على النفع منه؟ وقال آخناتون يسبح ربه:
"رب أحد دون شريك، برأت الدنيا وكنت فردًا.
خلقت البشر والأنعام، وكل ما يسعى على الأرض بقدم، ويحلق بجناح في الفضاء.
وأقطار سوريا والسودان وأرض مصر، وجهت كل فرد فيها إلى موطنه، ودبرت للجميع شئونهم، فأصبح لكل فرد رزقه وتعين لكل فرد أجله، وظلت الألسنة بينهم في النطق متباينة والهيئات والألوان متمايزة.
آتون يا ضوء النهار، يا عظيم المجد، بلدانا نائية تهبها الحياة وترسل الغيث من أجلها،
يموج الغيث فوق الجبال كالبحر الخضم ويسقي الحقول بين القرى.
ما أجل تدبيرك رب الخلود، فيضان في السماء لأهل القفار وحيوان الفلا وما يدب على قدم، وفيضان سواه لأرض مصر يأتي إليها من دنيا العدم".
وهكذا لم يجد آخناتون بأسًا من أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام والسودان، ما دام الخالق الرازق واحدًا، رحيمًا هنا رحيمًا هناك، جوادًا هنا منعمًا هناك، خلق الجميع على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومواطهنم، وتكفل برزقهم، وكان معجزًا حين وهب مصر فيضانًا من باطن الأرض، كريمًا حين وهب غيرها فيضانًا من جوف السماء.
وتزعم آخناتون مجالس الدعوة وأعلن نفسه نبيها والمصطفى لنشرها، واصطفى لنفسه حواريين يعلمهم كما علمه الإله. ورأى أن تشييد دور العبادة خير سبيل لنشر الدعوة، فعمل على الإكثار منها باسم آتون في أمهات المدن المصرية، وأوحى بإقامة أمثالها في عواصم النوبة والشام. وجعل مدينته "آخيتاتون" مدينة فاضلة تعمل للدين والدنيا معًا، تبشر بالإيمان السمح المستبشر، وتشيد بالعدل في كل أمره، وتتردد تسابيح الشكر والصلوات لآتون في معابدها، كما تتردد الأغاني والأنعام وأهازيج حب الطبيعة والجمال في مجالسها.
وعكس هو وأتباعه جوهر الدعوة على الآداب والفنون، فحاولوا أن يخلصوهما من ركام التقاليد وقيود التراث القديم التي لا توائم دعوة التحرر والاعتراف بالواقع في عهدهم، فتخففوا من أساليب الأدب المتقعرة القديمة وغلبوا عليها لغة الحديث المقبولة الشائعة. وبدأ آخناتون بنفسه في دعوة تحرير الفنون، ففتح مغاليق قصره للمثالين والرسامين، فمثلوه في بشريته الخالصة وصوره هو وأسرته في حياتهم العادية، حين فرحهم وحزنهم، وعبثهم وجدهم، وتوهم أنصار الدعوة أن الأمور قد صفت لهم، وتمنوا لفرعونهم ومعلمهم أن يظل بينهم وفي عاصمتهم "حتى يسود البجع، ويبيض الغراب، وتتحرك الجبال، وينساب الماء إلى حيث ينبع"(9).
وعلى الرغم من ذلك كله لم يطل الأمد بدعوة التوحيد، ولم يتهيأ لها من كثرة الأتباع ما كان يرجى لمثلها، ولم ينته الأجل بصاحبها حتى كان قد رأى عوامل التحلل والفشل تدب فيها من حيث ظن الخير ومن حيث لم يحتسب. وتمثلت هذه العوامل فيما قدمنا به عنها حين حديثنا عن الجوانب السياسية في عهده، ومجملها: عدم خروجه بنفسه للترويج لدعوته في أمهات العواصم داخل مصر وخارجها، وتقبله إسراف أنصاره في تمجيده حتى أعلنوه ابنًا للإله وأوشكوا أن يؤلهوه وأن ينشغلوا بشخصه عن ديانته، وأن دعوته لم تأت بجديد يجذب العامة إليها في حياتهم الاقتصادية أو الطبقية، وأن عقائد التعدد كانت قد تغلغلت في عادات الناس بحيث يصعب انتزاعها من نفوسهم بسهولة، وأن سمعة آمون القديمة ونفوذ من بقي من كبار كهنته كلاهما لم تخمد جذوته على الرغم من الرماد المؤقت الذي غطاها، وأن الشرق القديم الذي أمل آخناتون أن يجتذبه إليه بدعوته إلى عالمية الدين وإلى روح المسالمة والإخاء، كان في شغل شاغل عنه بمشاكله وبمن تنازعوا أموره من الأموريين والكنعانيين والأراميين والعابيرو والخابيرو، وبمن احتربوا عليه من الميتانيين والحيثيين. بل إن مشاكل أسرة آخناتون نفسها واتجاهات أمه وزوجته لم تكفل له الهدوء كاملًا، ولم يكن له ولد يرثه على العرش والدعوة، وإنما أخوان صغيران، اتجه أحدهما وهو "سمنخ كارع" إلى مهادنة كهنة آمون في حياة أخيه، وسلم الآخر وهو توت عنخ آتون ببأس خصومه والأمر الواقع بعد وفاة أخيه، فارتد عن دين آتون، وعاد إلى طيبة مقر آمون، وولي عرشها باسم "توت عنخ آمون" وناصر دينها وعمر معابد أربابها ورباتها.
وسلكت نفحة الوحدانية بعد ذلك مسالك أخرى تحاشت فيها نقمة أنصار التعدد فضمنت بقاءها ولو بين القلة من خاصة أهل الفكر في مجتمعها، مما نتناول تفصيله في بحث آخر(10).
عقائد البعث والخلود:
طمعت أغلب شعوب العالم القديم في الخلود واستئناف الحياة بعد الممات، كما طمع المصريون سواء بسواء. ولكن بينما رتبت هذه الشعوب طمعها في الخلود على الأمل وحده ووقفت عنده، رتب المصريون طمعهم فيه على المنطق والعمل والأمل والعقيدة في آن واحد، وكانوا أول أمة آمنت بالبعث والخلود من تلقاء نفسها وأصرت عليهما(11).
وافترض المصريون للإنسان مقومات عدة، طبيعية ومكتسبة، أهمها سبعة، وهي: جسم مادي "خت"، وقلب مدرك "إب"، وطاقة أو فاعلية أو نفس فاعلة "كا"(12)، واسم معنوي "رن"، وظل ملازم "شوت"، وروح خالدة تسري في الظاهر والباطن "با"، ونورانية شفافة "آخ". وتشتد صلته بالاثنتين الأخيرتين منها بعد وفاته، إذا كان صالحًا. واعتقدوا أنه لا بقاء للمرء في أخراه إلا باجتماع كل هذه المقومات، وأنه لا سعادة لها في جملتها دون مساعدة خارجية. ولهذا تلمسوا سبل الاهتمام بكل واحد منها على حدة، إلى جانب الاهتمام بها جميعها كوحدة واحدة. فالجسد ينبغي أن يصان ويحنط، والقلب يحفظ ويعوذ، والكا أو النفس الفاعلة تتلي التراتيل باسمها من أجل صاحبها وتقدم القرابين لصالحها، والروح تتنقل ما شاء لها ربها في عالم الأرض أو في عالم السماء ما دامت مؤمنة، والنورانية تكتسب بالتقوى، والاسم يخلد عن طريق صالح الأعمال، وترديده في الدعوات وتكراره في نقوش المقبرة وقرنه بالسمعة الطيبة للأسرة عن طريق جهود الابن الأكبر(13).
ووجد المصريون في خصائص بيئتهم ما يوحي لهم بمنطقية الخلود ويشجعهم على طلبه. فقد اعتادت أغلب أجيالهم منذ فجر تاريخهم على أن يدفنوا موتاهم في الحواف الصحراوية "والغربية منها بخاصة"، لينأوا بمقابرهم عن رطوبة الأرض الطينية، ويتركوا الأرض الطميية للزراعة. ويوفروا أراضي القرى لأحيائها. وشيئًا فشيئًا تبينوا أن مقابرهم الصحراوية تحفظ جثث موتاهم بحالة لا بأس بها لفترات غير قصيرة، وعندما اختلطت هذه الظاهرة بأحاسيسهم الدينية لم يردوها إلى جفاف الصحراء وحده، ولا إلى دور الرمال في امتصاص رطوبة الجسد وحده، وإنما ردوها أساسًا إلى قدرة ربانية حانية، وقدروا أنهم إذا استرضوا صاحب هذه القدرة وقدسوه، زاد في رعايته لجثثهم وحفظها سليمة لأطول مدة ممكنة. وقد حدث بالفعل أن المعبود الذي تخيلوه ربًّا للحواف الصحراوية وسموه "إنبو" "أو أنوبيس في الإغريقية"، كان هو نفس المعبود الذي تخيلوه راعيًا لجثث الموتى وقادرًا على حفظها وحاميًا للجبانات. وقد انتشر الإيمان به من طائفة إلى أخرى حتى أصبح الجميع يتوجهون بدعواتهم الأخروية إليه. واعتبروه ربًّا للتحنيط بارعًا فيه، ورمزوا إليه بهيئة ابن آوى، وهو رمز يصعب تعليل اختياره، مع شرور بنات آوى في الجبانات والصحراوات، إلا بما قدمنا به وهو الاعتقاد العكسي بأنه لن يستطيع أن يخبت شرة هذه الحيوانات إلا من خلقها وارتضى لها هيئتها وجعلها آية ظاهرة لقدرته، بعد أن يترضاه الناس ويحسنوا الظن به فيغلبوا قدرة الخير فيه على قدرة الشر.
ولم يكن نهر النيل وما يترتب عليه في دنيا المصريين بمعزل عن الإيحاء إليهم بإمكان تجدد الحياة والبعث وهم يرون فيضانه يتجدد كل عام في موسم لا يخلفه، فيخصب التربة، وينبت البذرة، ويدفع دورة الحياة الزراعية دائمًا دفعات جديدة، ولم يتوهموا هذه المظاهر تحدث تلقائيًّا من غير علة أو غاية، وإنما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الأرض، ويدفع النبات من الحب المدفون في التربة، ويحيي الحقول الجافة بعد الموات كلما مسها بفيضه ورحمته. ومع طول التدبر ونمو التدين قدروا أن من يتعهد طبيعتهم بالحياة المتجددة ويدفع عنها مواتها، قادر من غير شك على أن يتعهد أهلها بالحياة بعد وفاتهم، طالما أحبهم وأحبوه، وطالما تقربوا إليه وقدسوه. وقد حدث بالفعل أن المعبود الذي تخيله نفر منهم ربًّا للفيضان والخصب والزرع، وقدسوه باسم أوزير "أو أوزيريس كما دعاه الإغريق" كان هو نفس المعبود الذي نسبوا إليه ربوبية البعث والآخرة، وجعلوا مملكته تحت الأرض، وامتد تقديسهم له في طول البلاد وعرضها، وأحاطوه بأساطير وتخيلات عدة. "وهو غير إله النيل جعبي".
وكما استمد المصريون أملهم من أحوال الأرض وأربابها، استمدوا كذلك من السماء وأكبر أربابها حين لاحظوا ما لاحظته أغلب الشعوب القديمة، من أثر الشمس في دورة الحياة اليومية، وارتباط شروقها بيقظة الكائنات بعد النوم، والنوم هو الموت الأصغر كما يقولون، وبالحركة بعد الخمول، والرؤية بعد قلة الرؤية، فلم يردوا ذلك إلى عملية آلية لا روح فيها ولا هدف لها، وإنما ردوه إلى رب قادر اتخذ الشمس آيته الكبرى لنفع الأحياء في الدنيا، وتوهموا في هذا الرب "رع" وفي علل شروق شمسه وغروبها ما سبق لنا تفصيله في عقائد التأليه، ثم قدروا أن من يسير الشمس لنفعهم في الدنيا قادر على أن يوجهها لنفعهم في الآخرة، بعد أن تتجه إلى الأفق الغربي حيث توجد أغلب مدافنهم، فتنزل فيه إلى ما تحت الأرض وتضيء ظلمة القبور وتنير مسالك العالم السلفي، وتخيلوا للرب من أجل هاتين الغايتين، مركبين "سبق التنويه بهما"، مركبًا يعبر بها سماء الأحياء في النهار، وهي معنجة، ومركبًا يعبر بها سماء الموتى في الليل وهي "مسكتة"، وله في هذه الأخيرة مسار معلوم تحدثت عنه كتب الموتى في كل ساعة من ساعات الليل الاثنتي عشرة.
العصور ونمو الإمكانيات وتطور التصورات. فسادت الماديات في العصور المبكرة، ثم غلبت المعنويات عليها شيئًا فشيئًا خلال العصور المتحضرة المتتالية، ولكن دون أن تمحوها، فإلى جانب الارتقاء المستمر بعمارة المقابر وتوسيعها وتأمينها ضد عوادي الزمن واعتداءات الغير، باعتبارها المساكن الباقية لجثث أصحابها، بدأت الرعاية المادية في العصور المبكرة بتزويد المتوفى في قبره بما يمكن تزويده به من أواني الطعام والشراب والأدوات الضرورية وبعض مقتنياته الثمينة الخاصة، وتماثيل صغيرة رمزية لخدمه وجواريه إذا كان ثريًّا، وذلك ما يمكن تفسيره بالرغبة في إكرامه وإيثاره، وبالأمل في أن ينتفع بما يوضع معه في قبره خلال سفره الطويل، انتفاعًا يناسبه، وكل ذلك مع الحرص على تقديم القرابين وتلاوة التراتيل باسمه في الجزء العلوي من مقبرته في أوقات معينة وبما يتفق مع إمكانيات أهله.
وتطورت الرعاية شيئًا فشيئًا منذ أوائل العصور التاريخية، فاستعاضت عن الأطعمة الفعلية التي توضع في أسفل القبر، بتسجيل أسمائها وأعدادها ورموزها في قوائم منقوشة على لوحات خاصة تتخذ أوضاعًا محددة في قاعات تقديم القرابين فوق سطح الأرض، ثم تصوير مصادر خيرات الدنيا من زراعة وصناعة وصيد وفخر ولهو، على الجدران الداخلية في الجزء العلوي من المقبرة، ابتداء من أوائل الدولة القديمة. وقد رمزت هذه النقوش والمناظر في مجملها إلى أهم ما استحبه أهلها في دنياهم، ثم عبرت بتفاصيلها عن أغراض شتى، فاعتبرها أصحابها نموذجًا لما يودون أن تصبح عليه حياتهم في العالم الآخر، ورأوا فيها إذكاء لسعادة الروح وتذكيرًا لها بحياتها الأولى كلما هبطت من عالم السماء على قبرها، واعتقدوا بإمكان تحولها إلى حقائق تناسب العالم غير المنظور الذي سوف ينتقلون إليه، عن طريق ما يكتب معها ويتلى عليها من تعاويذ السحر وتراتيل الدين، واعتبروها تعويضًا احتياطيًّا لاحتمال تقصير ورثتهم في تقديم القرابين الفعلية لصالحهم، ثم اتخذوها وسيلة لتخليد السمعة والتفاخر والتعبير عن الثراء، ووسيلة للتعبير عن حب الزخرف والرغبة في استرواح صور الفن الجميل في الدنيا والآخرة. وانتقلت بعض هذه النقوش والمناظر منذ أواخر الدولة القديمة، من الحجرات فوق سطح الأرض إلى غرف الدفن وما حولها، وانتقل بعضها إلى سطوح التوابيت، ولكن ظلت أغراضها في أغلب الأحيان متشابة. وكان التابوت يعتبر المسكن الأصغر للمتوفى كما كان قبره يعتبر مسكنه الأكبر، ولهذا وجد من العناية والتطوير نصيبًا كبيرًا.
وتضمنت المقابر إلى جانب مناظرها ونقوشها، تماثيل كبيرة وصغيرة لأصحابها، وضعها الأحياء في أوائل الدولة القديمة في مقاصير مغلقة الجوانب وفي أقرب مكان فوق سطح الأرض يمكن أن يؤدي إلى بئر الدفن، كي ترغب الروح في التردد على مقبرة صاحبها وتسترشد بملامحها وهي في طريقها إلى حجرة دفنه حيث تحط على جثته. وليس من المستبعد أن تكون هذه الرغبة قد ارتبطت عند أصحابها بالخشية من أن تتغير ملامح الجثة أو تتحلل رغم وسائل حفظها، فتضل الروح عنها أو تنفر من أن تعود إليها، ثم انتقلت التماثيل منذ أواسط الدولة القديمة إلى مقاصير مفتوحة بالمقابر، وجمعت إلى غرضها السالف غرض تخليد صورة المتوفى بين الأحياء المترددين على مقبرته، وغرض تقديم القرابين والتراتيل أمامها لمنفعة روحه حين تتلبسها.
وساير الفنانون عقائدهم التي وعدت المؤمنين بالبعث براء من أعراض الضعف والمرض وعيوب البدن، فنحتوا هذه التماثيل في هيئات صحيحة قوية مستبشرة، ولم يمثلوا فيها عيوب البدن إلا في مرات نادرة. وغالبًا ما صحبت تماثيل المتوفى تماثيل أخرى صغيرة لخدمه وجواريه، كل بعمله الذي تخصص فيه، ابتغاء أن تنتفع روحه بمجهودات أعمالهم في الآخرة كما تنتفع بصورهم في مناظر المقبرة. ثم تماثيل أخرى صغيرة تسمى الرشابتي يقوم بعضها بدور المجيب عن صاحبه حين يُدعى لشأن من شئون الآخرة، ويقوم بعضها الآخر بدور التابع المسخر لأداء ما يأنف صاحبه من أدائه من أعمال في الآخرة(14).
وليس أدل على أن المصريين لم يعملوا لتقبل الموت بقدر ما عملوا للتغلب عليه من آية التحنيط التي حفظت على جثث كبارهم خواص تقاطيعها، وجلودها وشعورها، وأصابعها بأظفارها، على الرغم من مرور ما بين ثالثة آلاف وثالثة آلاف وخمسمائة عام عليها. ومعروف ما استهدفه المصريون من التحنيط من حيث الرغبة في الإبقاء على الجسم سليمًا واضح الملامح بقدر الإمكان، رعاية لصاحبه، وضمانًا لبعثه، وتشجيعًا لروحه على أن تأنس إليه وتتلبسه. وقد سكلوا في سبيل التحنيط مراحل وتجارب عدة، ندع تفاصيلها وتتابعها التاريخي لبحث آخر تالٍ، ويكفي أن نذكر أنهم وصلوا إلى كما التحنيط في الدولة الحديثة. ويفهم مما احتفظت به نصوص معدودات ومما سجله المؤرخان هيرودوت وديودور، ومما انتهى إليه الأخصائيون المحدثون(15)، أن البطن كانت تشق من جانبها بشفرة ظزانية رقيقة لتستخرج منها أحشاء الفراغ البطني والفراغ الصدري فيما عدا القلب، وقد يستخرج المخ من الرأس أيضًا، ثم تعالج كل من هذه بمواد معينة وتلف على حدة وتوضع في تجاويف الجسم ثانية. أو توضع في أوانٍ فاخرة تناسب صاحبها وتحاط بمواد تحفظ عليها كيانها وتمنع فسادها، مع الاعتقاد في إيكال رعايتها إلى أبناء الإله حور الأربعة، وحينئذ تملأ فراغاتها في الجسم بالراتنجات والصموغ والنشارة وما يماثلها أما المواد الأساسية المستعملة لكي تتشرب دهنيات الجسم وشحومه وعفونته، وتكسبه النقاء والجفاف والرائحة الزكية، فكان منها فيما يعرف حى الآن: النطرون وشمع العسل والقرفة والكاسيا والبصل وأنواع من الراتنجات الصمغية وحبوب العرعر وزيته وزيت الأرز وزيت الزيتون، والمر والمستكة والحناء، وكل ذلك بنسب وطرق لا تزال تحوطها الأسرار حتى الآن. وأضاف محنطو عصر الأسرة الحادية والعشرين خطوة قد تحتسب لهم أو عليهم، وهي معالجة تقلصات الأعضاء في بعض أجزاء الجسم حين التحنيط بحشو ما تحت الجلد بمواد مختلفة حتى تنبسط وتتخذ شكلها الأصيل، وحشو الصدغين أحيانًا حتى يتخذا امتلاءهما الطبيعي، وملء تجويف العين بما يرد عليها حيويتها. وشيئًا فشيئًا شاع استخدام التحينط لكل من يقدر على نفقاته من أفراد الشعب، وأصبحت له ثلاث مراتب كما روى هيرودوت تتفاوت في تكاليفها ومدى إتقانها، كما تتفاوت في فتراتها. بين أيام معدودات، وبين سبعين يومًا أو ما هو أكثر. وكان تمام عملية التحنيط فيما يسبقها ويصحبها ويتلوها من عمليات الغسل والتنظيف والتطهير والتعطير واللف والتكفين ثم وضع التمائم، لا سيما تميمة القلب، والحلي والأقنعة الذهبية، وكتابة الاسم والألقاب ونصوص الدين، فضلًا عما يتلى عليها من الرقى والإشارات الرمزية إلى فتح الفم وتنشيط الحواس، وما إلى ذلك مما ابتدعه الكهان وبرعوا فيه واعتمدوا في معيشتهم عليه.
ولم يكن للخطوات السابقة من أثر، في عرف المصريين، إلا بفضل ما يُتلى عليها من تراتيل السحر والدين، عند الوفاة، وعند الغسل والتطهير، وعند الدفن، وعند تقديم القرابين، وعند إجراء الصلوات في مقاصير المقابر وهياكل المعابد. وأوسع المصادر الدينية حظًّا فيما تضمنته من هذه التراتيل، وأوسعها تعبيرًا عن عقائد ما بعد الموت وتطورها من عصر إلى عصر، هي: متون الأهرام، ومتون التوابيت، وكتب الموتى. وقد استشهدنا ببعض خصائص المصدرين الأولين منها، خلال حديثنا عن التطور الحضاري للنصف الثاني من الدولة القديمة بالنسبة لمتون الأهرام، وخلال عصر اللامركزية الأولى بالنسبة لمتون التوابيت. وأسلفنا عن متون الأهرام التي بدأ تسجيلها في باطن أهرام الملوك منذ نهاية عصر الأسرة الخامسة حتى نهاية الدولة القديمة "ثم في العصر الصاوي"، أنها لم تكن وليدة عصر كتابتها وحده وإنما كانت من تراث عصور طويلة سابقة وإنتاج كفايات فكرية متباينة، لهذا تضمنت صورًا أخروية ودنيوية وأسطورية وفلسفية، بعضها بدائي مضطرب، وبعضها راقٍ منطقي.
وظهرت متون التوابيت، فيما مر بنا، منذ أواخر الدولة القديمة(16)، وزادت حصيلتها وتنوعت مذاهبها في عصر الانتقال الأول في الدولة الوسطى، واقتبس الكهان بعض أورادها من متون الأهرام، ثم ألقوا بقيتها بما يتناسب مع عهودهم المتتالية وآمال الناس فيها. وكان من أهم ظواهرها تلقب كل متوفى فيها بلقب "أوزير" أملًا في أن ينعم في الآخرة بما نعم به ويخلد فيها مثل خلوده. وكان هذا اللقب في بدايته قاصرًا على الفرعون باعتباره وريث أوزير في الدنيا والآخرة، فلما اهتزت أركان الملكية في أواخر الدولة القديمة، انتحل حكام الأقاليم امتيازاتها الدينية ورجوا لأنفسهم في الآخرة ما كان الفراعنة يرجونه لأنفسهم، وتلقبوا مثلهم بلقب أوزير، ثم قلدهم في ذلك من تحتهم حتى شاع اللقب وأصبح أملًا عامًّا لكل إنسان(17).
ولم تؤدِ متوت التوابيت إلى الاستغناء عن نقش متون دينية أخرى على الجدران، ثم لم تغنِ هذه ولا تلك عن ظهور موسوعات دينية جديدة في الدولة الحديثة، وهي كتب الموتى التي أصبحت تكتب على أدراج متفاوتة الأطوال من البردي وتحفظ مع المتوفى في تابوته أو توضع بين أكفانه. ولم تكن في حقيقة أمرها كتابًا يلتزم ترتيبًا معينًا، ويتحدد ببداية أو نهاية، ومن أجل هذا عدلنا عن تسميتها بالاسم الشائع لها وهو كتاب الموتى، وإنما كانت فصولًا دينية متفرقة تطور بعضها عن متون التوابيت، وألف بعضها الآخر بما يتفق مع تصورات عصره، وكان الكتبة الدينيون يكتبون في كل دراج ما يحفظونه منها أو ما تتوفر عندهم نسخه. أو ما يطلبه منهم العميل نفسه، أو يشيع عادة في أيامهم. وقد داخل هذه الفصول كثير من السحر والأخيلة الشعبية، ولكننا لا نكتفي بنماذج من أفضل ما فيها. وكانت فكرة الحساب والمسئولية أمام الأرباب قد ترددت من قبل في كل من متون الأهرام ومتون التوابيت ولكنها أصبحت أوضح من كتب الموتى، ويعبر عنها فيها باللفظ والصورة، وبصور معنوية وأخرى مادية، ومن أكثر صورها شيوعًا تصوير ميزان ينصب ويوضع قلب المتوفى في إحدى كفتيه، باعتباره مصدر النية والمشاعر والضمير بينما تصور في الكفة الأخرى ريشة ترمز من حيث اللفظ إلى كلمة "ماعت" بمعنى العدالة، وترمز من حيث الصورة إلى دقة الوزن وحساسيته. ويجري الحساب عادة في حضرة رب الآخرة أوزير، وبحضور اثنين وأربعين قاضيًا مقدسًا، يمثلون أرباب عواصم الأقاليم، بينما يقوم على تقييم الحسنات والسيئات رب الكتابة والحكمة تحوتي فيسطر على لوحته نتيجة الوزن ونتيجة دفاع المتوفى عن نفسه أمام أربابه وإلهه الأكبر، وحينئذ يتحدد مصيره، فإما إلى جنان ذات برك وغدران وزروع ترتفع سنابلها إلى سبعة أذرع، وإما إلى جحيم تتنوع فيه صور الحرمان والفزع وأذى الوحوش والحيات والنيران.
ويبدأ المتوفى يتنصل من آثام الدنيا في دفاع إنكاري طويل، يقول في بعض عباراته: لم أرتكب ذنبًا ضد الناس ... ، لم أضلل الرعية ... ، لم أرتكب إثمًا في دار الحق... ، ما قسوت على فقير، ما حرضت عبدًا على سيده ... ، ما أمرضت "إنسانًا"، وما أبكيت إنسانًا... ، لم أقتل ولم آمر بقتل ... ، لم آت اللواط لم أطفف الكيل ولا الميزان. وعندما ينتهي من حديثه الطويل يعلن طهارته بقوله: إني طاهر، طاهر، طاهر، طاهر؛ ونقائي نقاء طائر البنو الكبير في أهناسيا. وفي هذه المبادئ من الطهر وكثير أمثالها ما تضمنته كتب الموتى ونعالجه بتفصيل في بحث آخر، ما يشهد بأن القيم العليا في أغلب الأديان وفي الحضارات الراقية تكاد تكون واحدة (18).
__________
(1) في هذه الآراء ما يختلف عن أغلب ما فسرت به نشأة الدين المصري في المؤلفات الحديثة مما سنناقشه في كتاب آخر. وراجع: عبد العزيز صالح: قصة الدين في مصر القديمة - المجلة - نوفمبر 1958 - ص36 - 37، 43 - 44، 50 - 53.
(2) راجع: البحث نفسه - ص50+
(3) انظر أيضًا: أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة - معرف بالقاهرة - 1952.
(4) راجع: عبد العزي صالح: الوحدانية في مصر القديمة - يوليو 1959 - ص11 - 22.
(5) Brit. Mus. 40959; S. Hasan, Hymnes Religieux Du Moyen Empire, 192-193.
(6) Pap. Boulaq Xvii, I, 4.
(7)Conffin Texts, D 47, 209; D 50, 230; Xlvii, 208, 226; Sinuhe, B 213; Pap. Petersburg, 1116 B, 24-25; Urk. IV, 54; Cairo 34001, 7, 17, Etc.
وراجع: عبد العزيز صالح: البحث السابق - 15.
(8) تختلف ترجمتنا هذه عما أتت به أغلب المؤلفات الأخرى. Cf.Gunn,Jea, X, 168 F.
(9) Sandman, Op. Cit., 9; Erman, Op. Cit., 393.
(10) راجع المؤلف: ديانة مصر القديمة - القاهرة 1984.
(11) كثيرة هي المؤلفات التي كتبت عن عقائد ما بعد الموت في مصر القديمة ومنها:
أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة - معرب بالقاهرة 1952.
جيمس هنري برستد: تطور الفكر والدين - معرب بالقاهرة 1965.
جيمس هنري برستد: فجر الضمير - معرب بالقاهرة 1956.
A. H. Gardiner, The Attitude Of The Ancient Egyptians To Death And The Dead, 1935; H. Kees, Totenglauben Und Jenseitsvorstellungen Der Alten Aegypter, "2ed", 1956; J. Vandier, La 1962, Ch. Ix.
(12) راجع المؤلف: Saleh, "Notes On The Egyptian Ka", Bulletin Of The Faculty Of Arts, Cairo University, Vol. Xxii, Part 2 "1965", 1 F.
(13) راجع المؤلف: مداخل الروح وتطوراتها حتى أواخر الدولة القديمة - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - 1964 - ص95 - 136.
مقومات الإنسان وماهيته في مصر القديمة - نفس المجلة - 1969 - ص159 - 198.
(14) Speleere, Les Gurines Egyptiennes, Bruxelles, 1923.
(15) Ef. Pap Boul. Iii; Pap. Louver 5158; Herodotus, Ii, 88 F.; Diodorus, I, 91 F.; Dawson, Jea, Xiii, 40 F.; E. Smith And Dawson, Egyptian Mummies, 1924; K, Sethe, Zur Geschichte Der Einbalsmierung Bei Der Aegypter…, 1934; A. Lucas, Ancient Egyptian Materials And Industries, 1948, Ch. Xii And Notes.
(16) Speleers, Textes Des Cercueils, 1947; A. De Buck, the Egyptian Coffin Texts, 1935 F.; R.O. Faulkner, the Ancient Egyptian Coffin Texts, I-Iii.
(17) Moyen A. Moret, "Laccession De La Plebe Egyptienne Aux Droits Religeux Et Politiques Sous Le Empire", Rec. D'etudes Eg., 1922, 231 F.
(18) راجع المؤلف: ديانة مصر القديمة - القاهرة 1984.
 الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












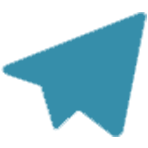
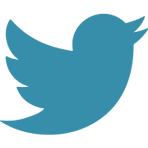

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)