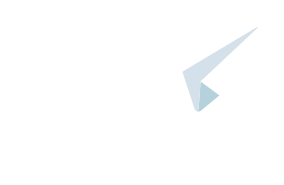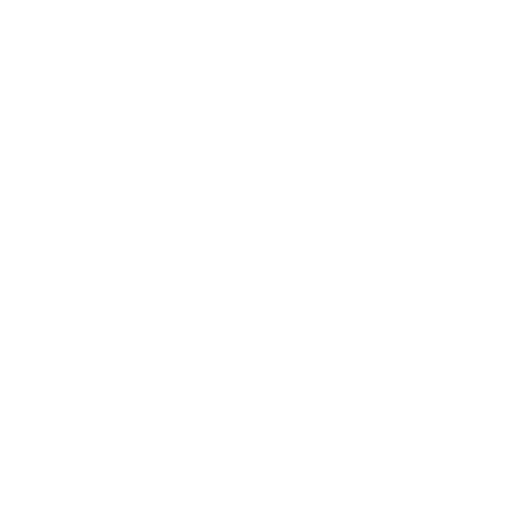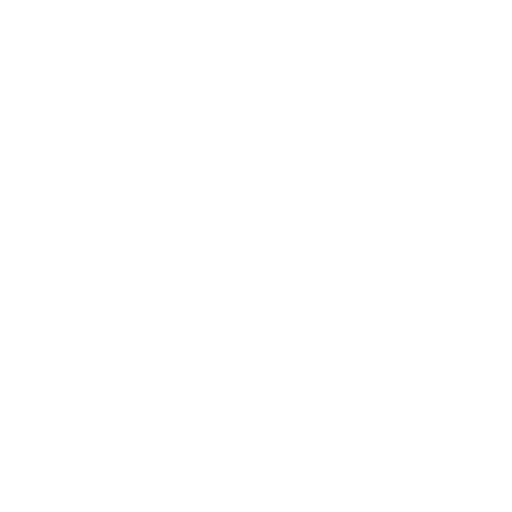النحو

اقسام الكلام

الكلام وما يتالف منه

الجمل وانواعها

اقسام الفعل وعلاماته

المعرب والمبني

أنواع الإعراب

علامات الاسم

الأسماء الستة

النكرة والمعرفة

الأفعال الخمسة

المثنى

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

العلم

الضمائر

اسم الإشارة

الاسم الموصول

المعرف بـ (ال)

المبتدا والخبر

كان وأخواتها

المشبهات بـ(ليس)

كاد واخواتها (أفعال المقاربة)

إن وأخواتها

لا النافية للجنس

ظن وأخواتها

الافعال الناصبة لثلاثة مفاعيل

الأفعال الناصبة لمفعولين

الفاعل

نائب الفاعل

تعدي الفعل ولزومه

العامل والمعمول واشتغالهما

التنازع والاشتغال

المفعول المطلق

المفعول فيه

المفعول لأجله

المفعول به

المفعول معه

الاستثناء

الحال

التمييز

الحروف وأنواعها

الإضافة

المصدر وانواعه

اسم الفاعل

اسم المفعول

صيغة المبالغة

الصفة المشبهة بالفعل

اسم التفضيل

التعجب

أفعال المدح والذم

النعت (الصفة)

التوكيد

العطف

البدل

النداء

الاستفهام

الاستغاثة

الندبة

الترخيم

الاختصاص

الإغراء والتحذير

أسماء الأفعال وأسماء الأصوات

نون التوكيد

الممنوع من الصرف

الفعل المضارع وأحواله

القسم

أدوات الجزم

العدد

الحكاية

الشرط وجوابه


الصرف

موضوع علم الصرف وميدانه

تعريف علم الصرف

بين الصرف والنحو

فائدة علم الصرف

الميزان الصرفي

الفعل المجرد وأبوابه

الفعل المزيد وأبوابه

أحرف الزيادة ومعانيها (معاني صيغ الزيادة)

اسناد الفعل الى الضمائر

توكيد الفعل

تصريف الاسماء

الفعل المبني للمجهول

المقصور والممدود والمنقوص

جمع التكسير

المصادر وابنيتها

اسم الفاعل

صيغة المبالغة

اسم المفعول

الصفة المشبهة

اسم التفضيل

اسما الزمان والمكان

اسم المرة

اسم الآلة

اسم الهيئة

المصدر الميمي

النسب

التصغير

الابدال

الاعلال

الفعل الصحيح والمعتل

الفعل الجامد والمتصرف

الإمالة

الوقف

الادغام

القلب المكاني

الحذف


المدارس النحوية

النحو ونشأته

دوافع نشأة النحو العربي

اراء حول النحو العربي واصالته

النحو العربي و واضعه

أوائل النحويين


المدرسة البصرية

بيئة البصرة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في البصرة وطابعه

أهم نحاة المدرسة البصرية


جهود علماء المدرسة البصرية

كتاب سيبويه

جهود الخليل بن احمد الفراهيدي

كتاب المقتضب - للمبرد


المدرسة الكوفية

بيئة الكوفة ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الكوفة وطابعه

أهم نحاة المدرسة الكوفية


جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود الكسائي

الفراء وكتاب (معاني القرآن)


الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف اسبابه ونتائجه

الخلاف في المصطلح

الخلاف في المنهج

الخلاف في المسائل النحوية


المدرسة البغدادية

بيئة بغداد ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في بغداد وطابعه

أهم نحاة المدرسة البغدادية


جهود علماء المدرسة البغدادية

المفصل للزمخشري

شرح الرضي على الكافية

جهود الزجاجي

جهود السيرافي

جهود ابن جني

جهود ابو البركات ابن الانباري


المدرسة المصرية

بيئة مصر ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو المصري وطابعه

أهم نحاة المدرسة المصرية


جهود علماء المدرسة المصرية

كتاب شرح الاشموني على الفية ابن مالك

جهود ابن هشام الانصاري

جهود السيوطي

شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك


المدرسة الاندلسية

بيئة الاندلس ومراكز الثقافة فيها

نشأة النحو في الاندلس وطابعه

أهم نحاة المدرسة الاندلسية


جهود علماء المدرسة الاندلسية

كتاب الرد على النحاة

جهود ابن مالك


اللغة العربية

لمحة عامة عن اللغة العربية

العربية الشمالية (العربية البائدة والعربية الباقية)

العربية الجنوبية (العربية اليمنية)

اللغة المشتركة (الفصحى)


فقه اللغة

مصطلح فقه اللغة ومفهومه

اهداف فقه اللغة وموضوعاته

بين فقه اللغة وعلم اللغة


جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى

جهود المحدثين


اللغة ونظريات نشأتها

حول اللغة ونظريات نشأتها

نظرية التوقيف والإلهام

نظرية التواضع والاصطلاح

نظرية التوفيق بين التوقيف والاصطلاح

نظرية محاكات أصوات الطبيعة

نظرية الغريزة والانفعال

نظرية محاكات الاصوات معانيها

نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية


نظريات تقسيم اللغات

تقسيم ماكس مولر

تقسيم شليجل


فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

لمحة تاريخية عن اللغات الجزرية

موطن الساميين الاول

خصائص اللغات الجزرية المشتركة

اوجه الاختلاف في اللغات الجزرية


تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللغات الشرقية

اللغات الغربية


اللهجات العربية

معنى اللهجة

اهمية دراسة اللهجات العربية

أشهر اللهجات العربية وخصائصها

كيف تتكون اللهجات

اللهجات الشاذة والقابها


خصائص اللغة العربية

الترادف

الاشتراك اللفظي

التضاد


الاشتقاق

مقدمة حول الاشتقاق

الاشتقاق الصغير

الاشتقاق الكبير

الاشتقاق الاكبر

اشتقاق الكبار - النحت

التعرب - الدخيل

الإعراب

مناسبة الحروف لمعانيها

صيغ اوزان العربية


الخط العربي

الخط العربي وأصله، اعجامه

الكتابة قبل الاسلام

الكتابة بعد الاسلام

عيوب الخط العربي ومحاولات اصلاحه


أصوات اللغة العربية

الأصوات اللغوية

جهود العرب القدامى في علم الصوت

اعضاء الجهاز النطقي

مخارج الاصوات العربية

صفات الاصوات العربية


المعاجم العربية


علم اللغة

مدخل إلى علم اللغة

ماهية علم اللغة

الجهود اللغوية عند العرب

الجهود اللغوية عند غير العرب


مناهج البحث في اللغة

المنهج الوصفي

المنهج التوليدي

المنهج النحوي

المنهج الصرفي

منهج الدلالة

منهج الدراسات الانسانية

منهج التشكيل الصوتي


علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة وعلم النفس

علم اللغة وعلم الاجتماع

علم اللغة والانثروبولوجيا

علم اللغة و الجغرافية


مستويات علم اللغة

المستوى الصوتي

المستوى الصرفي

المستوى الدلالي

المستوى النحوي

وظيفة اللغة

اللغة والكتابة

اللغة والكلام


تكون اللغات الانسانية

اللغة واللغات

اللهجات

اللغات المشتركة

القرابة اللغوية

احتكاك اللغات

قضايا لغوية أخرى


علم الدلالة

ماهية علم الدلالة وتعريفه

نشأة علم الدلالة

مفهوم الدلالة


جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود الجاحظ

جهود الجرجاني

جهود الآمدي

جهود اخرى

جهود ابن جني

مقدمة حول جهود العرب


التطور الدلالي

ماهية التطور الدلالي

اسباب التطور الدلالي

تخصيص الدلالة

تعميم الدلالة

انتقال الدلالة

رقي الدلالة

انحطاط الدلالة

اسباب التغير الدلالي

التحول نحو المعاني المتضادة

الدال و المدلول

الدلالة والمجاز

تحليل المعنى


المشكلات الدلالية

ماهية المشكلات الدلالية

التضاد

المشترك اللفظي

غموض المعنى

تغير المعنى

قضايا دلالية اخرى


نظريات علم الدلالة الحديثة

نظرية السياق

نظرية الحقول الدلالية

النظرية التصورية

النظرية التحليلية

نظريات اخرى

النظرية الاشارية

مقدمة حول النظريات الدلالية

موضوعات أخرى
المثنى 2
المؤلف:
الشيخ مصطفى الغلاييني
المصدر:
جامع الدروس العربية
الجزء والصفحة:
ج2/ ص320- 322
16-10-2014
2734
فالمثنى يُرفعُ بالألف، مثل (أفلح المجتهدان). ويُنصب ويجرُّ بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل (أَكرمت المجتهدَيْنِ، وأحسنتُ إلى المجتهديْنِ).
ص320
ص321
(1) قال ابن هشام في المغني وقد سئلت قديماً عن قول القائل "زيد وعمرو كلاهما قائم. أو كلاهما قائمان". فكتبت إن قدر (كلاهما) توكيداً قيل "قائمان" لأنه خبر عن "زيد وعمرو"، وإن قدر مبتدأ، فالوجهان، والمختار الإفراد. وعلى هذا، فإذا قيل "إن زيدً وعمراً" فإن قيل "كليهما" قيل "قائمان" أو "كلاهما" فالوجهان. ويتعين مراعاة اللفظ في نحو "كلاهما محب لصاحبه"، لان معناه كل واحد منهما، وقوله:-
*كلانا غني عن أَخيه حياته * ونحن، إذا متنا، أشد تغانياً*
(3) يؤكد بكلا المثنى المذكر. وبكلتا المثنى المؤنث، ويضافان أبداً لفظاً ومعنى إلى اسمٍ واحد معرفة، دال على اثنين إما بلفظه، نحو "جاءَ كلا الرجلين" وإما بمعناه. كقول الشاعر:-
*إن للخير وللشر مدى * وكلا ذلك وجه وقبل*
أَي وكلا ما ذكر من الخير والشر ولا يضافان إلى مفرد، وأما قول الشاعر:-
*كلا اخي وخليلي واجدي ابداً * في النائبات وإلمام الملمات*
فضرورة نادرة، لا يلتفت اليها ولا يستشهد بها، ولا تباح في شيء من الكلام، حتى الشعر لان الضرورة إنما يستشهد بها، إذا كانت كثيرة. فإن كثرت في كلامهم جاز للشاعر ارتكابها.
ص322
 الاكثر قراءة في المثنى
الاكثر قراءة في المثنى
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













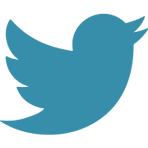

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)