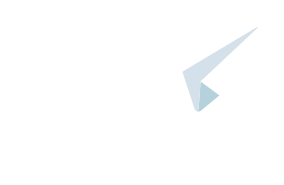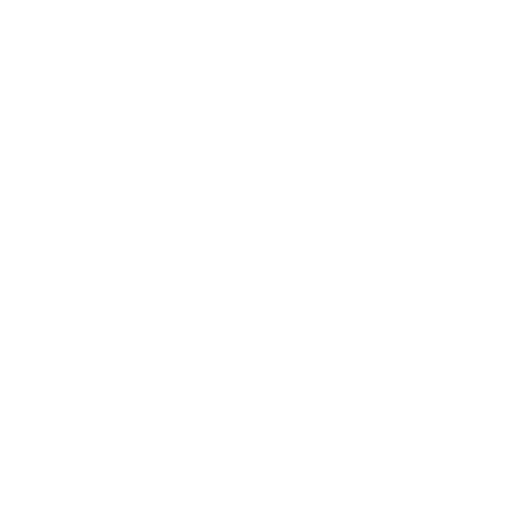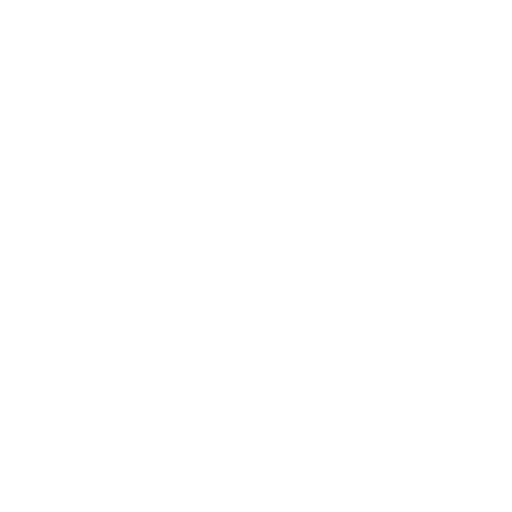الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ..
المؤلف:
السيد عبد الاعلى السبزواري
المصدر:
الاخلاق في القران الكريم
الجزء والصفحة:
323- 338
22-7-2021
4369
{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ * قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران: 14، 17]
قال تعالى : {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ} [آل عمران: 14]
مادة (زين) من المواد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات شتى ، قال تعالى : {وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} [فصلت : 12] .
وقال تعالى : {أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ} [يونس: 24] ، وقال تعالى : {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص : 79] ، وفي حديث الاستسقاء : " اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها " ، أي نباتها الذي يزينها.
والزينة من الأمور الإضافية المختلفة بحسب اختلاف العادات و الأعصار والأمصار ، وأنها من الجماليات التي يكون حسنها ممدوح وجذاب للنفوس ، بل إن بعض مراتبها منا يدرك بالحس ، ولا يمكن وصفها باللفظ ، والزينة الحقيقية هي ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وغيرها مما يوجب الشين في حالة دون أخرى ، فهي زينة بالوجه والاعتبار ، وليست هي حقيقية على الإطلاق.
والزينة على أقسام ثلاثة : زينة نفسانية ، كالعلم والاعتقادات الحسنة والكمالات النفسانية المقررة في الشريعة ، وزينة بدنية جسمانية ، كالشمائل الظاهرية ، قال علي (عليه السلام) : " زينة المرء حسن أدبه ، وجمال الجمال في عقولهم ، وعقول النساء في جمالهن " ، وزينة خارجية كالمال والبنين والاعتبار.
وقد ذكر تعالى جميع ذلك في مواضع من القرآن الكريم.
فتارة : نبها إلى نفسه عز وجل ، قال تعالى : {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات : 7] ، وقال تعالى : {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ } [الأعراف : 32].
وأخرى : إلى الشيطان ، قال تعالى : {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام : 43].
وثالثة : لم يسم فاعلها - كما في المقام - والوجه في ذلك أن الله تعالى خلق الدنيا وما عليها وسيلة إلى نيل الكمال والوصول إلى غاية حميدة ، وهي الدار الآخرة ، فكانت الدنيا متاعاً ودام مقام ينزل إليها الإنسان في برهة من الزمن ، ليتزود منها إلى سفر آخر طويل ، فكلما كان الزاد أحسن وأبقى ، كان العيش في الآخرة أهنأ وأحسن ، وقد خلق الله تعالى الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان ، وتكون وسيلة للتزود منها ويتوسل بها إلى الدخول في رضوان الله تعالى ، قال عز وجل : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا } [الكهف : 7، 8] ، وإلى ذلك يشير كل ما ورد من الآيات التي تنسب الزينة إليه تعالى.
وأما إذا جعل الإنسان الدنيا وما عليها من الزينة محط نظره ، واعتبرها أمرا مستقلا وجعلها هي الغاية من دون أن تكون وسيلة وذريعة إلى الدخول في رضوانه تعالى ، وأحبها حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم جعلوا ما في الدنيا من الأموال والأولاد تغني عنهم ، فزينت لهم أعمالهم ، فكانت الدنيا وبالاً عليهم، فتكون الزينة مستندة إلى الشيطان أو إلى نفس الإنسان، وإن كانت الدنيا مخلوقة لله تعالى، وقد أذن للإنسان أن يتمتع بها ، ليتم النظام ، ولكن لم يزين الدنيا لتلهي الإنسان بها ويعرض عن ذكره عز وجل ، فإن الله تعالى أعز وأمنع من أن يدبر خلقه بما لا غاية له ، أو يوصل الإنسان إلى غاية فاسدة، فالتعبير بالمجهول في ( زين ) للتنبيه على ما تقدم كما سيأتي.
ومادة (شهوة) تأتي بمعنى نزوع النفس إلى ما تريده. وهي إما صادقة ، أي ما يقوم بها البدن ولا تتم الحياة البشرية إلا بها ؛ وتكون من أتم ما بني عليه النظام الأحسن ، بحيث لو اختلت لبطل النظام وتعطلت أمور الأنام ، فإنها من سنن الحياة المستلذة بها.
وإما كاذبة ، وهي الشهوة المذمومة ، أي الإغواء أو الدافع الشيطاني ، وإنها مستقذرة حذرت الأديان الإلهية منها ، وجعلتها محور الانحرافات والأخلاق الذميمة ، سواء كانت خفية ، أي الصفات الذميمة والأخلاق السيئة التي يضمرها صاحبها ويصر عليها ، كما في الحديث عن نبينا الأعظم (صلى الله عليه واله) : " أن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية " ، أم كانت ظاهرية ، وهي ما كانت ظاهر من العمل.
والشهوات : جمع شهوة ، وهي توقان النفس للملائم أو الملذ لها ، وهي من أهم القوى التي خلقها الله تعالى في الحيوان ، ولولاها لما قام له أصل ولا بنيان.
وسياق الآية المباركة يدل على أن فاعل التزيين هو الشيطان أو النفس، لأن حب الشهوات مذموم ، ويشتد الذم كلما اشتد الحب ، ويخف كلما خف حتى يصل إلى مرتبة الحب النظامي الذي هو من لوازم الطبيعة في الإنسان والحيوان ، فتزول المذمة رأسا ، بل يكون ممدوحاً ويكون خلافه نقصاً ومذموما ، وعلى ذلك يحمل ما ورد عن سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) : " أحببت من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وقرة عيني الصلاة، ، وسيأتي وجه آخر لحمل كلامه .
ويمكن أن تكون الآية الشريفة في مقام بيان طبيعة الإنسان وما يتدخل في سلوكه، فإذا وفق بين الحب والطبيعة ، بحيث يتحكم العقل بالتوفيق ينهما ، كانت النتيجة فاضلة والأثر عظيماً، ويكون حياً ممدوحا ، وهو الذي يشاؤه الله ويريده ويرتضيه ، ولا ريب في أنه ممدوح عقلا أيضا ، فيكون تزيين الله تعالى هو إذنه وبيان حدوده ، فقد زين حب المذكورات في الآية الشريفة المتقدمة وفق الحكمة المتعالية ليكون وسيلة لتنظيم النظام وبقاء النوع وحسن الاجتماع ، وأما إذا الهى القلب عن التوجه إلى الله تعالى وأوجب الغفلة عنه عز وجل ، فهو من تزيين الشيطان ووساوسه ، وهو مذموم عقلا أيضا.
قال تعالى : {مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ} [آل عمران : 14].
ذكر سبحانه وتعالى أموراً ستة من المشتهيات ، وهي الأمور التي تتدحل في شؤون الإنسان وسلوكه وتحدد مصيره.
و( من ) بيانية ، والبنين جمع ابن ، وهو الذكر من الأولاد ، ولكن في المقام يشمل الذكور والإناث ، بقرينة قوله تعالى : {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } [التغابن: 15] ، وقوله تعالى : {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى} [سبأ: 37] ، وقوله تعالى : {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الممتحنة : 3] ، وإنما أتى عز وجل بصيغة الذكور إما تغليبا ، أو يكون كناية عن حبهم المذموم الذي كان دائراً بينهم.
وإنما زين حب البنين مع كونه من حب النساء أيضا ، لأن البنين هم الغاية القصوى من حب النساء ، وهم النتيجة لذلك الحب.
والقناطير : جمع القنطار ، وهو المال الكثير ، وفي بعض الأخبار ملأ مسك ذهباً ، وقيل : ملأ جلد ثور ذهباً. وقيل غير ذلك ، وهو اسم لمعيار خاص أيضا ، وسمي المال بالقنطار ، لأن صاحبه يعبر بواسطته الحياة الدنيا ، ويختلف ذلك اختلافاً كثير بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغيرها ، كالغنى الذي لا يمكن تحديده بحد خاص ، ومن حددهما إنما يحددهما بحسب الجهات الخارجية ، لا بحسب ذاتهما.
والمقنطرة اسم مفعول جيء به للتثبيت والتوكيد ، كما هو عاد العرب في توصيف الشيء بما يشتق منه للمبالغة وتثبيت معناه له .
وهذا التعبير مشعر بالكثرة والاقتناء .
وتعداد المشتهيات باعتبار كون الإنسان ذا أصناف ، فإن بعضاً منه يتعلق حبه بالنساء ، وبعضاً آخر يتعلق بجمع المال وتخزينه ، وثالثا بالأولاد البنين منهم بالخصوص ، ورابعاً بالأنعام والحرث.
وربما يجتمع في فرد أكثر من واحد من تلك المشتهيات ، فإن الشهوة ذات مراتب متفاوتة شدة وضعفاً بالنسبة إلى شخص واحد في حالات مختلفة ، فضلا عن الأشخاص.
فالآية المباركة تبين طبع الإنسان على نحو القضية الحقيقية ، كما أنها ليست في مقام حصر الشهوات ، فقد يتعلق حب الإنسان بالجاه والمقام ونحو ذلك ، وإن كانت المشتهيات الأخرى - التي لم تذكر في الآية الشريفة - أقل تأثيراً مما ذكر فيها ، فهي أمور وهمية تتعلق بها الرغبة ومقصودة ثانوية ، فيكون الحصر إضافيا ، فلا منافاة بين هذه الآية الشريفة وبين قوله تعالى : {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : 46] ، وسيأتي في البحث العلمي ما يتعلق به.
وتعلق حب الإنسان بهذه الثلاثة واضح ، لأن بها ينتظم النظام الاجتماعي في هذه الدنيا ، بل النظام الفردي والاقتصادي فيها ، وبها تتحقق أغلب رغباته ، وبقدر اشتداد هذه المنتهيات وضعفها يتحدد سلوك الإنسان ويتعين خلقه في الدنيا ومصيره في الآخرة ، فإن بالنساء تتحقق المعاشرة الزوجية إليهن وتسكن النفوس، وهن الطرف الآخر من الحياة التي عليهن مسؤوليات كثيرة في الكفاح والعيش ، فالمرأة والرجل متشابكان في عموم المنافع وانتظام النظام ، ولأجل ذلك أسس العلماء قاعدة اصطلحوا عليها بقاعدة الاشتراك ، أي اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، وقد حدد الشرع المقدس هذه الشهوة بحدود خاصة تحدد مسؤولية كل واحد منهما في هذه الحياة وتنظيم شؤونهما ، والتعدي عنها يوجب الفساد والدمار.
وإنما لم يذكر عز وجل حب ، النساء للرجال - مع أن الناس في صدر الآية الشريفة يشمل كلا منهما ، كما أن بقية الشهوات عامة لهما - إما لأن من أدب القرآن الكريم والسنة الشريفة الستر على النساء مهما أمكن ، أو لأجل أن كثيراً من الأمور التي تتعلق بهذه الشهوة إنما يتعلق بالرجال وتقل في جانب النساء ، فإن الأشد ولعاً بحب النساء واتخاذهن صواحب في اللذائذ ونحو ذلك هم الرجال ، كما أنهن أشد تأثيراً على الرجال ، إذا اشتد الغرام والتعشق بهن .
قال تعالى : {وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ} [آل عمران : 14].
المسومة : إما بمعنى الراعية من سامت الإبل سوما إذا ذهبت لترعى ، أو بمعنى المعلمة لتعرف من غيرها من السمة بمعنى العلامة ، ومنه قوله (صلى الله عليه واله) يوم بدر : " سوموا فإن الملائكة قد سومت " ، أي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا ، وهي تلك الخيل التي يقتنيها الأغنياء وغيرهم للافتخار والتباهي ، مضافاً إلى كونها مما يبذل بازائها المال الكثير.
والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لأنها اموال اهل القرى والبادية، ومنها يكون معاشهم وثروتهم.
والحرث اسم لكن ما يحرث، أي المغروس والمزروع، فيشمل نفس الزرع وتربيته ، فيكون فيه معنى الكسب . والحاجة إليه أشد من غيره ، وحبه لا يكون ضاراً بامور الآخرة ، ولذلك أخره عن الأنواع السابقة ، وبذلك تتم جميع ما يزين أصناف الناس ، فقد ذكر سبحانه الأنواع التي توجب الافتنان بكل صنف ، فالذهب والفضة لأهل التجارة والخيل للملوك وأهل الجاه والمقام ، والأنعام لأهل البادية ، والحرث لأهل القرى والأرياف ، فتصلح الآية الشريفة لكن عصر ومصر من دون اختصاصها بنصف خاص مورد كذلك.
قال تعالى : {ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [آل عمران : 14].
المتاع اسم لكن ما يتمتع به ، ويعبر عنه لكل ما هو في معرض الزوال والاندثار ، والتعبير به للتزهيد في الدنيا والترغيب للآخرة ، التي هي دار البقاء والحيوان ، أي : ما ذكر من المشتهيات هي أمور يتمتع بها في هذه الدنيا الفانية التي يتزود منها برهة من الزمن ، يقضي بها حوائجه من دون أن تكون باقية دائمة.
قال تعالى : {وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: 14].
المآب : المرجع ، وحسن المآب هو المرجع الذي لا فناء فيه ولا عناء و المنزه عن كل نقص وعيب ، فلا يشغل المتاع الزائل في الدنيا عن الخير الآجل والمطلق في العقبى.
وفي الآية المباركة كمال الترغيب إلى الآخرة، وتحقير الدنيا والتقليل من شأنها.
قال تعالى : {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ} [آل عمران : 15].
تفصيل لما أجمل سابقا ، وبيان لقوله تعالى : {وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: 14].، فقد أمر سبحانه وتعالى نبيه ببشارة المتقين، بأن لهم عند الله تعالى ما هو أعظم من هذه المشتهيات الزائلة المحدودة، التي لا تبقى ولا تدوم ، وهو الخير للإنسان ، فلا خير في ما سواه ، وهو وإن كان مشابها لما في هذه الدنيا ومجانساً للشهوات الإنسانية ، ولكنها أجل النعم وأعظمها، وهو خال عن النقص وبريء عن القبح والشرور ، وقد ذكر سبحانه ذلك في كلام بليغ تتوجه إليه النفوس وتهتز من فرح اللقاء الأرواح والقلوب.
وفيه جذبة ربوبية من الملكوت الأعلى للمتقين المسجونين في سجن الدنيا ، وقد وعدهم الجنة ومطهرات الأزواج والرضوان.
ومن إطلاق الخير يستفاد أنه خير في ذاته ومن جميع شؤونه وجهاته.
ولما أتى سبحانه بالكلام على صورة الاستفهام ، لتوجيه النفوس إلى الجواب وتشويقهم إلى العمل ، وهو أسلوب فصيح يؤثر في النفس ويستفزها على إصغاء الجواب.
قال تعالى : {لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ } [آل عمران: 15].
جملة (للذين اتقوا) خبر مقدم ، وجملة : ( جنات تجري ) مبتدأ مؤخر.
والتقوى هي إتيان الواجبات الشرعية واجتناب المحرمات الإلهية ، وهي المراد بالعمل الصالح الذي كثر الاهتمام به في القرآن الكريم ؛ كما أنها الورع الذي حثت عليه السنة القدسية بالسنة شتى ، فقد ورد : " أن من اجتنب محارم الله فهو من أورع الناس " ، وهي أساس الكمالات وقرة عين الأسباب والمرسلين ، وهي السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء ، وبها ينتظم نظام الدنيا والعقبى.
ولفظ الجنات يدل على كثرة الأشجار واستتار الأرض بها وتعددها وجريان الأنهار من تحت الأشجار إنما هو لأجل تمامية بهجة الجنات وازدياد رونقها ، وكون الجنات كذلك من أجلى مظاهر الفرح والانبساط ، لا سيما إذا استيقن الإنسان بدوام تلك النعمة ، ولذا عقبها قوله تعالى : { خالدين فيها} ، لتمامية النعمة ، بخلاف نعيم الدنيا.
ولجريان الأنهار أنواع كثيرة : منها ما إذا كان منبع الأنهار من غير تحت الأشجار ، ومنها ما إذا كان المنبع من تحتها ، ومنها ما إذا كان نزول الماء من الفوق في الأنهار ثم الجريان منها صاعداً (على نحو الفوارة) بالقدرة الأزلية الخلاقة إلى غير ذلك ، وبالجملة أن هذه الجنات تشتمل على جميع اللذائذ بأعلى مراتبها.
والأزواج المطهرة هي تلك الأزواج التي يرغب إليها الإنسان ، التي تكون طاهرة من جمع الرذائل ومبرأة من كل عيب وذم ونقصان ، خلقا وخلقاً بما يلائم طبع الإنسان ، فهي في غاية الملاحة والبشاشة والسرور ، وفي ذلك تمام النعمة.
وقد حمل الله تعالى الأزواج بالذكر من بين سائر اللذائذ الجسمانية ، لأن النساء أعظم المشتهيات النفسانية ، والوقاع من أشد اللذائذ عند الإنسان.
قال تعالى : { ورضوان من الله}.
الرضوان بكسر الراء أو ضمها من الرضا مصدران ، وهو ملائمة الشيء لنفس صاحبه ومرورها به.
وقد تكررت مادة (رضى) في القرآن الكريم بهيئات شتى تبلغ سبعين موردا ، وقد ينسب الرضا إلى الله عز وجل ويراد به عناية خاصة غير محدودة بأي حد من النعم المعنوية ، بلا فرق بين أن يكون رضاؤه تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد وطاعتهم له عز وجل ، أو صفاتهم وأحوالهم ، أو بالنسبة إلى أمر آخر يتعلق بهم ، قال تعالى : {رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} [الفتح: 18] .
وقال تعالى : {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } [المائدة: 3] وقال تعالى : {وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7].
وقد ينسب إلى العبد ، وهو أخر مقامات العبودية الخالصة الذي هو التخلق بأخلاق الله تعالى ، والتفاني في حبه ، ولذلك درجات كثيرة ، منها رضاء العبد عن الله تعالى لجزائه الحسنى وحكمه ، قال تعالى : {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100].
ورضوان الله تعالى هي الغاية القصوى لكل ذي لب ، وهي أعلى مراتب اللذائذ الروحانية ، وذكره بالخصوص إنما هو لأجل بيان أن الرضا هو أقصى ما يشتهيه الإنسان من مشتهيات الدنيا ، بل هو الغاية منها ، فلا بد من السعي إلى رضوان الله تعالى الذي هو أعظم اللذائذ عند المتقين وذوي الألباب ، فهو الخير الذي لا يتصور أعظم منه ، لا ما يتصوره الإنسان من الخير في المال والقناطير ، فإن ذلك إنما يكون برضائه تعالى ، ولذلك اعتنى عز وجل به وأفرده بالذكر في مقابل الجنات والأزواج المطهرة في هذه الآية وفي سائر الآيات التي اقترن بغيره من اللذائذ ، قال تعالى : {فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} [المائدة: 2]
وقال تعالى : {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ} [التوبة: 21]
وقال تعالى : {وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ} [الحديد: 20].
وقد جمع سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة اللذائذ الجسمانية في الآخرة ، وهي الجنات والأزواج المطهرة ، واللذة المعنوية الروحانية ، وهي : الرضوان الذي يحده حد ولا يشوبه نقص.
ويستفاد من الآية الشريفة اختلاف درجات المتقين في الآخرة ، وأن لأهلها مراتب وطبقات ، فمنهم من لا يليق به إلا اللذائذ الجسمانية ، كالجنات والأزواج المطهرة ، ومنهم من عظمت منزلته وارتقى إدراكه وعلا قربه ، فلا يليق به إلا رضوان الله تعالى.
قال تعالى : { والله بصير بالعباد}.
أي : والله خبير بعباده عليم بأفعالهم وما تطويه ضمائرهم ، فلا تخفى عليه خفاياهم وأمورهم ، فيجازي كل فرد بما يكسبه وما يليق بأفعاله.
ويستفاد من الآية الشريفة أن امتياز كل فرد من أفراد الإنسان بما يشتهيه الداخل في عواطفه وسلوكه في حياته الدنيوية والأخروية تحت إرادة الله تعالى وحكمته البالغة ، وهو عالم بمصالحهم وجزائهم لا تخفى عليه أمورهم ، فهذه الآية الشريفة بمنزلة التعليل لجميع ما سبق ذكره.
قال تعالى : {الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 16].
بيان لصفات المتقين المدلول عليهم بقوله تعالى : { للذين اتقوا} ، وهي من الصفات الحميدة ، وفيه إشارة إلى بعض صفات المحبين المخلصين ، وبعض مقامات العارفين ، كل ذلك في خطاب بليغ إلى أعز حبيبه وأطهر قلب من الشرك وأنواع العيب ، وفيه تظهر المعبودة المحضة للمعبود الحقيقي ، كما أن فيه وعد الاستجابة للطائعين والعابدين.
والقول : مطلق ما يشعر بالحكاية عما في الضمير ، بخلاف الكلام فإنه أعلم من القول.
فكل كلام قول ولا عكس ، والمراد به في المقام مطابقة ضمائرهم مع ما يقولون بألسنتهم ، وسياق الآية الشريفة شاهد لما قلناه.
ومادة (غفر) تأتي بمعنى إزالة الوسخ والدنس ، يقال : " اغفر ثوبك في الوعاء ليذهب عنه وسخه " ، وهي من الموارد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مختلفة جدا ، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه الأقدس في مواضع متعددة من القرآن الكريم ، فهو الغفار والغفور ، وأن منه المغفرة ، قال عز وجل : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ} [الرعد : 6].
وقال تعالى : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82].
وقال تعالى : { أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } [هود: 11].
وقال تعالى : {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 135].
وقال تعالى : {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [يوسف: 98].
ومادة (ذنب) تأتي معنى التبعة ، أي القبح الذي يتبع صاحبه ، والفرق بينه وبين الجرم بالاعتبار ، لأنه بمعنى القطع ، أي يقطع ارتباط صاحبه بالله تعالى ، فكل مجرم مذنب وكذا العكس.
والآية المباركة في مقام بيان استنجاز الوعد بعد الإيمان بالله تعالى ولذا فرع غفران الذنوب على الإيمان ، يعني : أننا وفينا بما عهد إلينا وهو الإيمان ، فانجز الله بوعدك بستر ذنوبنا بعفوك وخلاصنا من عذابك.
وعهد الله تعالى هذا مذكور في جملة من الآيات صريحا وضمنا ، منها قوله تعالى : {وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ} [الأحقاف : 31].
وقوله تعالى : {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53].
وقوله تعالى : : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [الصف: 10 - 12].
ومعنى الآية الشريفة : الذين يؤمنون ويعترفون بحقيقة العبودية لله تعالى والإيمان به عز وجل ، ويجعلون ذلك وسيلة لطلب غفران الذنوب ونجاتهم من عذاب النار ، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
والآية المباركة ليست في مقام المنة عليه عز وجل ، بل له تعالى المنة على عباده أن هداهم إلى الإيمان.
وإنما خصوا اسم الرب في دعائهم لما فيه من إظهار العبودية والاسترحام .
وإطلاق الاية المباركة يشمل جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة ، وقد قرر عز وجل إيمانهم مع ذلك ، فتكون الآية الشريفة حجة على من قال بأن ارتكاب الكبيرة لا يجتمع مع الإيمان.
نعم ، لو أراد أنه حين الارتكاب يزول إيمانه العملي بخصوص ما ارتكبه ، كما هو المستفاد من قوله (صلى الله عليه واله) : " لا يزني الزاني وهو مؤمن " ، فله وجه ، لكنه لا ينافي بقاء أصل الإيمان بنحو الجملة والإجمال.
والوقاية من عذاب النار والنجاة منها أعم من المغفرة والدخول في الجنة ، وإنما طلبوا النجاة من عذاب النار لأنها الوسيلة للوصول إلى الجنة ومقدمة له.
قال تعالى : {الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران : 17].
الصابر هو الحابس نفسه عن ارتكاب المعاصي والملازم لامتثال الأوامر ، والصادق المخبر بالشيء على ما هو عليه ، والقانت المطيع ؛ والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع ، وقد فسر بكل واحد منهما أيضا ، ولكن إذا استعمل في الأنبياء والأولياء وعباد الله المخلصين يراد به هما معا ، قال تعالى : {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ} [النحل : 120].
والإنفاق هو بذل ما هو راجع بذله ، فيشمل المال والجاه والعلم وقضاء حوائج الناس ، والأسحار جمع سحر ، وهذه المادة في أية هيئة استعملت تفيد معنى الخفاء والإخفاء.
وفي المقام عبارة عن اختلاط ظلام آخر الليل بضياء الفجر ، وهو اسم لذلك الوقت ، وهو أفضل الأوقات وأشرفها وأحسنها للعبادة ، وأطيبها لحضور القلب والإقبال على الدعاء والمناجاة مع الرب ، وأبعدها عن مداخلة الرياء ، وكلما قيل في مدحه وفضله فهو قليل ، فكم لله تعالى فيه من نفحة عطرة من بها على من يشاء وجائزة موفرة يخص بها من أخلص في الدعاء ، وكم من عبادة فيها هبت عليها نسمات القبول ، ودعوة من ذي طلبة مشفوعة بالمأمول ، فهو وقت العلماء العاملين والعرفاء المتعبدين ، وهو وقت نجوى الحبيب مع الحبيب ، بلا تخلل مغاير أو رقيب ، فالسعيد من أدرك هذا الوقت الشريف واستفاد من رحمة الرب اللطيف.
وهذا الوقت من آخر معلوم ، وهو اختلاط ظلام الليل بضياء النهار ، وأما من أوله ، فعن جمع هو السدس الأخير من الليل ، وعن آخرين أنه الثلث الأخير منه ، وعن آخر أنه الثمن ، والكل صحيح بحسب مراتب الفضل ، وقد تعرضنا لبعض الكلام فيه في كتابنا [مهذب الأحكام ] فراجع.
والآية المباركة تشتمل على خمس خصال وصف بها المتقون ، وهي أمهات الصفات الحسنة والخصال الحميدة والأخلاق الكريمة ، فبالصبر ينال الإنسان أعلى المقامات ويتحلى بمحاسن الأخلاق ، وبدونه لا يمكن أن يصل إلى درجة التقوى ، ولذا قدمه سبحانه في الكلام . وإطلاقه يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة ، وهو والصدق من أعلى مقامات السالكين إلى الله تعالى وأفضل درجات أهل الحق واليقين ، خصوصاً إن عممنا الصدق ليشمل صدق اللسان والحركات وخطرات الجنان وتطابق الظاهر مع الباطن ، فحينئذ لا يتصور للعبودية مقام فوق ذلك إن طابق كل ذلك مع الشرع المبين واقترن مع الخضوع والتذلل لله تعالى.
وهذه الخصال الخمس ستجمع جميع الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة ، ولا يشذ منها كل متق ، وهي خصال متكاملة تشيد صرح الإنسانية الكاملة وتبلغها إلى أوج العادة وأقصى الدرجات.
وبالأولى منها ينال الإنسان تلك الصفات والخصال الكريمة التي تعلق بالنفس وتبعدها عن رذائل الأخلاق.
وبالصدق يتحلى بالصفات التي تتعلق بالظاهر.
وهاتان الخصلتان ترجعان إلى نفس الإنسان وتصلحان سريرته وعلانيته.
والقنوت لله تعالى يجعل الإنسان خاضعاً ذليلا بين يدي عظمته ، مطيعاً لإرادته عز وجل ، وهذه الخصلة تصلح ما بينه وبين الله تعالى.
والإنفاق يبعده عن رذيلة الشح ويجعله يشعر بما يجري على أخيه الإنسان ، فيتحسس بالمسؤولية ، فهذه الخصلة تصلح بينه وبين الناس.
وأما القيام بالسحر ، فهو ارتباط مع عالم الغيب طلباً منه العون في جميع أموره والاستعاذة من الشيطان والنفس الأمارة.
والاستغفار بالأسحار هو القيام آخر الليل والصلاة فيه وطلب الرحمة والمغفرة ، كما فسرته السنة المقدسة بذلك ، وما ورد في الآيات الكريمة بالنسبة إلى السحر على أقسام ثلاثة:
الأول : هذه الآية الشريفة وقوله تعالى : {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 17 - 19].
الثاني : قوله تعالى : {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 16، 17]
الثالث : قوله تعالى : {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] ، والتهجد بالليل هو الاستيقاظ بالعبادة من قراءة القرآن والدعاء والصلاة ونحوها من العبادات ، ويستفاد من الجميع مطلوبية أصل الاستغفار في خصوص هذا الوقت الشريف ، ولها مراتب كثيرة ، منها أن يكون في الوتر من صلاة الليل ، وهي أفضلها وأشرفها ، ومنها أن يكون في ضمن الدعاء والمناجاة ولو كانا في غير الصلاة ، ومنها نفس كلمة : " استغفر الله ربي وأتوب إليه "، ومقتضى الإطلاق مطلوبية الجميع مع اختلاف المراتب.
والاستغفار بالسحر يوجب التوفيق لترك الذنوب في أثناء النهار ، فيكون سبباً لمحو الذنب السابق ، ومقتضيا لترك الذنب اللاحق ، فتستعد نفوس المستغفرين في الأسحار بذلك للاستعانة بأنوار الجلال والاستفادة من فيوضات الرحمن التي لم تزل ولا تزال.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












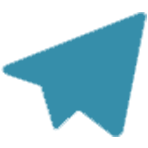
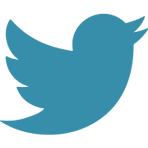

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)