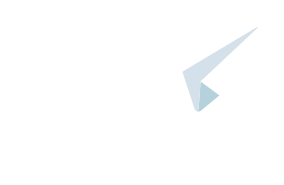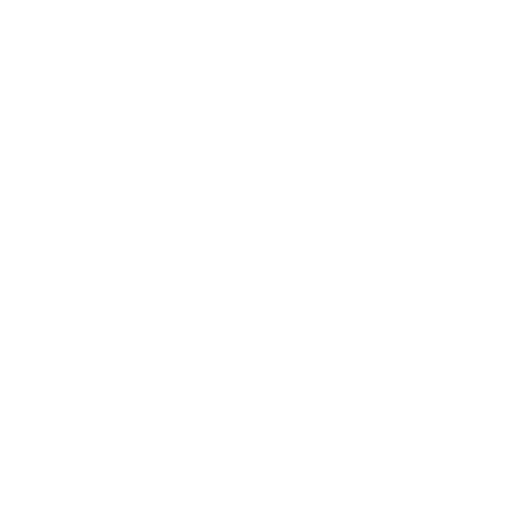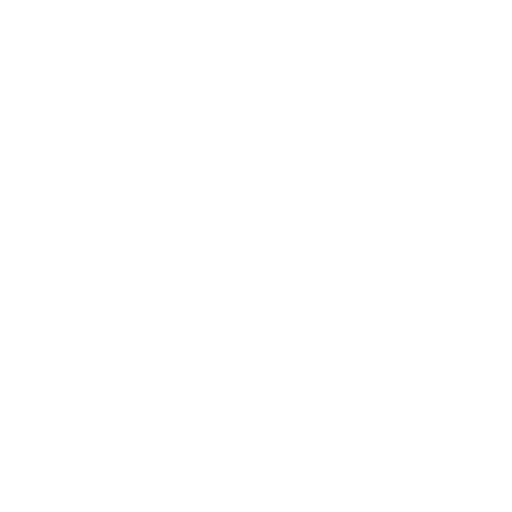الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
بحث مفصّل عن العبادة والدّعاء.
المؤلف:
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
الأخلاق في القرآن
الجزء والصفحة:
ج1 / ص 286 ـ 312
2024-12-07
1902
الخُطوة الأخرى، هي العبادة والدّعاء، ولأجل التّعرف على دور، العِبادة والدّعاء في بناء وتهذيب النّفوس، علينا أولاً التّعرف، على حقيقة ومفهوم العبادة والدّعاء.
الواقع أنّ الحديث عن هذا الموضوع، طويلٌ وعريضٌ، وقد تناوله العلماءُ، العظماءُ، في كتبهم الأخلاقيّة والتفسيريّة والفقهيّة، بصورةٍ مُفصّلةٍ ووافيةٍ، ولكن يمكن القول وباختصار شديدٍ: علينا قبل معرفة حقيقة العبادةِ ومفهومها، أوّلاً أن ندرس مفهوم كلمة «عبد»، وهي الأصل والجَذر اللّغوي، لكلمة: «العِبادة».
«العبُد» لُغة تُطلق على الإنسان، الذي لا حول له ولا قوّة، في مقابِل مولاه، فإرادته تابعةٌ لإرادة مَولاه، ولا يملك شيئاً في عرضِ ما يملكه مولاه، ولا حقَّ له في التّقصير في طاعة سيّده.
وعليه فإنّ العبودية، هي آخر وأقصى مراحل الخُضوع والخُشوع، في مقابل السيّد، حيث إنّ كلّ شيءٍ في حياته يراهُ من هبته وإنعامه وإكرامه، ومن هنا يتبيّن لنا بوضوح، أنّه لا أحد يستحقّ هذه الدّرجة من العِبادة، ويكون مَعبوداً سوى الله تعالى، فهو الفَيض اللّامتناهي الذي لا ينقطع أبداً.
ومن بُعدٍ آخر، أنّ «العُبوديّة»: هي قمّة ونهاية التّكامل المعنوي، للرّوح في حركة التّكامل المعنوي للإنسان، وغايةُ ما يطمح إليه الإنسان، من حالة القُرب من الله تعالى، والتّسليم المُطلق لِلذات المُقدسة، فالعبادة لا تنحصر بالرّكوع والسّجود والقيام والقُعود، بل إنّ روح العِبادة هي التّسليم المطلق لله تعالى، ولذاته المُقدسة والمَنزّهة من كلٍّ عيبٍ ونقصٍ.
ومن البديهي أنّ العبادة، هي أفضل وسيلةٍ للرّقي المعنوي، وتحصيل الكَمال المطلق، في حركة الإنسان والحياة، وتقف حائلاً أمام كلّ رذيلةٍ، فإنّ الإنسان يسعى لِلقُرب من معبوده، لِتَتَجلى في نفسه إشعاعاتٌ من نور قُدسه وجَلاله وجَماله، ويكون مظهراً ومرآةً لصفات الجمال والكَمال الإلهيّة، في واقعه النّفسي وسلوكه العملي.
وفي حديثٍ عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: «العبُودِيّةُ جَوهَرَةٌ كُنْهُها الرُّبُوبِيَّةُ» ([1]).
وهو إشارة لتلك الانعكاسة الربّانية، التي تتجلّى في العبد جرّاء العِبادة الخالصةِ، المنفتحة على الله، حيث يصل بواسطتها إلى درجاتٍ من الرّقي والكمال، بحيث يمكنه معها السّيطرة على الكَون، ويكون صاحبٌ بالولاية التَّكوينيّة، أو هو: كالحديد الأسود، الذي يحمّر جرّاء مجاورته لِلنار، وهذه الحرارة والنّورانية ليست من ذاته، لكنّها من معطيات تلك النار.
ومنها نعود لِلقرآن الكريم، لنستوحي ممّا فيه من آياتٍ حول العبادة، وما لها من دورٍ في تنمية الفضائل الأخلاقية:
1 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)([2]).
2 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)([3]).
3 ـ (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)([4]).
4 ـ (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ)([5]).
5 ـ (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)([6]).
6 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)([7]).
7 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)([8]).
تفسير واستنتاج:
تتحرك الآيات الآنفة الذّكر، لتؤكّد لنا حقيقةً واحدةً، ألا وهي، أنّ كلّ إنسانٍ يريد الوصول إلى الكمال المطلقُ ويتحرك على مستوى تهذيب النّفس، عليه أنّ يسلك طريق العبادة، فالسّائر في خطّ الاستقامة والتّربية، ولأجل أن يبني نفسه، ويحصل على ملكة التّقوى، عليه أنّ يَعبُد ويَدعو الله تعالى، من موقع العِشق والشّوق ليوفقه في ذلك، ويطلب منه العَون، لإزالة شوائب نفسه، لِتّتصل النّقطة بالبحر، ولِتَنْدَكّ ذاته بالذّات الأزليّة، ويتحول نحاس وجوده، في بوتقة العِشق، إلى ذهبٍ خالصٍ.
هنا تحرّكت «الآية الأُولى»، لتخاطب جميع الناس بدون استثناء، أن يسلكوا إلى الله من موقع العِبادة، وأرشدتهم لِطريق التقوى، فقالَ تعالى: (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
والتّأكيد على مسألة الخلقة للأوّلين، لعلها تقع في دائرة تنبيه العَرب الجاهلين، الذين كانوا يستدلون بعبادتهم للأصنام، بسنّة آبائهم، فيقول الباري: إنّنا خلقناكم والجِبلّة الأولين، نعم فهو الخالق والمالك لكلّ شيءٍ ولا يستحق العبادة أحدٌ إلّا هو، وإذا ما توجه الإنسان، حقيقةً نحو الباري تعالى، فستتفتح في جوانحه عناصر الخير والتّقوى، لأنّ ما يوجد من الشّوائب في النفس، إنّما هو بِسبب التّوجه لغير الله، من موقع العبادة الزّائفة.
فهذه الآية تبيّن معالم الرّابطة والعلاقة الوثيقة، بين العبادة التقوى.
وتطرقت «الآية الثّانية»، للحديث عن عبادةٍ مهمّةٍ، وهي الصّوم وعلاقته بالتّقوى، فقال: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
ومن المعلوم أنّ الصّوم يُنوّر القلب ويجلوه، بحيث يحسّ معه الإنسان أنّه يعيش القُرب من الحسنات، والبُعد عن السّيئات والقَبائح، والإحصائيات التي ترد في هذا الشّهر من المصادر المختصّة عن الجرائم، تشير إلى أنّها تصل إلى أدنى مستوى، في شهر رَمضان، وأنّ الشرّطة في هذا الشّهر المُبارك، يتفرّغون للاهتمام بأمور اخرى، إداريّة عالقة بالأشهر الماضية!!.
وهذا الأمر إنّ دلّ على شيءٍ، فهوَ يدلّ على أنّ الإنسان، كلّما اقترب من الله تعالى، في خطّ العبوديّة والطّاعة، فإنّه يبتعد عن الموبقات والآثام، والقبائح بنفس المقدار.
وأشارت «الآية الثّالثة»، إلى علاقة الصّلاة بالنّهي عن الفَحشاء والمنكر، وخاطبت الرّسول الكريم (صلى الله عليه وآله)، باعتباره قدوة واسوة للآخرين، فقالت: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ).
«فالفَحشاء والمنكر»، عبارةٌ عَنْ مجموعة الأفعال غير الأخلاقيّة، التي تنبع وتنشأ من الصّفات الأخلاقيّة، والنّزعات الشّريرة الموجودة في مطاوي النّفس البشرية، حيث تؤثّر بدورها في سلوك الإنسان، وتفرز الأخلاق الظاهريّة لَه، و «الصّلاة» تمثّل أَداةَ ردعٍ لتلك الأخلاق المنحرفة، في دائرة السّلوك، لأنّ الأذكار والأدعية، تعمل على تهذيب النّفس، وترويضها وتطويعها في طريقِ الخَير والصّلاح، وحالة القُرب من الباري تعالى، هذه هي التي تتولى إبعاد الإنسان عن منبع الشّر والرّذيلة، الذي هو عبارةٌ عن هوى النّفس وحبّ الدنيا، من خلال الانفتاح على آفاق المَلكوت، لِتَغرف نفسه من أنوار القُدس، وترتفع به إلى عالم الخلودِ والكَمالِ المُطلق.
فالمصلّي الحقيقي سيبتعد عن الفحشاء والمنكر لا مُحالة، لأنّ الصّلاة والعِبادة تَصون النّفس من المنكرات، وتحول دون إختراق الرذائل للنّفس الإنسانية، وتعمل على تَفعيل عناصر الخَير، في أعماق الوِجدان.
وتحدّثت «الآية الرابعة» عن حالة الجَزع والبخل، اللّذان هما من السجّايا الوضيعة في واقع الإنسان، وخُصوصاً الجَزع في حالة سيطرة المشكلات والشّرور، والبُخل في حالة انفتاح أبواب الثّراء أمام الإنسان، واستثنت الآية المصلّين، وقالت: (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ).
فهذه الآيات الكريمة، تبيّن لنا بصورِةٍ جيدةٍ، أنّ التّوجه لله تعالى، والسّير في خطّ العبادة والدُّعاء والمناجات، له دورٌ هامّ في مَحو الرّذائل الأخلاقيّة، من قبيل البُخل والجّزع من واقع النّفس.
وتشيرُ «الآية الخامسة»، إلى تطهير النّفس، بواسطة «الزّكاة»، والتي بدورها تُعتبر، من العبادات الإسلامِيَّةِ المُهِمَّةِ، في ديننا الحنيف، فتقول: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها).
وجُملة: (تُزَكِّيهِمْ بِها)، هي دليلٌ واضحٌ على هذه الحقيقة، وهي أنّ الزّكاة تعمل على تطهير النفس، من البَخل والحِرص وحُبِّ الدنيا، وتزرع في نفسه صفة الكرم، وحبّ الخير لِلناس، وتثير في نفسه الحركة، على مستوى حمِاية الفقراء والمحتاجين.
وما ورد من روايات في هذا الصدد، تبيّن هذه الحقيقة أيضاً، ومنها الحديث النبوي الشريف: «ما تَصَدَّقَ أَحَدُكُم بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ـ وَلا يَقْبَلُ اللهُ إلّا الطّيِّبَ ـ، إلّا أَخَذَها الرَّحمانُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كانَتْ تَمْرَةً فَتَربُو مِنْ كَفِّ الرَّحمانِ في الجِنان حَتّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ» ([9]).
هذا الحديث الشّريف يبيّن تلك العلاقة الوثيقة المباشرة، بين هذه العبادة المهمّة وبين توطيد العلاقة مع الله تعالى، وتفعيل الحالات المعنوية في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي.
وتتحرك «الآية السّادسة»، من موقع الإشارة إلى عبادة مهمّةٍ اخرَى، وهي عبادة: «الذِّكر»، للهِ تعالى، وما لَها من دورٍ في بعث الطّمأنينة، في واقع الرّوح فتقول: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).
فالطّمأنينة تقترنُ دائماً مع التّوكل على الباري تعالى ؛ وعدم الوقوع في أسر الماديّات والامور الدنيويّة، من الانخداع بِبَريق الدُنيا، والطّمع والبُخل والحَسد وما شابهها من الامور، فَمع وجود هذه الحالات السّيئة في واقع النفس، فسوف لن يذوق الإنسان معها الرّاحة والطّمأنينة.
وعليه، فإنّ ذكر الله تعالى بإمكانه إزالة هذه الصّفات السّلبية عن القلب، وتطهير النّفس منها لِتَتَهيأ الأرضيّة المساعدة، في تَفتّح براعم السّكينة والطّمأنينة في واقع القلب والرّوح.
أو بتعبيرٍ أدق، إنّ جميع الاضطرابات الرّوحية، وأشكال القلق النّفسي، في واقع الذّات البشريّة، ناشئة من هذه الرّذائل الأخلاقيّة، وستزول وتقلع جذورها بذكر الله، الذي يعمل على تسكين روح الإنسان، وتجفيف مصادر القلق هذه، لِتحل محلّها السّكينة والهدوء النّفسي ([10]).
وأخيراً تناولت «الآية السّابعة»، دور الصّلاة والصّيام في رفع المعنويات، وتقوية عناصر الخير في وجدان الإنسان: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).
وقد فسّرت بعض الرّوايات الإسلاميّة الصّبر بالصيام ([11])، من حيث كون الصّوم أحد المَصاديق البارزة لِلصبر، وإلّا فالصّبر له مفهومٌ وسيعٌ يشمل كلّ أنواع المُقاومة، والتّحدي لِلأهواء النّفسانية والوساوس الشيطانية، في طريق طاعة الله تعالى، وكذلك تَستوعب الآية حالة الصّبر على المصائب والمحن، التي تصيب الإنسان في حركة الواقع.
وقد وَرد في حديثٍ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه كلّما أهمّه شيءٌ اندفع مُسرعاً نحو الصّلاة، وبعدها يتلو هذه الآية ثلاث مرّاتٍ: «كانَ عَليٌّ (عليه السلام) إذا أَحالَهُ أَمْرٌ فَزِعٌ قامَ إِلى الصَّلاةِ ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيةَ: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)» ([12]).
نعم فإنّ العبادة ترسخ في النّفس محاسنها، وتصقلها وتعمل على تفعيل عناصر الخير فيها، من: التّوكّل والشّهامة والصّبر والاستقامة، وتستأصل الرّذائل الأخلاقيّة من قَبيل: الجُبن والشّك والاضطراب والتّوتر الناشئ من حالات الصّراع، وحبّ الدنيا وتزيحها عن واقع النّفس، وبهذا تحيي العبادة في واقع النّفس، شطراً مُهمّاً من الفضائل الأخلاقية، وكذلك تقوم بإلغاء الكثير من عناصر الشّر، وقوى الانحراف والرّذيلة من وجود الإنسان.
النّتيجة:
نستنتج ممّا ذُكر آنفاً: أنّ العِبادة لَها دورها الفاعل، والعميق في تَهذيب الأخلاق، ويمكن تَلخيص هذا المعنى في عدّة نقاط:
1 ـ إنّ التوجه لِلمبدأ، والإحساس بحضور الله تعالى، مع الإنسان في كلّ وقتٍ ومكانٍ، يدفع الإنسان نحوَ المزيد من مُراقبة أعماله وحركاته وسكناته، ويُساعده على السّيطرة على ميوله الذّاتية، وأهوائه النفسيّة، لأنّ العالم محضر الله، والمعصية في حال الحضور، تمثّل الانحراف عن خطّ الحقّ، وبالتّالي فهي عين الوقوع في لُجّة الكُفران للنعمة.
2 ـ إنّ التّوجه لصفات جَلاله وجَماله، التي وردت في العبادات والأدعية، يثير في نفس الإنسان حالةً من لُزوم الاقتباس، من تلك الأنوار القُدسيّة، ويعيشها في واقعه الرّوحي، ليسير في طريق التّكامل الأخلاقي.
3 ـ التّوجه للمَعاد والمحكمة الإلهيّة العظيمة في يوم القيامة، يمثّل أداةً فاعلةً لتطهير وتزكيّة النّفس، خوفاً من العقاب والحِساب في غدٍ.
4 ـ العِبادة والدّعاء، تضفي على الإنسان هالاتٍ من النّور لا توصف، فلا تستطيع معها ظُلمات الرّذيلة أن تقف أمامها، فيحسّ الإنسان بالقُرب الإلهي، وصفاء الضّمير بعد كلّ عبادةٍ، شريطَة أن تكونَ مقرونةً بحضور القلب.
5 ـ إنّ مضامين العبادات والأدعية، غنيٌّ جدّاً بالتّعاليم والآداب الأخلاقيّة، فهي ترسمُ الطّريق لِلسالك نحو الله تعالى، وهي في الحقيقة دروسٌ قيّمةٌ، توصل الإنسان السّالك لِهدفه السّامي، من أقصر طريقٍ، وبدونِ العبادة والمُناجاة، وخاصّةً في حالات الخَلوة مع الله، تعالى ولا سيّما في وقت السّحر، فسوف لن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة.
تأثير العبادة في صقل الرّوح في الرّوايات الإسلاميّة:
لهذه المسألة، صَداً وَاسعاً في الرّوايات الإسلاميّة، ونشير إلى بعضٍ منها، تاركين التّفاصيل إلى البحوث الموسّعة:
1 ـ أشارت جميع الرّوايات الإسلاميّة، التي تناولت فلسفة الأحكام، إلى دور العبادة في تَهذيب النّفوس وصفاء القلوب، فقال الإمام علي (عليه السلام)، في قِصار كلماته: «فَرَضَ اللهُ الإِيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّركِ، والصَّلاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الكِبْرِ وَالزَّكاةَ تَسبِيباً لِلرِّزْقِ وَالصِّيامَ ابتلاء لِإِخلاصِ الخَلْقِ» ([13]).
وَوَرد نفس هذا المعنى، مع اختلاف بسيطٍ في خُطبة الزّهراء (عليها السلام) فإنّها تقول: «فَجَعَلَ اللهُ الإِيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّركِ، والصَّلاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الكِبْرِ وَالزَّكاةَ تَزكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَماءً في الرِّزْقِ وَالصِّيامَ تَثبيتاً لِلإِخلاصِ» ([14]).
2 ـ ويشبّه الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) الصّلاة بنهرٍ جاري، يتولى تطهير البدن كلّ يومٍ خمس مرّاتٍ، حيث يقول: «إِنّما مَثلُ الصَّلاةِ فِيكُم كَمَثلَ السّري ـ وهو النهر ـ عَلى بابِ أَحَدِكُم يَخرُجُ إِلَيهِ في اليَومِ وَاللَّيلَةُ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمسُ مرّاتٍ، فَلا يَبْقى الدَّرنُ عَلَى الغَسلِ خَمْسُ مرّاتٍ، وَلَم تَبْقَ الذُّنُوبُ عَلى الصَّلاةِ خَمسُ مِّراتٍ» ([15]).
وعليه فقد ذكرت هذه الرّوايات، لكلّ عبادةٍ: دوراً خاصّاً في عمليّة تهذيب النّفوس الإنسانيّة.
3 ـ وَوَرد في حديثٍ آخر عن الإمام الرضا (عليه السلام)، يشرح فيه السّبب، الذي شرّع الله تعالى بِسَببِه العبادة، فيقول: «فَإنْ قالَ فَلِمَ تَعبَّدَهُم؟ قِيلَ لِئَلا يَكُونُوا ناسِينَ لِذِكْرِهِ وَلا تارِكِينَ لِأَدَبِهِ وَلا لاهِينَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيهِ إِذا كانَ فِيهِ صَلاحُهُم وَقِوامُهُم، فَلَو تُرِكُوا بِغَيرِ تَعَبُّدٍ لَطالَ عَلَيهِم الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم» ([16]).
فيتّضح من ذلك أنّ العبادة، تجلو القلب وتُبلوِر الرّوح وتَحثّ على ذكر الله تعالى، الذي هو مدعاة لإصلاح الظاهر والباطن.
4 ـ وَوَرد في حديث آخر، عن الإمام الرّضا (عليه السلام)، وفي مَعرض حديثه لإحصاء فوائد الصّلاة، أنّه قال: «مَعَ ما فِيهِ مِنَ الإِيجابِ وَالمُداوَمَةِ عَلى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ لِئَلا يَنْسَى العَبْدُ سَيِّدَهُ وَمُدَبِّرَهُ وَخَالِقَهُ، فَيَبْطُرَ وَيَطْغى وَيَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَقِيامِهِ بَينَ يَدَيهِ زاجِراً لَهُ عَنِ المَعاصِي وَمانِعاً لَهُ عَنْ أَنْواعِ الفَسادِ» ([17]).
5 ـ وَوَرد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، في دور الصّلاة وميزان قبولها، أنّه قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ قُبِلَتْ صَلاتُهُ أَمْ لَم تُقْبَلْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْ صَلاتُهُ عِنَ الفَحشاءِ وَالمُنْكَرِ، فَبِقَدَرِ ما مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ» ([18]).
فهذا الحديث يُبيّن بوضوح، أنّ صحّة الصّلاة وقبولها، لها علاقةٌ طرديّةٌ بالأخلاق والدّعوة إلى الخير وترك الشّر، ومن لم تؤثّر صلاته، في تفعيل عناصر الخير والصّلاح في وجدانه، فعليه أن يعيد النّظر فيها حتماً، لأنّها وإن كانت مسقطة للتكليف، إلّا أنّها غير مقبولةٍ لدى الباري تعالى.
6 ـ وفي فلسفة الصّيام، قال الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله):
«إِنَّ الصَّومَ يُمِيتُ مُرادَ النَّفْسِ وَشَهْوَةَ الطَّبْعِ الحَيوانِي، وَفِيهِ صَفاءُ القَلْبِ وَطَهارَةِ الجَواحِ وَعَمارَةُ الظَّاهِر وَالباطِنِ، وَالشُّكْرُ عَلَى النِّعَمِ، وَالإِحْسانِ إِلى الفُقَراءِ، وَزِيادَةُ التَّضَرُّعِ وَالخُشُوعِ، وَالبُكَاءِ وَجَعَلَ الالتجاء إِلى اللهِ، وَسَبَبُ انكسار الهِمَّةِ، وَتَخْفِيفِ السَّيِّئاتِ، وَتَضعِيفِ الحَسَناتِ وَفِيهِ مِنَ الفَوائِدِ ما لا يُحْصى» ([19]).
فقد ذكر هذا الحديث الشّريف، أربعة عشر صفةً إيجابيةً للصّوم في واقع النّفس، وهي مجموعةٌ من الفضائل والأفعال الأخلاقيّة، تصعد بالإنسان في مدارج الكمال المعنوي والإلهي.
7 ـ ونختم هذا البحث الواسع، بحديثٍ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «دَوامُ العِبادَةِ بُرهانُ الظَّفَرِ بِالسَّعادَةِ» ([20]).
ومن أراد التّفصيل أكثر فليراجع: «وسائل الشّيعة»، الأبواب الاولى من العِبادات، وكذلك ما ورد في: «بحار الأنوار».
نعم فإنّ كلّ من يطلب السّعادة، عليه أن يتحرك باتجاه توثيق العلاقة مع الله تعالى، من موقع الدّعاء والعبادة.
النّتيجة:
نستنتج من هذه الرّوايات الشّريفة التي أوردناها، والاخرى التي أَعْرضنا عنها للاختصار، أنّ علاقة العبادة بصفاء الرّوح، وتهذيب النّفوس، وتفعيل القيم الأخلاقيّة في واقع الإنسان، علاقةٌ طرديّةٌ، وكلّما تحرّك الإنسان في عبادته، من موقع الإخلاص لله تعالى، كان أثرها في نفسه أقوى وأشدّ.
وهذا الأمر محسوس جدّاً، فالمخلص الذي يؤدي عبادته بحضور قلبٍ، فإنّه يحسُ بالنّور والصفاء في قلبه، والميل إلى الخير والنّزوع عن الشّر، ويجد في روحه العبوديّة والخشوع والخضوع الحقيقي، باتجاه خالقه وبارئه.
وهذا الأخير في الحقيقة هو العامل المشترك بين جميع العبادات، وإن كان لكلّ منها تأثير خاص على النفس، فالصّلاة تنهى عن الفَحشاء والمنكر، والصّيام يقوّي الإرادة وينشط العقل، لِيْسيطر على جميع نوازع النّفس، والحج يمنح الإنسان بُعداً معنوياً، يجعله بعيداً عن زخارف الدّنيا وزبرجها، والزّكاة تقمع البخل في واقع النّفس، وتقضي على أشكال الطّمع والحرص على الدنيا.
وذِكر الله يهدّئ الرّوح، ويمنحها الطّمأنينة والرّاحة، وكلّ ذكرٍ من الأذكار، تتجلّى فيه صفةٌ من صفاتِ جَلاله وجَماله سبحانه وتعالى، التي تتولّى ترغيب الإنسان في السّلوك إلى الله، والانسجام مع خطّ الرّسالة.
وعليه فإنّ الشّخص الذي يؤدّي العبادة على أتمّ وجهٍ، سينتفع من فوائدها في دائرة المعطيات العامة، وكذلك تمنحه العبادات آثارها الإيجابيّة الخاصّة، بما يحقّق له بلورة فضائله الأخلاقيّة، وملكاته النفسانيّة في واقع وجوده، فالعِبادة تشكّل الخطوة والحجر الأساس، لبناء النّفس، في خطّ التّقوى والإيمان، والانفتاح على الله، شَريطة الانس بمثل هذه المعاني الروحيّة، والتّعرف على فلسفة العبادة، فلا ينبغي أن نقنع بالمحافظة على قوى الجسم وحده، ولأهميّة مَبحث الذّكر خصّصنا له بَحثاً مُستقلًّا عن باقي البحوث.
ذِكر الله وتربية الرّوح:
أعطى علماء الأخلاق، الأهميّة القُصوى لِلذكر، وذلك تبعاً لما ورد، في الرّوايات الإسلاميّة والقرآن الكريم، واعتبروه من العناصر المهمّة في خطّ العبادة، وتطهير النّفس وتهذيبها، وذكروا لكلّ مرحلةٍ من مراحل السّير والسّلوك، الذّكر الخاص بها.
فمثلاً في مرحلة التّوبة، ينبغي للسالك في طريق الحقّ، الاهتمام بِذِكر: «يا غَفّار»، وفي مرحلة محاسبة النّفس: «يا حَسيب»، وفي مرحلة استنزال الرّحمة: «يا رحمان» و «يا رَحيم» ... وَهَلُمَّ جرّا.
وهذه الأذكار تتناسب وحالات الإنسان، والسّلوك الذي يسلكه الإنسان في خطّ الاستقامة، والالتزام بها على كلّ حالٍ حسنٍ، ولا تختص بعنوان: قصد الوُرود إلى ساحة الرّحمة الإلهيّة.
نعم فإنّ ذكر الله تعالى، من أكبر العبادات وأفضل الحسنات، في عمليّة التّصدي للتحديات النّفسية الصّعبة، وتحقيق الصّيانة من الوساوس الشّيطانية.
ذكرُ الله، يخرق حُجب الأنانيّة والغرور والنّوازع النّفسانية، التي تُعدّ من أَقوى العوامل، لِهَدم سعادة الإنسان، ويمنح الإنسان وعياً في أجواء السّلوك إلى الله تعالى، من الأخطار التي تهدّد سعادته، ويرسم له معالم مسيرته في حركة الحياة والواقع.
ذكر الله تعالى: هو المطر الذي ينزل على أرض القَلب، لِيسقي بذور التّقوى والفضيلة، ويعمل على تقويتها وتنميتها. والحقيقة أنّ المحاولة للإحاطة بعظمة هذه العبادة، وإحصاء معطيّاتها على مستوى تهذيب النّفس، لا تفي بالغرض، ولا تحيط بأهميتها في خطّ السّلوك المعنوي للإنسان.
بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، لنستوحي من آياته، أهميّة ذكر الله تعالى:
1 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»)([21]).
2 ـ (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ)([22]).
3 ـ (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)([23])
4 ـ (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي)([24]).
5 ـ (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً)([25]).
6 ـ (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»)([26]).
7 ـ (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا)([27]).
8 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً* هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً)([28]).
9 ـ (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ)([29]).
10 ـ (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ)([30]).
تفسير واستنتاج:
«الآية الاولى»: تطرّقت للحديث عن دور ذكر الله تعالى، في خلق حالة الطّمأنينة في القلوب ؛ لِتتولّى إنقاذ الإنسان من حالات الزلّل والتّوتر، وتوجهه فيها إلى تحقيق الفضائل الأخلاقية في واقع النّفس، فيقول تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ).
ثمّ يبيّن قاعدةً كليّةً، تقول: (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).
فما يجول في خاطر الإنسان وخُلدِه، من الحُزن من المستقبل والتّفكير بالرّزق، والموت والحياة والمرض وما شابهها من امور الدنيا، كلّها تدفع الإنسان للتّفكير الجاد في مصيره، وتسلب منه الرّاحة النّفسية، وتَورثه القلق الحقيقي نحو المستقبل المجهول.
وكذلك عناصر: البخل والطّمع، والحرص، هي أيضاً من الامور التي تزرع القلق والتّوتر في نفس الإنسان، ولكن عند ما يتجسّد ذِكر الله الكريم، الغني القوي، الرّحمن الرّحيم، الرزّاق في وعي الإنسان، ويعيش الإيمان بأنّ الله تعالى، هو الواهب والمانع الحقيقي، فعند ما تَتَجسّد هذه المعاني والمفاهيم، وتتفاعل مع بعضها في واقع الإنسان في حركة الحياة، فسوف يعيش الإطمئنان، والسّكينة أمام تحدّيات الواقع، فكلّ شيءٍ يراه مسيّراً لقدرة الله تعالى وإرادته المطلقة، وما شاء كانَ وما لَمْ يَشأ لم يكن.
وبهذا سيطمئن الإنسان، ويسلّم أمره إلى بارئِه، وستزرع في نفسه حالة التّقوى وحبّ الفضائل، وهو ما نَقرأه في الآية الشّريفة:
(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً* فَادْخُلِي فِي عِبادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي)([31]).
وتحركت «الآية الثّانية»، بعد ذكرها لمعطيات الصّلاة، على مستوى النّهي عن الفحشاء والمُنكر: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)، إلى تقرير هذه الحقيقة وهي: (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ).
نعم، فإنّ ذكر الله هو روح الصّلاة، والرّوح أشرف شيءٍ في عالم الوجود، فإذا ما منَعت الصّلاة عن الفحشاء والمُنكر، فإنّما ذلك بسبب تضمّنها لذكر الله، لأنّ ذكر الله هو الذي يذكّر الإنسان بالنّعم، التي غرق بها الإنسان في واقع الحياة، وتذكّر نِعم الله، بِدوره يمنع الإنسان من العصيان والطّغيان، وسيخجل من ارتكاب الذّنوب، هذا من جهةٍ.
ومن جهةٍ اخرى، سيدعو الإنسان للتّفكير بيوم القيامة، الذي لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، ويوم تنشر الصّحف وتَتطاير الكُتب، ويعيش المُسيئون الفضيحة والعار، في انتظار ملائكة العذاب التي تأخذهم إلى الجحيم، ويكتب الفوز والنّصر للمحسنين، وسيكون في استقبالهم ملائكة الرّحمة الذين يقولون لهم، ادخلوها بسلامٍ آمِنين، فذِكر هذه الامور، وتجَسيدها في وعي الإنسان، سيدفع إلى التّوجه نحو الفضائل، ويمنعه من مُمارسة الرّذيلة والإثم.
وقال بعض المفسّرين، إنّ جُملة: (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ)، إشارةً إلى أنّ ذِكر الله تعالى، هو أسمى وأرقى العبادات، في مسيرة الإنسان المعنويّة.
ويوجد احتمال آخرٌ، وهو أنّ المقصود من: (وَلَذِكْرُ اللهِ)، هو ذِكر الله لِعبده، (وذلك في مقابل ذكر العبد لله تعالى) ([32]).
حيث يصعد ذكر الله تعالى به، إلى أسمى وأعلى درجات العبوديّة، في آفاقها الواسعة، ولا شيء أفضل من هذه الحالة المعنويّة للإنسان، ولكنّ الاحتمال الأوّل، يتناسب مع معنى الآية أكثر.
«الآية الثّالثة»: ذكرت أوّل كلامٍ لله تعالى، مع نبيّه موسى (عليه السلام)، في وادي الطّور الأيمَنِ، في البُقعة المباركة عند الشّجرة، فسمع موسى (عليه السلام) النداء قائلاً: (إِنَّني أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاٌعْبُدْني وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي).
والحقيقة أنّ الآية ذكرت، أنّ الهدف والفلسفة الأصليّة للصّلاة، هي ذكر الله تعالى، وما ذلك إلّا لأهميّة الذّكر، في حركة الإنسان المنفتحة على الله تعالى، وخُصوصاً أنّها ذكرت مسألة الصّلاة، وذكر الله بعد بحث التّوحيد مباشرةً.
«الآية الرابعة» خاطبت الأخوين موسى وهارون (عليهما السلام)، من موقع نَصبهما لِمقُام النّبوة والسّفارة الإلهيّة، وأمرتهما بمحاربة قوى الانحراف والزّيغ، والتّصدي لفرعون وأعوانه: (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي).
فالأمر بذكر الله تعالى وعدم التّواني فيه، لِلوقوف بوجه طاغية: مثلَ فِرعون، هو أمرٌ يحكي عن دور الذّكر وأبعاده الوسيعة، وأهميّته الكبيرة في عمليّة السّلوك إلى الله تعالى، فذِكر الله يمنح الإنسان عناصر القّوة والشّجاعة، في عمليّة مواجهة التّحديات الصّعبة، لِلواقع المُنحرف.
وَوَرد في تفسير: «في ظِلال القرآن»، في مَعرض تفسيره لهذه الآية، قوله: (إنّ الله تعالى أمر موسى وهارون (عليهما السلام)، أن اذكروني، فإنّ ذِكري، هو سِلاحكم ووسيلتكم لِلنجاة» ([33]).
وبعض المفسّرين فسّروا كلمة «الذّكر»، الواردة في الآية، بإبلاغ الرّسالة، وقال البعض الآخر، أنّها مطلق الأمر بالذّكر، وقال آخرون: إنّها ذِكر الله تعالى خاصّةً، والحقيقة أنّه لا فرق بين التّفسيرات الثّلاثة، ويمكن أن تجتمع كلّها في مفهوم الآية.
ومن المعلوم أنّ الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولأجل أن يستمر في إبلاغ الرّسالة، والتّحرك في خطّ الطّاعة والتّصدي لقوى الباطل والانحراف، عليه أن يستمد القوّة والقدرة من ذكر الله تعالى، والتّوجه إليه في واقع النّفس والقلب.
وتناولت «الآية الخامسة»، إفرازات ونتائج، الإعراض عن ذكر الله تعالى في حركة الإنسان، قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى).
فعذابهم بالدّنيا أنّهم يعيشون ضنك العيش، وفي الآخرة العمى، وفَقد البَصر!.
فضنك العيش، ربّما يكون بتضييق الرّزق على من يعيش الغفلة عن ذكر الله تعالى، أو ربّما بإلقاء الحرص على قلب الغني، فيتحرك في تعامله مع الآخرين، من مَوقع الطّمع والبُخل، فلا يكاد يُنفق درهماً في سبيل الله، ولا يعين فقيراً ولو بشقّ تَمرةٍ، فيكون مِصداق حديث أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث يقول: «يَعِيشُ فِي الدُّنيا عَيْشَ الفُقَراءَ وَيُحاسَبُ فِي الآخِرَةِ حِسابَ الأَغِنياء» ([34]).
ففي الحقيقة أنّ أغلب الأغنياء وبسبب حرصهم الشّديد على النّفع المادي، يعيشون في حالة قلقٍ دائمةٍ، ولا ينتفعون من أموالهم بالقدر الكافي، وتكون عليهم حسرات في الدّنيا والآخرة.
ولكن لماذا يُحشر أعمى؟
وَلَربّما لِتشابُه الأحداث هناك، مع الأحداث في الدنيا، فالغافل عن ذكر الله تعالى في الدنيا، ولإعراضه عن الحقيقة وآيات الله تعالى، وتَجاهله لدواعي الحقّ والخير في باطنه، فإنّه لا يرى الحقّ بعين البصيرة، في حركة الحياة والواقع، ولذلك سوف يُحشر أعمى في عَرصات القِيامة.
كيف يكون ذِكر الله؟
فسّرت الكثير من الرّوايات الإسلاميّة، ذِكر الباري تعالى: «بالحج»، وَوَرد في البعض الآخر، أنّ الذّكر هنا: بمعنى الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام).
والحق أنّ الإثنين هما مِصداقان من مَصاديق ذكر الله تعالى، فالحجّ هو مجموعةٌ من الأعمال والسّلوكيات، تذكّر بالله تعالى، وكذلك علي (عليه السلام)، فذِكره والنّظر إليه عبادةٌ، تُعمّق في الإنسان روح الإيمان، وتُذكّره بالله تعالى.
«الآية السّادسة»: خاطبت الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، من موقع النّهي عن طاعة الأشخاص الذين يعيشون في غفلةٍ، وحثّته على معاشرة الّذين يذكرون ربّهم، صباحاً وبِالغَداة والعَشِي، ولا يريدون إلّا الله تعالى، فقال تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً).
ومن المعلوم أنّ الله سبحانه وتعالى، ما كان ليعذّب أحداً بالغفلة عن ذكره، بل لأنّ مثل هؤلاء الأشخاص، ينطلقون في تعاملهم مع الحقّ، من موقع العناد والّتمرد والتّكَبّر والتعصّب لِلباطل.
وبناءاً عليه، فإنّ القصد من الإغفال هو سلب نعمة الذّكر منه، لِيلاقي جزاءه في الدّنيا قبل الآخرة، ولهذا، فإنّ ذلك لا يستلزم الجَبر.
ولا نرى أحداً من هذه الجماعة، إلّا مُتّبعاً لِهواه، مُتّخذاً سبيل الإفراط والتَّفريط في كلّ فعاله، لذلك تعقّب الآية قائلةً: (وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً).
ويُستفاد من هذه الآية، أنّ الغفلة عن ذِكر الله تعالى، تؤثّر سلباً في أخلاق وروح الإنسان، وتُؤدّي به إلى وادي الأهواء، وتجرّه إلى منحدرِ الأنانية.
نعم، فإنّ روح وقلبَ الإنسان، لا يسع اثنان، فإمّا «الله تعالى»، وإمّا «هوى النّفس»، ولا يمكن الجمع بينهما.
فالهَوى هو مصدر الغَفلة عن الله تعالى، وخلقه، وسَحق جميع القِيم والاصول الأخلاقية، وبالتّالي فإنّ هَوى النّفس، يغرق الإنسان في عُتمة ذاته الضّيقة، ويُعمي بصره عن كلِّ شيءٍ يدور حوله في واقع الحياة، والإنسان الذي يتحرّك من موقع الهَوى، لا يرى إلّا إشباع شَهواته، ولا مفهوم عنده لمفاهيم أخلاقيّة، مِثلَ: صلة الرحم وَالمُروّة والإيثار.
«الآية السابعة»: خاطبت الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أيضاً، من موقع التّحذير، عن مُخالطة المُعْرِض عن ذِكر الله تعالى، فقالت: (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا).
في تفسير «ذِكر الله»، قال البعض: أنّ المراد منها في هذه الآية، هو القرآن الكريم، واعتبرها البعض الآخر، إشارةً لِلأدلّة العقليّة والمنطقيّة، وقال آخرون، أنّها الإيمان، والظّاهر أنّ ذكر الله تعالى، له مفهومٌ واسعٌ يشمل كلّ ما ذُكر آنفاً.
وذَكر آخرون، أنّ هذه الآية تدعو لترك جهاد هؤلاء، ولهذا السّبب، نُسخت بآيات الجهاد التي نزلت بعدها، والحقّ أنّه لا نَسخ في البَيّن، وكلّ ما في الأمرِ، أنّها تمنع من مُجالسة الغافلين عن ذِكر الله تعالى، ولا مُنافاة بينها وبين مسألة الجهاد بشرائطها الخاصة.
وأخيراً تبيّن هذه الآية، العلاقة والرّابطة الوثيقة بين: «حبّ الدنيا» و «الغفلة عن ذِكر الله»، فكَما أنّ ذِكر الله تعالى له خصائصه، ومعطياته الإيجابية على الإنسان، على مستوى تَقوية عناصر الفضيلة وترشيد القيم الأخلاقيّة، فكذلك الغفلة لها آثارها، ونتائجها السلبيّة على روح الإنسان، على مستوى تقوية عناصر الشّر والرذيلة فيها.
«الآية الثّامنة»: خاطبت جميع المؤمنين، ودعتهم إلى ذِكر الله تعالى، والخروج من دائرة الظّلمات إلى دائرة النّور، فتقول: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً* هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً)».
والجدير بالذّكر في هذا الأمر، أنّ الآية الكريمة، بعد الأمر بالذّكر الكثير، والتّسبيح له بكرةً وأصيلاً، تخبرنا عن أنّ الله تعالى، سيصلّي هو وملائكته علينا، ويخرجنا من الظّلمات إلى النّور، ألَيسَ ذلك هو هدفنا في حركة الحياة، أَلَيس ذلك هو مُبتغانا من الإلتزام في خطّ الرّسالة، وكلّ ما نريده هو، أنّ الذّكر وصلاة الربّ والملائكة علينا، سيزرع فينا روح التّوفيق لِلطاعة والسّير في طريق الخَير، ويقلع من واقعنا بذور الشرّ، وجذور الفساد، ولتحل محلّها عناصر الفَضيلة والنّسك والأخلاق الحميدة؟!.
وقد وَرد في تفسير الميزان، أنّ ذيل الآية الكريمة، هو بِمنزلة التبيّن لعلّة الأمر، ب: «الذّكر الكثير»، وهو يؤيّد ما أشرنا إليه آنفاً ([35]).
وقد وَردت تفاسيرٌ مختلفةٌ، وآراءٌ مُتغايرةٌ لعبارة: «الذّكر الكثير»، فقال بعضهم، أن لا يُنسى الله تعالى في كلّ وقتٍ ومكانٍ.
وقال بعضٌ آخرٌ أنّه الذّكر والتّسبيح، بأسماء وصفات الله الحُسنى.
وذكرت روايات اخرى، أن المقصود به، هو التّسبيحات الأربعة، أو تسبيح الزّهراء (عليها السلام).
وقال إبن عباس: كلّ أوامر الله تعالى تنتهي إلى غايةٍ ما، إلّا الذّكر فلا حدّ له أبداً، ولا عُذر لتاركه أبداً.
وعلى كلّ حالٍ، فإنّ «الذّكر الكثير»، له مفهومٌ واسعٌ، ويمكن أن يجمع بين طيّاته كلّ ما ذكر آنفاً.
أمّا ما ذكر من، «الظّلمات» و «النّور» في هذه الآية، فما المقصود منه؟.
اختلفوا في تفسيرها أيضاً، فقال البعض أنّها الخُروج من ظلمات الكفر إلى الإيمان، وقال الآخرون، أنّها الخروج من ظلمات عالم المادة، إلى نور الأجواء المعنويّة والرّوحانية، وقال بعضٌ آخر، إنّها الخروج من ظلمات المعصية إلى نور الطّاعة، ولا تَنافي في البَين هنا.
إضافةً إلى أنّها، تشمل الخروج من ظلمات الرّذائل الأخلاقيّة إلى نور فضائلها، وهي أهمّ معطيات ذِكر الله جلّ شَأنه.
«الآية التّاسعة»: حذّرت المؤمنين من نتائج مُعاقرة الخَمرة والقِمار، فقال تعالى: (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ).
فذكرت هذه الآية، ثلاثة مفاسد لِشرب الخمر والمقامرة:
إيقاع العداوة بين النّاس، والردع والصدّ عن ذكر الله، وعن الصّلاة، ويستفاد من ذلك أنّ ذكر الله، كالصّلاة والمحبّة بين النّاس، أمرٌ ضروري وحياتي للإنسان في واقعه النّفسي، والحِرمان منه، يعتبر خَسارةً كُبرى لا تُعوّض.
بالإضافة إلى أنّه يستفاد من جوِّ الآية، وجود علاقةٍ بين: «الغفلة عن ذِكر الله، والصّلاة»، و «ظهور العداوة والشّحناء والمفاسد الأخلاقيّة الاخرى»، وهذا هو بيت القصيد، وما نُريد التّوصل إليه.
وفي «الآية العاشرة»: والأخيرة، إشارةٌ إلى رجالٍ، أحاطهم الله تعالى بأنوارِ قُدسه، في بيوتٍ ليس فيها إلّا ذِكرُه وتَسبيحُه والتّقديسُ له، وهي الآية: (36 و 37) من سورة النّور، فقالت: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ، * رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ ...).
وبناءً عليه، فإنّ أوّل خُصوصيات الرّجال الإلهيين: هو المُداومة على ذِكر الله في أي وقتٍ وفي كلّ مكانٍ، حيث لا تغرّهم الدّنيا، بغرورها وزخارفها وملاهيها الجميلة الخدّاعة، وهو أسمى إفتخار يعيشونه في واقعهم.
ثم تذكر الآية، خصوصيّات اخرى، لهؤلاء المؤمنين في دائرة السّلوك الدّيني، من قبيل إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة.
النّتيجة:
نستنتج ممّا ذُكر آنفاً من الآيات الكريمة، والآيات الاخرى التي لم نذكرها تجنّباً للإطالة، أن ذكر الله تعالى يورث الإنسان اطمئنان القَلب، ويَنهى عن الفحشاء والمنكر، ويزّود النّفس بالقُدرة والقُوّة الّلازمة، في مقابل التّحديات الصّعبة لِلعدو الدّاخلي والخارجي، ويميت الرّذائل الأخلاقيّة في قلب الإنسان، كالحِرص والبُخل وحبّ الدنيا، الذي هو رأس كلّ خطيئةٍ.
فلا ينبغي للسّائر في خطّ التّقوى والإيمان، أن يغفل عن هذا السّلاح الفعّال، فهو الدّرع الحصين لكلّ من يريد أن يتحرّك، على مستوى تهذيب النّفس وتربية عناصر الفضيلة فيها، وهو السدّ المنيع للمؤمنين، مقابل قوى الشّر والانحراف، وسلاحهم الذي يمدّهم بالقوّة والعزيمة، في مقابل الأعداء، والأخطار التي تحدق بهم في هذه الدنيا، المليئة بالوُحوش الضّارية الكاسرة، التي لا تعرف الرّحمة والشّفقة، وليكن ذِكرُهم للهِ كَذِكرهم لأنفسهم، بل أشدّ وأقوى.
علاقة ذِكر الله، بِتهذيب النّفوس في الأحاديث الإسلاميّة:
إنّ استعراض الكلام، عن أهميّة ذِكر الله في الأحاديث الإسلاميّة، لا يتّسع له هذا الُمختصر، وما نَبتغيه في هذا المجال، هو أنّ ذكرَ الله، يعدّ من العوامِلَ المهمّة في تهذيب النّفوس وتشذيب الأخلاق وبناء الرّوح، وقد أغنتنا الرّوايات في هذا المجال، وما وَرد عن المعصومين الأربعة عشر، إلى ما شاء الله، ولكنّنا نختار منها ما يلي:
1 ـ نقرأ في حديثٍ عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «مَن عَمَّرَ قَلْبَهُ بِدَوامِ الذِّكرِ حَسُنَتْ أَفْعالُهُ في السِّرِّ وَالجَهْرِ» ([36]).
فقد بيّن الحديث الشّريف، هذه العلاقة والرّابطة بوضوحٍ تامٍّ.
2 ـ نقرأ في حديثٍ آخر عن الإمام (عليه السلام) نفسه، حيث قال: «مُداومَةُ الذِّكرِ قُوتُ الأَرواحِ وَمِفْتاحُ الصَّلاحِ» ([37]).
3 ـ وعنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «أصلُ صلاحِ القَلبِ اشتغاله بِذِكْرِ اللهِ» ([38]).
4 ـ وأيضاً في حديث آخر عنه (عليه السلام)، قال: «ذِكرُ الله دَواءُ أَعلالِ النُّفُوسِ» ([39]).
5 ـ وعنه (عليه السلام)، قال: «ذِكرُ اللهِ رَأسُ مالِ مُؤمِنٍ، وَرِبْحُهُ السَّلامَةُ مِنَ الشَّيطانِ» ([40]).
6 ـ وأيضاً عن هذا الإمام الهمام (عليه السلام)، أنّه قال: «الذِّكْرُ جَلاءُ البَصائِرِ وَنُورُ السَّرائِرِ» ([41]).
7 ـ وأيضاً عن إمام المتقين (عليه السلام)، قال: «مَنْ ذَكَرَ اللهَ سُبحانَهُ أَحيَى قَلبَهُ وَنَوَّرَ عَقْلَهُ وَلُبَّهُ» ([42])
8 ـ وأيضاً عن الإمام نفسه (عليه السلام)، أنّه قال: «استديموا الذِّكْرَ فَإنَّهُ يُنِيرُ القَلبَ وَهُوَ أَفْضَلُ العِبادَةِ» ([43])
9 ـ وَرد في «ميزان الحكمة»، عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً خالِصاً، تَحْيُوا بِهِ أَفْضَلَ الحَياةِ وَتَسْلُكُوا بِهِ طُرُقَ النَّجاةِ» ([44]).
10 ـ وَوَرد عن الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة، في وصيّته المعروفة لابنه الإمام الحسن (عليه السلام)، أنّه قال: «اوصِيكَ بِتَقوَى اللهِ يا بُنَيَّ! وَلُزُومِ أَمْرِهِ وَعِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ» ([45]).
11 ـ وَرد في غُرر الحِكم، عن مولى الموحدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)، قال: «ذِكْرُ اللهِ مَطْرَدَةُ لِلشَّيطانِ».
12 ـ وَلِحُسن الخِتام، نَختم هذا البحث، بحديثٍ عن الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وإن كانت هناك رواياتٌ وافرةٌ لا يسعها هذا المختصر، قال: «ذِكْرُ اللهِ شِفاءُ القُلُوبِ» ([46]).
ونَستلهم ممّا ذُكر آنفاً، أنّ ذِكر الله تعالى، له علاقةٌ وثيقةٌ وقريبةٌ جدّاً بتهذيب النّفوس، فهوُ ينَوّر القلب، ويجلو الرّوح من عناصر الكِبَر والغُرور والبخل والحَسد، والأهمّ من ذلك أنّه يطرد الشّيطان الرجيم، من واقع الإنسان الدّاخلي، وَيُعيد لِلنفس ثِقتها.
وعلى حدِّ تعبير بعض العلماء الأكارم، أنّ القلب لا يَخلو من أمرين، لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ، فإمّا أن يتّجه لِذكر الله سُبحانه وتعالى ويغذيه بنوره ويطرد منه الظّلمات والشّيطان، وإمّا أن يكون مَرتعاً ومَلعباً لِلشَيطان الرّجيم ووساوسه، يوجهه حيث يشاء.
ومن جهةٍ اخرى، فإنّ الذّات المقدسة هي مصدر لكلِّ الكمالات، وذكر الله تعالى يُؤدّي إلى أنّ الإنسان يقترب من ذلك المصدر في كلّ يومٍ، وبالتّالي يتحرك في طريق الابتعاد عن الرّذائل الأخلاقيّة والأهواء النّفسانية، التي تنبع من النّقص المعنوي في واقع النّفس.
وبناءً على ذلك يجب الاستعانة بهذا السّلاح الماضي، والنّور المخترق لِلظلمات، لِلعبور من متاهات هذا الطّريق الموحش المُظلم، المحفوف بالأخطار الجسيمة، إلى جادّة السّلام، والكمال الإلهي في عالم النّفس، ممّا يورث استقرارها واتّصالها ببارئها.
ونُكمِّل بحثنا بثلاثِ نقاطٍ، وملاحظاتٍ، لا تخلو من فائدة:
1 ـ ما هي حقيقة الذِّكر
يقول «الرّاغب» في كتاب «المُفردات»: إنّ الذِّكر له مَعنيان، فمرّةً حضور الشّيء في الذّهن، ومرّةً بمعنى حفظِ المَعارف والاعتقادات الحقّة في باطن الرّوح.
وقال الأعاظم من علماء الأخلاق: إنّ «ذكرَ الله تعالى»، ليس هو لِقَلقَةِ لِسانٍ، أو مجرّد التّسبيح والتّحميد والتّهليل والتّكبير، في دائرة الألفاظ والكلمات، بل هو التّوجه الحقيقي للهِ تعالى، والإذعان لِقُدرته والإحساس بوجوده أينَما كُنّا.
ولا شكّ أنّ مِثلَ هذا الذّكر هو المطلوب، وهو الغاية القصوى والدّافع للاتجاه نحو الحسنات، والإعراض عن السّيئات والقَبائح.
ولذلك نقرأ عن الرّسول الكريم (صلى الله عليه وآله) في حديثٍ في هذا المضمار: «وَلَيْسَ هُوَ سُبحانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلّا اللهِ وَاللهُ أَكْبرُ، وَلَكِنْ إِذا وَرَدَ عَلى ما يَحْرُمُ عَلَيهِ، خافَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ» ([47]).
ونقل ما يقرب لهذا المعنى في حديث عن الإمامين: الصّادق والباقر (عليهما السلام) ([48]).
ونقل حديث آخر عن علي (عليه السلام)، أنّه قال: «الذِّكْرُ ذِكْرانِ: ذِكْرٌ عِنْدَ المُصِيبَةِ، حَسَنْ جَمِيلٌ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيكَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حاجِزاً» ([49]).
ونستنتج من ذلك، أنّ الذّكر الحقيقي، هو الذّكر الذي يترك أثره الإيجابي في أعماق روح الإنسان، ويفعّل اتجاهاتها الفكريّة والعمليّة في خطّ التّقوى والالتزام الدّيني، ويربّي في النّفس والرّوح، عناصر الخير والصّلاح، ويدعو الإنسان إلى الله العزيز الحكيم.
ومن يذكر الله تعالى على مستوى اللّسان، ويتبع الشّيطان على مستوى المُمارسة والعمل، فهو ليس بِذاكِرٍ حقيقي، ولا يذكر الله من موقع الإخلاص، بل هو كما قال الإمام علي بن موسى الرّضا (عليه السلام): «مَنْ ذكر الله ولَمْ يَسْتَبِقْ إِلى لِقائِهِ فَقَدْ استهزأ بِنَفْسِهِ» ([50]).
2 ـ مراتب الذّكر
ذكر علماء الأخلاق، أن ذّكر الله تعالى، على مراتب ومراحل:
المرحلة الاولى: الذِّكر اللّفظي، حيث يجري فيها الإنسان أسماء الله الحُسنى، وصفات جَماله وجَلاله، على لسانه، من دون التّوجه إلى معانيها ومُحتواها، كما يفعل كثيرٌ من المصلّين السّاهين في صلاتهم، وهو نوع من الذّكر، وله تأثيره المحدود على آفاق النّفس والفِكر! ولكن لماذا؟.
لأنّه أولاً: يعتبر مقدمةً لِلمراحل التّالية.
وثانياً: أنّه لا يخلو من التّوجه الإجمالي نحو الله تعالى، لأنّ المصلي وعلى أيّةِ حالٍ، يعلم أنّه يصلّي وهو واقفٌ بين يَدَيِّ الله تعالى، ولكنّه لا يتوجه لما يقول بصورةٍ تَفصيليَّةٍ، ولكن مع ذلك فهذا النّوع من الذّكر، لا يؤثّر في حياة الإنسان، على مستوى تهذيب النّفس وتربية الأخلاق.
المرحلة الثانية: الذّكر المعنوي، وهو أن يلتفت الإنسان لمعاني الأذكار التي تجري على لسانه، ومن البديهي أنّ التّوجه لمعاني الأذكار، وخصوصيّة كلّ واحدةٍ منها، سيعمّق الامتداد المعنوي لمضامين الذّكر في واقع الإنسان، وبالاستمرار والمداومة سيحسّ الذّاكر، بمعطيات هذا الذّكر في نفسه وروحِهِ.
المرحلة الثّالثة: الذّكر القلبي، وقالوا في تفسيره، إنّه الإحساس الوجداني بحضور الله
تعالى، في أجواء القلب، ثم جريان ذكر الله على اللّسان، فعند ما يرى عجائب خلقته، ودقائق صنعته، من أرضٍ وسماءٍ ومخلوقاتٍ، وما بثّ فيها من دابّةٍ، سيقول: «العَظَمَةُ للهِ الوَاحِدِ القهَّارِ».
فهذا الذّكر نابعٌ من القلب، وينبئ عن حالةٍ باطنيّةٍ في داخل الإنسان.
ومرّةَ يشهد الإنسان في نفسه، نوعاً من الحُضور المعنوي لله تعالى، من دون واسطةٍ، فيترنّم بأذكارٍ، مثل «يا سُبُّوحُ وَيا قُدُّسُ» أو «سُبحانَكَ لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ».
وهذا الأذكار القلبيّة، لها دورها الفاعل في تهذيب النّفوس وتربية الفضائل الأخلاقيّة، كما عاشت الملائكة هذا النوع من الذّكر، عند ما شاهدوا آدم (عليه السلام)، وسِعة علمه واطّلاعه على الأسماء الإلهيّة، فقالوا: (سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)([51]).
وأشار القرآن الكريم، إلى مراحلٍ من الذّكر، فقال: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)([52]).
وفي مكانٍ آخر، يقول: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ)([53]).
ففي الآية الاولى، نجد تقريراً على مستوى التّوجه لِلذكر اللّفظي العميق، ثم التّبتل والانقطاع إلى الله تعالى، أَيْ: التّحرك من موقع الابتعاد عن الناس، والاتّصال بالله تعالى في خطّ العبادة والذّكر.
والآية الثّانية: تتحدث عن الذّكر القلبي، الذي يؤدّي إلى أن يعيش الإنسان، حالة التّضرع والخوف من الباري تعالى، في أجواء الذكر الخفي، فتتحرك عمليّة الذّكر بشكلٍ بطيءٍ من الباطن وتجري على اللّسان.
3 ـ موانع الذّكر
لا توجد موانع تقف في طريق الذّكر اللّفظي، فيمكن لِلإنسان أن يذكر أسماء وصفات الله الجماليّة والجلاليّة، ويجريها على لِسانه في أيِّ وقتٍ شاء، إلّا أن يكون الإنسان مُنشغلاً وغارقاً في الدّنيا، لدرجةٍ لا يبقى وقتٌ لِلذكر اللّفظي.
أمّا الذّكر القلبي والمعنوي، فتقف دونه موانعٌ وسدودٌ كثيرةٌ، أهمّها ما يَكمُنْ في واقع الإنسان نفسه، فبالرّغم من أنّ الله تبارك وتعالى، مع الإنسان في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، وأقرب إلينا من كلّ شيءٍ: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)([54]).
أو كما ورد في الحديث العلوي المشهور: «ما رأَيتُ شَيئاً إلّا وَرَأيتُ اللهَ قَبلَهُ وَبَعدَهُ وَمَعَهُ».
ولكن مع ذلك، فإنّ كثيراً من أعمال الإنسان وصفاته الشّيطانيّة، تضع الحُجب على عينه، فلا يُحسّ بوجود الله تعالى أبداً، من موقع الحضور والشّهود القلبي، وكما يقول الإمام السّجاد (عليه السلام)، في دعاء أبي حمزة الثمالي: «وإنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلّا أَن تَحجُبَهُم الأَعمالُ دُونَكَ»، وأهم تلك الحُجب، هي «الأنانيّة» التي تذهل الإنسان عن ذكر ربه.
فالأناني لا يعيش مع الله تعالى من موقع الوُضوح في الرّؤية، لأنّ الأنانيّة من أنواع الشّرك التي لا تتناسب مع حقيقة التّوحيد!.
ونقرأ في حديثٍ عن عليٍّ (عليه السلام) أنّه قال: «كُلُّ ما أَلهى مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مِنْ إِبلِيسَ» ([55]).
وفي حديث آخر عن عليِّ (عليه السلام) أنّه قال: «كُلُّ ما أَلهى عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مِنْ المَيسرِ» ([56]).
ونعلم أن المَيسر، جُعِل في القرآن الكريم، رديفاً لعبادة الأوثان ([57]).
ونختم هذا الكلام عن موقع الذّكر، بحديثٍ عن الرّسول الأكرم، وقد جاء في معرض تفسيره للآية الكريمة: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ»)([58]).
قال (صلى الله عليه وآله): «هُم عِبادٌ مِنْ امَّتي، الصَّالِحُونَ مِنْهُم لا تُلهِيهِم تِجارَةٌ ولا بَيعْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعنِ الصَّلاةِ المَفرُوضَة الخَمْسِ» ([59]).
نعم فإنّهم في كلّ حركاتهم وسكناتهم، يبتغون وجه الله تعالى، ولا غير.
[1] مصباح الشّريعة ، ص 536 ، نقلاً عن ميزان الحكمة ، مادة «عبد».
[2] سورة البقرة ، الآية 21.
[3] سورة البقرة ، الآية 183.
[4] سورة العنكبوت ، الآية 45.
[5] سورة المعارج ، الآية 19 إلى 24.
[6] سورة التّوبة ، الآية 103.
[7] سورة الرّعد ، الآية 28.
[8] سورة البقرة ، الآية 153.
[9] صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 702 ، طبع بيروت.
[10] للتفصيل يرجى مراجعة التفسير الأمثل ، ذيل الآية الشريفة المبحوثة.
[11] مجمع البيان ، ج 1 ، ذيل الآية 45 من سورة البقرة ، التي تشابه الآية التي نحن في صددها ، وتفسير البرهان، ج 1 ، ص 166 ، ذيل 153 ، سورة البقرة ، ففي حديثٍ عن الصّادق عليهالسلام ، قال في الآية «الصّبرُ هُو الصّوم» : بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 294.
[12] اصول الكافي ، (طبقاً لنقل الميزان ، ج 1 ، ص 154).
[13] نهج البلاغة ، قِصار الكلمات ، الكلمة 252.
[14] يرجى الرجوع إلى كتاب : حياة السيدة الزهراء عليهاالسلام.
[15] المحجّة البيضاء ، ج ، ص 339 ، كتاب أسرار الصّلاة.
[16] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ، طِبقاً لنقل نور الثقلين ، ج 1 ، ص 39 ، ح 39.
[17] وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 4.
[18] مجمع البيان ، ج 8 ، ص 285 ، ذيل الآية 45 من سورة العنكبوت.
[19] بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 254.
[20] غُرر الحِكم ، الرقم 4147.
[21] سورة الرّعد ، الآية 28.
[22] سورة العنكبوت ، الآية 45.
[23] سورة طه الآية 14.
[24] سورة طه ، الآية 42.
[25] سورة طه ، الآية 124.
[26] سورة الكهف ، الآية 28.
[27] سورة النّجم ، الآية 29.
[28] سورة الأحزاب ، الآية 41 إلى 43.
[29] سورة المائدة ، الآية 91.
[30] سورة النّور ، الآية 37.
[31] سورة الفجر ، الآية 27 إلى 30.
[32] المحجّة البيضاء ، ج 2 ، ص 266.
[33] في ظِلال القرآن ، ج 5 ، ص 474.
[34] بحار الأنوار ، ج 69 ، ص 119.
[35] تفسير الميزان ، ج 16 ، ص 329 ، ذيل الآية المبحوثة.
[36] تصنيف دُرر الحِكم ، ص 189 ، الرقم 3658.
[37] المصدر السّابق ، الرقم 3661
[38] المصدر السّابق ، ص 118 ، الرقم 3608.
[39] المصدر السّابق ، ص 188 ، الرقم 3619.
[40] المصدر السّابق ، الرقم 3621.
[41] تصنيف دُرر الحِكم ، ص 189 ، الرقم 3631.
[42] المصدر السّابق ، لرقم 3645.
[43] المصدر السّابق ، الرقم 3654.
[44] ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 69 الطبعة الجديدة.
[45] نهج البلاغة ، الكتاب 31.
[46] كنز العمّال ، ح 1751.
[47] بحار الأنوار ، ج 90 ، ص 151 ، ح 4.
[48] المصدر السّابق ، ح 5 و 6.
[49] المصدر السّابق ، ج 75 ، ص 55.
[50] بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 356 ، ح 11.
[51] سورة البقرة ، الآية 32.
[52] سورة المزّمل ، الآية 8.
[53] سورة الأعراف ، الآية 205.
[54] سورة ق ، الآية 16.
[55] ميزان الحكمة ، ج 2 ، ث 975 ، الطّبعة الجديدة مبحث الذّكر.
[56] المصدر السّابق.
[57] راجع الآية 90 من سورة المائدة.
[58] سورة المنافقين ، الآية 9.
[59] ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 975 ، الطبعة الجديدة.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












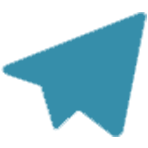
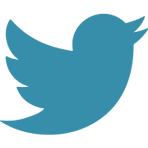

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)