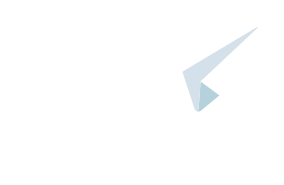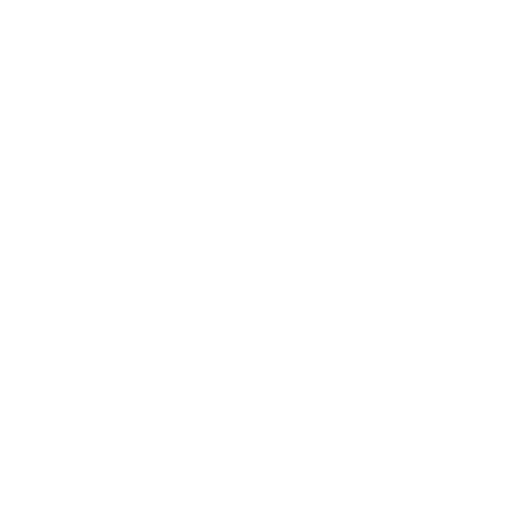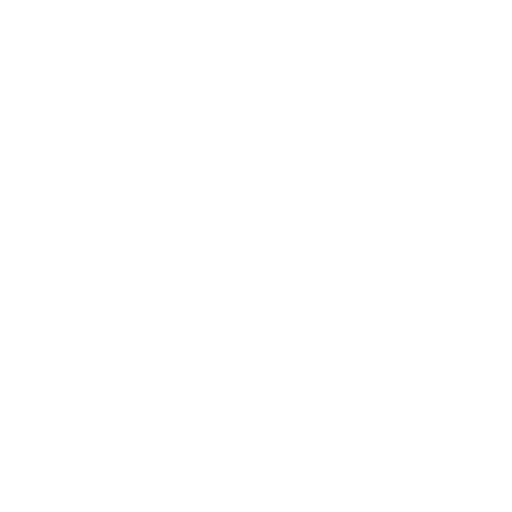الأدب


الشعر

العصر الجاهلي

العصر الاسلامي

العصر العباسي

العصر الاندلسي

العصور المتأخرة

العصر الحديث

النثر


النقد

النقد الحديث

النقد القديم


البلاغة

المعاني

البيان

البديع

العروض

تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
ابن المعتز
المؤلف:
د .شوقي ضيف
المصدر:
تاريخ الأدب العربي ـالعصر العباسي الثاني
الجزء والصفحة:
ص 352ـ347
22-7-2019
10310
ابن المعتز (1)
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامرّاء قبل مقتل جده المتوكل في سنة 247 للهجرة بأربعين يوما، فلم يكد يستقبل الحياة حتى صرع جده هذا المصرع الخطير،
ص325
صرعه جنده وقواده الأتراك الذين فسح لهم في الحكم والسلطان والتسلط، فإذا هم يسفكون دمه غير مراعين عهدا ولا ذمّة. وسرعان ما يتوفّى ابنه المنتصر الذى خلفه، ويصبح الخلفاء لعبة في أيديهم، فيولّون المستعين ويخلعونه ويقتلونه، ويولّون المعتز (252 - 255 هـ) وكان لا يزال في نحو العشرين من عمره، وكان جميل الوجه، وكأنما ورث جمال أمه الرومية التي سماها المتوكل قبيحة لجمال صورتها، من أسماء الأضداد، وكان مرهف الحس رقيق الذوق دقيق المشاعر، مما أنطقه بالشعر المصفّى. وكان يعكف على اللهو والصيد، فمجالسه لا تزال غاصة بشارية وعريب وزنام وابن بنان وغير هؤلاء من المغنيات والمغنين، ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد. وفي مواضع مختلفة من كتاب الديارات للشابشتي نرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء في قصره وفي بعض الأديرة (2)، ونطلع على جانب من ترفه في قصريه «الزوّ» و «الكامل» بسامراء، ومرّ بنا وصف البحتري للقصر الأخير وبستانه الممتد أمامه، ولعله نفس البستان الذى كان يزخر بالحيوانات، والذى كان يتسلّى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف يتواثبان (3).
وكانت أم عبد الله بدورها من الجواري، ولعلها كانت أيضا رومية الأصل مثل جدته، فقد كان جميل المحيّا، وورث عن أبيه كل طباعه، فهو مثله جميل السجايا رقيق المشاعر. وكان ذكى القلب صافى العقل، فأضاف إلى ترفه الذي نشأ منغمسا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره، حتى ليلفت ذلك البحتري، وهو لا يزال في التاسعة من عمره، فيمدحه قائلا (4):
أبا العباس برّزت على قوم … ك آدابا وأخلاقا وتبريزا
فأما حلبة الشعر فتستولى … على السبق بها فرضا وتمييزا
ص326
وقد يكون في ذلك مبالغة على عادة الشعراء في المديح، لكن على كل حال في البيتين وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكبّ على القراءة وأن موهبة الشعر بدأت تستيقظ في نفسه في هذه السنّ الصغيرة. ويبدو أن أباه كان معجبا به إعجابا شديدا مما جعله يضرب باسمه الدنانير. ويسجل ذلك البحتري في مدحة (5) طويلة له، يصور فيها جمال طلعته وشمائله الكريمة، ثم يقول:
وأبهجنا ضرب الدنانير باسمه … وتقليده من أمرنا ما تقلّدا
وفي الشطر الثاني ما يصور إرهاص البحتري للمعتز بأن يولىّ عبد الله العهد، ومضى يصرّح بذلك ويطالب به ويهتف في وضوح. ونراه في قصيدة (6) ثالثة يتشفع لعبد الله بأبيه كي يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام، وفي ذلك يقول في قصيدة رابعة (7):
وملّيت عبد الله إنّ سماحه … هو القطر في إسباله وأخو القطر
شفعت إليه بالإمام وإنما … تشفّعت بالشمس اقتضاء إلى البدر
ولم يلبث الدهر أن قلب ظهر المجن للمعتز وابنه، فإن جند الأتراك طالبوه في السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال، فاعتذر، ولم يقبلوا عذره، وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألفا، ولكنه لم يجدها، فصمموا على خلعه، وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس، ثم جعلوه في بيت أوصدوا بابه حتى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه. وصادروا أموال أمه قبيحة كما مرّ بنا في غير هذا الموضع، ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه وابني عميه قصىّ بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد. وهما محنتان قاسيتان أثّرتا في نفس الصبى آثارا بعيدة: محنته التي امتحن بها في أبيه الذي منحه الحياة والذي كان يغمره ببرّه وحنانه وعطفه، ومحنته بالنفي وعذابه ونكاله وعنائه، وما مرّ به في أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط، مع ما صلى به من حزن عميق على أبيه، مما ظل له أثر بعيد في نفسه، وهو أثر يتراءى بوضوح في أشعاره، إذ يطالعنا
ص327
فيها دائما الإحساس بآلام الحياة وما تكتظ به من كوارث وفواجع، كبّرها في نفسه وخياله ما؟ ؟ ؟ به في صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن حفّت بها الدماء المسفوكة، ؟ ؟ ؟ ، كما حفّ بها النفي والتشريد، فإذا النعيم يصبح جحيما، وينقضي عهده إلى غير مآب، وفي ذلك يقول ابن المعتز باكيا صباه بدموع غزار (8):
لهفي على دهر الصّبا القصير … وغصنه ذي الورق النّضير
وسكره وذنبه المغفور … ومرح القلوب في الصّدور
وطول حبل الأمل المجرور … في ظلّ عيش غافل غرير
ودار عام وتولّى المعتمد الخلافة لسنة 256 فأرسل في طلبه وطلب جدته وابني عمه وردّهم إلى سامرّاء، وكانت شئون القصر أخذت تستقيم، فلم يعد للترك تسلطهم ولا استطالتهم على الخلفاء، إذ جعل المعتمد الأمر والنهي والسلطان لأخيه الموفق طلحة، وكان من أحزم بني العباس وأشجعهم وأنبغهم في إدارة السياسة والحرب وهو الذي قضى على ثورة الزنج وثورة الصفّاريين كما أسلفنا في غير هذا الموضع.
فاطمأن الغلام المروّع وأخذت جدته قبيحة تعنى بتربيته، وأحضرت له المعلمين في الفقه والحديث والأدب واللغة، من مثل محمد بن عمران والحسن العنزي الإخباريين، ومحمد بن هبيرة صاحب الفراء، ويبدو أنه كان يلقى المبرد وثعلبا في أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد لسنة 276. وفي المختار من شعر بشار أن ثعلبا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتا، فكتب إليه من قصيدة طريفة (9):
يا فاتحا لكل علم مغلق … وصيرفيّا عالما بالمنطق
إنا على البعاد والتفرّق … لنلتقي بالذكر إن لم نلتق
وكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم (10). وأهم معلميه أحمد بن سعيد الدمشقي المحدّث الإخباري، ويروى أن البلاذري المؤرخ سعى عند جدته كي يصبح من معلميه ومؤدبيه، فغضب ابن سعيد ولزم بيته، وكانت سن ابن المعتز
ص328
حينئذ ثلاثة عشر عاما، وعلم بغضب أستاذه فكتب إليه أبياتا يترضاه بها، وهي تصور ثقافته تصويرا دقيقا، إذ يخاطبه بقوله (11):
أصبحت يابن سعيد حزت مكرمة … عنها يقصّر من يحفى وينتعل
سر بلتني حكمة قد هذّبت شيمي … وأجّجت غرب ذهني فهو مشتعل
أكون إن شئت قسّا في خطابته … أو حارثا وهو يوم الفخر مرتجل
وإن أشأ فكزيد في فرائضه … أو مثل نعمان ما ضاقت بي الحيل
أو الخليل عروضيّا أخا فطن … أو الكسائي نحويّا له علل
عقباك شكر طويل لا نفاد له … تبقى معالمه ما أطّت الإبل (12)
وهو يقول إن ابن سعيد خرّجه خطيبا فصيحا. لا يقل عن قسّ في خطابته التي اشتهر بها بين الجاهليين، كما لا يقل عن الشاعر الجاهلي الحارث بن حلزة في شعره وبداهته، ولا عن زيد بن ثابت في عمله بالميراث، ولا عن أبي حنيفة في علمه بالفقه، ولا عن الخليل بن أحمد في علمه بالعروض، ولا عن الكسائي في النحو واستنباط علله. وهذه هي مواد ثقافته في سن الثالثة عشرة، ولم يذكر بينها فلسفة ولا منطقا، غير أنه ينبغي أن نحذر التعميم في الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه في تلك السن المبكرة، ومن الطبيعي-وكان نهما بالقراءة-أن يكون قد أطلع على شيء من الفلسفة وقرأ بعض كتب الفلك والتنجيم، ففي أشعاره إشارات لهما (13)، وإن كنا نظن ظنّا أنه لم يلمّ بذلك في مطالع حياته. ولعل من الطريف أن نجده يقول (14):
ولا تفزعن من كل شيء مفزّع … فما كل تربيع النجوم بضائر
وكأنه كان يتشكك في حسابات المنجمين وما يزعمونه من طوالع السعد والنحس.
ومضى يمنح أوقاته للشعر والأدب، وكأنما قرر بينه وبين نفسه الانصراف عن السياسة وشئون السلطان، فقد بلا منهما في جده المتوكل وأبيه المعتز ما جعله يقرر في حزم
ص329
الفراغ للحياة الأدبية، وأنفق في ذلك أعواما كثيرة. وكان يقرأ كتابات سابقيه ويفكر فيما يقرأ منها ناقدا محللا، وما نصل إلى سنة 274 للهجرة حتى نجده يصنّف كتابه «البديع» محاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعا علميا دقيقا، وأن يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديمة في الأدب العربي وكل ما للمحدثين العباسيين منها إنما هو الإكثار، أما بعد ذلك فهي منثورة في القرآن الكريم والحديث النبوي وأشعار الجاهليين والإسلاميين. وألف كتبا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الجوارح والصيد، وكتاب فصول التماثيل في الشراب وآدابه، وكتاب السرقات، وكتابه «طبقات الشعراء المحدثين» ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسي الحديث كما يصور نظرات نقدية طريفة وذوقا مهذبا صافيا. وكان يعنى منذ فواتح حياته بالغناء والموسيقى، وفي ذلك يقول أبو الفرج الأصبهاني: «كان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقى والكلام على النغم وعللها، وله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة، ومراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين بني حمدون وغيرهم تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه (15)». ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن المعتز، ومنها نعرف أنه كان يميل في الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسان بعض نغم الغناء القديم، ثم يورد أبو الفرج من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل في وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج فيه إنتاجا ممتازا جعل العصور تحمله من بعده، وكثيرا ما كان يزوره بعض المغنين والمغنيات ويغنونه فيما يصنع من الشعر. ومن الجواري اللائي كن يكثرن من الاختلاف إليه والغناء في شعره زرياب وبنت الكراعة وخزامى، على نحو ما يحدثنا عنهن أبو الفرج في ترجمته.
وكان ابن المعتز يأخذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة (16)، وكأنه ورث عن أبيه كل مزاجه، أو قل هي حياة القصور المترفة التي تدفع من يعيشها إلى اللهو، مما جعله يفتح بيته للندماء في بعض الأيام وبعض الليالي يسمعون ويشربون، وكان أكثرهم من الشعراء أمثال النميري، وبينهما مراسلات شعرية طريفة، وعلي بن مهدي
ص330
الأصبهاني الكسروي وبينهما مكاتبات بالأشعار ومجاوبات (17) وجحظة وهو الذي أعطاه لقبه الذي اشتهر به. وكان شغوفا مثل أبيه بالصيد، وسنعرض لبعض أشعاره فيه. وينبغي أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن لهوا خالصا، فقد كان يختلف إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وفي مقدمتهم المبرد وثعلب أستاذاه وصديقاه، ويقول الصولي في ترجمته له بكتابه الأوراق: «كانت داره مغاثا لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة».
ومرّ بنا أن أباه وهبه إقطاعا كبيرا بالشام، ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعا أو إقطاعات أخرى في العراق، ومن أجل ذلك كنا نخالف من زعموا أنه كان يعيش في إقلال، ثم كان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وإن كان القائد التركي صالح ابن وصيف صادر أموالها، فقد كانت لها بقية عاشت منها حتى توفيت سنة 264. ولا بد أنه كان ينال راتبا كثيرا أو قليلا من الدولة لعهد عمه المعتمد الذي امتد حتى سنة 279، ويروي الصولي قصيدتين له مدحه بهما، وفي إحداهما يقول (18):
أهلا وسهلا بالإمام ومرحبا … لو أستطبع إلى اللقاء سبيلا
ولعل ابن المعتز نظم هذه القصيدة بعد أن ردّ الموفق أخاه المعتمد عن الموصل إلى بغداد لسنة 269 وكان قد ظن بأخيه الموفق الظنون وعزم على اللحاق بمصر. وقد يكون في ذلك ما يدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا يخشون حينئذ لقاء الخليفة خوفا من غضب أخيه وبطشه. وفي أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار عمه المعتمد، مما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسه، وكان عاكفا على الملاذ والملاهي، فكان طبيعيّا أن يتصل الودّ بين العم وابن أخيه وخاصة إذا كان مثل ابن المعتز شاعرا وإخباريّا ظريفا. ونراه يسوق إلى عمه الموفق الذي أبلى بلاء عظيما في محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرما غير مدحة، ويبدو أنه
ص331
أكثر حينئذ من تهانيه بظفره. من مثل قوله (19):
ولما طغى أمر الدعي رميته … بعزم يردّ السيف وهو كليل
وأعلمته كيف التصافح بالقنا … وكيف تروّى البيض وهي محول (20)
ويتوفى الموفق في سنة 278 ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقل شجاعة وحزما عنه وكان عونه وظهيره في حرب الزنج، ويسلم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه، ويتوفى سنة 279 فيخلفه المعتضد، وكان مهيبا شديد الوطأة، فخافه قواد الترك، وظلوا كما كانوا في عهد أبيه خانعين. ويتحول بالخلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة، ونرى ابن المعتز يوجه إليه مدائح مختلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى بغداد من مثل قوله (21):
لعمري لئن أمسى الإمام ببلدة … وأنت بأخرى شائق القلب نازع
وما أنا في الدنيا بشيء أناله … سوى أنا أرى وجه الخليفة قانع
ويأذن له المعتضد وينزل بغداد، وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباء، ويكثر المبرد من الاختلاف إليه فيها، وتروى كتب الأدب بعض ما كان يدور بينهما من محاورات في الشعر والشعراء (22). ويصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه على الشراب والسماع إلى الغناء، وتقبل الدنيا عليه، وتنعقد صداقة بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاكم بغداد القديم وصديق أبيه، ويهنئه باختيار ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا (23):
فرحت بما أضعافه دون قدركم … وقلت عسى قد هبّ من نومه الدّهر
فترجع فينا دولة طاهريّة … كما بدأت والأمر من بعده الأمر
وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد، ويبدو أنها صداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد، وهو يكثر من مدحه وشكره
ص332
على ما يصله به من أعطيات الدولة، وتنشأ بينه وبين ابنه القاسم الذي وزر بعده صداقة ثالثة ومودة أكيدة، وفي ذلك يقول منوّها بتلك الأسرة (24):
لآل سليمان بن وهب صنائع … إلىّ ومعروف لدىّ مقدّما
هم علّموا الأيام كيف تبرّني … وهم غسلوا عن ثوب والدي الدّما
ويتوفّى المعتضد سنة 289، وكان ابنه المكتفي غائبا، ويضطر رئيس الحرس مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حتى تؤخذ البيعة للمكتفي، وتمضي بسلام، ويسلك فيهم ابن المعتز، ونراه يجأر إلى القاسم بالشكوى من هذا الحبس الاضطراري وسرعان ما يردّ إليه القاسم حريته، كما يرد إليه أعطياته ويوالي له العطاء، فيكثر ابن المعتز من مدحه، معترفا له بصنيعه من مثل قوله (25):
أصلح بيني وبين دهري … وقام بيني وبين حتفي
ولا يلبث القاسم أن يلبى نداء ربه لسنة 291 ويظل المكتفي يفسح لابن المعتز في مجالسه، وابن المعتز يكثر من مدائحه، وينوه بانتصارات جيوشه على قرامطة الشام وزعيمهم الحسين بن زكرويه القرمطي المعروف بصاحب الشامة، وينادمه ويحضر مجالس سماعه وشرابه.
ويتوفّى المكتفي لسنة 295 للهجرة ويتولى الخلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا تتجاوز الثالثة عشرة فيكثر اللغط حوله ويتكلم الناس في شأنه ويقولون كيف يتولى الخلافة من لم يبلغ الحلم، كما يقول كثيرون ينبغي خلعه. وتدخل سنة 296 وما يوافى شهر ربيع الأول حتى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على الحكم كما مر بنا في غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الخلافة. وفي يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته في اليوم التالي (26)، وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الجراح الكاتب،
ص333
وقلّده ابن المعتز الوزارة وتكلم في المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الحلم وإنه لا تصح للناس صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح. ولم يكد يمر يوم على هذه البيعة حتى هبّ مؤنس الخادم في جند كثيرين فنقضها وجدّد للناس بيعة المقتدر وأخرج لهم الأموال وزاد في الأعطية. ولم يبق مع ابن المعتز أحد فهرب إلى دار ابن الجصاص تاجر الجواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله، وبذلك لم تتم له الخلافة إلا لمدة يوم وليلة، وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب. وما كان أحراه أن يبتعد عنها، متعظا بما أصاب أباه منها، ولكن النفس أمارة بالسوء.
ولعل فيما سبق ما يوضح العناصر التي كونت شخصية ابن المعتز الأدبية، فهو عربي عباسي يعتز بعروبته وأسرته، ولد في القصر العباسي وفي كل ما انبثّ فيه من لهو وطرب، على نحو ما هو معروف عن آبائه: الرشيد والمتوكل والمعتز، إذ كانوا يفرغون للهوهم ومتاعهم كلما أتيح لهم الفراغ، وقد يكون في ذلك بعض البواعث عنده على الإحساس المادي للأشياء، أو قل على وصفها وصفا ماديّا، إذ كان هذا الوصف هو الذي يلائم مزاجه المترف، كما كان يلائم عقله الذي يعيش في النعيم فلا يستطيع أن يتعمق الأشياء، وإنما يقف عند ظاهرها الحسي المكشوف، وقديما أشار ابن الرومي إلى تأثير بيئته المترفة في شعره، وإن كانت إشارته من طرف آخر ولكنه يلتقى بما قدمنا، فقد سأله شخص: لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ فقال له: أنشدني
شيئا من شعره أعجز عن مثله، فأنشده وصف ابن المعتز للهلال:
انظر إليه كزورق من فضّة … قد أثقلته حمولة من عنبر
فقال ابن الرومي له: زدني، فأنشده:
كأن آذريونها … والشمس فيه كاليه (27)
مداهن من ذهب … فيها بقايا غاليه (28)
وصاح ابن الرومي: وا غوثاه! لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذلك إنما
ص334
يصف ماعون بيته، لأنه ابن الخلفاء وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق به، أمدح هذا مرّة وأهجو هذا كرّة. وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طورا (29).
وابن الرومي يلاحظ التأثير المادي المترف للبيئة على ابن المعتز. وعنصر آخر اشترك في تكوين شخصيته الأدبية بقوة، وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية، وقد جعله ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق المجددين، حتى إذا انقسمت بيئات النقاد في عصره إلى مجددين مسرفين في التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها في الشعر العربي من جماعة المترجمين ومن التف حولهم، ومحافظين مسرفين في رفض هذه المقاييس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال ثعلب والمبرد والبحتري من الشعراء، ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون إفناء الشخصية الأدبية العربية في المقاييس الأجنبية من أمثال أبي تمام وابن الرومي وجدناه يأخذ صف المحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية في نفسه، ويصرّح بذلك في كتابه البديع الذي أنشأه ليثبت أن كل ما استحدثه العباسيون المستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس محدثا في حقيقته، بل هو يستمد من أصول قديمة في الشعر الجاهلي والإسلامي والقرآن الكريم والحديث النبوي.
وخصّ أبا تمام برسالة احتفظ بها في ترجمته كتاب الموشح للمرزباني، وهي تحمل كل الأسس التي كوّن منها الآمدي حملته على أبي تمام. ومعنى ذلك أنه على الرغم من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو المحافظين في فهم الشعر ونقده ونظمه. وكتابه «طبقات الشعراء المحدثين»، يدل على ثقافة واسعة بالشعر العباسي ولكنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه المحافظ عنده؛ إذ سخرّها كما يتضح في كتابه «البديع» لإثبات أن العباسيين لم يأتوا بشئ ذي بال، وأن كنوز الشعر العربي القديم لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل بارع طريف.
ولا بد أن نلاحظ بجانب ذلك مؤثرا نفسيّا أثر فيه وفي شخصيته وشعره آثارا عميقة، ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله، مما آذى نفسه إيذاء شديدا إذ نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب، وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته،
ص335
إذ يجلل شعره يأس عميق، وحقّا كان يكبّ كثيرا على اللهو يغرق فيه أحزانه.
ولكنها كانت أعظم من أن تغرق أو تنمحي من نفسه، ولعل ذلك ما جعله يكثر من الفخر بشجاعته، وهو يخاف الترك وغير الترك ويتملق عمومته وأبناءهم خوفا على حياته وإيثارا لعافيته.
وتلك هي مكونات شخصيته، بيئة مترفة ينغمس من فيها في ضروب عدة من اللهو والمتاع بالحياة، وثقافة عربية إسلامية محافظة، وأحداث خطيرة جعلت الشر يلمّ به مبكرا، وتدلهمّ من حوله الخطوب، فيفكر في الحياة والموت وما في الدنيا من بؤس وآلام، وكأنما كتب عليه ألا يشرب كئوس الترف واللهو صافية، فدائما أو قل كثيرا ما تمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر ونكر وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم، وابن المعتز مع ذلك كله غزل ظريف حلو الدعابة جميل المحضر يألفه كثير من الأدباء.
ويبدو أن أكبر شاعر محدث كان يعجب به هو البحتري، فقد روى عنه أنه قال: كان مما حبّب الشعر إلىّ أنى سمعت البحتري ينشد الماضي (يريد أباه المعتز) شعرا تشوّقه الناس واستحسنوه ووصفوه، تصرّف فيه بغزل ووصف ومدح وشكر، وعدّد أصناف ما أخذ، وطلب خاتم ياقوت، وهو عندي من أحسن شعره، وهو:
بودّى لو يهوى العذول ويعشق … فيعلم أسباب الهوى كيف تعلق (30)
والبحتري يستهل القصيدة بغزل ملئ بالشوق إلى علوة صاحبته الحلبية، ويصف طيفها الذي ألمّ به في حلمه ولهفته على لقائها، وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما والتصاق خدودهما حين يلتقيان، حتى ليقول:
فلو فهم الناس التّلاقي وحسنه … لحبّب من أجل التلاقي التفرّق
ويفيض في مديح المعتز وما أضفى عليه من عطايا، ويستوهبه في رقة ولطف خاتما. ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة التي أنشدها البحتري أباه وسنه
ص336
لا تتجاوز التاسعة، وتذوقه لها في هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ كثيرا من الشعر، حتى تكوّن له ذوق يستطيع به أن يفقه ما في الشعر من جمال.
ومرّ بنا وصف البحتري له في حياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر مما يدل على أن الشعر سال على لسانه وهو بعد في الثامنة أو التاسعة من حياته.
ولم يكن البحتري وحده أستاذه في مطالع حياته، فأهم منه أبوه المعتز إذ كان شاعرا بارعا، ولو قدّر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على نحو ما شغلهم ابنه، وكان ينفق كثيرا من أوقاته في اللهو والمجون والصيد، وينظم في ذلك كله أشعاره ويطلب إلى هذا المغنى أو ذاك أن يتغنى فيما ينظم، وكل ذلك ورثه ابن المعتز عن أبيه. وبذلك كان له في أوائل حياته أستاذان: أستاذ من بيته هو أبوه الذى كان يدرّبه على نظم الشعر، وأستاذ من غير بيته هو البحتري.
ومن المحقق أن نسيج صياغته لا يرتفع في متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحتري، حقّا كثيرا ما يرتفع، ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الجزلة الرصينة، مما جعل كثيرين في عصره وبعد عصره يحملون عليه، وتصدى لهم أبو الفرج ملوّحا في وجوههم بقوله: «شعره إن كان فيه رقّة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين فإن فيه أشياء كثيرة تجرى في أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهلية، فليس يمكن واصفا لصبوح في مجلس شكل ظريف بين ندامى وقيان على ميادين من النّور والبنفسج والنّرجس ومنضود من أمثال ذلك. . . أن يعدل عما يشبهه من الكلام السّبط (السهل) الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام ووحشيّه وإلى وصف البيد والمهامه والظّبى والظّليم والناقة والجمل والديار والقفار والمنازل الخالية المهجورة، ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسئ، ولا أن يغمط حقّه كلّه إذا أحسن الكثير وتوسّط في البعض وقصّر في اليسير وينسب إلى التقصير في الجميع لنشر المقابح وطي المحاسن. فلو شاء أن يفعل هذا كلّ أحد بمن تقدّم لوجد مساغا (31)». وأبو الفرج بذلك أنصف ابن المعتز، ووضعه في مكانه الصحيح، فهو في أكثر شعره محسن، وهو في بعضه متوسط الإجادة، وفي اليسير
ص337
منه مقصّر، وأكبر الظن أن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان في أثناء سمره أو في أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته في الغناء والموسيقى وأن هذه المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة التي تزن جرس الكلام، ولذلك كنا نحس عنده دائما بأنه لا يهمل الأسماع في شعره، إذ كان يحاول أن يلذّها بأنغامه وألحانه.
وظاهرة ثانية في أشعاره هي عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات والجناس والطباق وهي ظاهرة طبيعية، إذ كتب في هذه الفنون كتابه «البديع» ونوّه بها، غير أنه لم يفرط في الجناس والطباق إفراطا بعيدا، وقد عاب أبا تمام بذلك في كتابه، لأنه يخرج فيه على طريقة القدماء. والمحافظون من أمثاله وأمثال البحتري كانوا يوازنون بين البديع المستحدث وصوره عند القدماء، فلم يكونوا يسرفون فيه مثل أبي تمام ومسلم ابن الوليد.
ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده، لتتضح لنا شاعريته، وأول ما نقف عنده من تلك الفنون المديح، ومرّ بنا أنه مدح من الخلفاء المعتمد والمعتضد كما مدح عمه الموفق البطل المظفر، ونحس ببهجة حقيقة ومشاعر صادقة في مديحه لابن عمه المعتضد، أما مديحه في غيره ففاتر، وكان المعتضد كما أسلفنا بطلا مغوارا واستطاع-كما استطاع أبوه الموفق-أن يخضد شوكة الترك، بل أن يقلم أظفارهم، وكأنما كان يشفى غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم، إذ هم قتلة أبيه وسافكو دمه، وليس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه، فقد اتخذه نديما وجليسا وتوالت عطاياه عليه، فكان إذا مدحه انبعث في مديحه عن عاطفة صادقة حارة، وربما كانت خير مدائحه فيه رائيته التي يستهلّها بقوله (32):
سلمت-أمير المؤمنين-على الدّهر … ولا زلت فينا باقيا واسع العمر
حللت الثريّا خير دار ومنزل … فلا زال معمورا وبورك من قصر
فليس له فيما بنى الناس مشبه … ولا ما بناه الجنّ في سالف الدّهر
والثريا مجموعة من الدور والقصور بناها المعتضد، ويقال-كما مر بنا في غير
ص338
هذا الموضع-إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة فراسخ، ومن حولها البساتين والرياض، وقد صوّرها ابن المعتز تصويرا رائعا، إذ يقول في نفس القصيدة:
وأنهار ماء كالسلاسل فجّرت … لترضع أولاد الرياحين والزهر
جنان وأشجار تلاقت غصونها … فأورقن بالأثمار والورق الخضر
ترى الطير في أغصانهنّ هواتفا … تنقّل من وكر لهنّ إلى وكر
ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذي يجرّ إلى أشباله كل ليلة ذبيحة وحش أو ذبيحا من البشر، والذي ما يزال يفزع الناس بزئيره وبمن يفترس منهم ويقضمه قضما. وكان المعتضد حقّا شجاعا شجاعة خارقة، ويصور ابن المعتز ما بسط في البلاد من عدل ومن رفق بالعباد وجبروت شديد بمثل قوله في القصيدة:
حكمت بعدل لم ير الناس مثله … وداويت بالرّفق الجموح وبالقهر
وليس في أشعاره مديح أو تهنئات لولاة أو وزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وعبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم كما أسلفنا، وخير مدائحه فيهم جميعا ما مدح به عبيد الله بن سليمان بن وهب، وهو على كل حال لا يبالغ في إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم، إنما هي أبيات ينفث بها صدره من مثل قوله (33):
أيا موصل النّعمى على كل حالة … إلىّ قريبا كنت أو نازح الدّار
كما يلحق الغيث البلاد بسيله … وإن جاد في أرض سواها بأمطار
لقد عمر الله الوزارة باسمه … وردّ إليها أهلها بعد إقفار
وكانت زمانا لا يقرّ قرارها … فلاقت نصابا ثابتا غير خوّار
ص339
وفي ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه في ممدوحيه السالفين وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه حزنا شديدا، إذ أحسّ كأنما انهار ركن العباسيين الوطيد وانقض من أساسه، كما أحسّ أن أيام أنسه عادت ظلاما، فقد طوت المنية صديقه الحميم، وطار قلبه فزعا، واسودّت الدنيا من حوله، وقد مضى يرثيه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله في حمايتها ووقايتها من جهد جهيد وبأس له شديد، يقول والدموع تنهمر من عينيه وتكاد تخنقه خنقا (34):
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة … بالطاهريّة مقصى الدّار منفردا (35)
أين الجيوش التي قد كنت تسحبها … أين الكنوز التي لم تحصها عددا
أين السرير الذي قد كنت تملؤه … مهابة، من رأته عينه ارتعدا
أين الرّماح التي غذّيتها مهجا … مذ متّ ما وردت قلبا ولا كبدا
ويتحسر على قصره الثريا ووصائفه وملاهيه، وكأنما أصبح طللا مهجورا، ولا أثر ولا عين، كأنما لم يكن به المعتضد يوما. ويحزن حين توفى قبله وزيره عبيد الله ابن سليمان بن وهب، ولكنه لا ينظم فيه قصائد إنما ينظم أبياتا قليلة يبكى فيها قدرته الكتابية أو قدرته السياسية في الحكم والتدبير من مثل قوله (36):
هذا أبو القاسم في نعشه … قوموا انظروا كيف تسير الجبال
يا ناصر الملك بآرائه … بعدك للملك ليال طوال
وطبيعي ألا نجد عند ابن المعتز هجاء، فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى يستحيل في أيدى الشعراء سهاما يسددونها إلى خصومهم، ولم يكن له خصوم، ولا كان يكنّ لأحد خصومة إلا ما قد يقوله تندّرا ودعابة من مثل قوله لعلى بن بسام هجّاء عصره (37):
يا قذى في العيون يا حرقة بي … ن التراقى حزازة في الفؤاد
يا طلوع العذول ما بين إلف … يا غريما وافى على ميعاد
ص340
يا ركودا في يوم غيم وصيف … يا وجوه التجار يوم الكساد
خلّ عنا فإنما أنت فينا … واو عمرو أو كالحديث المعاد
ويكثر ابن المعتز في شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه في الحروب وفروسيته، وهو يحاكي في ذلك القدماء في حماستهم، فهو فخر مصطنع متكلّف في جمهوره، ويفخر طويلا بأسرته وبجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وبلائه في موقعة حنين، وبشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم، وفى ذلك يقول (38):
إنا لننتاب العداة وإن نأوا … ونهزّ أحشاء البلاد جموعا
ونقول فوق أسرّة ومنابر … عجبا من القول المصيب بديعا
قوم إذا غضبوا على أعدائهم … جرّوا الحديد أزجّة ودروعا
وكأن أيدينا تنفّر عنهم … طيرا على الأبدان كنّ وقوعا
والصورة الأخيرة بديعة، فهو يتصور رءوس الأعداء كأنها طير يتطاير بالسيوف مزايلا لمكانه من أبدانهن. ويمتزج الفخر عنده بشكوى كثيرة، وهي شكوى مردّها إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته في مقتل أبيه، على نحو ما مرّ بنا آنفا، فقد خلّفت هذه المحنة في نفسه ضيقا شديدا ولعل ذلك ما جعله يشكو من إخوانه أحيانا.
وكان كثيرا ما يوجه فخره بأسرته إلى العلويين، مبينا أن بيته أحق بالخلافة من بيتهم، وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره، مما جعله يكثر من وعيدهم وتهديدهم، مذكرا لهم بأن بيته هو الذي استطاع أن يثأر لهم من الأمويين قتلة الحسين وزيد حفيده (39)، ويحاول في مقطوعات وقصائد مختلفة أن يستلّ البغض والإحن من نفوسهم على شاكلة قوله (40):
بني عمّنا عودوا نعد لمودّة … فإنّا إلى الحسنى سراع التعطّف
لقد بلغ الشيطان من آل هاشم … مبالغه من قبل في آل يوسف
ص341
فهم في رأيه بيت واحد وإخوة وينبغي أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا كما حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه، حتى باعوه لسيّارة بثمن بخس دراهم معدودة. ويبدو أن بعض معاصريه لامه على ما يوجه للعلويين من لوم وأشاعوا أنه يسب علي بن أبي طالب، فنظم قصيدة طويلة في مديحه والثناء عليه، يقول في مطالعها (41):
أآكل لحمي وأحسو دمي … فيا قوم للعجب الأعجب (42)
علىّ يظنّون بي بغضه … فهلاّ سوى الكفر ظنّوه بي
ومضى يقول إن الذي يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادّة الدين باسم التشيع لعلى وهو منهم برئ وفضله لا ينكره أحد، وأخذ يصور بسالته وبلاغته وأخوّته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته في الحكم والقضاء وزواجه من السيدة فاطمة بنت الرسول، وسمّاه بحر العلوم، وذكر مواقفه العظيمة، وأشاد بالحسن والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأمويين الغاشمة، وبكاء العباسيين عليه وأخذهم لثأره. ولا بد أن نفصل بين شعر ابن المعتز الموجّه إلى العلويين، والآخر الموجه إلى القرامطة والروافض، فهو في الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف أما في الثاني فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة، مع ما يسمهم به من الإلحاد والكفر والزندقة.
وتلقانا في ديوانه مقطوعات غزلية كثيرة، ولكنها لا تنبئ عن حب حقيقي كان يكتوى بناره، فهي مقطوعات وقد تكون استهلالات لقصائد، لا تصدر عن وجد شديد، وإنما تصدر غالبا عن ود، وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع الحب أن يتعمقه، ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح في الطلب والأمل والشوق المبرح والتضرع الحار، وكل ما نجد إنما هو حب الشباب المترف الذى لا ينبع من أعماق النفس والقلب، أو قل هي أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الجواري أمثال نشر وشرّة على سبيل الدعابة من مثل قوله (43):
ص342
وابلائي من محضر ومغيب … وحبيب مني بعيد قريب
لم ترد ماء وجهه العين إلا … شرقت قبل ريّها برقيب
وقوله (44):
زاحم كمّي كمّه فالتويا … وافق قلبي قلبه فاستويا
وطالما ذاقا الهوى فاكتويا … يا قرّة العين ويا همى ويا
وهي أبيات لا تصور عذابا في الحب ولا ألما من ناره المحرقة، إنما هي أقرب ما تكون إلى الدعابة، وختم البيت الرابع بقوله: «ويا» كما يقول الناس: يا أختي ويا ويا مستغنين بذلك عن الشرح. وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيما بعد إلى لون من ألوان البديع سمّاه المتأخرون باسم الاكتفاء. واقرأ في ابن المعتز فإنك لن تقف على حب لاهب، إنما تقف على دعابات وصور وفنّ من مثل قوله (45):
تقول العاذلات تعزّ عنها … واطف لهيب قلبك بالسّلوّ
وكيف وقبلة منها اختلاسا … ألذّ من الشماتة بالعدوّ
وقوله (46):
إذا اجتنى وردة من خدّها فمه … تكوّنت تحتها أخرى من الخجل
وكان-كما أسلفنا-ينفق على شاكلة أبناء القصور-كثيرا من أوقاته في اللهو والخمر، وديوانه طافح بكئوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها، فهو لا يشربها في بيته ومجالسه مع أصدقائه فحسب، بل يشربها أيضا في أمكنتها المعروفة لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون، وهو يصرّح بأنه كان يغرق فيها همومه إذ يقول (47):
وليس للهمّ إلا شرب صافية … كأنّها دمعة من عين مهجور
ص343
فهو يقبل عليها لتنسيه همومه، ولتمسح على كدر حياته بنصاعتها وصفائها، وليتسلى ويتعزّى عن مقتل أبيه الذي لم ينسه يوما، ومثله في الخمر مثله في الحب، فهو لا يتعبّد لها كما كان يتعبد أبو نواس ولا يسبّح بآلائها مقدّما إليها قرابينه من الشعر، إنما هو يتسلّى بها ويتسلّى بما ينظمه فيها بمثل قوله في مديح الصبوح (48):
اسقني الراح في شباب النهار … وانف همّى بالخندريس العقار (49)
قد تولّت زهر النجوم وقد بشّ … ر بالصّبح طائر الأسحار
ما ترى نعمة السماء على الأر … ض وشكر الرياض للأمطار
وغناء الطيور كلّ صباح … وانفتاق الأشجار بالأنوار
فكأنّ الربيع يجلو عروسا … وكأنا من قطره في نثار (50)
وهي أبيات تصور إحساسه بما ينعكس على بصره من جمال الطبيعة صباحا في الربيع، ولكنها لا تصور حبّا ولا تهالكا على الخمر، ولا عاطفة جامحة أو متقدة، إنها ليست أكثر من أبيات يتسلى بها ويتعزى ويظهر مقدرته على النظم في الخمر، ولذلك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا المدح للصبوح ويضع قصيدة بل قل مزدوجة (51) في ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتا وفيها يقول:
فأي فضل للصّبوح يعرف … على الغبوق والظلام مسدف (52)
ويطيل في الأسباب التي من أجلها يذمه ذمّا قبيحا، كأن يعرّض المصطبحين للبرد القارص شتاء والحر اللافح صيفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات لعصره وبيان محاسن الشيء ومساوئه، كما مرّ بنا عند ابن الرومي في ذمه للورد، ولكن من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور في ذلك عاطفة، وإنما صور عبثا عقليّا، وقد
ص344
يكون أهم من هذا العبث وصفه للبستان في مزدوجة مشهورة له، إذ يقول:
وياسمين في ذرى الأغصان … منتظم كقطع العقيان
والسّرو مثل قضب الزبرجد … قد استمدّ العيش من ترب ندى
على رياض وثرى ثرى … وجدو كالمبرد الجلىّ
وجلّنار كاحمرار الخدّ … أو مثل أعراف ديوك الهند
ويستمر في رصف مثل هذه التشبيهات والصور، وكانت لديه مهارة خارقة في اجتلابها، والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الرومي آنفا. وقد لا يستمدها من ماعون بيته، ولكن نحس كأنما عقله كان كنزا زاخرا بالتشبيهات والصور. وأكثر من تصوير أضواء الصباح وهي تحسر عن الأفق خيوط الظلام وسواده، فتارة يشبه الظلام بحبشي أسود والصباح يفترّ عن أسنانه ضاحكا من فراره، أو يشبهه بغراب قوادمه بيضاء أو مقصوص الجناح، أو بأسود عريان يمشى في الدجى بسراج، وقد يشبه الهلال بزورق من فضة مملوء بالعنبر، ومن بديع تشبيهاته له تصويره بقوله (52):
كمنجل قد صيغ من فضّة … يحصد من زهر الدّجى نرجسا
وتكثر في الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة، ولم يقف عند الطبيعة المتحضرة وحدها فقد كان يلم بالطبيعة الصحراوية. ولعل أبا الفرج الأصبهاني لم يرد في دفاعه عنه الذي مرّ بنا أن ينكر عليه أنه نظم بعض شعره في الأطلال والبيد وحيواناتها، إنما أراد الإكثار من النظم في الصحراء إذ له أشعار مختلفة في وصفها، وقد مرت بنا في غير هذا الموضع أبيات طريفة له في وصف الأطلال والديار الخالية، وأخرى في وصف ثور الوحش وبقره، ومن طريف ماله في وصف الإبل قليلة اللبن وهي تحلب قوله (53):
رأيت انهمار الدرّ بين فروجها … كما عصرت أيدي الغواسل أثوابا
ص345
وقوله في أخرى وسراه عليها طوال الليل، كأنها هائمة تطلب شيئا ضالا منها (54):
فكأن أيديهنّ دائبة … يفحصن ليلتهن عن صبح
وله في الخيل أشعار مختلفة، وطبيعي أن يعنى بها، إذ كان شغوفا بالصيد، حتى ليحتل الطّرد جزءا كبيرا من ديوانه وأشعاره، ومن طريف ما نعته بها قوله في مقدمة إحدى طردياته يصف فرسا له (55):
قد أغتدي والصبح كالمشيب … في أفق مثل مداك الطيب (56)
بقارح مسوّم يعبوب … ذي أذن كخوصة العسيب (57)
أو آسة أوفت على قضيب … يسبق شأو النظر الرحيب (58)
أسرع من ماء إلى تصويب … ومن رجوع لحظة المريب
وينتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر أداته في تلك الرحلة للصيد، ويصف مهارته في تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها بمنسره ومخالبه، يخزها ويطعنها مسيلا لدمائها مزهقا لأرواحها، يقول:
وأجدل أحكم بالتأديب … سوط عذاب واقع مجلوب (59)
يهوى هوىّ الماء في القليب … ما طار إلا لدم مصبوب (60)
وعلى نحو ما يصور الصقور الجارحة في طرده وصيدها للطير يصور البزاة بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المشرعة، ومن طريف ماله في تصوير عين باز قوله (61):
ومقلة تصدقه إذا رمق … كأنها نرجسة بلا ورق
ص346
وله في الكلاب طرديات كثيرة يأتسي فيها بأبي نواس، بل هو في طردياته جميعا يأتسي به ويحاكيه حتى في ألفاظه التي يفتتح بها تلك الطرديات، من مثل: قد أغتدى. وقد مضى في إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة سمعها وحدّة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله في إحدى طردياته (62):
ومخطف موثّق الأعضاء … ذي أذن ساقطة الأرجاء (63)
كوردة السّوسنة الشّهلاء … وبرثن كمثقب الحذّاء (64)
ومقلة قليلة الأقذاء … صافية كقطرة من ماء
تنساب بين أكم الصحراء … مثل انسياب حيّة رقطاء (65)
وله طرديات أخرى في الفهد، وفى قوس البندق، ويكثر فيها جميعا من التشبيهات والصور الطريفة، ومن الحق أنه كان بارعا في تصوير أي شيء يلم به من كوكب في السماء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار في الطبيعة المتحضرة أو حيوانات وأطلال في الطبيعة المتبدية، وليس بين المحدثين من وصف الحيّة وصفه لها في قوله (66):
كأنّني ساورتني يوم بينهم … رقشاء مجدولة في لونها بلق
كأنها حين تبدو من مكامنها … غصن تفتّح فيه النور والورق
ينسلّ منها لسان تستغيث به … كما تعوّذ بالسّبّابة الغرق
وله مراسلات بالشعر بينه وبين إخوانه وهى تكثر كثرة تجعلنا نظن ظنّا أنه من أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات في الشعر العربي، وهو في طائفة منها ينحو نحو الدعابة. ويكثر في شعره-كما قدمنا-من التفكير في الموت ومصير الحياة
ص347
والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء، وعللنا ذلك آنفا بأنها طوابع طبعتها في نفسه نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة في صباه، وقد ظل يحنّ إلى سامراء بعد نزوله ببغداد وما لقى من بعوضها ونقيق ضفادعها (67).
وقد تحدثنا في غير هذا الموضع عن اهتمامه بالشعر التعليمي ونظمه فيه مزدوجة تاريخية صوّر فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعصره. ولعل في كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء لعصره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر في ابن المعتز وحياته وشعره كتاب الأوراق: أشعار أولاد الخلفاء للصولي ص 107 وما بعدها وكتاب الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) 10/ 274 والفهرست ص 174 وتاريخ بغداد 10/ 95 ومروج الذهب 4/ 203 والطبري 10/ 140 ونزهة الألباء لابن الأنباري وابن خلكان وفوات الوفيات 1/ 241 ومرآة الجنان لليافعي 2/ 225 وشذرات الذهب 2/ 221 والنجوم الزاهرة 3/ 164 وفى مواضع مختلفة وعبد الله بن المعتز العباسي لمحمد عبد العزيز الكفراوي (طبع مكتبة نهضة مصر) بالقاهرة وديوانه طبعة بيروت، وهى التي ترجع إليها وطبعة القاهرة، وطبع بعض المستشرقين منه جزأين في إستانبول. وتوجد منه مخطوطة برواية الصولي بدار الكتب المصرية.
(2) الديارات ص 110، 164.
(3) الديارات ص 111.
(4) ديوان البحتري 2/ 1119.
(5) الديوان 2/ 670.
(6) الديوان، 2/ 1309.
(7) الديوان 2/ 1007.
(8) ديوان المعاني 2/ 153.
(9) المختار من شعر بشار (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر) ص 54.
(10) الفهرست ص 174.
(11) معجم الأدباء 1/ 133.
(12) أطت: أنّت تعبا أو حنينا.
(13) الفن ومذاهبه في الشعر العربي (الطبعة السابعة) ص 263.
(14) الديوان ص 249.
(15) الأغاني 10/ 276.
(16) الديارات ص 72.
(17) معجم الشعراء ص 149.
(18) الديوان ص 376 وفى أشعار أولاد الخلفاء ص 131 أنها في المعتضد.
(18) زهر الآداب للحصري 3/ 193 وفى أشعار أولاد الخلفاء ص 131 أنها في المعتضد.
(19) البيض: السيوف-محول: مجدبة.
(21) الديوان ص 307 وأشعار أولاد الخلفاء ص 128.
(22) أخبار البحتري للصولي ص 164.
(23) أغاني 10/ 286.
(24) مروج الذهب ص 204.
(25) الديوان ص 319.
(26) انظر في بيعة ابن المعتز ومقتله الطبري 10/ 140 والنجوم الزاهرة 3/ 164 وذيل زهر الآداب ص 204.
(27) الآذريون: زهر أصفر في وسطه حمل أسود.
(28) الغالية: المسك، وهو أسود.
(29)النجوم الزاهرة 3/ 96.
(30)أخبار البحتري ص 108 والتحف والهدايا للخالديين نشر الدكتور سامى الدهان ص 73 وانظر الديوان 3/ 1534
(31) الأغاني 10/ 274.
(32)الديوان ص 215.
(33)الديوان ص 217.
(34) النجوم الزاهرة 3/ 127.
(35) الطاهرية: الدار التي دفن بها المعتضد غربي بغداد.
(36) الديوان ص 389.
(37) ذيل زهر الآداب ص 181.
(38) الديوان ص 300 وأشعار أولاد الخلفاء ص 165.
(39) الديوان ص 50.
(40) الديوان ص 327.
(41) الديوان ص 67.
(42) أحسو: أشرب.
(43) الديوان ص 52 وأشعاره أولاد الخلفاء ص 221 والأغاني 10 - 278.
(44) الأغاني 10/ 279.
(45) مروج الذهب 4/ 203.
(46) مروج الذهب 4/ 205.
(47) الديوان ص 230.
(47) الديوان ص 232 وأشعار أولاد الخلفاء ص 190.
(48) الخندريس العقار: الخمر.
(49) النثار: ما ينثر على العروس من الدراهم الفضية.
(51) الديوان ص 473 وأشعار أولاد الخلفاء ص 251.
(52) مسدف: مرخى الستور.
(52) الديوان ص 278.
(53) الديوان ص 36.
(54) الديوان ص 140.
(55) الديوان ص 86 وزهر الآداب 2/ 23 وأشعار أولاد الخلفاء 209.
(56) المداك: الحجر الذي يسحق عليه الطيب.
(57) قارح: مكتمل الخلق. مسوم: معلم حسن الخلق. يعبوب. سريع الجري.
(58) أوفت: أشرفت.
(59) أجدل: صقر.
(60) القليب: البئر.
(61) أشعار أولاد الخلفاء ص 218 وديوان المعاني 2/ 140.
(62) الديوان ص 18 وأشعار أولاد الخلفاء ص 207.
(63) مخطف: ضامر. ساقطة الأرجاء: شديدة السمع.
(64) السوسنة: الزنبقة.
(65) رقطاء: رقشاء أي بها نقط سود وبيض.
(66) الديوان ص 330.
(67) الديوان ص 401.
 الاكثر قراءة في تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
الاكثر قراءة في تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












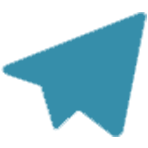
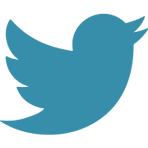

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)