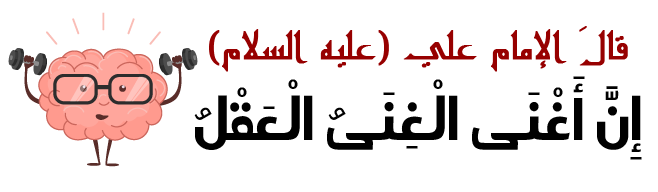
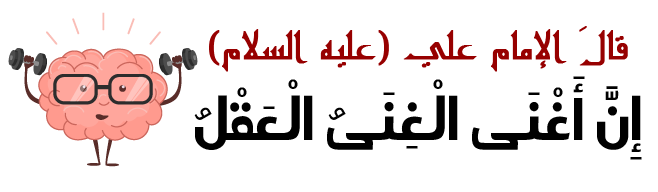

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكامقال تعالى : {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} [الغاشية: 1 - 26].
{هل أتاك حديث الغاشية} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يريد قد أتاك حديث يوم القيامة لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتة عن ابن عباس والحسن وقتادة وقيل الغاشية النار تغشي وجوه الكفار بالعذاب وهذا كقوله تغشى وجوههم النار عن محمد بن كعب وسعيد بن جبير {وجوه يومئذ خاشعة} أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها والشدائد التي تشاهدها والمراد بذلك أرباب الوجوه وإنما ذكر الوجوه لأن الذل والخضوع يظهر فيها وقيل المراد بالوجوه الكبراء تقول جاءني وجوه بني تميم أي ساداتهم وقيل عنى به وجوه الكفار كلهم لأنها تكبرت عن عبادة الله تعالى عن مقاتل.
{عاملة ناصبة} فيه وجوه (أحدها) أن المعنى عاملة في النار ناصبة فيها عن الحسن وقتادة قالا لم يعمل الله سبحانه في الدنيا فاعملها وانصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال قال الضحاك يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار وقال الكلبي يجرون على وجوههم في النار (وثانيها) أن المراد عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة عن عكرمة والسدي (وثالثها) عاملة ناصبة في الدنيا يعملون وينصبون ويتعبون على خلاف ما أمرهم الله تعالى به وهم الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل الله أعمالهم في البدعة والضلالة وتصير هباء لا يثابون عليها عن سعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبي الضحاك عن ابن عباس وقال أبوعبد الله (عليه السلام) كل ناصب لنا وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية {عاملة ناصبة}.
{تصلى نارا حامية} قال ابن عباس قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله وقيل المعنى إن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية الحرارة {تسقى من عين آنية} أي وتسقى أيضا من عين حارة قد بلغت إناها وانتهت حرارتها قال الحسن قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا هذا شرابهم ثم ذكر طعامهم فقال {ليس لهم طعام إلا من ضريع} وهو نوع من الشوك يقال له الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس وهو أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة وعن الضحاك عن ابن عباس قال :قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ((الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حرا من النار سماه الله الضريع)) وقال أبو الدرداء والحسن إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستقون فيعطشهم الله سبحانه ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة كلما أدنوه إلى وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك قوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ولما نزلت هذه الآية قال المشركون إن إبلنا لتسمن على الضريع وكذبوا في ذلك لأن الإبل لا ترعاه فقال الله سبحانه تكذيبا لهم:
{لا يسمن ولا يغني من جوع} أي لا يدفع جوعا ولا يسمن أحدا قال الحسن لا أدري ما الضريع لم أسمع من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) شيئا فيه وقيل هو سم عن مجاهد وقتادة وقيل ضريع بمعنى مضرع أي يضرعهم ويذلهم وقيل يسمى ضريعا لأن آكله يضرع في الإعفاء منه لخشونته وشدة كراهته عن كيسان وقيل هو الحجارة عن سعيد بن جبير ثم وصف سبحانه أهل الجنة فقال {وجوه يومئذ ناعمة} أي منعمة في أنواع اللذات ظاهر عليها إثر النعمة والسرور ومضيئة مشرقة {لسعيها} في الدنيا {راضية} حين أعطيت الجنة بعملها والمعنى لثواب سعيها وعملها من الطاعات راضية يريد أنه لما ظهر نفع أعمالهم وجزاء عباداتهم رضوه وحمدوه وهذا كما يقال عند الصباح يحمد القوم السري {في جنة عالية} أي مرتفعة القصور والدرجات وقيل إن علو الجنة على وجهين علو الشرف والجلالة وعلو المكان والمنزلة بمعنى أنها مشرفة على غيرها وهي أنزه ما تكون والجنة درجات بعضها فوق بعض كما أن النار دركات.
{لا تسمع فيها لاغية} أي كلمة ساقطة لا فائدة فيها وقيل لاغية ذات لغو كقولهم نابل ودارع أي ذو نبل ودرع قال الحطيئة ))وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تأمر)) {فيها} أي في تلك الجنة {عين جارية} قيل إنه اسم جنس ولكل إنسان في قصره من الجنة عين جارية من كل شراب يشتهيه وفي العيون الجارية من الحسن واللذة والمنفعة ما لا يكون في الواقفة ولذلك وصف بها عيون أهل الجنة وقيل إن عيون أهل الجنة تجري في غير أخدود وتجري كما يريد صاحبها {فيها} أي في تلك الجنة {سرر مرفوعة} قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها والسرر جمع سرير وهو مجلس السرور وقيل إنما رفعت ليرى المؤمنون بجلوسهم عليها جميع ما حولهم من الملك.
{وأكواب موضوعة} على حافات العيون الجارية كلما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة وهي الأباريق ليس لها خراطيم ولا عرى تتخذ للشراب وقيل هي أواني الشراب من الذهب والفضة والجواهر بين أيديهم ويشربون بها ما يشتهونه من الأشربة ويتمتعون بالنظر إليها لحسنها {ونمارق مصفوفة} أي وسائد يتصل بعضها ببعض على هيئة مجالس الملوك في الدنيا {وزرابي مبثوثة} وهي البسط الفاخرة والطنافس المخملة والمبثوثة المبسوطة المنشورة ويجوز أن يكون المعنى أنها مفرقة في المجالس وعن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) أنه ذكر أهل الجنة فقال يجيئون فيدخلون فإذا أسس بيوتهم من جندل اللؤلؤ وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ولولا أن الله تعالى قدرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون ويعانقون الأزواج ويعقدون على السرر ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا.
قال قتادة ولما نعت الله الجنة وما فيها عجب من ذلك أهل الضلال فأنزل الله سبحانه {أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} وكانت عيشا من عيشهم فيقول أ فلا يتفكرون فيها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يقول كما صنعت هذا لهم فكذلك أصنع لأهل الجنة في الجنة وقيل معناه أ فلا يعتبرون بنظرهم إلى الإبل وما ركبه الله عليه من عجيب الخلق فإنه مع عظمته وقوته يذلله الصغير فينقاد له بتسخير الله إياه لعباده فيبركه ويحمل عليه ثم يقوم وليس ذلك في غيره من ذوات الأربع فلا يحمل على شيء منها إلا وهو قائم فأراهم الله سبحانه هذه الآية فيه ليستدلوا على توحيده بذلك عن أبي عمرو بن العلاء والزجاج وسأل الحسن عن هذه الآية وقيل له الفيل أعظم من الإبل في الأعجوبة فقال أما الفيل فالعرب بعيدو العهد بها ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها والإبل من أعز مال العرب وأنفسه تأكل النوى وألقت وتخرج اللبن ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها ويحكى أن فأرة أخذت بزمام ناقة فأخذت تجرها وهي تتبعها حتى دخلت الحجر فجرت الزمام فبركت الناقة فجرت فقربت فمها من جحر الفأر .
{وإلى السماء كيف رفعت} أي كيف رفعها الله فوق الأرض وجعل بينهما هذا الفضاء الذي به قوام الخلق وحياتهم ثم إلى ما خلقه فيها من بدائع الخلق من الشمس والقمر والكواكب وعلق بها منافع الخلق وأسباب معايشهم {وإلى الجبال كيف نصبت} أي أ ولا يتفكرون في خلق الله سبحانه الجبال أوتادا للأرض ومسكنة لها وأنه لولاها لمادت الأرض بأهلها {وإلى الأرض كيف سطحت} أي كيف بسطها الله ووسعها ولولا ذلك لما صح الاستقرار عليها والانتفاع بها وهذه من نعم الله سبحانه على عباده لا توازيها نعمة منعم وفيها دلائل على توحيده ولو تفكروا فيها لعلموا أن لهم صانعا صنعهم وموجدا أوجدهم.
ولما ذكر سبحانه الأدلة أمر نيته بالتذكير بها فقال {فذكر} يا محمد والتذكير التعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم والنفع بالتذكير عظيم لأنه طريق للعلم بالأمور التي يحتاج إليها {إنما أنت مذكر} لهم بنعم الله تعالى عندهم وبما يجب عليهم في مقابلتها من الشكر والعبادة وقد أوضح الله تعالى طريق الحجج في الدين وأكده غاية التأكيد بما لا يسع فيه التقليد بقوله {إنما أنت مذكر} وقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ولقوم يذكرون ويتفكرون وقيل إن المراد فذكرهم بهذه الأدلة وأمرهم بالاستدلال بها ونبههم عليها عن الجبائي وأبي مسلم {لست عليهم بمصيطر} معناه لست عليهم بمتسلط تسليطا يمكنك أن تدخل الإيمان في قلوبهم وتجبرهم عليه وإنما الواجب عليك الإنذار فاصبر على الإنذار والتبليغ والدعوة إلى الحق وقيل معناه لست عليهم بمتسلط الآن حتى تقاتلهم إن خالفوك وكان هذا قبل نزول آية الجهاد ثم نسخ بالأمر بالقتال والوجه الصحيح أنه لا نسخ فيه لأن الجهاد ليس بأكره للقلوب والمراد أنك إنما بعثت للتذكير وليس عليك من ترك قبولهم شيء {إلا من تولى وكفر} أي أعرض عن الذكر ولم يقبل منك وكفر بالله وبما جئت به فكل أمره إلى الله عن الحسن وقيل معناه إلا من تولى وكفر فلست له بمذكر لأنه لا يقبل منك فكأنك لست تذكره {فيعذبه الله العذاب الأكبر} وهو الخلود في النار ولا عذاب أعظم منها ثم ذكر سبحانه أن مرجعهم إليه فقال {إن إلينا إيابهم} أي مرجعهم ومصيرهم بعد الموت {ثم إن علينا حسابهم} أي جزاءهم على أعمالهم فهذا جامع بين الوعد والوعيد ومعناه لا يهمنك أمرهم فإنهم وإن عاندوك وآذوك فمصير جميعهم إلى حكمنا لا يفوتوننا ومجازاتهم علينا وعن قريب تقر عينك بما تراه في أعدائك .
___________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج10، ص335-339.
{هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ} . الخطاب للرسول (صلى الله عليه واله وسلم) ولكن السبب الموجب يعم الجميع ، والغاشية القيامة ، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وأهوالها ، والمعنى هل تعرف شيئا عن يوم القيامة ؟ . . ان الناس فيه فريقان : الفريق الأول {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ} يظهر عليها أثر الذل والخزي والهوان {عامِلَةٌ ناصِبَةٌ} من النصب وهو التعب ، والمعنى ان أصحاب هذه الوجوه عملوا في الدنيا كثيرا ، وتعبوا كثيرا ، ولكن لغير اللَّه . . فما أصابوا من عملهم إلا التعب والكد في الدنيا ، والحسرة والعذاب في الآخرة ، فكان المهنأ لغيرهم ، والعبء على ظهرهم . وفي نهج البلاغة : ان أخسر الناس صفقة ، وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب ماله ولم تساعده المقادير على إرادته ، فخرج من الدنيا بحسرته ، وقدم على الآخرة بتبعته {تَصْلى ناراً حامِيَةً} تكوى بنار مستعرة {تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} وهي الشديدة الحرارة ، من أنى الماء يأنى إذا سخن ، وبلغ من الحرارة غايتها ، ومثله {يَطُوفُونَ بَيْنَها وبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ} - 44 الرحمن {لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ} قال صاحب القاموس المحيط : الضريع نبت لا تقربه دابة لخبثه . ومهما يكن فإنه رديء وبيل ، ويكفي أن يكون طعام أهل النار {لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ} لا يدفع ضرا ، ولا يجلب نفعا .
وهذا هو الفريق الثاني : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ} ذات بهجة وحسن {لِسَعْيِها راضِيَةٌ} رضيت أجرها في الآخرة على عملها في الدنيا {فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ} رفيعة وعظيمة في جميع صفاتها ومزاياها ، ومثله {فَهُو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ} - 21 الحاقة . {لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً} كلاما لا جدوى منه ، ومثله {لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً ولا تَأْثِيماً} - 25 الواقعة . {فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ} جنات تجري من تحتها الأنهار {فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ} عن الأرض {وأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ} على جانب العين ، فإذا أرادوا الشراب تناولوا بها الماء {ونَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ} النمارق جمع نمرقة ، وهي الوسادة - المسند أو المخدة - {وزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ} الزرابي البسط ، ومبثوثة متفرقة هنا وهناك ، وكل ما جاء هنا في وصف الجنة هو بعض ما تقدم في عشرات الآيات ، وكل ما قيل أو يقال في وصفها فهو تفسير وبيان لقوله تعالى : {وفِيها ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ} - 71 الزخرف .
{أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} . وتسأل : لما ذا خص سبحانه الإبل بالذكر دون الحيوانات ؟ .
وأجاب الشيخ محمد عبده بأنها أفضل دواب العرب وأعمها نفعا ، ولأنها خلق عجيب ، فإنها على شدتها تنقاد للضعيف ، ثم في تركيبها ما أعد لحمل الأثقال ، وهي تبرك لتحمل ، ثم تنهض بما تحمل مع الصبر على السير والعطش والجوع ، وفيها غير ذلك ما لا يماثلها حيوان آخر .
{وإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ} فوق الأرض بكواكبها اللامعة النافعة {وإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ} أوتادا للأرض : فسكنت على حركتها ، ولولا الجبال لمادت بأهلها ، وزالت عن مواضعها {وإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} فجعلها اللَّه لخلقه مهادا يقيمون عليها ويمشون في مناكبها . وتجدر الإشارة إلى ان المراد بالتسطيح هنا تسطيح الأرض في رؤية العين لا في الواقع ، وقد أشار سبحانه إلى كروية الأرض في الآية 5 من سورة الزمر . أنظر ج 6 ص 395 . وقال الشيخ محمد عبده : انما حسن ذكر الجمال مع السماء والجبال والأرض لأن هذه المخلوقات هي ما تقع تحت نظر العرب في أوديتهم وبواديهم .
{فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ} . هذا أبلغ وأوضح تحديد لمهمة الرسول : التذكير ، ومثله {وما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} - 54 النور . {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ} .
لست - يا محمد - مسلَّطا عليهم حتى تكرههم على الايمان ، ولكن ليس معنى هذا ان الذين كذبوك يتركون سدى . . كلا ، انهم إلينا راجعون ، وبأعمالهم ومقاصدهم مرتهنون ، ولا جزاء لهم إلا عذاب الخزي والهون .
_____________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص556-558.
سورة إنذار وتبشير تصف الغاشية وهي يوم القيامة الذي يحيط بالناس تصفه بحال الناس فيه من حيث انقسامهم فريقين: السعداء والأشقياء واستقرارهم فيما أعد لهم من الجنة والنار وتنتهي إلى أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يذكر الناس بفنون من التدبير الربوبي في العالم الدالة على ربوبيته تعالى لهم ورجوعهم إليه لحساب أعمالهم.
والسورة مكية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {هل أتاك حديث الغاشية} استفهام بداعي التفخيم والإعظام، والمراد بالغاشية يوم القيامة سميت بذلك لأنها تغشى الناس وتحيط بهم كما قال: {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: 47] ، أو لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتة كما قيل، أو لأنها تغشى وجوه الكفار بالعذاب.
قوله تعالى: {وجوه يومئذ خاشعة} أي مذللة بالغم والعذاب يغشاها، والخشوع إنما هو لأرباب الوجوه وإنما نسب إلى الوجوه لأن الخشوع والمذلة يظهر فيها.
قوله تعالى: {عاملة ناصبة} النصب التعب و{عاملة} خبر بعد خبر لوجوه، وكذا قوله: {ناصبة} و{تصلى} و{تسقى} و{ليس لهم} والمراد من عملها ونصبها بقرينة مقابلتهما في صفة أهل الجنة الآتية بقوله: {لسعيها راضية} عملها في الدنيا ونصبها في الآخرة فإن الإنسان إنما يعمل ما يعمل في الدنيا ليسعد به ويظفر بالمطلوب لكن عملهم خبط باطل لا ينفعهم شيئا كما قال تعالى: { وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23] فلا يعود إليهم من عملهم إلا النصب والتعب بخلاف أهل الجنة فإنهم لسعيهم الذي سعوه في الدنيا راضون لما ساقهم إلى الجنة والراحة.
وقيل: المراد أنها عاملة في النار ناصبة فيها فهي تعالج أنواع العذاب الذي تعذب به وتتعب لذلك.
وقيل: المراد أنها عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار يوم القيامة.
قوله تعالى: {تصلى نارا حامية} أي تلزم نارا في نهاية الحرارة.
قوله تعالى: {تسقى من عين آنية} أي حارة بالغة في حرارتها.
قوله تعالى: {ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع} قيل: الضريع نوع من الشوك يقال له: الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس وهو أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة، ولعل تسمية ما في النار به لمجرد المشابهة شكلا وخاصة.
قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناعمة} من النعومة فيكون كناية عن البهجة والسرور الظاهر على البشرة كما قال: {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} [المطففين: 24] ، أومن النعمة أي متنعمة.
قيل: ولم يعطف على قوله: {وجوه يومئذ خاشعة} إشارة إلى كمال البينونة بين حالي الفريقين.
قوله تعالى: {لسعيها راضية} اللام للتقوية، والمراد بالسعي سعيها في الدنيا بالعمل الصالح، والمعنى رضيت سعيها وهو عملها الصالح حيث جوزيت به جزاء حسنا.
قوله تعالى: {في جنة عالية - إلى قوله - وزرابي مبثوثة} المراد بعلوها ارتفاع درجاتها وشرفها وجلالتها وغزارة عيشها فإن فيها حياة لا موت معها، ولذة لا ألم يشوبها وسرورا لا غم ولا حزن يداخله لهم فيها فوق ما يشاءون.
وقوله: {لا تسمع فيها لاغية} أي لا تسمع تلك الوجوه في الجنة كلمة ساقطة لا فائدة فيها.
وقوله: {فيها عين جارية} المراد بالعين جنسها فقد عد تعالى فيها عيونا في كلامه كالسلسبيل والشراب الطهور وغيرهما.
وقوله: {فيها سرر مرفوعة} السرر جمع سرير وفي ارتفاعها جلالة القاعد عليها، {وأكواب موضوعة} الأكواب جمع كوب وهو الإبريق لا خرطوم له ولا عروة يتخذ فيه الشراب {ونمارق مصفوفة} النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة وكونها مصفوفة وضعها في المجلس بحيث يتصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة في الدنيا {وزرابي مبثوثة} الزرابي جمع زريبة مثلثة الزاي وهي البساط الفاخر وبثها بسطها للقعود عليها.
قوله تعالى: {أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} بعد ما فرغ من وصف الغاشية وبيان حال الفريقين، المؤمنين والكفار عقبه بإشارة إجمالية إلى التدبير الربوبي الذي يفصح عن ربوبيته تعالى المقتضية لوجوب عبادته ولازم ذلك حساب الأعمال وجزاء المؤمن بإيمانه والكافر بكفره والظرف الذي فيه ذلك هو الغاشية.
وقد دعاهم أولا أن ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟ وكيف صور الله سبحانه أرضا عادمة للحياة فاقدة للشعور بهذه الصورة العجيبة في أعضائها وقواها وأفاعيلها فسخرها لهم ينتفعون من ركوبها وحملها ولحمها وضرعها وجلدها ووبرها حتى بولها وبعرتها فهل هذا كله توافق اتفاقي غير مطلوب بحياله؟.
وتخصيص الإبل بالذكر من جهة أن السورة مكية وأول من تتلى عليهم الإعراب واتخاذ الآبال من أركان عيشتهم.
قوله تعالى: {وإلى السماء كيف رفعت} وزينت بالشمس والقمر وسائر النجوم الزواهر بما فيها من المنافع لأهل الأرض وقد جعل دونها الهواء الذي يضطر إليه الحيوان في تنفسه.
قوله تعالى: {وإلى الجبال كيف نصبت} وهي أوتاد الأرض المانعة من مورها ومخازن الماء التي تتفجر منها العيون والأنهار ومحافظ للمعادن.
قوله تعالى: {وإلى الأرض كيف سطحت} أي بسطت وسويت فصلحت لسكنى الإنسان وسهل فيها النقل والانتقال وأغلب التصرفات الصناعية التي للإنسان.
فهذه تدبيرات كلية مستندة إليه تعالى بلا ريب فيه فهورب السماء والأرض ما بينهما فهورب العالم الإنساني يجب عليهم أن يتخذوه ربا ويوحدوه ويعبدوه وأمامهم الغاشية وهو يوم الحساب والجزاء.
قوله تعالى: {فذكر إنما أنت مذكر} تفريع على ما تقدم والمعنى إذا كان الله سبحانه هو ربهم لا رب سواه وأمامهم يوم الحساب والجزاء لمن آمن منهم أو كفر فذكرهم بذلك.
وقوله: {إنما أنت مذكر} بيان أن وظيفته – وهو رسول - التذكرة رجاء أن يستجيبوا ويؤمنوا من غير إكراه وإلجاء.
قوله تعالى: {لست عليهم بمصيطر} المصيطر - وأصله المسيطر - المتسلط، والجملة بيان وتفسير لقوله: {إنما أنت مذكر}.
قوله تعالى: {إلا من تولى وكفر} استثناء من المفعول المحذوف لقوله السابق: {فذكر} والتقدير فذكر الناس إلا من تولى منهم عن التذكرة وكفر إذ تذكرته لغولا فائدة فيها، ومعلوم أن التولي والكفر إنما يكون بعد التذكرة فالمنفي بالاستثناء هو التذكرة بعد التذكرة كأنه قيل: ذكرهم وأدم التذكرة إلا لمن ذكرته فتولى عنها وكفر، فليس عليك إدامة تذكرته بل أعرض عنه فيعذبه الله العذاب الأكبر.
فقوله: {فذكر - إلى أن قال - إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر} في معنى قوله: { فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى } [الأعلى: 9 - 12] وقد تقدم بيانه.
وقيل: الاستثناء من ضمير {عليهم} في قوله: {لست عليهم بمصيطر} والمعنى لست عليهم بمتسلط إلا على من تولى منهم عن التذكرة وأقام على الكفر فسيسلطك الله عليه ويأمرك بالجهاد فتقاتله فتقتله.
وقيل: الاستثناء منقطع والمعنى لست عليهم بمتسلط لكن من تولى وكفر منهم يعذبه الله العذاب الأكبر، وما قدمناه من الوجه أرجح وأقرب.
قوله تعالى: {فيعذبه الله العذاب الأكبر} هو عذاب جهنم فالآية كما تقدم محاذية لقوله في سورة الأعلى {الذي يصلى النار الكبرى{.
قوله تعالى: {إن إلينا إيابهم} الإياب الرجوع و{إلينا} خبر إن وإنما قدم للتأكيد ولرعاية الفواصل دون الحصر إذ لا قائل برجوع الناس إلى غير الله سبحانه والآية في مقام التعليل للتعذيب المذكور في الآية السابقة.
قوله تعالى: {ثم إن علينا حسابهم} الكلام فيه كالكلام في الآية السابقة.
_____________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج20 ، ص246-249.
المتعبون.. الأخسرون!
تبتدأ السّورة بذكر اسم جديد ليوم القيامة: {هل أتاك حديث الغاشية}.
«الغاشية»: من (الغشاوة)، وهي التغطية، وسمّيت القيامة بذلك لأنّ حوادثها الرهيبة ستغطي فجاءة كلّ شيء.
وقيل: بما أنّ الأوّلين والآخرين سيجمعون في ذلك اليوم، فالقيامة تغشاهم جميعاً.
وقيل أيضاً: يراد بها نار جهنم، لأنّها ستغطي وجوه الكافرين والمجرمين ويبدو لنا التّفسير الأوّل أنسب من غيره.
وظاهر الآية: إنّها خطاب للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وما حوته من صيغة الإستفهام فلبيان عظمة وأهمية يوم القيامة.
ويبدو بعيداً ما احتمله البعض من كون خطاب الآية موجّه إلى كلّ إنسان.
وتصف الآيات التالية، حال المجرمين في يوم القيامة، فتقول أولاً: {وجوه يؤمئذ خاشعة}.
لا شك أنّ الوضع النفسي والروحي، تنعكس آثاره على وجه صاحبه، لذا فسترى تلك الوجوه وقد علتها علائم الخسران والخشوع لما أصابها من ذلّ وخوف ووحشة وهم بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين أليم.
وقيل: «الوجوه» هنا، بمعنى وجهاء القوم ورؤساء الكفر والطغيان، لما سيكون لهم من ذل وهوان وعذاب أشد من غيرهم.
ولكنّ المعنى الأوّل أنسب.
وتصف حال تلك الوجوه ثانياً: (عاملة ناصبة).
فكلّ ما سعوا وكدوّا فيه في الحياة الدنيا سوف لا يجنون منه إلاّ التعب والنصب، وذلك: لأنّ أعمالهم غير مقبولة عند اللّه، وما جمعوه من أموال وثروات قد ذهبت لغيرهم، ولا يملكون من ذكر صالح يعقبهم في الدنيا ولا ولد صالح يدعو ويستغفر اللّه لهم، فما اصدق هذا القول بحقّهم: (عاملة ناصبة).
وقيل: المراد، إنّهم يعملون في الدنيا، ولهم التعب والألم في الآخرة.
وقيل أيضاً: إنّ المجرمين سيقومون بأعمال شاقّة داخل جهنم، زيادة في عذابهم.
ويبدو التّفسير الأوّل أصح من غيره.
وخاتمة مطاف تلك الوجوه التعبة الذليلة أنّ: {تصلى ناراً حامية}.
«تصلى»: من (صلى) ـ على زنة نفى ـ وهو دخول النّار والبقاء فيها، والإحتراق بها(2).
ولن يقف عذابهم عند هذا الحد، بل أنّهم وبسبب حرارة النيران يصيبهم العطش الشديد وحينئذ: (تسقى من عين آنية).
«آنية»: مؤنث آني من (الأني) ـ على زنة حلي ـ وهوؤالتأخير، ويستعمل لما يقرب وقته، وجاء في الآية بمعنى: الماء الحارق الذي بلغ أقصى درجة حرارته وجاء في الآية (29) من سورة الكهف: {وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا}
وتحكي لنا الآية التالية عن طعام المجرمين: {ليس لهم طعام إلاّ من ضريع} وقد تعددت الآراء في معنى «الضريع».
فقال بعض: نبت ذو شوك لاصق بالأرض، تسمّيه قريش (الشبرق) إذا كان رطباً، فإذا يبس فهو(الضريع)، لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه، وهو سم قاتل.(3)
وقال الخليل (أحد علماء اللغة): الضريع نبات أخضر منتن الريح، يرمي به البحر.
وعن ابن عباس: هو شجر من نار، ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها.
وجاء في الحديث النبوي الشريف: «الضريع شيء يكون في النّار يشبه الشوك، أشدّ مرارة من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأحر من النّار، سمّاه اللّه ضريعاً».
وقال بعض آخر: هو طعام يضرعون عنده ويذلون، ويتضرعون منه إلى اللّه تعالى طلباً للخلاص منه.(4)
(ويُذكر أن (الضرع) بمعنى الضعف والذلة والخضوع).(5)
ولا تعارض بين هذه التفاسير، ويمكن قبولها كلها في تفسير الآية المذكورة.
وتصف لنا الآية التالية ذلك الطعام: (لا يُسمن ولا يُغني من جوع).
فهو ليس لسد جوع أو تقوية بدن، وإنّما هو طعام يغص به، ايغالاً في العذاب، كما ورد هذا المعنى في الآية (13) من وسورة المزمل: { وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا} [المزمل: 13].
فالذين شرهوا في تناول ألذ المأكولات في دنياهم، على حساب ظلم النّاس والتجاوز على حقوقهم، ومنعوا لقمة العيش عن كثير من المحرومين، فليس في طعام آخرتهم سوى العذاب الأليم.
ونعود لنكرر القول: إنّ ما نصفه ونتصوره عن نعيم الجنّة وعذاب جهنم، لا يتعدى عن كونه مجرد إشارات وأشباح نراها من بعيد ونحن نعيش في سجن الدنيا المحدود، وإلاّ فحقيقة ما سينعم به أهل الجنّة وما يعانيه أهل النّار فمما لا يمكن لأحد وصفه!.
وقوله تعالى : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَّاعِمَةٌ(8) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ(9) فِى جَنَّة عَالِيَة(10) لاّ تَسْمَعُ فِيَها لَغِيَةً(11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ(12) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ(13) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ(14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ(15) وَزَرَابِىٌّ مَبْثُوثَةٌ}
صورٌ من نعيم الجنّة:
بعد ذكر ما سيتعرض له أهل النّار، تنتقل عدسة السّورة لتنقل لنا مشاهداً رائعة لنعيم أهل الجنّة.. ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر الإلهي والرحمة الإلهية، وما بين الوعيد والبشارة.
فتقول الآية الاُولى: {وجوهٌ يومئذ ناعمة}، على عكس وجوه المذنبين المكسوة بعلائم الذلة والخوف.
«ناعمة»: من (النعمة)، وتشير هنا إلى الوجوه الغارقة في نعمة اللّه، وجوه طرية، مسرورة ونورانية، كما أشارت لهذا الآية (24) من سورة المطففين: {تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} [المطففين: 24].
وترى الوجوه: {لسعيها راضية}.
على عكس أهل جهنّم، فوجوههم «عاملة ناصبة»، أمّا أهل الجنّة، فقد حان وقت حصادهم لما زرعوا في دنياهم، وحصلوا عى أحسن ما يتمنون، فتراهم في غاية الرضى والسرور.
وما زرعوا سيتضاعف ناتجه بإذن اللّه ولطفه أضعافاً مضاعفة، فتارة عشرة أضعاف، واُخرى سبعمائة ضعف، وثالثة يجازون على ما عملوا بغير حساب، كما أشارت الآية (10) من سورة الزمر إلى ذلك بقولها: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [الزمر: 10] ويدخل البيان القرآني في التفصيل أكثر: {في جنّة عالية}.
«عالية»: قيل بإرادة المكان (في طبقات الجنّة العليا)، وقيل اُريد بها المقام الرفيع، ومع أنّ التّفسير الثّاني أرجح، إلاّ أنّه لا مانع من الجمع بينهما:
وكذا.. : {لا تسمع فيها لاغية}.(6)
فليس هناك ثمّة: جدال، كلام نفاق، عداوة، حقد، حسد، كذب، تهمة، إفتراء، غيبة ولا أيّ إيذاء، بل ولا حتى الكلام الفارغ.
فهل يوجد مكان أهدأ وأجمل من ذلك؟!
ولو تأملنا حقيقة مشاكلنا فيما بيننا، لرأينا أنّ الغالب منها ما كان ناشئاً عن سماع هكذا أحاديث، والتي تؤدي إلى عدم الإستقرار النفسي، وإلى تهديم أركان الترابط الإجتماعي فينهار النظام وتشتعل نيران الفتن لتأكل الأخضر واليابس معاً.
وبعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجنّة من نعمة روحية، يبيّن بعض النعم المادية في الجنّة: (فيها عين جارية).
ظاهر كلمة «عين» في الآية، إنّها عين واحدة بدليل مجيئها نكرة، إلاّ أنّه بالرجوع إلى بقية الآيات في القرآن الكريم، يتبيّن لنا إنّها للجنس، فهي والحال هذه تشمل عيوناً مختلفة، ومن قرائن ذلك ما جاء في الآية (15) من سورة الذاريات: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } [الحجر: 45].
وقيل: في كلّ قصر من قصور أهل الجنّة، ثمّة «عين جارية»، وهو المراد في الآية، ومن ميزة تلك الأنهار أنّها تجري حسب رغبة أهل الجنّة، فلا داعي معها لشقّ أرض أو وضع سد.
وينهل أهل الجنّة أشربة طاهرة ومتنوعة، فتلك العيون وعلى ما لها من رونق وروعة، فلكلّ منها شراب معين له مواصفاته الخاصّة به.
وينتقل الوصف إلى أسرة الجنّة: {فيها سرر مرفوعة}.
«سرر»: جمع (سرير)، وهومن (السرور)، بمعنى المقاعد التي يجلس عليها في مجالس الاُنس والسرور(7).
وجعلت تلك الأسرة من الإرتفاع بحيث يتمكن أهل الجنّة من رؤية كلّ ما يحيط بها والتمتع بذلك.
يقول ابن عباس: إذا أراد أن يجلس عليها، تواضعت له حتى يجلس عليها، ثمّ ترتفع إلى موضعها.(8)
ويحتمل أيضاً: وصفت بالمرفوعة إشارة إلى رفعتها وعلو شأنها.
وقيل: إنّها من الذهب المزين والمرصع بالزبرجد والدرّ والياقوت.
ولا مانع من الجمع بين ما ذكر.
ولمّا كان شرب الشراب يستلزم ما يشرب به، فقد قالت الآية التالية: {وأكواب موضوعة}.
ومتى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلك الأكواب لتصل بين أيديهم وقد ملئت من شراب تلك العيون، فيستلذون بما لا وصف له عند أهل الدنيا.
«أكواب»: جمع (كوب)، وهو القدح، أو الظرف الذي له عروة.
وبالاضافة إلى ذكر الـ «أكواب» فقد ذكر القرآن الكريم تعابير اُخرى لها، مثل: «أباريق» جمع (ابريق) وهو ظرف معروف، و«كأس» بمعنى القدح المملوء بالشراب، كما جاء في الآيتين (17) و(18) من سورة الواقعة: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ} [الواقعة: 17، 18] ويستمر الحديث عن جزئيات نعيم الجنّة: {ونمارق مصفوفة}.
«نمارق»: جمع (نمرقة)، وهي الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها.
«مصفوفة»: إشارة إلى تعددها بنظم خاص، ليظهر أنّ لأهل الجنّة جلسات اُنس جماعية، التي لا يتخللها أي لغو وباطل، ويدور الحديث فيها حول الألطاف الإلهية ونعمة الخالدة، وعن الفوز الحقيقي الذي أبعدهم عن عذاب الآخرة، وكيف أنّهم قد نجوا وخلصوا من الآم وأتعاب الدنيا.
ثمّ تكون الإشارة إلى فرش الجنّة الفاخرة: {وزرابيّ مبثوثة}.
«زرابية»: جمع (زرب) أو(زربيّة)، وهي الفرش والبسط الفاخرة ذات المتكأ.
ذكرت الآيات المبحوثة سبع نعم رائعة من نعم الجنّة، وكلّ منها أكثر روعة من الاُخرى.
والخلاصة: فمنزل الجنّة لا مثيل له من كلّ الجهات، فهو الخالي من أي ألم أو عذاب أو حرب أو جدال.. وتجد فيه كلّ ألوان الثمار والأنعام والعيون الجارية والأشربة الطاهرة والولدان المخلدين والحور العين والأسرة المرصعة والفرش الفاخرة وأقداح جميلة في متناول اليد وجلساء أصفياء، إلى غير ذلك ممّا لا يمكن عدّه بلسان أو وصفه بقلم ولا حتى تخيله إذا ما سرحت المخيّلة في عالمها الرحب!..
وكلّ ما ذكر وغيره سيكون في انتظار من آمن وعمل صالحاً، بعد حصوله على إذن الدخول إلى تلك الدار العالية.
وفوق هذا وذاك فثمّة «لقاء اللّه»، الذي ليس من فوز يوازيه.
وقوله تعالى : {أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ(17) وإِلَى السَّمِآءِ كَيفَ رُفِعَتْ(18) وَإِلَى الجِبَالِ كَيفَ نُصِبَتْ(19) وَإِلَى الأَرْضِ كَيفَ سُطِحَتْ(20) فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ(21) لَّستَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر(22)إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ العَذَابَ الأَكْبَرَ (24) إنَّ إِلَينَآ إِيَابَهُمْ(25) ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا حِسَابَهُم}.
الابل.. من آيات خلق اللّه:
بعد أن تحدثت الآيات السابقة بتفصيل عن الجنّة ونعيمها، تأتي هذه الآيات التوضح معالم الطريق الموصل إلى الجنّة ونعيمها.
فمفتاح المعرفة «معرفة اللّه»، ووصولاً لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإلهية وبديع الخلقة، داعية الإنسان للتأمل، عسى أن يصل إلى ما ينبغي له أن يصل إليه.
وتشير أيضاً إلى أنّ قدرة اللّه المطلقة هي مفتاح درك المعاد..
فتقول الآية الاُولى: {أفلا ينظرون إلَى الإبل كيف خلقت}.
ولكن، لِم اختص ذكر «الإبل» قبل غيره؟
للمفسّرين حديث طويل في ذلك، لكنّ الواضح إنّ الآيات في أوّل نزولها كانت تخاطب أهل مكّة قبل غيرهم، والإبل أهم شيء في حياة أهل مكّة في ذلك الزمان، فهي معهم ليل نهار وتنجز لهم ضروب الأعمال وتدر عليهم الفوائد الكثيرة.
أضف إلى ذلك أنّ لهذا الحيوان خصائص عجيبة قد تفرّد بها عن بقية الحيوانات، ويعتبر بحق آية من آيات خلق اللّه الباهرة.
ومن خصائص الإبل:
1 ـ لو نظرنا إلى موارد الإستفادة من الحيوانات الأليفة، فسنرى أنّ قسماً منها لا يستفاد إلاّ من لحومها، والقسم الآخر يستفاد من ألبانها على الأغلب، وقسم لا يستفاد منه إلاّ في الركوب، وقسم قد تخصص في حمل ونقل الأثقال، ولكنّ الإبل تقدم كلّ هذه الخدمات (اللحم، اللبن، الركوب والحمل).
2 ـ قدرة حمل وتحمل الإبل أكثر بكثير من بقية الحيوانات الأهلية، حتى أنّها لتبرك على الأرض فتوضع الأثقال عليها ثمّ تنهض بها، وهذا ما لا تستطيع فعله بقية الحيوانات الأهلية.
3 ـ تتحمل العطش لأيّام متتالية (بين السبعة إلى عشرة أيّام)، وقابليتها على تحمل الجوع مذهلة.
4 ـ يطلق عليها اسم (سفينة الصحراء)، لما لها من قابلية فائقة على طي مسافات طويلة في اليوم الواحد، رغم الظروف الصحراوية الصعبة، فلا يعرقل حركتها صعوبة الأرض أوكثرة المنخفضات الرملية، وهذا ما لا نجده في أي حيوان أخر وبهذه المواصفات.
5 ـ مع إنّها تتغذى على أي شوك وأيّ نبات، فهي تشبع بالقليل أيضاً.
6 ـ لعينها واُذنها وأنفها قدرة كبيرة على مقاومة الظروف الجوية الصعبة في الصحراء، وحتى العواصف الرملية لا تقف حائلاً أمام مسيرها.
7 ـ والإبل مطيعة وسهلة الإنقياد، لدرجة أنّ بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام مجموعة كبيرة من الإبل وتتحرك معه حيث يريد.
والخلاصة: إنّ ما يتمتع به هذا الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى.
وها هو القرآن ينادي بكلّ وضوح: يا أيّها الضالون في وادي الغفلة ألاّ تتفكرون في كيفية خلق الإبل، لتعرفوا الحق وتخرجوا من ضلالكم؟!
ولابدّ من التذكير، بأنّ «النظر» الوارد في الآية، يراد به النظر الذي يصحبه تأمل ودراسة.
وينتقل بنا البيان القرآني في الإبل إلى السماء: {وإلى السماء كيف رفعت}.
السماء التي حيّرت العقول بعظمتها وعجائبها وما فيها من نجوم وما لها من بهاء وروعة.. السماء التي يتصاغر وجود الإنسان أمامها ليعد لا شيء بالنسبة لها.. السماء التي لها من دقّة التنظيم والحساب الدقيق ما بهر فيها عقول العلماء المتخصصين.
ألا ينبغي للإنسان أن يتفكر في أمر مدبر هذا الخلق، وما الأهداف المرجوة من خلقه؟!
فكيف أصبحت تلك الكواكب في مساراتها المحدودة؟ وما هو سرّ استقرارها في أماكنها وبكلّ هذه الدقّة؟ ولِمَ لَم يتغيّر محور حركتها بالرغم من مرور ملايين السنين عليها؟!!!
ومع تطور الإكتشافات العلميّة الحديثة، نرى أنّ عالم السماء وما يحويه يزداد عظمة وجلالاً بدرجات ملموسة نسبة إلى ما كان عليه قبلاً...
مع كلّ هذا وذاك، ألا يكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل والتفكير، والخضوع والتسليم لربوبية الخالق الواحد الأحد؟!
وينقلنا إلى الجبال: {وإلى الجبال كيف نصبت}.
الجبال التي تشمخ بتعمق جذورها في باطن الأرض، وتحيط بالأرض على شكل حلقات وسلاسل لتقلل من شدّة الزلازل الناشئة من ذوبان المواد المعدنية في باطن الأرض، وكذا ما لها من دور في حفظ الارض من عملية المدّ والجزر الناشئة من تأثيرات الشمس والقمر.. الجبال التي لولا وجودها بهذه الهيئة لما توفرت ظروف عيش الإنسان على سطح الأرض، لما تمثله من سد منيع أمام قوّة أثر العواصف.. وأخيراً، الجبال التي تحفظ الماء في داخلها لتخرجه لنا على صورة عيون فياضة نعم الأرض ليخضر بساطها بأنواع المزارع والغابات.
ولعل ذلك كلّه كان وراء وصفها «أوتاداً» في القرآن الكريم.
فهي عموماً.. مظهر الاُبهة والصلابة والشموخ، وهي مصدر خير وبركة معطاة، ولعل ذلك من علل تفتح ذهنية الإنسان عندها، كما وليس من العبث أن يتّخذ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) جبل النور وغار حراء محلاً لعبادته قبل البعثة المباركة.
«نصبت»: من (النصب)، وهو التثبيت، وربّما رمز هذا التعبير إلى بداية خلق الجبال أيضاً.
فقد توصل العلم الحديث إلى أنّ تكّون الجبال يعتمد على عوامل عديدة وقسمها إلى عدّة أنواع:
فمنها: ما تكون نتيجة للتراكمات الحاصلة على الأرض.
ومنها: ما تكون من الحمم البركانية.
ومنها: ما تكون نتيجة لتفتت الأرض بواسطة الأمطار.
وكذا منها: ما تكون نتيجة للترسبات الحاصلة في أعماق البحار ومن بقايا الحيوانات (كالجبال والجزر والمرجانية).
نعم، فالجبال وبكلّ ما فيها ولها تعدّ آية من آيات القدرة الإلهية، لمن رآها بعين بصيرة ولبٍّ شغول.
ثمّ إلى الأرض: {وإلى الأرض كيف سطحت}.
فلينظر الإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأتربة كي تتكون بها السهول الصافية، لتكون صالحة للزراعة من جهة ومهيئة لما يعمل بها الإنسان من جهة اُخرى.. ولو كانت كلّ الأرض عبارة عن جبال ووديان، فما أصعب الحياة على سطحها والحال هذه!
ولابدّ لنا من التأمل والتفكير في مَن جعلها تكون على هذه الهيئة الملائمة تماماً لحياة الإنسان؟..
ولكن، ما علاقة الربط بين الإبل والسماء والجبال والأرض، حتى تذكرها الآيات بهذا التوالي؟
يقول الفخر الرازي في ذلك: إنّ القرآن نزل على لغة العرب، وكانوا يسافرون كثيراً لأنّ بلدتهم بلدة خالية من الزراعية، وكانت أسفارهم في أكثر الأمر على الإيل، فكانوا كثيراً ما يسيرون عليها في المهامة والقفار مستوحشين، منفردين عن النّاس، ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياء، لأنه ليس معه مَن يحادثه، وليس هناك شيء يشغل به سمعه وبصره، وإذا كان كذلك لم يكن له بدّ من أن يشغل باله بالفكرة، فإذا فكر في ذلك وقع بصره أوّل الأمر على الجمل الذي ركبه، فيرى منظراً عجيباً، وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء، وإذا نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال، وإذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرض، فكأنّه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والإنفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظر، ثمّ إنّه في وقت الخلوة في المفازة البعيدة لا يرى شيئاً سوى هذه الأشياء، فلا جرم جمع اللّه بينها في هذه الآية(9).
وإذا ما ابتعدنا المحيط العربي القديم وما كان فيه، وتوسعنا في مجال تأملنا ليشمل كلّ محيط البشرية، لتوصلنا إلى أنّ هذه الإشياء الأربع تدخل في حياة الإنسان بشكلً رئيسي، حيث من السماء مصدر النور والأمطار والهواء، والأرض مصدر نمو أنواع النباتات وما يتغذى به، وكذا الجبال فبالإضافة لكونها رمز الثبات والعلو ففيها مخازن المياه والمواد المعدنية بألوانها المتنوعة، وما الإبل إلاّ نموذج شاخص متكامل لذلك الحيوان الأهلي الذي يقدّم مختلف الخدمات للإنسان.
وعليه، فقد تجمعت في هذه الأشياء الأربع كلّ مستلزمات «الزراعة» و«الصناعة» و«الثروة الحيوانية»، وحريّ بالإنسان والحال هذه أن يتأمل في هذه النعم المعطاءة، كي يندفع بشكل طبيعي لشكر المنعم سبحانه وتعالى، وبلا شك فإنّ شكر المنعم سيدعوه لمعرفة خالق النعم أكثر فأكثر.
وبعد هذا البحث التوحيدي، يتوجه القرآن الكريم لمخاطبة النّبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): {فذكّر إنّما أنت مذكر}.. {لست عليهم بمصيطر}.
نعم، فخلق السماء والأرض والجبال والحيوانات ينطق بعدم عبثية هذا الوجود، وأنّ خلق الإنسان إنّما هو لهدف...
فذكّرهم بهدفية الخلق، وبيّن لهم طريق السلوك الربّاني، وكن رائدهم وقدوتهم في مسيرة التكامل البشري.
وليس باستطاعتك إجبارهم، وإن حصل ذلك فلا فائدة منه، لأنّ شوط الكمال إنّما يقطع بالإرادة والإختيار، وليس ثمّة من معنى للتكامل الإجباري.
وقيل: إنّ هذا الأمر الإلهي نزل قبل تشريع «الجهاد»، ثمّ نسخ به!
وما أعظم هذا الإشتباه!!
فرسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) مارس عملية التذكير والتبليغ منذ الوهلة الاُولى للبعثة الشريفة واستمر على هذا النهج حتى آخر لحظة من حياته الشريفة المباركة، ولم تتوقف العملية عن الممارسة من بعده، حيث قام بهذه المهمّة الأئمّة(عليهم السلام) والعلماء من بعدهم، حتى وصلت ليومنا وسوف لن تتوقف بإذن اللّه تعالى، فأيّ نسخ هذا الذي يتكلمون عنه!
ثمّ إنّ عدم إجبار النّاس على الإيمان يعتبر من ثوابت الشريعة الإسلامية السمحاء، أمّا هدف الجهاد فيتعلق بمحاربة الطغاة الذين يقفون حجر عثرة في طريق دعاة الحقّ وطالبيه.
وثمّة آيات اُخرى في القرآن قد جاءت في هذا السياق، كالآية (80) من سورة النساء: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا } [النساء: 80] ، وكذا الآية (107) من سورة الأنعام، والآية (48) من سورة الشورى ـ فراجع
«مصيطر»: من (السطر)، وهو المعروف في الكتب، و(المسيطر): الذي ينظم السطور، ثمّ استعمل لكلّ مَن له سلطة على شيء، أو يجبر أحداً على عمل ما.
وفي الآيتين التاليتين.. يأتي الإستثناء ونتيجته: {إلاّ مَن تولى وكفر}.. {فيعذبه اللّه العذاب الأكبر}.
ولكن، إلى أية جملة يعود الإستثناء؟
ثمّة تفاسير مختلفة في ذلك:
الأوّل :إنّه استثناء لمفعول الجملة «فذكّر»، أي: لا ضرورة لتذكير المعاندين الذين رفضوا الحق جملة وتفصيلا، كما جاء في الآية (83) من سورة الزخرف: { فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} [الزخرف: 83].
الثّاني: إنّه استثناء لجملة محذوفة، والتقدير: فذكّر إنّ الذكرى تنفع الجميع إلاّ من تولى وكفر، كما جاء في الآية (9) من سورة الأعلى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} [الأعلى: 9] ، (على أن يكون لها معناً شرطياً).
الثّالث: إنّه استثناء من الضمير «عليهم» في الآية السابقة، أي: (إنّك لست عليهم بمصيطر إلاّ مَن تولّى وكفر فأنت مأمور بمواجهاه).(10)
كلُّ ما ذُكِر من تفاسير مبنيٌّ على أنّ الإستثناء متصل، ولكن ثمّة من يقول بأنّ الإستثناء منقطع، فيكون معناه بما يقارب معنى (بل)، فيصبح معنى الجملة: (بل مَن تولّى وكفر فإنّ اللّه متسلط عليهم) أو(إنّه سيعاقبهم بالعذاب الأكبر).
ومن بين هذه التفاسير، ثمّة تفسيران مناسبان.
الأوّل: القائل بالإستثناء المتصل لجملة (لست عليهم بمصيطر) فيكون إشارة لاستعمال القوّة في مواجهة مَن تولى وكفر.
الثّاني: القائل بالإستثناء المنفصل، أيّ، سينالهم العذاب الأليم، الذي ينتظر المعاندين والكافرين.
ويراد بـ (العذاب الأكبر) «عذاب الآخرة» الذي يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم وسعة عذاب الآخرة، بقرينة الآية (26) من سورة الزمر: {فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ} [الزمر: 26].
وكذلك يحتمل إرادة نوع شديد من عذاب الآخرة، لأنّ عذاب جهنم ليس بمتساو للجميع.
وبحدّية قاطعة، تقول آخر آيتين في السّورة: {إنّ إلينا إيابهم}.. {ثمّ إنّ علينا حسابهم}.
والآيتان تتضمّنان التسلية لقلب النّبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في مواجهته لأساليب المعاندين، لكي لا يبتئس من أفعالهم، ويستمر في دعوته.
وهما أيضاً، تهديد عنيف لكلّ مَن تسول له نفسه فيقف في صف الكافرين والمعاندين، فيخبرهم بأنّ حسابهم سيكون بيد جبار شديد!
بدأت سورة الغاشية بموضوع القيامة وختمت به أيضاً، كما تمّت الإشارة فيما بين البدء والختام إلى بحث التوحيد والنّبوة، وهما دعامتا المعاد.
كما وتضمّنت السّورة عرضاً لبعض ما سيصيب المجرمين من عقاب، وعرضت في قبال ذلك ما سينعم به المؤمنون في جنّات النعيم الخالدة.
كما وأكّدت السّورة على حرية الإنسان في اختيار الطريق الذي يسلكه، وذكّرت بعودة الجميع إلى مولاهم الحق، وهو الذي سيحاسبهم على كلّ ما فعلوا في دنياهم
كما وبيّنت السّورة أن مهمّة الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) هي إبلاغ الرسالة، وأنّه غير مسؤول عن كفر وانحراف النّاس وذنوبهم، وهذه هي مهمّة مبلغي طريق الحقّ.
_____________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ،ج15 ، ص 274-287.
2 ـ صلي بالنّار، لزمها واحترق بها.
3 ـ تفسير القرطبي، ج10، ص7119.
4 ـ تفسير القرطبي، ج10، ص7120.
5 ـ بحثنا موضوع طعام أهل النّار، الذي يسميه القرآن تارة بـ «الضريع» واُخرى بـ «الزقوم» وثالثة بـ «غسلين»، وما بينها من تفاوت.. في ذيل الآية (36) من سورة الحاقة.
6 ـ «لاغية»: بالرغم من كونها اسم فاعل، ولكنّها تأتي بما يرادف (اللغو)، أي (ذات لغو).
7 ـ مفردات الراغب، مادة (سرّ).
8 ـ مجمع البيان، ج10، ص479.
9 ـ تفسير الفخر الرازي، ج31، ص158.
10 ـ ونستفيد من حديث شريف ورد في (الدرّ المنثور).. أنّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كان
مأموراً بمحاربة عبدة الأصنام، وفي غير ذلك فهو مأمور بالتذكير.

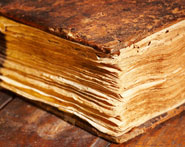
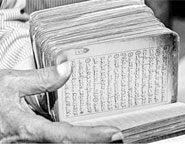
|
|
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|