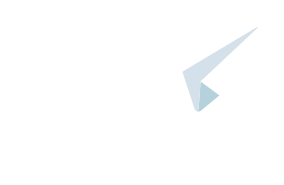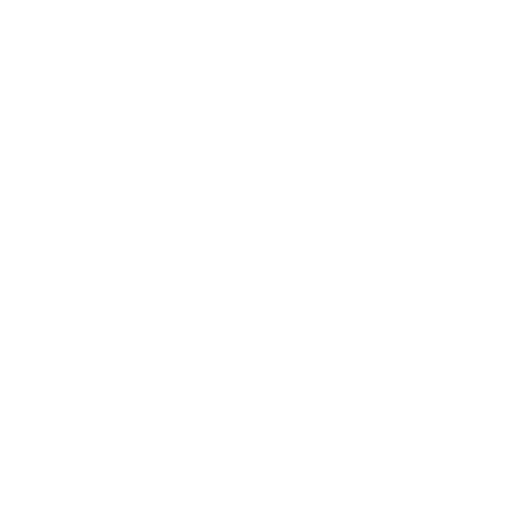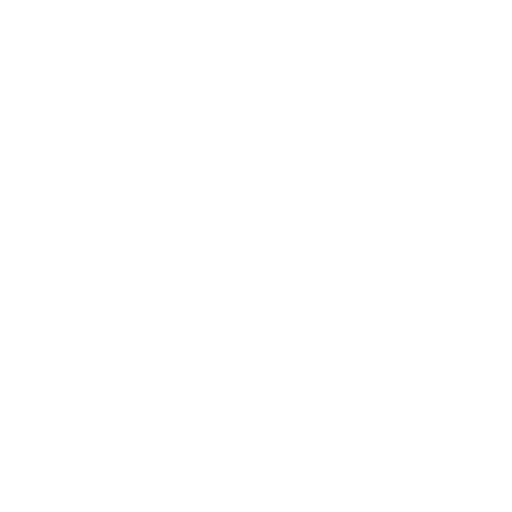تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
عذوبة ألفاظه وسلاسة عباراته
المؤلف:
محمّد هادي معرفة
المصدر:
تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص129-133.
5-11-2014
3288
قد أجمل الكلام في ذلك الجرجانيّ والسكاكيّ وغيرهما من أعلام البيان من المتقدّمين ، ( وتقدّم بعض كلامهم ) ، وأكمله النُقّاد من المتأخّرين المعاصرين ، قالوا :
لو تدبّرت ألفاظ القرآن في نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها ، ولن تجدها إلاّ مؤتلفة مع أصوات الحروف ، مساوقة لها في النظم الموسيقي ، حتى أنّ الحركة ربّما كانت ثقيلة فلا تعذب ولا تُساغ في نفسها ، فإذا هي استُعملت في القرآن رأيت لها شأناً عجيباً ، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي ، حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقّه ، وكانت متمكّنة في موضعها ، وكانت لهذا الموضع أَولى الحركات بالخفّة والروعة .
من ذلك لفظة ( النُذُر ) جمع نذير ، فإنّ الضمّة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معاً ، فضلاً عن جَسأة هذا الحرف ونبوّه في اللسان ، وخاصة إذا جاءت فاصلة للكلام .
ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى {وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ} [القمر : 36] فتأمّل هذا التركيب ، وأنعِم ثُمّ أنعِم على تأمّله ، وتذوّق مواقع الحروف ، واجرِ حركاتها في حسّ السمع ، وتأمّل مواضع القلقلة في دال ( لقد ) ، وفي الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو ( تماروا ) مع الفصل بالمدّ كأنّها تثقيل ، لخفّة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان ؛ ليكون ثقل الضمّة عليه مستخفاً بعد ، ولكون هذه الضمّة قد أصابت موضعها ، كما تكون الأحماض في الأطعمة ، ثُمّ ردّد نظرك في الراء من ( تماروا ) فإنّها ما جاءت إلاّ مساندة لراء ( النذر ) حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها ، فلا تجفو عليه ، ولا تغلظ ولا تنبو فيه . ثُمّ اعجب لهذه الغنّة التي سبقت الطاء في نون ( أنذرهم ) وفي ميمها ، وللغنّة الأُخرى التي سبقت الذال في ( النُذُر ) .
وما من حرف أو حركة في الآية إلاّ وأنت مصيب من كلّ ذلك عجباً في موقعه والقصد به ، حتى ما تشكّ أنّ الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركة ، ليس منها إلاّ ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدّم فيه النظر وأحكمته الرويّة ومن بين الكلمات ، وأين هذا ونحوه عند تعاطيه ! ومن أيّ وجه يلتمس! وعلى أيّ جهة يستطاع !
وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع ممّا يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه ، ولكنّها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في نظمه مخرجاً سرياً ، فكانت من أخصر الألفاظ حلاوةً وأعذبها منطقاً وأخفّها تركيباً ؛ إذ تراه قد هيّأ لها أسباباً عجيبةً من تكرار الحروف وتنوّع الحركات ، فلم يُجرِها في نظمه إلاّ وقد وجد ذلك فيها ، كقوله تعالى : {يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ } [النور : 55] فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف ، وقد جاءت عذوبتها من تنوّع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها ، فإنّها بذلك صارت في النطق كأنّها أربع كلمات ؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع .
وقوله : {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ } [البقرة : 137] فإنّها كلمة من تسعة أحرف ، وهي ثلاثة مقاطع ، وقد تكرّرت فيها لا الياء والكاف ، وتوسط بين الكافين هذا المدّ ( في ) الذي هو سرّ الفصاحة في الكلمة كلّها .
واللفظة إذا كانت خماسية الأُصول فهذا لم يرد منه في القرآن شيء ؛ لأنّه ممّا لا وجه للعذوبة فيه ، إلاّ ما كان من اسم عُرّب ولم يكن عربيّاً : كإبراهيم ، وإسماعيل ، وطالوت ، وجالوت ، ونحوها ، ولا يجيء به مع ذلك إلاّ أن يتخلّله المدّ كما ترى ، فتخرج الكلمة وكأنّها كلمتان .
وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه ، وما حسُنت في كلام قطّ إلاّ في موقعها من القرآن بالذات ، وهي كلمة ( ضِيزَى ) من قوله تعالى : {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} [النجم : 22] ، ومع ذلك فإنّ حسنها في نظم الكلام هنا من أغرب الحسن وأعجبه ، وإذا أدرت اللغة عليها ما صلُح لهذا الموضع غيرها .
فإنّ السورة التي هي منها ـ وهي سورة النجم ـ مفصّلة كلّها على الياء ، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ، ثُمّ هي في معرض الإنكار على العرب ، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد ، فإنّهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع وأدهم البنات فقال تعالى : {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} [النجم : 21، 22] ، فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشياء ملائمة لغرابة هذه القِسمة التي أنكرها عليهم ، وكانت الجملة كلّها كأنّها تصوّر في هيئة النطق بها ، الإنكار في الأُولى والتهكّم في الأُخرى ، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة ، وخاصّة في اللفظ الغريبة التي تمكّنت في موضعها من الفصل ، ووصفت حالة المتهكّم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى ، وجمعت إلى كلّ ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية .
وإن تعجب فعاجِب لنظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافه على ما قبلها ، إذ هي مقطعان : أحدهما مدّ ثقيل : والآخر مدّ خفيف ، وقد جاءت عقب غنّتين في ( إذا) و( قِسمة ) إحداهما خفيفة حادّة ، والأُخرى ثقيلة متفشّية ، فكأنّها بذلك ليست إلاّ مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي .
ثُمّ الكلمات التي يُظنّ أنّها زائدة في القرآن ـ كما يقوله بعض النحاة ـ فإنّ فيه من ذلك أحرفاً ، كقوله تعالى : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وقوله : {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} [يوسف : 96].
قالوا : إنّ ( ما ) في الآية الأُولى و( أن ) في الثانية ، زائدتان ، أي في الإعراب ، فيَظنّ مَن لا بصر له أنّهما كذلك في النظم ويقيس عليه !
مع أنّ في هذه الزيادة لوناً من التصوير ، لو حُذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته ، فإنّ المراد بالآية الأُولى تصوير لِين النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لقومه ، وأنّ ذلك رحمة من الله ، فجاء هذا المدّ في ( ما ) وصفاً لفظياً يُؤكّد معنى اللين ويُفخّمه ، وفوق ذلك فإنّ لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق ، ثمّ كان الفصل بين الباء الجارّة ومجرورها ـ وهو لفظ ( رحمة ) ـ ممّا يُلفت النفس إلى تدبّر المعنى ويُنبّه الفكر على قيمة الرحمة فيه ، وذلك كلّه طبعي في بلاغة الآية كما ترى .
والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه ؛ لبُعد ما كان بين يوسف وأبيه ( عليهما السلام ) وأنّ ذلك كأنّه كان منتظراً بقلق واضطراب (1) تُؤكّدهما وتصف الطرب لمَقدمه واستقراره غنّةُ هذه النون في الكلمة الفاصلة ، وهي : ( أن ) في قوله ( أن جاء ... ) .
وعلى هذا يجري كل ما ظُنّ أنّه في القرآن مزيد ، فإنّ اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها إنّما هو نقص يجلّ القرآن عنه ، وليس يقول بذلك إلاّ رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره ... فما في القرآن حرف واحد إلاّ ومعه رأي يسنح في البلاغة ـ من جهة نظمه ، أو دلالته ، أو وجه اختياره ـ بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة غير محكمة أو شيء ممّا تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أيّ أبواب الكلام إن وسعها منه باب .
وممّا يدلّ على أنّ نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر ، ولا يسعه طوق إنسان في نظم الكلام البليغ الجمع ولم يستعمل بصيغة الإفراد ، فإذا احتيج إلى صيغة المفرد استعمل مرادفها ، كلفظة ( اللبّ ) لم ترد إلاّ مجموعة {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [الزمر : 21] ، {لِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [إبراهيم : 52] ونحوهما (2) ولم تجئ فيه مفردة ، بل جاء مكانها ( القلب ) (3) أو ( الفؤاد ) (4) .
وذلك لأنّ لفظ الباء شديد مجتمع ، ولا يفضي إلى هذه الشدّة إلاّ من اللام الشديدة المسترخية ، فلمّا لم يكن ثَمّ فصل بين الحرفين ليتهيّأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدّة فتحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها ، نصباً أو رفعاً أو جرّاً ؛ ولذلك أسقطها القرآن من نظمه تبّةً ، على سعة ما بين أَوّله وآخره .
ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة ، كما في لفظة ( الجبّ ) وهي في وزنها ونطقها ، لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدّة في الجيم المضمومة .
وكذلك لفظة ( الكوب ) استعملت فيه مجموعة ولم يأتِ بها مفردة ؛ لأنّه لم يتهيّأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهور والرقّة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ ( الأكواب ) الذي هو جمع .
و( الأرجاء ) لم يَستعمل القرآن لفظها إلاّ مجموعاً ، وتَرك المفرد ـ وهو الرَّجا أي الجانب ـ لعلّةِ لفظه وأنّه لا يسوق في نظمه كما ترى .
وعكس ذلك لفظة ( الأرض ) فإنّها لم ترد فيه إلاّ مفردة ، فإذا ذُكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه ، ولم يجئ ( أرضون ) لهذه الجَسأة التي تدخل اللفظ ويختلّ بها النظم اختلالاً .
ومن الألفاظ لفظة ( الآجر ) وليس فيها من خفّة التركيب إلاّ الهمزة وسائرها نافر متقلقل ، ولفظ مرادفها ( القَرْمَد ) وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهما ، أمّا القرآن فلم يستعملهما ولكنّه أخرج معناهما بألطف عبارة وأرقّها وأعذبها ، وساقها في بيان مكشوف ، وذلك في قوله تعالى : {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا } [القصص : 38] ، فعبّر عن الآجر بقوله : {فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ} [القصص : 38] وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها من رقّة اللام ، فإنّها في أثناء التلاوة ممّا لا يُطاق أن يُعبّر عن حسنه وكأنّما تَنتزع النفس انتزاعاً .
وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب ، ولكن ما ترمي إليه إعجاز آخر ، فإنّها تُحقّر من شأن فرعون وتصف ضلاله وتُسفّه رأيه ؛ إذ طمع أن يبلغ الأسباب ، أسباب السماوات فيطّلع إلى إله موسى (5) ، وهو لا يجد وسيلةً إلى ذلك المستحيل ولو نصب الأرض سُلّماً ، إلاّ شيئاً يصنعه هامان من الطين (6) .
_____________________
(1) يُنبه على ذلك قوله تعالى قبل ذلك عن لسان يعقوب : ( إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ) ( يوسف : 94 ) .
(2) في ستة عشر موضعاً من القرآن جاءت اللفظة بصيغة الجمع فقط ، ولم تأتي إفراداً أبداً .
(3) في تسعة عشر موضعاً إمّا مقطوعاً أو مضافاً .
(4) في خمسة مواضع مقطوعاً ومضافاً .
(5) إشارة إلى الآية : 37 من سورة غافر .
(6) اقتضاب عاجل من إعجاز القرآن للرافعي : ص228 ـ 234 .
 الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












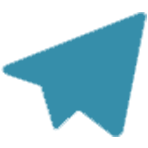
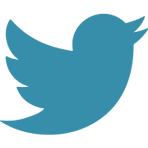

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)