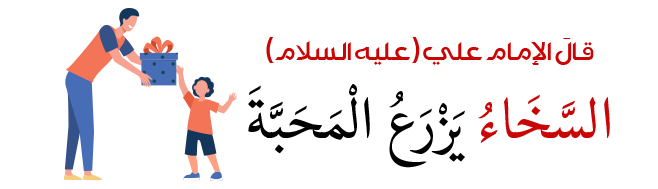
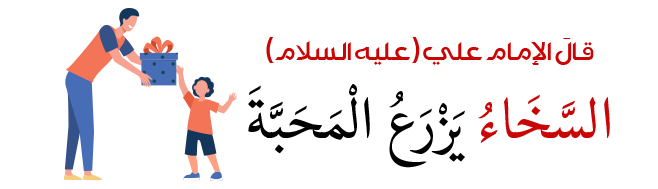

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-10-2019
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 19-7-2020
|
قبل الدخول في هذا البحث لابدّ من رسم اُمور ثلاثة:
الأمر الأول: أنّ الظنّ وبتعبير آخر: أنّ الأمارات الظنّية ليست بحجّة ذاتاً، أي ليست الحجّية من لوازمها الذاتيّة كما في القطع (مع قطع النظر عمّا مرّ منّا في مبحث القطع من أنّه لا معنى لحجّية القطع بمعنى كونه طريقاً إلى الواقع بل هو نفس النظر إلى الواقع ومشاهدته والإحاطة به).
الأمر الثاني: أنّه يمكن التعبّد بها وجعلها حجّة.
الأمر الثالث: في تأسيس الأصل في المسألة، فهل الأصل فيها أنّ جميع الأمارات الظنّية حجّة إلاّ ما خرج بالدليل أو العكس، أي ليس شيء منها بحجّة إلاّ ما ثبت خروجه بالدليل؟ وبعبارة اُخرى: هل يكون إثبات الحجّية وإقامة الدليل عليها على عهدة المنكر للحجّية أو على عهدة المثبت المدّعى لها؟ فإن كان الأصل هو الأوّل فلا بدّ للمنكر إقامة الدليل وهو مدّع في الواقع، وإن كان هو الثاني فعلى المثبت.
ولا يخفى أنّ البحث في الأمرين الأوّلين بحث في مقام الثبوت، وفي الأخير بحث في مقام الإثبات.
أمّا الأمر الأوّل: أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتاً:
فاستدلّ له:
أوّلا: بإجماع العقلاء واتّفاقهم على أنّ الظنّ ليس بحجّة ذاتاً بل لابدّ من جعلها بيد جاعل كجعل الحجّية لخبر الواحد، أو من حصول مقدّمات توجب الحجّية له إمّا عقلا بناءً على تماميّة
مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة، وأمّا شرعاً بناءً على تماميتها بنحو الكشف.
وثانياً: بحكومة الوجدان، فإنّ الوجدان شاهد على عدم حجّية الظنّ ذاتاً إذ لا كشف تامّاً لها عن الواقع كما في القطع فلا بدّ لجبران نقصها في الكشف إلى جعل جاعل من ناحية الغير، نظير ما يقال في الوجود الممكن من أنّه ليس ذاتياً له ولذلك لابدّ من حصوله له بسبب أمر خارج خلافاً للوجود الواجب.
بقي هنا شيء:
وهو أنّ المحقّق الخراساني (رحمه الله)في الكفاية ذكر لتصوّر الحجّية المجعولة للظنّ طريقين: جعل الجاعل وحصول مقدّمات الانسداد، ولكن هنا طريق ثالث وهو إخبار الشارع بعدم العقاب لمن عمل بالظنّ من دون أن يكون في مقام الجعل، فإنّ إخباره بذلك كاف في حصول الأمن عن العذاب الذي هو نتيجة الحجّية.
وأمّا الأمر الثاني: في إمكان التعبّد بالظّن:
وهو إثبات قابلية الظنّ لأن يصير حجّة وإمكان جعل الحجّية له. فنقول: المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي، بمعنى أنّه لا يلزم من وقوعه محذور عقلي من أمر ممتنع ذاتي كاجتماع الضدّين أو أمر ممتنع عرضي كالقبيح الذي يستحيل صدوره من الحكيم.
توضيح ذلك: المعروف من معاني الإمكان أربعة:
أحدها: الإمكان الذاتي وفي مقابله الامتناع الذاتي كاجتماع النقيضين.
ثانيها: الإمكان الوقوعي وفي مقابله الامتناع الوقوعي وهو ما يلزم من وقوعه محال كامتناع اجتماع الآلهة في العالم وهو مفاد قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]
ثالثها: الإمكان العادي بمعنى عدم الامتناع بحسب العادة في مقابل الامتناع العادي كامتناع بلوغ عمر الإنسان إلى آلاف سنين عادةً.
رابعها: الإمكان الاحتمالي وهو ما أشار إليه الشيخ الرئيس بقوله: كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يضدّك عنه قاطع البرهان.
أمّا القسم الأخير فلا شكّ في عدم كونه مقصوداً في المقام لأنّه إنّما يكون في النظر البدوي،
وسيزول بالتأمّل ويرجع إلى أحد الأقسام الاُخر، ولذلك عبّر الشيخ بـ «كلّما قرأ سمعك».
وكذلك الإمكان العادي لأنّ العادة لا يمكن أن تقع موضوعاً للأدلّة العقليّة، وأيضاً الإمكان الذاتي لأنّه لا شكّ لأحد في أنّه لا مانع في إمكان التعبّد بالظنّ ذاتاً وأنّ حجّية الظنّ ليست كاجتماع النقيضين، فيتعيّن حينئذ الإمكان الوقوعي، فالمراد بالإمكان في المقام هو الوقوعي في مقابل من يدّعي الامتناع الوقوعي كابن قبّة(1) من قدماء الأصحاب.
ومن العجب أنّ المحقّق النائيني (رحمه الله) ذهب إلى «أنّ المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، بمعنى أنّ من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم التشريع من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، واستلزامه الحكم بلا ملاك، واجتماع الحكمين المتنافيين وغير ذلك من التوالي الفاسدة المتوهّمة في المقام، أو أنّه لا يلزم شيء من ذلك؟ ثمّ قال: وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبّد بالظنّ أو الأصل محذور في عالم التكوين، فإنّ الإمكان التكويني لا يتوهّم البحث عنه في المقام وذلك واضح»(2).
ولكن لا يخفى ما فيه من أنّ كون موضوع الإمكان والاستحالة أمراً تشريعياً لا يقتضي خروج إمكانه عن التكوين إذا كان المحذور على كلّ لزوم اجتماع الضدّين في عالم التكوين أو صدور القبيح من الحكيم الذي يستحيل صدوره منه تكويناً أيضاً.
وبعبارة اُخرى: المحذورات الخمسة التي سيأتي في بحث اجتماع الحكم الظاهري والواقعي وكذلك شبهة ابن قبّة، كلّها ترجع إلى محذورات تكوينية ناشئة عن تشريع العمل بالظنّ فراجع وتدبّر.
والإنصاف أنّه لا معنى للإمكان التشريعي في مقابل الامتناع التشريعي إلاّ حكم الشارع بالإباحة في مقابل الحرمة، وأين هذا ممّا نحن بصدده.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ابن قبّة خالف إمكان حجّية خبر الواحد واستدلّ له بدليلين: أحدهما مختصّ بخبر الواحد، والآخر عام يشمل جميع الأمارات الظنّية.
أمّا الأوّل: فهو أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبّد به في
الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعاً، ووجه الملازمة أنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
والصحيح في الجواب عنه (كما سيأتي في مبحث خبر الواحد) أنّه قياس مع الفارق، لأنّ التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى ملازم لدعوى النبوّة، وهي من اُصول الدين، التي تحتاج إلى دليل قطعي.
وأمّا الثاني: فهو أنّ جواز التعبّد بالظنّ موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر مثلا بحلّيته حراماً وبالعكس.
أقول: كلامه هذا مبهم يحتاج إلى مزيد توضيح فنقول: إنّ تحليل الحرام أو تحريم الحلال اللازم من جواز التعبّد بالظنّ يستبطن بنفسه محاذير خمسة عقليّة:
أحدها: اجتماع النقيضين في صورة عدم إصابة الظنّ بالواقع، واجتماع المثلين في صورة الإصابة، وهذا بالنسبة إلى نفس الحكم.
ثانيها: اجتماع الضدّين في نفس المولى في صورة الخطأ وهو اجتماع الإرادة والكراهة لأنّ الأمر ينشأ من الإرادة والنهي ينشأ من الكراهة وهذا يكون بالنسبة إلى مباديء الحكم.
ثالثها: اجتماع الضدّين من المصلحة والمفسدة في صورة الخطأ، ويكون بالنسبة إلى متعلّق الحكم.
رابعها: التكليف بما لا يطاق، لأنّ الحكم الواقعي يكلّف الإنسان بالفعل في مفروض الكلام، والظاهري يكلّفه بالترك مثلا، والأمر بهما يستحيل على الحكيم الخبير.
خامسها: الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة في صورة الخطأ.
ولا يخفى أنّ جميع هذه المحاذير مبني على بقاء الحكم الواقعي في مورد الأمارة على قوّته كما هو الصحيح لأنّ ارتفاع الحكم الواقعي يستلزم التصويب الباطل عندنا.
ولقد حاول جميع العلماء بعد ابن قبّة رفع هذه المحاذير، وكلّ سلك في حلّها طريقاً خاصاً، وهذا هو الذي يسمّى عندهم بمسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
ومن الطرق طريق المحقّق الخراساني (رحمه الله)، ومنها ثلاث طرق ذكرها في درر الفوائد التي حكى اثنين منها من اُستاذه السيّد السند المحقّق الفشاركي (رحمه الله)، ومنها طريق المحقّق النائيني (رحمه الله)وطريق سادس ذكره في تهذيب الاُصول، وهيهنا طريق سابع يستفاد من كلمات شيخنا الأنصاري(رحمه الله) وهو المختار.
ونحن نذكرها واحداً بعد واحد ثمّ نبيّن المختار في المقام (وهو نفس ما يستفاد من كلمات شيخنا الأعظم):
1 ـ قال المحقّق الخراساني (رحمه الله)ما حاصله: أنّ أغلب هذه المحاذير نشأ من توهّم أنّ التعبّد بالأمارة واعتبار الأمارة شرعاً معناه أنّ للشارع أحكاماً ظاهريّة على طبق مؤدّياتها، فإذا قامت الأمارة على وجوب شيء فيحكم الشارع ظاهراً بوجوب ذلك الشيء، وإذا قامت على حرمة شيء فيحكم ظاهراً بحرمة ذلك الشيء وهكذا، وبعبارة اُخرى: أنّ هذه المحاذير نشأت من القول بجعل أحكام ظاهريّة على وفق مؤدّى الأمارة مع أنّنا لا نلتزم بإنشاء الأحكام الظاهريّة في مورد الأمارات بل المجعول فيها هو نفس المنجزيّة والمعذّريّة عند الإصابة والخطأ، وهذا لا يستتبع إنشاء أحكام تكليفية ظاهريّة على طبق مؤدّيات الطرق في قبال الأحكام الواقعيّة كي يلزم منها اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات ومطابقتها للواقع، واجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة بلا كسر وإنكسار في البين عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع، بل إنّما يلزم منها تنجّز التكليف الواقعي بقيام الأمارة المعتبرة عند اصابتها وصحّة الاعتذار بها عند خطأها.
نعم، يبقى في البين إشكال واحد وهو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة، وهذا ممّا لا محذور فيه إذا كان في التعبّد بالظنّ الذي إعتبره الشارع مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء كما لا يخفى.
أقول: الظاهر أنّ مراده من المصلحة الغالبة هو الوصول إلى الواقعيات غالباً مع تسهيل الأمر للمكلّفين ورفع التضييق عنهم، فحيث إنّها كانت أهمّ بنظر الشارع من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة أحياناً قدّمها عليه.
ثمّ قال: هذا كلّه إذا كانت الحجّية بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ولو فرضنا كونها بمعنى جعل الحكم المماثل فلا يلزم محذور أيضاً، لأنّ هذه الأحكام المجعولة على طبق مؤدّيات الأمارات أحكام طريقيّة مقدّمة للوصول إلى الواقعيات لا توجب إلاّ تنجّز التكليف إذا أصابت الواقع، وصحّة الاعتذار إذا أخطأت، من دون أن تكون ناشئة عن مصلحة أو مفسدة.
ثمّ إنّه (قدس سره) نظر إلى أنّ هذا البيان كلّه يصحّ بالنسبة إلى الأمارات ولكن الإشكال باق بعدُ في بعض الاُصول الشرعيّة مثل الإباحة الشرعيّة التي توجب جعل حكم ظاهري بلا ريب
وليست طريقاً إلى الواقع، لأنّ المفروض عدم كونها أمارة، فقال ما نصّه: «فلا محيص في مثله (بعض الاُصول العمليّة كأصالة الإباحة الشرعيّة) إلاّ عن الالتزام بعدم إنقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المباديء العالية أيضاً كما في المبدأ الأعلى لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلّف لتنجّز عليه كسائر التكاليف الفعليّة التي تنجّز بسبب القطع بها، وكونه فعلياً إنّما يوجب البعث والزجر في النفس النبويّة أو الأولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة».
وحاصل ما أفاده: أنّ الحكم الواقعي في مورد هذه الاُصول ليس فعليّاً تامّاً لأنّ الفعليّة موقوفة على حصول الإرادة وهو موقوف على عدم صدور إذن من جانب الشارع على الخلاف، وإلاّ لو صدر إذن من ناحيته كما في الاُصول العمليّة فالحكم فعلي تقديري، بمعنى أنّه لو تعلّق به العلم أو قامت أمارة عليه لتنجّز، بخلاف الإنشائي الذي لا تنجّز وإن تعلّق به العلم خارجاً، وبهذا ترتفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري، لأنّ الحكم الواقعي فعلي تقديري، والحكم الظاهري فعلي تحقيقي ولا منافاة بينهما.
فظهر إلى هنا أنّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) اختار لحلّ إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ثلاثة طرق:
الأوّل: إنكار أن يكون مؤدّى الأمارة حكماً بل هو مجرّد المنجّزيّة والمعذّريّة.
الثاني: كونه حكماً طريقيّاً.
الثالث: أنّ الواقعي فعلي تقديري أي فعلي لولا الترخيص والإذن، والظاهري فعلي مطلقاً.
ولا يخفى أنّ هذا الكلام منه مبني على ما ذهب إليه من أن للأحكام مراتب أربعاً كما مرّت الإشارة إليه منّا في باب اجتماع الأمر والنهي، وكما أشار إليه في تعليقته على رسائل شيخنا الأعظم(رحمه الله):
أحدها: الاقتضائيّة والشأنية، وهي عبارة عن كون الشيء ذا ملاك يقتضي الحكم الفلان على طبق ذلك الملاك.
ثانيها: الحكم الإنشائي وهو عبارة عن إنشاء الحكم على طبق المصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء ضرباً للقاعدة والقانون، من دون أن يكون في البين إرادة أو كراهيّة فعلية.
ثالثها: الحكم الفعلي، وهو عبارة عن تعلّق الإرادة الفعلية أو الكراهة الفعلية بشيء أي البعث والزجر.
رابعها: مرتبة التنجّز وهي عبارة عن حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة حكم المولى وعصيانه بعد وصوله إليه بعلم أو علمي.
هذا ـ وقد عرفت أنّه بعد تقسيمه الفعلي إلى الفعلي التامّ وغير التامّ، أو الفعلي التقديري والفعلي المطلق صارت الأقسام خمسة.
ولكنك قد عرفت سابقاً أنّ مرتبة الاقتضاء (التي يسمّيها بالحكم الاقتضائي أو الحكم الشأني) ومرتبة التنجّز لا ينبغي أن يعدّا من الأحكام الشرعيّة ومجعولات الشارع، لأنّ الحكم الاقتضائي والشأني ليس إلاّ مجرّد اقتضاء الحكم وشأنيته له وليس هذا أمراً مجعولا، والتنجّز حكم عقلي لا حكم شرعي، فإطلاق الحكم الشرعي عليهما لا يخلو من مسامحة، فلم يبق للحكم إلاّ مرتبتين: مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعليّة.
نقد كلام المحقّق الخراساني(رحمه الله):
وفي كلامه مواقع للنظر:
1 ـ إنّ ما ذكر من تفسير الحجّية بالمعذّريّة والمنجّزيّة خلاف ظاهر أدلّة حجّية الأمارات، فإن المستظهر منها هو جعل الأحكام على وفق مؤدّيات الأمارات، ويشهد لذلك فهم الفقهاء بأجمعهم وتعبيرهم في كتبهم الفقهيّة ورسائلهم العمليّة عن مفاد الأمارات بالوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام.
أضف إلى ذلك أنّ لحن بعض أدلّة الأمارات وتعبير الإمام (عليه السلام) فيها بحكم من الأحكام الخمسة بدلا عن التعبير بالحجّية من أقوى الأدلّة على ذلك:
منها: ما ورد في باب حجّية أمارة السوق من ما رواه فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر(عليه السلام)عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصّابون فقال: «كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه»(3).
وأيضاً ما رواه أبو نصر قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ فقال: «نعم ليس عليكم المسألة ...»(4).
ومنها: ما ورد في باب حجّية خبر الواحد ممّا رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام)في الرجل يشتري الأمة عن رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها»(5).
فهذه الرّوايات تعبّر عن مفاد الأمارات بالحكم (بقوله «كُل» و «يصلّي» و «يأتيها») مع أنّه بناءً على مبنى المحقّق الخراساني (رحمه الله)كان ينبغي أن يجيب الإمام(عليه السلام) في مقام الجواب بتعبير آخر من قبيل: «إذا كان حراماً فأنت معذور» مثلا.
ولو سلّمنا عدمه بالدلالة المطابقية فلا أقل من أنّها تدلّ على حكم الترخيص بالالتزام كما هو مفاد الاُصول الشرعيّة بلا ريب.
2 ـ ما الفرق بين الفعلي التقديري والإنشائي؟ فإنّ الفعلي التقديري ليس هو إلاّ الحكم الإنشائي، لأنّ في مورد الأمارة إذا لم ينقدح إرادة أو كراهة وبعث أو زجر بالنسبة إلى الحكم الواقعي فلا يتجاوز عن مرتبة الإنشاء، وهذا ما سيأتي من ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (رحمه الله)في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الذي لم يقبله هو (أي المحقّق الخراساني(رحمه الله)).
3 ـ (وهو العمدة في الإشكال عليه) أنّ ما أجاب به عن إشكال تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من وجود مصلحة غالبة ـ ينافي ما ذهب إليه من بقاء الحكم الواقعي على الفعليّة لأنّ فعلية الحكم تابعة للمصلحة الغالبة الأقوى فإذا كان مؤدّى الأمارة ذا مصلحة أقوى يكون مفادها هو الحكم الفعلي، ويسقط الحكم الواقعي عن الفعلية نظير سقوط حرمة الدخول في الدار المغصوبة لإنقاذ الغريق، لأنّ المصلحة الأقوى توجد في إنقاذ الغريق، وهو رجوع إلى ما فرّ منه.
4 ـ أنّه ليس لطريقية الحكم معنى محصّل، لأنّ الطريق إنّما هو الظنّ أو القطع لا الحكم، فالحكم الطريقي الذي أشار إليه في كلامه لا معنى له.
هذا كلّه في بيان ما اختاره المحقّق الخراساني (رحمه الله)في الجواب عن إشكال ابن قبّة ونقده.
2 ـ ما نسبه في الدرر إلى اُستاذه المحقّق السيّد محمّد الفشاركي قدّس سرّه الشريف وحاصله: أنّ الموضوع في الحكم الظاهري غير الموضوع في الحكم الواقعي، أي أنّهما حكمان
على موضوعين مختلفين لا على موضوع واحد لكي يستلزم مثلا اجتماع الضدّين أو المثلين. توضيح ذلك: أنّه لا إشكال في أنّ الأحكام لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات الخارجيّة بل إنّما تتعلّق بالمفاهيم المتصوّرة في الذهن لكن لا من حيث كونها موجودة في الذهن بل من حيث إنّها حاكية عن الخارج، فالشيء ما لم تتصوّر في الذهن لا تتّصف بالمحبوبيّة والمبغوضيّة، وهذا واضح، ثمّ إنّ المفهوم تارةً يكون مطلوباً على نحو الإطلاق واُخرى على نحو التقييد، والإطلاق والتقييد عنوانان لا يجتمعان في الذهن في آن واحد، فإذا فرضنا كون صلاة الجمعة حراماً بمقتضى دلالة أمارة مع أنّها واجب في الواقع فموضوع الوجوب هو صلاة الجمعة المتصوّرة على نحو الإطلاق، وأمّا موضوع الحرمة فهو صلاة الجمعة المتصوّرة على نحو التقييد، أي صلاة الجمعة المشكوك حكمها الواقعي فهما في رتبتين متفاوتتين: رتبة التقسيمات الأوّليّة السابقة، ورتبة التقسيمات الثانويّة اللاحقة، والأوصاف المتأخّرة عن الحكم لا يمكن ادراجها في موضوعه، وحينئذ إذا فرضنا بعد ملاحظة اتّصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقّق جهة المبغوضيّة فيه، فيصير مبغوضاً بهذه الملاحظة لا محالة ولا يزاحمها جهة المطلوبيّة الملحوظة في ذاته لأنّ الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقّلا فعلا، لأنّ تلك الملاحظة ملاحظة لذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، وهذه ملاحظة مع الحكم.
فإن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم يكن متعقّلا في مرتبة تعلّق الذات ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعقّل العنوان المتأخّر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر يجتمع العنوانان في اللحاظ، فلا يعقل المبغوضيّة في الرتبة الثانية مع محبوبيّة الذات.
قلت: إن تصوّر ما يكون موضوعاً للحكم الواقعي الأوّلي مبني على قطع النظر عن الحكم (أي بنحو الماهيّة بشرط لا) وتصوّره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابدّ وإن يكون بلحاظ الحكم (أي بنحو الماهيّة بشرط شيء) ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته(6).
أقول: وكلامه أيضاً قابل للمناقشة من جهات:
أوّلا: من ناحية اعترافه بأنّ المفاهيم المتصوّرة في الذهن تتعلّق بها الأحكام من حيث إنّها حاكية عن الخارج ـ فيرد عليه أنّه لا اعتبار بما في الذهن حينئذ بل الاعتبار كلّه بما هو في الخارج وهو المتعلّق للحبّ والبغض والإرادة والكراهة وفيه المصلحة والمفسدة لا في الذهن، وهو (أي ما في الخارج) يكون واحداً لا اثنين، وحينئذ يستلزم اجتماع الإرادة والكراهة في محلّ واحد، كما أنّ المفسدة والمصلحة أيضاً متعلّقهما هو الخارج، وهما لا يجتمعان في شيء واحد خارجي، وقد مرّ نظير هذا الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي، وأجبنا عنه بهذا الجواب.
وثانياً: من ناحية قوله: «أنّ صلاة الجمعة بشرط لا بالنسبة إلى الانقسامات السابقة وبشرط شيء بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة».
فيرد عليه: أنّ متعلّق الأحكام الواقعيّة كما أنّها لا تتقيّد بوجود الانقسامات اللاحقة فلا تكون بالنسبة إليها بشرط شيء، كذلك لا تقبل التقييد بالنسبة إلى عدمها، فلا تكون بشرط لا بالنسبة إليها أيضاً، بل أنّها من قبيل اللاّبشرط المقسمي، فيمكن أن يكون ذات الموضوع (وهو عنوان الصّلاة مثلا) ملحوظة في مرتبة تعقّل العنوان المتأخّر (وإن لم يمكن ملاحظة العنوان المتأخّر في مرتبة تعقّل ذاته) فيجتمع العنوانان في اللحاظ فلا تعقل المبغوضيّة في الرتبة الثانية مع محبوبيّة الذات.
فبهذا يظهر أنّ ما ذكره أيضاً لا يكفي في حلّ مشكلة التضادّ لا في الخارج ولا في الذهن.
3 ـ ما نسبه أيضاً في الدرر إلى المحقّق الفشاركي (رحمه الله)وهو «أنّ الأوامر الظاهريّة ليست بأوامر حقيقية بل هي إرشاد إلى ما هو أقرب إلى الواقعيات، وتوضيح ذلك: ـ على نحو يصحّ في صورة انفتاح باب العلم ولا يستلزم تفويت الواقع من دون جهة ـ أن نقول: إنّ انسداد باب العلم كما أنّه قد يكون عقليّاً كذلك قد يكون شرعياً، بمعنى أنّه وإن أمكن للمكلّف تحصيل الواقعيات على وجه التفصيل لكن يرى الشارع العالم بالواقعيات أنّ في التزامه بتحصيل اليقين مفسدة، فيجب بمقتضى الحكمة دفع هذا الالتزام عنه، ثمّ بعد دفعه عنه لو أحاله إلى نفسه يعمل بكلّ ظنّ فعلي من أي سبب حصل، فلو رأى الشارع بعد أن صار مالك أمر المكلّف إلى العمل بالظنّ أنّ سلوك بعض الطرق أقرب إلى الواقع من بعض آخر فلا محذور في إرشاده إليه، فحينئذ نقول: إمّا اجتماع الضدّين فغير لازم لأنّه مبني على كون الأوامر الطرقيّة حكماً مولويّاً، وأمّا الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فليس بمحذور بعد ما دار أمر المكلّف بينه وبين الوقوع في مفسدة أعظم»(7).
وعمدة الإشكال في هذا الطريق إنّا لا نقبل كون المجعول في الأمارات حكماً إرشاديّاً إلى ما هو أقرب إلى الواقعيات لأنّه خلاف ظاهر أدلّة حجّية الأمارات كما مرّ آنفاً. مضافاً إلى ما مرّ من فهم الفقهاء وتعبيرهم عن مفاد الأمارات بحكم مولوي من وجوب وحرمة وغيرهما.
4 ـ ما أفاده المحقّق الحائري (رحمه الله)بنفسه في الدّرر، بقوله: «إنّ بطلان ذلك مبني على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأنّ المورد من مصاديق ذلك العنوان فإنّ الأمر تعلّق بعنوان العمل بقول العادل مثلا، والنهي تعلّق بعنوان آخر مثل شرب الخمر، وحيث جوّزنا الاجتماع وبيّناه في محلّه فلا إشكال هنا أيضاً، لا يقال: جواز اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول به إنّما يكون فيما تكون هناك مندوحة للمكلّف كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصب لا فيما ليس له مندوحة، وما نحن فيه من قبيل الثاني، لأنّ العمل بمضمون خبر العادل مثلا يجب عليه معيّناً حتّى في مورد يكون مؤدّى الخبر وجوب شيء مع كونه حراماً في الواقع بخلاف الصّلاة لعدم وجوب تمام أفرادها معيّناً بل الواجب صرف الوجود الذي يصدق على الفرد المحرم وعلى غيره، لأنّا نقول: اعتبار المندوحة في تلك المسألة إنّما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق، وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق من جهة عدم تنجّز الواقع، فلم يبق في البين إلاّ قضية اجتماع الضدّين والمثلين وهو مدفوع بكفاية تعدّد الجهة»(8).
ثمّ إستشكل على هذا الطريق بما حاصله: إنّ ما نحن فيه ليس من باب تعدّد الجهة والعنوان حتّى يكون من باب اجتماع الأمر والنهي لأنّ جعل الخبر طريقاً إلى الواقع معناه أن يكون الملحوظ في عمل المكلّف نفس العناوين الأوّليّة، مثلا لو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة في الواقع فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على أنّها واجبة واقعاً، فيرجع إيجاب العمل به إلى إيجاب الصّلاة على أنّها واجبة واقعاً، فلو فرضنا كونها محرّمة في الواقع يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرّماً وواجباً، فليس من جزئيات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي قلنا بكفاية تعدّد الجهة فيه.
أقول: ما أورده على هذا الطريق وارد جدّاً، إلاّ أنّ هنا إشكالا آخر يرد على ردّه، وهو الذي نقله في ضمن كلامه (أي ما ذكره في حكم المندوحة) وهو أنّه إن كان المراد من عدم تنجّز
الواقع في جوابه كونه في مرتبة الإنشاء فقط فلا حاجة حينئذ إلى التمسّك بذيل باب اجتماع الأمر والنهي وتعدّد الجهتين لعدم المنافاة بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي، وإن كان المراد كون الواقع فعلياً أيضاً فلا وجه لعدم كونه منجزاً لأنّ عدم التنجّز إنّما يكون لمانع عن الفعليّة كالعجز والجهل، والمفروض عدمهما.
5 ـ هو ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله) وحاصله: أنّ الأحكام الظاهريّة على ثلاثة أقسام: الأمارات والاُصول التنزيلية نحو الاستصحاب، والاُصول غير التنزيلية، أمّا في الأمارات: فيرتفع الإشكال بأنّ الشارع لم يجعل فيها غير صفة المحرزيّة والوسطية في الإثبات شيئاً فلم يجعل فيها حكماً حتّى ينافي الحكم الواقعي وذلك لأنّ الأمارات إمضائيّة وليست عند العقلاء أحكام تكليفية ولازمه أن لا يكون بعد إمضاء الشرع للأمارات تكليفية ظاهريّة في مواردها. فحال الأمارات حال العلم الوجداني في أنّه ليس في موردها أحكام تكليفية.
وأمّا الاُصول التنزيلية: فالمجعول فيها هو الوسطية في الإثبات من حيث الجري العملي مع أخذ الشكّ في موضوعها خلافاً للأمارات.
وأمّا الاُصول غير التنزيلية: فليست ناظرة إلى الواقع أصلا فلا يمكن أن يكون المجعول الوسطية في الإثبات بل لابدّ فيها من الالتزام بجعل الأحكام التكليفية فيها فلتوهّم لزوم اجتماع الضدّين حينئذ مجال، وطريق دفعه أنّ الأحكام التكليفية فيها متأخّرة رتبة من التكاليف الواقعيّة فهي متفرّعة عليها وليس بينهما منافاة أصلا فلا يكون بينهما تضادّ، وهذا مراد سيّد أساتيذنا العلاّمة الشيرازي (قدس سره)من عدم كون الحكم الظاهري منافياً للواقع لترتّبه عليه(9).
نقد كلام المحقّق النائيني(رحمه الله):
أقول: إنّ كلامه قابل للمناقشة بجميع أقسامه:
أمّا القسم الأوّل: فلأنّ القطع أمر تكويني غير قابل للجعل كالبرودة والحرارة وليس من قبيل الملكيّة والزوجيّة وغيرهما من المجعولات الاعتباريّة، فلا يمكن للشارع أن يجعل ما ليس بعلم علماً، فإن كان المراد من جعل صفة المحرزيّة إلغاء احتمال الخلاف وجعل صفة العلم تكويناً فهو محال، وإن كان المراد الجري العملي على طبق مؤدّيات الأمارات كما يظهر من بعض كلماته في المقام فهذا معناه إيجاب الجري العملي على وفق الأمارة، وليس هذا إلاّ جعل وجوب العمل على مؤدّى الأمارة، وهذا حكم تكليفي ظاهري.
وأمّا ما أفاده من أنّ حجّية الأمارات ليست بشيء إلاّ إمضاء لطريق العقلاء، والعقلاء ليس لهم حكم على طبق مؤدّى الأمارة بل يعدّونها فقط طريقاً إلى الواقع.
ففيه: أنّ العقلاء أيضاً إذا علموا مثلا بأنّ هذا ليس لزيد من طريق أخبار خبر الثقة مثلا يحكمون بأنّه لزيد، ويكون مؤدّى الأمارة عندهم حكماً من الأحكام وقانوناً من القوانين، فكيف لم يكن عندهم أحكام ظاهريّة قانونيّة؟ وعدم وجود التكاليف المولويّة بينهم ليس دليلا على عدم وجود التكاليف القانونية.
وأمّا القسم الثاني: فلأنّ الاُصول موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي، ولا معنى لكون الشكّ طريقاً إلى الواقع، وحينئذ كيف يمكن جعل الشارع الوسطيّة في الإثبات والطريقيّة إلى الواقع لما ليس طريقاً أبداً؟ ولو قلنا أنّ الاستصحاب لا يخلو من طريقيّة إلى الواقع فلازمه عدّ الاستصحاب من الأمارات لا من الاُصول، وهو خلاف المفروض.
وأمّا القسم الثالث: ففيه: أنّ تأخّر الموضوع والتفرّع لا يحلّ المشكلة في المقام، لأنّه وإن كان الموضوع متعدّداً في الذهن إلاّ أنّ الخارج واحد، والمفروض أنّ الصورة الذهنيّة مأخوذة في الموضوع بما هي حاكية عن الخارج، فيلزم حينئذ اجتماع حكمين فعليين على محلّ واحد، ويعود الإشكال.
6 ـ ما أفاده في تهذيب الاُصول وحاصله بالنسبة إلى شبهة التضادّ «أنّهم عرفوا الضدّين بأنّهما الأمران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف، وعليه فما لا وجود له لا ضدّية بينه وبين شيء آخر كما لا ضدّية بين أشياء لا وجود لها كالاعتباريات التي ليس لها وجود إلاّ في وعاء الاعتبار ... والإنشائيات وبالتبع الأحكام التكليفيّة كلّها من الاُمور الاعتباريّة لا تحقّق لها إلاّ في وعاء الاعتبار»(10).
أقول: لو كان المراد من عدم وجود التضادّ في الأحكام التكليفيّة عدم التضادّ في مرحلة الإنشاء فلا بأس به، ولكن المدّعى ليس هو اجتماع الضدّين في تلك المرتبة بل أنّه بالنسبة إلى مرتبة الفعليّة، وفي هذه المرتبة وإن كان الإنشاء أو الحكم أمراً اعتباريّاً ولكن له مباد ولوازم حقيقية، حيث إن الحكم الفعلي لابدّ فيه من وجود مصلحة أو مفسدة في متعلّقه كما يحتاج إلى إنقداح إرادة أو كراهة في نفس المولى وبعث أو زجر، ولا يخفى أنّ المصلحة أو المفسدة والإرادة أو الكراهة أمران حقيقيان لهما وجودان في عالم التكوين كما مرّت الإشارة إليه حينما تعرّضنا لمعنى الإمكان في هذا المبحث في جواب ما اختاره المحقّق النائيني (رحمه الله) من الإمكان التشريعي.
بيان المختار في المقام:
المختار في حلّ المشكلة هو الطريق السابع: وهو ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله)في رسائله، ويرجع إليه كلام كثير من الأعلام، وإليك نصّ عبارته: «أنّه (ابن قبّة) إن أراد إمتناع التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه، وإن أراد الإمتناع مع انفتاح باب العلم والتمكّن منه في مورد العمل بالخبر فنقول: إنّ التعبّد بالخبر حينئذ بل بكلّ أمارة غير علميّة يتصوّر على وجهين:
الوجه الأوّل: أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في التعبّد بها إلاّ الايصال إلى الواقع، فلا مصحلة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع، والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلاّ للإرشاد، وهذا الوجه غير صحيح مع علم الشارع العالم بالغيب بعدم دوام موافقة هذه الأمارة للواقع.
الوجه الثاني: أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل بها وإن خالف الواقع فإنّ العمل على طبق تلك الأمارة يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع، وتلك المصلحة لابدّ أن تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وإلاّ كان تفويتاً لمصلحة الواقع وهو قبيح، والمراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقائه هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم أو الظنّ وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه، ويكفي في كونه الحكم الواقعي أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلا مقصّراً.
والحاصل: أنّ المراد بالحكم الواقعي هي مدلولات الخطابات الواقعيّة غير المقيّدة بعلم
المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها، ولها آثار عقليّة وشرعيّة يترتّب عليها عند لا علم بها أو قيام أمارة حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع، نعم هذه ليست أحكاماً فعلية بمجرّد وجودها الواقعي» (انتهى ملخّصاً).
فالمستفاد من كلامه هذا بل عصارة بيانه في المقام أمران:
أحدهما: وجود مصلحة في سلوك الأمارة يتدارك بها فقدان المصلحة الواقعيّة في صورة الخطأ.
ثانيهما: أنّ الحكم الواقعي الفعلي ينقلب إنشائيّاً إذا قامت أمارة معتبرة على خلافه ما ـ دام لم ينكشف خلافها.
أقول: يمكن أن يكون المراد من المصلحة السلوكيّة في كلامه هو مصلحة التسهيل وعدم لزوم الحرج الشديد واختلال النظام من اعتبار حصول القطع في صورة الإنفتاح واعتبار الاحتياط التامّ في صورة الانسداد بل عدم لزوم رغبة الناس عن الدين الحنيف وخروجهم من الدين أفواجاً، وإن شئت فاختبر ذلك بالعمل بالقطع يوماً وليلة واحدة، لا تأكل إلاّ الحلال القطعي ولا تلبس ولا تشرب ولا تسكن إلاّ ذلك، ولا تصلّي إلاّ في الحلال والطاهر الواقعيين، ولا تعتمد على سوق مسلم ولا على يده ولا غير ذلك من الأمارات الظنّية.
ولا يخفى أنّه ترتفع بهاتين النكتتين جميع المحاذير المتوهّمة في الأحكام الظاهريّة:
أمّا المحذور الأوّل (وهو لزوم اجتماع الضدّين أو المثلين) فلأنّه لا منافاة بين الحكم الفعلي والإنشائي، والمراد من الإنشائي ما يكون فيه مصلحة أو مفسدة لكن يمنع عن فعليته وعن صدور البعث أو الزجر مانع أو مصلحة أقوى.
وأمّا المحذور الثاني (أي لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة في متعلّق واحد) فلأنّه لا مصلحة في متعلّق الأمارة حتّى يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في محلّ واحد.
وأمّا المحذور الثالث (أي لزوم اجتماع الإرادة والكراهة في متعلّق واحد) فأوّلا: إنّ المتعلّق للإرادة والكراهة متعدّد، فإحديهما متعلّقة بالفعل والاُخرى متعلّقة بنفس السلوك لا بمتعلّق الأمارة، وثانياً: لو سلّمنا كون المتعلّق واحداً إلاّ أنّ إحديهما تقع تحت شعاع الاُخرى فتسقط عن الفعليّة وترجع إلى مقام الإنشاء لأنّ المفروض أنّ مصلحته أعمّ.
وأمّا الرابع (أي لزوم التكليف بما لا يطاق) فلأنّه إنّما يلزم فيما إذا كان الحكم الواقعي أيضاً
فعلياً مع أنّ المفروض كونه إنشائيّاً.
وأمّا المحذور الخامس (أي تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة) فلأنّ مصلحة السلوك أهمّ فتجبر بها ما فاتت من المصلحة الواقعيّة.
إن قلت: «إنّ ما هو المجعول واقعاً طبقاً للمصالح والمفاسد ويكون مشتركاً بين العالم والجاهل وتدلّ الأدلّة على اشتراكه بينهما وإنحفاظه في مرتبة الجهل به ـ هو الحكم الفعلي الذي لو وصل إلى المكلّف كان داعياً له نحو الفعل أو الترك، وإنكار مثل هذا الحكم في ظرف الجهل بالحكم الواقعي والقول بأنّ الموجود في هذا الظرف مجرّد الإنشاء فقط تصويب لا تقول به الإماميّة»(11).
قلت: الباطل من التصويب على قسمين: أحدهما: محال عقلي، والآخر: محال شرعي، أمّا المحال العقلي فهو أن يقال: إنّ الله تعالى يجعل الحكم بعد اجتهاد المجتهد مع خلوّ الواقع عن الحكم قبله فإنّ هذا محال عقلا لأنّ معناه أنّ المجتهد يجتهد ويتفحّص عن شيء لا وجود له في الواقع والخارج، ولا إشكال في أنّ لازمه الدور المحال، وأمّا المحال الشرعي فهو أن يقال: إنّ الله يجعل بعدد آراء المجتهدين أحكاماً شرعيّة، وهذا باطل إجماعاً عند أصحابنا رضوان الله عليهم، وأمّا لو قلنا بوجود حكم إنشائي مشترك بين جميع المكلّفين ولكنّه بالنسبة إلى بعضهم بلغ حدّ الفعلية وبالنسبة إلى الباقين بقى على حاله فلا دليل على كونه من التصويب المحال بل الدليل على خلافه.
إن قلت: ما الفائدة في جعل حكم وإنشائه من دون أن يكون فعليّاً على المكلّفين؟
قلنا: فائدة هذا الحكم هي فائدة المقتضي في جميع المقامات، فإذا اجتمعت فيه شرائط الفعلية وانتفت الموانع صار فعليّاً، ولذلك لا يكون الجاهل المقصّر في الفحص اجتهاداً أو تقليداً معذوراً، ومن هنا أيضاً يجب على المكلّف الإعادة بعد كشف الخلاف (بناءً على القول بعدم الإجزاء).
ثمّ إنّه في تهذيب الاُصول أورد على المصلحة السلوكيّة إشكالات أربع:
أحدها: «أنّ حجّية أمارة في الشرع ليس إلاّ إمضاء ما كان في يد العقلاء في معاشهم ومعادهم، من غير أن يزيد عليه شيئاً أو ينقص منه شيئاً، ومن المعلوم أنّ اعتبار الأمارات لأجل كونها طريقاً إلى الواقع فقط من دون أن يترتّب على العمل بها مصلحة وراء إيصالها إلى الواقع، فليس قيام الأمارة عند العقلاء محدثاً للمصلحة لا في المؤدّى ولا في العمل بها وسلوكها، وعليه فالمصلحة السلوكيّة لا أساس لها».
وفيه: أنّ للعقلاء أيضاً في تشريعاتهم وتقنيناتهم مصلحة تتعلّق بسلوك الأمارات بلا إشكال لأنّ عدم حجّية الظنّ في ما بينهم أيضاً يوجب الحرج الشديد واختلال نظامهم ومعاشهم الدنيويّة ولا نعني بالمصلحة السلوكيّة إلاّ هذا، فالإنسان إذا لم يعتمد على اليد كالدليل على الملكية وعلى قول المشهور، وكذا ظواهر الألفاظ وخبر الثقة وغير ذلك من الأمارات العقلائيّة لا يقدر على أن يعيش ولو شهراً إلاّ في حرج شديد وضيق أكيد.
ثانيهما: ما حاصله: أنّه لا يتصوّر لسلوك الأمارة وتطرّق الطريق معنى وراء العمل على طبق مؤدّاها، فلا يتصوّر له مصلحة وراء المصلحة الموجودة في الإتيان بالمؤدّى.
وإن شئت قلت: الإتيان بالمؤدّى والسلوك على طبق الأمارة من المفاهيم المصدريّة النسبية لا يعقل أن تصير متّصفة بالمصلحة أو المفسدة، بل المصلحة والمفسدة قائمتان بنفس الخمر والصّلاة مثلا.
وفيه أيضاً: إنّ المصلحة السلوكيّة ليس معناها أنّ صلاة الجمعة مثلا (التي يدلّ خبر الواحد على وجوبها) تصير ذا مصلحتين بالسلوك بل المقصود أنّ جعل الحجّة للأمارة وجعلها طريقاً إلى الواقع يوجب التسهيل وعدم رغبة الناس عن الدين وشبه ذلك.
ثالثها: «إنّ ظاهر عبارة الشيخ وشارح مراده أنّ المصلحة قائمة بالتطرّق والسلوك بلا دخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة، وعليه فلو أخبر العادل عن الاُمور العادية لزم العمل على قوله في هذه الموارد أيضاً لأنّه ذا مصلحة سلوكيّة، وهو كما ترى».
أقول: ظاهر هذه العبارة أنّ وجود المصلحة السلوكيّة في الاُمور الشرعيّة يستلزم وجودها في الاُمور العادية أيضاً (لأنّ المفروض أنّ حجّية الأمارات إمضاء لطريق العقلاء، والمصلحة قائمة بنفس السلوك بلا دخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة) مع أنّه كما ترى، أي لا معنى لحدوث المصلحة في سلوك الأمارة في الاُمور العادية.
والجواب عنه واضح، لأنّ المراد من طريقة العرف والعقلاء الممضاة عند الشارع هي طريقيتهم في دائرة القوانين العرفيّة العقلائيّة، ولا شكّ في وجود المصلحة السلوكيّة فيها أيضاً كما مرّ آنفاً، لأنّ اعتبار حصول القطع عندهم أيضاً يوجب لزوم الاختلال في نظامهم الاجتماعي ومعاشهم.
رابعها: «أنّ لازم تدارك المصلحة الواقعيّة بالمصلحة السلوكيّة هو الاجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء إذ لو لم يتدارك مصلحة الواقع لزم قبح الأمر بالتطرّق، ولو تدارك سقط الأمر، والمفروض أنّ المصلحة القائمة بتطرّق الطريق ليست مقيّدة بعدم كشف الخلاف، فما يظهر من التفصيل من الشيخ الأعظم(رحمه الله) وبعض أعاظم العصر ليس في محلّه»(12).
وفيه أيضاً: إنّ ما يتصوّر من المصلحة في الأمارات على نوعين: تارةً هي مصلحة تقوم مقام المصلحة الواقعيّة فإشكاله حينئذ وارد، فلا بدّ من القول بالإجزاء مطلقاً سواء انكشف الخلاف أو لم ينكشف، واُخرى ليست هي مصلحة تقوم مقامها ولكن في نفس الحال تكون أهمّ منها نظير العثور على الكنز لمن يحفر البئر للوصول إلى الماء، مع أنّها لا تقوم مقامها أصلا ولا يرتفع بها الظمأ، ومن هذا القبيل مصلحة التسهيل وعدم خروج الناس عن الدين في المقام، وحينئذ لو انكشف الخلاف وظهرت المصلحة الواقعيّة لابدّ من إحرازها والحصول عليها بالإعادة أو القضاء على القول بعدم الاجزاء.
والعجب من قوله أخيراً: «والمفروض أنّ المصلحة القائمة بتطرّق الطريق ليست مقيّدة بعدم كشف الخلاف» لأنّه ليس في البين إطلاق حتّى يتمسّك به ويستفاد منه وجود المصلحة في السلوك في كلتا الصورتين بل الدليل في المقام هو حكم العقل والقدر المتيقّن منه صورة عدم انكشاف الخلاف.
بقى هنا شيء: وهو أنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في إمكان الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ورفع المحاذير المتوهّمة بين الأمارات والاُصول فنقول في موارد الاُصول العمليّة أيضاً: أنّ الحكم الواقعي إنشائي والظاهري (أي مفاد الأصل) فعلي مع وجود المصلحة في سلوكها ومن دون فرق بين التنزيلية منها وغير التنزيليّة.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني (أي في إمكان التعبّد بالظنّ).
الأمر الثالث : في تأسيس الأصل في المسألة:
إنّ الأمارة الظنّية قد يعلم حجّيتها وقد يعلم عدم حجّتها ، وقد يقع الشكّ فيها فإذا وقع الشكّ ، فهل الأصل حجّيتها إلاّ ما خرج بالدليل أو العكس ، أي أنّ الأصل عدم حجّيتها إلاّ ما خرج؟
لا خلاف في أنّ الأصل هو الثاني ، أي عدم الحجّية ، إنّما الخلاف في طريق الاستدلال عليه ، فذكر شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله له طريقاً ، وللمحقّق الخراساني رحمه الله طريق آخر، فاستدلّ الشيخ رحمه الله بأنّ أصالة حجّية الظنّ معناها جواز الاستناد إلى الظنّ والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه ، مع أنّ هذا الاستناد عند الشكّ حرام بالأدلّة الأربعة ما لم يدلّ دليل على جوازه.
وقال المحقّق الخراساني رحمه الله تضعيفاً لذلك ما ملخّصه : أنّ صحّة الالتزام بما أدّى إليه الظنّ من الأحكام وصحّة نسبته إليه تعالى لا دخل لهما بمسألة الحجّية كي إذا لم تصّح الالتزام والنسبة كشف ذلك آناً عن عدم الحجّية ، وذلك كما في الظنّ على الانسداد والحكومة فإنّه حجّة عقلاً كالعلم في حال الانفتاح مع عدم صحّة الالتزام بما أدّى إليه وعدم صحّة نسبته إليه تعالى ، إذ المفروض عدم القول بالكشف وأنّ الظنّ طريق منصوب من الشرع ، بل هو حجّة عقلاً يجب العمل على طبقه والحركة على وفقه ، أي يقبح عقاب العبد على أزيد من ذلك ، ولو فرض صحّة الالتزام والنسبة فيما شكّ في اعتباره لم يُجد في إثبات حجّيته ما لم يترتّب عليه آثار الحجّية من المنجّزيّة والمعذّريّة ، ومع فرض ترتّب آثار الحجّية لم يضرّ عدم صحّتهما كما عرفت في الظنّ على الانسداد والحكومة فالمدار في الحجّية وعدمها على ترتّب آثارها وعدم ترتّبها لا على صحّة الالتزام والنسبة وعدمهما.
أقول : إنّه إشكال وارد في بدء النظر ، بل يمكن تأييده بأنّ مسألة صحّة الإسناد والالتزام من الأحكام الفرعيّة الفقهيّة ، ومسألة الحجّية مسألة اصوليّة لا ربط بينهما ، ولكن عند الدقّة والتأمّل يمكن الجواب عنه والدفاع عن مقالة الشيخ قدس سره بأنّ مراده من صحّة الإسناد والالتزام وعدمها هو مدلولها الالتزامي أي الحجّية ، حيث إن الحجّية الشرعيّة تلازم جواز الإسناد والالتزام ، والبحث في الحجّية الشرعيّة لا الحجّية العقليّة ، وطرح المسألة بهذا النحو وإن كان يجعلها من المسائل الفقهيّة لكن تثبت به الحجّية آناً.
وإن شئت قلت : أنّ صحّة الالتزام والنسبة وإن لم يكونا من آثار الحجّية لما عرفت من جواز انفكاك الحجّة عنهما كما في الظنّ الإنسدادي على الحكومة ولكن لا يكاد يجوز تحقّقهما في غير الحجّة ، فليس كلّ حجّة ممّا صحّ الالتزام بكون مؤدّاه حكم الله وصحّ نسبته إليه تعالى ، ولكن كلّما صحّ الالتزام بكون مؤدّاه حكم الله وصحّ نسبته إليه تعالى كان حجّة قطعاً.
أضف إلى ذلك أنّه لا حاجة بناءً على مبنى المحقّق الخراساني رحمه الله في تفسير الحجّية إلى التمثيل بالظنّ الإنسدادي على الحكومة ، لأنّه بناءً على ذلك المبنى في تمام الحجج الشرعيّة لا يجوز الإسناد والالتزام لأنّ الحجّية عنده بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ، وهما في الواقع قضيتان شرطيتان ، أي لو وافق مؤدّى الأمارة الواقع كان منجزاً ولو خالفه كان عذراً ، وليستا حاكيتين عن حكم واقعي أو ظاهري حتّى يصحّ الإسناد ، فظهر أنّ مآل الطريقين إلى أمر واحد.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله استدلّ للمسألة بالضرورة فقال : « ضرورة أنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ولا يكون مخالفته تجرّيّاً ولا يكون مخالفته بما هي موافقة انقياداً ».
ومقصوده من الضرورة هنا هو الضرورة العقليّة والبداهة الوجدانيّة ، وهو كذلك ، لأنّ الوجدان حاكم على عدم ترتّب آثار الحجّية على أمارة ما لم تتّصف بالحجية الفعليّة في مقام الإثبات.
وأمّا شيخنا الأنصاري رحمه الله فاستدلّ لحرمة الإسناد والإلزام التي يستفاد منها عدم الحجّية بالدلالة الالتزاميّة كما مرّ بالأدلّة الأربعة وقال : « التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل، محرّم بالأدلّة الأربعة ويكفي من الكتاب قوله تعالى : {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء ، ومن السنّة قوله صلى الله عليه وآله في عداد القضاة من أهل النار « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » (13) ، ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيّاً عند العوام فضلاً عن العلماء ، ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده من المولى ولو كان جاهلاً مع التقصير ».
أقول : أمّا الإجماع فلا يخفى أنّه في مثل المقام مدركي يرجع إلى سائر الأدلّة فلا اعتبار به مستقلاً ، وأمّا السنّة فقد نوقش فيها بأنّ مقام القضاء مقام خاصّ ، وللشارع اهتمام خاصّ به ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى ، كما ناقش فيها في تهذيب الاصول بأنّ مقام القضاء مقام إنشاء الحكم لا إسناده إلى الله تعالى ، أي أنّ القاضي إنّما يقول : « حكمت وقضيت بكذا وكذا » ولا يقول : « الله يقول كذا وكذا » (14).
لكن يرد عليه ( على مناقشة تهذيب الاصول ) : أنّ القضاء إنشاء يلازم الإخبار عن الشارع ، لأنّ القاضي قام على منصب القضاء الشرعي ، وكأنّه يقول : أنّي أحكم بكذا وكذا لأنّي من قضاة الشرع ومنصوباً من قبل الشارع ، فإنشاؤه حينئذٍ لا ينفكّ عن الإخبار.
ولكن الأنسب والأولى للشيخ قدس سره أن يستدلّ بما ورد في نفس الباب ( أي الباب 4 من أبواب صفات القاضي ) من دون أن يكون مختصّاً بباب القضاء ، وهي ثلاث روايات :
أوّلها : ما رواه زياد بن أبي رجاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما علمتم فقولوا : وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ، أنّ الرجل ينتزع الآية يخرّ فيها أبعد ما بين السماء » (15).
ثانيها : ما رواه مفضّل بن فريد ( يزيد ) قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : « أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم » (16).
ثالثها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : « إيّاك وخصلتين ففيهما هلك من هلك : إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم » (17).
وأمّا دليل العقل فهو شبيه بما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه الله ، يعني ضرورة العقل والوجدان ، وعلى أي حال فقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأصل هو عدم حجّية الظنّ إلاّ ما خرج بالدليل.
كلام في التشريع :
ثمّ إنّه لمّا انتهى الكلام إلى هنا ينبغي البحث عن حقيقة التشريع وأنّه هل هو عبارة عن الالتزام القلبي أو مجرّد الإسناد إلى الله تعالى مطلقاً؟ فنقول هنا امور ثلاثة لابدّ من البحث فيها :
الأوّل : في حقيقة التشريع.
الثاني : في الدليل على حرمته ..
الثالث : في أنّ المحرّم هل هو خصوص التديّن والتعبّد ، أو يسري القبح إلى الفعل المتشرّع به أيضاً فيصير الفعل الخارجي قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً؟
أمّا الأمر الأوّل : فنقول : إنّ حقيقة التشريع ومعناه ادخال ما ليس من الدين في الدين بحسب الاعتقاد القلبي وهو غير الإسناد إلى الله تعالى ، والنسبة بينهما هي العموم المطلق ، فالمعروف بين العلماء أنّ حقيقة التشريع تصدّق في الوحدة أيضاً بمجرّد بناء القلب من دون الإظهار والإسناد ، كما إذا صام يوم عيد الفطر بنيّة استحبابه من قبل الله تعالى من دون أن يسندها في محضر غيره إلى الله فيتحقّق حينئذٍ التشريع من دون تحقّق الإسناد الذي هو نوع من الإخبار.
ثّم إنّه هل التشريع يصدق في صورة الشكّ أيضاً؟ فإذا شككنا مثلاً في وجوب سجدتي السهو ، فهل يصدق التشريع إذا أتى بهما بنيّة الوجوب أو لا يصدق ، بل الصادق حينئذٍ مجرّد التجرّي؟
الصحيح عندنا هو الثاني ، لأنّ المسلّم من حرمة التشريع هو إدخال ما ليس من الدين في الدين اعتقاداً ، وإن كان المعروف عند العلماء أنّ التديّن والاعتقاد بالمشكوك فيه أيضاً تشريع محرّم.
وكيف كان ، فالمعروف أنّ التشريع عبارة عن الالتزام القلبي كالالتزام قلباً بأنّ هذا واجب أو حرام ولذا يقال : لا يجوز إتيان الذكر الفلان بقصد الورود ، أو يقال : يجوز إتيان الذكر الفلان بقصد الرجاء.
لكن قد أورد بعض الأعاظم على هذا إشكالاً حاصله : « أنّ الالتزام الجزمي بما شكّ كونه من المولى أمر ممتنع ، وكيف يمكن التعبّد الحقيقي بما لا يعلم أنّه عبادي ، فإنّ الالتزامات النفسانيّة ليست واقعة تحت اختيار النفس حتّى توجدها في أي وقت شاء » (18).
أقول : الحقّ أن التعبّد الحقيقي بما لا يعلم أنّه عبادي أمر ممكن كما هو المعروف في الألسنة والكتب الفقهيّة لأنّه من قبيل قوله تعالى {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} فلا إشكال في أنّ فرعون مثلاً كان كافراً بالله تعالى مع علمه به ، وليس هذا إلاّ أنّه بنى في قلبه والتزم قلباً بأنّه ليس في العالم إله يسمّى بـ « الله » ، هذا في الاصول الاعتقاديّة ، وكذلك في الفروع فيمكن الالتزام القلبي بأنّ الشيء الفلان حرام مع العلم بحلّيته.
وإن شئت قلت : ليس التشريع هو العلم بل هو اعتقاد وعقد في القلب ، والاعتقاد غير العلم لأنّ العلم ، هو مجرّد الإدراك ، وأمّا الاعتقاد فإنّه من عقد القلب والبناء القلبي ، وكم من شيء يعلمه الإنسان ( أي يدركه ) ولكن لا يقبله ولا يلتزم به في قلبه وبالعكس.
وبعبارة اخرى : عقد القلب هو التسليم الباطني تجاه شيء ، علم به أو لم يعلم ، كما يدلّ عليه ما مرّ سابقاً ، وهو ما رواه إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال : أخبرني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « من أصغى إلى ناطق فقد عبده، ... إلى أن قال : فإنّ أدنى ما يخرج به الرجل عن الإيمان أن يقول للحصاة ، هذه نواة ثمّ يدين بذلك ويبرأ ممّن خالفه ، يا ابن أبي محمود احفظ ما حدّثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة » (19).
هذا كلّه في الأمر الأوّل.
أمّا الأمر الثاني : وهو الدليل على حرمة التشريع ، فيدلّ عليها أوّلاً : جميع ما يدلّ على حرمة البدعة من الإجماع والآيات والأخبار الواردة في باب البدعة وتحريمها لأنّ التشريع مصداق من مصاديقها.
وثانياً : حكم العقل بقبح التشريع ، لأنّ من المستقلاّت العقليّة أنّ التشريع نوع تلاعب بأحكام المولى ومخالف لحقّ الطاعة ورسم العبوديّة.
أمّا الأمر الثالث : وهو أنّ المحرّم هل هو خصوص التديّن والا لتزم القلبي أو يسري قبح التشريع إلى الفعل المتشرّع به بحيث يصير الفعل قبيحاً عقلاً وحراماً شرعاً؟ فذهب المحقّق النائيني رحمه الله إلى الثاني وقال : « إنّه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيّرة لجهة حسن العمل وقبحه فيكون الالتزام والتعبّد والتديّن بعمل لا يعلم التعبّد به من الشارع موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه وتطرأ عليه بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلاً وحرمته شرعاً ، وظاهر قوله : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدلّ على حرمة نفس العمل » (20).
أقول : كلامه في محلّه لأنّ أدلّة حرمة التشريع لا تعمّ مجرّد الالتزام القلبي من دون تحقّق عمل في الخارج ، وبعبارة اخرى : ليس التشريع من قبيل اصول الدين التي تتقوّم بنفس الاعتقاد في القلب بل القدر المتيقّن من الأدلّة هو الفعل الخارجي الناشيء من الالتزام القلبي ، وإن شئت فعبّر « الفعل الخارجي مع هذه النيّة ».
______________
1. هو من عيون الأصحاب وصالحيهم وكان معاصراً للشيخ المفيد (رحمه الله) والشيخ كان يروي عنه وكان من تلاميذه وهو صاحب كتاب الإنصاف، وكان فقيهاً متكلّماً، وقيل أنّه كان معتزلياً ثمّ استبصر.
2. فوائد الاُصول: ج3، ص88، طبع جماعة المدرّسين.
3. وسائل الشيعة: ج16، كتاب الصيد والذباحة، الباب29، ح1.
4. المصدر السابق: أبواب النجاسات: الباب50، ح3.
5. وسائل الشيعة: ح 1، الباب 6، من ابواب النكاح العبيد و الاماء.
6. راجع درر الفوائد: ج2، ص351 ـ 353، طبع جماعة المدرّسين.
7. درر الفوائد: ج 2، ص 354 ـ 355، طبع جماعة المدرّسين.
8. درر الفوائد: ج 2، ص 355، طبع جماعة المدرّسين.
9. راجع فوائد الاُصول: ج3، ص105 ـ 112، طبع جماعة المدرّسين.
10. راجع تهذيب الاُصول: ج2، ص65 ـ 66، طبع جماعة المدرّسين.
11. راجع منتهى الاُصول للمحقّق البجنوردي(رحمه الله): ج2، ص71 ـ 72.
12. تهذيب الاُصول: ج2، ص64 ـ 65، طبع جماعة المدرّسين.
13. وسائل الشيعة : الباب 4 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 6.
14. راجع تهذيب الاصول : ج 2 ، ص 85 ، طبع جماعة المدرّسين.
15. وسائل الشيعة : الباب 4 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 5.
16. المصدر السابق : ح 2.
17. المصدر السابق : ح 3.
18. راجع تهذيب الاصول : ج 2 ، ص 85 ، طبع جماعة المدرّسين.
19. وسائل الشيعة : الباب 10 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 13.
20. فوائد الاصول : ج 3 ، ص 122 ـ 121 ، طبع جماعة المدرّسين.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|