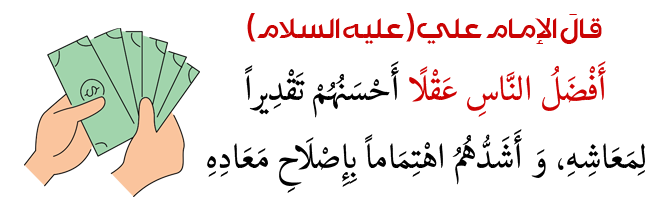
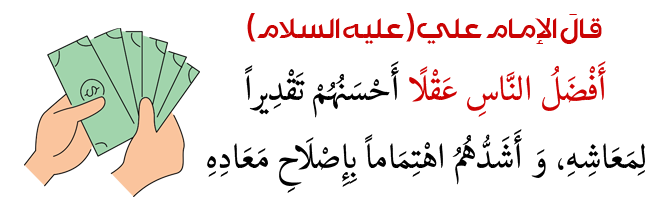
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2022
التاريخ: 2023-09-27
التاريخ: 2024-01-07
التاريخ: 29-5-2022
|
قحطانيون يمانيون و عدنانيون مضريون و نزلها معهم بربر كثيرون من أفريقيا و كانوا ينقسمون مثل العرب إلى قبيلين كبيرين: بتر و كانوا ينحازون إلى العرب العدنانيين، و برانس و كانوا ينحازون إلى العرب القحطانيين، و جلب الحكام الأمويون إلى الأندلس كثيرين من الصقالبة، و بذلك كله كانت الأندلس مجمعا لعناصر جنسية شتى. و ذكرنا- فيما أسلفنا من حديث-أن الرومان أدخلوا فيها المسيحية، و أن بعض أهلها شاركوا في الأدب و الفكر اللاتينيين و لكن لا في موطنهم بالأندلس، و إنما في روما نفسها حين نشأوا فيها أو هاجروا إليها. و الأندلس بل جميع شبه جزيرة ايبيريا لم تستطع في تاريخها القديم أن تضيف إلى تاريخ الحضارة الإنسانية شيئا ذا بال يذكر لها. و نزلتها منذ أوائل القرن الخامس للميلاد قبائل جرمانية متبربرة من القندال و القوط قضت-أو كادت-على ما كان بها من حضارة رومانية، و أنزلت بها ضروبا من العسف و الظلم حتى كاد أهلها يستحيلون إلى ما يشبه الرقيق، سوى ما نشروا في البلاد من الجهل، مما جعل الأندلس تلقى العرب و البربر الفاتحين بلهجة رومانسية عامية مجدبة من كل ما يتصل بالعلم و الفكر و الدين إلا ما كان من مجموعة القس إيزيدور الإشبيلي المتوفى سنة 6٣6 للميلاد و قد أشرنا إليها في الفصل الماضي و قلنا إنها تعرض صورة ساذجة للتاريخ و العلوم و بعض تفسيرات للكتاب المقدس، كما قلنا إنها تمتلئ بأخطاء كثيرة، و تدل-بوضوح- على ما كان يعم الأندلس و ايبيريا عامة من جهالة مطبقة و تخلف شامل في مضمار الدين و الفكر و العلوم مع ما كان يعمها من فقدان الحرية و العدل الذي لا تطيب حياة أي شعب بدونهما بل إنها تصبح نكرا و شرا خالصين مع ما كان يجثم عليها من الظلم و القهر البشع و البؤس التعس.
و كأنما كتب للأندلس-حينئذ-أن تتخلص من كل هذه الخطوب المدلهمة بنزول العرب فيها حاملين إلى أهلها تعاليم دينهم السمح في معاملة أهل الكتاب من النصارى و اليهود بمنتهى الرفق، بحيث تكفل لهم حريتهم الدينية في عباداتهم و ما يتخذون لها من كنائس و بيوت و شعائر دون أي تدخل، و بحيث يرفع عنهم ثقل الضرائب الفادحة التي فرضها عليهم القوط و أحالوا بها حياتهم إلى صور بغيضة من البؤس و الظلم و الهوان.
و كانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة التي حررت أهل الأندلس من جور القوط بعد أن كانوا مسترقين لهم استرقاقا قبيحا، و التي ملأت الأندلس بالعدل الذى يعطى لصاحب الحق حقه دون أي حيف، و الذي يسوى بين الناس في مواجهة الحياة بقسطاس مستقيم، سببا قويا في أن يعتنق كثيرون من مسيحييّ الأندلس الإسلام لما يرون فيه من مثل إنسانية رفيعة، و من دين قويم لا تشوبه أي شائبة من فكرة التثليث المعقدة في الدين المسيحي، مع ما يتيح لمعتنقه من سعادة في دنياه و آخرته، و أيضا لأن من كان يعتنق الدين الحنيف منهم يصبح له جميع حقوق العربي الفاتح لدياره، فله كل ما للمسلمين الفاتحين من هذه الحقوق. و هيأ ذلك سريعا في الأندلس لأن تدخل أفواج متلاحقة في الإسلام و كانوا يسمون المسالمة، و سمّى أبناؤهم باسم المولدين. و ينبغي أن نذكر أنه لم يحدث في تاريخ العرب بالأندلس أن أكره أحد على الإسلام، فقد كانت الحرية الدينية مكفولة للنصارى و اليهود إلى أقصى حد، و كان من أسلم من أهل الكتاب لا بد أن يعلن ذلك أمام قاض من قضاة المسلمين في قرطبة و غيرها من البلدان، و أن يسجل إعلانه لذلك في وثيقة يشهد عليها شاهدين، قائلا فيها إنه يعتنق الإسلام بعد أن وقف على شريعته «طائعا آمنا، غير فارّ من شىء و لا مكره، و أنه يحمد اللّه على أن هداه للإسلام شاكرا له نعمته على هدايته له» (1).
و طبيعي أن يقبل من أسلم من أهل الأندلس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء شعائر الإسلام و تلاوة كتابه التي تعدّ جزء لا يتجزأ من اعتناقه، و بالمثل دفعوا أبناءهم إلى هذا التعلم، و معنى ذلك أن شطرا كبيرا من أهل الأندلس تعربوا تعربا كاملا: دينا و لغة، و قد بقى وراءهم شطر ظل على مسيحيته، و كان يتخذ لهجة لاتينية عامية أو رومانثية لغة في تخاطبه اليومي، غير أنه شعر سريعا بما ذكرناه آنفا من أنها لغة مجدبة فقيرة، و خاصة حين يقرنها إلى العربية، إذ ليس لها تراث أدبي كتراث العربية، و أيضا ليس لها مثلها تراث ثقافي و لا حضاري، تستطيع أن تثبت به أمامها، فضلا عما لأهل العربية في البلاد من عزة و قوة و سلطان و غلبة، و معروف أن المغلوب دائما يحاول أن يحاكى الغالب، فما بالنا إذا ظل هذا الغالب يستعلى على مسيحييّ الأندلس و يهودها ثقافيا و أدبيا و حضاريا لا قرنا و لا قرنين بل قرونا متعاقبة من القرن الثامن الميلادي حتى نهاية القرن الخامس عشر، و هم طوال هذه الحقب كانوا يقفون مشدوهين أمام هذا الفكر العربي الباهر في العلم و الأدب و الفلسفة، و يصور ذلك «ترند» في مقاله بتراث الإسلام قائلا:
«كانت قرطبة في القرن العاشر الميلادي أكثر المدن الأوربية حضارة، و كانت في ذلك الحين مثار إعجاب العالم، و بلغ من ارتفاع شأنها أن حكام ليون و نبارّه و برشلونه كانوا يقصدون إليها كلما مسّتهم الحاجة إلى جراح أو مهندس معماري أو مطرب كبير» (2). و منذ أواسط القرن الحادي عشر تتحول طليطلة و بعض المدن الأندلسية التي استولت عليها الإمارات المسيحية الشمالية إلى مؤسسات (3)ترجمة ضخمة لكل ما هو عربي من علم و فلسفة و أدب، و يؤمّ طليطلة طلاب العلم من مختلف البلاد الأوربية: الفرنسية و الإيطالية و الألمانية و الإنجليزية فضلا عن البلاد الإسبانية يحمل كل منهم بمقدار طاقته و جهده أقباسا عربية إلى مدنه و بلدانه، و ظل ذلك حتى القرن الخامس عشر للميلاد، و كانت هذه الأقباس من أكبر العوامل في نهضة أوربا و خروجها من ظلام العصور الوسطى إلى أضواء العصر الحديث. و إنما قلت ذلك كله لأتخذ منه الدليل الساطع على أن من بقى من المسيحيين في الأندلس على دينه تعرب-مثل زميله الذي اعتنق الدين الحنيف-بحكم ما كان للعربية و العرب من تفوق حضاري و ثقافي، و أيضا بحكم ما كان لهم من شعر و أدب رفيع قصص و غير قصص، بينما كانت اللهجة الرومانسية الدارجة في التخاطب «اليومي» للمسيحيين في الأندلس و في شمال ايبيريا فقيرة فقرا شديدا، بحيث لا نستطيع أن نجد مبررا كافيا لما ذهب إليه المستشرق الاسباني ريبيرا في نظريته(4)الجديدة المفضية إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون العربية الفصيحة لغة رسمية يتعلمونها في المدارس و يكتبون بها الوثائق و ما إليها، و كانوا في شئونهم اليومية و أحاديثهم فيما بينهم يستخدمون لهجة من اللاتينية الدارجة أو الرومانثية، و يقول: إن هذا الازدواج في اللغة كان الأصل في نشوء طراز شعري مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية و شرقية. و اتخذ هذا الطراز الجديد من الأدب الشعبي صورتين هما الزجل و الموشحة و هما فن شعري واحد، غير أن الزجل سوقي دارج و الموشحة عربية فصيحة. و في رأينا أن ريبيرا بالغ في كل ذلك مبالغة أدته إلى نظريته المخطئة.
و قد يشهد لها أن يروى الخشني عن بعض القضاة بقرطبة أنه كان يعرف اللاتينية الدارجة أو كما كانوا يسمونها العجمية، إذ ذكر عنه أن شخصا صاح عليه بالعجمية و هو منصرف من مجلس قضاء ليقف له، فقال لمن معه قولوا له بالعجمية إن القاضي قد أدركته الملالة و السآمة)5). و واضح أنه فهم مراده من صياحه بالعجمية، مما يدل على أنه كان يعرفها. و أوضح من ذلك في الدلالة على معرفة بعض القضاة للاتينية الدارجة ما ذكره الخشني من أن رجلا من شهود أحد القضاة يسمى ابن عمار كانت له بغلة هزيلة تلوك لجامها طوال النهار على باب المسجد، فتقدمت امرأة إلى هذا القاضي في مجلسه بالمسجد، فقالت له بالعجمية: يا قاضي انظر لشقيّتك هذه (تقصد نفسها) فقال لها بالعجمية: - كما يقول الخشني-لست أنت شقيتي إنما شقيتي بغلة ابن عمار التي تلوك لجامها على باب المسجد طوال النهار )6). و كان بين القائمين على الشهادة عند القضاة بقرطبة شيخ أعجمي اللسان مقبول الشهادة عندهم )7). و هذه الأخبار جميعا عند الخشني لا تدل دلالة قاطعة على أنه كانت بقرطبة فضلا عن الأندلس لهجة لاتينية دارجة يستخدمها العرب في لغة التخاطب لأنها أخبار فردية، و ممكن أن يكون القاضيان السالفان رزقا لأمّين أعجميتين، فتلفّظ كل منهما الأعجمية عن أمه، أما اتخاذ القضاة لشاهد أعجمي اللسان فيدل على أنهم كانوا في حاجة إليه و أنهم كانوا لا يعرفون اللاتينية الدارجة التي يلوكها بعض الأعاجم، فاحتاجوا إلى مترجم يترجم ما يقولون سواء أكانوا من أصحاب الدعاوى أو المتهمين، حتى يحكم القضاة في قضاياهم عن حسن فقه بها و دقة فهم لها. و هو بذلك خبر ينقض ما يقال من أن لغة التخاطب في قرطبة كانت لهجة لاتينية دارجة، إذ لم تكن كثرة القضاة بها تعرفها. و مما يدلل به أيضا أنصار نظرية ريبيرا أن بعض الألقاب اللاتينية ظلت تلاحق بعض أعلام الأسر الإسبانية التي دخلت في الإسلام، و هو شيء طبيعي أن يظل اللقب اللاتيني القديم ملحقا ببعض الأعلام لأنه رمز الأسرة، و قد يقولون: إننا نجده يلحق بعض أبناء العرب أنفسهم من الشعراء و غيرهم، من ذلك أن الشاعر مؤمن بن سعيد المتوفى سنة ٢6٧ لقّب زميله عبد اللّه بن بكر بن سابق الكلاعي الشاعر بلقب النّذل كما في المقتبس لابن حيان (8)، و في التكملة لابن الأبار أنه لقّبه بالقملة و لعلها تحريف لكلمة القنلة allanaCباللاتينية أي النذل (9)، و كأنما شاع عليه اللقب بالعربية و اللاتينية. و يلقانا بعده شاعر يسمى محمد بن يحيى بن زكريا المتوفى سنة ٣٠٢ و كان هجاء كبيرا قذر الثياب دائما، فلقبه بعض معاصريه انتقاما منه بلقب القلفاط، (10)و etafalaCباللاتينية الدارجة دهّان السفن بالقار، نبزوه بذلك-كما يرى الدكتور مكي-لقذارة ثيابه. و كان سعيد بن عثمان المرواني شاعر المنصور بن أبي عامر في أواخر القرن الرابع ينبز بلقب البلّينه (11)anellaB و هو باللاتينية الدارجة-كما قال ابن سعيد-الحوت لضخامته. و مثل هذا النبز بالألقاب العجمية لأبناء العرب في قرطبة و الأندلس كان محدودا إذ لا يتجاوز المعروف منه الواضح في دلالته على النبز عدد أصابع اليدين إن لم يكن عدد أصابع اليد الواحدة، و لذلك لا نستطيع أن نتخذه دليلا على شيوع اللاتينية الدارجة في تخاطب العرب بالأندلس.
و قد يقول أصحاب نظرية ريبيرا إن في أيدينا برهانا قويا على صحتها هو ما ذكره ابن حزم في كتابه «جمهرة أنساب العرب» عن قبيلة بلىّ بالأندلس، إذ قال: «دارهم في الموضع المعروف باسمهم بشمالي قرطبة، و هم هنالك إلى اليوم (في القرن الخامس الهجري) على أنسابهم لا يحسنون الكلام باللاتينية لكن بالعربية فقط: نساؤهم و رجالهم» (12). و يقولون واضح من هذا النص لابن حزم أن قبيلة بلىّ وحدها في الأندلس دون القبائل العربية الأخرى لم تكن تحسن الكلام باللاتينية الدارجة، بخلاف سواها من القبائل، إذ كانت تتكلم بها و تتخاطب في لغتها اليومية. و ابن حزم إنما تحدث عن بلىّ وحدها، دون أن ينسب بوضوح إلى غيرها من القبائل أنها كانت تحسن الأداء عما في نفسها باللاتينية. و لعل مما يؤكد أنه كان وراءها قبائل بل مدن لا تتكلم إلا بالعربية على شاكلتها ما جاء عند ياقوت بالقرن السابع في كتابه معجم البلدان عن أهل شلب إذ يقول: «قلّ أن ترى من أهلها من لا يقول شعرا و من لا يعانى الأدب، و لو مررت بالفلاح فيها خلف محراثه، و سألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه و أي معنى طلبت منه» (13). و يقول ابن الخطيب في الإحاطة(14)إن أهل غرناطة-في زمنه بالقرن الثامن الهجري-ألسنتهم فصيحة عربية، يتخللها إعراب كثير. و في الروض المعطار للحميري المتوفى سنة ٩٠٠: «مدينة شلب في الجنوب الغربي للأندلس» و يقول: «إن سكانها و سكان قراها ظلوا يحافظون على اللغة العربية الفصيحة إلى عهود متأخرة» (15). و كأنما ظل يعيش في الأندلس ببعض مدنها و ديارها عرب لم يفارقوا لغتهم الفصيحة حتى عصور متأخرة، فكيف يذهب باحث إلى أن العرب-أو كثيرا منهم-هناك زايلت العربية أماكنها من ألسنتهم و عقولهم و قلوبهم و حلت محلها اللاتينية الدارجة في تخاطبهم اليومي، بينما كانت الفصحى لغة السياسة و السلطان و الحكم و لغة الدين و الثقافة و الفكر و الأدب؟ !
و مما يدل على خطأ نظرية ريبيرا أيضا-من بعض الوجوه-صيحة ألبرو القرطبي المشهورة سنة ٢4٠ ه/٨54 م و فيها يأسى لولع نصارى الإسبان بالأدب العربي و لغته العربية، فما بالنا بولع المسلمين من العرب و الإسبان بهذه اللغة و أدبها الرائع، يقول، و الحسرة تقطّع نياط قلبه: «إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب و حكاياتهم، و يقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين و الفلاسفة المسلمين، لا ليردّوا عليها و ينقضوها، و إنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا، و أين تجد الآن واحدا-من غير رجال الدين-يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ! و من-سوى رجال الدين-يعكف على دراسة كتابات الحواريين و آثار الأنبياء و الرسل؟ ! يا للحسرة! إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب و آدابها، و يؤمنون بها و يقبلون عليها في نهم، و هم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها، و يصرّحون في كل مكان بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب، فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم. يا للألم! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم، فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من الخطأ، فأما عن الكتابة بلغة العرب فإنك واجد فيهم عددا عظيما يجيدونها في أسلوب منمق، بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا و جمالا» (16).
و ألبرو يصرخ-بأعلى صوته-إن شبان النصارى في الأندلس لزمنه أصبحوا يشغفون شغفا شديدا بلغة العرب و آدابها الرائعة، حتى لقد نسوا لروعتها الباهرة لغتهم اللاتينية، فإذا هي تملك منهم الألسنة و القلوب و تسيطر على العقول و المشاعر و الأحاسيس، و إذا هم يعكفون عليها قارئين متخذين منها أمثلتهم في الكتابة المنمقة و نظم الأشعار البديعة. و يؤكد بالنثيا تلك الصيحة لألبرو قائلا: «إن كل ما ذكره حقيقي تؤيده تلك القصائد التي نجدها في خاتمة مخطوط محفوظ في المكتبة الأهلية بمدريد، و هو يضم مجموعة من القوانين الكنسية، و قراراتها مرتبة أبوابا على حسب موضوعاتها و مترجمة من اللاتينية إلى العربية بقلم قسّ يسمّى بنجنسيس، و الكتاب مهدى إلى الأسقف عبد الملك، و نظمت عبارات الإهداء في قصيدة شعرية عربية لا تفترق في شيء عما ينظمه العرب المسلمون في هذا المقام شكلا و مضمونا» . و يسوق بالنثيا أربعة أبيات بديعة من تلك القصيدة، ثم يقول: «و الكثير من الكتب اللاتينية التي كتبها المستعربون (من نصارى الإسبان) تحمل هوامشها شروحا و تعليقات عربية. . و قد ظلوا يستخدمون العربية زمنا طويلا بعد زوال سلطان الإسلام من الجزيرة (في طليطلة و غيرها من المدن الأندلسية الوسطى و الغربية و الشرقية) و ظلوا يكتبون بلغة العرب وقائعهم و يتسمّون بأسماء عربية حتى أوائل القرن الرابع عشر، كما يتضح من الوثائق التي خلّفها لنا مستعربو طليطلة» (17).
و يشهد لبالنثيا و ألبرو أن نجد بين الإسبان المسيحيين من بلغ من إتقانهم العربية أن عيّنوا كتابا في دواوين الدولة الأموية منذ أواسط القرن الثالث الهجري مثل قومس بن أنتنيان الذي مرّ ذكره في الفصل الأول لعهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. و إذا كان ألبرو يشهد بتعرب الإسبان المسيحيين بحيث أصبحوا يستحبّون العربية على لغتهم اللاتينية الدارجة فإن اليهود الذين كانوا يعيشون بإسبانيا منذ قرون طويلة تعرّبت-في ظننا- كثرتهم حتى لنجد كتب التراجم الأدبية الأندلسية تترجم لنفر منهم بين كتاب الأندلس و شعرائها و موسيقييها و وشّاحيها، و قد ترجم ابن سعيد في كتابه المغرب لسبعة منهم، هم:
إسماعيل بن يوسف بن النغريلّة وزير باديس بن حبوس في غرناطة و كان سيئ السيرة، و كذلك لابنه يوسف و كانا شاعرين، و لمعاصرهما حسداي بن يوسف بن حسداي كاتب بني هود بسرقسطة، و قد أقاله اللّه من دينه، فأسلم و حسن إسلامه، و كان أديبا مجيدا شعرا و نثرا، و له ترجمة طويلة في كتاب الذخيرة و كان أبوه كاتبا عند بني هود قبله، و عيّن عبد الرحمن الناصر جده حسداي كاتبا في دواوينه. و ممن ترجم لهم ابن سعيد بين شعراء المائة السادسة إلياس بن صدّود الطبيب و إسحق بن شمعون و كان يحسن الغناء و الضرب على الآلات الموسيقية الأندلسية. و ترجم ابن سعيد لشاعر يهودي طليطلي مستعرب هو إبراهيم بن الفخار رسول ألفونس إلى الأئمة في دولة الموحدين. و ترجم ابن سعيد في القرن السابع أيضا لإبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي الذى آثر الإسلام دينا و عقيدة، و كان شاعرا نابها و وشاحا مجيدا. و مما يدل على اتساع التعرب بين يهود الأندلس أن نجد بين نسائهم شاعرات مجيدات مثل قسمونة بنت إسماعيل اليهودي و كان أبوها-كما يقول المقّري-شاعرا و اعتنى بتأديبها، و كانت تطارحه الشعر، و كان ربما نظم قسما من موشحة، فأتمتها هي بقسم آخر. و مما يؤكد أن الكثرة من يهود الأندلس تعربت تعربا كاملا أنه حين أخذ الإسبان و الغربيون يطلبون ترجمة الثقافة العربية إلى الإسبانية الدارجة و اللاتينية كان لهم في ذلك دور ضخم، سوى ما تمثلوه من تلك الثقافة في لغتهم العبرية، حتى ليقول بالنثيا: «نبعت ثقافة يهود إسبانيا من موارد الثقافة الإسلامية الأندلسية بصفة مباشرة» (18).
و لعل في ذلك كله ما ينقض-بوضوح-نظرية ريبيرا المفضية إلى أن عرب الأندلس كانوا يستخدمون في شئونهم اليومية و أحاديثهم فيما بينهم لهجة من اللاتينية الدارجة أو العجمية، لأن في ذلك ما يخالف الحقائق الكبرى التي قدمناها. و أيضا فإنه لا يستطيع أحد أن يقول إن نصارى الإسبان في الأندلس و يهودها لم يكونوا يستخدمون في تخاطبهم اليومي العامية العربية الأندلسية، بينما سموا مستعربين و هو اسم لصق بهم طوال امتزاجهم بالعرب قرونا متوالية. و كل ما يستدل به ريبيرا على نظريته المخطئة ظهور طراز جديد من الأدب الشعبي في الأندلس اتخذ صورتين هما الموشحة و الزجل، و معروف أن الموشحة سبقت في نشأتها الزجل بأكثر من قرنين على الأقل و أنها كانت تنظم بالعربية الفصحى في جمهورها، إلا ما قد يتظرف به ناظمها في الحين بعد الحين من ذكر كلمات رومانسية في نهايتها، على نحو ما سنوضح ذلك فيما بعد، و معروف أيضا أن الزجل لا ينظم بلاتينية دارجة، إنما ينظم بعامية أندلسية تتراءى فيها أحيانا ألفاظ من اللغة اللاتينية الدارجة، و هي ليست عامية لاتينية، إنما هي عامية عربية، شأنها شأن العاميات التي نشأت في جميع البلاد العربية من التقاء الفصحى فيها بلغات أهلها الوطنية، و قد دخلتها في كل بلد عربي بعض خصائص تلك اللغات في النبر و التصريف، كما دخلتها ألفاظ منها كثيرة. و هو ما حدث في الأندلس على نحو ما يتضح في أزجالها، فهي منظومة بعربية عامية تتخللها من حين إلى حين ألفاظ من اللهجة الرومانثية التي كانت مستقرة في الأندلس قبل الفتح العربي و ظلت حية فيما وراءها من الإمارات المسيحية في الشمال، و بالمثل في الأندلس على ألسنة بعض النصارى و الجواري الإسبانيات و المسترقين من الإسبان في الحروب، و انزلقت منها بعض ألفاظ في الأزجال.
و بين أيدينا نصوص لا تكاد تحصى أو تستقصى من هذه الأزجال المنظومة بالعامية، و ليس فيها أي نص مكتوب أو منظوم باللهجة الرومانثية الدارجة في الأندلس، مما يؤكد أن نظرية ريبيرا المفضية إلى شيوع تلك اللهجة على ألسنة عرب الأندلس مخطئة و كل ما يمكن أن يقال إن بعض عرب الأندلس كانوا يعرفون تلك اللهجة أو يلمون بشيء منها بجانب الفصحى و العامية العربية الأندلسية المتداولة في الألسنة. و لم يكتب الزجالون بتلك العامية أزجالهم وحدها، بل كتبوا معها أيضا قصائد نظموها على أوزان العروض العربي، على نحو ما يلقانا عند أبي عبد اللّه أحمد بن الحاج المعروف باسم مدغلّيس، و هو من شعراء القرن السادس الهجري، إذ ذكر صفي الدين الحلي في كتابه: «العاطل الحالي» أنه قرأ له في ديوانه بجانب أزجاله ثلاث عشرة قصيدة عامية على أوزان الشعر العربي، و قد سمّى أوزان عشر قصائد منها، و هي أربع من وزن المديد، و اثنتان من وزن الرمل، و أخريان من وزن الخفيف، و قصيدة من وزن المتقارب و أخرى من وزن مخلّع البسيط، و أنشد من كل قصيدة مجموعة غير قليلة من أبياتها العامية(19). و من المؤكد أن الأزجال عند مدغليس و غيره كانت مثل هذه القصائد العامية تنظم على أوزان الشعر العربي كما سيتضح-فيما بعد-في تعليقنا على ما ننشده من بعض الأزجال.
و الأندلس-بذلك كله-لم يتداول أهلها من العرب في ألسنتهم لهجة لاتينية دارجة كما توهم ريبيرا، إنما تداولوا فيها عامية عربية، كان يتداولها العامة بالأندلس في تخاطبهم اليومي بالأسواق و غير الأسواق، و اشترك معهم فيها أوساط المثقفين مع تمسكهم بالفصحى و آدابها الرفيعة، يستوي في ذلك المسلمون و المسالمة، كما يستوى المسيحيون المستعربون ممن تحدث عنهم ألبرو آنفا. و الشعب الأندلسي-في هذا الصنيع-يلتقي بجميع الشعوب الإسلامية في البلدان العربية المختلفة، إذ كانت الأوساط الثقافية فيها جميعا تتمسك بالفصحى و تتمثل آدابها و تشارك فيها بما تنتج من شعر و نثر، و في الوقت نفسه تتحدث هذه الأوساط بلغة عامية دارجة مثلها في ذلك مثل العامة من حولها، و هي لغة أهمل فيها الإعراب، و دخلتها بعض خصائص و ألفاظ من اللغات القديمة التي كانت سائدة في تلك البلدان قبل أن ينزلها العرب و يستقروا فيها و يتخذوها أوطانا جديدة لهم.
و كما أن العامة بمختلف البلدان العربية بدّلت في بعض ألفاظ العربية تبديلات مختلفة في حركاتها و انزلقت من كلماتها السوقية و العامية بعض ألفاظ إلى كتابات الكتّاب و قصائد الشعراء مما جعل بعض اللغويين في المشرق يؤلف كتبا في لحن العامة، حتى يجتنبه الأدباء و ينحّوه عن كتاباتهم و أشعارهم على نحو ما نعرف عند الكسائي البغدادي المتوفى سنة ١٨٩ للهجرة كذلك ألّف الزبيدي القرطبي الذي مرّ ذكره بين اللغويين الأندلسيين في القرن الرابع الهجري كتابا في لحن العوام حتى ينبّه الكتّاب و الشعراء إلى ما أفسدته العامة من ألفاظ العربية و دخل أحيانا في كتاباتهم و أشعارهم حتى يتبيّنوه و يجتنبوه)20).
و إذن فقد كانت تشيع عامية عربية في الأندلس على ألسنة العرب و المستعربين لا لاتينية دارجة أو رومانثية، كما ظن ريبيرا، و هي عامية كانت تهمل الإعراب و تفسد أحيانا النطق السليم لبعض ألفاظ العربية شأن العاميات التي نشأت في البلدان العربية الأخرى، و قد كتب فيها-كما ذكرنا-العلماء اللغويون من أمثال الزبيدي كتبا، و نظم فيها زجالون أزجالا كثيرة، و أحيانا دواوين زجلية، و أضاف بعض الزجالين إلى أزجالهم قصائد عامية، و هو تراث عربي أندلسي عامي ضخم، و هو لا يقاس من حيث الضخامة إلى ما خلقت العربية هناك من تراث فصيح هائل ثقافي و أدبي و علمي و فلسفي، بحيث نستطيع أن نقول بحق إن العرب أنشأوا في الأندلس شعبا عربيا كبيرا ظل بها ثمانية قرون متعاقبة، و ظل عربي اللغة فصيحة و عامية، و ظل عربي الدين و الحضارة كما ظل عربي الثقافة و العقل و الفكر و الشعور و الوجدان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كتاب الوثائق و السجلات لابن العطار (طبع مدريد) ص 4٠5 و ما بعدها.
2) تراث الإسلام (طبع لجنة التأليف و الترجمة و النشر) ص ١٧.
3( انظر في ذلك تاريخ الفكر الأندلسي لبانثيا ص 5٣6 و ما بعدها و في مواضع مختلفة.
4) راجع هذه النظرية في بالنثيا ص ١4٢ و ما بعدها.
5) قضاة قرطبة للخشني (طبعة مصر) ص ٩6.
6) الخشني ص ١١٨.
7) الخشني ص ٨4.
8) انظر المقتبس (تحقيق د. مكى طبع بيروت) ص ٩٨ و قابل بالمغرب ١/١١٣.
9) التكملة (طبع مدريد) رقم ١٢4٠ و راجع في ذلك تعليق د. مكى في المقتبس ص 5٠4
10) راجع المغرب ١/١١١.
11) المغرب ١/١٩٧.
12) راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم (طبع دار المعارف) ص 44٣.
13) انظر مدية شلب في معجم البلدان لياقوت.
14) الإحاطة (الطبعة الأولى)١/١٣5.
15( الروض المعطار للحميري (طبع لجنة التأليف و الترجمة و النشر) ص ١٠6.
16) راجع نص هذه الصيحة في بالنثيا ص 4٨5 و ما بعدها.
17) انظر بالنثيا ص 4٨6 و ما بعدها.
18) راجع دور اليهود في ترجمة الثقافة الأندلسية عند بالنثيا ص 4٨٨ و 5٣٧.
19) راجع كتاب العاطل الحالي و المرخص الغالي لصفي الدين الحلي بتحقيق حسين نصار (نشر الهيأة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) ص ١5 و ما بعدها.
20) انظر مقدمة كتاب لحن العوام للزبيدي بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب (طبع مكتبة دا. العروبة بالقاهرة).
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|