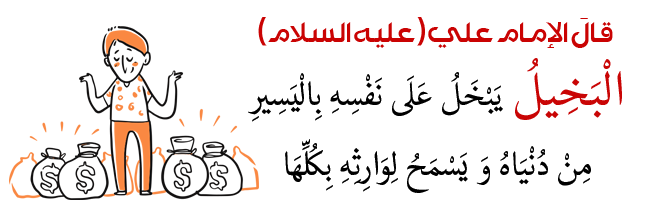
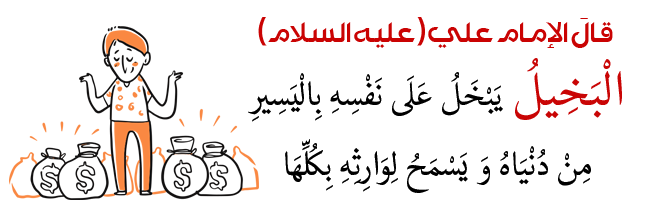

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
التاريخ: 2025-05-01
التاريخ: 2024-02-24
التاريخ: 23-8-2016
|
تناولت الرّوايات الإسلاميّة هاتين المسألتين، بمزيدٍ من الاهتمام، وكذلك علماء الأخلاق، أكّدوا عليهما في أبحاثهم التّربوية، لاعتقادهم أنّ السّير والسّلوك إلى الله تعالى، لنْ يتحقّق في واقع الإنسان إلّا بالسّكوت، وحفظ اللّسان من الذنوب التي قد يقع الإنسان فيها من خلال الكلام، وإن كان، قد أتعب نفسه في الرياضات الرّوحيّة وأنواع العبادات.
أو بتعبيرٍ أدَقْ: إنّ مفتاح مسيرة التهذيب والسّلوك إلى الله تعالى هو الإلتزام بِذَينك الأمرين، ومن لم يستطع السّيطرة على لسانه، فلن يُفلح في الوصول، إلى الأهداف السّامية والمقاصد العالية.
وبعد هذه الإشارة نعود إلى بحثنا الأساسي، ودراسة الآيات والرّوايات التي وَرَدت في هذا المِضمار.
السّكوت في الآيات القرآنيّة الكريمة:
في كِلا المَوردين، اعتبر القرآن الكريم، هذه المسألة من القيم السّامية، في خطّ الإيمان والأخلاق، ففي بادئ الأمرِ، استعرض قصّة مريم (عليها السلام)، فعند ما كانَت في وضعها المُتأزّم، وتفكيرها في حملها وحالة الطلق التي أصابتها، ووحدتها في تلك الصّحراء المريعة، وقد هوّمت نحوها الهُموم من كلِّ جانبٍ، وأشدّها افتراءات بني إسرائيل عليها، فتمنّت الموت في تلك السّاعة من بارِئها، ولكن جاءها النّداء، أن لا تحزن ولا تغتم، فإنّ الله معها وهو الذي يتكفّل أمرها، وهذا ما تُحدِّثنا به الآيات التالية: «فَأَجَاءَهَا الْمخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَنْسِيّاً* فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً* وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً* فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولي إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً» ([1]).
واختلف المفسّرون في الذي نادى مريم (عليها السلام)، فقال بعضهم: إنّه جِبرائيل (عليه السلام)، وسياق الآية قرينةٌ على هذا المعنى، وقال البَعض الآخر، كالعلّامة الطّباطبائي (رحمه الله)، إنّه ابنها عيسى (عليه السلام)، وكلمة: «من تحتها»، تناسب هذا المعنى، لأنّه كان بين أقدامها، علاوة على أنّ أغلب الضّمائر في الآية الشّريفة، تعود على المسيح (عليه السلام)، وتَتَناسب أيضاً مع كلمة «نادى»، وعلى كلٍّ فإنّ مَحَطَّ نظرنا، هو الأمرُ بنذر السّكوت، فأيّاً كان المُنادي، جبرائيل (عليه السلام)، أو المسيح (عليه السلام)، فإنّ المهم هو، أنّ ذلك النّذر، يفضله ويرجحّه الباري تعالى، وخصوصاً أنّ ذلك الأمر، كان سائداً في وقتها، وهو من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يعترض على مريم (عليها السلام) أحد، بالنّسبة إلى هذا العمل بالذّات.
ويوجد احتمال آخرٌ لصوم مريم (عليها السلام)، وهو الصّوم عن الطّعام والشّراب، بالإضافة لصوم السّكوت.
أمّا في الشّريعة الإسلاميّة، فإنّ صوم السّكوت حرام، لتغيّر الظّروف المكانيّة والزمانيّة، وقد وَرد عن الإمام علي بن الحسين السّجاد (عليه السلام)، أنّه قال: «وَصَومُ الصَّمتِ حَرامٌ» ([2]).
وَوَرد في نفس هذا المعنى في حديثٍ آخر، في وصايا النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، إلى الإمام علي (عليه السلام) ([3]).
وَوَرد عن الإمام الصّادق (عليه السلام)، أنّه قال: «وَلا صَمْتَ يَوماً إِلَى اللّيلِ» ([4]).
والطّبع، فإنّ من آداب الصّوم عندنا، هو المحافظة على اللّسان وباقي الجوارح من الذّنوب، قال الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا الصّدد: «إِنّ الصّومَ لَيسَ مِنْ الطّعامِ والشَّرابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَريَمَ قَالتْ إِنّي نَذَرتُ لِلرَّحمانِ صَوماً أي صمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُم وَغُضُّوا أَبْصارَكُم» ([5]).
ومن هذه الآية والرّوايات الشّريفة، التي وردت في تفسيرها، تتبيّن أهميّة وقيمة السّكوت، في خطّ التّربية والتّهذيب.
وفي الآية (10) من نفس السورة، توجد إشارةٌ اخرى لفضيلة السّكوت، وذلك عند ما وهب الباري تعالى يحيى (عليه السلام)، لنبيّه الكريم زكريّا (عليه السلام)، فخاطب الباري تعالى، وقال: (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً)، فقال له: (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا)، ولا تحركه إلّا بذكر الله.
وصحيح أنّ هذه الآية لم تَحمد ولم تَذم السّكوت، ولكن قيمة السّكوت تتّضح، من جعله: آيةَ النّبي زكريا (عليه السلام).
وورد نفس هذا المعنى، في الآية (41) من سورة آل عمران، فبعد تلقّيه البشارة من الباري تعالى، طلب أن يجعل له آيةً في دائرة تقديم الشّكر للباري تعالى، فقال له: (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً).
وإحتمل بعض المفسّرين، أنّ إمتناع زكريا (عليه السلام) عن الكلام، كان باختياره ولم يكن مجبوراً عليه، والحقيقة أنّه كان مأموراً بالسّكوت لمدّة ثلاثة أيّام.
يقول الفَخر الرّازي، نقلاً عن «أبي مسلم»: أنّ هذا النحو من التّفسير جميلٌ ومعقولٌ، لكنّه مخالفٌ لسياق الآية، فزكريّا (عليه السلام) طلب آيةً لمّا بُشّر بيحيى، والسّكوت الاختياري لا يكون دليلاً على هذا المعنى، إلّا بتكلّف وتحميل على المفهوم من الآية الشّريفة.
وعلى أيّةِ حال فإنّ هذا الاختلاف في تفسير الآية، لا يُؤثّر على ما نحن فيه، لأنّ غرضنا من إيراد هذه الآيات، هو التّنويه بقيمة السّكوت في القرآن الكريم، باعتباره آيةً من الآيات الإلهيّة.
السّكوت في الروايات الإسلاميّة:
ما ورد عن: «الصّمت»، في الروايات الإسلاميّة، أكثر من أن يُحصى، فقد أشارت الروايات إلى عدّة نقاطٍ وملاحظاتٍ دقيقة وهامة جدّاً في هذا الصّدد، وبيّنت ثمرات جميلةً للصّمت، ومنها:
1 ـ دَور السّكوت في تعميق التّفكير، وثبات العقل، فقد قال الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «إِذا رَأَيْتُمْ المُؤمِنَ صَمُوتاً فَآدْنُوا مِنْهِ فَإِنَّهُ يُلْقي الحِكْمَةَ، وَالمُؤمِنُ قَليلُ الكَلامِ كَثِيرٌ العَمَلِ وَالمُنافِقُ كَثِيرُ الكَلامِ قَلِيلُ العَمَلِ» ([6]).
2 ـ وجاء عن الإمام الصّادق (عليه السلام)، أنّه قال: «دَلِيلُ العاقِلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمتُ» ([7]).
3 ـ ما ورد عن الإمام علي (عليه السلام)، أنّه قال: «أَكْثِرْ صَمْتَكَ يَتَوفَر فِكْرُكَ ويَستَنيرُ قَلْبُكَ وَيَسلَم النّاسُ مِنْ يَدِكَ» ([8]).
فيظهر من هذه الرّوايات، العلاقة الوثيقة الدقيقة، التي تربط التّفكر بالسّكوت، ودليله واضح، لأنّ القوى الفكريّة سوف تفقد التوحّد والانسجام، وتصيبها حالةٌ من التّشتت والانفلات، في حالات الكلام الزّائد، وعند ما يتخذ الإنسان السّكوت جِلباباً له، فستَتَمَركز قِواه الفكريّة، ممّا يعينه على التّفكير الصّحيح، وبالتّالي انفتاح أبواب الحِكمة بِوَجهه، ولا يُلّقى الحكمة إلّا ذو حَظٍّ عظيمٍ.
4 ـ يُستَشفّ من بعض الأخبار، أنّ السكوت هو أهمّ العبادات، فنقرأ في مواعظ الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، لأبي ذر (رحمه الله)، قال: «أَرْبَعَ لا يُصِيبَهُنَّ إلّا مُؤمِنْ، الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلَ العِبادَةِ» ([9]).
5 ـ ويُستفاد من الرّوايات الواردة، أنّ كثرة الكلام تزرع القساوة في القلب، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، حديثٌ يقول فيه: «كانَ المَسِيحُ (عليه السلام) يَقُولُ لا تكثروا الكَلامَ في غَيرِ ذِكْرِ اللهِ فَإنَّ الَّذِينَ يكْثِرُونَ الكَلامَ في غَيرِ ذِكْرِ اللهِ قاسِيَةٌ قُلُوبُهُم وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ» ([10]).
6 ـ ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، أنّه قال: «إِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ أَبوابِ الحِكْمَةِ، إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الَمحَبَّةَ إِنَّهُ دَليلٌ عَلَى كُلِّ خَيرٍ» ([11]).
فقوله إنّ السّكوت يكسب المحبّة، لأنّ أكثر المشاحنات والملاحاة، تصدر عن اللّسان، والسّكوت يسدّ أبواب الشّر.
7 ـ السّكوت نجاةٌ من الذّنوب، ومفتاح دخول الجنة، فقد ورد في حديثٍ عن الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، قَالَ لِرَجُلٍ أَتاهُ: أَلا أَدُلُّكَ عَلى أَمْرٍ يُدخِلُكَ اللهُ بِهِ الجَنَّةَ؟، قَالَ: بَلى يا رَسُولَ الله، قال (صلى الله عليه وآله): «.... فاصْمُتْ لِسانَكَ إلّا مِنْ خَيرٍ، أَما يَسُرُّكَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ خِصلَةٌ مِنْ هُذِهِ الخِصال تَجُرُّكَ إِلى الجَنَّةِ» ([12]).
8 ـ والسّكوت علامةُ الوقار، فقد ورد عن الإمام علي (عليه السلام): «الصَّمْتُ يَكْسِبُكَ الوِقارُ، وَيَكْفِيكَ مَؤُونَةَ الاعتذار» ([13]).
فالثّرثار كثير الخطأ، كثير الاعتذار والنّدم، لما يصدر منه مِنْ شطحات، من موقع الغفلة والاندفاع العاطفي والانفعال النّفسي.
9 ـ وعنه (عليه السلام)، في حديث أوضح وأجلى، فقال: «إِنْ كانَ في الكَلامِ بَلاغَةٌ فَفي الصَّمْتِ سَلامَةٌ مِنَ العِثارِ» ([14]).
فالصّمت قد يكون، أبلغ من أيّ كلامٍ في بعض الموارد!.
10 ـ ما ورد عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، أنّه قال: «نِعْمَ العَونُ الصَّمْتُ في مَواطِنٍ كَثِيرةٍ وَإِنْ كُنْتَ فَصِيحاً» ([15]).
وهناك رواياتٌ كثيرةٌ في هذا المجال، لم نذكرها هنا، خوفاً من الإطالة والخروج عن مِحَور البحث.
إزالة وَهم:
إنّ كلّ ما ورد في الآيات والأحاديث الشّريفة، من معطيات الصّمت الإيجابيّة في حياة الإنسان وواقعه، من قَبيل تعميق الفكر ومنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، وصيانته من كثيرٍ من الذّنوب، وحفظ وَقاره وشَخصيّته، وعدم الحاجة إلى الاعتذار المُكَرّر، وأمثالُ ذلك، كِلّ هذا لا يعني أن السكوت، يمكن أن يتخذه الإنسان قاعدةً على الدّوام، فالسّكوت المَطلق مذمومٌ بدوره، وخسارةٌ اخرى لا تُعوّض.
والغاية ممّا تقدم، في مَدح السّكوت والصّمت في الآيات والرّوايات الإسلامية، هي منع اللّسان عن الثّرثرة وفضول الكلام، في خط التّربية ومصداق، أن: «قلْ خيراً وإلّا فاسْكت»، وإلّا فالسّكوت في كثيرٍ من الامور، حَرامٌ مَسلّمٌ.
ألم يذكر القرآن الكريم في سورة الرحمن نعمة البيان باعتبارها من أسمى إفتخارات البشر؟
ألا تقام أكثر وأغلب العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم ومراسم الحج والذكر باللسان؟
ولو لا اللسان، فكيف سيتمكن المؤمن من إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف سيكون دور الإرشاد والتربية والتعليم، وكيف سيتمكن العلماء والمصلحين من أداء دورهم في عملية هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق والسعادة؟!
فالمذموم هو الافراط والتفريط والطريق الوسطى هي الجادّة!
وما صدر من إمامنا السجاد (عليه السلام) في هذا المضمار هو خير مرشد ودليل في هذا المجال، حيث سأله شخص عن أيهما الأفضل: الكلام أو السكوت؟ فقال (عليه السلام): «لِكُلِّ وَاحدٍ مِنْهُما آفاتٌ فَإذا سَلِما مَنَ الآفاتِ فَالكَلامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، قِيلَ كَيفَ ذَلِكَ يا بنَ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله)؟ قَالَ: لِأَنّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ما بَعَثَ الأَنْبِياءَ وَالأَوصياءَ بِالسُّكُوتِ، إِنَّما بَعَثَهُم بِالكِلامِ، وَلا اسْتَحَقَّتِ الجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ وَلا اسْتَوجَبَتْ وِلايَةً بِالسُّكُوتِ ولا تِوَقِّيتِ النّارُ بِالسُّكُوتِ إِنَّما ذَلِكَ كُلُّهُ بِالكَلامِ، وَما كُنْتُ لِأعدِلَ القَمَرَ بِالشَّمْسِ إِنَّكَ تَصِفُ فَضْلَ السُّكُوتِ بِالكَلامِ وَلَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الكَلامِ بِالسُّكُوتِ» ([16]).
أجل لا شك أنّ لكلٍّ من الصّمت والكلام، محاسنه ومَساويه، والحقّ أنّ إيجابيات الكلام أكثر، ولكن متى؟، فقط: عند ما يصل الإنسان، إلى مراحل سامية من التّهذيب للنفس، في معراج الكمال المعنوي، وأمّا من كان في بداية الطّريق، فعليه التّحلي بالسّكوت رَيْثَما تتعمق في نفسه تلك الملكات الرّوحانية، التي يكتسبها الإنسان في حركة الانفتاح على الله، أو كما يُقال، ريثما يملك السّالك لسانه عن ممارسة اللّغو والكلام الباطل، وبعدها يجلس لِلوَعظ والإرشاد.
وبالإمكان بيان معيارٍ جيّدٍ لهذه الحالة، فنحن إذا أردنا في يومٍ من الأيّام، تسجيل ما يصدر منّا من كلماتٍ وألفاظٍ على آلة التسجيل، ثم أصغينا لهذه الأحاديث والكلمات، منِ موقع الإنصاف وبعيداً عن التّعصب، فَسَنرى الشّريط ملىءٌ بالتّفاهات والتّرّهات، ولن يبقى من الكلام المفيد إلّا كلماتً أو جملاً قليلةً، تتعلق بالغايات الإلهيّة والحاجات الضرورية، في حركة الحياة والواقع العملي.
ويبقى أمرٌ أخير، تجدر الإشارة إليه، أَلا وهو، أنّ «الصّمت» و «السّكوت» وَردا بمعنى واحد في معاجم اللّغة، ولكن بعض علماء الأخلاق ذهب إلى وجود فرق بينهما، فان السّكوت هو التّرك المُطلق للكلام، والصّمت هو التّرك المقصود للكلام الزائد واللّغو، أي: «تركُك ما لا يُعينك»، وهدف السّالك الحقيقي في إطار تهذيب النّفس، والسّلوك المعنوي ينسجم مع: [الصّمت] لا [السّكوت].
إصلاح اللّسان:
ما تقدم آنفاً من أهمية السّكوت أو الصّمت، ودوره في تهذيب النّفوس، والأخلاق في خطّ السّير والسّلوك إلى الله، هو في الحقيقة من الطّرق الحياتيّة للوقاية من آفات اللّسان، لأنّ اللّسان في الحقيقة، هو المفتاح للعلوم والثّقافة والعقيدة والأخلاق، وإصلاحه يُعدّ أساساً لِكلّ الإصلاحات الأخلاقيّة في واقع الإنسان، والعَكس صحيح، ولأجله فإنّ الحديث عن إصلاح اللّسان، أوسع منَ مبحث السّكوت وأَشمل.
وقد اكتسب مبحث إصلاح اللّسان، أهميّةً بالغةً في الأبحاث الأخلاقيّة باعتباره، تُرجمان القلب ورَسول العَقل، ومفتاح شخصيّة الإنسان، ونافذة الرّوح على آفاق الواقع.
وبعبارةٍ اخرى: إنّ ما يرتسم على صفحات الرّوح والنّفس، يظهر قبل كلّ شيء على فَلتات اللّسان، واللّطيف في الأمر أنّ قُدامى الأطباء، كانوا يُشخّصون المرض، ويتعرّفون على سلامة الشّخص ومزاجه عن طريق اللّسان، فَلَم تكن عندهم هذه الإمكانيّات المعقدّة التي بأيدينا اليوم، فالطّبيب الحاذق، كان يتحرك في عمليّة تشخيصه، لأمراض الباطن عن طريق اللسان، حيث يَنكشِف له من خلال ظاهر اللّسان ولونه، الأمراض الكامنة في خَبايا جسم صاحبه.
وهكذا الحال بالنّسبة لأمراض الرّوح والعقل والأخلاق، فيمكن للّسان أن يكشف لنا المفاسد الأخلاقيّة، والسّلبيات النّفسية والتّعقيدات الرّوحية، التي تعتلج في صدر وروح الإنسان أيضاً.
وعليه، فإنّ علماء الأخلاق يرون، أنّ همّهم الأول والأخير حفظ وإصلاح اللّسان، ويعتبرونها خُطوةً مهمّةً ومؤثرةً في طريق التّكامل الرّوحي والأخلاقي، وقد عكس لنا أميرُ المؤمنين (عليه السلام)، ذلك الأمر في حديثه الذي قال فيه: «تَكَلَّمُوا تُعرَفُوا فإنّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسانِهِ» ([17]).
وجاء في حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «لا يَسْتَقِيمُ إِيمانُ عَبدٍ حَتّىْ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهَ ولا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتّى يَستَقِيمَ لِسانْهُ» ([18]).
ونعود بعد هذه الإشارة إلى أصل بحثنا، ونقسّمه إلى أربعة محاور.
1 ـ أهميّة اللّسان باعتباره نعمة إلهية كبيرة.
2 ـ العلاقة الوثيقة بين إصلاح اللّسان، وإصلاح روح وفكر الإنسان وأخلاقه.
3 ـ آفاتُ اللّسان.
4 ـ الاصول والأسس الكليّة، لِعلاج آفاتِ اللّسانِ.
في المحور الأوّل: تحدّث القرآن الكريم، في آيتين من سورة «البلد» و «الرّحمان»، بِأبلغ الكلام.
فنقرأ في سورة البَلد، الآيات (8 ـ 10): (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ).
فبيّنت هذه الآيات الشّريفة، النّعم والمواهب الإلهيّة الكبيرة على الإنسان في الحياة، من قَبيل نِعمة العين واللّسان والشفتان، كأدواتٍ وجوارحٍ يستخدمها الإنسان لمعرفة الخَير والشّر.
نعم، فإنّ الحقيقة، أنّ أعجب جوارح الإنسان هي اللّسان، قطعةٌ من البدن، حَمَلَتْ وحُمّلت أثقل الوظائف، فاللّسان علاوة على دوره في بلع الطّعام ومَضغِه، فإنّه يؤدي واجِبَهُ بِمهارةٍ فائقةٍ من دون أيّ إشتباهٍ، في أداء هذه المهمّة الكبيرة، وَلَوْلا مهارته في تَقليب اللّقمة بين الأسنان، فما ذا سيكون حالنا!، وبعد الأكل يقوم بعمليّة تنظيف الفم والأسنان أيضاً.
والأهمّ من ذلك والأعجب، هو كيفيّة الكلام، بواسطة حركات اللّسان السّريعة، والمرتّبة والمنظّمة في جميع الجهات.
واللّطيف في الأمر، أنّ الله سبحانه وتعالى، قد سهّل عمليّة الكلام، بصورةٍ كبيرةٍ بحيث أنّ اللّسان لا يملّ ولا يكلّ من النّطق والتّحدث إلى هذا وذاك، ومن دون تكلفةٍ ونفقةٍ، والأعجب من ذلك، قابلية الإنسان للكلام، وتكوين الجمل والكلمات المختلفة، كموهبةٍ إلهيةٍ، وملكة أصليّةٍ في روح الإنسان وفطرته، بالإضافة إلى استعداده وقدرته، لتكوين وتأليف اللّغات المختلفة، وتعددها إلى الآلاف، وكلّما مرّ الزمان ازداد عددها وتنوّعها بتنوع الأقوام والجماعات البشريّة.
فليس عجيباً عند ما يتحدث عنها القرآن الكريم، ويقول أنّها أعظم النعم؟
والجدير بالذكر، أنّ الآية الكريمة ذكرت الشّفتين إلى جانب اللّسان، فهما في الحقيقة يُساعدان اللّسان في التّلفظ بالكثير من الحروف، وتنظيم الأصوات والكلمات في عمليّة التّكلم.
ومن جهةٍ اخرى فإنّ الشّفتين، أفضل وسيلة للسّيطرة على اللّسان، كما حدّثنا بذلك رسولنا الكريم (صلى الله عليه وآله)، عن الباري تعالى، أنّه قال: «يا ابنَ آدَمَ إِنْ نازَعكَ لِسانُكَ فِى ما حَرَّمَتُ عَلَيكَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ بِطَبَقَتَينِ فأطْبِق» ([19]).
وفي بداية سورة الرّحمان: (الآيات 1 ـ 4)، يشير سُبحانه إلى نعمة البيان، التي هي ثمرة من ثمرات اللّسان، وبعد ذكر إسم «الرّحمان»، التي وسعت رحمته كلّ شيءٍ، يشير سُبحانه إلى أهمّ وأفضلّ المواهب الإلهيّة، يعني القرآن الكريم، ثم خلقة الإنسان، ثم يعرّج على موهبة البيان لدى الإنسان: (الرَّحْمنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ).
وبناءًا عليه فإنّ نعمة البيان، هي أهمّ موهبةٍ أعطاها الله سبحانه، لعباده بعد خلقهم.
وإذا ما أردنا أن نستعرض دور البيان، في تكامل ورُقي الإنسان، ودوره الفاعل في بناء الحضارة الإنسانيّة، عندها سنكون على يقينِ بأنّه لو لا تلك النّعمة الإلهيّة، والموهبة الربّانية، لما استطاع الإنسان أن ينقل خبراته وتجاربه للأجيال المتعاقبة، ولما تقدّم العِلم، ولما إنتشر الدّين والأخلاق والحضارات بين الامم السّابقة واللّاحقة.
ولنتصور أنّ الإنسان، في يوم من الأيّام، سيفقد هذه الموهبة، فممّا لا شك فيه أنّ المجتمع البشري، سيعود في ذلك اليوم إلى أجواء التّخلف الحضاري، والانحطاط في جميع الصُّعد.
عُنصر «البيان»، تتوفر فيه أداةٌ ونتيجةٌ، وبما أنّنا اعتدنا عليه، فلذلك نتعامل مع هذه الظّاهرة من موقع اللّامبالاة وعدم الاهتمام، لكنّ الحقيقة هي غير ذلك، فهو عملٌ دقيقٌ معقّدٌ فنّيٌ لا مثيل له ولا نظير. لأنّه من جهة، تتعاون الأجهزة الصوتيّة فيما بينها، من الرئة إلى الهواء الداخل إلى الأوتار الصوتيّة، والتي بدورها تتعاون، مع: اللّسان والشّفتان والأسنان والحلق والفم، لتكوين وتأليف الأصوات بسرعةٍ فائقةِ دقيقةٍ جدّاً، حتى يصل إلى الحُنجرة، التي تقوم بتقطيعه وتقسيمه حسب الحاجة.
ثم إنّ قصّة وضع اللّغات البشريّة، وتعدّدها وتنوّعها هي قصةٌ عجيبةٌ ومعقدةٌ، وتزيد من أهميّة الموضوع، «يقول بعض العلماء: أنّ عددَ لُغات العالم، وصل إلى حوالي (3000) لغة».
ونحن نعلم أنّ هذا العدد لن يتوقف عند هذا الحد، وأنّ عدد اللّغات في تزايدٍ مُستمرٍ.
فهذه النّعمة الإلهيّة، هي من أهم وأغرب وألطف النّعم، والتي لها دورٌ فاعلٌ في حياة الإنسان وتكامله ورقيّه، وهي الوسيلة، لتقارب البشر وتوطيد العلاقات فيما بينهم، على جميع المستويات.
وقد انعكست هذه المسألة، في الرّوايات بصورةٍ واسعةٍ، ومنها ما وَرد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما الإِنسانَ لَو لا اللّسانُ إِلّا صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ أَو بَهَيمَةٌ مُهمَلَةٌ» ([20]).
والحقُّ ما قاله الإمام (عليه السلام)، لأنّه لو لا اللسان فعلاً لَما امتاز الإنسان عن الحيوان، وَوَرد في حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «الجَمالُ فِي اللّسانِ» ([21]).
ونقل هذا الحديث بصورة اخرى، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجَمالُ في اللّسانِ والكَمالِ في العَقلِ» ([22]).
ونختم بحديثٍ آخرٍ عن عن الإمام علي (عليه السلام)، فقال: «إِنّ فِي الإِنسانِ عَشَرَ خِصَالٍ يُظْهِرُها لِسانُهُ، شاهِدٌ يُخْبِرُ عَنِ الضَّميرِ، وَحاكِمٌ يَفْصِلْ بَينَ الخِطابِ، وَناطِقٌ يَرُدُّ بِهِ الجَوابَ، وَشافِعٌ يُدْرِكُ بِهِ الحاجَةَ، وَواصِفٌ يَعْرِفُ بِهِ الأشياءَ، وَأَمِيرٌ يأمُرُ بِالحَسَنِ، وَوَاعِظٌ يَنهى عَنِ القَبِيحِ، وَمُعَزٍّ تَسْكُنُ بِهِ الأحزانُ، وَحاضِرٌ (حامِدٌ) تُجْلى بِهِ الضَّغائِنُ، وَمُونِقٌ تَلَذُّ بِهِ الأَسماعُ» ([23]).
ولحسن الختام، نعرج على كتاب: «المحجّة البيضاء» في «تهذيب الأحياء».
ففي بداية الكلام، وتحت عنوان: «كتاب آفات اللّسان»، يقول: (فإنّ اللّسان من نعم الله العظيمة، ومن لطائف صُنعه الغريبة، فإنّه صغيرٌ جرمه، عظيمٌ طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان، إلّا بشهادة اللّسان، وهما غاية الطّاعة والطغّيان، ثمّ إنّه ما من موجودٍ أو معدومٍ، خالق أو مخلوق، متخيّل أو معلوم، مظنون أو موهوم إلّا واللّسان يتناوله، ويتعرّض له بإثباتٍ أو نفي، فإنّ كلّ ما يتناوله العلم، يُعرب عنه اللّسان، إمّا بحقّ أو باطلٍ، ولا شيء إلّا والعلم متناول له، وهذه خاصيّة لا توجد في سائر الأعضاء، فإنّ العين لا تصل إلى غير الألوان والصّور، والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذا سائر الأعضاء، واللّسان رَحب الميدان، ليس له مردّ ولا لمجاله مُنتهى ولا حدّ، فله في الخير مجال رَحب، وله في الشرّ مجرى سحب، فمن أطلق عذبة اللّسان وأهمله مرخى العِنان، سَلك به الشّيطان في كلّ ميدان، وساقه إلى شفا جرفٍ هار). ([24])
علاقة اللّسان بالفكر والأخلاق:
لا شك أنّ اللّسان هو نافذة الرّوح، وهو يعني أنّ شخصيّة الإنسان مخبوءةٌ تحت لِسانِه، وبالعكس فإنّ كلمات كلّ إنسانٍ لها دورٌ في بلورة وصياغة روحه ونفسيّته، فالتّأثير بين الكلام وشخصيّة المتكلم، هو تأثيرٌ مُتقابلٌ.
والآية الوحيدة التي تناولت، علاقة اللّسان بالفكر والأخلاق، هي الآية (30) من سورة محمد (صلى الله عليه وآله)، بالشّكل الذي يشخّص معها الإنسان، ما يدور في خُلد طَرفه المقابل، عن طريق حديثه وكلامه معه، ولذلك فإنّ الإنسان، سعى قديماً وحديثاً للتّركيز على هذا الأمر، لمعرفة خبايا وبواطن الرّجال عن طريق المحادثة والطّب النّفسي، فنقرأ في هذه الآية، التي نزلت لتفضح المنافقين، قوله تعالى: (وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ).
وعلى حدّ تعريف الرّاغب، في: «مفردات القرآن»، أنّ معنى «اللّحن»، هو الخطأ في الإعراب، أو الانحراف عن قواعد اللّغة، أو قلب الكلام من الصّراحة إلى الكناية، والإشارات، «ولحن القول» المقصود في الآية، هو المعنى الأخير، وهي الكنايات والتّعبيرات ذات المعاني المتعدّدة، والحمالة لوجوهٍ.
ففي حديثٍ عن أبي سعيد الخدُري قال: (لَحْنُ القَولِ بُغْضُهُم عَلي بنَ أَبي طالبٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ المُنافِقِينَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بِبُغْضِهِم عَلي بنَ أَبي طالِبٍ) ([25]).
ولم تنسَ الروايات حظها في هذا المجال، فقد وَرد:
1 ـ «ما أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيئَاً إلّا ظَهَرَ فِي فَلَتاتِ لِسانِهِ وَصَفَحاتِ وَجِهِهِ» ([26]).
فهذا الحديث يمكن أن يكون أساس الطبّ والعلوم النّفسية، والحقيقة أنّ اللّسان هو مرآة الرّوح.
2 ـ وعنه (عليه السلام) أيضاً: «الإِنسانُ لُبُّهُ لِسانُهُ» ([27]).
3 ـ وعنه (عليه السلام) أيضاً: «قُلْتُ أَربَعاً، أَنْزَلَ اللهُ تَصدِيقي بِها في كِتابِهِ، قُلْتُ المَرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ فإذا تَكَلَّمَ ظَهَرَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْنِ القَولِ) ([28])، قُلْتُ فَمَنْ جَهِلَ شَيئَاً عاداهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ؛ (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) ([29])، وَقُلْتُ قِيمَةُ كُلُّ امرِءٍ ما يُحْسِنُ، فَأَنْزَلَ اللهُ، فِي قِصَّةِ طالُوتَ (إِنَّ اللهَ اصطفَاهُ عَلَيكُم وَزَادهُ بَسْطَةً في العِلْمِ والجِسمِ) ([30])، وَقُلْتُ القَتلُ يُقِلُّ القَتلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ، وَلَكُم فِي القِصاصِ حياةٌ يا اولِي الأَلبابِ) ([31])» ([32]).
4 ـ وفي حديثٍ آخرٍ عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «يُسْتَدَلُّ عَلى عَقْلِ كُلِّ امرِءٍ بِما يَجرِي عَلَى لِسانِهِ» ([33]).
وقال (عليه السلام) أيضاً: «إِياكَ والكَلامَ في ما لا تَعْرِفُ طَرِيقَتَهُ وَلا تَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ فَأنَّ قَولَكَ يَدُلُّ عَلى عَقْلِكَ وَعِبادَتِكَ تُنْبَؤُ عَنْ مَعْرِفَتِكَ» ([34]).
والحقيقة أنّ اللّسان له دور حيوي وفعّال، في حياة الإنسان وبناء شخصيته، وهو أمرٌ لا يخفى على أحدٍ، وله أصداءٌ واسعةٌ في الرّوايات الإسلاميّة، وما ورد آنفاً ليس إلّا نَزَرٌ قليلٌ من ذاك الكمّ الكثير.
وبالطّبع فإنّ النّعم الإلهيّة العظيمة، هي رأسمالٌ عظيمٌ لبناء الذّات في طريق التّكامل المعنوي، وكلّما ازدادت النعم الإلهيّة، وتوسّعت، ازداد الأمر خطورةً، للحفاظ عليه من الآفات والأخطار في دائرة التّحديات الصعبة، التي تحاول القضاء على شخصيّة الإنسان.
والمعروف: «أنّه إلى جانبِ كلِّ جبلٍ عظيمٍ وادٍ سحيقٍ»، ففي جانب كلّ نعمةٍ وموهبةٍ، هناك خطرٌ محدقٌ، فالطّاقة الذريّة مثلاً إذا استعملت في الأغراض السلميّة، والإعمار، فستبني وتُعمّر دنيا الإنسان، وإذا ما استعملت في الشر فستفني العالم في دقائق معدودة.
ومنها نفتح باب الحديث، على آفات اللّسان.
آفات اللّسان:
كما أشرنا أنّ فوائد اللّسان وبركاته البنّاءة عديدةٌ، وكذلك آثاره السلبيّة، وما يترتب عليه من ذنوبٍ وآثامٍ، ونتائجٍ مخرّبةٍ على مستوى الفرد والمجتمع، وقد ذكر العلّامة المرحوم الفيض الكاشاني (رحمه الله)، في كتابه: «المحجّة البيضاء»، والغزالي في كتابه: «إحياء العلوم»، بحوثاً مطوّلة، فذكر الغزالي عشرين نوعاً من أنواع الانحرافات والأخطار للّسان:
1 ـ الكلام في ما لا يعني الإنسان، «وليس له أثر مادّي ولا معنوي في حياة الإنسان».
2 ـ الثّرثرة والكلام اللّغو.
3 ـ الجدال والمراء.
4 ـ الخصومة والنّزاع واللّجاج في الكلام.
5 ـ التّكلم حول المنكرات، مثل الشّراب والقمار وما شابهه.
6 ـ التكلّف في الكلام، والتّصنع في السّجع والقافية.
7 ـ البَذاءة
8 ـ اللّعن لغير مستحقّيه.
9 ـ الغِناء.
10 ـ المِزاح الرّكيك.
11 ـ السّخرية والاستهزاء بالآخرين.
12 ـ إفشاء أسرار الناس.
13 ـ الوعود الكاذبة.
14 ـ الكذب والأخبار الكاذبة.
15 ـ الغيّبة.
16 ـ النمَّيمة.
17 ـ النّفاق في اللّسان، «أو كما يقال ذو اللسانين».
18 ـ المدح لِغَير مُستَحقّيه.
19 ـ الكلام والتّحدث بدون تفكّر وتدبّر، حيث يُصاحبه الوقوع في الخطأ والاشتباه عادة.
20 ـ التّساؤل عن الامور المعقدّة والغّامضة، التي تخرج عن قُدرة المسؤول، هذا وإنّ الدّقة في البحث، أثبتت لنا أنّ الآفات لا تَنحصر بهذه الامور فقط، فالمرحوم الكاشاني والغزالي، ربّما لم يكن قَصدهما، إحصاء جميع عناصر الخلل والزّيغ في اللّسان، ولذلك فإنّنا نضيف إلى هذه الموارد العشرين، موارد اخرى، وهي:
1 ـ التّهمة.
2 ـ الشّهادة بالباطِل.
3 ـ مدح النّفس.
4 ـ نشر الشّائعات والأكاذيب، التي لا تعتمد على أساس، وإشاعة الفَحشاء والمُنكر، وإن كان من باب الاحتمال.
5 ـ البذاءَة والخُشونة في الكلام.
6 ـ الإصرار العَقيم: (كما أصرّ أصحاب بقرة بني إسرائيل).
7 ـ ايذاء الآخرين بالكلام الجارِح.
8 ـ المذمّة لغير مُستحقيها.
9 ـ الكُفران وعدم الشّكر باللّسان.
10 ـ الدّعاية لِلباطِل، والتّرغيب على الذَنب، والأمر بالمُنكر، والنّهي عن المعروف.
وغَنيٌّ عن البيان، أنّ ما تقدّم آنفاً لا يشكل جميع خطايا اللّسان، بل يمكن القول أنّ هذه الموارد الثّلاثين، من امهّات المِوارد في هذا الصّدد.
والجدير بالذّكر، أنّ البَعضِ أفرطوا في هذا المجال، ونسبوا إلى اللّسان ذُنوباً هو بَريءٌ منها، كَإظهار الفقر والمَسكنة والبدعة في الدّين، والتّفسير بالرّأي والجاسوسيّة ما شابَهها، فكلٌّ منها يعتبر ذنباً مُستقلًّا، فربما ارتكبت باللّسان أو بالقلم، أو بوسائل اخرى، وتصنيفها في عداد ذنوب اللّسان، ليس بالشّيء المُناسب، لأنّه على هذا الأساس، يمكن تصنيف جميع الذّنوب في قائمة ذنوب اللّسان، حيث إنّها ترتكب بنوعٍ ما، بواسطة اللّسان، أو أنّ لها علاقة به، كالرّياء والحسد والتكبر والقتل والزّنا.
والبعض أَقَدم على كلّ خطيئةٍ من خَطايا اللّسان، وقسّمها إلى أقسامٍ عديدةٍ، وجعل كلّ قسم منها، في فرع خاصٍّ وعنوانٍ مستقلٍ، مثل الجَسارة مع الأستاذ أو الوالدين، أو تلقيبّهم بألقاب نابيةٍ.
وعلى كلّ حال، علينا اتخاذ جانب الاعتدال في كلّ شيءٍ، وإن كانت هذه التّقسيمات، في الحقيقة لا تؤثّر في أصلِ البحث.
الاسس الكليّة للوقاية من أخطار اللّسان:
تبيّن ممّا سَبق، أنّ اللّسان في الوقت الذي يعدّ فيه نعمةً إلهيةً عظميةً، هو في نفس الوقت، خطرٌ جدّاً إلى درجةٍ أنّ بإمكانه، أن يكون مصدرَ الخطايا والذّنوب، وأن يَهبُط بالإنسان في خطّ الباطل، إلى أسفل السّافلين ويجره إلى الحَضيض.
ولأجله علينا التّفكير، في الاصول التي تُعيننا في تجنّب أخطاره الكبيرة، أو تقليلها إلى أقصى حد.
ونستعين في دائرة الكشف عن أخطار اللّسان، بتوجيهات أئمّتنا العظام (عليهم السلام) ورواياتهم، وكذلك نَستعين بِبَعض من كلمات علماء الأخلاق، حيث وضعوا لنا اصولاً واسساً وخطوطاً عامةً، عليها التَّعويل في حركتنا المعنويّة المتجهة نحو الله تعالى، ومنها:
1 ـ الانتباه الحَقيقي لأخطار اللّسان
للوقاية من أخطار أيّ موجودٍ خطرٍ علينا، في البِداية نَلتَزِم حالة الانتباه والتّوجه الّتام، لما يترتب عليه من أخطار، فعند ما يستيقظ الإنسان كلّ يومٍ صباحاً، عليه أن يُوصي نفسه ومعها على مستوى الحَذر، من شطَحات لسانه وأفكاره، لأنّ هذا العضو من البدن إذا تعامل معه الإنسان، من موقع الانضباط في خطّ المسؤوليّة، فسوف يصعد به إلى أوج السّعادة والكَمال، وإذا أطلق له العِنان، فسيورد صاحبه في المهالك، فهو وَحشٌ ضارَي لا همّ له إلّا التّدمير والتّخريب، وقد ورد هذا المعنى بصورةٍ جملية وتعبيراتٍ مؤثّرةٍ في رواياتنا الشّريفة، منها ما ورد عن سعيد بن جُبير، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث قال: «إذا أَصبَحَ ابن آدَمَ أَصْبَحَتْ الأَعْضاءُ كُلُّها تَشْتَكِي اللِّسانَ أَي تَقُولُ إِتَّقِ اللهَ فِينا فَإِنَّكَ إِنْ اسْتَقَمْتَ استقمنا وَإِنْ اعوججت اعوججنا» ([35]).
وجاء عن إمامنا السّجاد (عليه السلام): «إِنَّ لِسان ابن آدَمَ يُشْرِفُ عَلى جَمِيعِ جَوارِحِهِ كُلَّ صَباحُ فَيَقُولُ كَيفَ أَصْبَحْتُم؟! فَيَقُولُونَ بِخَيرٍ إِنْ تَرَكْتَنا وَيَقُولُونَ اللهَ اللهَ فِينا، وَيُناشِدُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّما نُثابُ وَنُعاقَبُ بكَ». ([36])
2 ـ السّكوت
تطرّقنا سابقاً لمباحث السّكوت، بصورةٍ وافيةٍ، ونقلنا آيات وروايات كثيرة في هذا الصّدد، فكلّما كانَ الكلام أقل، كان الزّلل كذلك، وكلّما كان السّكوت أكثر، كانتْ السّلامة تحيط بالإنسان في حركة الحياة والواقع، عِلاوةً على ذلك فإنّ التزام السّكوت في أغلب الحالات، يعوّد الإنسان السّيطرة على لسانه والحدّ من جموحه، والوصول في هذه الحالة النّفسية، إلى درجةٍ لا يقول إلّا الحقّ، ولا يتكلّم إلّا بما يُرضي الله تعالى.
ويجب الانتباه إلى أنّ المراد من السّكوت، ليس هو السكوت المطلق، فكثيرٌ من امورنا الحياتيّة لا يتحقّق إلّا بالكلام، من قبيل كثيرٍ من الطّاعاتِ والعبادات، ونشر العلوم والفَضائل، وإصلاح ذاتِ البَين، وأمثال ذلك، فالمقصود قلّة الكلام والاجتناب عن فُضوله، فقد قال الإمام علي (عليه السلام): «مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَياؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَياؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعَهُ ماتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّارَ» ([37]).
ونقل هذا التّعبير، بصورةٍ اخرى عن الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ([38]).
وفي حديثٍ آخر عن الإمام علي (عليه السلام)، أنّه قال: «الكَلامُ كَالدَّواءِ قَلِيلُهُ يَنْفَعُ وَكَثِيرهُ قاتِلٌ» ([39]).
3 ـ حِفظ اللّسان: «التفكّر أولاً ثّم الكَلام»
إذا فكّر الإنسان في مضمون كلامه، ودوافعه ونتائجه، فسيكون بإمكانه أن يَتجنّب كثيراً من الشّطحات، والذّنوب التي تنطلق من موقع الغفلة، نعم فإنّ إطلاق العِنان لِلّسان من موقع اللّامبالاة والاستهانة، بإمكانه أن يوقعه في أنواع الذّنوب والمَهالك في حركةِ الحياة.
وَوَرد في حديثٍ عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله)، أنّه قال: «إِنَّ لِسانَ المُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ، فَإِذا أَرادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشيءٍ تَدَبِّرَهُ بِقَلْبِهِ، ثُمَّ أَمضاهُ بِلِسانِهِ وإنَّ لِسانَ المُنافِقِ أَمامَ قَلْبِهِ، فَإِذا هَمَّ بِشيءٍ أَمضاهُ بِلِسانِهِ وَلَم يَتَدَبَّرْهُ بِقَلْبِهِ» ([40]).
وَوَرد نفسُ هذا المعنى، مع بعض الاختلاف في كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام)، في الخُطبة (176) من نهج البلاغة.
ونقرأ في تعبيرٍ آخر ورد عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، أنّه قال: «قَلْبُ الأَحْمَقِ في فَمِهِ، وَفَمُ الحَكِيمِ فِي قَلْبِهِ» ([41]).
فَمن البَديهي، أنّ المراد من القلب هُنا هو العقل والفكر، وَوُجود اللّسان في موقع الأمام أو الخلف، هو كنايةٌ عن التدبّر والتفكّر في محتوى الكلمات والألفاظ، قبل النّطق بها، وبالفِعل كم يكون جميلاً، لو أنّنا حسبنا لكلامنا حسابه، وفكّرنا في كلّ كلمةٍ نريد أن نقولها، والدّوافع والنّتائج التي ستعقبها، وهل أنّها من اللّغو أو ممّا يفضي إلى إيذاء مؤمنٍ، أو إلى تأييد ظالم وأمثال ذلك، أو أنّها تنطلق من موقع الدّوافع الإلهيّة، ولغرض حماية المظلوم، وفي طريقٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكسب مَرضاة الله تعالى؟!.
ونَختم هذا الكلام، بحديثٍ جامعٍ لجميع الموارد المذكورة آنفاً، يمنح قلب الإنسان نوراً وصفاءً، وقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: «إِنْ أَحبَبتَ سَلامَةَ نَفْسِكَ وَسَترَ مَعايبِكَ، فأقلل كَلامَكَ وَأَكْثِر صَمْتَكَ، يَتَوفَّرْ فِكْرُكَ وَيَستَنِرُ قَلْبُكَ». ([42])
هذه هي خلاصة دور اللّسان في تهذيب النّفس، وطهارة الأخلاق والاصول الكلّية لحفظ اللّسان، وبالطّبع سوف نقدم شرحاً وافياً، لتفاصيل أهمّ الانحرافات والذّنوب اللّسانيّة، كالغيبة والتّهمة والكَذب والَنميمة ونشر الأكاذيب وإشاعة الفحشاء، وذلك في المجلّد الثاني من الكتاب، إن شاء الله تعالى، بعد الإنتهاء من بيان الاصول الكلّية لِلقيم الأخلاقيّة.
[1] سورة مريم ، الآية 23 إلى 26.
[2] وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 390 ، باب تحريم صوم الصّمت.
[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق.
[5] نور الثّقلين ، ج 3 ، ص 332.
[6] بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 312.
[7] المصدر السابق ، ص 300.
[8] ميزان الحكمة ، ج 2 ، ص 1667 ، الرقم 10825.
[9] المصدر السابق ، مادة الصّمت ، ح 10805.
[10] اصول الكافى ج 2 ص 114 (باب الصمت وحفظ اللسان ح 11).
[11] المصدر السابق ص 113.
[12] اصول الكافى ج 2 ص 113.
[13] غرر الحكم الرقم 1827.
[14] المصدر السابق الرقم 3714.
[15] ميزان الحِكمة ، مادّة صمت ، ح 10826.
[16] بحار الانوار ، ج 68 ، ص 274.
[17] نهج البلاغة ، الكلمة 392 ، من قصار كلماته عليهالسلام.
[18] بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 287 ، المحجّة البيضاء ، ج 5 ، ص 193.
[19] مجمع البيان ، ج 10 ، ص 494 ، ذيل الآية المبحوثة ، نور الثقلين ، ج 5 ، ص 518.
[20] غُرر الحِكم ، الرقم (9644).
[21] بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 141 ، ح 24.
[22] المصدر السّابق ، ج 75 ، ص 80 ، ح 64.
[23] الكافي ، ج 8 ، ص 20 ، ح 4.
[24] المحجّة البيضاء ، ج 5 ، ص 190.
[25] مجمع البيان ، ج 6 ، ص 106 ، ونقل كثير من أهل الحديث هذه القصة ، كأحمد بن حنبل في الفضائل ، وابن عبد البر في «الاستيعاب» والذهبي في «تاريخ أوّل الإسلام» وابن الأثير في «جامع الاصول» ، وغيرها.
[26] نهج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة 26.
[27] بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 56.
[28] سورة محمد ، الآية 30.
[29] سورة يونس ، الآية 39.
[30] سورة البقرة ، الآية 247.
[31] سورة البقرة ، الآية 179.
[32] بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 283.
[33] غرر الحكم.
[34] غرر الحكم.
[35] المحجّة البيضاء ، ج 5 ، ص 193.
[36] الكافي ، ج 2 ، ص 15 ، ح 13.
[37] نهج البلاغة ، الكلمات القِصار ، الكلمة 349.
[38] المحجّة البيضاء ، ج 5 ، ص 196.
[39] غُرر الحِكم ، الرقم 2182.
[40] المحجّة البيضاء ، ج 5 ، ص 195.
[41] بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 374.
[42] غُرر الحكم ، ص 216 ، ص 4252.



|
|
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقيم ندوة علمية عن روايات كتاب نهج البلاغة
|
|
|