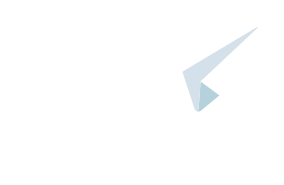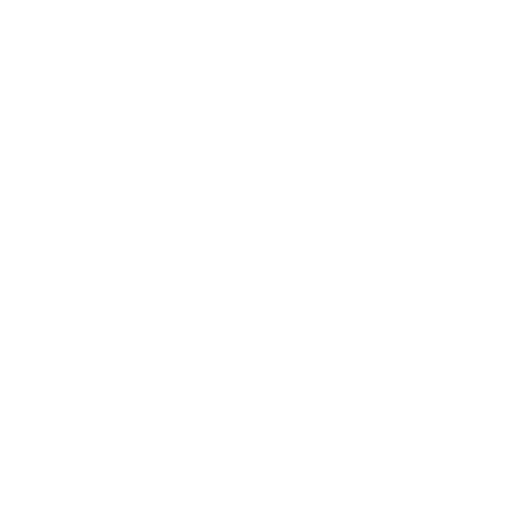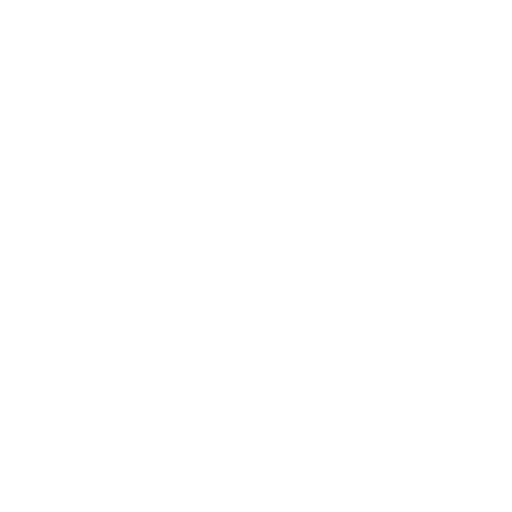تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الحكمة في وجود المتشابِه في القرآن الكريم
المؤلف:
محمد باقر الحكيم
المصدر:
علوم القرآن
الجزء والصفحة:
ص 182-190 .
11-10-2014
2900
لقد تعرّض الباحثون في علوم القرآن لهذا البحث ، وذكروا لإثارته سببين :
الأوّل :
إنّ القرآن الكريم كتاب هدايةٍ ونور مُبين ، ووجود المُتشابِه فيه لا يتّفق مع هذه الحقيقة؛ لأنّ المُتشابِه لا يعلمه إلاّ الله والراسخون في العلم.
الثاني :
ما أشار إليه الفخر الرّازي ونَسَبه إلى الملاحدة : إنّ وجود المتشابِه في القرآن كان سبباً لاختلاف المذاهب والآراء ، وتمسّك كلّ واحدٍ منها بشيءٍ من القرآن بالشكل الذي ينسجم مع متبنّياته ؛ وهذا يناقض الأهداف التي جاء من أجلها القرآن الكريم.
ولذا عمل الباحثون في علوم القرآن على استكشاف وجوه الحكمة في وجود المتشابِهات في القرآن ، وعلى هذا الأساس ذكرت وجوه متعدّدة ومختلفة تتأرجح
بين الضعف وغاية القوّة والمتانة (1) .
وسوف نُشير في بحثنا إلى بعضها ، مع مناقشة ما يستحق النقد منها.
الأوّل :
ما ذكره الشيخ محمّد عبده :
إنّ الله سبحانه أنزل التشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق به ، فإنّه لو كان كلُّ ما ورد في الكتاب واضحاً لا شبهة فيه عند أحدٍ من الأذكياء ولا من البلداء ، لما كان في الإيمان به شيء من معنى الخضوع لما أنزل الله تعالى ، والتسليم لما جاءت به رسله (2) .
وقد ناقشه العلاّمة الطباطبائي بأنّ الخضوع هو انفعال معيّن ، وتأثّر خاص من قِبَل الضعيف في مقابل القوي ، ولا يكون ذلك من الإنسان إلاّ لمّا يدرك عظمته ، أو لشيءٍ لا يتمكّن من إدراكه لعظمته وكبره ، كقدرة الله وعظمته وسائر صفاته التي إذا واجهها العقل رجع القهقرى؛ لعجزه عن الإحاطة به ، وهذان الأمران غير واردين في المتشابِه؛ لأنّه وإن كان من الأُمور التي لا يدركها العقل ولا ينالها ، ولكنّه يغترّ باعتقاده لإدراكها وحينئذٍ قد يزيغ الإنسان فيغترّ بإدراكه لِكُنْهه ، ومن هنا جاء تمحيص القلوب بالمتشابِه ، فإذا صدّق الإنسان به واستسلم له فهو قد ثبت على الإيمان ، وإذا اغتر به وحاول معرفة تأويله فقد زاغ قلبه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حيث قال :
{...وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا...} [آل عمران : 7]
فهو شيءٌ تُمحّص به القلوب ، فمن كان في قلبه مرضٌ وزَيغ اتّبعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
ولكنّ هذا التفسير إنّما ينفع في بعض آيات المتشابِه ، التي هي من قَبيل مفاهيم عالَم الغيب : كاللّوح والعرش والقلم ، حيث يكون موقف الإنسان منها هو الإيمان المطلق بها ، وأمّا الآيات المتشابِهة التي يمكن فهمها بعد عرضها على المُحْكَم فلا بُدّ أن يكون لوجودها غرضٌ آخر وهو الهُدى المترتّب عليها.
الثاني :
ما ذكره الشيخ محمّد عبده أيضاً :
إنّ وجود المتشابِه في القرآن كان حافزاً لعقل المؤمن إلى النظر ، كي لا يضعف فيموت ، فإنّ السهل الجلي جدّاً لا عمل للعقل فيه ، والعقل أعزّ القوى الإنسانية التي يجب تربيتها ، والدين أعزّ شيءٍ على الإنسان ، فإذا لم يجد العقل مجالاً للبحث في الدين يموت عامل العقل فيه ، وإذا مات فيه لا يكون حيّاً بغيره (3) .
وقد ناقشه العلاّمة الطباطبائي :
إنّ القرآن الكريم اهتمّ بالعقل وتربيته اهتماماً بالغاً ، فأمر باستعمال العقل في الآيات (الآفاقيّة) (والأنفسيّة) إجمالاً في بعض الموارد ، كما فصّل ذلك في موارد أُخرى : كالأمر بالتدبّر في خلق السماوات ، والأرض ، والجبال ، والشجر ، والدواب ، والإنسان ، واختلاف الألسنة والألوان.
كما حثّ على التفكير والسير في الأرض والنظر في أحوال الماضين ، وحرَّض العقل والفكر ومدح العلم بأبلغ المدح ، وفي كلِّ ذلك ما يُغني عن سلوك طريقٍ آخر هو إنزال المتشابِهات الذي يكون مزلقةً للأقدام ومصرعاً للعقل (4) .
الثالث :
ما ذكره الشيخ محمّد عبده أيضاً :
إنّ الأنبياء بُعثوا إلى جميع الأصناف من عامّة الناس وخاصّتهم ، وفيهم العالم والجاهل والذكي والبليد ، وهناك من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كُنْهه ، بحيث يفهمه الجميع على السواء ، وإنّما يفهمه الخاصّة منهم عن طريق الكناية والتعريض ، ويُؤمر العامّة بتفويض الأمر فيه إلى الله تعالى عند حد المُحكم ، فيكون لكلٍّ نصيبه على قدْر استعداده (5) .
وقد ناقشه العلاّمة الطباطبائي :
بأنّ الكتاب الكريم كما يشتمل على المتشابِهات كذلك يشتمل على المُحْكَمات التي تبيّن هذه المُتشابِهات عند الرجوع إليها ، ولازم ذلك أن لا تتضمّن المتشابِهات من المعاني ما هو أزيد ممّا تكشف عن المُحْكَمات ، وعند ذلك يبقى سؤالنا :
(ما فائدة وجود المتشابِهات في الكتاب وأيّ حاجةٍ إليها مع وجود المُحْكَمات؟) على حاله.
والسبب في هذا الاشتباه الذي وقع فيه الشيخ محمّد عبده : أنّه أخذ المعاني نوعين متباينين :
الأوّل :
معانٍ يفهمها جميع المخاطبين من العامّة والخاصّة وهي مداليل المُحْكَمات.
الثاني :
معانٍ لا يدرك حقيقتها إلاّ الخاصّة ولا يتلقّاها غيرهم وهي المعارف الإلهيّة والحكم الدقيقة ، فكان من نتيجته أنّ من المتشابِهات ما لا ترجع معانيها إلى المُحْكَمات ، وقد مرّ أنّ ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالّة على أنّ القرآن يفسِّر بعضه بعضاً وغير ذلك (6) .
ويمكن أن نُلاحظ على المناقشة :
أنّه ما هو الشيء الذي يمنع من وجود هذين القسمين من المعاني؟
إذا كان المانع من ذلك هو ما يشير إليه العلاّمة الطباطبائي من أُمومة المُحْكَمات للمُتشابِهات... فقد عرفنا أنّ هذه الأُمومة لا تعني أكثر من وضع حدود خاصّة معيّنة للمُتشابِهات تمنع عن الزَّيغ فيها ، وتسقط من الحساب جميع الصور والتجسيدات غير المنسجمة مع روح القرآن.
وهذا لا يعني تحديد الصورة الحقيقية للمعنى المتشابِه ، وتعيينها في مصداق خاص؛ حتّى تختفي الفائدة منه ، فقوله تعالى : {...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ...} [الشورى : 11] محكم يُسقط من الحساب جميع التجسيدات التي (تشبه الأشياء) في مفهوم (الاستواء) على العرش في قوله تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه : 5] ولكنّه لا يُعطينا الصورة الواقعية والمصداق المجسّد لهذا (الاستواء) ، فهو معنىً لا يمكن أن نفهمه من ذلك المُحْكَم : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
وإذا عرفا دور المُحْكَم تجاه المُتشابِه أمكننا أن نتصوّر بسهولة ، أنّ بعض المعاني لا يدركها ـ على مستوى المصداق ـ إلاّ الراسخون في العلم دون العامّة ، خصوصاً المعاني التي ترتبط ببعض المعلومات الكونية الطبيعية :
كجريان الشمس : {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا... } [يس : 38].
أو تلقيح الرياح : {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ...} [الحجر : 22].
أو جعل الماء مصدراً للحياة : {...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...} [الأنبياء : 30].
فإنّ كلّ هذه المعلومات حين تنكشف لدى العلماء تكون من المعلومات التي أشار إليها القرآن الكريم ، ويعرفها الخاصّة من الناس دون غيرهم.
والعلاّمة الطباطبائي نفسه تصوّر هذا التمايز بين الناس في الإدراك للمعاني ، وإن حاول أن يصوغه بشكلٍ آخر :
(فظهر أنّ للناس ـ بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى ـ مراتب مختلفة من العمل والعلم ، ولازمه أن يكون ما يتلقّاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقّاه أهل المرتبة والدرجة الأُخرى التي فوق هذه أو تحتها؛ فقد تبيّن للقرآن معانٍ مختلفة مترتّبة) (7) .
فهو يتعقّل في المعنى القرآني التعدّد ، ولكنّه يتصوّره على أساس التعدّد في الدرجة والمرتبة للمعنى الواحد ، كما يتعقّل في الفهم الإنساني هذا التعدّد أيضاً.
وحين نتعقّل ذلك لا يبقى ما يمنع إرادة القرآن الكريم بآيةٍ معيّنة مرتّبة ، ودرجة خاصّة من معنىً معيّن دون غيرها ، وحينئذٍ لا يقدر على فهم هذه المرتبة والدرجة إلاّ ذلك القريب من الله.
الرابع :
ما ذكره العلاّمة الطباطبائي :
إنّ التربية الإسلامية سارت على منهجٍ معيّن ، يقوم على أساس فرض الواقع للإنسان ، وعلاقته بالله سبحانه ، خالق الكون ومدبّر أُموره ، وبالمعاد والجزاء.
وهذا المنهج يتلّخص في : أنّ عامّة الناس لا تكاد تتجاوز أفهامهم وعقولهم المحسوسات المادّية إلى عالم ما وراء الطبيعة ، ولا يمكن أن يُعطى إنسان ما معنىً من المعاني ، إلاّ عن طريق تصوّراته ومعلوماته الذهنية التي حصلت له خلال حياته المادّية والعقلية ، والناس في هذه التصوّرات والمعلومات على مراتب ودرجات ، تختلف باختلاف الممارسة المادّية والعقلية.
والهداية القرآنية ليست مختصّةً بجماعةٍ دون أُخرى ، وإنّما هي هبة الله سبحانه للناس كافّة.
وهذا الاختلاف في الفهم وعموم الهداية القرآنية ، يفرضان أن يسوق القرآن الكريم بياناته مساق الأمثال ، بأن يستثمر ما يعرفه الإنسان ويعهده في ذهنه من المعاني والصور ، ليبيّن ما لا يعرفه من هذه المعاني والصور.
وقد يكون ذلك في القرآن الكريم ، مع عدم وجود التوافق الكلّي بين المعنى الذي يعرفه الإنسان مسبقاً والمعنى الجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعريف الإنسان عليه؛ وإنّما يلحظ القرآن جانباً معيّناً من الانسجام والتوافق ، كما نفعل ذلك في حياتنا العملية ، حين نستثمر الأوزان والمكاييل للتعريف بالمواد الغذائية وغيرها ، مع عدم وجود التوافق بينها وبين المواد الغذائية ، في شكلٍ أو صورةٍ أو حَجْم.
وحين نستعمل الصورة المادّية المحسوسة ـ التي عرفها الإنسان في حياته ـ كأمثال للمعارف الإلهيّة المجرّدة يقع الفهم الإنساني في إدراكه لهذه المعارف الممثّلة بين أمرين ، قد يستلزم كلٌ منهما محذوراً :
الأوّل :
الجمود بهذه المعارف في مرتبة الحسّ المادّي ، وحينئذٍ تنقلب عن واقعها المجرّد الذي استهدفته الهداية القرآنية.
الثاني :
الانعتاق من الإطار المادّي للمثال ، والقيام بعملية تجريد للخصوصيات غير الداخلة في التمثيل ، وهذا يستلزم ـ أحياناً ـ الزيادة والنقيصة في هذه العملية أو الشدِّة والضعف.
ولذا نجد القرآن يلجأ إلى عمليّةٍ واسعةٍ في التمثيل ، تفادياً لهذه المشاكل العقلية والنفسية ، وذلك بتوزيع المعاني التي يريد من الإنسان إدراكها ، وتربيته على تصوّرها إلى أمثال مختلفة ، وجعلها في قوالب متنوّعة ، حتّى يُفسِّر بعضها بعضاً ، ويوضّح بعضها أمر بعض ، لينتهي الأمر إلى تصفيةٍ عامّة تؤدّي إلى النتيجتين التاليتين :
الأولى :
إنّ البيانات القرآنية ليست إلاّ أمثالاً ، لها في ما ورائها حقائق ممثّلة ، وليس الهدف والمقصود منها مرتبطاً باللّفظ المأخوذ من الحسِّ والمحسوسات ، فنتخلّص بذلك من محذور الجمود.
الثانية :
بعد الالتفات إلى أنّ البيانات القرآنية أمثال ، نعلم حدود المعنى الإلهي المقصود من وراء هذه البيانات ، حين نجمع بين هذه الأمثال المتعدّدة وننفي بكلّ
واحدٍ منها خصوصيّة من الخصوصيّات المأخوذة من عالم الحس ، الموجودة في المثال الآخر ، فنطرح ما يجب طرحه من الخصوصيّات المحيطة بالكلام ، ونحتفظ بما يجب الاحتفاظ به منها (8) .
ولا شكّ أنّ هذا الوجه من أروع ما قيل في تفسير ظاهرة وجود المُتشابِه ، ويمكن أن يُعتبر تعليلاً وجيهاً لورود الكثير من الآيات المُتشابِهة ، ولكنّنا لا نقبله تعليلاً شاملاً لكلِّ ما ورد في القرآن من المُتشابِهات ، حيث نرى أنّ بعضها لا يمكن تحديد مصداقه بشكلٍ قاطع ، بناءً على مذهبنا في حقيقة المتشابِه الذي عرفنا فيه : أنّ المفهوم اللُّغوي له مفهومٌ صحيح ، وليس باطلاً لينتفي الريب بواسطة الأمثلة الأُخرى القرآنية.
وفي نهاية المطاف يجدر بنا أنْ نذكر خلاصة الوجه الصحيح في حكمة ورود المُتشابِه في القرآن ، وبهذا الصدد يحسن بنا أن نقسِّم المُتشابِه إلى قسمين رئيسين :
الأوّل :
المُتشابِه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلاّ الله.
الثاني :
المُتشابِه الذي لا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم ، ولو كان ذلك بتعليم الله تعالى لهم.
أمّا ورود القِسم الأوّل في القرآن؛ فلأنّ من الأهداف الرئيسة التي جاء من أجلها القرآن الكريم هو : ربط الإنسان الذي يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الأعلى ، وهو الله سبحانه ، وبالمعاد وهو الدار الآخرة وعوالمها؛ وهذا الربط لا يمكن أن يتحقّق إلاّ عن طريق إثارة الموضوعات التي تتعلّق بعالم الغيب وما يتّصل به من أفكار ومفاهيم؛ لينمّي غريزة الإيمان التي فُطر الإنسان عليها ، ويشدّه إلى عالمه الذي سوف ينتهي إليه؛ فلم يكن هناك سبيل أمام القرآن الكريم يتفادى به
المُتشابِه في القرآن بعد أن كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى هذا الهدف الرئيس.
وأمّا ورود القِسم الثاني في القرآن الكريم بهذا الأُسلوب فإنّه أراد أن يطرح أمام العقل البشري قضايا جديدة ، كبعض المسائل الكونيّة أو الإنسانية وغيرها من المفاهيم الغيبيّة؛ لينطلق في تدبّر حقيقتها واكتشاف ظلماتها المجهولة ، أو يقترب منها بالقدْر الذي تسمح له معرفته ودرجته في تلك المعرفة ، كما ذكر العلاّمة الطباطبائي.
ونحن في هذا العصر حين نعيش التطوّر المدني العظيم في المجالات العلمية المختلفة ، نُدرك قيمة بعض الآيات القرآنية التي ألمحت إلى بعض الحقائق العلميّة ، ووضعتها تحت تصرّف الإنسان؛ لينطلق منها في بحثه وتحقيقه ، وكذلك بعض المصاديق الإنسانية (9) .
وبذا يمكن أن نقدّم تفسيراً لحكمة ورود المُتشابِه في القرآن الكريم.
__________________________
(1) راجع بهذا الصدد الفخر الرّازي ، التفسير الكبير 7 : 184 ـ 185 ، والسيوطي ، الإتقان 2 : 12ـ 13 ، والزرقاني ، مناهل العرفان 2 : 178 ـ 181.
(2) رشيد رضا ، تفسير المنار 3 : 170.
(3) رشيد رضا ، تفسير المنار 3 : 170.
(4) الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 3 : 58.
(5) رشيد رضا ، تفسر المنار 3 : 170 ـ 171.
(6) الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 3 : 58.
(7) الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 3 : 67.
(8) العلامة الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن 3 : 58 ـ 65. وقد لخصنا كلامه ، وتركنا بيان الأمثلة والإيضاحات الفكرية التي أوردها لتأييد مدعياته.
(9) سيأتي بعض التوضيح لهذه الأفكار عند تناولنا (التفسير عند أهل البيت) وكذلك في كتابنا) الهدف من نزول القرآن الكريم) في معالجتنا لظاهرة المحكم والمتشابه.
 الاكثر قراءة في المحكم والمتشابه
الاكثر قراءة في المحكم والمتشابه
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












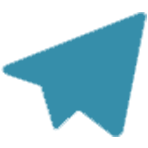
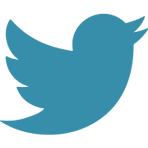

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)