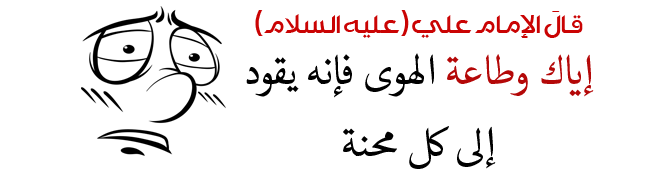
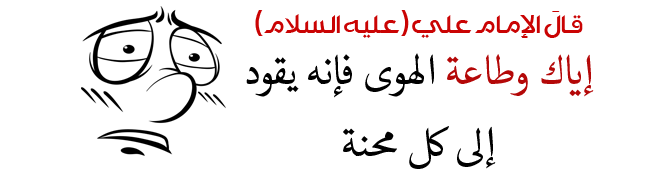

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-7-2020
التاريخ: 18-7-2020
التاريخ: 18-7-2020
التاريخ: 16-7-2020
|
قال تعالى:{ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحْمِلُ كلُّ أُنثى ومَا تَغِيض الأَرْحَامُ ومَا تَزْدَادُ وكلُّ شىْء عِندَهُ بِمِقْدَار(8) عَلِمُ الْغَيْبِ والشهَدَةِ الْكبِيرُ الْمُتَعَالِ(9) سوَاءٌ مِّنكم مَّنْ أَسرَّ الْقَوْلَ ومَن جَهَرَ بِهِ ومَنْ هُومُستَخْفِ بِالَّيْلِ وسارِب بِالنهَارِ(10) لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّن بَينِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ يحْفَظونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيرُ مَا بِقَوْم حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْم سوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ومَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال} [الرعد: 8-11]
{ الله يعلم ما تحمل كل أنثى } أي: يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أوأنثى تام أوغير تام ويعلم لونه وصفاته { وما تغيض الأرحام } أي: يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر { وما تزداد } على ذلك عن أكثر المفسرين وقال الضحاك: الغيض النقصان من الأجل والزيادة: ما يزداد على الأجل وذلك أن النساء لا يلدن لأجل واحد وقيل يعني بقوله { ما تغيض الأرحام } الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من ستة أشهر وما تزداد الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدة الحمل عن الحسن وقيل: معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض وهوانقطاع الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع عن ابن عباس بخلاف وابن زيد { وكل شيء } أي: وكل شيء من الرزق أوالأجل أوما سبق ذكره من الحمل { عنده بمقدار } أي: بقدر واحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه على ما توجبه الحكمة { عالم الغيب والشهادة } أي: عالم بما غاب عن حس العباد وبما يشاهده العباد لا يغيب عنه شيء وقيل: عالم بالمعدوم والموجود والغيب هوالمعدوم وقيل: عالم السر والعلانية عن الحسن والأولى أن يحمل على العموم ويدخل في هاتين الكلمتين كل معلوم نبه سبحانه بذلك على أنه عالم بجميع المعلومات الموجودات منها والمعدومات منها { الكبير } وهو السيد الملك القادر على جميع الأشياء وقيل: هوالذي كل شيء دونه لكمال صفاته ولكونه عالما لذاته قادرا لذاته حيا لذاته وقيل: هوالذي كبر عن شبه المخلوقين { المتعال } وهوالذي علا كل شيء بقدرته فلا يساويه قادر وقيل: هوالمنزة عما لا يجوز عليه في ذاته وفعله وعما يقوله المشركون { سواء منكم من أسر القول ومن جهر به } معناه: سواء عند الله وفي علمه من أسر القول في نفسه وأخفاه ومن أعلنه وأبداه ولم يضمره في نفسه.
{ ومن هو مستخف بالليل وسارت بالنهار } أي: ومن هومستتر متوار بالليل ومن هوسالك في سربه أي: في مذهبه ماض في حوائجه بالنهار معناه: أنه يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار بخلاف المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهله وقال الحسن: معناه ومن هو مستتر بالليل ومن هومستتر بالنهار وصحح الزجاج هذا القول لأن العرب تقول: انسرب الوحش إذا دخل في كناسة { له معقبات } اختلف في الضمير الذي في {له} على وجوه أحدها: أنه يعود إلى {من} في قوله { من أسر القول ومن جهر به } والآخر :أنه يعود إلى اسم الله تعالى وهوعالم الغيب والشهادة وثالثها : أنه يعود إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) في قوله { إنما أنت منذر } عن ابن زيد.
واختلف في المعقبات على أقوال أحدها : أنها الملائكة يتعاقبون تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار وملائكة النهار ملائكة الليل وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والجبائي وقال الحسن هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر وهومعنى قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا وقد روي ذلك عن أئمتنا (عليهم السلام) أيضا والثاني : أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيحيلون بينه وبين المقادير عن علي (عليه السلام) وابن عباس وقيل هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه والثالث: أنهم الأمراء والملوك في الدنيا الذين يمنعون الناس عن المظالم وتكون لهم الأحراس والشرط والمواكب يحفظونه عن عكرمة والضحاك وروي أيضا عن ابن عباس وتقديره ومن هوسارب بالنهار له إحراس وأعوان قدر أنهم يحرسونه ولم يتجه إحراسه من الله.
{ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله } أي: يطوفون به كما يطوف الموكل بالحفظة وقيل: يحفظون ما تقدم من عمله وما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه عن الحسن وقيل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطب ومن الجن والإنس والهوام وقال ابن عباس: يحفظونه مما لم يقدر نزوله فإذا جاء المقدر بطل الحفظ وقيل: من أمر الله أي بأمر الله عن الحسن ومجاهد والجبائي وروي ذلك عن ابن عباس وهذا كما يقال هذا الأمر بتدبير فلان ومن تدبير فلان وقيل: معناه يحفظونه عن خلق الله فتكون من بمعنى عن كما في قوله {وآمنهم من خوف} أي: عن خوف قال كعب : لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفنكم الجن { إن الله لا يغير ما بقوم } من النعمة والحال الجميلة { حتى يغيروا ما بأنفسهم } من الطاعة فيعصون ربهم ويظلم بعضهم بعضا قال ابن عباس: إذا أنعم الله على قوم فشكروها زادهم وإذا كفروها سلبهم إياها وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: إذا أقبلت عليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر { وإذا أراد الله بقوم سوء } أي: عذابا وإنما سماه سوءا لأنه يسوء { فلا مرد له } أي: لا مدفع له .وقيل: معناه إذا أراد الله بقوم بلاء من مرض وسقم فلا مرد لبلائه { وما لهم من دونه من وال } يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم .
___________________
1- تفسير مجمع البيان ،الطبرسي،ج6،ص17-19.
{ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وما تَغِيضُ الأَرْحامُ وما تَزْدادُ } . ذكر سبحانه في الآية السابقة ان المشركين طلبوا من محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) المزيد من المعجزات الدالة على نبوته ، وفي هذه الآية قال : انه تعالى يعلم ما في أرحام النساء ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو أكثر ، ناقصا أو تاما ، ومن يعلم هذا يعلم أن طلب المزيد من المعجزات انما هو لأجل العناد والمكابرة لا بقصد الاسترشاد وطلب الهداية . .
وفي نهج البلاغة : ان اللَّه يعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى ، وقبيح أو جميل ، وشقي أو سعيد .
واتفق المسلمون جميعا ان اللَّه تعالى يعلم جميع المخلوقات كبيرها وصغيرها ،
لأن كل مخلوق فهو معلوم لدى خالقه . وبتعبير محيي الدين بن العربي : ان ما من موجود في العالم الا وله وجه خاص إلى موجده . . ثم اختلف الفلاسفة وعلماء الكلام في أن اللَّه يعلم الجزئيات كأفراد الحيوان والنبات والجماد علما مباشرا ومن غير توسط ، أو يعلمها بتوسط أسبابها وما تتولد منه ؟ . قال المتكلمون بالأول ، وذهب الفلاسفة إلى الثاني .
ونحن لا نرى أية جدوى في هذا الخلاف ، لأن على المسلم أن يؤمن بأن علم اللَّه شامل لكل شيء كليا كان أو جزئيا ، حتى خفقة القلب واللمحة في الذهن ، أما الايمان بأن علمه تعالى على هذا النحو دون ذاك فليس من الدين في شيء . .
وهناك أحاديث تنهى عن التفكر في ذات اللَّه ، وتأمر بالتفكر في خلقه وصنعه .
{ وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ } فلا يخلقه عبثا ومن غير أصول ، بل لكل شيء حده ونظامه في الكم من حيث أجزاؤه ومقوماته وخواصه وآثاره ، وفي الكيف من حيث شكله وصورته ومكانه وزمانه ، وأسبابه وسننه - كل ذلك على ما تستدعيه الحكمة والمصلحة . . وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يرى ويراقب ، ويعادل ويقيس ، وقد يخطئ أو يصيب ، لأن علم الإنسان مكتسب يفتقر إلى سبب ، وكثيرا ما يظن أن هذا الشيء سبب للعلم بكذا ، وهو في واقعه جهل محض ، أما علمه تعالى فهو ذاتي وعين الواقع .
{ عالِمُ الْغَيْبِ والشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ } . ليس المراد بالكبر الضخامة ، وبالعلو المكان المحسوس ، بل هما كناية عن عظمة اللَّه في ذاته وصفاته ، وعالم الغيب ما غاب عنا علمه ، وعالم الشهادة ما نراه ونشاهده . . ان الكون مليء بالمخلوقات من شتى الأجناس والأصناف العلوية والسفلية ، فمن الجراثيم إلى الإنسان والملائكة ، ومن المعادن إلى النبات والحيوان ، إلى الماء والهواء ، وما فيهما ، إلى ما لا نهاية ، وقد يعلم الإنسان طرفا من أشياء الكون ، ولكن علمه مهما بلغ لا يعد شيئا إلى جانب ما غاب عنه ، فأكثر الحقائق وضوحا تبطن الكثير من الأسرار ، ولا يعلم كلّ ما في الكون الا خالق الكون ، فهو وحده الذي يتساوى لديه السر والعلن ، والغائب والشاهد وما أوتيتم من العلم الا قليلا .
{ سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ومَنْ جَهَرَ بِهِ ومَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وسارِبٌ بِالنَّهارِ } . مر نظيره في الآية 78 من التوبة ، والآية 3 من الأنعام ج 3 ص 159 .
{ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } . ضمير له ويديه وخلفه يعود إلى الإنسان ، كما هو الظاهر من سياق الكلام ، ومعقبات كناية عن حواس الإنسان وغرائزه التي لها تأثيرها في صيانته وحفظ كيانه ، و { من } في قوله تعالى : « مِنْ أَمْرِ اللَّهِ » بمعنى الباء مثلها في قوله تعالى : يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ - 45 الشورى » . أي بطرف خفي ، وفي ذلك رواية عن الإمام أبي جعفر الصادق ( عليه السلام ) . وقال المفسرون : المراد بالمعقبات الملائكة ، وفي بعض التفاسير ان اللَّه يرسل عشرة من الملائكة بالنهار يحرسون الإنسان ، وعند الغروب يذهب هؤلاء ، ويأتي عشرة آخرون يحرسون بالليل ، وهكذا يفعل مع كل فرد من أفراد الإنسان في كل يوم من الأيام ، اما إبليس فيقوم بدور الغواية وتضليل الإنسان بالنهار ، وأولاده بالليل .
وبالإضافة إلى أن هذا بعيد عن دلالة اللفظ فإن الافهام والأذواق ترفضه وتأباه والذي نتصوره نحن ان المراد بالمعقبات حواس الإنسان وغرائزه التي بها يحفظ وجوده وكيانه ، كما أشرنا ، وان المعنى ان اللَّه سبحانه خلق الإنسان ، وجعل فيه السمع والبصر والإدراك وغيرها من الصفات والغرائز لتحرسه وتصونه ، وهذا المعنى وان كان بعيدا عن دلالة اللفظ فإنه يتفق مع الواقع ، ولا ينفيه السياق ، فبالإدراك يميز الإنسان بين النافع والضار ، وبالبصر يعرف طريق السلامة ، وبحب الذات يتحفظ من المهلكات .
لا يغير حتى يغيروا :
{ إِنَّ اللَّهً لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ } . قال المفسرون : ان هذه الآية تدل على أن القوم الذين يعيشون بنعمة المال والأمن الجاه فإن اللَّه لا يغيرها عنهم ما داموا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، فان عصوا زالت عنهم هذه النعمة .
أما نحن فنفسر الآية في ضوء تعاليم الإسلام ، وواقع الحياة ، وما يتحمله لفظ الآية من معنى . . أما تعاليم الإسلام فمن أهمها وجوب جهاد النفس إذا مالت إلى المحرمات والموبقات ، أو رضيت بالذل والفقر ، والجهاد بالنفس والمال في سبيل العدل والتحرر من الظلم والرق . . وليس من شك ان من استنكف عن الهوان ، واستهان بالحياة وأبى إلا الكرامة أو الموت شمله اللَّه بعنايته ، وأخذ بيده إلى ما يبتغيه ويهدف إليه . ومن خلد إلى الراحة والكسل مهما كانت نتائجه يخذله اللَّه ، ويكله إلى ضعفه ، ولا ينظر إليه أو يسمع له ، وان ملأ الدنيا تضرعا وبكاء ، وعبادة ودعاء .
وبهذا يتضح معنى قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهً لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ، » وانه جلت عظمته يبقي الإنسان في البؤس والهوان ، ما دام في جموده وركوده ، لا يقاوم باطلا ، ولا يحرك ساكنا للتخلص مما هو فيه . . أجل ، ان اللَّه لا يغير ما بنا من فقر حتى نعتقد ان الفقر من الأرض لا من السماء ، وحتى نكافح ونجاهد ضد الاستغلال والاستثمار ، وحتى نقيم المصانع ، وننشئ المزارع ، واللَّه لا يغير ما بنا من جهل حتى نبني الجامعات والمختبرات ، واللَّه لا يغير ما بنا من عبودية حتى نثور على الظالمين والمستبدين ، واللَّه لا يغير ما بنا من شتات حتى نخلص النوايا ، ونزيل ما بيننا من الحدود والحواجز .
{ وإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ } . المراد بالسوء هنا العذاب ، ومتى أراده اللَّه لإنسان أو لفئة فلا منجى مما أراد الا إليه ، وهو عادل لا يريده الا لمن يستحقه ، والوالي من صفات اللَّه لأنه يلي الأمور ويقوم عليها بالعناية والتدبير .
_________________
1- التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية،ج4، صفحه 383-386.
قوله تعالى:{ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} قال في المفردات،: غاض الشيء وغاضه غيره نحو نقص ونقصه غيره قال تعالى:{وغيض الماء}{وما تغيض الأرحام} أي تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه وليلة غائضة أي مظلمة انتهى.
وعلى هذا فالأنسب أن تكون الأمور الثلاثة المذكورة في الآية أعني قوله:{ما تحمل كل أنثى} و{ما تغيض الأرحام} و{ما تزداد} إشارة إلى ثلاثة من أعمال الأرحام في أيام الحمل فما تحمله كل أنثى هو الجنين الذي تعيه وتحفظه وما تغيضه الأرحام هو دم الحيض تنصب فيها فتصرفه الرحم في غذاء الجنين، وما تزداده هو الدم التي تدفعها إلى خارج كدم النفاس والدم أو الحمرة التي تراها أيام الحمل أحيانا وهو الذي يظهر من بعض ما روي عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وربما ينسب إلى ابن عباس.
وأكثر المفسرين على أن المراد بما تغيض الأرحام الوقت الذي تنقصه الأرحام من مدة الحمل وهي تسعة أشهر، والمراد بما تزداد ما تزيد على ذلك.
وفيه خلوة عن شاهد يشهد عليه فإن الغيض بهذا المعنى نوع من الاستعارة التي لا غنى لها عن القرينة.
ويروى عن بعضهم أن المراد بما تغيض الأرحام ما تنقص عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وهو السقط وبما تزداد ما يولد لأقصى مدة الحمل، وعن بعض آخر أن الغيض النقصان من الأجل والإزدياد الإزدياد فيه.
ويرد على الوجهين ما أوردناه على سابقهما، وقد عرفت أن الأنسب بسياق الآية النقص والزيادة فيما يقذف في الرحم من الدم.
وقوله:{وكل شيء عنده بمقدار} المقدار هو الحد الذي يحد به الشيء ويتعين ويمتاز به من غيره إذ لا ينفك الشيء الموجود عن تعين في نفسه وامتياز من غيره ولو لا ذلك لم يكن موجدا البتة.
وهذا المعنى أعني كون كل شيء مصاحبا لمقدار وقرينا لحد لا يتعداه حقيقة قرآنية تكرر ذكرها في كلامه تعالى كقوله:{ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}: الطلاق: 3، وقوله:{ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}: الحجر: 21 وغير ذلك من الآيات.
فإذا كان الشيء محدودا بحد لا يتعداه وهو مضروب عليه ذلك الحد عند الله وبأمره ولن يخرج من عنده وإحاطته ولا يغيب عن علمه شيء كما قال:{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}: الحج: 17 وقال:{ألا إنه بكل شيء محيط}: حم السجدة: 54، وقال:{ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ}: السبأ: 3 فمن المحال أن لا يعلم تعالى ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
فذيل الآية أعني قوله:{وكل شيء عنده بمقدار} تعليل لصدرها أعني قوله:{الله يعلم ما تحمل كل أنثى} إلخ والآية وما يتلوها كالتذييل للآية السابقة أن الله يعلم بكل شيء ويقدر على كل شيء ويجيب الدعوة ويخضع له كل شيء فهو أحق بالربوبية فإليه أمر الآيات لا إليك وإنما أنت منذر.
قوله تعالى:{ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} الغيب والشهادة كما سمعت مرارا معنيان إضافيان فالشيء الواحد يمكن أن يكون غيبا بالنسبة إلى شيء وشهادة بالنسبة إلى آخر وذلك أن الأشياء - كما تقدم - لا تخلو من حدود تلزمها ولا تنفك عنها فما كان من الأشياء داخلا في حد الشيء غير خارج عنه فهو شهادة بالنسبة إليه مشهود لإدراكه وما كان خارجا عن حد الشيء غير داخل فيه فهو غيب بالنسبة إليه غير مشهود لإدراكه.
ومن هنا يظهر أن الغيب لا يعلم به إلا الله سبحانه أما أنه لا يصير معلوما لشيء فلأن العلم نوع إحاطة ولا معنى لإحاطة الشيء بما هو خارج عن حد وجوده أجنبي عن إحاطته، وأما أنه تعالى يعلم الغيب فلأنه تعالى غير محدود الوجود بحد وهو بكل شيء محيط فلا يمتنع شيء عنه بحده فلا يكون غيبا بالنسبة إليه وإن فرض أنه غيب بالنسبة إلى غيره.
فيرجع معنى علمه بالغيب والشهادة بالحقيقة إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه بل الغيب والشهادة اللذان يتحققان فيما بين الأشياء بقياس بعضها إلى بعض هما معا شهادتان بالنسبة إليه تعالى، ويصير معنى قوله:{عالم الغيب والشهادة} أن الذي يمكن أن يعلم به أرباب العلم وهو الذي لا يخرج عن حد وجودهم والذي لا يمكن أن يعلموا به لكونه غيبا خارجا عن حد وجودهم هما معا معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكل شيء.
وقوله{الكبير المتعال} اسمان من أسمائه تعالى الحسنى، والكبر ويقابله الصغر من المعاني المتضائفة فإن الأجسام إذا قيس بعضها إلى بعض من حيث حجمها المتفاوت فما احتوى على مثل حجم الآخر وزيادة كان كبيرا وما لم يكن كذلك كان صغيرا ثم توسعوا فاعتبروا ذلك في غير الأجسام، والذي يناسب ساحة قدسه تعالى من معنى الكبرياء أنه تعالى يملك كل كمال لشيء ويحيط به فهو تعالى كبير أي له كمال كل ذي كمال وزيادة.
والمتعال صفة من التعالي وهو المبالغة في العلو كما يدل عليه قوله:{ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا }: الأسراء: 43 فإن قوله:{علوا كبيرا} مفعول مطلق لقوله:{تعالى} وموضوع في محل قولنا:{تعاليا} فهو سبحانه علي ومتعال أما أنه علي فلأنه علا كل شيء وتسلط عليه والعلو هو التسلط، وأما أنه متعال فلأن له غاية العلو لأن علوه كبير بالنسبة إلى كل علو فهو العالي المتسلط على كان عال من كل جهة.
ومن هنا تظهر النكتة في تعقيب قوله:{عالم الغيب والشهادة} بقوله:{الكبير المتعال} لأن مفاد مجموع الاسمين أنه سبحانه محيط بكل شيء متسلط عليه ولا يتسلط عليه ولا يغلبه شيء من جهة البتة فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة ولا يتسلط عليه ولا يغلبه غيب حتى يعزب عن علمه بغيبته كما لا يتسلط عليه شهادة فهو عالم الغيب والشهادة لأنه كبير متعال.
قوله تعالى:{ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} السرب بفتحتين والسروب الذهاب في حدور وسيلان الدمع والذهاب في مطلق الطريق يقال سرب سربا وسروبا نحو مر مرا ومرورا.
كذا في المفردات، فالسارب هو الذاهب في الطريق المعلن بنفسه.
والآية كالتفريع على الآية السابقة أي إذا كان الله سبحانه عالما بالغيب والشهادة على سواء فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به أي بالقول والله سبحانه يعلم بقولهما ويسمع حديثهما من غير أن يخفى عليه إسرار من أسر بقوله، وسواء منكم من هو مستخف بالليل يستمد بظلمة الليل وإرخاء سدولها لأن يخفى من أعين الناظرين ومن هو سارب بالنهار ذاهب في طريقه متبرز غير مخف لنفسه فالله يعلم بهما من غير أن يخفى المستخفي بالليل بمكيدته.
قوله تعالى:{ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} إلخ ظاهر السياق أن الضمائر الأربع{له}{يديه}{خلفه}{يحفظونه} مرجعها واحد ولا مرجع يصلح لها جميعا إلا ما في الآية السابقة أعني الموصول في قوله:{من أسر القول} إلخ، فهذا الإنسان الذي يعلم به الله سبحانه في جميع أحواله هو الذي له معقبات من بين يديه ومن خلفه.
وتعقيب الشيء إنما يكون بالمجيء بعده والإتيان من عقبه فتوصيف المعقبات بقوله:{من بين يديه ومن خلفه} إنما يتصور إذا كان سائرا في طريق، ثم طاف عليه المعقبات حوله وقد أخبر سبحانه عن كون الإنسان سائرا هذا السير بقوله:{ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ}: الانشقاق: 6 وفي معناه سائر الآيات الدالة على رجوعه إلى ربه كقوله:{وإليه ترجعون}: يس: 83{وإليه تقلبون}: العنكبوت: 21 فللإنسان وهو سائر إلى ربه معقبات تراقبه من بين يديه ومن خلفه.
ثم من المعلوم من مشرب القرآن أن الإنسان ليس هو هذا الهيكل الجسماني والبدن المادي فحسب بل هو موجود تركب من نفس وبدن والعمدة فيما يرجع إليه من الشئون هي نفسه فلها الشعور والإرادة وإليها يتوجه الأمر والنهي وبها يقوم الثواب والعقاب والراحة والألم والسعادة والشقاء، وعنها يصدر صالح الأعمال وطالحها، وإليها ينسب الإيمان والكفر وإن كان البدن كالآلة التي يتوسل بها في مقاصدها ومآربها.
وعلى هذا يتسع معنى ما بين يدي الإنسان وما خلفه فيعم الأمور الجسمانية والروحية جميعا فجميع الأجسام والجسمانيات التي تحيط بجسم الإنسان مدى حياته بعضها واقعة أمامه وبين يديه وبعضها واقعة خلفه، وكذلك جميع المراحل النفسانية التي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربه والحالات الروحية التي يعتورها ويتقلب فيها من قرب وبعد وغير ذلك والسعادة والشقاء والأعمال الصالحة والطالحة وما ادخر لها من الثواب والعقاب كل ذلك واقعة خلف الإنسان أو بين يديه ولهذه المعقبات التي ذكرها الله سبحانه شأن فيها بما أن لها تعلقا بالإنسان.
والإنسان الذي وصفه الله بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يقدر على حفظ شيء من نفسه ولا آثار نفسه الحاضرة عنده والغائبة عنه، وإنما يحفظها له الله سبحانه قال تعالى:{الله حفيظ عليهم}: الشورى: 6 وقال:{ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ}: السبأ: 21 وقال يذكر الوسائط في هذا الأمر{وإن عليكم لحافظين}: الانفطار: 10.
فلو لا حفظه تعالى إياها بهذه الوسائط التي سماها حافظين تارة ومعقبات أخرى لشمله الفناء من جهاتها وأسرع إليها الهلاك من بين أيديها ومن خلفها غير أنه كما أن حفظها بأمر من الله عز شأنه كذلك فناؤها وهلاكها وفسادها بأمر من الله لأن الملك لله لا يدبر أمره ولا يتصرف فيه إلا هو سبحانه فهو الذي يهدي إليه التعليم القرآني، والآيات في هذه المعاني متكاثرة لا حاجة إلى إيرادها.
والملائكة أيضا إنما يعملون ما يعملون بأمره قال تعالى:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ}: النحل: 2، وقال:{ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}: الأنبياء: 27.
ومن هنا يظهر أن هذه المعقبات الحفاظ كما يحفظون ما يحفظون بأمر الله كذلك يحفظونه من أمر الله فإن جانب الفناء والهلاك والضيعة والفساد بأمر الله كما أن جانب البقاء والاستقامة والصحة بأمر الله فلا يدوم مركب جسماني إلا بأمر الله كما لا ينحل تركيبه إلا بأمر الله، ولا تثبت حالة روحية أو عمل أو أثر عمل إلا بأمر من الله كما لا يطرقه الحبط ولا يطرأ عليه الزوال إلا بأمر من الله فالأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله.
وعلى هذا فهذه المعقبات كما يحفظونه بأمر الله كذلك يحفظونه من أمر الله، وعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله في الآية المبحوث عنها:{يحفظونه من أمر الله}.
وبما تقدم يظهر وجه اتصال قوله تعالى:{ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} وأنه في موضع التعليل لقوله:{يحفظونه من أمر الله} والمعنى أنه تعالى إنما جعل هذه المعقبات ووكلها بالإنسان يحفظونه بأمره من أمره ويمنعونه من أن يهلك أويتغير في شيء مما هو عليه لأن سنته جرت أن لا يغير ما بقوم من الأحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالات الروحية كأن يغيروا الشكر إلى الكفر والطاعة إلى المعصية والإيمان إلى الشرك فيغير الله النعمة إلى النقمة والهداية إلى الإضلال والسعادة إلى الشقاء وهكذا.
والآية أعني قوله:{إن الله لا يغير} إلخ، يدل بالجملة على أن الله قضى قضاء حتم بنوع من التلازم بين النعم الموهوبة من عنده للإنسان وبين الحالات النفسية الراجعة إلى الإنسان الجارية على استقامة الفطرة فلوجرى قوم على استقامة الفطرة وآمنوا بالله وعملوا صالحا أعقبهم نعم الدنيا والآخرة كما قال.
}ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا}: الأعراف: 96 والحال ثابتة فيهم دائمة عليهم ما داموا على حالهم في أنفسهم فإذا غيروا حالهم في أنفسهم غير الله سبحانه حالهم الخارجية بتغيير النعم نقما.
ومن الممكن أن يستفاد من الآية العموم وهو أن بين حالات الإنسان النفسية وبين الأوضاع الخارجية نوع تلازم سواء كان ذلك في جانب الخير أوالشر فلو كان القوم على الإيمان والطاعة وشكر النعمة عمهم الله بنعمه الظاهرة والباطنة ودام ذلك عليهم حتى يغيروا فيكفروا ويفسقوا فيغير الله نعمه نقما ودام ذلك عليهم حتى يغيروا فيؤمنوا ويطيعوا ويشكروا فيغير الله نقمه نعما وهكذا.
هذا. ولكن ظاهر السياق لا يساعد عليه وخاصة ما تعقبه من قوله{ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} فإنه أصدق شاهد على أنه يصف معنى تغييره تعالى ما بقوم حتى يغيروا فالتغيير لما كان إلى السيئة كان الأصل أعني{ما بقوم} لا يراد به إلا الحسنة فافهم ذلك.
على أن الله سبحانه يقول:{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}: الشورى: 30 فيذكر أنه يعفو عن كثير من السيئات فيمحو آثارها فلا ملازمة بين أعمال الإنسان وأحواله وبين الآثار الخارجية في جانب الشر بخلاف ما في جانب الخير كما قال تعالى في نظير الآية:{ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}: الأنفال: 53.
وأما قوله تعالى:{ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} فإنما دخل في الحديث لا بالقصد الأولي لكنه تعالى لما ذكر أن كل شيء عنده بمقدار وإن لكل إنسان معقبات يحفظونه بأمره من أمره ولا يدعونه يهلك أو يتغير أو يضطرب في وجوده والنعم التي أوتيها، وهم على حالهم من الله لا يغيرها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وجب أن يذكر أن هذا التغيير من السعادة إلى الشقاء ومن النعمة إلى النقمة أيضا من الأمور المحكمة المحتومة التي ليس لمانع أن يمنع من تحققها، وإنما أمره إلى الله لا حظ فيه لغيره، وبذلك يتم أن الناس لا مناص لهم من حكم الله في جانبي الخير والشر وهم مأخوذ عليهم وفي قبضته.
فالمعنى: وإذا أراد الله بقوم سوء ولا يريد ذلك إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من سمات معبودية ومقتضيات الفطرة فلا مرد لذلك السوء من شقاء أو نقمة أو نكال.
ثم قوله:{وما لهم من دونه من وال} عطف تفسيري على قوله:{ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ} ويفيد معنى التعليل له فإنه إذا لم يكن لهم من وال يلي أمرهم إلا الله سبحانه لم يكن هناك أحد يرد ما أراد الله بهم من السوء.
فقد بان من جميع ما تقدم أن معنى الآية - على ما يعطيه السياق - والله أعلم - أن لكل من الناس على أي حال كان معقبات يعقبونه في مسيره إلى الله من بين يديه ومن خلفه أي في حاضر حاله وماضيه يحفظونه بأمر الله من أن يتغير حاله بهلاك أوفساد أو شقاء بأمر آخر من الله، وهذا الأمر الآخر الذي يغير الحال إنما يؤثر أثره إذا غير قوم ما بأنفسهم فعند ذلك يغير الله ما عندهم من نعمة ويريد بهم السوء وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لأنهم لا والي لهم يلي أمرهم من دونه حتى يرد ما أراد الله بهم من سوء.
وقد تبين بذلك أمور: أحدها: أن الآية كالبيان التفصيلي لما تقدم في الآيات السابقة من قوله:{وكل شيء عنده بمقدار} فإن الجملة تفيد أن للأشياء حدودا ثابتة لا تتعداها ولا تتخلف عنها عند الله حتى تعزب عن علمه، وهذه الآية تفصل القول في الإنسان أن له معقبات من بين يديه ومن خلفه موكلة عليه يحفظونه وجميع ما يتعلق به من أن يهلك أويتغير عما هو عليه، ولا يهلك ولا يتغير إلا بأمر آخر من الله.
الثاني: أنه ما من شيء من الإنسان من نفسه وجسمه وأوصافه وأحواله وأعماله وآثاره إلا وعليه ملك موكل يحفظه، ولا يزال على ذلك في مسيره إلى الله حتى يغير فالله سبحانه هو الحافظ وله ملائكة حفظة عليها، وهذه حقيقة قرآنية.
الثالث: أن هناك أمرا آخر يرصد الناس لتغيير ما عندهم وقد ذكر الله سبحانه من شأن هذا الأمر أنه يؤثر فيما إذا غير قوم ما بأنفسهم فعند ذلك يغير الله ما بهم من نعمة بهذا الأمر الذي يرصدهم، ومن موارد تأثيره مجيء الأجل المسمى الذي لا يختلف ولا يتخلف، قال تعالى:{ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى}: الأحقاف: 3 وقال:{إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر}: نوح: 4.
الرابع: أن أمره تعالى هو المهيمن المتسلط على متون الأشياء وحواشيها على أي حال وأن كل شيء حين ثباته وحين تغيره مطيع لأمره خاضع لعظمته، وأن الأمر الإلهي وإن كان مختلفا بقياس بعضه إلى بعض منقسما إلى أمر حافظ وأمر مغير ذو نظام واحد لا يتغير وقد قال تعالى:{ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}: هود 56، وقال:{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ }: يس: 83.
الخامس: أن من القضاء المحتوم والسنة الجارية الإلهية التلازم بين الإحسان والتقوى والشكر في كل قوم وبين توارد النعم والبركات الظاهرية والباطنية ونزولها من عند الله إليهم وبقاؤها ومكثها بينهم ما لم يغيروا كما يشير إليه قوله تعالى:{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}: الأعراف: 96 وقوله:{ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}: إبراهيم: 7 وقال:{ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}: الرحمن: 60.
هذا هو الظاهر من الآية في التلازم بين شيوع الصلاح في قوم ودوام النعمة عليهم، وأما شيوع الفساد فيهم أو ظهوره من بعضهم ونزول النقمة عليهم فالآية ساكتة عن التلازم بينهما وغاية ما يفيده قوله:{لا يغير ما بقوم حتى يغيروا} جواز تغيره تعالى عند تغييرهم وإمكانه لا وجوبه وفعليته، ولذلك غير السياق فقال:{وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له} ولم يقل: فيريد الله بهم من السوء ما لا مرد له.
ويؤيد هذا المعنى قوله:{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ }: الشورى: 30 حيث يدل صريحا على أن بعض التغيير عند التغيير معفو عنه.
وأما الفرد من النوع فالكلام الإلهي يدل على التلازم بين صلاح عمله وبين النعم المعنوية وعلى التغير عند التغير دون التلازم بين صلاحه والنعم الجسمانية.
والحكمة في ذلك كله ظاهرة فإن التلازم المذكور مقتضى حكم التلاؤم والتوافق بين أجزاء النظام وسوق الأنواع إلى غاياتها فإن الله جعل للأنواع غايات وجهزها بما يسوقها إلى غاياتها ثم بسط تعالى التلاؤم والتوافق بين أجزاء هذا النظام كان المجموع شيئا واحدا لا معاندة ولا مضادة بين أجزائه فمقتضى طباعها أن يعيش كل نوع في عافية ونعمة وكرامة حتى يبلغ غايته فإذا لم ينحرف النوع الإنساني عن مقتضى فطرته الأصلية ولا منحرف من الأنواع ظاهرا غيره جرى الكون على سعادته ونعمته ولم يعدم رشدا، وأما إذا انحرف عن ذلك وشاع فيه الفساد أفسد ذلك التعادل بين أجزاء الكون وأوجب ذلك هجرة النعمة واختلال المعيشة وظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض ما عملوا لعلهم يرجعون.
وهذا المعنى كما لا يخفى إنما يتم في النوع دون الشخص ولذلك كان التلازم بين صلاح النوع والنعم العامة المفاضة عليهم ولا يجري في الأشخاص لأن الأشخاص ربما بطلت فيها الغايات بخلاف الأنواع فإن بطلان غاياتها من الكون يوجب اللعب في الخلقة قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}: الدخان: 38 وقد تقدم بعض الكلام في هذا الباب في أبحاث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب.
وبما تقدم يظهر فساد الاعتراض على الآية حيث إنها تفيد بظاهرها أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك خلاف ما قررته الشريعة من عدم جواز أخذ العامة بذنوب الخاصة هذا فإنه أجنبي عن مفاد الآية بالكلية.
هذا بعض ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة وللمفسرين في تفسيرها اختلاف شديد من جهات شتى: من ذلك اختلافهم في مرجع الضمير في قوله:{له معقبات} فمن قائل: إن الضمير راجع إلى{من} في قوله:{من أسر القول} إلخ، كما قدمناه، ومن قائل: إنه يرجع إليه تعالى أي لله ملائكة معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه.
وفيه أنه يستلزم اختلاف الضمائر.
على أنه يوجب وقوع الالتفات في قوله:{من أمر الله} من غير نكتة ظاهرة، ومن قائل: إن الضمير للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والآية تذكر أن الملائكة يحفظونه.
وفيه أنه كسابقه يستلزم اختلاف الضمائر والظاهر خلافه.
على أنه يوجب عدم اتصال الآية بسوابقها ولم يتقدم للنبي - (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر.
ومن قائل: إن الضمير عائد إلى من هو سارب بالنهار.
وهذا أسخف الوجوه وسنعود إليه.
ومن ذلك اختلافهم في معنى المعقبات فقيل: إن أصله المعتقبات صار معقبات بالنقل والإدغام يقال: اعتقبه إذا حبسه واعتقب القوم عليه أي تعاونوا ورد بأنه خطأ، وقيل: هو من باب التفعيل والتعقيب هو أن يتبع آخر في مشيته كأنه يطأ عقبه أي مؤخر قدمه فقيل: إن المعقبات ملائكة يعقبون الإنسان في مسيره إلى الله لا يفارقونه ويحفظونه كما تقدم، وقيل: المعقبات كتاب الأعمال من ملائكة الليل والنهار يعقب بعضهم بعضا فملائكة الليل تعقب ملائكة النهار وهم يعقبون ملائكة الليل يحفظون على الإنسان عمله.
وفيه: أنه خلاف ظاهر قوله:{له معقبات} على أن فيه جعل يحفظونه بمعنى يحفظون عليه.
وقيل: المراد بالمعقبات الأحراس والشرط والمواكب الذين يعقبون الملوك والأمراء والمعنى: أن لمن هو سارب بالنهار وهم الملوك والأمراء معقبات من الأحراس والشرط يحيطون بهم ويحفظونهم من أمر الله أي قضائه وقدره توهما منهم أنهم يقدرون على ذلك، وهذا الوجه على سخافته لعب بكلامه تعالى.
ومن ذلك اختلافهم في قوله:{من بين يديه ومن خلفه} فقيل: إنه متعلق بمعقبات أي يعقبونه من بين يديه ومن خلفه.
وفيه أن التعقيب لا يتحقق إلا من خلف، وقيل: متعلق بقوله:{يحفظونه} وفي الكلام تقديم وتأخير والترتيب: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله.
وفيه عدم الدليل على ذلك، وقيل: متعلق بمقدر كالوقوع والإحاطة ونحوهما أو بنحو التضمين والمعنى له معقبات يحيطون به من بين يديه ومن خلفه وقد تقدم.
ومن جهة أخرى قيل: إن المراد بما بين يديه وما خلفه ما هو من جهة المكان أي يحيطون به من قدامه وخلفه يحفظونه من المهالك والمخاطر، وقيل: المراد بهما ما تقدم من أعماله وما تأخر يحفظها عليه الملائكة الحفظ ويكتبونها ولا دليل على ما في الوجهين من التخصيص، وقيل: المراد بما بين يديه ومن خلفه ما للإنسان من الشئون الجسمية والروحية مما له في حاضر حاله وما خلفه وراءه وهو الذي قدمناه.
ومن ذلك اختلافهم في معنى قوله:{يحفظونه} فقيل هو بمعنى يحفظون عليه، وقيل: هو مطلق الحفظ، وقيل: هو الحفظ من المضار.
ومن ذلك اختلافهم في قوله:{من أمر الله} فقيل: هو متعلق بقوله:{معقبات} وإن قوله:{من بين يديه ومن خلفه} وقوله:{يحفظونه} وقوله:{من أمر الله} ثلاث صفات لمعقبات.
وفيه أنه خلاف الظاهر، وقيل: هو متعلق بقوله:{يحفظونه} و{من} بمعنى الباء للسببية أوالمصاحبة والمعنى يحفظونه بسبب أمر الله أو بمصاحبة أمر الله، وقيل: متعلق بيحفظونه و{من} للابتداء أو للنشو أي يحفظونه مبتدأ ذلك أو ناشئا ذلك من أمر الله، وقيل: هو كذلك لكن{من} بمعنى{عن} أي يحفظونه عن أمر الله أن يحل به ويغشاه وفسروا الحفظ من أمر الله بأن الأمر بمعنى البأس أي يحفظونه من بأس الله بأن يستمهلوا كلما أذنب ويسألوا الله سبحانه أن يؤخر عنه المؤاخذة والعقوبة أو إمضاء شقائه لعله يتوب ويرجع، وفساد أغلب هذه الوجوه ظاهر غني عن البيان.
ومن ذلك اختلافهم في اتصال قوله:{له معقبات من بين يديه ومن خلفه} إلخ فقيل: متصل بقوله:{سارب بالنهار} وقد تقدم معناه، وقيل: متصل بقوله:{الله يعلم ما تحمل كل أنثى} أوقوله:{عالم الغيب والشهادة} أي كما يعلمهم جعل عليهم حفظة يحفظونهم.
وقيل متصل بقوله:{إنما أنت منذر} الآية يعني أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) محفوظ بالملائكة.
والحق أنه متصل بقوله:{وكل شيء عنده بمقدار} ونوع بيان له، وقد تقدم ذكره.
ومن ذلك اختلافهم في اتصال قوله:{إن الله لا يغير ما بقوم} إلخ فقيل: إنه متصل بقوله:{ويستعجلونك بالعذاب} الآية أي أنه لا ينزل العذاب إلا على من يعلم من جهتهم بالتغيير حتى لوعلم أن فيهم من سيؤمن بالله أو من في صلبه ممن سيولد ويعيش بالإيمان لم ينزل عليهم العذاب، وقيل: متصل بقوله:{سارب بالنهار} يعني أنه إذا اقترف المعاصي فقد غير ما به من سمة العبودية وبطل حفظه ونزل عليه العذاب.
والقولان - كما ترى - بعيدان من السياق والحق أن قوله:{ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ} إلخ، تعليل لما تقدمه من قوله:{يحفظونه من أمر الله} وقد مر بيانه.
______________
1- تفسير الميزان ،الطبرسي،ج11،ص250-260.
عِلمِ الله المطلق:
نقرأ في هذه الآيات قسماً من صفات الخالق، والتي تكمل بحث التوحيد والمعاد، فالحديث عن علمه الواسع ومعرفته بكلّ شيء، هو ذاك العلم الذي يقوم عليه نظام التكوين وعجائب الخلقة وآيات التوحيد، وهو العلم الذي يكون أساساً للمعاد والعدالة الإلهيّة يوم القيامة وهذه الآيات إستندت إلى هذين القسمين: (العلم بنظام التكوين، والعلم بأعمال العباد).
تقول الآية أوّلا: { اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى} في رحمها، سواء من اُنثى الإنسان أو الحيوان {وما تغيض الأرحام} أي تنقص قبل موعدها المقرّر {وما تزداد}(2) أي يعلم بما تزيد عن موعدها المقرّر.
في تفسير هذه الجمل الثلاث هناك آراء مختلفة بين المفسّرين:
يعتقد البعض ـ أنّها تشير ـ كما ذكرنا آنفاً ـ إلى وقت الولادة، وهي على ثلاثة أنواع: فمرّة يولد المولود قبل موعده. ومرّة في موعده، وأُخرى بعد الموعد المقرّر. فالله يعلم كلّ ذلك ويعلم لحظة الولادة بالتحديد، وهذه من الأُمور التي لا يستطيع أي أحد أو جهاز أن يحدّد موعده، وهذا العلم خاص بذات الله المنزّهة، وسببه واضح لأنّ إستعدادات الأرحام والأجنّة مختلفة، ولا أحد يعلم بهذا التفاوت.
وقال بعض آخر: إنّها تشير إلى ثلاث حالات مختلفة للرحم أيّام الحمل، فالجملة الأُولى تشير إلى نفس الجنين الذي تحفظه، والجملة الثانية تشير إلى دم الحيض الذي يُنصب في الرحم ويمصّه الجنين، والجملة الثالثة إشارة إلى الدم الإضافي الذي يخرج أثناء الحمل أحياناً، أو دم النفاس أثناء الولادة(3).
وهناك عدّة إحتمالات أُخرى في تفسير هذه الآية دون أن تكون متناقضة فيما بينها، ويمكن أن يكون مراد الآية إشارةً إلى مجموع هذه التفاسير، ولكن الظاهر أنّ التّفسير الأوّل أقرب، بدليل جملة (تحمل) المقصود منها الجنين والجمل (تغيض) و (تزداد) بقرينة الجملة السابقة تشير إلى الزيادة والنقصان في فترات الحمل.
روى الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أو الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير الآية أنّ «الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كلّ شيء حمل على تسعة أشهر». وفي تكملة الحديث يقول: «كلّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد وبعدد الأيّام التي زاد فيها في حملها من الدم»(4).
{وكلّ شيء عنده بمقدار} ولكي لا يتصوّر أحد أنّ هذه الزيادة والنقصان بدون حساب ودليل، بل انّ كلّ ساعة وثانية ولحظة لا تمرّ دون حساب، كما أنّ للجنين ودم الرحم حساب وكتاب أيضاً. فالآية التي بعدها تؤكّد ما قلناه في الآية السابقة حيث تقول: {عالم الغيب والشهادة} فعلمه بالغيب والشهادة لهذا السبب {الكبير المتعال} فهو يحيط بكلّ شيء، ولا يخفى عنه شيء.
ولتكميل هذا البحث وتأكيد علمه المطلق يضيف القرآن الكريم: {سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار}(5)وهذا هو الحقّ فالذي يوجد في كلّ مكان لا معنى للغيب والشهادة أو الليل والنهار عنده، فهو محيط بها وعالم بأخبارها بشكل متساو.
المعقّبات الغيبية!
علمنا في الآيات السابقة أنّ الله بما أنّه عالم الغيب والشهادة فإنّه يعلم أسرار الناس وخفاياهم، وتضيف هذه الآية أنّه مع حفظ وحراسة الله لعبادة فإنّ {له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله}(6).
ولكي لا يتصوّر أحد أنّ هذا الحفظ بدون شروط وينغمِسُ في المزلاّت، أو يرتكب الذنوب الموجبة للعقاب، ومع كلّ ذلك ينتظر من الله أو الملائكة أن يحفظوه، يعلّل القرآن ذلك بقوله: {إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم}.
وكي لا يتبادر إلى الأذهان أنّه مع وجود الملائكة الحافظة فأيّ معنى للعذاب أو الجزاء؟ هنا تضيف الآية {وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال} ولهذا السبب فإنّه حين صدور العذاب الإلهي على قوم أو اُمّة، فسوف ينتهي دور المعقّبات ويتركون الإنسان عرضةً للحوادث.
_________________________
1- تفسير الامثل، مكارم الشيرازي،ج6،ص400-405.
2 ـ «تغيض» أصلها الغيض بمعنى إبتلاع السائل وهبوط مستوى الماء. وتأتي بمعنى النقصان والفساد، و «الغيضة» المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه، و «ليلة غائضة» أي مظلمة.
3 ـ يقول صاحب الميزان مؤيّداً هذا الرأي: إنّ بعض روايات أئمّة أهل البيت يؤيّد هذا الرأي. وابن عبّاس ممّن يؤيّد هذا الرأي أيضاً، ولكن بالنظر إلى الرّوايات المنقولة في تفسير نور الثقلين في ذيل الآية فانّ أكثرها يؤيّد ما قلناه في الرأي الأوّل.
4 ـ أصول الكافي،ج6،ص12، نقلا عن تفسيرنور الثقلين، ج2، صفحة 485.
5 ـ «سارب» من سرَبَ على وزن ضرر، بمعنى الماء الجاري، ويقال للشخص الذاهب إلى عمل أيضاً.
6 ـ هناك حديث بين المفسّرين في أنّ الضمير (له) لمن يعود، وكما تشير الآية فإنّه يعود للإنسان كما تؤكّد عليه الآيات السابقة، ولكن بعضهم قال: يعود للنبي أو لله. وهذا يخالف ما جاء في ذيل الآية[فتأمّل].



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|