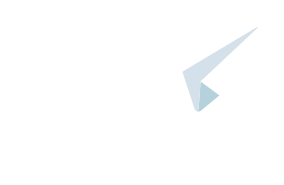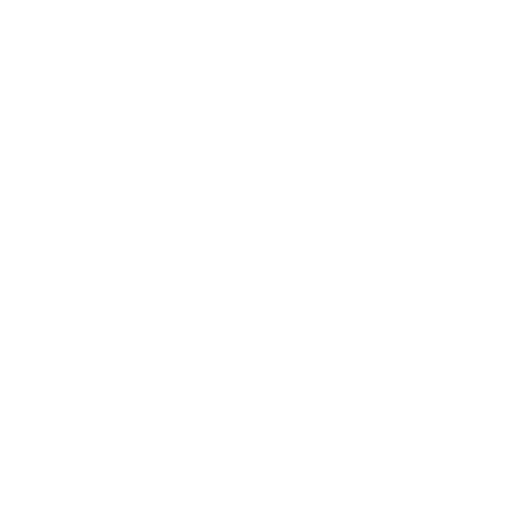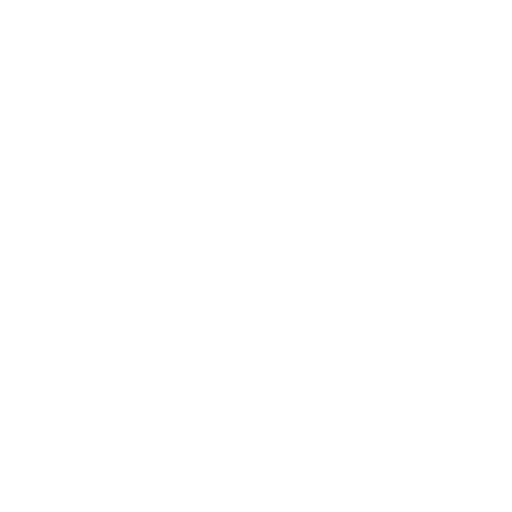القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الوسائل القانونية للإدارة في تحريك الدعوى الجزائية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 45-53
2025-10-18
38
ان كل جريمة تحدث داخل المجتمع ينشأ عنها ضرر عام حيث ان هذا الضرر يكون بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة وبذلك ينشئ حق للمجتمع بأن يقوم بمعاقبة الجاني، وذلك من اجل الدفاع عن امنه واستقراره وذلك لا يكون من خلال وسيلة واحدة وهي تحريك الدعوى الجزائية لكن لا يكون تحريكها دائما دون قيود فهناك قيود في تحريك بعض الشكاوى وسنبينهما فيما يلي:
أولا: الطلب في اللغة يعني طلب الشيء أي أراده وحاول أخذه كما يعرف (بأنه التعبير عن إرادة سلطة عامة في ان تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت اخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر على تنفيذها ) (1) ويقصد ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنياً عليها في جريمة أضرت بمصلحتها أم بصفتها ممثلة المصلحة أخرى أصابها اعتداءات كما تم وصف الطلب من قبل محكمة النقض المصرية بأنه (عمل اداري لا يعتمد على إرادة فرد، ولكن على مبادئ موضوعية في الدولة) (2) ويذهب بعض الفقهاء في تعريف الطلب على أنه هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة العامة حيث تعبر فيه عن إرادتها في تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم اشترط القانون؛ لرفع الدعوى عنها طلب وقد تكون الجهة المتضررة أي المجني عليها هي التي تصدر الطلب، وقد يحدد القانون جهة أخرى حيث يرى المشرع انها اقدر من الأولى في تقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى من عدمه (3) ، كما ذهب رأي ثاني في تعريفه إلى أنه قيد من قيود استعمال الدعوى الجزائية يتمثل في عمل اجرائي يصدر من جهات نص عليها القانون، وذلك في الغالب يكون محدداً من ناحية الشكل حيث يكون كتابيا يعبر فيها عن إرادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم حددها القانون(4).
ومن هذا يتبين، لنا من خلال هذه التعاريف السابقة أن الطلب يشتمل على عدة عناصر، هي:
1- ان الطلب هو احد القيود على حرية الادعاء العام في تحريك أو رفع الدعوى الجزائية أو الاثنين معا.
2- أنه يتم تقديمه لجهة معينة وفي الغالب يكون للادعاء العام في التسريع العراقي او النيابة العامة في التشريع المصري.
3- يجب أن يكون الطلب متضمناً وقائع محددة حيث تحمل هذه الوقائع في طياتها جريمة معاقبًا عليها، ولا يستطيع الادعاء العام تحريك ورفع الدعوى الجزائية عنها إلا بتقديم ذلك الطلب (5).
4 - يتم تقديم الطلب من الجهة التي حددها القانون، وفي الغالب تكون من جهة مجني عليها تعبر فيه عن ارادتها بأبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة معينة وقد مست مصالحها (6).
5- يجب أن يُقدِّم الطلب كتابيًا، ولا يكفي مجرد إرسال خطاب يفيد صدور الطلب، ولا يجوز بدء التحقيق إلا بانضمام الطلب المكتوب إلى أوراق التحقيق (7) ذلك ومع يرى جانب من الفقهاء إمكانية تقديم الطلب بشكل شفهي، و من ثم يلحق به الطلب المكتوب (8).
6 - لا يشترط أن يكون المتهم محددًا ، فقد يأتي الطلب أثاره القانونية، ولو كان المتهم مجهولا؛ لأن الجهة المتضررة هي من تحرك الدعوى.
7- ان الحق في الطلب لا يسقط بوفاة مدير المصلحة أو الهيئة(9).
8- أنه يقدم عن جرائم معينة محددة حصرًا في قوانين مختلفة.
ان الغرض من الطلب و تعليق رفع الدعوى الجزائية في بعض الجرائم على تقديم طلب من جهة معينة يحددها القانون هي أن هذه الجرائم تمس مصالح تلك الجهة في مجال معين، ومن ثم ترك لها تقدير ملاءمة مباشرة الإجراءات الجزائية في شأنها، فإذ كانت رغبتها هي السير في إجراءات الدعوى الجزائية تمثل ذلك في تقديم الطلب، أما إن كان الأمر غير ذلك عبرت عن رأيها بعدم تقديم الطلب لذلك شرع الطلب تحقيقاً لمصلحة عامة، فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيًا عليها أم بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، وينصرف الطلب إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق فيها أو، ويعني ذلك أنه قبل تقديم الطلب لا يجوز للادعاء العامة تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق فيها أو رفع الدعوى الناشئة عنها (10) فإذ ما حركت الدعوى الجزائية سواء بتحقيق قام به الادعاء العام بوصفه سلطة تحقيق وممثل عن المجتمع أم برفع الدعوى الجزائية أمام جهات الحكم قبل اتمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن، وهو تقديم الطلب، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام؛ لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما يكون منها ماثلاً بشخصه كسؤال الشهود، ويتشابه الطلب مع الشكوى حيث ان الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة، سواء النيابة العامة أم مأمور الضبط القضائي بوقوع جريمة، طالبًا تحريك الدعوى الجنائية (11).
في الجرائم التي حددها القانون التي يتطلب من اجل تحريكها توافر هذا الإجراء، ومن هذا فإن الشكوى والطلب يلتقيان في بعض أوجه الشبه حيث ان كليهما قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وقبل تقديم أي منهما، لا تملك النيابة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى، وبعد التقديم تسترد النيابة سلطاتها كاملة (12) كما يجوز النزول عنهما بعكس الإذن فلا يجوز النزول عنه، يقومان معا على وحدة الواقعة، فتقديم الطلب أو الشكوى ضد أحد المتهمين يعتبر مقدما ضد الباقين حال تعددهم والنزول بالنسبة لأحدهم نزولاً عن الجميع، وبالرغم من أوجه الشبه التي ذكرناها فيما سبق بين الطلب والشكوى، فإن هناك أوجه خلاف بينهما، أهمها الحالات التي يستلزم القانون فيها تقديم الطلب إنما تقررت في الواقع لحماية المصلحة العامة دون غيرها، في حين أن الأحوال التي يتطلب فيه القانون شكوى المجني عليه إنما تقررت في الأصل حماية له مما قد يناله من قيام الادعاء العام بتحريك الدعوى وما يترتب على ذلك من مساس باعتباره وسمعته يعادل ما يلحق الجاني من أذى وربما يتجاوزه (13) ، يشترط أن يُقدم الطلب كتابة، وذلك على التفضيل الذي سوف يرد في موضعه، أما الشكوى فلا يشترط فيها شكل خاص فقد تكون كتابية أو شفهية. كما يجب أن يقدم الطلب من الشخص الذي حدده القانون على سبيل الحصر ومن يفوضه إذ كان القانون يجيز ذلك ولا يشترط أن يكون ذلك المجني عليه، أما الشكوى فتقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص بتوكيل صريح خاص صادر عن واقعة معينة سابقة حدوثه ان المدة الزمنية لتقديم الطلب تكون على مبدأ العام على عكس الشكوى فأنها تكون محددة بمدة زمنية وهي ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة او تاريخ العلم بها.
اما الطبيعة القانونية للطلب، بما ان القانون قد قيد حق الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية بقيد الطلب، فما هو أساس هذا القيد.
ان أساس هذا القيد وهو قيد الطلب هو المصلحة العامة وأساس قيد الطلب على وجه الخصوص هو حماية مصلحة أحد أجهزة الدولة التي وقعت عليها الجريمة أو بعض الهيئات الأخرى (14).
ومع التطور التشريعي لاسيما الاقتصادي، وتوسع هذه التشريعات في الأخذ بقيد الطلب، لم يعد الأساس في هذا القيد ينبع من حماية مصلحة جهة معينة، ولكن دخل عليه أساس آخر وزادت أهميته وهو أن جهة معينة هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى رفع الدعوى؛ وبالتالي ليس الأساس حماية مصلحة خاصة لها، كما هو الحال في جرائم التهريب الضريبي والجمركي على ما سيأتي بيانه، ولكن لكونها الأقدر على الملاءمة والتقدير، كما هو الحال في قيد الطلب في جرائم قانون الاستثمار رقم (80) لسنة 1998 ، وقانون البنك المركزي رقم (88) لسنة 2003 وقانون سوق المال وفقا لآخر تعديل صادر بالقانون رقم (123) لسنة 2008؛ فهذه التشريعات وضعت قيد الطلب ليس لحماية مصلحة خاصة لهذه الجهات كمجني عليها فحسب، ولكن لكون هذه الجهات هي الأقدر على ملاءمة مدى الحاجة إلى تحريك الدعوى، فهذه الجهات بحكم وضعها وظروفها أقدر على فهم كافة الظروف والملابسات ووزن الاعتبارات المختلفة في الموضوع، وليس بشرط أن تكون هذه الجهات هي مجني عليها في الجريمة موضوع .
الإذن في اللغة يقصد به أن يأذن بالشيء أي أباحه له وسمح له به، أما في الاصطلاح فهو إجراء يصدر من جهة معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية ضد شخص معين ينتمي إليها أو بصدد جريمة معينة ارتكبت ضدها (15).
ويعرفه رأي آخر بأنه عمل إجرائي يصدر عن بعض هيئات الدولة؛ للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلى هذه الهيئات، مثال القضاء وأعضاء مجلس الشعب(16).
ويذهب رأي آخر إلى أن الإذن هو عمل إجرائي يتضمن تعبيرا عن إرادة هيئات معينة بشأن رفع القيد الذي يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إزاء بعض المتهمين وهو تصرف قانوني إجرائي فيما يتعلق بالخصومة الجنائية وعمل من طبيعة إدارية بالنسبة لمن يصدر منه (17).
ويأخذ الإذن صورتين الأولى إيجابية، والثانية سلبية، وذلك على حسب الاعتبارات التي يضعها المشرع حيث يكون إيجابيا إذ وضع المشرع في اعتباره طبيعة المصلحة القانونية التي وقعت الجريمة عليها وتم الاعتداء عليها (18) ، فلا يهتم المشرع بشخص الجاني ومركزه، وإنما يأخذ في الاعتبار الحق أو المصلحة التي أضرت او هددت بالضرر من وقوع الجريمة ولذلك أناط بجهات معينة سلطة إصدار الإذن من عدمه (19) ، ويلاحظ أن هذا النوع قد يختلط في الاعتبارات التي دعت إليه مع أنه لا يوجد فرق جوهري بينهما ، وهو أن الطلب تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخص المجني عليه أو تتعلق بمصالح جهات إدارية، أما الإذن الإيجابي فتراعى فيه اعتبارات شخص المجني عليه بقدر ما تراعى فيه الاعتبارات المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وليس مصالح الجهات الإدارية (20)، اما الإذن السلبي إذْ كان المشرع استلزمه لاعتبارات تتعلق كلها بشخص الجاني، الذي ينتمي بحكم وظيفته الى جهة معينة (21).
ان معظم التشريعات تختلف فيما بينها في حدود الإذن؛ فالبعض يقصره على النوع السلبي؛ أي فقط في الحالات التي يكون الجاني فيها ينتمي لهيئة أو جهة معينة، ومثال ذلك التشريع المصري والفلسطيني والأردني، والبعض الآخر يجمع بين النوعين من الإذن فيراعي المصلحة محل الحماية الجنائية التي أضرت من الجريمة، كما يراعي أيضا الاعتبارات المتعلقة بشخص الجاني، مثل القانون الليبي (22)، إن الغاية التي أرادها المشرع من وجود صدور إذن من الجهة العامة ضد الأشخاص الذين ينتمون إليها قبل أن تتخذ ضدهم الإجراءات الجنائية هو حماية المصلحة العامة.
رأى المشرع ضرورة الحفاظ على ما يتمتع به هؤلاء الأشخاص من أدائهم المهام الوظيفية الموكولة إليهم (23)؛ وتفاديا لأي اتهام يوجه إليهم لإجبارهم على السير على نحو معين، يكون هدفه الكيد لهم والإساءة إلى سمعتهم؛ وتفاديًا لأي ضغط أو تهديد يتعرضون له؛ لإجبارهم على السير نحو اتجاه معين (24)؛ ولهذا اتجه المشرع إلى أحاطتهم بنوع من الحصانة؛ تضمن تجنبهم كل ذلك، وتوفر لهم الطمأنينة في قيامهم بأعمالهم؛ وبالتالي يمكنهم القيام بها دون خوف أو تردد؛ وبالتالي حماية ورعاية المصلحة العامة؛ فهذه الحصانة ليست ميزة شخصية؛ للتمتع بها؛ ولكنها مقررة للمصلحة العامة (25) ، هناك عدة خصائص للأذن يمتاز بها وهي:
1- أنه إجراء شخصي يتعلق بالشخص المتهم وحده دون أن يمتد إلى غيره من اقاربه أو أفراد أسرته، ولا يمتد كذلك إلى من يشتركون معه في ارتكاب الجريمة (26)؛ فإذْ صدر الإذن في حق أحد المتهمين عند تعددهم، فلا يستفيد منه إلا الشخص المحتاج له دون غيره حتى لو كانوا جميعًا يحتاجون إلى إذن، فلابد أن يصدر في حق كل منهم إذن خاص به.
2- أنه إجراء فرض لحماية الجاني (27)، فهو يمنع اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده حالة ارتكابه الجريمة قبل أن تصدر الجهة المختصة إذنا يبيح ذلك، فلا يجوز اتخاذ هذه الإجراءات ضده إلا بعد صدور الإذن، وإلا كان ما يتخذ قبل ذلك باطلاً.
3- أنه إجراء لا يصدر إلا بالنسبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، فلا يحول دون رفع الدعوى المدينة ضد المتهم لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المجني عليه من جراء ارتكابه للجريمة أمام المحاكم المدينة (28) .
4- أنه إجراء هدفه حماية ورعاية المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية للمتهم، وبالتالي ضمان حماية العمل العام وحسن سيره وتمكين الأشخاص الذين يحتاجون إلى إذن من مباشرة أعمالهم بحرية وطمأنينة.
5- أنه إجراء لا يصدر إلا مكتوبًا، حيث لا يجوز أن يصدر شفاهة.
6- أنه إجراء يراد به إقرار الجهة التي يشترط استئذانها بأن الاتهام الموجه إلى الشخص الذي ينتمي لها خاليا من أي كيد أو تعسف، وبالتالي سماحها وموافقتها على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ولا يراد به رغبتها في تحريك ورفع دعوى المصلحة العامة الشكوى و من الإذن والشكوى الحق العام ضده.
7- أنه إجراء لا يجيز للجهة المختصة بإصداره أن تطلب من النيابة العامة أن تحرك وترفع دعوى الحق العام ضد الشخص المنتمي لها، ولكنه إجراء مثار لا يصدر إلا بعد أن يُقدم الطلب من النيابة العامة أو من أجاز لهم القانون رفع دعوى الحق العام على المتهم كما انه لا يجوز التنازل عنه.
لا يشترط في الإذن أي شرط خاص بالمدة وبالتالي فهو جائز مادامت الدعوى لم تنقض بعد بالتقادم.
________
1- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي الاسكندرية، 1988، ص 152.
2- نقض 7 مارس سنة 1967 مجموعة الاحكام محكمة النقض س 18 رقم 68 ص 224 نقلا عن المصدر أعلاه ص 152.
3- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 418، وكذلك د ادوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 103، وكذلك د. مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص 152.
4- د. محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 165.
5- د. هيثم عبد الرحمن البطي، الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المالية، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2005، ص 85.
6- د. محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 ، احكام تطبيقية ومضمونه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص 75.
7- د. احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 551
8- د. جلال ثروت أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 141؛ د. صادق المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف الاسكندرية، 2007، ص 85.
9- غازي خالد درويش الشبيلات شكوى المجني عليه رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1991، ص 61.
10- نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، دار النهضة العربية القاهرة، 2009، ص 267.
11- د. حسنين عبيد، شكوى المجني عليه مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث 1974، ص 122.
12- سليمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 386.
13- أنور العمروسي، شرح قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، 1958، ص 363.
14- د. مجدي إسماعيل محمود الطلب كفيد إجرائي على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 2012، ص 39.
15- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي الاسكندرية، 1988، ص 166
16- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 423.
17- د. أمال عبد الرحيم عثمان شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص 101.
18- د. حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائية منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 109.
19- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي الاسكندرية، 1988، ، ص 164.
20- عزت مصطفى الدسوقي، قيود تحريك الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 1986، ص 223.
21- أيمن حمادة يوسف المصري، قيود تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 2005، ص 141
22- إبراهيم سليمان احمد الغلبان القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الفلسطيني (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 2013 ص 370.
23- د عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006،ص 751.
24- أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 98
25- اشرف توفيق شمس الدين مرجع سابق، ص 98.
26- محمد شلال العاني الأذن كسبب مانع من تحريك دعوى الحق العام، مجلة الحقوق جامعة عمان الاهلية، ص 35.
27- عوض محمد العوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1999 ، ص 114.
28- سعيد محمد سعيد الشباب القيود على سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العليا، 2003، ص90.
 الاكثر قراءة في القانون الاداري
الاكثر قراءة في القانون الاداري
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













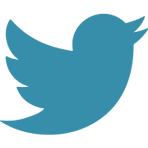

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)