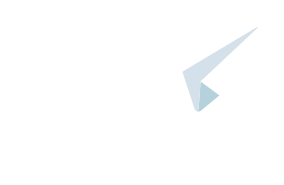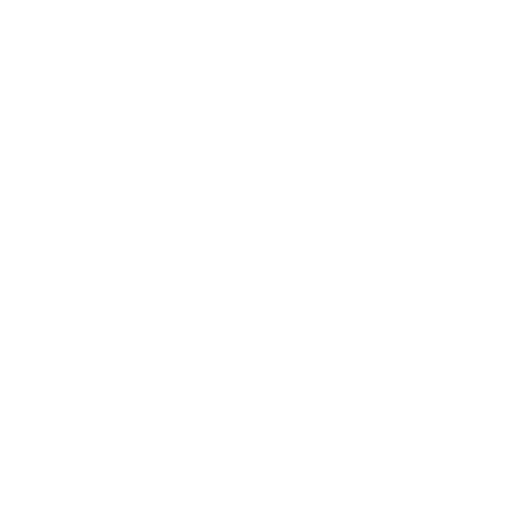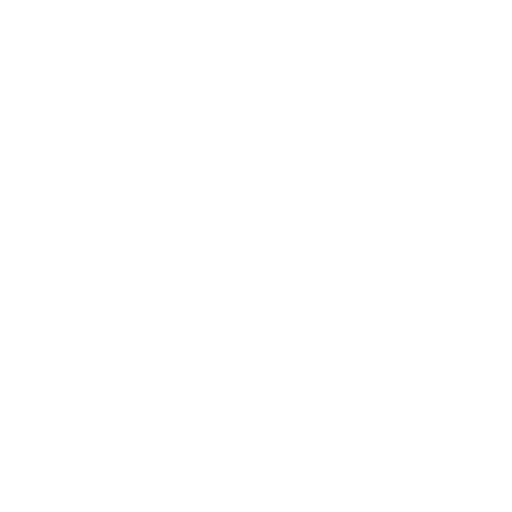علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
أثر الحديث في علوم الأدب
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 315 ــ 324
2025-10-09
37
الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَثَرُ الحَدِيثِ فِي عُلُومِ الأَدَبِ:
نَشْأَةُ العُلُومِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي ظِلِّ الحَدِيثِ:
كان بعض العلماء يقول: «العُلُومُ ثَلاَثَةٌ عِلْمٌ نَضَجَ وَمَا احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ النَّحْوِ وَالأُصُول، وَعِلْمٌ لاَ نَضَجَ وَلاَ احْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ البَيَانِ وَالتَّفْسِيرِ، وَعِلْمٌ نَضَجَ وَاحْتَرَقَ وَهُوَ عِلْمُ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ» (1). وانّه لقول سديد ينبئ عن المراحل التي مرّت بها العلوم الإسلاميّة الكبرى، ويصوّر النتائج التي انتهى إليها الباحثون بعد الموازنة بين تلك العلوم، وبعد المقارنة بين أصولها المؤصّلة، وقواعدها المقرّرة، ومصطلحاتها الدقيقة.
ولقد جعل صاحب هذه الكلمة كُلاًّ من الفقه والحديث عِلْمًا وَاحِدًا، وأصاب وأحسن صنعًا؛ لأنّ فروع الفقه تشعّبت عن التراث التشريعيّ الضخم الذي تركه حديث رسول الله في مختلف أبواب الحياة، سواء أكان هذا الحديث تبيانًا لمجملات القرآن أم أصلاً تشريعيًّا مستقلاً بعد كتاب الله. وما من ريب في أنّ هذا التداخل الوثيق بين الفقه والحديث قد قارب بين خطواتها في طريق التطوّر، وقارن بين مراحلهما المتعاقبة في سبيل النماء، فما أرسيت أصول الفقه إلّا بعد أن وضعت اللبنة الأولى في بناء «علوم الحديث».
وبعد أن مرّ الحديث والفقه بطور التمهيد والتحضير، اتّسع البحث فيهما وتنوع، ودارت حولهما المدارس الفكريّة تنتصر للمأثور تارة وللرأي تارة أخرى، فنضجا مَعًا واحترقا مَعًا، وظلت الرابطة وثيقة بينهما لتماثلهما في النشأة الأولى، وتشابههما في خطاهما الكبرى، واستمرار تلاقيهما في خدمة التشريع، وتعبيد الطريق للتحقيق والتدقيق فإن نُرِدْ الآن تسميتهما باسم واحد لا نجد أدقّ في الدلالة عليهما من لقب (علم الحديث)، وكأنّا حينئذٍ نستغني بأحدهما عن الآخر إيماء إلى مكانة الحديث خاصّة في مسائل الفقه جميعًا، فلولا الحديث لما كان الفقه عِلْمًا مَذْكُورًا.
إنّ العلم الذي نضج ثمّ احترق إذن - من كثرة التصنيف فيه - هو علم الحديث أو «فقه الحديث»، وإنّ العلوم الأخرى - سواء أنضجت ولم تحترق كأصول النحو أم لم تنضج ولم تحترق كمناهج التفسير - قد تأثّرت تأثّرًا يتفاوت قوة وضعفًا، واتّساعًا وعمقًا، بما وضعه نقّاد الحديث من مقاييس، وَأَرْسَوْهُ من قواعد وأصول.
ولئن نشأ الفقه في ظلّ الحديث ثُمَّ أضحى جزءًا لا يتجزأ من كلّه الكبير، فقد وجد التفسير أيضًا طريقه في رحاب الحديث حين عَوَّلَ المفسّرون على السنّة النبويّة في تأويل كتاب الله، وظلّ التفسير بعد ذلك - كالفقه – جزءًا من الحديث، حتّى استقل علمًا قائمًا بذاته له مناهجه وأصوله، ولكنّه - على استقلاله - ما انفكّ شديد الارتباط بحديث الرسول، ولو في جانب منه على الأقل: وهو جانب التفسير بالمأثور (2).
وهكذا احتجّ المفسرون بالعلم الذي نضج واحترق - وهو الحديث - تأييدًا للذي لم ينضج ولم يحترق وهو التفسير (3)، كما احتجّوا أيضًا على الفقه بالحديث، فَدَأَبَ الفقهاء المفسّرون يحتذون مناهج المحدّثين، وطبعت ألوان كثيرة من الفقه والتفسير بطابع الحديث.
تَأْثِيرُ الحَدِيثِ فِي أُصُولِ النَّحْوِ:
بقيت أصول النحو التي نضجت ولم تحترق، فَأَنَّى يكون تأثّرها بالحديث؟ وما حاجة النحو - وهو العلم الدنيويّ الإنسانيّ - إلى أصل من أصول الدين، ودعامة من دعائم التشريع؟! ومن عَجَبٍ أَنَّا، في إجابتنا، نكاد نرى رأي العين تأثير الحديث في النحو وأصوله بنسبة من القوّة لا تقل عن تأثير الحديث في الفقه والتفسير، ولكن الزاوية التي ننظر من خلالها الى التأثّر والتأثير في هذا المضمار أصيلة مبتكرة ليس فيها شيء من التقليد.
وقبل أن نمضي في توضيح رأينا نودّ أن نلتزم - تَخَفُّفًا من ثقل التعبير - أنّ مرادنا من «النحو» كلّما ذكرناه في هذا الفصل أصوله الكبرى التي تشتمل على مسائل لغويّة محضة اشتمالها على جزئيّات نحويّة صرفة: فأصول النحو هذه - على هذا الاصطلاح العام الشامل - هي التي تلقّت تأثير الحديث، وأخذت من «منهجيته» الشيء الكثير.
على أنّ تأثير الحديث في أصول النحو - على اتّساعه وعمقه وبعد مداه - كان على وجهين: أحدهما رافق نشأة علم الحديث قبل أن ينضج، والآخر شهد احتراق هذا العلم بعد أن نضج وآتى أكله اليانع الشهي!.
وليس لنا في الوجه الأول أن نغلو في هذا التأثير ولا أن نطيل، فإنّا لنتصوّر الآن نشأة التفكير بإسناد الحديث سَاذَجًا أَوَّلِيًّا في عصر الخلفاء الراشدين، ثم نتصوّر نشأة التفكير - سَاذَجًا أَوَّلِيًّا أيضًا - بوضع مسائل في النحو والعربية في عهد عَلِيٍّ [أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ]، ونبصر القوم في هذا المضمار أو ذاك يُعْنَوْنَ بضبط روايتهم التي يستمدّون منها مسألة نحويّة عنايتهم بضبط التي يستنبطون منها حُكْمًا شَرْعيًّا: فأبو الأسود الدؤلي الذي اشتهر بأنّه سبق إلى وضع مسائل في العربيّة (4) إنّما عزا إلى عَلِيٍّ [أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ]، التفكير الأوّل في ذلك الأمر، وفي عزوه هذا ضرب من الإسناد يؤكّد التبكير في إيضاح طريق التحمّل والأداء ولو لم يتعلّق المرويّ بموضوع دينيّ تشريعيّ. وأبو الأسود كما نقل عن عَلِيٍّ [أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ] هذه الرواية وأسندها، أخذ عنه الكثير من فتواه في الدين عَازِيًا إليه ما أخذ أوضح ما يكون العزو والإسناد. فما يُظَنُّ من صعوبة تحديد الوقت الذي بدأ فيه الإسناد في رواية الحديث لم ينشأ إلّا من قلّة الرجوع إلى مصادر الحديث؛ لأنّ من العسير نفي تلك الآثار المستفيضة المتضافرة على أخذ بعض الصحابة من بعض، وإسناد أحدهم القول إلى أخيه، وتعضيد القول الواحد بما يثبته من أقوال الصحب الغر الميامين.
والقارئ الذي اطّلع على فصلنا السابق عن «الاحتجاج بالحديث في التشريع»، وشهد معنا ما أشهدناه إيّاه من تناوب الصحابة مجلس النبي - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لسماع العلم وتحمّله وأدائه، ورأى الصور التي انتزعناها له من رواية بعض القوم عن بعض حتى في عصر النبي الكريم، ما نحسبه بحاجة إلى توكيد جديد لممارسة الرواية وما يتّصل بها من الأسانيد، وما نحسبه يتردّد في الحكم على الصحابة والتابعين بعزوهم الروايات لأصحابها عندما كانوا يحدّثون.
تَبْكِيرُ القَوْمِ بِالرِّوَايَةِ المَصْحُوبَةِ بِالإِسْنَادِ:
وحين نقع على أخبار تومئ إلى أنّ بعض التابعين - كقتادة بن دعامة السدوسيّ - لم يكن يُسْنِدُ الحديث، تكون هذه الأخبار نفسها شاهدنا في أن معظم التابعين في مختلف الأمصار كانوا للحديث مسندين. ولولا ذلك لما حرص الراوي على استثناء قتادة - أو أيّ تابعي آخر سواه - من حكم عام لا يجهل أحد أنّه - في ذلك العصر- كان يشمل الجميع.
ففي الطبقات الكبرى (5) على سبيل المثال قول حمّاد بن سلمة: «كُنَّا نَأْتِي قَتَادَةَ فَيَقُولُ: بَلَغَنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ. وَلا يَكَاد يُسْنِدُ. فَلَمَّا قَدِمَ حَمَّادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ البَصْرَةَ جَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ. فَبَلَغَ قَتَادَةَ ذَلِكَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سَأَلْتُ مُطَرِّفًا وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ. وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَ بِالإِسْنَادِ».
وظاهر هذا الخبر: أنّ قتادة ما أخبر بالإسناد إلّا بعد أن أصابته عدوى حمّاد بن أبي سليمان لدى مقدمه البصرة، وفحوى هذا الخبر: أنّ كثيرًا من التابعين غير حمّاد بن أبي سليمان كانوا في أمصارهم يسندون، وهذا هو الذي نهضت به الحجّة وقام عليه الدليل... والمهم أنّ الرواية المصحوبة بالإسناد عرفت - أوّل ما عرفت - في نقل سُنَّةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ -، لما كان لها من أثر في توجيه المسائل الفقهيّة والتشريعيّة. ومن عُنِيَ إلى ذلك - في صدر الإسلام - بروايات تتعلّق بغير الدين أسند ما نقل كما وسعه الإسناد بألفاظ أقرب ما تكون إلى عفويّة الورعين، وأبعد ما تكون عن جفاء اللفظيّين من أصحاب الاصطلاح، وعلى هذا لم يكن الذين سبقوا إلى وضع مسائل في العربية مِمَّنْ عُدُّوا مؤسّسي النحو في نشأته الأولى - بِدْعًا من الصحابة والتابعين الآخرين الذين أسهموا في نقل ما تيسّر لهم من أخبار وآثار في مختلف الميادين؛ لأنّ أحدًا من هؤلاء وأولئك لم يكن يجد فاصلاً حقيقيًّا بين رواة الأخبار بوجه عام ورواة الأحاديث النبويّة بوجه خاص.
ونقول مع ذلك: إنّ التأثير العفويّ الطبيعيّ الذي خَلَّفَهُ الحديث في أصول النحو، يوم فكّر القوم في وضع أوائلها، إنّما رافق نشأة علم الحديث قبل أن ينضج، فليس لنا أن نبالي فيه، ولا أن نغلو في أبعاده ومراميه، ولكنّا - بعد نضج هذا العلم في القرن الثاني، ثم بعد احتراقه في القرن الثالث - مهما نَغْلُ في وصف ما كان للحديث من أثر في النحو وأصوله، وفي مختلف العلوم ومناهجها، نَظَلُّ دون إيفاء علم الحديث حقّه، فما من تيار فكريّ إسلاميّ إلّا وله من عدوى الحديث حظ معلوم، إن لم يكن فيما حمله تراث النبوة من وصايا وَحِكَمٍ وتعاليم ففي طرق التحمّل والأداء، وشروط الرواية والرواة، ومقاييس النقد والتجريح، وأساليب التصنيف والتخريج، ومعايير الموازنة والترجيح، فهذه كلّها دخلت شواهد النحو، وسادت أبحاث اللغة، وارتفعت إلى أخبار الأدب، وتركت في الجميع أصداءها الشداد، عن طريق الرواية والإسناد!
عُلُومُ الأَدَبِ وَتَأَثُّرِهَا بِأَسَانِيدِ المُحَدِّثِينَ:
وتفصيل ذلك أنّ النحو والصرف ومسائل اللغة كلّها شعب من علوم الأدب، فلا يستشهد عليها - كما قال الرعينيّ (6) - إلّا بكلام العرب الأصيل، وهل من سبيل غير الرواية الصحيحة والإسناد الثابت المتّصل للوقوف على كلام العرب القدامى الفصحاء؟
وأجمع العلماء - ولعلّهم في إجماعهم قد أصابوا - «على أنّه لا يحتج بكلام المولّدين والمحدّثين في اللغة العربية (7)، وحملوا - عن طريق هذا الإجماع - إلى علوم العربيّة روايات لا ينالها الإحصاء فيها كثير من شعر الجاهليّين الذين لم يدركوا الإسلام، والمخضرمين الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام، وفيها أحيانًا طائفة من الشعر الإسلاميّ الذي لم يدرك أصحابه من الجاهليّة شيئًا (8). فهل تيسّر لأحد منهم أن ينقل تلك الشواهد كلّها من غير أن يتأثّر، قليلاً أو كثيرًا، بطريقة المحدّثين في إسناد الروايات؟ .... منذ أن اتّسع القول في علوم الحديث، ووضعت الأصول الكبرى لمصطلحات الحديث، وشاعت بين الناس تلك القواعد والمصطلحات، بدأ الرواة يحرصون على رواية ما اتّصل من الأسانيد، في كلّ ما أرادوا تعلّمه أو تعليمه من الأخبار والسير والأشعار، وإن كانوا في ذلك كلّه أحرص على الورع والاحتياط في نقل أحاديث الرسول العربي الكريم.
فقد نستنتج إذن أنّ النّاس - في عصر تصنيف العلوم - التزموا الإسناد المتّصل في رواية الحديث، أو كانوا أشدّ التزامًا لاتّصال الحلقات في هذا الضرب من الرواية الدينيّة (9)، ثم من حقّنا - بل يجب علينا أيضًا - أن نستنتج أنّ أولئك الناس أنفسهم كانوا رواة لشواهد اللغة والنحو من الشعر وما كان من قبيله، فكانوا فيها ربّما يَتَخَفَّفُونَ شَيْئًا ما من حَرَجِ الرواية الدينيّة، ولكنّهم ما كانوا يتساهلون في شيء من ذلك تساهلهم في الجاهلية؛ لأنّ نقّاد الحديث تركوا فيهم من الأثر العميق ما لا يزول حتّى بالجهد والمعاناة!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عزاه السيوطي في " الأشباه والنظائر في النحو ": 1/ 5 إلى بدر الدين الزركشي في أول قواعده.
(2) اقرأ في كتابنا " مباحث في علوم القرآن " فصل (التفسير) ص 289، واقرأ منه بإمعان ما يتعلق بالتفسير بالمأثور.
(3) ولا يمكن أن ينضج ولا أن يحترق؛ لأنّه - لتعلّقه بكلام الله - سيظل محتملاً لألوان من التأويل لا تحصى عددًا، مع تصريح أصحابها في كلّ زمان ومكان بأنّهم لم يصيبوا حقيقة المراد بكلام الله العليم الحكيم.
(4) " البرهان في علوم القرآن " للزركشي: 1/ 378.
(5) " الطبقات الكبرى " لابن سعد: 7 / ق 2 - ص 2.
(6) هو الرعينيّ الأندلسيّ، من علماء المائة الثامنة، وممّا قاله في "شرح بديعية زميله ابن جابر": «علوم الأدب ستّة: اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع، والثلاثة الأولى لا يستشهد عليها إلّا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة فإنّه يستشهد عليها بكلام المولّدين؛ لأنّها راجعة إلى المعاني». انظر "خزانة الأدب" للبغدادي: 1/ 20 (المطبعة السلفيّة بالقاهرة، 1348 هـ).
(7) " الاقتراح " للسيوطي: ص 31.
(8) طبقة الشعراء الإسلاميّين لم يمل إلى الاحتجاج بها في علوم اللغة والأدب إلّا ثلّة من العلماء المحقّقين، كالبغدادي في "خزانة الأدب": 1/ 20.
(9) راجع بوجه خاص ما ذكرناه ص 134 - 136.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













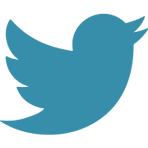

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)