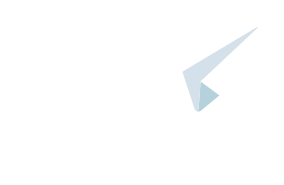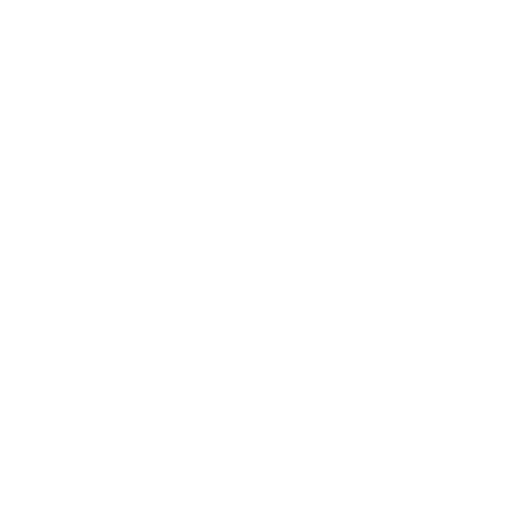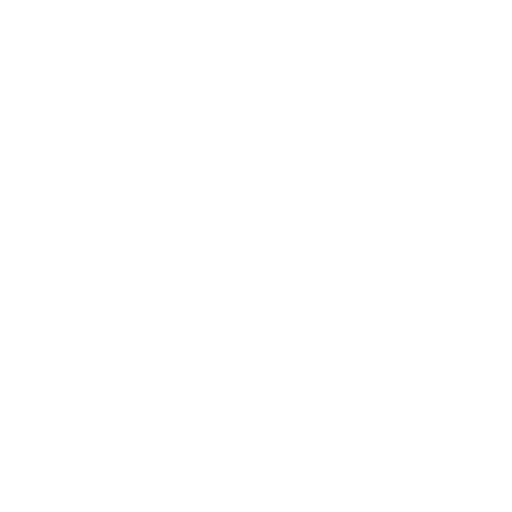علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
شروط الراوي ومقاييس المحدّثين
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 126 ــ 138
2025-09-17
57
الفصل الثالث: شروط الراوي ومقاييس المحدّثين:
العقل والضبط والعدالة والإسلام شروط لا بد منها لقبول الرواية، فلو فقدها الراوي أو فقد بعضها ردّت روايته، وترك حديثه. وإلى هذه الشروط الأربعة تؤول أقوال نقّاد الحديث من قدامى ومتأخّرين. غير أنّ دقّة الاصطلاح هي ميزة المتأخّرين الذين اطّلعوا على الكثير من آراء الأوائل ورجّحوا بينها واختاروا أحدها، أمّا القدامى فكانوا يقنعون من الموضوع بتطبيقه العمليّ، فتغنيهم الدربة والممارسة عن وضع المصطلحات والتدقيق في المقاييس.
قيل لشعبة بن الحجاج (- 160 هـ): من الذي يُترَكُ حديثه؟ فقال: «إذا روى عن المعروفين، ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، تُرِكَ حديثه، فإذا اتّهم بالحديث تُرِكَ حديثه، فإذا أكثر الغلط تُرِكَ حديثه، وإذا روى حديثًا اجتمع عليه أنَّهُ غلط تُرِكَ حديثه، وما كان غير هذا فاروِ عنه» (1).
ويكاد شعبة بهذا يصرح بشرطين من شروط الراوي الذي يقبل حديثه وهما الضبط والعدالة، فكثرة الغلط تنافي الضبط، والاتّهام في الحديث يعارض العدالة. أمّا الإسلام والعقل فأمران بديهيان لم يلتزم شعبة ذكر لفظهما، إذ كان لا يتصوّر العدالة من غير إسلام، أو الضبط من غير عقل وتمييز.
لكن المتأخّرين من نقّاد الحديث - حين أخذوا أنفسهم بدقّة المصطلحات ووضوح المقاييس - نبّهوا على الشروط جميعا، فذكروا البديهيات أحيانًا، ولم يضنّوا على طالب هذا العلم بالتبويب والتقسيم.
وشرط العقل يرادف عند المحدّثين مقدرة الراوي على التمييز، فيندرج تحته البالغ تحمّلاً وأداء، والصبي المميّز تحمّلاً لا أداءً. فقد لوحظ في شرط العقل البلوغ ضمنًا؛ لأنّ في وسع الصبي أن يتحمّل الرواية، ولكنّه لا يؤدّيها إلّا بعد بلوغه (2).
وممّن كثرت الرواية عنه من الصحابة، وكان سماعه في الصغير، أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدريّ. وكان محمود بن الربيع يذكر أنّه عقل مجّة مجّها رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ في وجهه من دلو كان معلّقًا في دارهم، وتوفّي [النبيّ] ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ وله خمس سنين (3).
ولم يتّفق المحدّثون على مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه (4)، فقال قوم: الحد في السماع خمس عشرة سنة، وقال غيرهم: ثلاث عشرة. وقال جمهور العلماء: يصح السماع لمن سنّه دون ذلك. وبهذا الرأي الأخير أخذ الخطيب البغدادي وقال: «وهذا هو عندنا الصواب» (5).
والحدّ في السماع خضع لبعض الاعتبارات الإقليميّة، فإذا كان أهل البصرة يكتبون الحديث ويسمعونه لعشر سنين (6)، فما كان الكوفيّون ليتساهلوا في ذلك إلا بعد استكمال أحدهم عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبّد (7)، أمّا أهل الشام فما كانوا يكتبون العلم إلّا لثلاثين (8).
ويريدون بضبط الراوي سماعه للرواية كما يجب وفهمه لها فهما دقيقًا، وحفظه لها حفظًا كاملاً لا تردّد فيه، وثباته على هذا كلّه من وقت السماع إلى وقت الأداء (9). فيلاحظ في شرط الضبط قوّة الذاكرة ودقّة الملاحظة.
ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم غالبًا - ولو من حيث المعنى - فضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختلّ ضبطه ولم يحتجّ بحديثه (10).
والحق أنّ مخالفة الثقات الضابطين ضرب من الانحراف والشذوذ. ولا ريب في أنّ الذي يتحمّل الروايات الشاذّة يتحمّل وزرًا كبيرًا وشرًّا كثيرًا (11).
قال شعبة بن الحجّاج: «لا يجيئك الحديث الشاذّ إلّا من الرجل الشاذّ» (12).
ولقد قيّض الله للرواية علماء أعلامًا شدّدوا في أمرها، وكانوا في تشدّدهم حكماء، فلم ينقلوا إلّا الصحيح. والصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنّما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع (13). ومن الطبيعي إذن أن يحذّر عبد الله بن المبارك من كتابة الحديث أو سماعه عن غلّاط لا يرجع، وكذّاب، وصاحب بدعة وهوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدّث من حفظه (14).
ويريدون بعدالة الراوي استقامة التامّة في شؤون الدين، وسلامته من الفسق كلّه، وسلامته من خوارم المروءة (15). وقد عرّف الخطيب البغدادي العدل بأنّه «من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به، وتوقّي ما نهي عنه، وتجنّب الفواحش المسقطة، وتحرّي الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوقّي في لفظه [ما] يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنّه عدل في دينه، ومعروف بالصدق في حديثه» (16).
وفرّقوا بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد. وإذا كانت التزكية لا تقبل إّلا بشهادة رجلين فتعديل الراوي يثبت بمعرف واحد، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، حرًّا أم عبدًا، شريطة أن يكون في نفسه عدلاً مرضيًّا (17). وهذا هو اختيار الإمام فخر الدين (18)، والسيف الآمديّ (19). على أنّ بعض العلماء يسوّي بين الشاهد والراوي، فالتعديل يثبت لكليهما بتعريف شخص واحد (20). وقد انتصر القاضي أبو بكر (21) لهذا الرأي. وواضح أنّ تزكية الشاهد ليست هي عين الشهادة، فلا بُدَّ من رجلين في الشهادة على جميع الأقوال، أمّا تزكية الشاهد فهي التي جرى حولها الخلاف هل يكفي لإثباتها شخص واحد أم لا بُدَّ من شخصين؟.
والمروءة التي ينبغي توافرها في الراوي المعدل كثيرًا ما قيست بالمقاييس الخلقيّة الإنسانيّة المشتركة. ويستشهد الخطيب البغدادي على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته» (22).
وفي ضوء هذه المقاييس، لم يكن بُدَّ من غضَّ النظر عن بعض العيوب التي لا يعرى منها إنسان، وسيظلّ ما يجهله الناس من سيرة كلّ عالم وكل راوٍ أكثر ممّا يعرفونه، «فليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلّا وفيه عيب، لا بُدَّ، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» (23). فليكن مقياسًا في تعديل الرواة أنّ «من كان فضله أكثر من نقصه وُهِبَ نقصه لفضله» كما قال سعيد بن المسيّب (24).
وحسن الظنّ بالراوي حمل بعض العلماء على التساهل في رواية الحديث عن مستور الحال، وهو كلّ حامل علم معروف بالعناية فيه، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتّى يتبيّن جرحه (25) لقوله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين» (26).
لكنّ المحقّقين من الأصوليّين على ردّ كلّ رواية عن مستور الحال دفعًا للمفسدة (27)، فلا بُدَّ من تعديله والكشف عمّا يكمن من دخائله. وإن كان التوغّل في الكشف عن سريرته ليس من عمل المحدّثين في شيء.
ولا ريب أنّ العدالة شيء زائد على مجرّد التظاهر بالدين والورع، لا يعرف إلّا بتتبعّ الأفعال، واختبار التصرّفات، لتكوين صورة صادقة عن الراوي.
والبحث عن عدالة المخبر كالبحث عن عدالة الشاهد يتناول ضروبًا من الاستقصاء الدقيق الذي لا يجرح كرامة أحد، بل يزكّي الخبر المروي من خلال تزكية المخبر الراوي.
ولا غرابة بعد هذا أن يكره المحدثون الرواية عن أهل الأهواء والبدع (28)، وعن أهل المجون والخلاعة (29)، على حين تساهلوا في الرواية عن المشاهير من غير أن يسألوا عن سبب عدالتهم: فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من المحدّثين أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها لا يحتاج إلى تعديل المزكّين، كمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري (30)، والأوزاعيّ (31)، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والليث بن سعد (32)، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه (33) فقال: «مثل إسحاق يُسْأَلُ عنه؟!» وسُئِلَ ابن معين، عن أبي عبيد، فقال: «مثلي يُسْأَلُ عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يُسْأَلُ عن الناس!» (34).
ومناهج المحدّثين في الجرح أشدّ منها في التعديل: فهم يقبلون التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور (35)، أمّا الجرح فيردّونه إذا لم يبين سببه بيانًا شافيًا، لاعتقادهم بأنّ النّاس يختلفون في إسقاط العدالة والحكم بالفسق، وأنّ «مذاهب النقّاد للرجال غامضة دقيقة، وربّما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقّف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لردِّ الحديث، ولا مسقطًا للعدالة»(36).
من ذلك أنّهم تشدّدوا في رواية مرتكب المباحات، كالتنزّه في الطرقات، والأكل في الأسواق، والتبسّط في المداعبة والمزاح (37)، أمّا اللعب بالشطرنج ونحوه، واللهو بآلات الطرب، فأمرهما أشدّ. قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ: «لَقِيتُ نَاجِيَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَرَأَيْتُهُ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ فَتَرَكْتُهُ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، ثُمَّ كَتَبْتُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ»، وَقَالَ شُعْبَةُ أَيْضًا: «أَتَيْتُ مَنْزِلَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو فَسَمِعْتُ فِيهِ صَوْتَ الطُّنْبُورِ، فَرَجَعْتُ. فَهَلاَّ سَأَلْتُ؟ عَسَى أَنْ لاَ يَعْلَمُ هُوَ» (38).
والمعروف في كتب الجرح والتعديل أنَّ مُؤَلِّفِيهَا قَلَّمَا يتعرّضون لبيان أسباب الجرح، بل يقتصرون على مجرّد قولهم: «فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، وفلان متروك، ونحو ذلك». والنّاس مع ذلك يُعَوِّلُونَ عليها في رَدِّ حديث الرواة.
غير أنّ التحقيق العلمي الدقيق في موضوع هذه الكتب أثبت أنّ فائدتها ليست في اعتمادها للحكم بالجرح، بل في إثارة الرِّيبَةِ حول من جَرَّحُوهُ والتوقّف في أمره، فلا يقبل حديثه إلّا إذا انزاحت هذه الرِّيبَةُ عنه وحصلت الثقة به (39).
وهذه الشدّة المتناهية، والورع الزائد، والدقة البالغة، كلّها أثر من شعور النقّاد بقيمة المروي، فما هو بالكلام العادي، ولا بالأشعار والخطب والقصص وإنّما هو دين لا يؤخذ إلا بالنقل الأمين، والسماع الصحيح. قال محمد بن سيرين: «إنّ هذا [العلم] دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم» (40). ورفع بعضهم حديثا إلى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بهذا المعنى، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنّه قال: «يا ابن عمر دينك دينك، إنّما هو لحمك ودمك، فانظر عمّن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا» (41).
وعلى هدي هذه الوصايا، مضى طلّاب الحديث يتخيّرون الشيوخ إذا تباينت أوصافهم(42)، فكانوا يقدّمون السماع من الأمناء، ويكرهون النقل والرواية عن الضعفاء(43)، ويرجّحون الأخذ عمّن علا إسناده وقرب من النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - معتقدين أنّ «قرب الإسناد قربة إلى الله» (44)، وحين لا يتيسّر لهم الإسناد القريب إلى النبي نفسه يطلبون أقرب الأسانيد إلى الصحابة أو التابعين أو الأئمّة الأعلام، واثقين أنّ العلم في تلك العصور الذهبية كان «غضًّا طريًّا، والارتسام به محبوبًا شهيًّا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر» (45). واهتمامهم بالأسانيد العالية لم يكن ينصرف إليها لذاتها، بل لما يترتّب عليها من قوّة الظنّ بصحّة متونها، فما يقيمون وزنًا لإسنادٍ عالٍ إذا شكّوا في رجاله؛ لأنّ ضعف رجال الإسناد سيؤدّي ضرورة إلى ضعف المتن المروي، لذلك فضّلوا النزول عن الثقات على العلو عن غير الثقات (46) وأنشدوا مع أبي بكر بن الأنباري (47):
علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم ... وترككم كتبه ضرب من العنت
إنّ النزول إذا ما كان عن ثبت ... أعلى لكم من علو غير ذي ثبت (48).
وعرف بعض نقّاد الحديث للأسانيد النازلة مزيّة لم يعرفوها للعالي من الأسانيد، فرأوا «أنّ السماع النازل أفضل؛ لأنّه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر»(49).
وبلغ بالمحدّثين حسّهم النقديّ ذروة لا تسامى حين لاحظوا أنّ المعاصر حجاب، فكرهوا التحديث عن الأحياء (50) كأنّهم يخشون أثر الحب في حسن الظن وأثر الكره والمنافسة في إساءة الظنّ بالمروي عنه، فلا تكون أسس الجرح والتعديل سليمة ولا صحيحة. قال ابن عبد الحكم: ذاكرت الشافعي يومًا بحديث وأنا غلام، فقال: من حدّثك به؟ فقلت: أنت. فقال: «ما حدّثتك به من شيء فهو كما حدّثتك. وإيّاك والرواية عن الأحياء» (51). وقال ابن عون: «قلت للشعبي: ألا أحدّثك؟» (قال): فقال الشعبي: «أعن الأحياء تحدّثني أم عن الأموات؟» قال: «قلت، لا بل عن الأحياء»، قال: «فلا تحدّثني عن الأحياء» (52).
ولنقّاد الحديث اصطلاحات في التعديل والتجريح يدلّ تنوّعها وتغايرها على تباين أحوال الرواة في القوّة والضعف، والثقة والريبة. وقد جعل ابن حجر هذه الاصطلاحات اثنتي عشرة مرتبة (53): «1 - الصحابة. 2 - من أكّد مدحه بأفعل التفضيل، كأوثق الناس، أو بتكرار الصفة لفظا، كثقة ثقة، أو معنى، كثقة حافظ، 3 - من أفرد بصفة: كثقة، أو متقن، أو ثبت، 4 - من قصر عمن قبله قليلا كصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس، 5 - من قصر عن ذلك قليلا، كصدوق سيّئ الحفظ، أو صدوق يهمّ، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغيّر بأخرة، ويلحق بذلك أهل الأهواء والبدع، 6 - من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث، 7 - من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثّق، ويشار إليه بمستور، أو مجهول الحال، 8 - من لم يوجد فيه توثيق معتبر، وجاء فيه تضعيف وإن لم يبيّن، والإشارة إليه: ضعيف، 9 - من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثّق، ويقال فيه: مجهول، 10 - من لم يوثّق البتّة وضعّف مع ذلك بقادح، ويقال فيه متروك، أو متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط، 11 - من اتّهم بالكذب، ويقال فيه: متّهم، ومتّهم بالكذب، 12 - من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، ككذّاب، أو وضّاع أو يضع، أو ما أكذبه! ونحوها».
والدقّة في شروط الراوي - في ضوء مصطلحات الناقدين – كانت تراعى حتى أواخر القرن الثالث الهجري بتحفظ شديد، وحيطة بالغة، لتيسر السماع وتداول هذه الألفاظ على ألسنة الشيوخ والتلاميذ. بيد أن الرواة اضطروا بعد ذلك إلى كثير من التساهل في هذه الشروط، فاكتفوا في تعديل الراوي بشروط العقل والبلوغ والإسلام والضبط وعدم التظاهر بالفسق لأن الرواية باتت دراسة للكتب، لا نقلا بالمشافهة والسماع (54).
وأمّا شرط الإسلام، فهو واضح في نفسه، كما أنّ الغاية من اشتراطه واضحة: فالراوي يؤدّي أحاديث وأخبارًا وآثارًا تتعلّق بهذا الدين، وبأحكامه وحكمه وتشريعاته: فالأحوط أن يقوم بهذا الشأن من كان مؤمنًا بهذه العقيدة التي يتحمّل مسؤوليّة تفهيمها للنَّاس. على أنّ الإسلام يشترط عند أداء الرواية لا عند تحمّلها (55)، فقد قبلت رواية جبير بن مطعم «أنّه سمع النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ يقرأ في المغرب بسورة الطور» مع أنّه كان قد جاء في فداء أسرى بدر ولم يكن قد أسلم بعد، وقال عن نفسه - كما في "صحيح البخاري": «وذلك أوّل ما وقر الإيمان في قلبي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) " معرفة علوم الحديث ": ص 62.
(2) انظر " الكفاية ": ص 54، باب ما جاء في صحة سماع الصغير.
(3) " الكفاية ": ص 56.
(4) انظر الآراء المختلفة حول هذه القضية في " الجامع لأخلاق الراوي ": 4/ 71.
(5) " الكفاية ": ص 54.
(6) " الكفاية ": ص 55.
(7) " الكفاية ": ص 54.
(8) " الكفاية ": ص 55.
(9) والمحدّثون يفرّقون هنا بين قديم حديث الرجل وجديده، فقد يضعف ضبط الرجل في أواخر أيّامه فيقال فيه: «تغيّر بأخرة». انظر في (" سنن أبي داود ": 3/ 85 رقم 2695) كيف ردّ حديث أحد الرواة؛ لأنّه تغيّر ولم يخرّج الحديث إلّا بأخرة.
(10) " التدريب ": ص 110.
(11) " الكفاية ": ص 140.
(12) " الكفاية ": ص 141.
(13) " معرفة علوم الحديث ": ص 59.
(14) " الكفاية ": ص 143. وراجع في هذه الصفحة ذاتها من " الكفاية " أقوال العلماء في ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه، وكان الوهم غالبًا على روايته.
(15) قارن بـ" توضيح الأفكار ": 2/ 118.
(16) " الكفاية ": ص 80.
(17) " توضيح الأفكار ": 2/ 121 وقارن بـ" الفروق " للقرافي: 1/ 5 - 22، ط. تونس.
(18) هو فخر الدين الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله، إمام كبير في المعقول والمنقول. صاحب "التفسير الكبير المشهور". له كتب كثيرة منها "نهاية العقول" و "المحصول في علم الأصول" و "كتاب الأربعين في أصول الدين". توفّي سنة 606 هـ.
(19) سيف الدين الآمدي: هو أبو الحسن، علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي: من علماء الأصول. له نحو عشرين مصنّفا منها: "منتهى السول في [علم] الأصول" و "دقائق الحقائق" و "أبكار الأفكار" في علم الكلام. منسوب إلى آمد من «ديار بكر». توفّي سنة 631 هـ.
(20) " توضيح الأفكار ": 2/ 121.
(21) هو محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر، المشهور بالقاضي الباقلانيّ. انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. أشهر كتبه "إعجاز القرآن" توفي سنة 403 هـ.
(22) " الكفاية ": ص 78.
(23) " الكفاية ": ص 79.
(24) نفسه: ص 79. فالعبارة كلّها منسوبة إلى سعيد بن المسيّب، سيّد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة... وكان - على اشتغاله بالحديث والفقه - يعيش من كسب يده، من التجارة بالزيت. وأكثر أئمّة الحديث على وفاته سنة 105 كما قال الحاكم (انظر " تذكرة الحفّاظ ": 1/ 56.).
(25) " توضيح الأفكار ": 2/ 126، 127.
(26) " الجامع لأخلاق الراوي ": 1/ 15 وجه 2.
(27) " تدريب الراوي ": ص 115.
(28) " الجامع لأخلاق الراوي ": 1/ 18 وجه 1.
(29) " الكفاية ": ص 156.
(30) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، نسبة إلى ثور وهو أبو قبيلة من مضر. توفّي سنة 160 أو 161 هـ (انظر "الرسالة المستطرفة": ص 31).
(31) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد المشهور بالأوزاعي، وصفه الوليد بين مزيد فقال: «تعجز الملوك أن تؤدّب أولادها أدبه في نفسه». توفّي سنة 157 هـ (انظر " تذكرة الحفاظ ": 1/ 178 - 183).
(32) هو الحافظ الفقيه الورع شيخ الديار المصريّة، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث. توفّي سنة 175 هـ.
(33) هو الحافظ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه، ويكنّى أبا يعقوب. كان يحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب. وله "مسند" كبير. توفّي سنة 238 هـ. (انظر "الرسالة المستطرفة": ص 49).
(34) " تدريب الراوي ": ص 109.
(35) وقد علّل السيوطي ذلك بكثرة أسباب التعديل حتّى يثقل ذكرها ويشقّ؛ إذ على المعدّل أن يقول: لم يرتكب كذا، فيعدّد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاقّ جدًّا. (" التدريب ": ص 111).
(36) " الكفاية ": ص 109.
(37) " الكفاية ": ص 111.
(38) " الكفاية ": ص 111، 112.
(39) " التدريب ": ص 111.
(40) " الجامع لأخلاق الراوي ": 1/ 15 وجه 2.
(41) " الكفاية ": ص 121.
(42) " الجامع ": 1/ 14 وجه 2.
(43) " الكفاية ": ص 132.
(44) كما روي عن محمد بن أسلم الطوسي في "الجامع ": 1/ 13 وجه 2. وفي الصفحة نفسها من هذا المخطوط أنّ أحمد بن حنبل، كان يقول: «طلب إسناد العلو من السنّة». وسندرس في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف» أهمّ ما يتعلّق بالحديث العالي والحديث النازل، فانتظر التفصيل هناك.
(45) " الجامع ": 1/ 11 وجه 1.
(46) " الجامع ": 1/ 14 وجه 1.
(47) هو محمد بن بشار المعروف بأبي بكر بن الأنباري، النحوي المعدود في حفظ الحديث، ومصنّف التصانيف الكثيرة. توفّي ببغداد سنة 328 هـ.
(48) " الجامع ": 1/ 14 وجه 2. ويراد بعلم النزول في هذين البيتين معرفة الأسانيد النازلة البعيدة عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - أو عن الأئمّة الأعلام.
(49) " الجامع ": 1/ 11 وجه 2.
(50) " الكفاية ": ص 139.
(51) " الكفاية ": ص 140.
(52) " الكفاية ": ص 139.
(53) وذلك في خطبة كتابه "تقريب التهذيب". وقد آثرنا اختصارها على النحو الذي ذكرناه. وقارن بـ"الباعث الحثيث": ص 118، 119، وبـ"توضيح الأفكار": 2/ 261 - 271 وبمقدمة كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.
(54) "اختصار علوم الحديث": ص 119.
(55) "الكفاية": ص 76.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













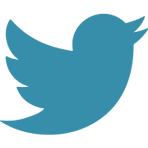

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)