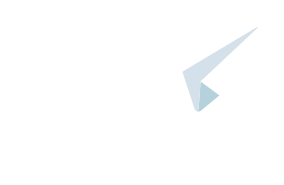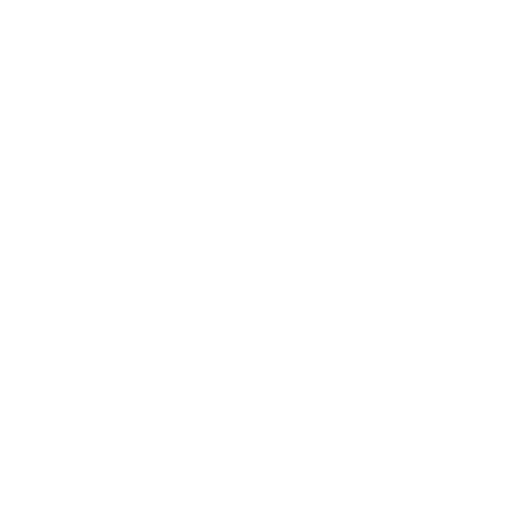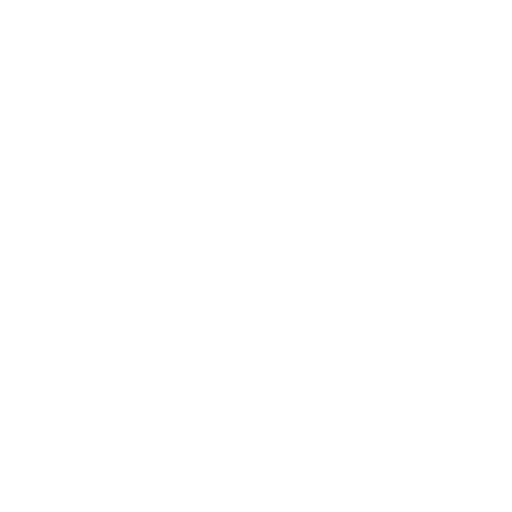علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة


علم الرجال

تعريف علم الرجال

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)

أصحاب الائمة (عليهم السلام)

العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري
كتابة الحديث رواية ومراتبها
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 115 ــ 125
2025-09-17
387
الفَصْلُ الثَّانِي: كِتَابَةُ الحَدِيثِ رِوَايَةً وَمَرَاتِبُهَا:
مَرَاتِبُ هَذِهِ الكُتُبُ:
لقد صُنِّفَتْ في الحديث كُتُبٌ كثيرة وصل إلينا بعضها، ولم يصل بعضها الآخر، ولا يزال عدد كبير منها مخطوطًا في المكاتب العالميّة، وسيعيش لها الجهابذة من العلماء لينفضوا عنها الغبار وَيُحْيُوا بها التراث الإسلامي العظيم.
وكان ينبغي أن تكون كتب الحديث بهذه الكثرة؛ لأنّ مجمعة الأحاديث النبوية يتعذّر إحصاؤها وضبطها في كتاب يجمعها مهما يكن هذا الكتاب ضخمًا عظيمًا، فأحمد بن حنبل انتخب "مسنده" وحده من 750.000 (خمسين ألف وسبع مائة ألف) (1) مع أنّ أحاديث هذا "المسند" لا تبلغ الأربعين ألفًا (2).
وقد حاول السيوطي في كتابه "جمع الجوامع" أن يستوعب الأحاديث النَّبَوِيَّةِ بأسرها، وفقًا لما أدّاه إليه اجتهاده واطّلاعه، فجمع منها مائة ألف حديث ومات قبل أن يتمّ تصنيفه. وجدير بالذكر أنّه كان يقول: «أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ مِائَتَا أَلْفَ حَدِيثٍ وَنَيِّفٍ» (3).
إنّ هذا المقدار العظيم من الأحاديث التي جمعت من كتب شتّى أُلِّفَتْ في أعصر مختلفة لا يمكن أن ينظر إلى مصادره كلّها نظرة متساوية، وبعبارة أخرى: لا يمكن أن تكون مصادر الحديث - على اختلافها - ذات طبقة واحدة، ومرتبة واحدة، ولذلك اصطلح العلماء على تقسيم كتب الحديث بالنسبة إلى الصحّة والحسن والضعف إلى طبقات(4):
الطبقة الأولى: تنحصر في "صحيحي البخاري ومسلم" و"موطأ مالك بن أنس"، وفيها من أقسام الحديث: المتواتر، والصحيح الآحاديّ، والحسن.
الطبقة الثانية: وفيها "جامع الترمذي"، و"سنن أبي داود"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"مُجْتَبَى" النسائي، وهي كتب لم تبلغ مبلغ "الصحيحين" و"الموطأ"، ولكن مُصَنِّفِيهَا لم يرضوا فيها بالتساهل فيما اشترطوه على أنفسهم، وتلقّاها مَنْ بَعْدَهُمْ بالقبول، ومنها استمدّت أكثر العلوم والأحكام وإن كانت لا تخلو من الضعيف.
والمحدّثون يعتمدون على هاتين الطبقتين بوجه خاص، ويستنبطون منهما أصول العقيدة والشريعة.
الطبقة الثالثة: وهي الكتب التي يكثر فيها أنواع الضعيف من شاذ ومنكر ومضطرب، مع استتار حال رجالها وعدم تداول ما شذّت به أو انفردت: كـ "مسند ابن أبي شيبة"، و"مسند الطيالسي"، و"مسند عبد بن حُمَيْدٍ "، و"مصنّف عبد الرزّاق"، وكتب البيهقي والطبراني والطحاوي، وهذه الطبقة لا يستطيع الاعتماد عليها والاستمداد منها إلا جهابذة المحدّثين، الذين أفنوا حياتهم في استكمال هذا العلم وتتبّع جزئياته.
الطبقة الرابعة: مصنّفات هزيلة جمعت في العصور المتأخّرة من أفواه القُصَّاصِ وَالوُعَّاظِ والمتصوّفة والمؤرّخين غير العدول وأصحاب البدع والأهواء كما في تصانيف ابْنِ مَرْدَوَيْهْ وابن شاهين وأبي الشيخ. ومن الواضح أنّ هذه الطبقة الأخيرة لا يعوّل عليها أحد من الذين لهم إلمام بالحديث النبوي؛ لأنّها مصدر الأهواء والبدع.
التَّعْرِيفُ بِأَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ وَالمَسَانِيدِ:
تعدّدت أنواع كتب الحديث، كما تعدّدت طبقاتها، فكان منها كتب الصحاح والجوامع والمسانيد، والمعاجم، والمستدركات، والمستخرجات والأجزاء.
أ - أمّا كتب الصحاح فهي تشمل "الكتب الستّة" للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنّ العلماء اختلفوا في ابن ماجه، فجعلوا الكتاب السادس "موطأ مالك"، كما قال رُزَيْنٌ وابن الأثير، أو "مسند الدارمي" كما قال ابن حجر العسقلاني (5).
وعلى ذلك فإنّ من الواضح أنّ عبارة "الكتب الخمسة" تصدق على كتب الأئمّة الذين ذكروا قبل ابن ماجه، فإذا قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة: «رَوَاهُ الخَمْسَةُ» فمعنى ذلك أنّ البخاري ومسلمًا وأبا داود والترمذي والنسائي قد اتفقوا جميعًا على رواية هذا الحديث. وعبارة «الصَّحِيحَيْنِ» تطلق على كتابي البخاري (6) ومسلم(7)، ويقال في الحديث الذي رَوَيَاهُ «رَوَاهُ الشَّيْخَانِ» أو «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ».
وإنّما سمّيت "الكتب الستّة" بالصحاح على سبيل التغليب، وإلّا فإنّ كتب "السنن الأربعة" للترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه هي دون "الصحيحين" منزلة، وأقل منهما دقّة وضبطًا (8).
ولكلّ من أصحاب "الكتب الستّة" ميزة يعرف بها، فمن أراد التفقّه فعليه بـ"صحيح البخاري"، ومن أراد قلّة التعليقات فعليه بـ"صحيح مسلم" (9)، ومن رغب في زيادة معلوماته في فن التحديث فعليه بـ"جامع الترمذي"، ومن قصد إلى حصر أحاديث الأحكام فبغيته لدى أبي داود (10) في "سننه"، ومن كان يعنيه حسن التبويب في الفقه فابن ماجه (11) يُلَبِّي رغبته، أمّا النسائي (12) فقد توافرت له أكثر هذه المزايا.
و"صحيح البخاري" أرجح من "صحيح مسلم"؛ لأنّ البخاري اشترط في إخراجه الحديث شرطين؛ أحدهما: معاصرة الراوي لشيخه، والثاني: ثبوت سماعه، بينما اكتفى مسلم بمجرّد شرط المعاصرة (13).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه "فتح الباري" أنّ عِدَّةَ أحاديث البخاري بِالمُكَرَّرِ وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082)، فيها من المتون الموصولة بلا تكرار (2602) ومن المتون المُعَلَّقَةِ المَرْفُوعَةِ (159) ولم يتناول ابن حجر بالعَدَّ والاستقصاء ما في "البخاري" من الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين (14).
أمّا عِدَّةَ ما في "صحيح مسلم" بلا تكرار فيبلغ نحو أربعة آلاف حديث (15).
والبخاري قد وضع بنفسه عناوين "صحيحه" فَبَوَّبَهُ بطريقة خاصّة تدلّ على سَعَةِ علمه وفقهه، وهو غالبًا يفتتح الباب بالآيات القرآنيّة، فيستنبط من ذلك رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة. أمّا مسلم فإنّه رَتَّبَ أحاديثه بطريقة خاصّة، فجعل كلّ طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد متلاحقة متتابعة من غير أن يُفْرِدَهَا بعنوان لها بنفسه، ولقد بَوَّبَ له "صحيحه" ووضع له عناوينه النووي، فأصبح الانتفاع به أيسر.
ولمسلم في "صحيحه" مزايا منها سهولة تناوله؛ لأنّه جعل لكلّ حديث مَوْضِعًا واحدًا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها وأورد فيه أسانيده المتعدّدة، بخلاف البخاري فإنّه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرّقة متباعدة.
ومسلم يُمَيِّزُ بين «حَدَّثَنَا» و«أَخْبَرَنَا» فكان يرى أنّ «حَدَّثَنَا» لا يجوز إطلاقه إلّا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصّة، و«أَخْبَرَنَا» لما قُرِئَ على الشيخ (16).
وهذا مذهب أكثر أصحاب الحديث، ولا سيما الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق.
ثم إنّ مسلمًا يُعْنَى في "صحيحه" بضبط ألفاظ الرواة، كقوله: «حَدَّثَنَا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَاللَّفْظُ لِفُلاَنٍ قَالَ أَوْ قَالاَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ» (17).
وإذا كان بين الرواة اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنّه حريص على التنبيه عليه ولو لم يتغيّر به المعنى (18) وهذا إن دَلَّ على شيء فعلى ضبطه وأمانته.
وفي كلّ من "الصحيحين" نجد الإشارة إلى «حَدَّثَنَا» بهذه العبارة «ثَنَا» وإلى «أَخْبَرَنَا» بهذه العبارة «أَنَا» وهما اصطلاحان يُرَادُ بهما الاختصار.
ويكثر في "صحيح مسلم" خاصّة حرف حاء (ح) يرمز إلى التحوّل من إسناد إلى إسناد، وذلك إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر، فعلى القارئ إذا انتهى إليها أن يقول (ح) ثم يستمر في قراءة ما بعدها (19).
والبخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فلقد فاتهما عدد قليل من الأحاديث اعترفا بصحتها مع أنّها لم تَرِدْ في كتابيهما، وإنّما وردت في كتب "السنن الأربعة" أو سواهما من الكتب المشهود لها بالصحّة (20).
أمّا "موطأ الإمام مالك" (21) فإنّه يلي "الصحيحين" في الرتبة، على الرأي القائل بأنّه سادس "الكتب الستّة"، ولم يعدّ في الكتب الصحاح على رأي الذين يجعلون الأصل السادس "سنن ابن ماجه"، وتعليل ذلك لديهم أنّ فيه كثيرًا من المراسيل من ناحية، وكثيرًا من الآراء الفقهيّة من ناحية ثانية، فهو إلى كتب الفقه أقرب (22).
ب - والجوامع من كتب الحديث تشتمل على جميع أبواب الحديث التي اصطلحوا على أنّها ثمانية: باب العقائد، باب الأحكام، باب الرقاق، باب آداب الطعام والشراب، باب التفسير والتاريخ والسير، باب السفر والقيام والقعود (ويُسَمَّى باب الشمائل أيضًا)، باب الفتن، وأخيرًا باب المناقب والمثالب (23).
فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الثمانية يُسَمَّى جامعًا؛ كـ "جامع البخاري" و"جامع الترمذي".
ج - المسانيد: جمع مسند، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة حسب السوابق الإسلامية (24)، أو تبعًا للأنساب (25).
ومنها "مسند أبي داود الطيالسي المُتَوَفَّى سَنَةَ 204، وهو كما ذكرنا سابقًا أوّل من ألّف في المسانيد، ومنها "مسند بقي بن مخلد" المُتَوَفَّى سَنَةَ 296 (26)، ويسمّى "مسنده" أيضًا "مُصَنَّفًا"؛ لأنّه صنّف فيه حديث كلّ صاحب على أبواب الفقه.
وأوفى تلك المسانيد وأوسعها "مسند أحمد بن حنبل" (27) وفي هذا المسند (28) أحاديث صحيحة كثيرة لم تخرج في "الكتب الستّة ".
وقد قال أحمد بن حنبل في "مسنده" هذا: «هَذَا الكِتَابُ جَمَعْتُهُ وَانْتَقَيْتُهُ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا فَمَا اخْتَلَفَ المُسْلِمُونَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - فَارْجِعُوا إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ» (29).
وقد عقّب الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: «هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى غَالِبِ الأَمْرِ وَإِلّا فَلَنَا أَحَادِيثَ قَوِيَّةٌ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" و"السُّنَنِ" والأَجْزَاءِ مَا هِيَ فِي "المُسْنَدِ"» وسنرى في بحث «الموضوع وأسباب الوضع»، أنّ للحافظ ابن حجر رسالة سّماها " القول المسدد في الذبّ عن مسند الإمام أحمد" رَدَّ فيها أقوال الزاعمين أنّ في "المسند" موضوعات، وقد فصّل ابن تيمية في هذه القضيّة فصلاً حكيمًا إذ نفى في كتابه "التوسّل والوسيلة" وجود الموضوع في "مسند أحمد" إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كَذَّابٌ، «أمّا إذا كان المراد ما لم يقله النبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -، لغلط راويه وسوء حفظه، ففي "المسند" و"السنن" من ذلك كثير».
د - والمعاجم جمع معجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل، مرتّبة على حروف المعجم (30).
وأشهر المعاجم " معجم الطبراني الكبير"، و"المتوسّط"، و"الصغير".
هـ - والمستدركات جمع مستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه. وأشهرها "مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين"، وقد لَخَّصَهُ الذهبي(31)، غير أنّ الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتِهَا عندهما (32) على أنّ الضرر في " مستدرك الحاكم " أنّه
كان يظنّ ما ليس بصحيح صحيحًا؛ لأنّه يحاول تخريج بعض الأحاديث على شرط الشيخين، وإن كان في كثير من استدراكاته مقال (33).
وـ والمستخرجات، وموضوع المستخرج - كما قال العراقي: «أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ إِلَى الْكِتَابِ فَيُخَرِّجَ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الكِتَابِ، فَيَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ» (34).
من ذلك "مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على البخاري"، و"مستخرج أبي عوانة على مسلم"، و "مستخرج أبي علي الطوسي على الترمذي "، و" مستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على سُنن أبي داود ". قال ابن كثير في " مختصر علوم الحديث " في هذا السياق: «وَكُتُبٌ أُخَرُ الْتَزَمَ أَصْحَابُهَا صِحَّتَهَا كَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيَّ. وَهُمَا خَيْرٌ مِنَ "المُسْتَدْرَكِ" بِكَثِيرٍ وَأَنْظَفُ أَسَانِيدَ وَمُتُونًا» (35).
ز - الأجزاء، والجزء عندهم تأليف الأحاديث المرويّة عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، كجزء أبي بكر، أو الأحاديث المتعلّقة بمطلب من المطالب، كـ "جزء قيام الليل" للمروزي، و"جزء صلاة الضحى" للسيوطي، ومنه الفوائد الحديثيّة كالوحدانيّات والثنائيّات إلى العشاريّات. ومنه كتاب "الوحدان" للإمام مسلم (36).
وكلّ من علم شروط العمل بالحديث، وكان أهلاً لتحمّله وأدائه، جاز له أن ينقل الحديث من الكتب الصحيحة المشهورة، وأن يرويه ويذيع معناه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "خصائص المسند" لأبي موسى المديني. انظر "المسند"، طبعة أحمد شاكر، المقدمة: 1/ 21.
(2) يقول العَلاَّمَةُ أحمد شاكر في "المسند": «هُوَ عَلَى اليَقِينِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِينَ أَلْفًا، وَقَدْ لاَ يَبْلُغُ الأَرْبَعِينَ أَلْفًا. وَسَيَتَبَيَّنُ عَدَدُهُ عِنْدَ تَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ»: 1/ 23. ولكن مَنِيَّتَهُ عاجلته قبل أن يُتِمَّهُ.
(3) وقد صَرَّحَ السيوطي بذلك فقال: «سَمَّيْتُهُ "جَمْعَ الجَوَامِعِ"، وَقَصَدْتُ فِيهِ جَمْعَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ بِأَسْرِهَا». ويعلّق المَنَاوِي على هذه العبارة فيقول: «وَهَذَا حَسْبَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ المُصَنِّفُ، لاَ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ».
(4) قارن بـ"حجّة الله البالغة" للشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي: ص 105 وما بعدها. القاهرة، المطبعة الخيريّة، سَنَةَ 1322 هـ.
(5) "الرسالة المستطرفة": ص 10، 11.
(6) البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وَيُكَنَّى أبا عبد الله. أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من عمره، فكتب عن أكثر من ألف شيخ، وحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف غير صحيح، وكتابه "الجامع الصحيح" هو أصحّ الكتب بعد القرآن المجيد، سمعه من أكثر من سبعين ألفًا، وظلّ يشتغل في جمعه ستّ عشرة سَنَةً. ولـ"صحيح البخاري "شروح كثيرة ذكر منها صاحب "كشف الظنون" اثنين وثمانين شرحًا، ولكن أفضلها شرح ابن حجر المُسَمَّى "فتح الباري".
ومن مُصَنَّفَاتِ البخاري التواريخ الثلاثة: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير" و"كتاب الكُنَى"، و"كتاب الوحدان"، وكتاب "الأدب المفرد"، و"كتاب الضعفاء".
تُوُفِّيَ البخاري سَنَةَ 256 هـ في قرية من قُرَى سَمَرْقَنْدْ تُسَمَّى «خَرْتَنْكْ».
(7) هو مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريّ، وبنو قشير قبيلة عربيّة معروفة، النيسابوريّ، وكنيته أبو الحسن، أجمع العلماء على إمامته في الحديث، وقد رحل كثيرًا في طلبه. ولمسلم كُتُبٌ كثيرة منها "صحيحه" المشهور، وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدّثين"، وكتاب "من ليس له إلّا راوٍ واحد"، وكتاب "طبقات التابعين"، وكتاب "المخضرمين"، وكتاب "المسند الكبير" على أسماء الرجال. وقد توفّي بنيسابور سَنَةَ 261 هـ، عن خمس وخمسين سَنَةٍ.
(8) وكتب الصحاح غير "الكتب الستّة" - كما ذكر السيوطي في خطبة كتابه "جمع الجوامع" - هي "صحيح ابن خزيمة" أبي بكر محمد بن إسحاق المُتَوَفَّى سَنَةَ 311 هـ، و"صحيح أبي عوانة "يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايينيّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 316 هـ، و"صحيح ابن حبّان "محمد بن حبّان البُسْتِي المُتَوَفَّى سَنَةَ 354 هـ، و"الصحاح المختارة" للضياء المقدسي: محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المُتَوَفَّى سَنَةَ 634 هـ، وقارن بـ" الرسالة المستطرفة ": ص 16 - 21.
(9) قيل: إنّها لا تزيد عن أربعة عشر موضعًا، يعلّق فيها سند الحديث فيقول: «مُسْلِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -». وقد سَرَدَهَا الحافظ العراقي في "شرحه لمقدّمة ابن الصلاح". (انظر ص 20، 21) طبعة حلب سَنَةَ 1350 هـ.
(10) هو أحد أئمّة الحديث المتقنين، الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث، الأزدي، السجستاني، اقتصر في "سننه" على أحاديث الأحكام. وله ملاحظات قَيِّمَةٌ على الرُوَّاةِ والأحاديث، تُوُفِّيَ سَنَةَ 275 هـ.
(11) هو الحافظ أبو عبد الله، محمد بن القزويني، المعروف بابن ماجه (بهاء ساكنة وصلاً ووقفًا؛ لأنّه اسم أعجمي)، وهو لقب أبيه لا جَدِّهِ. وأوّل من أضاف "سُنَنَهُ" مكمّلاً به الأصول الستّة أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في "أطراف الكتب الستّة" له وقد تُوُفِّيَ ابن ماجه سَنَةَ 275 هـ على الأشهر.
(12) هو الحافظ أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، نسبة إلى نَسَاءَ بلدة مشهورة بخراسان. و"سننه" أقلّ السنن حديثًا ضعيفًا بعد "الصحيحين". وقد جَرَّدَ الصحاح من "سننه الكبرى" فصنع منها كتابًا سَمَّاهُ "المُجْتَبَى" وهو المعدود من الأمّهات الكبرى، وأحد "الكتب الستّة" عند الإطلاق. وقد تُوُفِّيَ النسائي سَنَةَ 303 هـ.
(13) "اختصار علوم الحديث": ص 22. غير أنّ أبا علي النيسابوري، شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب يُرَجِّحُونَ "صحيح مسلم" على "صحيح البخاري". الكتابان بإجماع علماء المسلمين أصحّ كتب الحديث قاطبة.
(14) "فتح الباري": 1/ 470 - 478.
(15) "اختصار علوم الحديث": ص 25.
(16) "شرح صحيح مسلم" للنووي: 1/ 151.
(17) مثاله: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ القَطَّانُ...»، كتاب البيوع، بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ: 5/ 26.
(18) مثاله: «حَدَّثَنَا [عُبَيْدُ اللهِ] بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الأَزْدِيُّ، وَيُقَالُ المَرَاغِيُّ، وَالمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الأَزْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ...». "صحيح مسلم"، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةَ، بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: 2/ 104.
(19) انظر دلالة حاء التحويل: "علوم الحديث": ص 182، 183.
(20) "اختصار علوم الحديث": ص 23، 24.
(21) سبقت ترجمته: ص 91 ح 4.
(22) "الباعث الحثيث": ص 31، 32.
(23) قارن "التوضيح": 2/ 15 بـ " المستطرفة ": ص 32. وهذه الأبواب الثمانية قبل أن تضمّ بين دَفَّتَيْ «جامع» واحد يجمعها، كان كلّ منها موضوعًا لكتاب قائم برأسه. ففي العقائد "كتاب التوحيد" لابن خزيمة، وفي الأحكام "كتب السنن الأربعة " التي سبقت الإشارة إليها، لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الرقاق كتاب "الزهد" للإمام أحمد بن حنبل. وفي الآداب كتاب "الأدب المفرد" للبخاري. وفي التفسير كتاب ابن مردويه وابن جرير، وفي السفر والقيام كتاب "الشمائل "للترمذي، وفي الفتن كتاب لنعيم بن حمّاد، وراجع ما ذكره عن «الجوامع» 2/ 15 في "التوضيح".
(24) قال الخطيب: «وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي تَخْرِيجِ الْمُسْنَدِ فَيَبْدَأُ بِالْعَشَرَةِ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بِالْمُقَدَّمِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ» [الجامع لأخلاق الراوي]: 10/ 190 وجه 1.
(25) وحينئذٍ يبدأ ببني هاشم الأقرب فالأقرب إلى رَسُولِ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - في النسب. الجامع: 10/ 190 وجه 1.
(26) وانظر في وصف "مسند بقي [بن مخلد]" (نفح الطيب): 1/ 581 و2/ 131.
(27) هو أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، المروزي ثم البغدادي. وكنيته أبو عبد الله، كان آية في الحفظ والضبط، كتبه كثيرة منها "المسند" و"كتاب العلل"، وكتاب "الزهد" وكتاب "فضائل الصحابة". تُوُفِّيَ سَنَةَ 241 هـ.
(28) "مسند ابن حنبل" مطبوع في مصر في ستة مجلدات كبار، وقد تمّ طبعه سَنَةَ 1313 هـ، والعَلاَّمَةُ أحمد محمد شاكر شرع بطبعه بتحقيق مشكور، ولكنَّ مَنِيَّتَهُ أعجلته عن إتمامه فلم ينشر إلّا خمسة عشر مجلدًا.
(29) راجع مقدمة "المسند"، ط. شاكر: ص 21. وكان أحمد بن حنبل شديد الاعتزاز بمسنده؛ لإيمانه بأنّه جمع السُنَّةَ فأوعاها، فكان يقول لابنه عبد الله راوي "المسند" عنه: «احْتَفِظْ بِهَذَا المُسْنِدِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِلْنَّاسِ إِمَامًا».
(30) "الرسالة المستطرفة": ص 101.
(31) وهما مطبوعان في الهند.
(32) "اختصار علوم الحديث": ص 26.
(33) "تدريب الراوي": ص 100.
(34) "التدريب": ص 33.
(35) "اختصار علوم الحديث": ص 27.
(36) "الرسالة المستطرفة": ص 64، 65.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













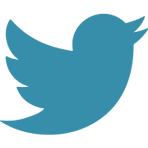

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)