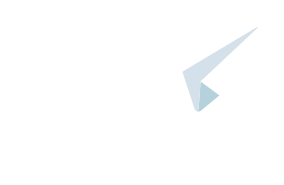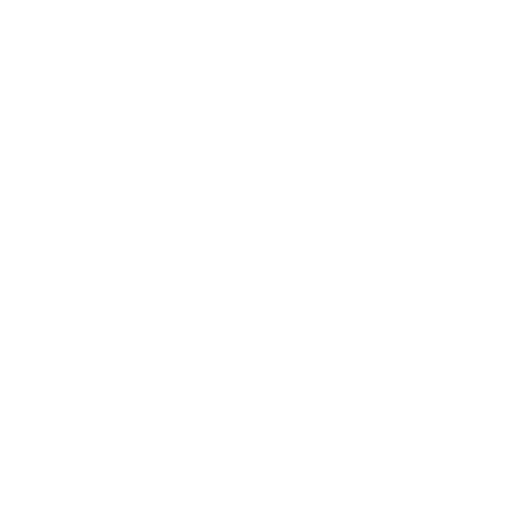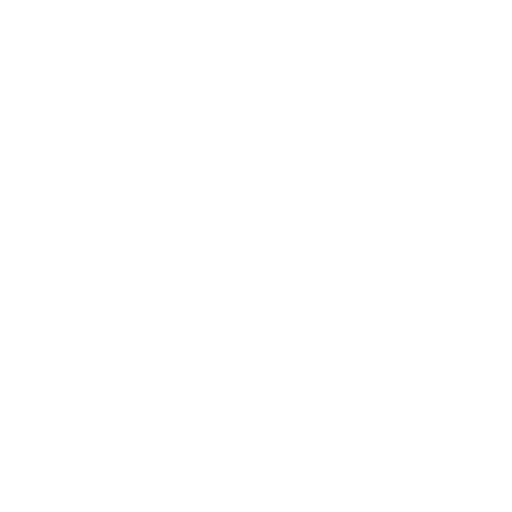القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز الاستنباط القضائي من الاجتهاد القضائي
المؤلف:
طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
المصدر:
الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص 19-23
2024-03-30
1950
أطلق مصطلح الاجتهاد القضائي على أكثر من صورة من صور العمل القضائي ، فهناك من يذهب قي تعريفه بالقول: (بذل قاضي محكمة الموضوع وسعه لإصدار الحكم القضائي في الدعوى المنظورة من قبله عند فقدان النص أو غموضه) (1) ، أي هذه الصورة تكون في حالة الفراغ التشريعي أو النقص القانوني ، فحينئذ يجتهد القاضي في ضوء قواعد العدالة ، ويستخرج الحل والحكم منها ، أو عندما يبذل جهده في تفسير النص إذا كان غامضا ، وهناك من يضيف على التعريف المتقدم، ما يبذله القاضي من جهد إذا كان النص غير كاف للفصل في القضية) (2).
وأطلق ايضا الاجتهاد القضائي على عملية تكييف القاضي للدعوى أيضاً ، فلو اشترى شخص من آخر بضاعة بثمن باهض مؤجل ثم باعها له بثمن بخس معجل ، فالقاضي هنا يجتهد لمعرفة حقيقة هذه الواقعة فيُكيفها ويعطيها وصفا واقعيا بأنها عقد قرض ربوي فاحش وليس بيع ، فهذه العملية المنطقية التي يريد بها القاضي ربط واقعة الدعوى بالقاعدة المنطبقة عليها والمسماة بالتكييف، تعتبر مصداق من مصاديق الاجتهاد القضائي(3).
وتُعد ممارسة القاضي لسلطته التقديرية صورة من صور هذا الاجتهاد أيضاً ، فلو عدّل القاضي نطاق الدعوى سعة أو ضيقا ، أو ارتأى توجيه اليمين المتممة ، أو ارتأى ضرورة استدعاء الشهود ونحو ذلك ، فهذا النشاط الذهني والنظر العقلي للقاضي، وهو قوام السلطة التقديرية ، يُعدُّ اجتهادا قضائيا في الدعوى(4).
ولكن الصورة التي يُستعمل فيها مصطلح الاجتهاد القضائي التي تكاد تكون هي المورد الذي ينصرف إليه الذهن عند أطلاقه هي استعماله للدلالة على ما تستقر عليه المحاكم العليا كالتمييز والنقض من مبادئ قضائية في حالة الفراغ التشريعي والنقص القانوني(5).
وبناءً على ما تقدم فان لاصطلاح الاجتهاد القضائي معنيّن معنى ضيق خاص وهو ينصرف إلى ما ذكرناه أعلاه أي ما تستقر عليه المحاكم العليا من مبادئ ، ومعنى واسع يندرج تحته عدة صور ومصاديق متعدّدة كما تقدم .
واستعمل مصطلح الاجتهاد ، في مصادر التشريع الاسلامي ، من دون وصفه بالقضائي ، على أكثر من مصداق أيضاً ، فذهب بعضهم إلى أنه يُرادف الرأي أي ما يجتهد فيه القاضي عند فقدانه النص برجوعه إلى المصادر التبعية كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وإن كان هناك من قصره على القياس فقط فلديهم الاجتهاد هو القياس ، ولذا عرفوه بقولهم : بذل الوسع في طلب الغرض وهو على ثلاثة اضرب تحقيق المناط ، وتنقيح المناط ، وتخريج (المناط وهذه الثلاثة تندرج تحت القياس(6).
وهذا الاجتهاد بالرأي أو بالقياس يكون مصدرا لاستخراج الحكم عند مواجهة مسألة جديدة ، وهذا ما يسميه بعضهم بالاجتهاد الأنشائي ، ولكن قد يبذل الفقيه جهده لمعرفة الحكم الشرعي برجوعه إلى ما ادلى به الفقهاء السابقون فيرجح راياً على رأي آخر وينتقي أحد الأحكام الشرعية الراجحة ، وهذا ما اطلقوا عليه الاجتهاد الأنتقائي ، ومن هذا القبيل ، أعني ما ليس فيه استخراج للحكم ، الاجتهاد المقاصدي الذي فيه يستفرغ الفقيه وسعه من أجل الكشف عن المقاصد العامة التي تتضمنها النصوص وبذلك تراعى المعاني والحكم الملحوظة للشارع من أحكامه (7).
فالاجتهاد قد يكون استنباطي وقد يكون غير استنباطي، ومن أهم أنواع هذا الاجتهاد الثاني هو الاجتهاد الخاص بتطبيق الأحكام (8) الذي يُعرف بالاجتهاد التنزيلي، وهو يعني كيفية تطبيق الحكم وتنزيله على الواقع (9) لتحقيق الثمرة المرجوة من استنباطه أي تطبيق الأحكام على الوقائع المشخصة بما يحقق المقصد الشرعي منها .
ومع كل ما تقدم من صور لاستعمال مصطلح الاجتهاد لدى الأصوليين ، إلا أن المورد الذي أكثر استعمالا لهذا المصطلح عندهم هو إطلاقه على تحصيل الحكم من أدلته . وقد عبروا عنه باستفراغ الجهد في الوصول إلى الأحكام الشرعية ، أو استنباط الأحكام من مصادرها المقررة ، أو بذل الطاقة العلمية لاكتشاف الحكم الحقيقي للموضوع المعني به ، أو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط (10)
وهذا الاستنباط تارة يكون فرديا وتارة قد يشترك فيه أكثر من فقيه . وقد ظهر اليوم مصطلح يسمى بالاجتهاد الجماعي، الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المُثارة لاسيما فيما يكون له طابع عام ومحل اهتمام المجتمع ، ويتجسد هذا في اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيأة أو مؤسسة على حكم شرعي بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور أي بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمعين لتحصيل حكم شرعي في مسألة ما (11).
يظهر لنا مما تقدم أن المورد الشائع لمصطلح الاجتهاد لدى الأصوليين أطلاقه على استخراج الحكم من أدلته، ولكن هناك من قصره على حالة فقدان النص، وهناك من ضيقه في دائرة فقدان النص حتى قصره على القياس فقط ، ولكن بمرور الزمن تبين أن مفهوم الاجتهاد قد توسع بإدراج صور متعدّدة تحت هذا العنوان مع إضافة وصف للمصطلح يميز بعضها عن بعضها الآخر، كما تقدم ، ولم يبق منحصرا في الاجتهاد الاستنباطي .
وأما مقارنة مع الاجتهاد القضائي فلم نجد من الأصوليين من استعمل الاجتهاد بالمعنى الخاص للاجتهاد القضائي وهو استقرار المحاكم العليا على مبدأ قضائي معين، بل إنهم لم يستعملوا مصطلح الاجتهاد القضائي وإن كان بعض صور الاجتهاد لديهم تلتقي مع أحد صوره ألا وهي حالة فقدان القاضي للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع المعروض أمامه ، التي يُعبر عنها حالة الفراغ التشريعي أو النقص القانوني، وهم يُعبّرون عنها بحالة فقدان النص .
وأما النسبة بين الاستنباط القضائي والاجتهاد القضائي ، حسبما ما استعرضناه آنفا، فتارة يكون الأول أعم والثاني أخص أو بالعكس ، فإذا لاحظنا الاجتهاد القضائي بمعناه الخاص يكون الاستنباط القضائي أعم منه حينئذ ، على أساس من أن هذا الاجتهاد قد يكون أحد مصادر الاستنباط للحكم القضائي كما سيأتي لاحقا ، وإذا لاحظنا الاجتهاد القضائي بمعناه الواسع فيكون الاستنباط حينئذ جزءاً من جزئيات الاجتهاد . وأما لدى الأصوليين فإن الاجتهاد بالمعنى الشائع لديهم يُرادف الاستنباط القضائي للأحكام ، أما الاستعمالات الأخرى فبعضاها تفترق عن هذا الاستنباط إذا كان في الأحكام ؛ لأن الاجتهاد فيها يسعى إلى غرض آخر غير تحصيل الحكم ، نحو الوصول إلى المقصد أو التطبيق السليم للحكم على ما رأينا فيما تقدم، وهي بهذا الوصف تكون أقرب إلى هذا الاستنباط إذا كان في الوقائع على أساس من كونه بحثاً أو استقراءاً لأجل استخلاص دلالة معينة ، وهذه الدلالة قد تكون قرينة قضائية لإثبات الدعوى أو قد تكون تشخيصا لمصلحة أو تشخيصا للوجهة السليمة في التطبيق .
وأما في التشريعات ، فقد أستعمل المشرع العراقي مصطلح (الاجتهاد ) مجردا عن صفة قضائي في المادة (2) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 إذ نص على أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) .
إن المصدر التأريخي لهذه المادة مجلة الأحكام العدلية التي ورد هذا النص في المادة (14) منها ، ويُراد بالنص فيها ما يقابل الظاهر ، فهو اللفظ الذي لا يحتمل أكثر من معنى وبخلافه الظاهر . غير أن القواعد التشريعية على الأعم الأغلب هي نصوص ظنية تحتمل أكثر من معنى ، ولذا هي محل للاجتهاد لتشخيص المعنى الراجح من بين المعاني المحتملة ، وهذا يعني أن النصوص التشريعية في الغالب ليست بنص ، بل إن النص منها ، مع ذلك، يفتقر للاجتهاد المعرفة مدى انطباقه على الواقعة موضوع الدعوى (12) وقد رأينا ، كما تقدم ، لدى الأصوليين نوعاً من أنواع الاجتهاد الذي يهتم بتطبيق الأحكام . ولم نجد في القانون المدني المصري رقم 31 لسنة 1948 نظير النص أعلاه ، ومع ذلك يُعمل به بوصفه قاعدة أصولية مُسلم بها في مجال البحث عن دلالات النصوص .
__________
1- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 36 .
2- د حامد شاکر محمود ، العدول في الاجتهاد القضائي ، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص36.
3- الأستاذ ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، معهد البحوث والدراسات العربية ، بغداد، 1984، ص 61. عباس قاسم الداقوقي ، مصدر سابق ، ص 405.
4- عباس قاسم الداقوقي ، المصدر نفسه ، ص487
5- د. حامد شاکر محمود ، مصدر سابق ، ص 36 و ص 50 .
6- تحقيق المناط : أي النظر في احاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على اصل ، والبحث فيما اذا كانت علة الأصل ثابتة ومتحققة في هذه الصور الفرعية ، اما تخريج المناط : هو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الأجماع ليجعل علة الحكم ، فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة ، اما تنقيح المناط : هو بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها اذا ثبت ذلك بنص أو إجماع عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف . د. فرحان أحمد علي ، الاجتهاد التنزيلي، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، المجلد 7 ، السنة 2018 ، ص 4 . الشيخ عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، دار القلم ، الكويت، 1993 ، ص 8 . البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 104. محمد الحسيني ، الدليل الفقهي، ط 1 ، مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية ، 2007 ، ص 102 و ص 124.
7- د. مجدي محمد عبد الرحمن ، الاجتهاد الجزئي وأهميته ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر، العدد الواحد والثلاثون ، المجلد الثاني 2014، ص 108 . محمد الحسيني ، الدليل الفقهي، ط 1 ، مركز ابن إدريس الحلي للدراسات الفقهية ، 2007 ، ص 10.
8- عبد المهدي محمد سعيد ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقها في الاجتهاد القضائي الأردني ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ، 2005 ، ص12.
9- يُراد بالواقع ، الذي يجب أن يُلاحظه القاضي والفقيه عند تطبيق الحكم عليه ، هو الواقع الإنساني أي ما تجري عليه الحياة في مجتمع ما، وأسلوب هذا المجتمع في تحقيق أغراضه ، ويدخل في ذلك مجموع ما تواضع عليه المجتمع من أعراف وتقاليد وعادات ، وما فيه من نظم ، فهذه كلها تجتمع لينشا منها الأسلوب في تحقيق الأغراض . إن التغيير الإصلاحي للواقع الإنساني يُعد هدفاً أساسياً للشريعة والقانون، فالأحكام الشرعية والقواعد القانونية ، ما جاءت لأجل التراكم المعرفي فحسب ، وما شرعت إلا لتكون نظاما ملزما يحكم مختلف جوانب الحياة ، ومنهجا عمليا لسلوك الأفراد ، ولذلك فإن معرفة الواقع الإنساني بعناصره ومكوناته يُعد أمراً ضروريا وعنصرا أساسيا في عملية تطبيق الأحكام الواقع الإنساني تشترك في تكوينه ثلاثة عناصر هي الإنسان والمكان والزمان ، ذلك أن أي واقعة تتكون من ثلاثة أركان الفاعل ومحل الفعل وزمن الفعل . أما الأول فإن الناس يختلفون في طباعهم وظرفهم، فلابد للقاضي والفقيه أن يكون على معرفة وتصور للمجتمع وأحوال الناس فيه وما هو مستواه المعرفي وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراده ، وعليه بهذا الصدد الاستفادة من معطيات العلوم الإنسانية المعاصرة وما توصلت إليه من نتائج في مجال علم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء .. أما الثاني المكان ، ويُقصد به التجمع السكاني في بقعة محددة ، فلكل تجمع سكاني طابعه الخاص به وله ثقافته وأفكاره وأعرافه ، فإذا كان الحال كذلك فلابد للقاضي والفقيه أن يُراعي عند تطبيق الأحكام ما يناسب ظروف وأحوال كل بلد ، ونوع الأزمات والمشاكل التي يعاني منها . أما العنصر الثالث الزمان ، هو عنصر التجدد والتغير والتطور، فالحياة الإنسانية كلما تقادم الزمن تتبدل وتتطور، صحيح أن هناك ثوابت ولكن هناك كذلك متغيرات ومستجدات ومستحدثات ، فالزمان هو الوعاء الذي يحوي هذا التجدد والتطور للحياة الإنسانية ، وكثير من موضوعات الأحكام تتبدل وتختلف من زمن إلى آخر، فالقاضي والفقيه لابد أن يدرك ظروف عصره وما تغير فيه وتطور، وما استجد في حياتهم من أعراف وعادات ، وما طرأ في واقعهم من مشاكل وأزمات ، ليتمكن من تحقيق مقاصد الشريعة والحكمة التشريعية للقوانين انظر: د. فرحان أحمد علي ، الاجتهاد التنزيلي، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، المجلد 7 ، السنة 2018 ، ص 16-21.
10- د. مصطفى إبراهيم الزلمي معين القضاة لتحقيق العدل والمساواة ، ط 11 ، احسان للنشر والتوزيع، بلا مكان نشر 2014، ص179. نضال داود عليوان، أسباب تغير الاجتهاد، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ، المجلد ،16، العدد 1 ، 2019، ص 529. د. مجدي محمد عبد الرحمن ، الاجتهاد الجزئي وأهميته ، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر، العدد الواحد والثلاثون ، المجلد الثاني 2014 ، ص108. د. فرحان أحمد علي ، الاجتهاد التنزيلي، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، المجلد 7 ، السنة 2018 ، ص2.
11- د. سعيد محي الدين سعيد ، الاجتهاد الجماعي وأهميته في الفقه الإسلامي ، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الصادرة من دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني ، الإصدار 36، 2014، ص 134 - 136.
12- الشيخ فاضل الصفار، المهذب في اصول الفقه ، ط ا ، مؤسسة الفكر الاسلامي ، لبنان، 2010، ص 160-161 د. مصطفى ابراهيم الزلمي، اصول الفقه في نسيجه الجديد ، ج 1، شركة الخنساء ، بغداد ، بلا سنة نشر، ص 336 . عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 103. د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص 63.
 الاكثر قراءة في قانون المرافعات
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية













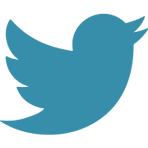

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)