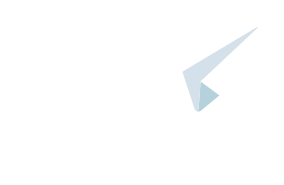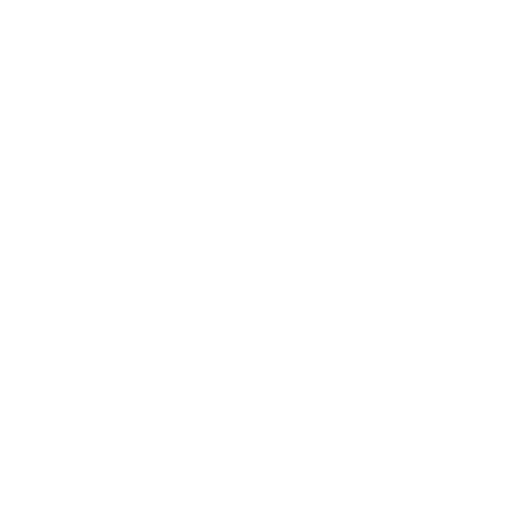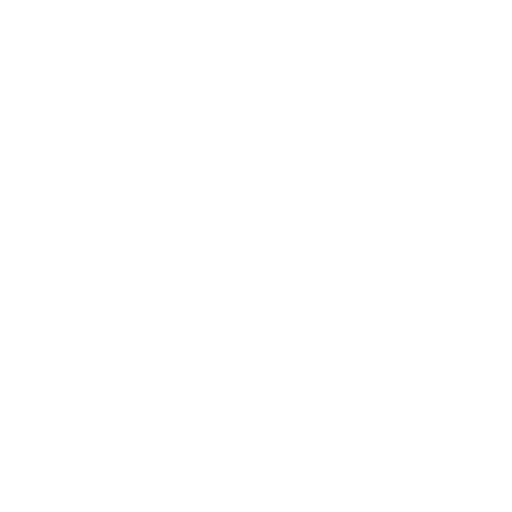الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
بحث روائي _ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ..
المؤلف:
السيد عبد الاعلى السبزواري
المصدر:
الاخلاق في القران الكريم
الجزء والصفحة:
362- 385
15-7-2021
4495
{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفعوا من شيء فإن الله به عليم * كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران: 92 - 95]
في الكافي وتفسير العياشي : عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى :
{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران : 92]، قال (عليه السلام) : " هكذا فاقرأها ".
اقول : هذه قراءة أهل البيت ، والفرق بينها وبين قراءة المشهور أن الأولى تبين مصداق المحبوب عند المنفق ، والثانية تبين فردا من كل محبوب ، فيشمل المصداق أيضا.
وفي المجمع : عن ابن عمر قال : " سئل النبي (صلى الله عليه واله) عن هذه الآية :
{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران : 92] هو أن ينفق العبد المال وهو شحيح ، يأمل الدنيا ويرجو الغنى ويخاف الفقر ".
أقول : وردت ورايات كثيرة عن أهل البيت (عليه السلام) في ذلك، وإنما عند (صلى الله عليه واله) هذه الجهات لأن كل واحدة منها من الأمور التي تورث محبة الشيء ، فإذا اجتمعت وأنفق المال معها كان جزاؤه أعظم ونيله للبر أكثر.
وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران : 93] ، قال : " إن يعقوب كان يصيبه عرق النسا فحرم على نفسه لحم الجمل ، فقال اليهود : إن لحم الجمل محرم في التوراة ، فقال عز وجل لهم : {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] إنما حزم إسرائيل على نفسه ولم يحزمه على الناس ، وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبر ".
أقول : ذكرنا سابقاً المحتملات في الآيات الشريفة وهذا من أحدها.
وفي الكافي وتفسير العياشي : عن الصادق (عليه السلام) : " إن إسرائيل كان إذا أكل لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم الإبل ، وذلك قبل أن تنزل التوراة ، فلما نزلت التوراة لم يحزمه ولم يأكله ".
اقول : لا منافاة بين وجع الخاصرة الذي ورد في الحديث وعرق النسا الذي ورد في الحديث السابق ، لإمكان اجتماعهما، ويظهر منه أن التحريم لم يكن تحريماً شرعيا ، بل كان تتزيهاً لأجل ذلك العارض.
ومعنى قوله (عليه السلام) : " لم يحرمه ولم يأكله " ، أي لم يحزمه إسرائيل بعنوان التشريع السماوي ، ولكنه لم يأكله خيفة من عروض ذلك العارض عليه . ويحتمل أن يرجع الضمير فيهما إلى موسى (عليه السلام) المدلول عليه بقوله تعالى : { فأتوا بالتوراة }.
وفي أسباب النزول للواحدي : في قوله تعالى : { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} ، قال أبو روق والكلبي : نزلت حين قال النبي (صلى الله عليه واله) : " أنا على ملة إبراهيم ، فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟! فقال النبي (صلى الله عليه واله) : كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله ، فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحزمه فإن كان محزماً على نوح لإبراهيم حتى انتهى إلينا ، فأنزل الله عز وجل تكذيباً لهم : { كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه}.
أقول : على فرض اعتبار الرواية ، فإن ما ورد فيها يكون من جملة الاحتمالات التي ذكرناها سابقا ، وتقدم أن مقالة اليهود كذب وافتراء.
كمال النفس البشرية
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ *وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ } [آل عمران: 102 - 108]
هذه الايات من جلائل الايات الكريمة التي وردت في تكميل النفوس الانسانية وتنظيم نظام الدنيا والاخرة بالنحو الاحسن الاكمل الذي تعترف به جميع العقول وتقبله الفطرة المستقيمة ، وهي مرتبطة بالآيات السابقة ، فإنه تعالى بعدما حذر المؤمنين من مكائد الكافرين وفتن اهل الكتاب وإضلالهم ، أمرهم بالاعتصام بحبل الله جلت عظمته ، ليهديهم إلى الصراط المستقيم ويوفقهم للدين القويم ويحفظهم من المهالك.
ويبين سبحانه في هذه الايات المباركة الصلة به تعالى ، تلك التي يحبها كل قلب مؤمن ، وهي التقوى لأنها من سبل الاعتصام بالله ، بل من أهمها ، فكل ما اقترب العبد من الله بتقواه اشتاق إلى مقام أرفع منا بلغ إليه.
وقد دعا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الشريفة أيضا إلى الاعتصام بحبل الله ، من الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهي كلها من سبل الاعتصام به.
ثم أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق ونهاهم عن الاختلاف ، ووعدهم الحسنى والخير إن هم قاموا بالوظيفة التي أمرهم بها.
فهذه الآيات المباركة تعتبر تتمة الآيات السابقة ، فإن السياق في الطائفتين واحد.
التفسير
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران : 102]
تقدم ما يتعلق بهذا الخطاب في أول سورة البقرة وغيره من الآيات الشريفة ، وفي تكراره لا يخفى من اللطف بالمؤمنين والتشريف لهم ، لا سيما بعد خطاب : {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البقرة : 101].
والتقوى كما تقدم مكرراً هي الطاعة لله تعالى والاحتراز عن الوقوع في ما يوجب سخطه وعذابه ، ويلزم ذلك الشكر لنعمه ، وإنما أمرهم بالتقوى لأنها جوهرة الكمالات الإنسانية ومفتاح السعادة وأساس مكارم الأخلاق ، وبها يفوز العبد بالقرب إلى الله تعالى والبعد عن النار ، وهي تحفظ إيمان المؤمن وتزيده قوة وثباتا.
هذا ، ولكن التقوى على نحوين ، تقوى ظاهرية خالية عن الخلوص والإخلاص ، وباطنية حقيقة مشتملة عليهما ، وهي التي لا يشويها باطل ولا فساد ، وهي ذكر المنعم بلا نسيان وطاعته بلا عصيان. وبالجملة ، فهي العبودية المحضة التي لا كمال بعدها ، وهذا النحو من التقوى هو حق في نفسه. وحق الله تعالى ، وهي التي تليق باحته تبارك وتعالى دون غيرها.
وقد ورد مثل هذا التعبير في ستة مواضع من القرآن الكريم ، قال تعالى : {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة : 121] ، وقال تعالى : {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } [الحج : 78] ، وقال تعالى : {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27] ، وقال تعالى : {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] ، ومثله في سورة الحج ، الآية 74 وسورة المزر ، الآية 67 ، والمستفاد من هذا التعبير هو الأمر بالحقيقة الخالصة من شوائب الأوهام ، وتدل تلك الجملات على كمال الأهمية بالمورد ، حتى أنه تعالى نفى الحقبة عن غيره كما هو المستفاد من النفي والإثبات ، وعرفان الحق لا يحتاج إلى البيان. فإنه نفس واقع الشيء على ما هو عليه في ذاته.
ويحتمل أن يكون المراد في قوله تعالى : " حق تقاته " ، آخر مراتب التقوى وأعلاه درجاتها التي من صفات الأنبياء والأولياء ، وهي حقيقة التقوى التي أوحاها عز وجل إلى أنبيائه ، وبشرت بها رسله ؛ وغيرها خارج عن تلك الحقيقة وليست شيئاً زائداً عليها.
نعم، الاشتداد والتضعف الجاريان في كل مقولة يجريان في هذ الحقيقة أيضا ، ولكن الآية المباركة ليست ناظرة إلى هذه الجهة ، كما أنها ليست منسوخة ولا ناسخة ، فيكون تعميم الخطاب في صدر الآية لجميع المؤمنين تشريفاً لهم شيئا وطلب حق التقوى شيئا آخر ، وطلب الموت على الإسلام في ذيل الآية الشريفة شيئا ثالثا ، فيصير صدر الآية وذيلها شاهدين على أن ليس المراد بالتقوى هنا خصوص تقوى الأنبياء والأولياء فقط ، بل هي عامة تشمل الآية جميع المراتب كل على حسب ما يقدر عليه.
ويحتمل التنزيل على مراتب القدرة والاستطاعة ، بل هي ظاهر الآية الشريفة ، فالصحيح يصلي قائماً مثلا والمريض جالسا ، وهكذا كل على قدر استطاعته. وعلى هذا ، فيكون قوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16] ، شارحا لهذه الاية الشريفة.
ومحصل معنى الآيتين : أن مراتب التقوى ، كمراتب أصل التكليف ، كما أن الأخير لا يتعلق إلا بالمستطاع وينحل إلى مراتب كثيرة ، وكذلك التقوى فكن مؤمن لا بد أن يحظى بالتقوى على قدر استطاعته وطاعته.
كما أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16]، الترغيب إلى إتيان المندوبات ، والتنزه عن إتيان المكروهات ، لأن الأولى من شؤون الواجبات والثانية من شؤون المحرمات، وكل ذلك من حمى الله تعالى كما في بعض الروايات. وعليه فلا ربط لها لهذه الآية الشريفة.
قال تعالى : {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران : 102].
تحريض على مداومة التقوى بعد الأمر بتحصيل حقيقتها والخلوص فيها. فيكون المراد من الإسلام في الآية هو الإسلام الحقيقي الاستمراري حتى الانتقال إلى النشأة الاخرى ووقوع الموت، الذي هو أمر غيبي في حال الإسلام والتسليم.
وعلى هذا ، لا وجه للتفصيل يكون الطلب في الآية الشريفة متعلقا بأمر تكويني أو بجامع من الأمر التكويني والاختياري، فإن ظاهر الآية هو الأمر بتحصيل المداومة على التقوى حتى الموت، وتقدم بعض الكلام في آية 189 من سورة البقرة.
والمراد بالإسلام هو الطاعة لله تعالى وعدم المحادة له بالمعصية ،
وهذه هي التقوى التي أمرنا الله تعالى بها سابقا.
وذكر بعض المفسرين أن المراد بالإسلام هو الإيمان القلبي ، لأن الأعمال حال الموت مما لا تكاد أن تتأتى.
وفيه من التكلف ما لا يخفى ، فما ذكرناه أظهر من الآية الشريفة وأنسب إلى الأمر بالتقوى كما عرفت.
وكيف كان ، ففي الآية المباركة التأكيد على ترك طاعة أهل الكتاب.
قال تعالى : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران : 103]. الاعتصام : هو التمسك والالتجاء ، وتقدم اشتقاق الكلمة في الآية السابقة.
والحبل : معروف ويستعمل في سبب منيع يوصل إلى البغية والحاجة، وفي الدعاء : " يا ذا الحبل الشديد "، والمراد به القرآن أو الدين أو الجب ، كما ورد فى صفة القرآن : " كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض " ، أي نور هداه يكون كذلك ، وفي حديث آخر : " وهو حبل الله المتين".
وقيل : المراد عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب.
وقيل : المراد منه العهد والميثاق.
وقيل غير ذلك، وجميعها من باب التفسير بالمصداق.
والمراد به في المقام ما جعله الله تعالى سبباً عاصما من الوقع في
الضلالة والمهالك ، والمعروف أن في الكلام استعارة تمثيلية ، بأن شبه التمسك بما جعله الله عاصماً من الوقع في المهالك بالتمسك بالحبل المتدلي من مكان رفع وثيق مأمون الانقطاع ، الذي يمنع التمسك من السقوط والهلكة.
وجميعا : حال من فاعل اعتصموا ، أي : مجتمعين ، فيكون قوله تعالى : {ولا تفرقوا} تأكيدا ، والنهي عن التفرق باتباع السبل المختلفة ، فيوجب البعد عن سبيل الله تعالى ، كما قال عز وجل : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام : 153].
واختلف المفسرون في المراد بالحبل في هذه الآية الشريفة.
فقيل : إنه كتاب الله.
وقيل : إنه الإسلام.
وقيل : إنه الطاعة والجماعة.
والحق أن يقال إنه بعد أن بين عز وجل في الآية السابقة أن التمسك بآيات الله تعالى ، وبالرسول اعتصام بالله تعالى مضمون له الهدى ومأمون من الضلال والهلاك، فإن كل واحد منهما يكتل الآخر ويفسره . والرسول كتاب ناطق ، كما أن القرآن رسول صامت ، فيكون التمسك بالرسول (صلى الله عليه واله) تمسكاً بالقرآن ، لا سيما بعد أمر القرآن بذلك، قال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] ، وقد أمرنا سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله في هذه الآية ، فتكون النتيجة أن حبل الله هو الكتاب والرسول ، ولكن بما أن الحكم في الآية السابقة معلق على شخص الرسول الكريم ، باعتباره جامعاً لجميع الكمالات وملتزما للطاعات ومعصوماً من المعاصي والزلات شارحاً للكتاب المبين ومفسرا لرموزه ودقائقه ، فمن يكون مثل الرسول من هذه الجهة يكون من مصاديق حبل الله ، ويدل على ذلك حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين : " إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ". فإن الكتاب والرسول وعترته كلها مشاعر هدايته عز وجل و مصاديق حبل الله ، وأن حقيقة هذا الحبل هي الإنسانية الكاملة ، التي هي في الحقيقة الصراط المستقيم ، وأن الكتب السماوية والأنبياء والمرسلين تدعو إلى الاهتداء إليها ، وهي حقيقة الجنة التي وعد الله عباده بها ، وهي التي توجب مخالفتها النار ، فلهذه الحقيقة صورة كثيرة مختلفة في جميع العوالم والنشآت.
فتارة : يكون موسى بن عمران والتوراة. واخرى : يكون عيسى بن مريم والإنجيل.
وثالثة : يكون حبيب الله محمد بن عبد الله والقرآن الكريم.
ورابعة : يكون عترته الطاهرة، لأنهم شراح القرآن وامتداد لشخص الرسول الكريم كما عرفت، وحينئذ يكون الأمر بالاعتصام بحبل الله أمراً حقيقياً واقعياً تكوينياً، وهو عبارة عن الإضافة بين العلة والمطول، أو المقتضي (بالكسر) مع المقتضى (بالفتح)، أو بين الخالق والمخلوق، فالخطاب من سنخ الخطابات التكوينية التي لا يختص بزمان دون زمان
ولا بقوم دون آخرين.
نعم ، أفضل مصاديقه الإنسان الكامل والإسلام ، لأنهما أفضل الممكنات .
ومن ذلك كله يعرف أنه ليس المراد بالاعتصام القولي منه فقط أو الاعتقادي ، بل الاعتصام العملي والطاعة لله تعالى بكل ما شاء وأراد ، ومثل هذا الاعتصام تحكم بحسنه فطرة العقول ، لأن اعتصام الفقير المطلق بالغني كذلك مما تحكم بلزومه الفطرة ، بل أن الممكن بذاته معتصم لمبداه ، لا سيما بعد أن أثيت المحققون من الفلاسفة أن مناط الحاجة هو الإمكان لا الحدوث ، ولا بد وأن يظهر الإنسان هذا الاعتصام الذاتي في الاعتقاد والقول والعمل ، بأن يطابق ما يصدر عنه لما هو المحبوب لدى المعتصم به.
وإنما أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله على نحو الجمع في قوله : " واعتصموا " ، ثم أكده بقوله تعالى : " جميعاً " ، وثالثة بقوله : " ولا تفرقوا " ، لأن اختلاف الأمة أحزاباً وأشياعاً أضر شيء بالتظامن ويستفاد من أن هذا الحكم لا يتحقق حدوثاً وبقاء إلا على نحو الجمع والاجتماع ، فالاعتصام الفردي من دون الجماعة لا يثبت المطلوب والغرض من هذا الحكم ، فيكون عدم الاجتماع على هذا الحكم من موجبات التفرق والاختلاف والوقوع في المهالك ، فالآية السابقة تتعرض لحكم الفرد من حيث التقوى والموت على الإسلام ، وهذه الآية لحكم الجماعة.
قال تعالى : {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } [البقرة: 231]
دعوى إلى تذكر يعم الله تعالى التي فيها الموعظة والعبرة ، وفيها الحث على الاجتماع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى المؤذي إلى التآلف وزوال الأضغان والنفرة بين أفراد المجتمع.
وفي الآية الشريفة دعوة إلى تعلم العلل والأسباب التي تؤذي إلى خير الإنسان وسعادته ، وتهديه إلى الحق والتوفيق إلى الإيمان الصحيح ونبذ التقليد الأعمى ، الذي لا يجنى منه الخير. وهذا هو الأصل القويم الذي اعتمد عليه القرآن الكريم في تعليم الإنسان وهديه إلى سعادته ، فإنه يأمره بالعلم النافع والعمل الصالح ، ليمكنه معرفة الحقائق وارتباط بعضها مع البعض ، ثم كيفية ارتباطها مع مسبب الأسباب والمبدأ الفياض ورجوعها إلى الله تعالى والامر بالاعتصام بحبله والتسليم لأمره ، فإن في ذلك السعادة الحقيقية وفي غيره الجهل والبعد عن الحقيقة ، وقد نهى عز وجل عن التقليد الأعمى الذي يسلب الإرادة عن الإنسان وينفي عنه التفكر الصحيح، ويشوه الحقائق. وقد أقام سبحانه أدلة ثلاثة على ما حث عليه من التذكر وندب إليه من التفكر ، اثنتان منها تشهد عليهما التجربة ، والثالث مبني على البرهان القطعي.
قال تعالى : { إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ} [آل عمران: 103].
هذا هو الدليل الأول ، وهو تذكر العداوة التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي الفاسد والبغضاء التي كانت قائمة بينهم ، وقد قاسوا مرارتها وكابدوا شدائدها وأهوالها ، فقد كانت الحروب والقتل والدمار والضغائن والأحقاد ملتهبة وبلغت ذروته أبان الدعوة الإسلامية ، فألف عز وجل بين القلوب بالإسلام والرسول الكريم الأمين ؛ فزالت تلك الأحقاد وحل الصلح والوئام وند تألفت قلوبهم ، وهو أكبر دليل على حقيقة الإيمان بالله والاعتصام بحبله وتذكر نعمه فإنه لولا الإسلام لما ذاق الاجتماع حلاوة المحبة والأخوة ، ولما زالت مرارة العداوة والفرقة.
قال تعالى : {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران : 103].
هذا هو الدليل الثاني، والإخوان جمع الأخ. وقيل إن أكثر ما يجمع أخو الصداقة على الإخوان ، والأخ في النسب على الإخوة ، وقد ورد في أخ الصداقة قوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات : 10] ، في النسب قوله تعالى : {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] ، وقوله تعالى : {أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ} [النور: 61].
والمراد بها وقوع التآلف في القلوب ، كعادة الإخوة الأشقاء في كونهم يداً واحدة بقلوب مؤتلفة . وفي تكرار هذه المنة التنبيه على ما ذكرناه والحث على التمتك بحبل الله والاعتصام به وتذكر نعمه التي توصلكم إلى السعادة وتهديكم إلى الرشاد فإن في الأخوة التي منها الله تعالى عليهم الاجتماع والتآلف.
قال تعالى : {وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} [آل عمران : 103].
عطف على كنتم (( أعداء )) ، وهذا هو الدليل الثالث المبني على البرهان، وشفا حفرة أي طرف الحفرة وحافتها ، فإن شفا كل شيء جرفه وحافته. ومنه حديث علي (عليه السلام) : " نازل بشفى جرف هار " أي جانبه ، وفي المأثور : " لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه ، ولكن انظروا إلى ورعه إذا شفى " ، أي أشرف على الدنيا وأقبلت عليه ، ويقال : " أشفى على الهلاك "، أي ورد على شفاه.
وقيل إن كلمة " شفى " لا تستعمل إلا في الشر.
وقد تستعمل في القليل أيضاً ، يقال : " ما بقي منه إلا شفا " ، أي قليل ، ويثنى على شفوين والجمع أشفاء ، ويضاف إلى الأعلى وإلى الأسفل ، وكنتم على شفا حفرة أي مشرفين على السقوط فيها.
والمراد من النار هي التي أوقدوها بأعمالهم ومعتقداتهم التي كانت سبباً للنار الحقيقي وهي نار جهنم ، ونار الدنيا التي هي الحروب والمنازعات ، فإنها استعملت فيها كثيراً في المحاولات الصحيحة، كقوله تعالى : {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ } [المائدة: 64].
وكيف كان ، فالآية الشريفة تبين حالهم في المجتمع الجاهل الفاسد المبني على الضغائن والحروب والمنازعات والتنافر والافتراق ، كما تبين مآلهم الذي يصلون إليه، وهو الدخول في النار في الآخرة وسلب الطمأنينة والأمن ، فقد جلبت لهم الشقاوة والعناء والزوال في الدنيا. وقد أنقذهم الله تعالى من مآلهم الفاسد بالإسلام الذي جلب لهم الطمأنينة والأمن والرفاه والعيش الهنيء والعادة ، وقد شاهدوا بدخولهم في الغسلام ما لم يتخيلوه في الحسبان ، فلذلك كان هذا البرهان أوقع في النفوس من غيره ، لأنه كان به خلاصهم من العذاب في الآخرة والشقاء والحرمان في الدنيا ، وهذا الدليل حاصل مضمون الدليلين المتقدمين المشتملين على الحس والوجدان ، دون محض التقدير ومجرد الحسبان.
قال تعالى : {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران : 103].
أي يبينها برهاناً ووجداناً ومشاهدة ، لأجل اهتدائكم إلى حقيقة الإيمان والاعتصام بحبل الله المبين ، وتدخلون في الصراط المستقيم وتتذكرون نعمه التي أنعمها الله تعالى على المسلمين.
قال تعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران : 104].
أمر سبحانه وتعالى بتكميل الغير بعدما أمرهم بتكميل أنفسهم ، حيث إن الاعتصام بحبل الله تعالى المادة المهيأة لتوارد الصور الكمالية عليها . ومن المعلوم أن المادة لا فعلية لها إلا بالصورة ، كما هو ثابت في الفلسفة الإلهية ، فلا بد من المعي في تحصيل تلك الصورة ، وهي الدعوة إلى الخير ، سواء كان من النبي أم الوصي أو من يقوم مقامهما في هذا الشأن.
وإنما تكون الدعوة إلى الخير بمنزلة الصورة الفعلية للاعتصام بالله تعالى ، والدعوة إلى الخير هي من أهم الأسباب التي تكون دخيلة في رقي الأمة وتقدمها في كل المجالات ، فهي تحفظ العلم عن الضياع والعمل عن الفساد ، والمجتمع عن الانهيار في مهلكة الشرور ، فهي جامعة العادة ومانعة الشقاوة ، وأن القوانين المجعولة - خالفية كانت أم خلقية - إنما يترتب الأثر عليها من حيث البقاء ومداومة العمل بها ، لا بمجرد حدوثها فقط ، وأن البقاء يتقوم بأمرين :
الأول : العمل بها بشرائطها المقررة .
الثاني : الترغيب إلى فعلها والترهيب عن تركها ، وبعبارة أخرى أن القوة المجرية لها في . مقام حفظ القانون هي الدعوة ، ويعبر عنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا كانت لهما المنزلة العظيمة في الشرائع السماوية ، بل في القوانين المجعولة ، ولولاهما لاختل النظام وتعطلت الأحكام، ولأنبياء الله العظام وأوصيائهم الكرام الزعامة الكبرى في التمذي لهذين التكليفين العظيمين.
والمراد من الخير كل ما له دخل في الاعتصام بحبل الله ، سواء كان من المعارف الحقة أم الأعمال الصالحة أو مكارم الأخلاق ، وما ذكره عز وجل في المقام ترغيباً إلى الخير الذي تدعو إليه فطرة العقول ويحبه كل إنسان ، ولا يمكن أن يجهله أحد ، ولبيان أن المجتمع الذي يكون الخير هو مطلبهم ومنهاجهم وعملهم هو المجتمع السعيد والأمة الراقية.
وقد اختلف المفسرون في معنى الخير في المقام ، فقيل : إنه الإسلام.
وقيل : إنه اتباع القرآن وسنة الرسول ، وقيل غير ذلك.
والحق أن ما ذكروه من مصاديق مطلق الخير ، والصحيح ما ذكرناه ، فإن جميع ذلك دواع إلى الاعتصام بحبل الله تعالى.
والأمة : الجماعة التي تؤم أمرا معيناً ، وقد أطلقت في القرآن الكريم كثيراً على اتباع الأنبياء لأنهم اجتمعوا على قصد واحد، وهو اتباع الحق وراء قدوة شخص معين ، وتطلق أيضاً على الدين والملة ، قال تعالى : {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } [الزخرف: 22] ، وعلى السنين ، قال تعالى : { وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} [يوسف: 45] ، والجميع يرجع إلى معنى واحد ، وقد تقدم في قوله تعالى : {وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً} [البقرة: 128] ، وكذا في قوله تعالى : {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ} [البقرة: 134] بعض الكلام في اشتقاق هذه الكلمة .
والدعاء إلى الخير هو الدعاب إلى كل ما فيه صلاح الأمة ديناً ودنيا وآخرة ، كما عرفت. وفي الحديث : { سأخبركم بأول أمري : دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى " ، دعوة إبراهيم (عليه السلام) هي قوله تعالى : {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ } [البقرة: 129] ، وبشارة عيسي هي قوله تعالى : {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف : 6].
كن ما هو خير وحسن عقلا ولم ينه عنه شرعاً ، فهو اسم جامع يشمل طاعة الله جل جلاله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ، وفي الحديث : " أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة " ، يعني من بذل معروفه في الدنيا وأحسن العشرة مع الناس ، آتاه الله جزاء معروفه في الآخرة، وروي عن ابن عباس في معنى الحديث : " يأتي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم وتبقى حسناتهم جامة (جامدة) فيعطونها لتن زادت سيئاته على حسناته ، فيغفر له ويدخل الجنة ، يجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة ".
والمنكر : هو ما أنكره العقل والشرع، فيكون ضد المعروف. وعطف الأمر بالمعروف على دعوة الخير، يكون عطفاً تفسيراً لبيان أن دعوة الخير هي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ، ولمعلومية الخير ومحبوبيته لدى الجميع ، فلا بد أن يكون المعروف والمنكر معلومين عند الداعي إلى الخير ، وللإعلام بأن المجتمع الذي بلغ من الكمال بالاعتصام بحبل الله تعالى صار المعروف عندهم هو الخير والمنكر هو الشر ، كما أنه يمكن أن يكون أيضاً لأجل أن المعروف والمنكر عند الشرع هو الخير والشر ؛ المعروفان عند العقل وتدعو إليهما الفطرة.
إن عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على دعوة الخير ، هو من عطف الخاص على العام ، فيكون من قبيل عطف أفضل الأفراد على الكلي.
ولا ينافي ذلك ما ذكرناه.
وكيف كان ، فالآية الشريفة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا شك في ذلك.
وإنما البحث والخلاف في كونه كفائياً أو عينيا ، والظاهر أنه يرجع إلى دلالة " من "، إنها للتبعيض ، فيكون الوجوب كفائيا.
إنها بيانية. والمعنى : كونوا أمة كذلك ، فيكون الوجوب عينيا.
وسياق الآية الشريفة يدل على الأول ، ويرجحه أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما تكون واجبة لأجل البعث على الطاعات والزجر عن القبائح والمعاصي ، ولا معنى لوجوبهما بعد حصول الغرض من البعض ، فالخطاب وإن كان متعلقاً بالجميع لكن الغرض يحصل من أي فرد كان ، وبما أن المقام يحتاج إلى التعاضد والتعاون حتى يكون له التأثير القوي في حصول الغرض، وليا كغيرهما من الواجبات، كان الأمر متعلقاً بالجمع، وبعد ذلك فلا وقع للنزع في كون " من " تبعيضية أو بيانية ، فإن الأمر متعلق بالجمع بقدر ما يتعلق بالأفراد والبعض ، فإن هذا التكليف لطف إلهي يتعلق بالجميع ولا بد من التعاضد والتعاون ولا يمكن ترك القائم به لوحده والإعراض عنه ، وقد ذكرنا في الأصول أنه لا فرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني بحب ذات الوجوب ، وإنما الفرق بينهما باعتبار سقوط التكليف عن الكل بعد قيام البعض به في الأول دون الثاني . وهذا يكون من باب تعدد الدال والمدلول ، لا باعتبار حقيقة الوجوب ، ولذا اشتهر بين الفقهاء أن في ترك الجميع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعاقب الكل لا البعض ، فراجع ما ذكرناه في [ مهذب الأحكام ] ، ويدل على ما ذكرناه ذيل الآية الشريفة الظاهر في الرجع إلى الموصوفين بهذه الصفة.
جملة استئنافية ، أي الداعون إلى المعروف والناهون عن المنكر هم الكاملون في الفلاح ، كما هو قضية الحصر.
ويستفاد من الآية الشريفة كمال الأهمية لهذ التكليف الإلهي والمنصب الرفيع ، بل هما من مناصب الأنبياء والأوصياء والأولياء الصالحين ، وتد ورد في فضلهما روايات كثيرة ، يأتي في البحث الروائي نقل بعضها ، ولهما شروط وآداب كثيرة ، يستفاد بعضها من هذه الآية الشريفة والبقية من غيرها.
ويستفاد من مجمع الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتاباً وسنة ، أن هذه الدعوة من صفات الباري . جل جلاله ، كالحكم بين الناس بالعدل ، وقد فوض الله تعالى ذلك إلى أنبيائه وأوصيائه والقائمين مقامهم ، وهذه الدعوة ترجع إلى التخلق بأخلاق الله تعالى والتخلي عما لا يرضاه الله والتحلي بما يرضاه ، وتفاني الدنيا في عالم العقبى ، فيصير الكل باقياً ببقاء الله تعالى ، ولعن ما ورد في الحديث : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى ، من أحياهما أحياه الله تعالى "، يرجع إلى ذلك ، فإن الخلق إنما يعتبر في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات، والمراد بالإحياء الأعم من الإحياء الدنيوي والأخروي ؛ وسبب الإحياء معلومن لأنه اتصال فعلي بالحي القيوم.
قال تعالى : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105].
بعدما أكد سبحانه الدعوة إلى الاتحاد والاعتصام بحبل الله تعالى والدعوة إلى الخير ، بين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يترتب على الإعراض عن ذلك والإحجام عن ما أمرهم في سبيل الوحدة والاتحاد بين أفراد المجتمع ، فإنه لا يمكن أن تختلف أمة إذا اجتمعت على مقصد واحد وهدف معين وانفقت عقائدهم ، وكانت بعيدة عن الأهواب الباطلة وما يوجب الضلال ، وتحقق التعاون والتناصر بين أفرادها ، وقريت أواصر الوحدة فيهم ، وبعدت عما يوجب الافتراق والاختلاف بينهم ، فهذه الآية كالدليل على لزوم متابعة ما ورد في الآيات السابقة.
والتفرق إنما يكون في ما يجب فيه الاجتماع مما فيه الصلاح والإصلاح ، ويكون ابتداء في الأبدان والابتعاد عما يوجب اتحاد الأفراد.
وأما الاختلاف إنما يكون في العقائد والآراء ويوجبه الافتراق في الكلمة ، فهو كالمقدمة التي توصل إلى الاختلاف في العقائد والآراء ، فإن كل اختلاف في الرأي إنما ينشأ عن التفرق في الكلمة وتباعد أفراد المجتمع ، والاختلاف هذا إنما يكون عن ضلال الأهواء والبغي ، ولذا نسب سبحانه وتعالى الاختلاف إلى البغي في عدة آيات ، منها قوله تعالى : {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [البقرة: 213] ، فإن الاختلاف بعد مجيء الآيات للحق الموجبة للاتحاد والاجتماع إما يكون عن إعراض عنها ، فيكون عن بغي وضلال .
والمعنى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا في الكلمة ولم يجتمعوا على ما أمرهم الله تعالى وخرجوا عن الجماعة ، فأوجب التباغض بينهم والتباين في آرائهم والاختلاف في عقائدهم ، فصاروا شيعاً وأحزابا ، وفي ذلك زوال سعادتهم ووقوعهم في الشقاق والنفاق والحروب والمنازعات ، فتذهب كرامتهم واستقلالهم وأمنهم وأمانهم.
ويستفاد من الآية الشريفة أن الاختلاف المذموم هو ما إذا كان البغي والضلال ، وأما غيره فلا ضرر فيه ، بل هو ضروري لاختلاف الأفهام والإدراكات ، ويكون سبباً للرقي والاستكمال ولكن لا بد أن لا يصل إلى حد يوجب التباغض والتنافر.
قال تعالى : {وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [آل عمران: 105]
جملة استئنافية هي نتيجة للسابق ، أي : أن الذين افترقوا واختلفوا في دين الله لهم عذاب عظيم ، جزءاً لظلمهم وعدوانهم لما أوجدوا من التفرق والاختلاف.
وإنما ختم سبحانه وتعالى هذه الآية الشريفة بهذه الجملة مقابلة للآية السابقة ، فإن النتيجة إذا كان فيها الفلاح والنجاح فلا محالة يكون في عكس ذلك الخسران والعذاب.
قال تعالى : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106]
تفريع على التقسيم السابق ، وبيان لجزاء الطائفتين المتقدمتين ، ويكون التقسيم من اللف والنشر المشوش المصطلح عليه في علم البديع ، فتكون وجوه المفلحين مبيضة ووجوه الظالمين مسودة.
وإنما ذكر عز وجل الوجوه من بين سائر الأعضاء ، إعلاناً لرفعة شأن المفلحين في الآخرة ، حتى يعرفهم جميع أهل المحشر وينظروا إليهم ، وتبييناً لخسة الظالمين وإذلالهم حتى يكونوا منفعلين في الآخرة كما كانوا كذلك فى الدنيا.
وقد خص سبحانه وتعالى من يغم الاخرة وعذابها بياض الوجه ومراده ، لأن المفلحين لما كانوا معتصمين بحبل الله تعالى تلحقهم البشارات الإلهية في كل آن وكانوا مجتمعين في الاعتصام به عز وجل ، كانت الطلاقة والبشاشة ظاهرة في وجوههم في الدار الدنيا ، فيكونون كذلك في الدار الآخرة ، وأما الظالمون الذين أعرضوا عن الاعتصام بحبله ، فانقطعت عنهم البشارات الربانية ، ووقعوا في النزاع والتباغض والاختلاف ، فكانوا مخذولين قد ظهر على وجوههم الانكسار والانفعال في الدنيا ، فلحقهم مثل ذلك في الدار الآخرة ، فكان الجزاء مناسبا لأعمالهم وصفاتهم.
قال تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [آل عمران: 106]. تفصيل بعد إجمال.
والجملة مركبة من الشرط ، وهو : {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: 106] ، والجواب فيقال لهم : {أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [آل عمران: 106] ، وحذف القول واستتباع الفاء في الحذف له شايع في كلمات الفصحاء ، وإنما الممنوع حذفها وحدها.
وعن بعض المفسرين يجوز أن يكون الجواب : " فهم في عذاب أليم " كما يدل عليه قوله تعالى : { فذوقوا العذاب} ، ويناسب قوله تعالى في الآية الأخرى : { فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107] ، وفائدة ذلك التهويل بالجواب ليقدره السامع بكل نحو يشعر به المقام من الهول ، وهو باب واسع في البلاغة.
ولكن ، يمكن أن يقال إنه لا وجه لهذا الاختلاف في الأسباب التوليدية ، كما أثبتناه في علم الأصول ، سواء كان الجواب السبب أم المسبب ، مع أن هذا التهويل والتخويف يستفاد من لفظ المذاب المعهود الموصوف بالعظمة.
وكيف كان ، ففي قوله تعالى : { أكفرتم بعد ايمانكم} التفات لغرض التوبيخ والتقريع . وإنما قدم عز وجل جزاء الظالمين لمجاورته لقوله تعالى : { وتسود وجوه} ، وتوبيخاً لهم وتشنيعاً لفعلهم ، مع انه عر وجن ابتدأ بدكر أصل الثواب، واختتم بجزام المفلحين، ليكون الابتداء والاختتام بما يشرح الصدر ويسن الطبع، وللإعلام بأن رحمته سبقت غضبه. وحقيقة هذا الخطاب عامة بالنبة إلى الدنيا والآخرة.
والمراد بالإيمان الظاهري منه، أي الذين آمنوا به، كما أن المراد بالكفر ترك الاعتصام بحبل الله، فتفرقوا واختلفوا وبذلوا دين الله تعالى وهتكوا حرماته فكفروا بأنعم الله ، وحينئذ لا تختض الآية الشريفة بطائفة خاصة كما قيل ، بل تعلم جميع من آمن صورة وترك العمل بما آمن به وكفر بأنعمه عز وجل.
قال تعالى : { فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}.
إنما أطلق عز وجل العذاب ولم يصفه بأمر ، تعظيماً له وتهويلا ، والأمر للإهانة ، والفاء للإيذان بأن العذاب مترتب على الكفر ، كما يدل عليه ذيل الآية الشريفة : {بما كنتم تكفرون} ، والباء للسببية.
وإنما جمع عز وجل الفعل الماضي والمستقبل ، للدلالة على استمرارهم على الكفر ، وكـنه صار طبعهم ، وبذلك استحفوا الجزاء الأليم ، وأن ذلك العذاب جزاء أعمالهم ، اختاروه بسوء أعمالهم.
قال تعالى : {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107].
الرحمة عامة شاملة لجمع مواهبه تعالى وإفاضاته بالنسبة إلى عباده المؤمنين ، دنيوية كانت تلك الرحمة أو أخروية ، وكل ما يكون في الدنيا يتمثل في العقبى بصورة حسنة ، وكل ما هو في الجنة يكون في صورة الفلاح والنجاح ، فهما متحدان ذاتاً ، فيكون الجزاء في الطائفتين مناسبا لأفعالهم ، فكل ما يصدر عنهم في الدنيا يكون لهم أو عليهم في العقبى.
قال تعالى :{ تلك آيات الله نَتْلُوهَا عليك بالحق}. الظرف متعلق بالآيات ، كما يصح تعلقه بقوله : " تتلوها " ، لأن المتلو عين تلك الآيات ، وهي عين ما يتلوها الله تعالى على نبيه ، فلا فرق ين تعلق الظرف بالتلاوة أو بالآيات المتلوة ، وهو قيد توضيحي ، لأن كل ما يصدر عنه تبارك وتعالى حق بجمع معنى الكلمة.
والمراد بالآيات والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن المراد بالحق نفس الأمر الواقعي ، الذي يقوم به نظام الدنيا والآخرة، فإن الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده تتضمن سعادتهم الدنيوية والأخروية ، بل لأجلها شرعت.
قال تعالى : {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ } [آل عمران: 108].
بيان لمعنى الحق ، فإن ما هو الحق واقعاً لا يعقل منه الظلم ، لأنه إنما يكون لترميم النقص وتكميله ، والمفروض أنه محال عليه تعالى ، فهو عام يشمل جميع أنحاء الظلم تشريعاً وجزاء ، كما تدل عليه الآية الشريفة ، فإن الظلم نكرة واقعة في سياق النفي.
والعالمين جمع محلى باللام ، يفيد الاستغراق يشمل كل عالم في سلسلة الزمان ، كما يشمل عالم البرزخ والآخرة إلى ما لا نهاية له . وهذه الآية تأكيد لقوله تعالى:{فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون} ، فان العذاب إذا كان نتيجة الكفر لا وجه لاحتمال الظلم بالنسبة إلى العامل الذي اختار الجزاء بنفسه ، فتكون جميع المساوي والشرور التي تصيب الإنسان في العالمين – الدنيا والاخرة – من ترك الاعتصام بحبل الله تعالى عملا ، ومن التفرق والاختلاف كما تقدم.
 الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
الاكثر قراءة في أخلاقيات عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












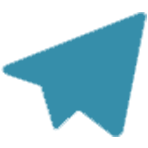
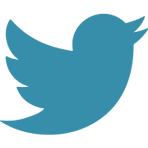

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)