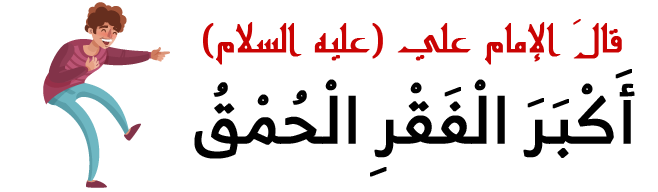
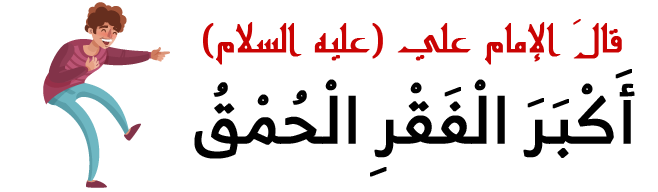

 النبي الأعظم محمد بن عبد الله
النبي الأعظم محمد بن عبد الله
 أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)
 الإمام علي بن أبي طالب
الإمام علي بن أبي طالب 
 حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله
 السيدة فاطمة الزهراء
السيدة فاطمة الزهراء
 الإمام الحسن بن علي المجتبى
الإمام الحسن بن علي المجتبى
 الإمام الحسين بن علي الشهيد
الإمام الحسين بن علي الشهيد
 الإمام علي بن الحسين السجّاد
الإمام علي بن الحسين السجّاد
 الإمام محمد بن علي الباقر
الإمام محمد بن علي الباقر
 الإمام جعفر بن محمد الصادق
الإمام جعفر بن محمد الصادق
 الإمام موسى بن جعفر الكاظم
الإمام موسى بن جعفر الكاظم
 الإمام علي بن موسى الرّضا
الإمام علي بن موسى الرّضا
 الإمام محمد بن علي الجواد
الإمام محمد بن علي الجواد
 الإمام علي بن محمد الهادي
الإمام علي بن محمد الهادي
 الإمام الحسن بن علي العسكري
الإمام الحسن بن علي العسكري
 الإمام محمد بن الحسن المهدي
الإمام محمد بن الحسن المهدي
 الغيبة الصغرى
الغيبة الصغرى
 الغيبة الكبرى
الغيبة الكبرى|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
التاريخ: 1-12-2017
التاريخ: 4-10-2017
التاريخ: 10-12-2017
|
قبل أن نبدأ بشرح بعض كلمات هذه الخطبة نجلب إنتباه القارئ الكريم إلى هذا التمهيد :
تدبر قليلاً لتتصور أجواء ذلك المجلس الرهيب ، ثم معجزة السيدة زينب الكبرى في موقفها الجريئ!
بالله عليك! أما تتعجب من سيدة أسيرة تخاطب ذلك الطاغوت بذلك الخطاب؟
وتتحداه تحدياً لا تنقضي عجائبه؟
ولا تهاب الحرس المسلح الذي ينفذ الأوامر بكل سرعة وبدون أي تأمل أو تعقل؟!
وأعجب من ذلك سكوت يزيد أمام ذلك الموقف مع قدرته وإمكاناته؟
وكأنه عاجز لا يستطيع أن يقول شيئاً أو يفعل شيئاً!
أليس من العجيب أن يزيد ـ وهو طاغوت زمانه ، وفرعون عصره ـ لم يستطع أو لم يتجرأ على أن يرد على السيدة زينب كلامها ، بل يشعر بالعجز والضعف عن مقاومة السيدة زينب ، ويكتفي بقراءة قول الشاعر : يا صيحة تحمد من صوائح !
فما معنى هذا البيت في هذا المقام؟!
وما المناسبة بين هذا البيت وبين كلمات خطبة السيدة زينب؟
فهل كانت حرفة السيدة زينب النياحة حتى ينطبق عليها قول يزيد : ما أهون النوح على النوائح ؟
وما يدرينا مدى ندم يزيد بن معاوية من مضاعفات جرائمه التي ارتكبها؟ وخاصة تسيير آل رسول الله من العراق إلى الشام.
فإنه ـ بالقطع واليقين ـ ما كان يتصور أن سيدة أسيرة سوف تغمسه في بحار الخزي والعار ، فلا يستطيع يزيد أن يغسل عن نفسه تلك الوصمات .. إلى يوم القيامة.
وتكشف الغطاء عن هوية يزيد ، وترفع الستار عن ماهيته وأصله ، وحسبه ونسبه ، وسوابقه ولواحقه ، وتخاطبه بكل تحقير ، وتقرع كلماتها مسامع يزيد ، وكأنها مطرقة كهربائية ، ترتج منها جميع أعصابه ، فيعجز عن كل مقاومة!!
والآن إليك شرحاً موجزاً لبعض كلمات هذه الخطبة الحماسية الملتهبة : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على جدي سيد المرسلين
إفتتحت كلامها بحمد الله رب العالمين ، ثم الصلاة على جدها : سيد المرسلين ، فهي ـ بهذه الجملة ـ عرفت نفسها للحاضرين أنها حفيدة رسول الله سيد المرسلين (صلى الله عليه واله) حتى يعرف الحاضرون أن هذه العائلة المسبية الأسيرة هي من ذراري رسول الله ، لا من بلاد الكفر والشرك. ثم قرأت السيدة هذه الآية :
صدق الله سبحانه ، كذلك يقول : ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوئى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون .
وما أروع الإستشهاد بها ، وخاصةً في مقدمة خطبتها!!
وعاقبة كل شيء : آخره ، أي : ثم كان آخر أمر الذين أساؤا إلى نفوسهم ـ بالكفر بالله وتكذيب رسله ، وارتكاب معاصيه ـ السوئي ، أي : الصفة التي تسوء صاحبها إذا أدركته ، وهي عذاب النار.
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون أي : بسبب تراكم الذنوب والمعاصي في ملف أعمالهم حصل منهم التكذيب بآيات الله والحقائق الثابتة ، وظهر منهم الإستهزاء بها وبالمقدسات الدينية.
وهي (عليها السلام) تشير بكلامها ـ هذا ـ إلى تلك الأبيات التي قالها يزيد :
لعبت هاشم بالملك فلا ... خبر جاء ولا وحي نزل
ومعنى هذا البيت من الشهر : أن بني هاشم ـ والمقصود من بني هاشم : هو رسول الله ـ لعب بالملك بإسم النبوة والرسالة ، والحال أنه لم ينزل عليه وحي من السماء ، ولا جاؤه خبر من عند الله تعالى.
فتراه ينكر النبوة والقرآن والوحي!!
وهل الكفر والزندقة إلا هذا؟!
ثم إن بعض الناس ـ بسبب أفكارهم المحدودة ـ يتصورون ـ خطأ ـ أن الإنتصار في الحرب يعتبر دليلاً على أنهم على حق ، وعلى قربهم من عند الله تعالى ، فتستولي عليهم نشوة الإنتصار والظفر ، ويشملهم الكبرياء والتجبر بسبب التغلب على خصومهم ؛
ولكن السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) فندت هذه الفكرة الزائفة ، وخاطبت الطاغية يزيد باسمه الصريح ، ولم تخاطبه بكلمة : أيها الخليفة أو يا أمير المؤمنين وأمثالهما من كلمات الإحترام.
نعم ، خاطبته باسمه ، وكأنها تصرح بعدم إعترافها بخلافة ذلك الرجس ، فقالت : أظننت ـ يا يزيد ـ حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء ، فاصبحنا لك في أسار ، نساق إليك سوقاً في قطار ، وأنت علينا ذو اقتدار ، أن بنا من الله هوانا ، وعليك منه كرامة وامتنانا ؟!
تصف السيدة زينب حالها ، وأحوال من معها من العائلة المكرمة ، أنهم كانوا في أشد الضيق ، كالإنسان الذي أخذوا عليه ، أي : منعوه وحاصروه من جميع الجوانب والجهات ، بحيث لا يستطيع الخروج والتخلص من الأزمة.
وبعد هذا التضييق والتشديد ، والمنع والحبس أصبحنا نساق مثل الأسارى الذين يأتون بهم من بلاد الكفر عند فتحها.
سوقاً في قطار يقال ـ ولا مناقشة في الأمثال ـ : قطار الإبل أي : عدد من الإبل على نسق واحد وفي طابور طويل ، وقد قرأنا أن جميع أفراد العائلة ومعهم الإمام زين العابدين والسيدة زينب (عليهما السلام) كانوا مربوطين ومكتفين بحبل واحد!
وأنت علينا ذو اقتدار أي : نحن في حالة الضعف وأنت في حالة القدرة.
أن بنا من الله هواناً ، وعليك منه كرامة وامتناناً ؟!
أي : أظننت ـ لما رأيتنا مغلوبين ، ووجدت الغلبة والظفر لنفسك ـ أن ليس لنا جاه ومنزلة عند الله ، لأننا مغلوبون؟!! وظننت أن لك عند الله جاهاً وكرامة لأنك غلبتنا وظفرت بنا ، وقتلت رجالنا ، وسبيت نساءنا؟!!
و ظننت : أن ذلك لعظم خطرك أي : لعلو منزلتك.
وجلالة قدرك عند الله تعالى؟!
وعلى أساس هذا الظن الخاطئ الذي لا يغني من الحق شيئاً و إن بعض الظن إثم ، إستولت عليك نشوةً الإنتصار.
فشمخت بانفك يقال : شمخ بأنفه : أي رفع أنفه عزاً وتكبراً.
ونظرت في عطفك العطف ـ بكسر العين ـ : جانب البدن ، والإنسان المعجب بنفسه ينظر إلى جسمه وإلى ملابسه بنوع من الأنانية وحب الذات والغرور.
تضرب أصدريك فرحاً الأسدران : عرقان تحت الصدغين ، وضرب أصدريه : أي : حرك رأسه ـ بكيفية خاصة ـ تدل على شدة الفرح والإعجاب بالنفس .. إزاء ما حققه من إنتصار موهوم.
وتنفض مذرويك مرحاً
يقال : جاء فلان ينفض مذرويه. إذا جاء باغياً يهدد الآخرين.
هذا ما ذكره اللغويون ، ولكن الظاهر أن معنى ينفض مذرويه أي يهز إليتيه ، وهو نوع من حركات الرقص عند المطربين حينما تأخذهم حالة الطرب والخفة.
حين رأيت الدنيا لك مستوسقة
أي : مجتمعة.
والأمور لديك متسقة
أي : منتظمة ، بمعنى : أنك رأيت الأمور على ما تحب وترضى ، وعلى ما يرام بالنسبة إليك ، فكل شيء يجري كما تريد.
وحين صفى لك ملكنا ، وخلص لك سلطاننا
أي : ومن أسباب فرحك ، وقيامك بالحركات الطائشة التي تدل على شدة سرورك ، أنك رأيت من نفسك ملكاً وسلطاناً قد نجح في خطته التي رسمها لإبادة منافسه ، وأسر نسائه.
لكن .. إعلم أيها المغرور : أن هذه القدرة والمكانة التي اغتصبتها ـ وهي الخلافة ـ هي لنا أساساً ، لأن يزيد كان يحكم بإسم خلافة رسول الله (صلى الله عليه واله).
ومن الواضح أن خلافة رسول الله لها موارد خاصة ، وأن خلفاء رسول الله أفراد معينون ، منصوص عليهم بالخلافة ، وهم : الإمام علي بن أبي طالب ، والأئمة الأحد عشر من ولده : ، ولكن الآن .. صارت تلك القدرة والسلطة بيد يزيد!!
بعد هذه المقدمة والتمهيد قالت : فمهلاً مهلاً
يقال ـ للمسرع في مشيه ، أو المتفرد برأيه ـ : مهلاً. أو : على مهلك ، أي : أمهل ، ولا تسرع ، أي : ليس الأمر كما تعتقد أو كما تظن ، أو : ليس هذا الإسراع في العمل صحيحاً منك فلا تعجل حتى نبين لك حقيقةً الأمر.
لا تطش جهلاً طاش فلان : أخذه الغرور وفقد إتزانه ، فصار غير ناضج في تصرفاته.
أي : يا يزيد! لا تطش .. بسبب جهلك بالحقائق ، وخلطك بين المفاهيم والقيم ، والإغترار بالظواهر.
أنسيت قول الله ( عزوجل ) : {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: 178] ؟!!
نملي : أي نطيل لهم المدة والمجال ، أو نطيل أعمارهم ونجعل الساحة مفتوحة أمامهم خير لأنفسهم ، بل : إنما نطيل أعمارهم ومدة سلطتهم وحكومتهم .. لتكون عاقبة أمرهم هي إزدياد الإثم والمعاصي في ملف أعمالهم ، ولهم عذاب مهين ، أي : يجزيهم ـ في جهنم ، تعذيباً ممزوجاً مع الإهانة والتحقير.
ثم خاطبته وذكرته بأصله السافل ، ونسبه المخزي ، فقالت : أمن العدل يا بن الطلقاء ...
وهذه الكلمة إشارة إلى ما حدث يوم فتح مكة ، فإن رسول الله (صلى الله عليه واله) لما فتح مكة ـ وصارت تحت سلطته ـ كان بإمكانه أن يقتلهم لما صدرت منهم من مواقف عدائية وحروب طاحنة ومتتالية ضد النبي الكريم ـ بالذات ـ وضد المسلمين بصورة عامة ، لكنه رغم كل ذلك .. إلتفت إليهم وقال لهم :
يا معاشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟
قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم
فقال لهم : إذهبوا فأنتم الطلقاء وكان فيهم : معاوية وأبو سفيان.
ويزيد هو ابن معاوية ، وحفيد أبي سفيان ، ويطلق عليه ( ابن الطلقاء ) إذ قد يستعمل ضمير الجمع في مورد التثنية.
أما معنى كلمة يابن الطلقاء فالطلقاء ـ جمع طليق ـ : وهو الأسير الذي أطلق عنه إساره ، وخلي سبيله.
إن رسول الله (صلى الله عليه واله) فتح مكة ، فصارت البلدة ومن فيها تحت سلطته وقدرته ، وكان بإمكانه أن ينتقم منهم أشد إنتقام ، وخاصة من أبي سفيان الذي كان يؤجج نار الفتن ، ويثير الناس ضد رسول الله ، ويقود الجيوش والعساكر لمحاربة النبي والمسلمين ، كما حدث ذلك يوم بدر وأحد ، وحنين والأحزاب ، وهكذا إبنه معاوية الذي كان على دين أبيه ، ولكن الرسول الكريم أطلقهما وخلى سبيلهما في من أطلقهم.
قال الله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما مناً بعد وإما فداءً ، حتى تضع الحرب أوزارها فإما منا بعد أي : إما أن تمنوا عليهم مناً بعد أن تأسروهم ، أي : تحسنوا إليهم فتطلبوا منهم دفع شيء من المال إزاء إطلاقكم سراحهم.
وكان رسول الله (صلى الله عليه واله) مخيراً بين ضرب أعناقهم وبين المن والفداء ، فاختار الرسول الكريم المن وأطلقهم بلا فداء ولا عوض.
والظاهر أن السيدة زينب تقصد من كلمة يابن الطلقاء واحداً من معنيين :
المعنى الأول : أن تذكر يزيد بأنه ابن الطليقين الذين أطلقهما رسول الله (صلى الله عليه واله) مع أهل مكة ، وكأنهم عبيد ، فتكون الجملة تذكيراً له بسوء سوابقه المخزية وملف والده وجده!
والمعنى الثاني : أن تذكر يزيد بالإحسان الذي بذله رسول الله لأسلاف يزيد حيث أطلقهم ، فقالت : أمن العدل أي : هل هذا جزاء إحسان رسول الله (صلى الله عليه واله) مع أسلافك .. أن تتعامل مع حفيدات الرسول هذا التعامل السيئ؟!
ولعل السيدة زينب قصدت المعنيين معاً.
ومن الواضح أنها لا تقصد ـ من كلامها هذا ـ السؤال والإستفهام ، بل تقصد توبيخ يزيد على سلوكه القبيح ، ونفسيته المنحطة ، وتنكر عليه تعامله السيئ ، وتعلن له أنه بعيد ـ كل البعد ـ عن أوليات الفطرة البشرية ، وهي جزاء الإحسان بالإحسان!!
تحذيرك حرائرك وإماءك :
يقال : خدر البنت : الزمها الخدر ، أي : أقامها وراء الستر.
الحرائر ـ جمع حرة ـ : نقيض الأمة. وسوقك بنات رسول الله سبايا السوق : يقال : ساق الماشية يسوقها سوقاً : حثها على السير من خلف وذلك يعني : الحث على السير من الوراء مع عدم الإحترام.
اقول : لا يرجى من يزيد العدل والعدالة ، ولكنه لما ادعى الخلافة لنفسه ، كان المفروض والمتوقع منه أن يكون عادلاً.
ولهذا خاطبته السيدة زينب بقولها : أمن العدل أن تجعل جواريك والنساء الحرائر ـ الساكنات في قصرك ـ وراء الخدر ، وتسوق بنات الرسالة وعقائل النبوة ، ومخدرات الوحي .. سبايا؟
قد هتكت ستورهن ، وأبديت وجوههن :
فبعد أن كن مخدرات مستورات ، لا يرى أحد لهن ظلاً ، وإذا بهن يرين أنفسهن أمام أنظار الرجال الأجانب ، وبعد أن كن محجبات .. وإذا بالأعداء قد سلبوهن ما كن يسترن به وجوههن .. من البراقع والمقانع!
تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد :
أي : يسوقهن الأعداء من كربلاء إلى الكوفة ، ومنها إلى الشام ، ويمرون بهن على البلاد التي في طريق الشام.
وحينما كان يمر موكبهن على البلاد والقرى والأرياف ، كان الناس ـ على اختلاف طبقاتهم ـ يخرجون للتفرج عليهن ، وأحياناً كانوا يصعدون على سطوح دورهم للتفرج عليهن ، ولهذا قالت السيدة : ويستشرفهن أهل المناقل ، ويتبرزن لأهل المناهل :
المناقل ـ جمع منقل ـ وهو الطريق إلى الجبل.
والمناهل ـ جمع منهل ـ : وهو الماء الذي ينزل عنده والمقصود : المنازل التي في طريق المسافرين ، للتزود بالماء أو الإستراحة.
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد ، يتصفح : أي يتأمل وجوههن لينظر إلى ملامحهن!!
والشريف والوضيع ، والدنيء والرفيع :
والحال أنه ليس معهن من رجالهن ولي ، ولا من حماتهن حمي ، عائلة محترمة ، وليس معهن من رجالهن أحد يشرف على شؤونهن ويحرسهن ويحميهن من الأخطار والأشرار ، لأن رجالهن قد قتلوا بأجمعهم ، ولم يبق منهم سوى الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام). كل هذه الجرائم التي صدرت منك ، وبأمرك كانت عتواً منك على الله
العتو : هو التكبر.
وجحوداً لرسول الله
الجحود : هو الإنكار مع العلم بأن هذا هو الواقع والحق ، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم .
ودفعاً لما جاء به من عند الله
الدفع : الإزالة والإبادة والرد.
أي : قمت بهذه الأعمال لأجل القضاء على الإسلام ، وعلى ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه واله) من عند الله تعالى.
ولا غرو منك ، ولا عجب من فعلك :
لا غرو : لا عجب.
إن السيدة زينب (عليها السلام) تعتبر تلك الجرائم ـ التي صدرت من يزيد ـ أموراً طبيعية وظواهر غير عجيبة ، فـ كل إناء بالذي فيه ينضح .
وإن الآثار السلبية لعامل ـ بل عوامل ـ الوراثة ، والإستمرار على شرب الخمر والفحشاء والفجور والعيش في أحضان العاهرات ، كلها أسباب كان لها دورها في إيجاد هذه النتائج والعواقب السيئة للطاغية يزيد.
وأنى ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الشهداء ، ونبت لحمه بدماء السعداء؟
أي : كيف ومتى يتوقع الخوف من الله تعالى .. من ابن من رمت من فمها أكباد الشهداء الأبرياء؟
هذه الكلمة إشارة إلى ما حدث في واقعة أحد ، وإلى مقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وعم رسول الله (صلى الله عليه واله) حينما جاءت هند ـ أم معاوية ـ وجدة يزيد ـ وشقت بطن سيدنا حمزة ، واخرجت كبده واخذت قطعة من كبده ، ووضعتها في فمها وعضتها بأسنانها وحاولت أن تأكلها ، بسبب الحقد المتأجج في صدرها ، ولكن الله تعالى أبى أن تدخل قطعة من كبد سيدنا حمزة في جوف تلك المرأة الساقطة ، فانقلبت تلك القطعة صلبةً كالحجر ، فلم تؤثر أسنانها في الكبد ، فلفظتها ، ورمتها من فمها ، فاكتسبت بذلك لقب ( آكلة الأكباد )!!
ويزيد : هو حفيد هكذا امرأة حقودة. وحقده على الدين وارتكابه للجرائم الكبيرة ليس بشيء جديد!!
ونصب الحرب لسيد الأنبياء :
لقد ذكرنا ـ في الفصل الرابع من هذا الكتاب ـ أن أبا سفيان هو الذي كان يجهز الجيوش في مكة ، ويخرج لحرب رسول الله (صلى الله عليه واله) وقتال المسلمين ، حينما كان النبي الكريم في المدينة المنورة.
وجمع الأحزاب :
إن أبا سفيان هو الذي جمع العشائر والقبائل الكثيرة .. من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم ، وأمر بنفير عام وشامل لمختلف الأعمار والديانات ، وخرج بجيش جرار كالسيل الزاحف ، للقضاء على الرسول العظيم ومن معه من المسلمين ، في واقعة الأحزاب التي عرفت ـ فيما بعد ـ بـ غزوة الخندق .
وشهر الحراب ، وهز السيوف في وجه رسول الله (صلى الله عليه واله)
الحراب ـ جمع حربة ـ : وهي آلة قصيرة من الحديد ، محددة الرأس ، تستعمل في الحرب.
وهز السيوف كناية عن الخروج للحرب وإصدار الأوامر للهجوم والغارة ، وبما أن أبا سفيان كان هو السبب في هذه الحروب فقد جاءت كلمة السيوف بصيغة الجمع.
أشد العرب لله جحوداً ، وأنكرهم له رسولاً ، وأظهرهم له عدواناً ، وأعتاهم على الرب كفراً وطغياناً .
من الواضح أن العرب في مكة وغيرها .. كانوا على درجات متفاوتة في نسبة إنكارهم لوجود الله تعالى ، أو إتخاذهم الأصنام آلهة من دونه سبحانه.
فهناك من هو جاحد ومنكر مائة بالمائة ، وهناك من هو جاحد (عليه السلام)0 % ، وهكذا.
ومنهم : من هو عازم على الإستمرار في الكفر رغم علمه بالتوحيد ، ومنهم : من كان يعيش حالة الشك في الإستمرار في الكفر أو الشرك.
ومنهم : من كان يحيك المؤامرات ضد النبي الكريم بصورة سرية ، ومنهم : من كان يخرج لحرب رسول الله .. بشكل مكشوف.
ومنهم : من كان منكراً لله تعالى .. ولكنه يتخذ موقف المحايد تجاه النبي الكريم ، ولا يبذل أي نشاط ضد الإسلام والمسلمين.
ولكن الكافر الذي ضرب الرقم القياسي في إنكار الله تعالى ، وإنكار رسالة النبي الكريم (صلى الله عليه واله) : هو أبو سفيان.
هذه كلها صفات ومواصفات أبي سفيان ، وقد ورثها منه حفيده يزيد ، حيث كان يشترك مع جده في جميع هذه الأوصاف والأحقاد ، وبنفـس النسبة والدرجة ، لكن مـع تبدُّل الظروف!
فلقد وقف أبو سفيان في وجه رسول الله (صلى الله عليه واله) وحاربه وأظهر أحقاده.
وجاء ـ من بعده ـ إبنه معاوية ، فوقف في وجه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وحاربه بكل ما لديه من طاقة وقوة ، وعلى مختلف الأصعدة والمجالات ، الإعلامية والعسكرية وغيرها.
إن الوثائق التاريخية تقول : مات معاوية وعلى صدره الصنم ، فكم تحمل هذه الكلمة من معان ودلالات ، والحر تكفيه الإشارة !!
وقد جاء في التاريخ ـ أيضاً ـ : مات معاوية على غير ملة الإسلام .
ثم جاء يزيد ـ من بعد معاوية ـ فكان كالبركان يتفجر حقداً على آل رسول الله وأبناء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
فماذا تراه يفعل؟!
وماذا تتوقع منه؟!
وخاصة وأنه يرى تحت تصرفه جيشاً كبيراً ينفذ أوامره بكل سرعة ، ويطيعه طاعةً عمياء ، دون رعاية الجوانب الإنسانية أو العاطفية أو الدينية.
وكان له مستشار مسيحي حاقد إسمه : سرجون يملي عليه ما يتبادر إلى ذهنه في كيفية القضاء على الإسلام ، ويرسم له الخطط للوصول إلى هذا الهدف!
ألا : إنها نتيجة خلال الكفر
ألا : حرف لجلب الإنتباه ، أو للتأكيد على ما يخبر عنه.
النتيجة ـ هنا ـ العاقبة.
خلال ـ جمع خلة ـ وهي الخصلة.
أي : إن يزيد حينما أمر بقتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين (عليه السلام) لم يكن لمجرد أنه كان يرى منه منافساً له في السلطة فقضى عليه ، بل إن ذلك كان من منطلق الكفر والإلحاد ، ولذلك .. فهو لم يكتف بقتل الإمام ، بل أمر بسبي نسائه وأطفاله ، وقام بغير ذلك من الجرائم والجنايات.
وهذه الأمور : هي نتيجة خبث نفسيته الطائشة وأثر صفاته الكفرية الموروثة من أبيه وجده!
وضب يجرجر في الصدر لقتلى يوم بدر ، والضب ـ بكسر الضاد ـ : الغيظ الكامن والحقد الخفي.
جرجر البعير : إذا ردد صوته في حنجرته.
أي : وحقد يتأجج في الصدر ، ويطالب يزيد للأخذ بثارات المقتولين في غزوة بدر ، وهم أقطاب المشركين الذين كانوا قد خرجوا من مكة لمحاربة رسول الله (صلى الله عليه واله) وقتال المسلمين.
وهم المشركون الذين تمنى يزيد حضورهم بقوله : ليت أشياخي ببدر شهدوا وهم : عتبة بن ربيعة ، وشيبة ، والوليد بن شيبة.
أما عتبة فقتله عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، وأما شيبة وابنه الوليد فقد قتلهما الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
إن جميع ما قام به الطاغية يزيد ، من قتله الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته ، وسبي الطاهرات من نسائه وحرمه ، وإهانته لرأس الإمام الحسين (عليه السلام) تعتبر نتيجة طبيعية للكفر المكشوف والحقد الدفين في قلب يزيد ، فلم يكن يوجد في قلبه مقدار ذرة من الإيمان بالله تعالى وبيوم القيامة ، بل إنه إتخذ منصب خلافة الرسول الكريم ، وسيلة لسلطته على الناس ، وانهماكه في الشهوات ، ومحاربته للدين وعظماء الدين.
فقد كان يتجاهر بشرب الخمر ، ولعب القمار وغيرهما من المنكرات التي حرمها الله سبحانه وبذلك أعطى الجرأة لجميع الناس كي يجلسوا في الأماكن العامة ، ويرتكبوا ما شاؤا من المعاصي والذنوب ، من دون أي خوف أو حذر ، أو حياء أو خجل ، أو إحترام لحدود الله تعالى ، أو رعاية للخطوط الحمراء التي وضعها الله سبحانه حول بعض الأعمال المحرمة.
لقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) أنه قال : ... من نظر إلى الشطرنج فليلعن يزيد وآل يزيد ...
فلا يستبطئ في بغضنا ـ أهل البيت ـ من كان نظره إلينا شنفاً وإحناً وضغناً
وفي نسخة : وكيف يستطبئ في بغضنا
أي : كيف لا يسرع إلى بغض أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله) من كانت نظرته وعقيدته فيهم عقيدة الكراهة والحقد.
والشنف والشنآن والإحن والأضغان : معانيها متقاربة ، والمقصود منها : شدة الحقد والبغض.
يظهر كفره برسوله ، ويفصح ذلك بلسانه :
إشارة إلى الأبيات التي أنشدها يزيد :
لعبت هاشم بالملك فلا ... خبر جاء ولا وحي نزل
فقد أظهر كفره برسالة النبي (صلى الله عليه واله) وتجاهر بذلك ، واعتبر النبوة والرسالة والوحي والقرآن كلها العاب ، وأنكرها جميعاً.
يفصح : أي يظهر ما في قلبه على لسانه.
وهو يقول ـ فرحاً بقتل ولده ، وسبي ذريته ، غير متحوب ولا مستعظم:
لأهلـوا واستهلوا فرحاً ... ولقالوا : يا يزيد لا تشل
غير متحوب : أي غير متأثم أو غير متحرج من
القبيح. والحوبة : من يأثم الإنسان في عقوقه .. كالوالدين.
والظاهر : أن السيدة زينب (عليها السلام) تقصد أن يزيد كان يعيش حالة عدم الإكتراث أو المبالاة بما قام به من جرائم ، وبما يصرح به من كلمات كفرية ، وبما يشعر به من الفرح والسرور لقتله ابن رسول الله ، وسبي ذريته الطاهرة. إذ من الواضح أن الذي لا يؤمن بيوم الجزاء لا يفكر في مضاعفات جرائمه ، ولا يشعر بالحرج أو الخوف من أعماله التي سوف تجر إليه الويل!!
منحنياً على ثنايا أبي عبد الله ـ وكان مقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) ـ ينكتها بمخصرته
ثنايا ـ جمع الثنية ـ : وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ، ثنتان من فوق وثنتان من تحت.
مقبل : موضع التقبيل.
ينكت : يضرب.
مخصرة : العصا ، وقيل : هي العصا التي في أسفلها حديدة محدة ، كحديدة رأس السهم.
أقول : إن القلم ليعجز عن التعبير عن شرح هذه المقطوعة من الخطبة!! وذلك لهول المصيبة ، فكيف تجرأ الطاغية يزيد على أن يضرب تلك الثنايا المقدسة ، التي كانت موضعاً لتقبيل رسول الله .. مئات المرات .. وفعل يزيد ذلك بمرأى من عائلة الإمام الحسين ونسائه وبناته؟!
ولم يكتف يزيد بالضرب مرةً واحدة أو مرتين ، بل مرات متعددة ، وهو في ذلك الحال في أوج الفرح والإنتعاش!!
ولم يكن الضرب على الأسنان الأمامية فقط ، بل كان يضرب على شفتيه ووجهه الشريف ، ويفرق بين شفتيه بعصاه ليضرب على أسنانه!
إنا لله وإنا إليه راجعون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!!
قد التمع السرور بوجهه
قد يكون الفرح شديداً فيتدفق الدم إلى الوجه فيحمر ، وبذلك تظهر آثار الفرح على ملامحه ، فيقال : إلتمع السرور بوجهه.
هكذا كانت فرحة يزيد حين ضربه تلك الثنايا الشريفة.
لعمري لقد نكات القرحة
نكأ القرحة : قشرها بعد ما كادت تبرأ.
لعل المعنى : أن ضرب يزيد تلك الثنايا صار سبباً لهيجان الأحزان من جديد ، وفجر دموع العائلة الكريمة ، فاستولى عليهن البكاء والنحيب ، وخاصة أن بنتين من بنات الإمام الحسين (عليه السلام) جعلتا تتطاولان ( أي : تقفان على رؤوس أصابع رجليهما ) لتنظرا إلى الرأس الشريف ، من وراء كراسي الجالسين ، فلما نظرتا إلى يزيد وهو يضرب الرأس الشريف ، ضجتا بالبكاء والعويل ، ولاذتا بعمتهما السيدة زينب ، وقالتا : يا عمتاه! إن يزيد يَضرب ثنايا أبينا ، فقولي له : لا يفعل ذلك؟!
فقامت السيدة زينب (عليها السلام) ولطمت على وجهها ونادت : واحسيناه! يابن مكّة ومِنى! يا يزيد : إرفع عودك عن ثنايا أبي عبد الله .
واستأصَلتَ الشأفة
يُقال : إستَأصل شأفته : أي أزاله من أصله.
ولعلّ المعنى : يا يزيد : لقد قطعت شجرة النبوة من جذورها بقتلك الإمام الحسين (عليه السلام) فهو آخر من كان باقياً من أصحاب الكساء ، الذين نزلت فيهم آية التطهير وعبّر الله تعالى عنهم ـ في القرآن الكريم ـ بكلمة اهل البيت ، فكلّ من كان يُقتل من هؤلاء الخمسة الطيّبة ..
كانَ في الباقين ـ منهم ـ سلوة لآل رسول الله ، وبقتل الإمام الحسين (عليه السلام) إنقطعت شجرة أهل البيت من جذورها ، وكان ذلك بأمر يزيد وتنفيذ إبن زياد.
بإراقتك دم سيد شباب أهل الجنّة ، وابن يعسوب الدين ، وشمس آل عبد المطّلب
يعسوب : النحلة التي يُعبّر عنها بـ المَلكة في مملكة النحل ، وقد لقّب رسول الله (صلى الله عليه واله) الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) بلقب يعسوب الدين وشبّه شيعته بالنحل الذي يعيش في ظلّ تلك المملكة ويتّبع ذلك اليعسوب ، واشتُهر بين المسلمين ـ في ذلك اليوم ـ هذا اللقب للإمام علي (عليه السلام) ولذلك قال الشاعر :
ولايتي لأمير النحل تكفيني ... عند الممات وتغسيلي وتكفيني
وطينتي عُجِنت من قَبل تكويني ... بحبّ حيدر ، كيف النار تكويني؟!
ثمّ عبّرت السيدة زينب عن الإمام الحسين (عليه السلام) بـ شمس آل عبد المطّلب ، ويا لهذا التعبير من بلاغة راقية ، وتشبيه جميل ، فإنّ الإمام الحسين كان هو الوجه المشرق الوضّاء والواجهة المُتلألأة لآل عبد المطلب بن هاشم ، وسبب الفخر والإعتزاز لهم ، وهم كانوا المجموعة أو العشيرة الطيّبة لقبيلة قريش ، وقريش كانت أشرف قبائل العرب.
وهَتَفتَ بأشياخك
حينما قلتَ : ليت أشياخي ببدر شهدوا فتمنّيت حضورهم ليروا إنتصارك الموهوم ، وأخذك لثارهم من آل رسول الله (صلى الله عليه واله) ، مع أنّ أشياخك هم الذين خرجوا ـ من مكة إلى المدينة ـ لقتال رسول الله ، وهم الذين بدؤا الحرب مع المسلمين ، فكانوا بمنزلة الغُدّة السرطانيّة الخبيثة في جسم البشريّة ، وكان يلزم قطعها كي لا ينتشر المرض والفساد في بقيّة أجزاء الجسم.
وتقرّبت بدمه إلى الكفرة من أسلافك
أي : قُمتَ بإراقة دم الإمام الحسين (عليه السلام) تقرّباً إلى أسلافك ، وقلتَ :
قد قَتَلنا القَرم مِن ساداتهم ... وأقمنا مثل بدرٍ فاعتدَل
ثمّ صرختَ بندائك
أي : بندائك لأشياخك. ومن هذه الجملة يُستفاد أنّ يزيد كان رافعاً صوته حين قراءته لتلك الأبيات الكُفريّة ، والشعارات الإلحادية.
ولعمري لقد ناديتهم لو شهدوك
قال ابنُ مالك ـ ما معناه ـ : لو : حرفٌ يقتضي في الماضي إمتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه .
وبناءً على هذا .. يكون معنى كلام السيدة زينب (عليها السلام) : يا يزيد! لقد تمنّيتَ أسلافك لو كانوا حاضرين كي يشهدوك ويشهدوا أخذك لثارهم ، ولكنّ هذه الأمنية لا تتحقّق لك ، فأسلافك موتى معذّبون في نار جهنّم ، ومن المستحيل أن يعودوا الآن ويشهدوا ما قُمتَ به من الجرائم ، وليقولوا لك : سَلِمَت يداك!!
ووشيكاً تشهدهم ولن يشهدوك
وشيكاً : أي : سريعاً أو قريباً ويُقال : أمرٌ وشيك : أي : سريع
المعنى : يا يزيد : سوف تموت قريباً عاجلاً ، لأنّ مُلكك يزول سريعاً ، ولا تطول أيام حياتك ، وتنتقل إلى عالم الآخرة ، إلى جهنّم فترى أسلافك هناك في الأغلال والقيود وفي صالات التعذيب ، وممرّات السجون ، ولكنّهم لا يرونك ، أي : لا تجتمع معهم في مكان واحد ، لأنّك ستكون في درجة أسفل منهم في طبقات نار جهنّم ، لأنّ جرائمك الموبقة تستوجب العذاب الأشدّ ، لكنّك حين نزولك إلى ذلك المكان الأسفل ، سوف يكون طريقك عليهم ، فتراهم ولكنّهم لا يرونك ، لأنّ شدة عذابهم يُشغلهم عن الإلتفات إلى ما حولهم ومَن حولهم مِن الجُناة!
وقد رُوي عن رسول الله (صلى الله عليه واله) أنّه قال : إنّ قاتل الحسين بن علي .. في تابوت من نار ، عليه نصف عذاب أهل الدنيا ، وقد شُدّت يداه ورجلاه بسلاسل من نار ، مُنكّس في النار ، حتى يقع في قعر جهنّم ، وله ريحٌ يتعوّذ أهل النار إلى ربهم من شدّة نتنه ، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم ، مع جميع من شايع في قتله ، كلّما نضجت جلودهم بدّل الله ( عز وجل) عليهم الجلود حتى يذوقوا العذاب الأليم ، لا يُفَتّر عنهم ساعة ، ويُسقَون من حميم جهنّم ، فالويل لهم من عذاب الله تعالى في النار .
ولتودّ يمينُك ـ كما زعمت ـ شُلّت بك عن مِرفَقها وجُذّت
شُلّت : الشلل : تعطّل أو تيبّسٌ في حركة العضو أو وظيفته ، يُقال ـ في الدعاء ـ : شُلّت يمينك.
جُذّت : قُطعت أو كُسٍِرَت
المعنى : يا يزيد! إنّك في الدنيا زَعمت أن أسلافك لو كانوا حاضرين .. لقالوا لك : يا يزيد لا تُشَل أمّا في يوم القيامة ، حين تُعاقب تلك العقوبة الشديدة ، سوف تتمنّى أنّ يمينك كانت مشلولة أو مقطوعة حتى لا تستطيع أن تَضرب بعصاك ثنايا الإمام الحسين (عليه السلام).
وهذا إخبارٌ من السيدة زينب (عليها السلام) بما يدور في ذهن يزيد حين يُلاقي جزاء أعماله الإجراميّة.
وتتمنّى ـ أيضاً ـ حينما تُلاقي أشدّ درجات العقوبة والتعذيب : وأحبَبتَ أنّ أُمّك لم تحملك ، وإيّاك لم تَلِد حين تصير إلى سخط الله ومُخاصمك رسول الله (صلى الله عليه واله) ..
أحبَبتَ ـ هنا ـ : بمعنى تَمنّيتَ من أعماق قلبك أن أمّك لم تكن تحمل بك ، ولم تلدك حتى لا تكون مخلوقاً وموجوداً من أول يوم ، ولم تَكتَسِب هذه السيئة الكبيرة التي دفعت بك إلى أسفل السافلين في التابوت الموجود في اسفل طبقات جهنّم ، حيث يستقرّ فيه أفراد معيّنون من الجُناة الذين جرّوا الوَيلات على البشريّة جمعاء ، وعلى كلّ الأجيال والبلاد والشعوب ، وأسّسوا الأُسس ومهّدوا الطرق لمن يأتي من بعدهم من الطغاة والخَوَنة ، في أن يقوموا بكلّ جريمة ، وبكل جُرأة!
إنّ الأحاديث الشريفة تقول : إنّ أهل النار ـ جميعاً ـ يستغيثون بالموكّلين بهم من الملائكة .. أن لا يفتحوا باب ذلك الصندوق ، لأنّ درجة الحرارة فيها أشدّ ـ بكثير ـ مِن حرارة جهنّم نفسها!!
وتقول الأحاديث الشريفة : إنّه كلّما خَفّت ونزلت درجة حرارة نار جهنّم .. تَفتَح الملائكة باب ذلك الصندوق لمدّة قليلة فتزداد حرارة جهنّم كلّها بالحرارة الشديدة التي أُضيفت إليها من ذلك التابوت ، كالقِدر الكبير للطعام الذي توضع فيه البقول ، وتوضع على نار خفيفة ، وفُجأةً يرفعون درجة تلك النار إلى أقصى نسبة ممكنة ، فيحدث إضطراب عجيب في ذلك القدر وما فيه!
ويُعبّر عن ذلك الصندوق بـ التابوت وبالمعذّبين فيه بـ أهل التابوت .
وقد رُوي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه قال : ... إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله (صلى الله عليه واله) ومعه الحسين (عليه السلام) ويده على رأسه يقطر دماً ، فيقول : يا ربّ سل أمّتي فيمَ ( أي : لمـاذا ) قتلوا ولـدي! ثمّ بدأت السيدة زينب (عليها السلام) بالدعاء على يزيد ومَن شاركه في ظلم آل رسول الله الطيّبين الطاهرين ، دَعَت عليهم مِن ذلك القلب المُلتَهِب بالمصائب المُتتالية ، فقالت :
اللهم! خُذ بحقّنا ، وانتقم من ظالمنا ، واحلُل غضبك على من سفك دماءنا ، ونقضَ ذمارنا ، وقَتلَ حُماتنا ، وهتك عنّا سدولنا
نَقَضَ : لم يُراع الحرمة والعهد.
الذمار : ما ينبغي حفظه والدفاع عنه ، كالأهل والعِرض.
وقيل : ذمار الرجل : كل شيء يلزمه الدفع عنه.
سدول ـ جمع سدل ـ السِتر.
ثم أرادت السيدة زينب (عليها السلام) أن تُبيّن ليزيد حقيقة واقعيّة : وهي أنّ جميع ما قُمتَ به ضدّ آل رسول الله ، مِن : قتل وسَبي ، وحمل الرؤوس من بلد إلى بلد ، وإهانة الرأس الشريف ، والإفصاح عن الكلمات الكُفريّة الكامنة في الصدر ، وغيرها .. لا تعود عليك بالفائدة والنَفع ، بل تعود عليك بالخسران والعقوبة ، حتى لو جعَلَتك تفرح لمدّة قصيرة ، لكنّ هذا الفرح سوف لا يستمرّ ، بل يتعقّبه سلسلة متواصلة من أنواع الخسارة والعذاب الجسدي والنفسي ، فقالت (عليها السلام) :
وفعلت فِعلتك التي فعلت ، وما فرَيت إلا جلدك ، وما جَزَرت إلا لحمك
فَريتَ : شققتَ وفتَتَّ وقَطعتَ .
جزَرتَ : قطعتَ ويُستعمل غالباً في نحر البعير وتقطيع لحمه.
وسترد على رسول الله بما تحمّلتَ من دم ذريّته ، وانتهكتَ من حرمته ، وسفكت من دماء عترته ولُحمَته .
اللُحمة : القرابة ، يُقال : بينهم لُحمة نسب.
المعنى : سترِد على رسول الله (صلى الله عليه واله) ـ بعد موتكَ ـ وأنت تحمل على ظهرك من الجرائم ما لا تحملها الجبال الرواسي ، فيُخاصمك على كل واحدة واحدة منها .. أشدّ أنواع الخصومة ، من دون أن يخفى عليه شيء!
حيثُ يُجمع به شملهم ، ويُلمّ به شعثهم ، وينتقم من ظالمهم ، ويأخذ لهم بحقّهم من أعدائهم .
الشعث : ما تَفرّقَ من الأمور أو الأفراد ، يُقال ـ في الدعاء ـ : لَمّ الله شعَثه .
المعنى : سوف يجمع الله تعالى آل رسول الله عند النبي الكريم في جبهة واحدة ـ وذلك في يوم القيامة ـ فيَشكو كلّ واحد من آل الرسول إلى النبي الكريم كلّ ما لقيَ من الناس مِن عداءٍ وظلم ، فينتقم الله من أعدائهم أشدّ الإنتقام .
ومادام الأمر كذلك ، فاسمع يا يزيد : فلا يستفزّنّك الفرح بقتلهم
لا يستفزّنك : أي : لا يُخرجك الفرح عن حالتك الطبيعيّة ، يُقال : إستفزّه : أي استخفّه ، أو ختَله حتى ألقاه في مهلكة.
فلا خير في فرحة قصيرة يتعقّبها حزن دائم ، وعذاب أليم ، وخلود في النار.
ثمّ أدمجت السيدة زينب (عليها السلام) كلامها بالقرآن الكريم ، فقالت : {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: 169، 170] ... وحسبُك بالله ولياً وحاكماً
لعلّ المقصود من قولها وحسبك بالله وليّاً وحاكماً أي : وليّاً للدم ، وآخذاً للثار ، فالإمام الحسين (عليه السلام) هو : وصيّ رسول الله ، وسيّد أولياء الله تعالى ، فمن الطبيعي : أن يكون الله ( عز وجل ) هو الطالب بثاره ، والوليّ لدمه ، فهو الشاهد لمصيبة قتل الإمام الحسين ، وهو القاضي ، وهو الحاكم ، فهنا .. الحاكم والقاضي هو الذي قد شَهِدَ الجريمة بنفسه ، فلا يحتاج إلى شهادة شهود ، وهو الذي يَعرف عظمة المقتول ظلماً ، وهو الذي يعلم أهداف القاتل مِن وراء قتله للإمام ، وهو يزيد.
وبرسول الله خَصماً ، وبجبرائيل ظهيراً
لقد روي عن الصحابي : إبن عباس أنّه قال : لمّا اشتدّ برسول الله (صلى الله عليه واله) مرضه الذي مات فيه ، حضَرتُه وقد ضمّ الحسين إلى صدره ، يسيل من عرَقه عليه ، وهو يجود بنفسه ويقول : ما لي وليزيد! لا بارك الله فيه ، اللهم العن يزيد .
ثمّ غُشيَ عليه طويلاً وأفاق ، وجعل يُقبّل الحسين وعيناه تذرُفان ويقول : أما إنّ لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله .
ثمّ صعّدَت السيدة زينب (عليها السلام) من لهجتها في تهديد يزيد وإنذاره ، مُغامرةً منها في حربها الكلاميّة ومُخاطرتها في كشف الحقائق ، وإهانتها للطاغية يزيد .
فقالت : وسيعلم من بوّأك ومكّنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلاً ، وأيّكم شرّ مكاناً وأضلّ سبيلاً ..
مكّنَكَ : مهّد لتسلّطك على كرسيّ الحكم على الناس والتلاعب بدماء المسلمين.
وهذا تصريح من السيدة زينب (عليها السلام) ـ أمامَ يزيد ومَن كان حوله في مجلسه ـ بعدم شرعيّة تسلّطه على رقاب الناس ، بل وعدم شرعيّة سلطة من مهّد ليزيد هذه السلطة وهو أبوه معاوية بن أبي سفيان ، فهو الذي يتحمّل ما قام به يزيد من الجرائم ، مُضافاً إلى ما تحمّله هو من الجنايات وقتل الأبرياء. فسيكون عذابه أشد ، لأن جرائمه أكثر ووزرَه أثقل. ولعلّ هذا المعنى هو المقصود من قول السيدة زينب ـ حكايةً منها عن القرآن الكريم : أيّكم شرّ مكاناً .
وما استصغاري قَدرك ، ولا استعظامي تَقريعك ، التَقريع : الضرب مع العُنف والإيلام.
وفي نسخة : ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك ، إنّي لأستصغر قدرك ، وأستعظِم تقريعك .
الدواهي ـ جمع داهية ـ : دَواهي الدهر : ما يُصيب الإنسان من نُوَبه.
لعلّ السيدة زينب (عليها السلام) تقصد ـ من كلامها هذا ـ : أنّ يا يزيد! من الصعب عليّ جداً أن أُخاطبك ، لأنّي في منتهى العفة والخدارة ، وأنت في غاية اللؤم والحقارة ، ومن الصعب عليّ أن أُخاطب رجلاً نازل القدر والمكانة ، لكنّ الضرورة والظروف المؤسفة وتقلّبات الدهر ، جعلتني أكون طرفاً لك في الخطاب ، لكي أُبيّن لك فظاعة تقريعك لرأس أخي الإمام الحسين (عليه السلام).
تَوَهّماً لإنتجاع الخطاب فيك ...
الإنتجاع : إحتمال التأثير.
المعنى : ليس هدفي من مُخطابتك إحتمال تأثير خطابي فيك ، بل هو ردّ فعل طبيعي لما شاهدته وأُشاهده من المصائب ، وعسى أن يؤثّر كلامي في بعض الجالسين في هذا المجلس ، ممّن خفيَت عنهم الحقائق ، بسبب تأثير الدعايات ، وأقول قَولي هذا .. لكي أُبطِل وأُدمر ما أحرزته من الإنتصارات الموهومة.
بعد أن تركتَ عيون المسلمين به عبرى
أي : مُغرَورقة ومليئة بالدموع بسبب استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بلا ذنب ، وبتلك الكيفية الفجيعة!
وصدورهم عند ذكره حرّى
أي : ملتهبة من الحزن والأسى ، عند تذكّر ما جَرت عليه من المصائب المقرحة للقلوب.
وهذا أمر طبيعي لكل مسلم ـ بل كلّ إنسان ـ لم تتغيّر فيه الفطرة الأولية التي فطر الله الناس عليها ، فالتألّم من هكذا فاجعة .. هو رد فعل طبيعي لكل من تكون صفة العاطفة سليمة لديه.
ثمّ ذكرت السيدة زينب (عليها السلام) سبب عدم إحتمال تأثير خطابها في نفسيّة يزيد وحاشيته ، فقالت (عليها السلام) : فتلك قلوب قاسية ، ونفوس طاغية ، وأجسام محشوّة بسخط الله ولعنة الرسول ، قد عشّش فيها الشيطان وفَرّخ ..
مَحشوّة : أي : مملوءة.
إنّ القلب إذا صار قاسياً ، والنفس إذا أخذها الطغيان ، فسوف لا تكون الأرضيّة مساعدة فيهما لتقبّل المواعظ والنصائح.
يُضاف إلى ذلك .. أنّ الشيطان الرجيم إذا وجد التفاعل والتجاوب من شخص ، فسوف يتربّع في فكره وذهنه ، ويتّخذه لنفسه عشاً ووكراً ، ومسكناً ومحلاً للإقامة فيه ، ويكون بمنزلة جهاز التحكّم في الأشياء ، يتحكّم في ميوله واتّجاهاته ، فيوجّه الشخص حيثما يريد ، ويأمره بأنواع الإنحراف والإنسلاخ عن الفطرة الإنسانية والعاطفة وجميع الصفات الحميدة ، ويعطيه الجُرأة على اقتاحم المخاطر الدينية ، فإذا أراد الشيطان مغادرة فكر هذا المنحرف فإنّ هناك فراخه ، أي : جنوده ، الذين يقومون مقامه ويؤدّون دوره في مهمّة الإغراء والتشجيع على الجريمة من دون التفكير في مضاعفاتها السلبيّة.
ومن هناك مِثلك ما دَرَج
ومن هناك : أي : وبسبب ذلك ، ونتيجة لتلك الأسباب. وقيل : ما في ما درج : زائدة.
درج : يُقال : درج الصبيّ : أي : أخذ في الحركة ومشى
مشياً قليلاً .. أوّل ما يمشي.
وقيل : درج : أي نشأ وتقوّى.
فالعجب كلّ العجب لقتل الأتقياء ، وأسباط الأنبياء ، وسليل الأوصياء ، بأيدي الطلقاء الخبيثة ، ونسل العَهَرة الفجرة ..
الأتقياء ـ هنا ـ : الإمام الحسين (عليه السلام) والمستشهدين معه.
أسباط ـ جمع سبط ـ : الحفيد.
السليل : الوَلَد.
العهرة ـ جمع عاهر وعاهرة ـ : الرجل الزاني ، والمرأة الزانية.
الفجرة ـ جمع فاجر وفاجرة ـ : الرجل أو المرأة التي تُمارس جريمة الزنا والفجور.
حقّاً إنّه عجيب ، بل هو من أعجب الأعاجيب أن يُقتل أشرف وأطيب خلق الله تعالى على أيدي ذريّة العاهرين والعاهرات!!
ولكن .. هذه هي طبيعة الحياة الدنيا ، أنّها تكون قاعة امتحان للأخيار والأشرار ، وللذين يضربون أرقاماً قياسيّة في الطيب أو الخبث.
ومن هنا .. بقيت فاجعة كربلاء خالدة إلى يوم القيامة ، عند كلّ مجتمع يمتاز بالوعي والإدراك ، وفهم المفاهيم والقيم الإنسانية ، وكلّما إزداد البشر نُضجاً وفَهماً أقبل على دراسة وتحليل هذه الفاجعة بصورة أوسع ، والتفكير حولها بشكل أشمل ، والكتابة عنها بتفصيل أكثر.
وقد شاء الله تعالى أن يبقى هذا الملفّ مفتوحاً لدى العقلاء المؤمنين ، ويُجدّد فتحه في كل عام ، بل في كل يوم ، لتحليل ودراسة جزئيّات هذه الفاجعة!!
ولخلود فاجعة كربلاء ـ وإمتيازها على بقيّة فجائع وكوارث التاريخ ـ أسباب متعددّة ، نذكر بعضها ، ليعرف ذلك كل من يبحث عن إجابة هذا السؤال ، ويريد معرفة الواقع والحقيقة :
1 ـ إنّ الذين انصبّت عليهم مصيبة القتل أو السبي .. ـ في هذه الفاجعة ـ كانوا هم أفضل طبقات البشر ، وأشرف خلق الله تعالى .. رجالاً ونساءً ، بل كانوا في قمّة شاهقة ، ودرجة عالية من العظمة والجلالة والإيمان بالله تعالى ، والنفسيّة الطيّبة ، بحيث لا مجال لأن نقيس بهم
غيرهم من البشر .. مهما كانوا عظماء.
2 ـ إنّ الذين ارتكبوا الجرائم ـ في هذه الفاجعة ـ .. كانوا أخبث البشر ، وأكثر الناس لؤماً ، وأنزلهم نفسيّةً.
3 ـ إنّ هذه الفاجعة مهّدَت الطريق لسلسلة من الفجائع والجرائم والجنايات ، فأعطت الناس الجُرأة بأن لا يخافوا من أحد ، ولا يلتزموا بعقيدة أو دين ، فكان عمل مرتكبي هذه الفاجعة .. بمنزلة تأسيس الأُسُس وفتح الطريق أمام كل خبيث ولئيم ، في أن يقوم بما تطيبُ له نفسه القذرة من الجرائم والجنايات!
ولقد جاء في التاريخ : أنّ الإمام الحسين (عليه السلام) صرّح بهذه الحقيقة ، أثناء مُقاتَلَته مع أهل الكوفة ، فقال : ... يا أمّة السَوء : بئسما خلفتهم محمداً في عترته ، أما إنّكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله ، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إيّاي ... .
4 ـ إنّ طبيعة الحياة : هي أنّ التاريخ يُعيد نفسه .. لكن .. مع إختلاف الافراد والأجيال ، فكان ضروريّاً على كل مسلم أن يستلهم الدروس والعبر من هذه الفاجعة الكبرى ، ويقوم بدراستها ومعرفة تحليلها .. بشكل شامل ، لكي لا يَسقُط في الإمتحانات الإلهيّة الصعبة ، والمنعطفات الحادّة الخطيرة ، وحتى لا تتكرّر مآسي وفجائع مشابهة.
وحتى لو تكرّرت ذلك فإنّه يبادر إلى صفوف الأخيار ، ويتّخذ موقف الإنسان المؤمن الذي يخاف الله تعالى ، ويؤمن بيوم الحساب ، وذلك لأنّ لديه خلفيّة دينيّة واسعة وشاملة عن فاجعة كربلاء ومضاعفاتها.
5 ـ إنّ فتح ملف فاجعة كربلاء والبكاء حين قراءة أو سماع تفاصيلها يعني : تأمين جاذبيّة قويّة ، تجذب الناس نحو الدين بـ إسم الإمام الحسين (عليه السلام) ، وبجاذبيّة عاطفيّة لا يمكن تَصَوُّر درجة قوّتها!!
وهنا .. ينبغي الإلتفات إلى حقيقة مهمّة ، وهي : أنّ الأدلّة العقليّة والإستدلالات المنطقيّة ـ في مجال دعوة الناس إلى الإلتزام بالدين ـ تقوم بدَور الإقناع فقط ، لكن لابدّ لذلك من عامل يجذب الناس لإستماع هذه الأدلّة ، وأقوى عوامل الجذب هو : العامل العاطفي ، وهو متوفّر في كلّ بند من بنود هذه الفاجعة!
وهذه الجاذبيّة لا تقتصر على جذب الناس نحو الدين فحسب ، بل تجذبهم نحو الفضائل والأخلاق ، والتطبيق العملي لبنود الدين ، وتعلّم معالم وعقائد وعبادات الدين من أئمة أهل البيت : .. لا مِن غيرهم.
فإنّ الله تعالى جعل شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت وإتّباعهم ، لا مجرّد محبّتهم ، وجعل الله ( عز وجل ) الإسلام الواقعي ينحصر في مذهب أهل البيت ، لا المذاهب الأخرى .. حتى لو كانت تلك المذاهب مشتملة على ظواهر ومظاهر دينيّة ، فالمظهر وحده لا يكفي ، بل لابدّ من التمسّك بالمحتوى الصحيح!
ولابدّ من التوقيع الإلهي على شرعيّة ذلك المذهب ، عن طريق نزول الوحي على رسول الله الصادق الأمين ، أو ظهور المعجزات من إمام ذلك المذهب.
ولذلك فقد اشتُهر وتواتر عن رسول الله (صلى الله عليه واله) قوله : مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، مَن ركبها نجى ، ومن تخلّف عنها غرِق .
والآن .. نعود إلى شرح كلمات خطبة السيدة زينب (عليها السلام) : تقول السيدة : إنّ قتل الأتقياء وأحفاد الأنبياء وإبن الأوصياء ، كان على أيدي الطلقاء الخبيثة ، ونسل العهرة الفجرة.
إنّنا حينما نُراجع التاريخ الصحيح نجد أنّ الذين ارتكبوا فاجعة كربلاء الدامية كانوا من أولاد الحرام!! بِدءاً من يزيد ، إلى ابن زياد ، إلى الشمر ، إلى العشرة الذين سحقوا جسد الإمام الحسين (عليه السلام) بعد شهادته ، بحوافر خيولهم!!
ولإلتحاق كلّ واحد منهم بأبيه قصّة مذكورة في كتب علم الأنساب .
فقد جاء في التاريخ : أنّ إمرأة نصرانية إسمها : ميسون بنت بجدل الكلبي زَنَت مع عبد أبيها ، فحملت بـ يزيد وبعد الحمل بشهور تزوّجها معاوية.
وأمّا عبيد الله بن زياد ، فإنّ أمّه مرجانة كانت مشهورة ـ عند الجميع ـ بالزنا المُستمرّ!!
وكلام الإمام الحسين (عليه السلام) مشهور وصريح بأنّ عبيد الله وأباه زياد كانا إبنَي زنا ، حيث قال الإمام : ... الا وإنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين : بين السلّة والذلّة ، وهيهات منّا الذلّة ... .
وقد رويَ عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه قال : قاتل الحسين (عليه السلام) ولد زنا.
تَنطِف أكُفّهم من دمائنا
تنطِفُ : تقطرُ أو تسيل.
والظاهر أنّ هذا الكلام ـ أيضاً ـ إستعارة بلاغيّة ، وتعني السيدة زينب (عليها السلام) تلك الأيدي والأكفّ التي كانت تضرب بسيوفها ورماحها على أجسام آل رسول الله : الإمام الحسين ورجال أهل بيته وأصحابه ، فتتقاطر أكفّهم وسيوفهم من دماء أولئك الطيّبين.
وتتحلّب أفواههم من لحومنا
تتحلّب : يُقال : حَلَبَ فلانٌ الشاة أو الناقة : أي : إستخرج ما في ضَرعها من اللبن ، واستحلب اللبن : إستدرّه. وتحلّب فوه أو الشيء : إذا سال. لعل المراد : أنّه كما أنّ ولد الناقة تتحلّب وتمتصّ بفمها الحليب من محالب أمّها ، كذلك كان الأعداء يمتصّون بأفواههم من لحوم ودماء آل رسول الله (صلى الله عليه واله) مصّاً قوياً بدافع الحقد والبغضاء!!
وهذه ـ أيضاً ـ إستعارة بلاغيّة وكناية عن شدّة حقدهم وعدائهم.
ويُمكن أن تكون هذه الكلمة إشارةً إلى ما فعلته هند جدّة يزيد ـ في غزوة أحد ـ : مِن شقّها لبطن سيّدنا حمزة بن عبد المطّلب ، وإخراجها كبده ، ثم وضعه في فمها ومحاولتها أن تمضغه وتأكل منه ، حقداً منها عليه ، لكونه عمّاً لرسول الله ، وقائداً كفوءاً في جيش المسلمين.
تلك الجُثث الزاكية ، على الجَبوب الضاحية
الجَبوب : وجه الأرض الصلبة وقيل : الجَبوب : التُراب.
الضاحية : يُقال ضحا ضَحواً : برز للشمس ، أو أصابه حرّ الشمس ، وأرض ضاحية الظلال : أي : لا شجر فيها.
إخبار من السيدة زينب (عليها السلام) عن مصيبة بقاء الأجساد الطاهرة على وجه الأرض عدّة أيام .. من غير دفن ، تصهرها الشمس بأشعّتها المباشرة ، كلّ ذلك .. رغم كونهم سادات أولياء الله تعالى.
تَنتابها العواسل
تنتابها : تأتي إليها مرّة بعد مرّة.
العواسل ـ جمع عاسِل ـ : وهو الذئب.
وهنا إحتمالان في المقصود من هذا الكلام.
الإحتمال الأول : إنّ المقصود من العواسل : هم الذين حضروا يوم عاشوراء لقتل الإمام الحسين (عليه السلام) والصفوة الطيبة من ذريته وأهل بيته واصحابه. عبّرت السيدة زينب (عليها السلام) عن أولئك الاعداء بالذئاب ، لأنّهم كانوا يحملون صفة الذئاب وهي الإفتراس ، ويُعبّر عن هذا النوع من التشبيه ـ في علم البلاغة والأدب ـ بـ الإستعارة .
وقد استعمل الإمام الحسين (عليه السلام) هذا النوع من الإستعارة في خطبته التي ألقاها قبل خروجه من مكّة نحو العراق ، حيث قال ـ فيها ـ : ... خُيّرَ لي مصرع أنا لاقيه ، وكأنّي بأوصالي تُقطّعها عُسلان الفلوات ، بين النواويس وكربلاء ... .
وبناءً على هذا .. يكون المقصود من كلمة تَنتابها الهجوم المتوالي والغارات المتتالية التي كان الأعداء يَشِنّونها على أصحاب الإمام الحسين وخيامه .. يوم عاشوراء.
الإحتمال الثاني : هو أنّ الشأن والعادة تقتضي أن لو بقيت جُثث أناس على الأرض ـ من غير دفن ـ ، وكانت المنطقة تتواجد فيها الذئاب ، فإنّها تأتي إلى تلك الجثث وتأكل من لحومها.
إلا أنّ المعنى لم يحصل ـ بكلّ تأكيد ـ بالنسبة إلى الجسد الطاهر للإمام الحسين (عليه السلام) وأجساد أصحابه وأهل بيته الطاهرين ، الذين قُتلوا معه ، وبقيت أجسادهم على الأرض لمدّة ثلاثة أيام ، من غير دفن أو مواراة في الأرض ، من دون أن يتعرّض لها ذئب أو أيّ حيوان مفترس آخر.
وتُعفّرها أمّهات الفراعل
الفراعل ـ جمع فُرعُل ـ : ولد الضبع.
الظاهر أنّ هذا الكلام ـ أيضاً ـ إستعارة بلاغيّة ، ولعلّها تشير إلى أولئك الأفراد العشرة الذين ركبوا خيولهم وسحقوا جسد الإمام الحسين (عليه السلام) بعد قتله .. بحوافر الخيل ، في يوم عاشوراء ، أو اليوم الحادي عشر من المحرّم.
قال الراوي : ثمّ نادى عمر بن سعد في أصحابه : مَن ينتدبُ للحسين فيوطئ الخيل ظهره؟
فانتدب منهم عشرة وهم : إسحاق بن حوية ، وأخنَس بن مرثد ، وحكيم بن طفيل ، وعمر بن صبيح الصيداوي ، ورجاء بن مُنقذ العبدي ، وسالم بن خَيثمة الجعفي ، وصالح بن وهب الجعفي ، وواحظ بن غانم ، وهاني بن ثَبيت الحضرمي ، وأُسيد بن مالك ( لعنهم الله ) فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى رضّوا ظهره وصدره!!
قال الراوي : وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا عند ابن زياد ، فقال له أحدهم:
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر ... بكـلّ يعبـوبٍ شديـد الأسـر
فقال ابن زياد : مَن أنتم؟
قالوا : نحن وطئنا بخيولنا ظهر الحسين .. حتى طحنّا جناجن صدره!!
فأمر لهم بجائزة.
قال أبوعمرو الزاهد : فنظرنا في نسب هؤلاء العشرة ، فوجدناهم جميعاً أولاد زنا!
فلئن اتّخذتنا مغنَماً ، لتجدُ بنا وشيكاً مُغرماً حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك ، وما الله بظلام للعبيد
مَغنَماً : الغنيمة ، وجمعها : مغانم وقيل : المَغنَم : هو كل ما حصل عليه الإنسان من أموال الحرب.
مُغرَماً : المُغرَم : المُثقل بالدَين أو أسير الدَين وقيل : المغرَم : مصدر وُضِعَ موضع الإسم ، ويُراد به مُغرَم الذنوب والمعاصي.
المعنى : يا يزيد! إنّك أمرت بأسرنا ، وتعاملَت جلاوزتك معنا ـ في طريق الشام ـ تعامل السبايا والغنائم الحربيّة ، ولكن .. إعلم أنّك ـ في القريب العاجل ـ سوف تجد نفسك مُثقلاً بالذنوب ومحاصراً بالمعاصي التي يلزم عليك دفع ضريبتها ، والدفاع عن نفسك في محكمة العدل الإلهية ، حيث لا تجد معك إلا ما قدّمت يداك : من جرائم وجنايات ، والتي مِن أبرزها : سبيِ نساء آل رسول الله (صلى الله عليه واله). وفي ذلك الحين ترى نفسك وحيداً ذليلاً مهاناً ، من غير محام يدافع عنك ، ولا عذرٍ لتبرّر به أعمالك ، ولا مال لتدفعه رشوةً وتُخلّص به نفسك ، بل تبقى أنت وأعمالك!!
فإلى الله المشتكى والمُعَوّل ، وإليه الملجأ والمؤمّل
المُعَوّل : إسم مفعول بمعنى المُستعان ، يقال : عَوّلتُ عليه : أي استَعَنتُ به ، وصَيّرت أمري إليه وقيل : العَولُ : المُستعان به ، والعِوَل : الإتّكال والإستعانة ، يُقال : عَوَل الرجل عليه : أي : إعتمد وإتّكل عليه ، واستعانَ به.
وبعد ما ذكرَت السيدة زينب (عليها السلام) ما جرى على آل الرسول الطاهرين من المصائب ، تقول فإلى الله المُشتكى وعليه الإعتماد والإتّكال والإستعانة به .. لا إلى غيره ، فقد كان تعالى هو الشاهد على ما جرى ، وسيكون هو المنتقم من الأعداء ، المقتدر على إبادتهم وعقوبتهم. وإليه المَلجأ والمؤمّل فهو ـ سبحانه ـ الملجأ لنا ولبقيّة أفراد العائلة المكرّمة ، وخاصّة بعد فقدنا لسيّدنا الإمام الحسين (عليه السلام) وتواجدنا في عاصمة بني أميّة ، في قيد الأسر والسبي!
وهو المؤمّل : الذي نأمل منه أن يُعيننا على ما أصابنا ، ويُعطينا الصبر الجميل على تحمّل ذلك ، ويمنحنا الأجر الجزيل إزاء ما لاقيناه من المكاره والنوائب.
ثمّ عادت السيدة زينب (عليها السلام) لتصبّ جاماً آخر من غضبها على المجرم الأصلي لفاجعة كربلاء ، وهو يزيد الي قام بتلك الجرائم مباشرة ، أو أصدر الأوامر لعامله اللعين ابن زياد ، الذي نفّذ أوامر يزيد من القتل والسبي والضرب وغير ذلك.
وكأنّها ترى أن كلّ ما خاطبته به غير كافٍ لِما يستحقه من شجبٍ وتعنيف!
فقالت : ثمّ كِد كيدك ، واجهد جهدك
الكيد : إرادة مَضَرّة الغير خُفية ، والحيلة السيّئة ، والخُدعة ، والمكر .
جَهَد جهداً : جدّ ، يُقال : طلب حتى وصل إلى الغاية ، والجهد ، الوُسع والطاقة.
هذا كلام يَطغى عليه طابع التهديد الشديد ، مِن سيّدة أسيرة ، ولكنّها واثقة من نفسها ـ أعلى درجات الثقة ـ أنّ جميع نشاطات يزيد ـ والفصول اللاحقة من مخطّطاته ـ
سوف تفشل ، وسوف لا يتوصّل إلى أيّ واحد من أهدافه!! بل ترجع عليه بشكل مُعاكس ، فكُرسيّه يتزعزع ، وسلطته تضعُف ، وقدرته تذهب!
فالسيدة زينب (عليها السلام) تريد أن تقول ليزيد : إصنع ما بدا لك ، من تخطيط وتفكير ، وقَتل وإبادة ، وسَبي وأسر ، وابذل ما في وسعك من جهود ، فسوف لا تصل إلى الهدف الذي حَلِمتَ به ، وهو إستئصال شجرة النبوة من جذورها .. بكافّة أغصانها وفروعها وأوراقها ، وعدم إبقاء صغير أو كبير من آل رسول الله .. رجلاً كان أو إمرأة!
فو الله الذي شرّفنا بالوحي والكتاب ، والنبوّة والإنتخاب ـ
القسم للتأكيد الأكثر ، وهو ـ في الواقع ـ إنعكاس آخر لعلوّ مستوى درجة الثقة بالنفس والإتّكال على الله تعالى ، واليقين بما يقوله الإنسان ويحلف من أجله ، وعِلم السيدة بحوادث المستقبل ، وما ستؤول إليه الأمور ، فإنّ حوادث اليوم ، وأحداث المستقبل تُعتبر ـ أمام عين السيدة زينب (عليها السلام) في حدّ سواء ، لأن الله تعالى ميّزها عن بقية سيدات البشر بأن يُوصّل إليها العلوم مباشرة .. عن طريق الإلهام .. ودون تعلّم من البشر ، ولذلك فإنّ حوادث المستقبل معلومة وواضحة لها كاملاً كالحوادث المعاصرة ، ومثالها مثال مَن يُخرج رأسه مِن نافذة الغرفة ، فيرى ـ بكلّ وضوح ـ كلّ ما هو موجود إلى آخر الشارع ، وليس مثالها مثال من يجلس في غرفة ويفتح النافذة فلا يرى إلا ما يُقابل النافذة فقط.
إنّنا نتلمّس ـ من كلمات القسم هذه ـ المعنويّات العالية التي كانت تمتاز بها السيدة زينب (عليها السلام) حين إلقائها لخطبتها ، فهي تفتخر وتعتزّ بمزاياها الفريدة فتقول : فو الله الذي شرّفنا بالوحي والكتاب ، فالقرآن الكريم نزل على جدّ السيدة زينب وهو رسول الله سيّدنا محمد (صلى الله عليه واله) وفي دارها.
وكذلك اختار الله هذه الأسرة وانتخبها لتكون فيهم النبوّة. وكأنّها تُعرّض بكلامها ليزيد : أن أنت بماذا تَعتز؟ وبماذا تفتخر؟!
وهل توجد فيك فضيلة واحدة حتى تفتخر بها؟!
ولعلّ السيدة زينب كانت تقصد ـ أيضاً ـ إسماع الجماهير المتواجدة في ذلك المجلس هذه الحقائق ، ومِن باب المَثل الذي يقول : إيّاك أعني واسمَعي يا جارَه .
وبعد كلمات القسم تذكر السيدة زينب (عليها السلام) الأمور التي أقسَمَت من أجلها :
لا تُدرِك أمَدَنا ، ولا تَبلُغ غايتنا ، ولا تمحو ذكرنا
أمدنا : الأمد : الغاية والنهاية.
أي : مهما بذلت من الجهود ، وحاولتَ من المحاولات ، فسوف تفشل في ذلك ، فقد حاول ذلك مَن كان قبلك ـ وهو معاوية ـ فلم يستطع ذلك ، رغم أنّه كان أقوى منك.
ولا يُرحَضُ عنك عارُها
يُرحض : يُغسل.
تُصرّح السيدة زينب (عليها السلام) بحقيقة واقعيّة : وهي أنّ العار والخزي وسبّة التاريخ ، سوف تكون ملازمة ليزيد إلى الأبد ، ولا يتمكّن من غَسلها ، لا هو .. ولا مَن سيأتي من بعده من الشواذ الذين يُشاركونه في الإتجاه واللؤم.
إنّ التاريخ يقول : حينما بدأت الأمور تنقلب على يزيد ، فقد صارت مجالس تعليم القرآن الكريم .. في الشام يتحدّث فيها المعلّم عن جرائم يزيد في قتله الإمام الحسين (عليه السلام) وسبيه نساء آل رسول الله ، ثمّ بدأ الناس يُنقّبون ويُنَبّشون في ملف يزيد ، لِيَروا الفارق الواسع بين سيرته وأعماله ، وبين ما سمعوه أو قرأوه عن سيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله).
لمّا حدث كل هذا .. بدأ يزيد يُلقي باللوم على ابن زياد ، وصار يلعنه ويقول : إنّه قتل الحسين من تِلقاء نفسه.
ولكنّ جميع هذه المحاولات باءَت بالفشل والفضيحة الأكثر ليزيد!
وهل رأيُك إلا فَنَد ، وأيّامك إلا عدد ، وجمعك إلا بدَد
فند : الفند : الخطأ في القول والرأي. وقيل : الفند : هو الكَذِب.
لعلّ المعنى : أنّ رأيك ـ في تخطيطك ومحاولتك للتخلّص من مضاعفات جريمتك ـ خطأ وضعيف.
وأيّامك إلا عدد
العدد : هو الكميّة المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ بالمتعدّد في ذاته. وعدد : للتقليل : أي : معدود ، هو نقيض الكَثرة.
لعلّ المعنى : يا يزيد إنّ أيامك الباقية من عمرك قليلة ، فسوف لا تبقى في هذه الحياة إلا أياماً معدودة ، فأنتَ قريب إلى الموت والهلاك ، وبعد ذلك سوف تلاقي جزاء أعمالك ، فالعذاب منك قريب.
إنّ جريمة قتل الإمام الحسين (عليه السلام) أثّرت تأثيراً سلبيّاً في مقدار عمرك ، فجعلته قصيراً جدّاً.
فقد جاء في التاريخ : أنّ يزيد عاش بعد فاجعة كربلاء سنتين وشهرين وأربعة أيام ، فلم يَتَهنّا بطول الحياة وطول مدّة السلطة ، كما كان يتمنّى ذلك ، وكما كان يُتوقّعه بعد القضاء على منافسه ـ حسب زعمه ـ وهو الإمام الحسين (عليه السلام).
وجمعك إلا بدَد
بدَد : يُقال بَدّهُ بَدّاً : أي فَرّقَه ، وبَدّدَ الشيء : فَرّقَه والتَبَدّد : التفرُّق.
المعنى : سوف يتفرّق جمعك وجلاوزتك ، وحاشيتك التي كنت تسهرُ معهم على مائدة الخمر والقمار والغناء ، فسوف يغيبون عن عينك ، لمرض أو موت ، أو تتغيّر نظرتهم بالنسبة إليك ، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل كلّ يوم من الأيام يحمل لك حزناً وهمّاً جديداً ، فلا تتهنّا بمن حولك.
يوم ينادي المنادي : ألا لعن الله الظالم العادي
المعنى : يوم تموت ، وتسمع صوتاً مرعباً لمناد ينادي ـ من عند الله تعالى ـ : ألا لعن الله الظالم العادي فأوّل شيء تراه بعد موتك هو : سماعك لهذا الصوت.
وكلمة لعن الله الظالم أي : أبعده عن رحتمه وعفوه ومغفرته.
ثمّ .. بدأت السيدة زينب (عليها السلام) تُمهّد لختام خطبتها الخالدة ، فقالت : والحمد لله الذي حَكَم لأوليائه بالسعادة ، وختم لأصفيائه بالشهادة ، ببلوغ الإرادة
حَكَم لأوليائه : قضى لهم ، وقدّر لهم ذلك.
أصفيائه : الصفيّ مِن كلّ شيء صَفوُهُ ، وجمعُه : أصفياء.
بقلب مفعم بالإيمان بالله تعالى ، والرضا بما يختاره الله لعباده ، بدأت السيدة زينب (عليها السلام) تختم خطبتها بحمد الله سبحانه الذي قضى لأوليائه بالسعادة ، وتقصد من الأولياء ـ هنا ـ : الإمام الحسين (عليه السلام) ـ الذي هو سيد أولياء الله تعالى ـ وأصحابه الذي قُتلوا معه يوم عاشوراء ، ونالوا ـ بذلك ـ شرف الشهادة.
إنّ الإنسان الذي يلتزم بالدين ، ويصنع من نفسه وليّاً لله ـ وذلك بأدائه لِلَوازم العبودية لله سبحانه ـ سوف يحظى بنتائج إلهيّة فريدة ، وهي عبارة عن المِنَح المميزة ، والألطاف الخاصّة التي يُفيضها الله عليه ، والتي لا تشمل غيره من الناس ، ومن أبرز تلك الألطاف الخاصة : السعادة الأبدية ، ولعلّ إلى هذا المعنى الرفيع أشار الله تعالى بقوله : والله يختصّ برحمته من يشاء .
إنّ أولياء الله تعالى كانوا يفكّرون ـ باستمرار ـ في جَلب رضى الله سبحانه.
أجَل .. كان هذا هو الهدف الذي يُشغلون به بالهم ، ويتحرّكون في هذا المدار ويدورون حول هذا المحور.
ومن الطبيعي أنّهم كانوا ـ ولا زالوا ـ على درجات ، فهناك مَن يكون وليّاً لله تعالى منذ السنوات الأولى من حياته ، وهناك من يصير ولياً لله تعالى في مرحلة متقدّمة من العمر.
وعلى هذا الأساس يقضي الله ( عز وجل ) لهم بالفوز والتفوّق والسعادة الأبديّة ، بجميع ما لهذه الكلمة من معنى.
وأحياناً يُقدّر الله تعالى لهم بعض المكاره والصعوبات ، وذلك لأسرار وحِكَم يعلمها الله سبحانه ، فترى الأولياء يُظهرون من أنفسهم كلّ إستعداد وتحمّل وتقبّل لتلك المكاره ويستقبلونها بصدر واسع وصبر جميل.
وختم الله تعالى لأصفيائه بالشهادة ، فقد كانت حياتهم كلها خير وبركة منذ البداية إلى النهاية ، فمِن المؤسف ـ حقّاً أن يموت الوليّ ميتةً طبيعية على الفراش ، بل المتوقّع له أن يوفّقه الله تعالى للشهادة والقتل في سبيله ، لكي تكون لموته أصداءٌ تعود للدين بالفائدة ، كما كانت حياته كذلك.
فقتلهم يوقظ الغافلين غير المُلتزمين بالدين ، ويجعلهم يُفكّرون ويتساءلون عن سبب قتله رغم كونه إنساناً طيباً ، ويبحثون عن هويّة القاتل ، وهدفه من قتل هذا الرجل!
فتكون هذا الأصداء سبباً لعودة الكثيرين إلى الإلتزام الشديد بالدين ومبادئه.
أليس كذلك؟!
ولعلّ أولئك الأولياء هم الذين أرادوا أن يكون ختام حياتهم بالشهادة ، وسألوا من الله ( عزّ وجل ) ذلك ، فاستجاب الله ـ سبحانه ـ لهم دعاءهم ، وقدّر لهم الشهادة في سبيل الله تعالى ، ولعلّ هذا هو معنى كلام السيدة زينب (عليها السلام) : بِبلوغ الإرادة . نقلهم إلى الرحمة والرأفة ، والرضوان والمغفرة .
المعنى : نَقَلهم إلى عالم يُرَفرف على رؤوسهم رحمة الله الواسعة المخصّصة للشهداء في سبيل الله تعالى ، والرأفة : أي : العاطفة المزيجة باللطف والحنان ، التي لا تَشمَل غير الشهداء الذين باعوا أعزّ شيء لديهم ـ وهي حياتهم ـ للدين ، وفي سبيل المحافظة على روح الدين الذي كان يتجسّد في الإمام الحسين (عليه السلام) ، وعدم الرُضوخ لبيعة يزيد الكافر.
والرضوان والمغفرة إنّ القرآن الكريم يُصرّح بأن أعلى وأغلى وألذّ نعمة يتنعّم بها بعض أهل الجنّة ـ وفي طليعتهم شهداء فاجعة كربلاء ـ هو شعورهم وإحساسهم بأنّ الله تعالى راض عنهم ، قال تعالى : وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة في جنّات عدن ، ورضوان من الله أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم .
هذا سوى ما يُعيّن لهم من أنواع النِعَم والكرامة والإحترام اللائق .. الذي لا مَثيل له في عالم الدنيا!
يُضاف إلى ذلك : أنّ الرجل الذي يُقتَل في سبيل الله بنيّة خالصة سوف يمرّ نسيم العفو والمغفرة على ما صدر منه من مخالفات ، فيصير ملفّه أبيض لا سواد فيه.
إنّنا نقرأ في دعاء صلاة يوم عيد الفطر والأضحى : ... اللهم وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة ، وهذا لجميع المؤمنين التائبين ، ولكنّ الشهيد يمتاز بمزايا وتسهيلات خاصّة قرّرها الله تعالى للشهداء فقط.
هذا إذا كان الشهيد إنساناً عادياً غير معصوم من الذنوب ، أمّا إذا كان معصوماً فلا توجد في صحيفة أعماله ذنوب أو معاصي ، فيكون معنى المغفرة بالنسبة إليه علوّ درجته في الجنّة ، واختصاصه بمنح فريدة كالشفاعة للآخرين ، وغير ذلك من المميّزات.
وأمّا سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) فقد خاطبه الله تعالى ـ بقوله ـ : {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27 - 30] ، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّ المقصود والمُخاطب بهذه الآية : هي نفس الإمام الحسين (عليه السلام).
وكم تتضمّن هذه الآيات من كلمات وضمائر عاطفيّة!!
ولم يَشقَ بهم غيرك
المعنى : إنّ الذي صار شقيّاً وتعيساً ومطروداً من رحمة الله .. هو أنت يا يزيد ، .. بسبب قتلك إيّاهم وقضائك على حياتهم ، وطعنِك في قلب الإسلام النابض وهو الإمام الحسين (عليه السلام).
ولا ابتُليَ بهم سواك
إنّ الذي امتُحنَ بالقدرة والسلطة ومشاهدة كرسيّ الملك الذي مهّده له معاوية ، فاراد القضاء على كلّ من لا يركع له ، وبذلك سقط في الإمتحان سقوطاً ذريعاً هو أنت أيّها الخامل الحاقد!
أمّا الذين قُتِلوا مع الإمام الحسين (عليه السلام) ونالوا شرف الشهادة معه .. فهم قد نجحوا في الإمتحان نجاحاً باهراً وفوزاً متوالياً متواصلاً ، أي : كما كانوا مِن قَبل الشهادة ـ أيضاً ـ في مرحلة عالية من سلامة الفكر والعقيدة والسلوك ، والطاعة التامّة لإمام زمانهم الحسين (عليه السلام).
فهم ـ الآن ـ في أعلى درجات الجنان والتي يُعبّر عنها بـ الفردوس الأعلى .
أما أنت ـ يا يزيد ـ فسوف يكون مصيرك في أسفل دَرَك من الجحيم ، وفي ذلك التابوت الذي يُمَوّن جميع طبقات جهنّم بالحرارة العالية التي لا يُمكن للبشر ـ في هذه الدنيا ـ أن يتصوّر درجة حرارتها وشدّة اشتعالها.
قال تعالى ـ بالنسبة لأهل النار ـ : {وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} [إبراهيم: 17] .. وقال ( جلّ ثناؤه ) : وقالوا : يا مالِك! لِيَقضِ علينا ربّك؟ قال : إنّكم ماكثون .
ونَسأله أن يُكمِل لهم الأجر ، ويُجزل لهم الثواب والذخر
أكمَلَ الشيء : أتمّه ، وفي القرآن الكريم : اليوم أكملتُ لكم دينكم ويقال ـ أيضاً ـ : الكَمَلُ : الكامل ، يُقال : أعطاه حقّه كملاً : وافياً.
يُجزِل : الجَزلُ : العطاء الكثير ، ويُقال : أجزَل العطاء.
والجَزلُ : الكثير من كلّ شيء.
الثواب : الجزاء والعطاء ، وقيل : هو الجزاء الذي يُعطى مع الإحترام والإجلال والتقدير .. وليس مجرّد إعطاء الجزاء .
الذُخر : يُقال : ذَخَر لنفسه حديثاً حسناً.
المعنى : ونسأل الله تعالى أن يُكمِلَ لهم الجزاء المخصّص للشهداء ، جزاءً تامّاً يَليقُ بتقدير الله سبحانه للشهداء المخلصين ، الذين تركوا زوجاتهم أرامل ، وأطفالهم أيتام ، وأمّهاتهم ثُكالى .. كل ذلك .. في سبيل الله!
فيُعطيهم العطاء الكثير الوافر ، مع الإحترام والتقدير ، إذ قد يَدفع الإنسان الأجرة إلى العامل .. مِن دون أن تكون كيفيّة الإعطاء مقرونة بالإحترام ، أمّا الثواب : فهو إعطاء الأجر .. مع الإستقبال الحارّ ، والإحترام والإبتسامة واللُطف.
ويَكتُب لهم الثناء الجميل والذكر الحسن ، على ألسنة الناس وفي صفحات التاريخ.
وقد استجاب الله تعالى دُعاء السيدة زينب العظيمة (عليها السلام) ، فقد رُوي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه قال : ما مِن عبدٍ شرِب الماء فذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله إلا كتب الله له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة ، ورفع له مائة ألف درجة ، وكأنّما أعتق مائة ألف نَسَمة ، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثَلجَ الفؤاد .
وروي عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) أنّهما قالا : إنّ الله تعالى عوّض الحسين (عليه السلام) عن قتله أن : جعل الإمامة في ذريّته ، والشفاء في تربته ، وإجابة الدعاء عند قبره ، ولا تُعدّ أيام زائريه .. ـ جائياً وراجعاً ـ مِن عمره .
وقد روي ـ أيضاً ـ عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه أمَر رجلاً كان يريد الذهاب إلى زيارة قبر الإمام الحسين (عليه السلام) أن يزور قبور الشهداء ـ بعد الفراغ من زياة الإمام الحسين (عليه السلام) ـ ويُخاطبهم بهذه الكلمات : ... بأبي أنتم وأمّي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم ، وفزتم فوزاً عظيماً ... .
ونسأله حسنَ الخلافة ، وجميل الإنابة ، إنّه رحيم ودود ..
الخلافة : يُقال خَلَف فلان فلاناً .. خلفاً وخِلافةً : جاء بعده فصار مكانه . وفي الدعاء : أخلَفَ الله لك وعليك خيرا .
وفي الدعاء أيضاً : واخلُف على عَقِبِه في الغابرين .
الإنابة : الرجوع الى الله ، قال سبحانه : إرجعي إلى ربّك .
المعنى : ونسأل الله تعالى أن يُخلّف لناعمّن فقدناه أفراداً صالحين ، يسدّون بعض الفراغ الذي تركه مقتل أولئك الصفوة الطيّبة من رجال آل رسول الله (صلى الله عليه واله) بأن يجعل في البقيّة الباقية منهم خيراً.
أو : أن يجعل مستقبلنا مستقبلاً حسناً مريحاً ، بعد ما شاهدناه وعانيناه من المصائب الفجيعة التي لن تُنسى!!
إنتهت السيدة زينب البطلة الشجاعة ، مِن إلقاء خطبتها الخالدة.
والآن .. توجّهت أنظار الحاضرين إلى يزيد الحاقد لِيَروا منه ردود الفعل.
فما كان منه سوى أنّه عَلّق على هذه الخطبة المفصّلة بقوله :
يا صحيةً تُحمدُ من صوائح ... ما أهونَ الموت على النوائح
فهل إنعقد لسانه عن إجابة كلّ بند من بنود تلك الخطبة؟! أم أنّ أعصابه أُصيبت بالإنهيار والإهتزاز ، فلم يستطع التركيز والرد؟!
أم رأى أنّ الإجابة والتعليق يُسبّب له مزيداً من الفضيحة أمام تلك الجماهير الغفيرة الحاشدة في المجلس ، فرأى السكوت خيراً له من خَلق أجواء الحوار مع إبنة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) التي ظَهَرت جدارتها الفائقة على مقارعة أكبر طاغوت ، بكلام كلّه صدقٌ ، واستدلال منطقي وعَقلي مُقنع. وخاصة أنّ الجملات الأخيرة ـ التي كانت تَحمل في طيّاتها التهديد المُرعب ـ جعلت يزيد ينهار رغم ما كان يشعر به مِن تجبّر وكبرياء.



|
|
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|