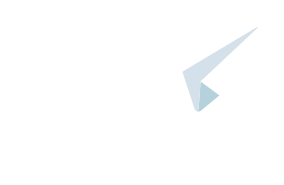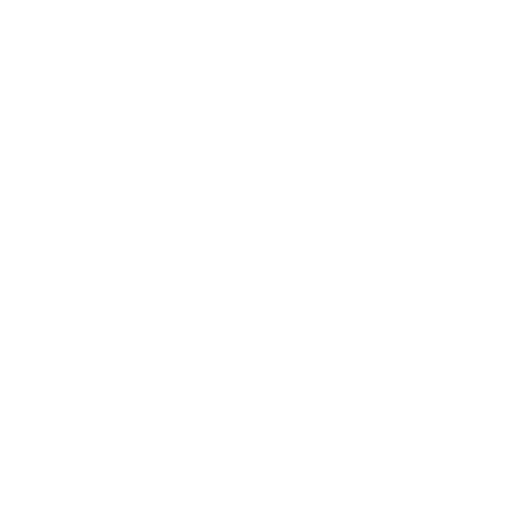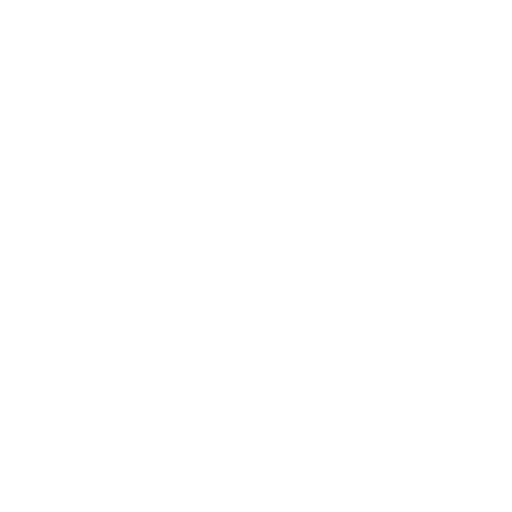تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (258) من سورة البقرة
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
10-5-2017
14028
قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 258].
لما بين تعالى أنه ولي المؤمنين وأن الكفار لا ولي لهم سوى الطاغوت تسلية لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلّم) قص عليه بعده قصة إبراهيم ونمرود فقال {أ لم تر} يا محمد أي أ لم ينته علمك ورؤيتك {إلى الذي حاج إبراهيم} أي إلى من كان كالذي حاج فكأنه قال هل رأيت كالذي حاج أي خاصم وجادل إبراهيم وهو نمرود بن كنعان وهو أول من تجبر وادعى الربوبية عن مجاهد وغيره وإنما أطلق لفظ المحاجة وإن كانت مجادلة بالباطل ولم تكن له فيه حجة لأن في زعمه أن له فيه حجة .
واختلف في وقت هذه المحاجة فقيل عند كسر الأصنام قبل إلقائه في النار وجعلها عليه بردا وسلاما عن الصادق (عليه السلام) {في ربه} أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده وعبادته {أن آتاه الله الملك} أي لأن آتاه الله الملك الهاء من آتاه تعود إلى المحاج لإبراهيم أي أعطاه الله الملك وهو نعيم الدنيا وسعة المال فبطر الملك حمله على محاجة إبراهيم عن الحسن والجبائي والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله تعالى به على كل أحد.
فأما الملك بتمليك الأمر والنهي وتدبير أمور الناس وإيجاب الطاعة على الخلق فلا يجوز أن يؤتيه الله إلا من يعلم أنه يدعو إلى الصلاح والسداد والرشاد دون من يدعو إلى الكفر والفساد ولا يصح منه لعلمه بالغيوب والسرائر تفويض الولاية إلى من هذا سبيله لما في ذلك من الاستفساد وقيل إن الهاء تعود إلى إبراهيم عن أبي القاسم البلخي.
ويسأل على هذا فيقال كيف يكون الملك لإبراهيم والحبس والإطلاق إلى نمرود وجوابه أن الحبس والإطلاق والأمر والنهي كان من جهة الله لإبراهيم وإنما كان نمرود يفعل ذلك على وجه القهر والغلبة لا من جهة ولاية شرعية {إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت} في الكلام حذف وهو إذ قال له نمرود من ربك فقال ربي الذي يحيي ويميت بدأ بذكر الحياة لأنها أول نعمة ينعم الله بها على خلقه ثم يميتهم وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله تعالى لأن الإماتة هي أن يخرج الروح من بدن الحي من غير جرح ولا نقص بنية ولا إحداث فعل يتصل بالبدن من جهته وهذا خارج عن قدرة البشر.
{قال أنا أحيي وأميت} أي فقال نمرود أنا أحيي بالتخلية من الحبس من وجب عليه القتل وأميت بالقتل من شئت ممن هو حي وهذا جهل من الكافر لأنه اعتمد في المعارضة على العبارة فقط دون المعنى عادلا عن وجه الحجة بفعل الحياة للميت أو الموت للحي على سبيل الاختراع الذي ينفرد به تعالى ولا يقدر عليه سواه {قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب} قيل في انتقاله من حجة إلى أخرى وجهان ( أحدهما ) أن ذلك لم يكن انتقالا وانقطاعا عن إبراهيم فإنه يجوز من كل حكيم إيراد حجة أخرى على سبيل التأكيد بعد تمام ما ابتدأ به من الحجاج وعلامة تمامه ظهوره من غير اعتراض عليه بشبهة لها تأثير عند التأمل والتدبر لموقعها من الحجة المعتمد عليها ( والثاني ) أن إبراهيم إنما قال ذلك ليبين أن من شأن من يقدر على إحياء الأموات وإماتة الأحياء أن يقدر على إتيان الشمس من المشرق فإن كنت قادرا على ذلك فأت بها من المغرب وإنما فعل ذلك لأنه لو تشاغل معه بأني أريت اختراع الموت والحيوة من غير سبب ولا علاج لاشتبه على كثير ممن حضر فعدل إلى ما هو أوضح لأن الأنبياء إنما بعثوا للبيان والإيضاح وليست أمورهم مبنية على تحاج الخصمين وطلب كل واحد منهما غلبة خصمه وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن إبراهيم (عليه السلام) قال له أحي من قتلته إن كنت صادقا ثم استظهر عليه مما قاله ثانيا {فبهت} الذي كفر أي تحير عند الانقطاع بما بأن من ظهور الحجة فإن قيل فهلا قال له نمرود فليأت بها ربك من المغرب قيل عن ذلك جوابان ( أحدهما ) أنه لما علم بما رأى من الآيات أنه لو اقترح ذلك لأتى به الله تصديقا لإبراهيم فكان يزداد بذلك فضيحة عدل عن ذلك ( والثاني ) أن الله خذله ولطف لإبراهيم حتى أنه لم يأت بشبهة ولم يلبس.
{والله لا يهدي القوم الظالمين} بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد وقيل معناه لا يهديهم إلى المحاجة كما يهدي أنبياءه وأولياءه وقيل معناه لا يهديهم بألطافه وتأييده إذا علم أنه لا لطف لهم وقيل لهم لا يهديهم إلى الجنة وهذا لا يعارض قوله وأما ثمود فهديناهم لأنا قد بينا معاني الهداية ووجوهها قبل عند قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فبعضها عام لجميع المكلفين وبعضها خاص للمؤمنين وفي هذه الآية دلالة على أن المعارف غير ضرورية إذ لو كانت كذلك لما صحت المحاجة في إثبات الصانع وفيها دلالة على فساد التقليد وحسن الحجاج وأنه تعالى إنما يعلم بأفعاله التي لا يقدر عليها غيره وفي تفسير ابن عباس أن الله سبحانه سلط على نمرود بعوضة فعضت شفتيه فأهوى إليها بيده ليأخذها فطارت في منخره فذهب ليستخرجها فطارت في دماغه فعذبه الله بها أربعين ليلة ثم أهلكه .
____________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي، ج2 ، ص167-169.
بيّن اللَّه سبحانه في الآية السابقة ان المؤمنين وليهم اللَّه ، وانهم يخرجون من ظلمة الشك إلى نور الهداية والايمان ، وان الكافرين أولياؤهم الطاغوت ، ويخرجون من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والضلال . ثم قص على نبيه الأكرم قصة المؤمن الذي خرج من ظلمة الشك إلى نور الايمان في الآية الآتية ، وقصة الكافر الذي حاج إبراهيم بعد أن خرج من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر ، قال سبحانه :
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي ويُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وأُمِيتُ } . وهذا الحوار يذكره اللَّه تعالى لنبيه وللناس كافة في أسلوب التعجب من المجادل مع الإنكار عليه .
دعا إبراهيم ( عليه السلام ) إلى نبذ الأصنام والطغاة ، والى دين العدالة والمساواة ، فعارضه وقاومه أهل الامتياز والحكام ، لا ايمانا منهم ببطلان دعوته ، بل خوفا على منافعهم ومكاسبهم ، وحرصا على استغلالهم ومناصبهم . . وكالمعتاد جادلوا إبراهيم باللسان ، ولما عجزوا وأفحموا أعلنوا عليه الحرب ، وحاولوا الخلاص منه بأحراقه في النار ، تماما كما يفعل المستعمرون في هذا العصر ، يبثون دعايات التضليل والتمويه عن طريق الصحف والإذاعات والأبواق المأجورة ، فان أخفقوا دبروا مؤامرات الانقلاب ، فان فشلوا ألقوا قنابل {النابالم} وغيرها على الآمنين والمستضعفين .
قال الذي أطغاه الجاه والمال لإبراهيم : من ربك ؟ قال إبراهيم : ربي الذي يهب الحياة لمن يشاء ، ثم يزيلها ، ولا أحد يشاركه في ذلك . قال الطاغية :
وأنا أيضا أقدر على ذلك ، ثم أحضر رجلين ، فقتل أحدهما ، وأرسل الآخر . .
ولما رأى إبراهيم مغالطة الطاغية وتدليسه بالاعتماد على حرفية اللفظ ، متجاهلا وجه الحجة ، والمعنى المقصود جاءه بمثال آخر لا يمكن أن يغالط فيه ويدعيه ، وقال :
{فَإِنَّ اللَّهً يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} .
لأنه عجز عن التمويه والتضليل ، وهكذا كل مبطل يلجأ في تلفيق حججه إلى التزييف والتدليس ، فإذا لم تنطل الحيلة أسقط في يده ، وأخذته الدهشة والحيرة .
وقال جماعة من المفسرين : ان إبراهيم عدل عن الجواب الأول ، وهو يحيي ويميت إلى جواب ثان ، وهو فأت بها من المغرب ، ليقطع الجدال عن قريب ، ولا يطيل النقاش . وقال الرازي والشيخ محمد عبده : ليس قوله : فأت بها من المغرب جوابا آخر ، بل هو انتقال من مثال ، لتوضيح الدليل ، إذ المعنى ان الذي أعطى الحياة هو الذي أتى بالشمس من المشرق ، وإذا استطعت التمويه على قومك بالمثال الأول فإنك أعجز من أن تموه عليهم في هذا المثال .
وسواء أكان قول إبراهيم جوابين ، أم مثالين فان الذي كفر قد أفحم ، وانما افحم لأنه مبطل ، وهو مبطل لأنه كافر . {واللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } .
الذين ظلموا أنفسهم بمناصرة الباطل ، ومعارضة الحق .
ولم تذكر الآية اسم الطاغية ، لأن المهم استخراج العبرة من القصة ، لا اسم ( بطلها ) . والمشهور انه نمرود بن كنعان بن سام بن نوح ، وقيل : هو أول من وضع التاج على رأسه ، وتجبر وادعى الربوبية . . وسنعود إلى قصة إبراهيم وقومه في سورة الأنبياء ، وغيرها ، حيث تدعو المناسبة .
_________________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص403-404.
الآية مشتملة على معنى التوحيد ولذلك كانت غير خالية عن الارتباط بما قبلها من الآيات فمن المحتمل أن تكون نازلة معها.
قوله تعالى: {أ لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه}، المحاجة إلقاء الحجة قبال الحجة لإثبات المدعى أو لإبطال ما يقابله، وأصل الحجة هو القصد، غلب استعماله فيما يقصد به إثبات دعوى من الدعاوي، وقوله: {في ربه} متعلق بحاج، والضمير لإبراهيم كما يشعر به قوله تعالى فيما بعد: {قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت}، وهذا الذي حاج إبراهيم (عليه السلام) في ربه هو الملك الذي كان يعاصره وهو نمرود من ملوك بابل على ما يذكره التاريخ والرواية.
وبالتأمل في سياق الآية، والذي جرى عليه الأمر عند الناس ولا يزال يجري عليه يعلم معنى هذه المحاجة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، والموضوع الذي وقعت فيه محاجتهما.
بيان ذلك: أن الإنسان لا يزال خاضعا بحسب الفطرة للقوى المستعلية عليه، المؤثرة فيه، وهذا مما لا يرتاب فيه الباحث عن أطوار الأمم الخالية المتأمل في حال الموجودين من الطوائف المختلفة وقد بينا ذلك فيما مر من المباحث.
وهو بفطرته يثبت للعالم صانعا مؤثرا فيه بحسب التكوين والتدبير، وقد مر أيضا بيانه، وهذا أمر لا يختلف في القضاء عليه حال الإنسان سواء قال بالتوحيد كما يبتني عليه دين الأنبياء وتعتمد عليه دعوتهم أو ذهب إلى تعدد الآلهة كما عليه الوثنيون أو نفي الصانع كما عليه الدهريون والماديون، فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما دام الإنسان إنسانا وإن قبلت الغفلة والذهول.
لكن الإنسان الأولي الساذج لما كان يقيس الأشياء إلى نفسه، وكان يرى من نفسه أن أفعاله المختلفة تستند إلى قواه وأعضائه المختلفة، وكذا الأفعال المختلفة الاجتماعية تستند إلى أشخاص مختلفة في الاجتماع، وكذا الحوادث المختلفة إلى علل قريبة مختلفة وإن كانت جميع الأزمة تجتمع عند الصانع الذي يستند إليه مجموع عالم الوجود لا جرم أثبت لأنواع الحوادث المختلفة أربابا مختلفة دون الله سبحانه فتارة كان يثبت ذلك باسم أرباب الأنواع كرب الأرض ورب البحار ورب النار ورب الهواء والأرياح وغير ذلك، وتارة كان يثبته باسم الكواكب وخاصة السيارات التي كان يثبت لها على اختلافها تأثيرات مختلفة في عالم العناصر والمواليد كما نقل عن الصابئين ثم كان يعمل صورا وتماثيل لتلك الأرباب فيعبدها لتكون وسيلة الشفاعة عند صاحب الصنم ويكون صاحب الصنم شفيعا له عند الله العظيم سبحانه، ينال بذلك سعادة الحياة والممات.
ولذلك كانت الأصنام مختلفة بحسب اختلاف الأمم والأجيال لأن الآراء كانت مختلفة في تشخيص الأنواع المختلفة وتخيل صور أرباب الأنواع المحكية بأصنامها، وربما لحقت بذلك أميال وتهوسات أخرى.
وربما انجر الأمر تدريجا إلى التشبث بالأصنام ونسيان أربابها حتى رب الأرباب لأن الحس والخيال كان يزين ما ناله لهم، وكان يذكرها وينسى ما وراءها، فكان يوجب ذلك غلبة جانبها على جانب الله سبحانه، كل ذلك إنما كان منهم لأنهم كانوا يرون لهذه الأرباب تأثيرا في شئون حياتهم بحيث تغلب إرادتها إرادتهم، وتستعلي تدبيرها على تدبيرهم.
وربما كان يستفيد بعض أولي القوة والسطوة والسلطة من جبابرة الملوك من اعتقادهم ذلك ونفوذ أمره في شئون حياتهم المختلفة، فيطمع في المقام ويدعي الألوهية كما ينقل عن فرعون ونمرود وغيرهما، فيسلك نفسه في سلك الأرباب وإن كان هو نفسه يعبد الأصنام كعبادتهم، وهذا وإن كان في بادئ الأمر على هذه الوتيرة لكن ظهور تأثيره ونفوذ أمره عند الحس كان يوجب تقدمه عند عباده على سائر الأرباب وغلبة جانبه على جانبها، وقد تقدمت الإشارة إليه آنفا كما يحكيه الله تعالى من قول فرعون لقومه: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24] ، فقد كان يدعي أنه أعلى الأرباب مع كونه ممن يتخذ الأرباب كما قال تعالى: {وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ } [الأعراف: 127] ، وكذلك كان يدعي نمرود على ما يستفاد من قوله: {أنا أحيي وأميت}، في هذه الآية على ما سنبين.
وينكشف بهذا البيان معنى هذه المحاجة الواقعة بين إبراهيم (عليه السلام) ونمرود، فإن نمرود كان يرى لله سبحانه ألوهية، ولولا ذلك لم يسلم لإبراهيم (عليه السلام) قوله: {إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب}، ولم يبهت عند ذلك بل يمكنه أن يقول: أنا آتي بها من المشرق دون من زعمت أو أن بعض الآلهة الأخرى يأتي بها من المشرق، وكان يرى أن هناك آلهة أخرى دون الله سبحانه، وكذلك قومه كانوا يرون ذلك كما يدل عليه عامة قصص إبراهيم (عليه السلام) كقصة الكوكب والقمر والشمس وما كلم به أباه في أمر الأصنام وما خاطب به قومه وجعله الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم وغير ذلك، فقد كان يرى لله تعالى ألوهية، وأن معه آلهة أخرى لكنه كان يرى لنفسه ألوهية، وأنه أعلى الآلهة، ولذلك استدل على ربوبيته عند ما حاج إبراهيم (عليه السلام) في ربه، ولم يذكر من أمر الآلهة الأخرى شيئا.
ومن هنا يستنتج أن المحاجة التي وقعت بينه وبين إبراهيم (عليه السلام) هي، أن إبراهيم (عليه السلام) كان يدعي أن ربه الله لا غير ونمرود كان يدعي أنه رب إبراهيم وغيره ولذلك لما احتج إبراهيم (عليه السلام) على دعواه بقوله: {ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت} ، فادعى أنه متصف بما وصف به إبراهيم ربه فهو ربه الذي يجب عليه أن يخضع له ويشتغل بعبادته دون الله سبحانه ودون الأصنام، ولم يقل: وأنا أحيي وأميت لأن لازم العطف أن يشارك الله في ربوبيته ولم يكن مطلوبه ذلك بل كان مطلوبه التعين بالتفوق كما عرفت، ولم يقل أيضا: والآلهة تحيي وتميت.
ولم يعارض إبراهيم (عليه السلام) بالحق، بل بالتمويه والمغالطة وتلبيس الأمر على من حضر، فإن إبراهيم (عليه السلام) إنما أراد بقوله: {ربي الذي يحيي ويميت}، الحياة والموت المشهودين في هذه الموجودات الحية الشاعرة المريدة فإن هذه الحياة المجهولة لكنه لا يستطيع أن يوجدها إلا من هو واجد لها فلا يمكن أن يعلل بالطبيعة الجامدة الفاقدة لها، ولا بشيء من هذه الموجودات الحية، فإن حياتها هي وجودها، وموتها عدمها، والشيء لا يقوى لا على إيجاد نفسه ولا على إعدام نفسه، ولوكان نمرود أخذ هذا الكلام بالمعنى الذي له لم يمكنه معارضته بشيء لكنه غالط فأخذ الحياة والموت بمعناهما المجازي أو الأعم من معناهما الحقيقي والمجازي فإن الإحياء كما يقال على جعل الحياة في شيء كالجنين إذا نفخت فيه الحياة كذلك يقال: على تلخيص إنسان من ورطة الهلاك، وكذا الإماتة تطلق على التوفي وهو فعل الله وعلى مثل القتل بآلة قتالة، وعند ذلك أمر بإحضار رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر فقتل هذا وأطلق ذاك فقال: أنا أحيي وأميت، ولبس الأمر على الحاضرين فصدقوه فيه، ولم يستطع لذلك إبراهيم (عليه السلام) أن يبين له وجه المغالطة، وأنه لم يرد بالإحياء والإماتة هذا المعنى المجازي، وأن الحجة لا تعارض الحجة، ولوكان في وسعه (عليه السلام) ذلك لبينه، ولم يكن ذلك إلا لأنه شاهد حال نمرود في تمويهه، وحال الحضار في تصديقهم لقوله الباطل على العمياء، فوجد أنه لوبين وجه المغالطة لم يصدقه أحد، فعدل إلى حجة أخرى لا يدع المكابر أن يعارضه بشيء فقال إبراهيم (عليه السلام): إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، وذلك أن الشمس وإن كانت من جملة الآلهة عندهم أو عند بعضهم كما يظهر من ما يرجع إلى الكوكب والقمر من قصته (عليه السلام) لكنها وما يلحق وجودها من الأفعال كالطلوع والغروب مما يستند بالآخرة إلى الله الذي كانوا يرونه رب الأرباب، والفاعل الإرادي إذا اختار فعلا بالإرادة كان له أن يختار خلافه كما اختار نفسه فإن الأمر يدور مدار الإرادة، وبالجملة لما قال إبراهيم ذلك بهت نمرود، إذ ما كان يسعه أن يقول: إن هذا الأمر المستمر الجاري على وتيرة واحدة وه وطلوعها من المشرق دائما أمر اتفاقي لا يحتاج إلى سبب، ولا كان يسعه أن يقول: إنه فعل مستند إليها غير مستند إلى الله فقد كان يسلم خلاف ذلك، ولا كان يسعه أن يقول: إني أنا الذي آتيها من المشرق وإلا طولب بإتيانها من المغرب، فألقمه الله حجرا وبهته، والله لا يهدي القوم الظالمين.
قوله تعالى: {أن آتاه الله الملك}، ظاهر السياق: أنه من قبيل قول القائل: أساء إلي فلان لأني أحسنت إليه يريد: أن إحساني إليه كان يستدعي أن يحسن إلي لكنه بدل الإحسان من الإساءة فأساء إلي، وقولهم: واتق شر من أحسنت إليه، قال الشاعر:
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر. *** وحسن فعل كما يجزى سنمار.
فالجملة أعني قوله: {أن آتاه الله الملك} بتقدير لام التعليل وهي من قبيل وضع الشيء موضع ضده للشكوى والاستعداء ونحوه، فإن عدوان نمرود وطغيانه في هذه المحاجة كان ينبغي أن يعلل بضد إنعام الله عليه بالملك، لكن لما لم يتحقق من الله في حقه إلا الإحسان إليه وإيتاؤه الملك فوضع في موضع العلة فدل على كفرانه لنعمة الله فهو بوجه كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8]، فهذه نكتة في ذكر إيتائه الملك.
وهناك نكتة أخرى وهي: الدلالة على رداءة دعواه من رأس، وذلك أنه إنما كان يدعي هذه الدعوى لملك آتاه الله تعالى من غير أن يملكه لنفسه، فهو إنما كان نمرود الملك ذا السلطة والسطوة بنعمة من ربه، وأما هو في نفسه فلم يكن إلا واحدا من سواد الناس لا يعرف له وصف، ولا يشار إليه بنعت، ولهذا لم يذكر اسمه وعبر عنه بقوله: {الذي حاج إبراهيم في ربه}، دلالة على حقارة شخصه وخسة أمره.
وأما نسبة ملكه إلى إيتاء الله تعالى فقد مر في المباحث السابقة: أنه لا محذور فيه، فإن الملك وهو نوع سلطنة منبسطة على الأمة كسائر أنواع السلطنة والقدرة نعمة من الله وفضل يؤتيه من يشاء، وقد أودع في فطرة الإنسان معرفته، والرغبة فيه، فإن وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة، قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ } [القصص: 77] ، وإن عدا طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة وبوارا، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} [إبراهيم: 28] ، وقد مر بيان أن لكل نسبة إليه تعالى على ما يليق بساحة قدسه تعالى وتقدس من جهة الحسن الذي فيه دون جهة القبح والمساءة.
ومن هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسرين: أن الضمير في قوله أن آتيه الله الملك، يعود إلى إبراهيم (عليه السلام)، والمراد بالملك ملك إبراهيم كما قال تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا } [النساء: 54] ، لا ملك نمرود لكونه ملك جور ومعصية لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه.
ففيه أولا: أن القرآن ينسب هذا الملك وما في معناه كثيرا إليه تعالى كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون: {يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ} [غافر: 29] و، قوله تعالى حكاية عن فرعون - وقد أمضاه بالحكاية -: { قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ} [الزخرف: 51] ، وقد قال تعالى: {لَهُ الْمُلْكُ } [التغابن: 1] ، فقصر كل الملك لنفسه فما من ملك إلا وهو منه تعالى، وقال تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام): { رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً} [يونس: 88] ، وقال تعالى في قارون: {وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} [القصص: 76] ، وقال تعالى خطابا لنبيه: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا} [المدثر: 11، 12] - إلى أن قال -: { وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ } ، إلى غير ذلك.
وثانيا: أن ذلك لا يلائم ظاهر الآية فإن ظاهرها أن نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده وإيمانه لا أنه كان ينازعه ويحاجه في ملكه فإن ملك الظاهر كان لنمرود، وما كان يرى لإبراهيم ملكا حتى يشاجره فيه.
وثالثا: أن لكل شيء نسبة إلى الله سبحانه والملك من جملة الأشياء ولا محذور في نسبته إليه تعالى وقد مر تفصيل بيانه.
قوله تعالى: {قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت}، الحياة والموت وإن كانا يوجدان في غير جنس الحيوان أيضا كالنبات، وقد صدقه القرآن كما مر بيانه في تفسير آية الكرسي، لكن مراده (عليه السلام) منهما إما خصوص الحياة والممات الحيوانيين أو الأعم الشامل له لإطلاق اللفظ، والدليل على ذلك قول نمرود: أنا أحيي وأميت، فإن هذا الذي ادعاه لنفسه لم يكن من قبيل إحياء النبات بالحرث والغرس مثلا، ولا إحياء الحيوان بالسفاد والتوليد مثلا، فإن ذلك وأشباهه كان لا يختص به بل يوجد في غيره من أفراد الإنسان، وهذا يؤيد ما وردت به الروايات: أنه أمر بإحضار رجلين ممن كان في سجنه فأطلق أحدهما وقتل الآخر، وقال عند ذلك: أنا أحيي وأميت.
وإنما أخذ (عليه السلام) في حجته الإحياء والإماتة لأنهما أمران ليس للطبيعة الفاقدة للحياة فيهما صنع، وخاصة الحياة التي في الحيوان حيث تستتبع الشعور والإرادة وهما أمران غير ماديين قطعا، وكذا الموت المقابل لها، والحجة على ما فيها من السطوع والوضوح لم تنجح في حقهم، لأن انحطاطهم في الفكر وخبطهم في التعقل كان فوق ما كان يظنه (عليه السلام) في حقهم، فلم يفهموا من الإحياء والإماتة إلا المعنى المجازي الشامل لمثل الإطلاق والقتل، فقال نمرود: أنا أحيي وأميت وصدقه من حضره، ومن سياق هذه المحاجة يمكن أن يحدس المتأمل ما بلغ إليه الانحطاط الفكري يومئذ في المعارف والمعنويات، ولا ينافي ذلك الارتقاء الحضاري والتقدم المدني الذي يدل عليه الآثار والرسوم الباقية من بابل كلدة ومصر الفراعنة وغيرهما، فإن المدنية المادية أمر والتقدم في معنويات المعارف أمر آخر، وفي ارتقاء الدنيا الحاضرة في مدنيتها وانحطاطها في الأخلاق والمعارف المعنوية ما تسقط به هذه الشبهة.
ومن هنا يظهر: وجه عدم أخذه (عليه السلام) في حجته مسألة احتياج العالم بأسره إلى الصانع الفاطر للسماوات والأرض كما أخذ به في استبصار نفسه في بادي أمره على ما يحكيه الله عنه بقوله: {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 79] ، فإن القوم على اعترافهم بذلك بفطرتهم إجمالا كانوا أنزل سطحا من أن يعقلوه على ما ينبغي أن يعقل عليه بحيث ينجح احتجاجه ويتضح مراده (عليه السلام)، وناهيك في ذلك ما فهموه من قوله: {ربي الذي يحيي ويميت}.
قوله تعالى: {قال أنا أحيي وأميت}، أي فأنا ربك الذي وصفته بأنه يحيي ويميت.
قوله تعالى: {قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر} ، لما أيس (عليه السلام) من مضي احتجاجه بأن ربه الذي يحيي ويميت، لسوء فهم الخصم وتمويهه وتلبيسه الأمر على من حضر عندهما عدل عن بيان ما هو مراده من الإحياء والإماتة إلى حجة أخرى، إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية على دعوى الخصم في الحجة الأولى كما يدل عليه التفريع بالفاء في قوله: {فإن الله} "إلخ"، والمعنى: إن كان الأمر كما تقول: إنك ربي ومن شأن الرب أن يتصرف في تدبير أمر هذا النظام الكوني فالله سبحانه يتصرف في الشمس بإتيانها من المشرق فتصرف أنت بإتيانها من المغرب حتى يتضح أنك رب كما أن الله رب كل شيء أو أنك الرب فوق الأرباب فبهت الذي كفر، وإنما فرع الحجة على ما تقدمها لئلا يظن أن الحجة الأولى تمت لنمرود وأنتجت ما ادعاه، ولذلك أيضا قال: {فإن الله} ولم يقل: فإن ربي لأن الخصم استفاد من قوله: {ربي سوءا} وطبقه على نفسه بالمغالطة فأتى (عليه السلام) ثانيا بلفظة الجلالة ليكون مصونا عن مثل التطبيق السابق! وقد مر بيان أن نمرود ما كان يسعه أن يتفوه في مقابل هذه الحجة بشيء دون أن يبهت فيسكت.
قوله تعالى: {والله لا يهدي القوم الظالمين}، ظاهر السياق أنه تعليل لقوله فبهت الذي كفر فبهته هو عدم هداية الله سبحانه إياه لا كفره، وبعبارة أخرى معناه أن الله لم يهده فبهت لذلك ولو هداه لغلب على إبراهيم في الحجة لا أنه لم يهده فكفر لذلك وذلك لأن العناية في المقام متوجهة إلى محاجته إبراهيم (عليه السلام) لا إلى كفره وهو ظاهر.
ومن هنا يظهر: أن في الوصف إشعارا بالعلية أعني: أن السبب لعدم هداية الله الظالمين هو ظلمهم كما هو كذلك في سائر موارد هذه الجملة من كلامه تعالى كقول: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الصف: 7] ، وقوله: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الجمعة: 5] ، ونظير الظلم الفسق في قوله تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [الصف: 5].
وبالجملة الظلم وهو الانحراف عن صراط العدل والعدول عما ينبغي من العمل إلى غير ما ينبغي موجب لعدم الاهتداء إلى الغاية المقصودة، ومؤد إلى الخيبة والخسران بالأخرة، وهذه من الحقائق الناصعة التي ذكرها القرآن الشريف وأكد القول فيها في آيات كثيرة.
________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2 ، ص296-302.
محاجة إبراهيم مع طاغوت زمانه :
تعقيباً على الآية السابقة التي تناولت هداية المؤمنين بواسطة نور الولاية والهداية الإلهيّة، وضلال الكافرين لاتّباعهم الطاغوت، يذكر الله تعالى في هذه الآية : عدّة شواهد لذلك، وأحدها ما ورد في الآية أعلاه وهي تتحدّث عن الحوار الذي دار بين إبراهيم (عليه السلام) وأحد الجبّارين في زمانه ويدعى (نمرود) فتقول : {ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربّه}.
وتعقِّب الآية بجمله اُخرى تشير فيها إلى الدافع الأساس لها وتقول : إنّ ذلك الجبّار تملّكه الغرور والكبر وأسكره الملك {أن آتاه الله الملك}.
وما أكثر الأشخاص الذين نجدهم في الحالات الطبيعيّة أفراد معتدلين ومؤمنين، ولكن عندما يصلون إلى مقام أو ينالون ثروةً فأنّهم ينسون كلّ شيء ويسحقون كلّ المقدّسات.
وتضيف الآية أنّ ذلك الجبّار سأل إبراهيم عن ربّه : من هو الإله الذي تدعوني إليه ؟ {إذ قال إبراهيم ربّ الذي يحيي ويميت}.
الواقع أنّ أعظم قضيّة في العالم هي قضيّة الخلقة، يعني قانون الحياة والموت الذي هو أوضح آية على علم الله وقدرته.
ولكن نمرود الجبّار إتّخذ طريق المجادلة والسفسطة وتزييّف الحقائق لإغفال الناس والملأ من حوله فقال : إنّ قانون الحياة والموت بيدي (قال أنا أحيي واُميت).
ومن أجل إثبات هذه الدعوى الكاذبة استخدم حيلة كما ورد في الرواية المعروفة حيث أمر بإحضار سجينين أطلق سراح أحدهما وأمر بقتل الآخر، ثمّ قال لإبراهيم والحضّار : أرأيتم كيف أحيي وأُميت(2).
ولكنّ إبراهيم قدّم دليلاً آخر لإحباط هذه الحيلة وكشف زيف المدّعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك من إغفال النّاس فقال : {قال إبراهيم فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب} وهنا ألقم هذا المعاند حجراً {فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين}.
وبهذا اُسقط في يدي العدو المغرور، وعجز عن الكلام أمام منطق إبراهيم الحيّ، وهذا أفضل طريق لاسكات كلّ عدو عنيد. بالرغم من أنّ مسألة الحياة والموت أهم من قضيّة حركة الشمس وشروقها وغروبها من حيث كونها برهاناً على علم الله وقدرته، ولهذا السبب أورده إبراهيم دليلاً أوّل، ولوكان في ذلك المجلس عقلاء ومتفكِّرون لاَكتفوا بهذا الدليل واقتنعوا به، إذ أنّ كلّ شخص يعرف أنّ مسألة اطلاق سراح سجين وقتل آخر لا علاقة له بقضيّة الإحياء والإماتة الطبيعيتين أبداً، ولكن قد يكون هذا الدليل غير كاف لأمثال هؤلاء السذّج، ويحتمل وقوعهم تحت تأثير سفسطة ذلك الجبّار المكّار، فلهذا قدّم إبراهيم (عليه السلام)دليله الآخر وهو مسألة طلوع وغروب الشمس لكي يتضح الحق للجميع(3).
وما أحسن ما صنع إبراهيم (عليه السلام) من تقديمه مسألة الحياة والموت كدليل على المطلوب حتّى يدّعي ذلك الجبّار مشاركة الله تعالى في تدبير العالم، ثمّ طرح مسألة طلوع وغروب الشمس بعد ذلك ليتّضح زيف دعواه ويحجم عن دعوى المشاركة.
ويتّضح ضمناً من جملة {والله لا يهدي القوم الظالمين} أنّ الهداية والضلالة بالرغم من أنّهما من أفعال الله تعالى، إلاّ أنّ مقدّماتهما بيد العباد، فارتكاب الآثام من قبيل الظلم والجور والمعاصي المختلفة تشكّل على القلب والبصيرة حجبٌ مظلمة تمنع من أدراك الحقائق على حقيقتها.
________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج2 ، ص98-99.
2- تفسير مجمع البيان ، ذيل الاية مورد البحث ، وبحار الانوار ، ج12 ، ص34.
3 ـ إن الاستدلال الثاني يبدأ (بالفاء) وقد يكون إشارة إلى أن الاستدلال الثاني لا يعني صرف النظر عن الاستدلال الأوّل بل تضاف إليه.
 الاكثر قراءة في سورة البقرة
الاكثر قراءة في سورة البقرة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












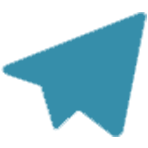
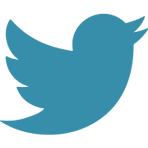

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)