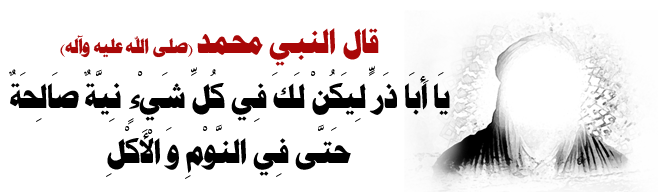
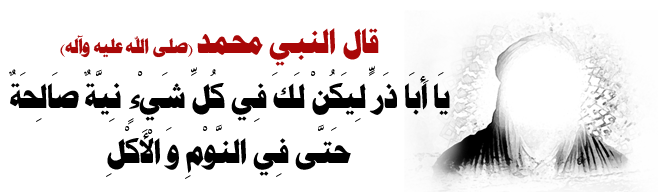

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
التاريخ: 9-9-2016
التاريخ: 9-9-2016
التاريخ: 10-9-2016
|
ليس المراد من الفرد المردد هو المردد بحسب الواقع ونفس الأمر ، إذ لا نتعقل معنى لذلك ، فالمحتملات المتصورة لمعنى الفرد المردد واقعا لا تخلو عن أحد معان أربعة وكلها مستحيلة :
المعنى الاول : ان يكون التردّد من جهة الوجود والعدم بمعنى ان يكون الفرد المردد مردّدا واقعا بين الوجود والعدم ، وهو مستحيل ، إذ لا واسطة بين الوجود والعدم ، فإما ان يكون الفرد بحسب الواقع موجودا واما ان يكون في حيز العدم ، وأما افتراض تردده بحسب الواقع بين الوجود والعدم فهذا معناه ارتفاع النقيضين في مورده ، واستحالة ذلك من الوضوح بحيث لا يتعقل ان يحتمله أحد.
المعنى الثاني : ان يكون التردّد من جهة التشخّص ، بمعنى ان لا يكون للفرد المردد ما يشخصه واقعا وفي نفس الأمر ، وهذا ما أوجب نعته بالمردد ، فهو مجرّد من تمام المشخصات الزمانية والمكانية وغيرها. وهذا مستحيل أيضا ، لأنّ افتراض وجود الفرد المردد يساوق تشخصه ، لأنّ الشيء ما لم يتشخص لا يوجد.
المعنى الثالث : ان يكون التردد هو جهة التشخص للفرد المردد ، فكما انّ سائر الأفراد الموجودة لها ما يشخصها ويميزها فإنّ ما يشخص الفرد المردد ويميزه هو التردد ، وهذا ما لا نفهم له معنى محصلا ، إذ انّ التردد يباين التشخّص فكيف يكون ما به التشخّص مباينا للتشخص.
المعنى الرابع : ان يكون التردّد من جهة قابلية الفرد المردد للصدق على كثيرين ، وهذا المعنى ان كان المراد منه الكلي فهو معنى معقول لكنه غير مراد حتما ولو كان مرادا فهو من سوء التعبير ، وان كان المراد منه الجزئي بالحمل الشائع فهو مستحيل لأن الجزئي يمتنع فرض صدقه إلاّ على نفسه.
وبهذا اتضح انّ الفرد المردد الذي نبحث عن امكان جريان الاستصحاب في مورده ليس المقصود منه الفرد المردد واقعا ، وانّما هو الفرد المردد عند المكلّف المتشخّص في نفس الأمر والواقع.
وقد ذكروا له صورتين :
الصورة الاولى : هو القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، وهو ما لو علم المكلف بتحقّق الكلّي بواسطة فرده إلاّ انّ هذا الفرد مردد بين فردين لو كان الاول لكان قد انتفى يقينا ، ولو كان الثاني فهو باق يقينا.
ومثاله ما لو علم المكلف بجامع الحدث بواسطة العلم بصدور إما حدث البول أو حدث الجنابة ، فلو كان الصادر عنه هو حدث البول فهو مرتفع يقينا ، وذلك لافتراض توضأ المكلّف بعد العلم بصدور جامع الحدث ، ولو كان الصادر عنه هو حدث الجنابة فهو باق يقينا.
وهنا ذكر الأعلام انّ الذي يمكن استصحابه هو كلّي الحدث باعتبار توفّره على أركان الاستصحاب ، إلاّ انّه في مقابل ذلك ذكر بعض الأعلام امكانية استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين ولا حاجة لاستصحاب الكلّي.
ولا يخلو كلامه من غموض ، إذ انّ مراده ـ كما أفاد المحقق النائيني ـ ان كان هو استصحاب الفرد الخارجي دون ملاحظة خصوصية الفردين والتي هي في المثال الجنابة والبول فهذا هو استصحاب الكلي ، إذ انّ تجريد الحدث عن خصوصية الجنابة وخصوصية البول تقتضي ان يكون المستصحب هو جامع الحدث ، وان كان مراده استصحاب الفرد على تقدير خصوصيته الاولى واستصحابه على تقدير خصوصيته الثانية فهو ممتنع قطعا لأنّه على تقدير خصوصيته الاولى « حدث البول » منتف جزما ـ كما هو الفرض ـ فلا شك في البقاء على تقدير هذه الخصوصية وعلى تقدير الخصوصية الثانية « حدث الجنابة » لا يقين بالحدوث.
الصورة الثانية : هي افتراض علم المكلّف بجامع التكليف مثلا مع التردد فيما هو متعلّقه واقعا وهل هو الفرد الأول أو الفرد الثاني ، ثم يحتمل ارتفاع الجامع بسبب احتمال عروض ما يوجب ارتفاع متعلّقه الواقعي.
والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة انّ منشأ الشك في بقاء الجامع في الصورة الاولى هو الجزم بارتفاع أحد الفردين ، وحينها لو كان هو المتعلّق واقعا للجامع لكان الجامع قد ارتفع، ولمّا لم نكن نحرز انّه متعلّق الجامع واقعا أدى ذلك للشك في بقاء الجامع ، وأما منشأ الشك في بقاء الجامع في هذه الصورة فهو احتمال عروض ما يوجب ارتفاع متعلّق الجامع واقعا ، ومن هنا وقع الشك في بقاء الجامع.
ومثال هذه الصورة ما لو علم المكلّف بوجوب احدى الصلاتين ، اما صلاة الطواف أو صلاة الآيات ثم احتمل ارتفاع الوجوب بسبب نسخ أو انتفاء الموضوع.
وهنا لا يمكن استصحاب الفرد المردد لو كان بمعنى استصحاب الفرد على تقدير خصوصيّته الاولى واستصحابه على تقدير خصوصيته الثانية ، امّا استصحابه بقطع النظر عن الخصوصيتين فهو استصحاب لجامع التكليف المعلوم تفصيلا. والظاهر امكان استصحاب تنجّز الفرد الاول واستصحاب تنجّز الفرد الثاني.



|
|
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم دعوة إلى كلية مزايا الجامعة للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|