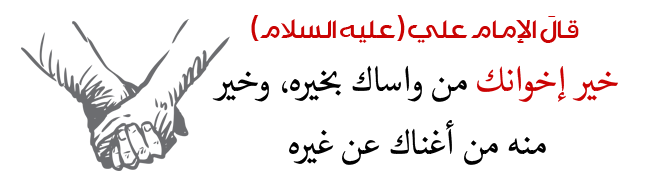
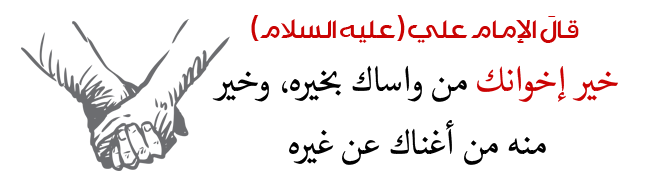

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
التاريخ: 15-7-2020
التاريخ: 9-8-2016
التاريخ: 13-7-2020
|
تمهيد: عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور. ومرادهم من كلمة (التعادل) تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ومرادهم من كلمة (التراجيح): جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر، إذ جمعه ترجيحات. والمقصود منه المصدر بمعنى ألفاعل، أي المرجح. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون (التعادل)، لان المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون الا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث: بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأنسب ان تعنون المسألة بعنوان (التعارض بين الأدلة)، لان التعادل والترجيح بين الأدلة انما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير انه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها عنونوها بما ذكرناه. وهذه المسألة - كما ذكرناه سابقا - أليق شيء بها مباحث الحجة، لان نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في: المقدمة - بيان أمور يحتاج إليها: مثل حقيقة التعارض وشروطه، وقياسه بالتزاحم، والحكومة والورود، ومثل القواعد العامة في الباب، فنقول:
1 - حقيقة التعارض: التعارض: مصدر من باب (التفاعل) الذي يقتضي فاعلين، ولا يقع الا من جانبين، فيقال: تعارض الدليلان. ولا تقول: (تعارض الدليل)، وتسكت. وعليه، فلا بد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة: ان كلا منهما - إذا تمت مقومات حجيته - يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وأما في بعض النواحي على وجه لا يصح فرض بقاء حجية كل منهما مع فرض بقاء حجية الآخر ولا يصح العمل بها معا. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كلا منهما يكذب الآخر، ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض. وهو مأخوذ من عارضه، أي جانبه وعدل عنه.
2- شروط التعارض: ولا يتحقق هذا المعنى من التعارض الا بشروط سبعة هي مقومات التعارض نذكرها لتتضح حقيقة التعارض ومواقعه:
1- ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا، لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر، والمعلوم كذبه لا يعارض غيره. واما القطع بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع.
2- ألا يكون الظن ألفعلي معتبرا في حجيتهما معا، لاستحالة حصول الظن ألفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. نعم يجوز ان يعتبر في أحدهما المعين الظن ألفعلي دون الآخر.
3- ان يتنافى مدلولهما ولو عرضا وفي بعض النواحي، ليحصل التكاذب بينهما. سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني أو الإلتزامي. والجامع في ذلك أن يؤديا إلى مالا يمكن تشريعه ويمتنع جعله في نفس الأمر، ولو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما، كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، فان الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد، ولكن لما علم من دليل خارج انه لا تجب الا صلاة واحدة في الوقت الواحد فانهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما. وعلى هذا، يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال: الضابط في التعارض: امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية.
أو يقال بعبارة جامعة: الضابط في التعارض: تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر. ومن هنا يعلم ان التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل، بل المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان. وإنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان، لان امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما انما ينشأ من تنافي المدلولين. ولأجل هذا قال صاحب الكفاية: (التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات). فحصر التعارض في مقام الإثبات ومرحلة الدلالة.
4- ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كلا منهما لو خلى ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وان كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. والسر في ذلك واضح، فانه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح ان يكون مكذبا لما هو حجة وان كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له، لما قلنا من ان التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات. أذن، لا تعارض بين الحجة واللاحجة، كما لا تعارض بين اللاحجتين. ومن هنا يتضح انه لو كان هناك خبر - مثلا - غير واجد لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجد لها، فان الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليها أحكامه وقواعده، وان كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي.
5- ألا يكون الدليلان متزاحمين، فان المتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وان كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع: فانه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان. ولا بد من أفراد بحث مستقل في بيان الفرق، كما سيأتي.
6- ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر.
7- ألا يكون أحدهما واردا على الآخر. وسيأتي ان الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين. ولا بد من أفراد بحث عنهما أيضا، فانه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه:
3- الفرق بين التعارض والتزاحم: تقدم في 2 / 286 بيان الحق الذي ينبغي ان يعول عليه في سر التفرقة بين بأبي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي.
وخلاصته: إن التعارض - في خصوص مورد العامين من وجه - انما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة إلتزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما، فيتكاذبان من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الإلتزامية فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. وحينئذ - أي حينما يفقدان تلك الدلالة الإلتزامية - لو امتنع على المكلف ان يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فان الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما: بان يمتثل اما هذا أو ذاك. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. وطبعا انما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض: أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض. وينبغي ألا يغيب عن بال الطالب انه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين - كما تقدم في الجزء الثاني - لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لان العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. وعليه، فالضابط في التفرقة بين البابين - كما اشرنا إليه أكثر من مرة - هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة.
وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة. ولا ينبغي ان يخلو كتابنا من الإشارة إليها. وهذه خير مناسبة لذكرها، فنقول:
4- تعادل وتراجيح المتزاحمين: لا شك في انه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية، فان الحكم فيهما هو التخيير. وهذا أمر محل اتفاق، وان وقع الخلاف في تعادل المتعارضين انه يقتضي التساقط أو التخيير على ما سيأتي. وفي الحقيقة ان هذا التخيير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. بيان ذلك: إنه بعد فرض عدم امكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين وعدم جواز تركهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض ويستحيل الترجيح بلا مرجح - فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف ألفعلي في كل منهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء. ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لان هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. مثاله: إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ - فانه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك وموافقته على التخيير. إذا عرفت ذلك، فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم. ومن الواضح إنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم. ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها، فلا بد من بيان تلك الجهات وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار:
1 - ان يكون أحد الواجبين لا بدل له مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفارة، أو اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة وان كان البدل اضطراريا، لان الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة ولم يرخص في ترك مالا بدل له، ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديم ذي البدل، فان فيه تفويتا للأول بلا تدارك.
2 - ان يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا، مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فان المضيق أو ألفوري أهم من الموسع قطعا، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في سعة وقتها. وهذا الثاني ينسق على الأول، لان الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري، فتقديم المضيق أو ألفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع فان فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو ألفوري بلا تدارك. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد فان الصلاة مقدمة إذ لا تدارك لها.
3 - أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها، لان الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له الا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات.
4 - ان يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر.
والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه. ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما. ولو قال قائل: ان كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلا، أذن، للوجوب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه.
فالجواب : نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل، فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة. ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض المزاحمة، إذ لا شك في ان المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروض، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدرة الشرعية. والخلاصة: أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه وهو القدرة العقلية، بخلاف مزاحمه المشروط، لما ذكرنا من احتمال أن ما أخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة والحاصلة عند المزاحمة. فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته. وعليه، فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، ويخلو الجو للواجب المطلق، وان كان مشروطا بالقدرة العقلية.
5 - أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من أحداهما فقط. فانه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة ألفعلية بالنسبة إليه. فإذا فعله انتفت القدرة ألفعلية بالنسبة إلى المتأخر فلا يبقى له مجال. ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا، أما لو اختلفا فان المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وان كان زمان فعله متأخرا.
6- ان يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة. والأولوية تعرف اما من الأدلة، واما من مناسبة الحكم للموضوع، واما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. ومن أجل ذلك فان الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور، ولا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك: فمن تلك الأولوية ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام، فانه أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمة. و(منها) ما كان يتعلق بحقوق الناس، فانه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة، أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها. و(منها) ما كان من قبيل الدماء والفروج، فانه يحافظ عليه أكثر من غيره، لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها. فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله، فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا. و(منها) ما كان ركنا في العبادة، فانه مقدم على ما ليس له هذه الصفة عند المزاحمة، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع، فان الركوع مقدم على القراءة وان كان زمان امتثاله متأخرا عن القراءة. وعلى مثل هذه فقس، وأمثالها كثير لا يحصى، كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه الفتنة بينهم، فان الصلح مقدم على الصدق. وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي.
ومما ينبغي ان يعلم في هذا الصدد انه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين فان الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية. وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات. وعليه، فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين، بل يكفي الاحتمال. وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع ألفقهية، فاحتفظ به.
5- الحكومة والورود: وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلالي، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره - كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام - فانه لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ. وكان رحمه الله - على ما ينقل عنه - يصرح بأن أساطين ألفقه المتقدمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه، وان لم يبحثوه بصريح القول ولا بهذا المصطلح. واللفتة الكريمة منه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلة، إذ وجد ان من حقها أن تقدم على أدلة أخرى، في حين انها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص والعام، بل قد يكون بينهما العموم من وجه. ولا يوجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية، ولا تجري بينهما قواعد التعارض، لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية ولا منافاة، يعني ان لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطله، بل أحدهما المعين من حقه بحسب لسانه وأدائه لمعناه وعنوانه ان يكون مقدما على الآخر تقديما لا يستلزم بطلان الآخر ولا تكذيبه ولا صرفه عن ظهوره. وهذا هو العجيب في الأمر والجديد على الباحثين، وذلك مثل تقديم أدلة الأمارة على أدلة الأصول العملية بلا إسقاط لحجية الثانية ولا صرف لظهورها.
والمعروف ان أحد اللامعين من تلامذته (1) التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر قبل ان يتعرف عليه وقبل أن يعرف الشيخ بين الناس، وسأله سؤال امتهان واختبار عن سر تقديم دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور، فقال له: إنه حاكم عليه.
قال: وما الحكومة؟ فقال له: يحتاج إلى ان تحضر درسي ستة أشهر على الأقل لتفهم معنى الحكومة. ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ بأستاذه. إن موضوعا يحتاج إلى درس ستة اشهر - وان كان فيه نوع من المبالغة - كم يحتاج إلى البسط في البيان، بينما ان الشيخ في كتبه لم يوفه حقه من البيان، الا بعض الشيء في التعادل والتراجيح، وبعض اللقطات المتفرقة في غضون كتبه. ولذا بقي الموضوع متأرجحا في كتب الأصوليين من بعده، وان كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في العصور المتأخرة. ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر شرحا كافيا، وانما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها (الورود) قدر الامكان، فنقول:
1- الحكومة ان الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة هو: أن يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، ولذا سميت بالحكومة. فيكون تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ليس من ناحية السند ولا من ناحية الحجية، بل هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما، فلا يتعارضان. وانما التقديم - كما قلنا - من ناحية أدائية بحسب لسانهما، ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة (الورود) الآتي معناه. فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمى (حكومة).
وهذا في الحقيقة هو الضابط لها، فلذلك وجب توضيح الفرق بينها وبين التخصيص من جهة، ثم بينها وبين الورود من جهة أخرى، ليتضح معناها بعض الوضوح: أما الفرق بينها وبين (التخصيص) فنقول: ان التخصيص ليكون تخصيصا لا بد ان يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص غير انه لما كان الخاص أظهر من العام فيجب ان يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه ان المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام وان كان ظاهر اللفظ العموم والشمول، لحكم العقل يقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء. وعليه، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. أما الحكومة (في بعض مواردها) هي كالتخصيص بالنتيجة، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، ولكن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلا وادعاءا، فلذلك يكون الحاكم متصرفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. ونستعين على بيان الفرق بالمثال، فنقول: لو قال الأمر عقيب أمره بإكرام العلماء: (لا تكرم ألفاسق)، فان القول الثاني يكون مخصصا للأول لأنه ليس مفاده الا عدم وجوب إكرام ألفاسق مع بقاء صفة العالم له. اما لو قال عقيب أمره: (ألفاسق ليس بعالم) فانه يكون حاكما على الأول، لان مفاده إخراج ألفاسق عن صفة العالم تنزيلا، بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو علم ألفاسق بمنزلة عدم العلم. وهذا تصرف في عقد الوضع، فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادعاء والتنزيل. وبالطبع لا يعطي له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. ومثاله في الشرعيات قوله (عليه السلام)(لا شك لكثير الشك) ونحوه مثل نفي شك المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، فان هذا ونحوه يكون حاكما على أدلة حكم الشك، لان لسانه إخراج شك كثير الشك وشك المأموم أو الإمام عن حضيرة صفة الشك تنزيلا، فمن حقه حينئذ ألا يعطى له أحكام الشك من نحو إبطال الصلاة أو البناء على الأكثر أو الأقل أو غير ذلك. وإنما قلنا: (الحكومة في بعض مواردها كالتخصيص)، فلان بعض موارد الحكومة الأخرى عكس التخصيص، لان الحكومة على قسمين: قسم يكون التصرف فيها بتضييق الموضوع كالأمثلة المتقدمة، وقسم بتوسعته، مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء: (المتقي عالم)، فان هذا يكون حاكما على الأول وليس فيه إخراج، بل هو تصرف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء إلى ما يشمل المتقي، تنزيلا للتقوى منزلة العلم، فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه. ومثاله في الشرعيات: (الطواف صلاة)، فان هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك. ومثله: (لحمة الرضاع كلحمة النسب) الموسع لموضع أحكام النسب.
2- الورود وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود، فنقول: كما قلنا ان الحكومة كالتخصيص في النتيجة، كذلك الورود كالتخصص في النتيجة، لان كلا من الورود والتخصص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا، ولكن الفرق ان الخروج في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل (أكرم العلماء) فيقال: ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا، وأما في الورود فان الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه. مثاله دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية كالبراءة وقاعدة الاحتياط وقاعدة التخيير، فان البراءة العقلية لما كان موضوعها عدم البيان الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه، فالدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الأمارة بيانا تعبدا، وبهذا التعبد يرتفع موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان. وهكذا الحال في قاعدتي الاحتياط والتخيير فان موضوع الأولى عدم المؤمن من العقاب، والإمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة منه، وموضوع الثانية الحيرة في الدوران بين المحذورين، والإمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين، فترتفع الحيرة. وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحكومة، فان ورود أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد، فيكون الأول واردا على الثاني، أما الحكومة فإنها لا توجب خروج مدلول الحاكم عن موضوع مدلول المحكوم وجدانا وعلى وجه الحقيقة، بل الخروج فيها انما يكون حكميا وتنزيليا وبعناية ثبوت المتعبد به اعتبارا.
6- القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير: أشرنا في... (ص 190) إلى ان القاعدة في التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل، وذلك محل وفاق، أما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في ان القاعدة هي التساقط أو التخيير؟ والحق إن القاعدة الأولية هي التساقط وعلية أساتذتنا المحققون، وان دل الدليل من الأخبار على التخيير كما سيأتي، ونحن نتكلم في القاعدة بناء على المختار من ان الأمارات مجعولة على نحو الطريقية. ولا حاجة للبحث عنها بناء على السببية، فنقول: إن الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو: ان التعارض لا يقع بين الدليلين الا إذا كان كل منهما واجدا لشرائط الحجية، كما ..في شروط التعارض (ص 191) والتعارض أكثر ما يوجب سقوط أحدهما غير المعين عن الحجية ألفعلية لمكان التكاذب بينهما، فيبقى الثاني غير المعين على ما هو عليه من الحجية ألفعلية واقعا، ولما لم يمكن تعيينه والمفروض ان الحجة ألفعلية منجزة للتكليف يجب العمل بها، فلا بد من التخيير بينهما. والجواب: ان التخيير المقصود اما ان يراد به التخيير من جهة الحجية أو من جهة الواقع: فان كان الأول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، لان دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد أنفسهما انما مفاده حجية أفراده على نحو التعيين لا حجية هذا أو ذاك من أفراده لا على التعيين، حتى يصح أن يفرض أن أحدهما غير المعين حجة يجب الأخذ به فعلا، فيجب التخيير في تطبيق دليل الحجية على ما يشاء منهما. وبعبارة أخرى: ان دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه انما يدل على وجود المقتضى للحجية في كل منهما لولا المانع، لا فعلية الحجية. ولما كان التعارض يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن ألفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجية ألفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به، فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا، حتى يجب التخيير، بل حينئذ يتساقطان، أي أن كلا منهما يكون ساقطا عن الحجية ألفعلية وخارجا عن دليل الحجية. وان كان الثاني فنقول:
(أولا) - لا يصح ان يفرض التخيير من جهة الواقع الا إذا علم بإصابة أحدهما للواقع، ولكن ليس ذلك أمرا لازما في الحجتين المتعارضتين، إذ يجوز فيهما ان يكونا معا كاذبتين. وإنما اللازم فيهما من جهة التعارض هو العلم بكذب أحدهما لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع. وعلى هذا فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخيير بينهما من أجله.
و(ثانيا) - على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير المعين للواقع، فانه أيضا لا وجه للتخيير بينهما، إذ لا وجه للتخيير بين الواقع وغيره. وهذا واضح. وغاية ما يقال: انه إذا حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع فان الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وحينئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه. ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا - وهي مسألة: ان القاعدة في المتعارضين هو التساقط أو التخيير - لان قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر، على اختلاف الموارد.
إذا عرفت ذلك فيتحصل: ان القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. اما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ الحق انه لا يقتضي ذلك لان المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه، فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الإلتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية. هذا فيما إذا كانت أحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجوب، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجوه فان الحكم فيه بعدم سقوط حجية أحداهما بسقوط الأخرى أولى.
7- الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح: اشتهر بينهم ان الجمع بين المتعارضين مهما أمكن من الطرح، وقد نقل عن (غوالي اللآلي) دعوى الإجماع على هذه القاعدة.
وظاهر ان المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، فانه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض امكان الجمع. وعليه، فمقتضى القاعدة مع امكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها، ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي.
1- أما من (الناحية الأولى) فمن الظاهر انه لا مدرك لها الا حكم العقل بأولية الجمع، لان التعارض لا يقع الا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة، كما .. في الشرط الرابع من شروط التعارض (ص 188) ومع فرض وجود مقومات الحجية أي وجود المقتضي للحجية، فانه لا وجه لرفع اليد عن ذلك الا مع وجود مانع من تأثير المقتضي، وما المانع في فرض التعارض الا تكاذبهما. ومع فرض امكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضى الحجية فيهما، فكيف يصح ان نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما.
2- وأما من (الناحية الثانية) فانا نقول: ان المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث. وقد يظن الظان ان امكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقدير المتقدم في مدركها، إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ، فيكون الجمع أولى.
ولكن يجاب عن ذلك: انه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية الا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الأخبار عليها، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. بل ربما يقال: لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين. وببيان آخر برهاني نقول: إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع: أما ان يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند، أو بالعكس أي يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والأخر بالعكس، أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فان ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل الفرض الثاني مستحيل كما [في] (ص 188). وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرها: فان كانت (الأولى) فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا إليه، بل هما في هذه الحالة اما ان يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية أو يتساقطان حيث لا مرجح أو يتخير بينهما. وان كانت (الثانية)، فانه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما أو طرح أحدهما من ناحية السند، فلم يبق الا التصرف فيهما من ناحية الدلالة. ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. وحينئذ فان كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر أو كل منهما قرينة على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع الدلالتي، فان هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيدخلان بحسبه في باب الظواهر ويتعين الأخذ بهذا الظهور. وان لم يكن هنا جمع عرفي فان الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء. ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي. ويكون دليلا على حجيته؟
وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما، ولا يقتضي ان يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي فان هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه. ولا دليل حسب الفرض؟ وان كانت (الثالثة) فانه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا، فان كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. واما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فان تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء ولا دليل آخر عليه كما تقدم في الصورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين: طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة. فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذلك العكس، ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. وان كانت (الرابعة)، فان الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين، والسر في هذا الدوران: ان دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا، لا بد ان نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر، وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد ان نحكم بكذب سند أحدهما فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر، كما تقدم. نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فانه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملاءمة بينهما، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. ومن هنا نقول: ان الجمع العرفي أولى من الطرح. بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين، كما سيأتي. فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. اما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي، فان الجمع التبرعي لا يصلح للملاءمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، فأما ان يقدم أحدهما على الآخر لمزية أو يتخير بينهما أو يتساقطان. فتحصل من ذلك كله انه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين.
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في (المقدمة) - فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، والمرجحات السندية وما يتعلق بها.
الأمر الأول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح ان القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو (الجمع العرفي) الذي سماه الشيخ الأعظم ب(الجمع المقبول)، وغرضه المقبول عند العرف. ويسمى الجمع الدلالتي. وفي الحقيقة - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - انه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض. والوجه في ذلك انه انما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد. وبعبارة أخرى، انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا، فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها، واما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فان التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. ويتضح من ذلك انه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع. وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب:
(فمنها) ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر، فان الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه، لأنه بمنزلة القرينة عليه. وقد جرى البحث في ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، أو انما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم، ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني. كما جرى البحث في ان أصالة الظهور في الخاص حاكمة، أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو ان في ذلك تفصيلا. ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فان المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر، والأظهر على الظاهر، فانها من باب واحد. و(منها) ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على ان يكون قدرا متيقنا من اللفظ، بل من الخارج، لأنه لو كان للفظ قدر متيقن فان الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم للفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تعارض. مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد (ثمن العذرة سحت) وورد أيضا (لا بأس ببيع العذرة)، فان عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني، فهما من ناحية لفظية متبائنان متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهم بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن، فيرتفع التكاذب بينهما، ويتلاءمان عرفا. و(منها) ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن ان يراد من العموم، فان مثل هذا العام يقال عنه: انه يأبى عن التخصيص. فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. و(منها) ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، فان مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص، إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه: انه يأبى عن التخصيص. وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما الا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك وقد تقدم البحث عن ذلك في المجلد الأول ص 150، فراجع... ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث.
الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين قد تقدم ان القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير ان آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال:
1- التخيير في الأخذ بأحدهما، وهو مختار المشهور، بل نقل الإجماع عليه.
2- التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، ولو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. وانما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط، لان التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل، كما في المورد ألفاقد للنص، مع العلم الإجمالي بالحكم.
3- وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فان لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما. ولا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال. وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن امكان صحة هذه الأقوال جملة، بعد ما سبق من تحقيق ان القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما، للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخيير. نقول في الجواب عن هذا السؤال: انه إذا فرضت قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فان ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين، وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، لأنه انما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين، ولكن لا يقدح في ذلك ان يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد، لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة. ولا يلزم من ذلك - كما قيل - ان تكون الأمارة حينئذ مجعولة على نحو السببية، فانه انما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول. وبعبارة أخرى أوضح: انه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فانه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين، لقصور تلك الأدلة عن شمولها لهما، فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا. أما وقد فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص على حجية أحدهما فلا بد من الأخذ به ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد، ولا مانع عقلي من تلك. وعلى هذا، فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع، بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط. بقي علينا ان نفهم معنى التخيير على تقدير القول به، بعد ان بينا سابقا انه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية، ولا من جهة الواقع فنقول: إن معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ومعذر للمكلف على تقدير الخطأ، وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه، فللمكلف ان يختار ما يشاء منهما فان أصاب الواقع فقد تنجز به وإلا فهو معذور. وهذا بخلاف ما لو كنا نحن والأدلة العامة، فانه لا منجزية لأحدهما غير المعين ولا معذرية له. والشاهد على ذلك انه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا، لأنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذر له في مخالفة الواقع، بينهما انه معذور في مخالفة الواقع لو اخذ بأحدهما. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص، موجودا فانه يجوز له ترك العمل بهما معا وان استلزم مخالفة الواقع إذ لا منجز للواقع بالمتعارضين بمقتضى الأدلة العامة.
إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة، فان منها ما يدل على التخيير مطلقا، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف، ثم نعقب عليها بما يقتضي، فنقول: ان الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي:
1- خبر الحسن بن جهم عن الرضا (عليه السلام)(2): قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين، مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق؟ قال: فإذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره - الذي لم نذكره - مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على ان التخيير انما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة.
2- خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3): (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه). وهذا الخبر أيضا يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة (فموسع عليك) ويقيد بالروايات الدالة على الترجيح الآتية. ولكن يمكن ان يناقش في استظهار التخيير منه:
(أولا) - بان الخبر وارد في فرض التمكن من لقاء الإمام والأخذ منه، فلا يعلم شموله لحال الغيبة الذي يهمنا إثباته، لان الرخصة في التخيير مدة قصيرة لا تستلزم الرخصة فيه أبدا ولا تدل عليها.
(ثانيا) بأن الخبر غير ظاهر في فرض التعارض، بل ربما يكون واردا لبيان حجية الحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب. ومعنى (موسع عليك) الرخصة بالأخذ به كناية عن حجيته، غاية الأمر انه يدل على ان الرخصة مغياة برؤية الإمام ليأخذ منه الحكم على سبيل اليقين. وهذا أمر لا بد منه في كل حجة ظنية، وان كانت عامة حتى لزمان حضور الإمام الا انه مع حصول اليقين بمشافهته لا بد ان ينتهي أمد جواز العمل بها. وعليه، فلا شاهد بهذا الخبر على ما نحن فيه.
3- مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام)(4): (اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر: فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما الا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك!). فوقع (عليه السلام)(موسع عليك بأية عملت). وهذه أيضا استظهروا منها التخيير مطلقا وتحمل على المقيدات كالثانية. ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل ان يراد من التوقيع بيان التخيير في العمل بكل من المرويين باعتبار ان الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض معا، لا ان المراد التخيير بين الروايتين، فيكون الغرض تخطئة الروايتين. وهو احتمال قريب جدا، لاسيما ان السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي به، أي أنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين، والجواب ينبغي ان يطابق السؤال، فكيف صح ان يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين، وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني.
4- جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل الله فرجه (5). (في ذلك حديثان: أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الحديث الآخر فانه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا). وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا ويحمل على المقيدات. ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بانه من المحتمل قريبا ان المراد بيان التخيير في العمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه، لا التخيير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله: (كان صوابا)، لان المتعارضين لا يمكن ان يكون كل واحد منهما صوابا، ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما، الا لبيان خطأ الروايتين وان الحكم الواقعي على خلافهما.
5- مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللآلي، وقد جاء في آخرها: (أذن فتخير أحدهما، فتأخذ به وتدع الآخر). ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين وفي انه بعد فرض التعادل، لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها، ولكن الشأن في صحة سندها وسيأتي التعرض له. وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها.
6- خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(6). قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه: أحدهما بأخذه، والأخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. وقد استظهروا من قوله (عليه السلام)(فهو في سعة) التخيير مطلقا. وفيه (أولا) - ان الرواية واردة في فرض التمكن من لقاء الإمام أو كل من يخبره بالحكم على سبيل اليقين من نواب الإمام خصوصا أو عموما. فهي تشبه من هذه الناحية الرواية الثانية المتقدمة.
و(ثانيا) - ان الأولى فيها ان تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير، وذلك لكلمة (يرجئه). واما قوله (في سعة) فالظاهر ان المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار ان الأمر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة. أذن، فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما ان ذلك لا تلتئم مع الأمر بالإرجاء، لان العمل بأحدهما تخييرا ليس أرجاء، بل الإرجاء ترك العمل بهما معا. فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين.
7- وقال الكليني بعد تلك الرواية: (وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك). يظهر منه انها رواية أخرى، لا انها نص آخر في جواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب ان يقول (بأيهما اخذ) لضمير الغائب، لا (بأيهما أخذت) بنحو الخطاب. وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، ويحمل على المقيدات.
8- ما في عيون أخبار الرضا (7) للصدوق في خبر طويل جاء في آخره: (فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والإتباع والرد إلى رسول الله). والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، الا انه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن ان يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما اخبر عن حكمه انه على نحو الكراهة) ولذا انها فيما يتعلق بالأخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله (عليه السلام)(وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا). وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث. وعليه فالأجدر بهذه الرواية ان تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير.
9- مقبولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات، وقد جاء في آخرها: (إذا كان ذلك - أي فقدت المرجحات - فأرجئه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات). وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل.
10- خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8): قلت: يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالعمل به، والأخر ينهانا عن العمل به؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك، فتسأل عنه. قلت: لا بد ان يعمل بأحدهما. قال: أعمل بما فيه خلاف العامة.
11- مرسلة صاحب غوالي اللآلي، على ما نقل عنه، فانه بعد روايته المرفوعة المتقدمة برقم 5 قال: (وفي رواية انه قال (عليه السلام)أذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله).
هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف. والظاهر منها - بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة - ان الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. والخلاصة ان المتحصل منها جميعا انه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين فان لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا ان القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وان كان فيهما ما يرجح أحدهما على الأخر. نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط - وهي خبر سماعه - ان التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل.
ولكن التأمل فيها يعطي انها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فان الظاهر ان المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا ان نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة. وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق (ج 1 ص 100). وأنت - بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير - تستطيع ان تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له الا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. اما (الخامسة). وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد اشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه، على ان راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة (برقم 11) الواردة في التوقف والإرجاء. واما (السابعة) مرسلة الكليني، فليس من البعيد انها من استنباطاته حسبما فهمه من الروايات، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب. ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي (ص 9) من مرسلة أخرى بهذا المضمون: (بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)، لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير الا تلك المرسلة التي نحن بصددها وهي بخطاب المفرد، وهذه بخطاب الجمع. وعليه فيظهر ان المرسلتين معا هما من مستنبطاته، فلا يصح الاعتماد عليهما. إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك ان القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف، ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط، وان كان التخيير مذهب المشهور. وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، لان الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط، بل هو من لوازمه، فأخبار التوقف تكون على القاعدة. وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير: ان أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما ان أخبار التوقف مقيدة به. وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد. ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. أقول: ان أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور، لان استفادة ذلك يتوقف على ان يكون للغاية مفهوم، وقد تقدم (م 1 ص 116) بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا: (ان الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم، ولا تدل على المفهوم الا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم). والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء لا لحكمه وهو الوجوب، يعني ان المستفاد من هذه الأخبار ان نفس الإرجاء مغيى بملاقاة الإمام، لا وجوبه.
والحاصل: انه لا يفهم من أخبار التوقف، الا انه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة، ولا العمل بواحد منها، وانما يحال الأمر في شأنها الا الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته، لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤل إلى ان الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها. وينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام والسؤال منه. فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. وعلى هذا، فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير لا أخص منها.
الأمر الثالث المرجحات تقدم ص 188 ان من شروط تحقق التعارض ان يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللاحجة، فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه ان نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى، بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللاحجة. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللاحجة. ومن أجل هذا يجب ان نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك: في صدد الترجيح أو التمييز. فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي تقصدها في بيان المرجحات، فنقول: ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تاريخا، وبصفات الراوي، وبالشهرة، وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان انه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات:
المقام الأول - المرجحات الخمسة:
1- الترجيح بالأحداث: في هذا الترجيح روايات أربع، نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (9) قال (عليه السلام)أرأيت لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ. قلت: آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله!
أقول: ان الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي انها لا تدل على ترجيح الا حدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنه لا تدل على ذلك الا إذا فهم منها ان الا حدث هو الحكم الواقعي وان الأول واقع موقع التقية أو نحوها، مع انه لا يفهم منها أكثر من ان من ألقي إليه البيان خاصة حكمه ألفعلي ما تضمنه البيان الأخير. وليست ناظرة إلى انه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية. كما انه ليست ناظرة إلى ان هذا الحكم ألفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمان. والحاصل ان هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على ان البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وان ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة ولو كان من باب التقية، ولا شك ان الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها.
2- الترجيح بالصفات: ان الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا. والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا، لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يروها الا صاحب (غوالي اللآلي). وقد طعن صاحب (الحدائق) في التأليف والمؤلف إذ قال ج 1 ص 99: (فانا لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلي، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها).
أذن، الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لان راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين اجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم، كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم (10). واليك نصها بعد حذف مقدمتها: قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
قلت: فان كان الخبران عنكما (11) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر: فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك! أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والأخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك! فان وافقهم الخبران جميعا؟
قال: انظر إلى ما هم إليه أميل - حكامهم وقضاتهم - فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه وفي (بعض النسخ: فأرجئه) حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. انتهت المقبولة. أقول: من الواضح ان موردها التعارض بين الحاكمين، لا بين الراويين ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث - تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة. غير انه - مع ذلك - لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه. والسر في ذلك واضح لان اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث، والمفهوم من المقبولة ان ترجيح الأعدل والأورع والأفقه انما هو بما هو حاكم في مقام نفوذ حكمه، لا في مقام قبول روايته. ويشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات كونه (أفقه) في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. نعم ان المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشهرة، وان كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم، فان هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه. وعليه، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات. وأما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي.
3- الترجيح بالشهرة: تقدم ص 146 ان الشهرة ليست حجة في نفسها، وأما إذا كانت مرجحة للرواية - على القول به - فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها. والشهرة المرجحة على نحوين: شهرة عملية وهي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية، وشهرة في الرواية وان لم يكن العمل على طبقها مشهورا. أما (الأولى) فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها، فإذا قلنا بالترجيح بها، فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، على ما سيأتي وجهه، غاية الأمر ان تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران:
1- ان يعرف استناد الفتوى إليها، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق باقر بيتها إلى الواقع.
2- أن تكون الشهرة العملية قديمة، أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها. هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض، أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه. والحق انها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم. وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فانه يوجب وهنه وان كان رواية ثقة وكان قوي السند، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه.
وأما (الثانية)، وهي الشهرة في الرواية - فان إجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة، وقد جاء فيها (فان المجمع عليه لا ريب فيه). والمقصود من (المجمع عليه) المشهور، بدليل فهم السائل ذلك، إذ عقبه بالسؤال: (فان كان الخبران عنكما مشهورين). ولا معنى لان يراد من الشهرة الإجماع. وقد يقال: ان شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور، وعلى الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره. وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه، فلا تعمه أدلة حجية الخبر. وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح أحدى الحجتين بل تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة. والجواب: إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة ألفعلية بمعارضة، فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر، لان الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق ألفعلي بخبره. وقد تقدم في حجية خبر الثقة انه لا يشترط حصول الظن ألفعلي به ولا عدم الظن بخلافه.
4- الترجيح بموافقة الكتاب: في ذلك روايات كثيرة: (منها) مقبولة ابن حنظلة المتقدمة. و (منها) خبر الحسن بن الجهم المتقدم (رقم 1) فقد جاء في صدره: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا: فان كان يشبههما فهو منا، وان لم يكن يشبههما فليس منا. قال في الكفاية: (ان في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا: وجهه قوة احتمال ان يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في انه زخرف وباطل وليس بشيء أو انه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار..). أقول: في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار:
(الأولى) - في بيان مقياس أصل حجية الخبر، لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية: انه زخرف وباطل. إلى آخره. فلا بد ان تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما.
(والثانية) في بيان ترجيح أحد المتعارضين. وهذه لم يرد فيها مثل ذلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها. وينبغي ان تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به وانما المانع من الأخذ به وجود المعارض، إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات، ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك إذ قال: (فان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة). ولا يكون ذلك الا الموافقة لظاهره وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب. كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة مخالفة الظاهر لا النص. ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن المتقدم: (فان كان يشبههما فهو منا)، فان التعبير بكلمة (يشبههما) يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر.
5- مخالفة العامة: إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي، وقد نقل عن ألفاضل النراقي انه قال: انها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فيما نقل عنه. وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في (رقم10) لا حجة فيها لضعفها بالإرسال. فينحصر الدليل في (المقبولة) المتقدمة. وظاهرها كما سبق قريبا ان الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجة الخبرين في أنفسهما، فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل. والنتيجة: ان المستفاد من الأخبار ان المرجحات المنصوصة ثلاثة: الشهرة، وموافقة الكتاب والسنة، ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي.
المقام الثاني - في المفاضلة بين المرجحات :
ان المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها.
1- ما يكون مرجحا للصدور، ويسمى (المرجح الصدوري)، ومعنى ذلك ان المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي.
2- ما يكون مرجحا لجهة الصدور، ويسمى (المرجح الجهتي) فان صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فانه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر.
3- ما يكون مرجح للمضمون، ويسمى (المرجح المضموني). وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات انها مترتبة عند التعارض بينها أو أنها في عرض واحد، على أقوال:
(الأول) - انها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين، فيقدم الأقوى مناطا، فان لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما. وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية.
(الثاني) - انها مترتبة ويقدم المرجح الجهتي على غيره، فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وان كان مشهورا. وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني.
(الثالث) - انها مترتبة، ولكن على العكس من الأول، أي انه يقدم المرجح الصدوري على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم. وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني.
(الرابع) - انها مترتبة حسبما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم - مثلا حسبما يظهر من المقبولة - المشهور فان تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فان تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة. وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها. وفي الحقيقة ان هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل يبتنى على أشياء: (منها) - انه يبتنى على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، فان مقتضى ذلك ان يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب، والى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فهي، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت.
والذي نقوله - على نحو الاختصار -: انه يبدو من تتبع الأخبار إنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها، ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها، كما لم تتفق في الترتيب بينها. نعم ان (المقبولة) - التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم - ذكرت الشهرة أولا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجح. واما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها، كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة. وعلى كل حال، فان استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها. و (منها) انه يبتني - بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة - على ان القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو بالعكس، أو لا تقتضي شيئا منهما؟. وعلى التقدير الثالث لا بد ان يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى بالتقديم. وقد أصر شيخنا النائيني أعلى الله درجته على الأول، اي انه يرى ان القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا، لان جهة الصدور من شؤون الصادر، فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه انه صادر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان غيره. وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة، لان مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع، ليحمل المشهور على التقية، إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ. أقول: ان المسلم انما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا وتوقف الأول على الثاني، ولكن ذلك غير المدعى، وهو توقف مرجح الأول على مرجح الثاني فانه ليس المسلم نفس المدعى، ولا يلزمه.
أما انه ليس نفسه فواضح لما قلناه من ان المسلم هو توقف الأول على الثاني وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجحه الذي هو المدعى. واما انه لا يستلزمه فكذلك واضح، فانه إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين:
1- مشهور موافقا للعامة.
2- شاذا مخالفا لهم.
فان الترجيح للشاذ بالمخالفة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا على فعلية حجيته، ولا على عدم فعلية حجية المشهور في قباله، بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة ويترتب عليه حينئذ عدم فعلية حجية المشهور.
وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة انما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا على فعلية حجيته، ولا على فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ وعليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له، ومن ذلك يتضح انه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. نعم إذا دل دليل خاص مثل (المقبولة) على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل، لا انه مقتضى القاعدة. والنتيجة: إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، فان لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط لا التخيير. ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد.
المقام الثالث - في التعدي عن المرجحات المنصوصة:
لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال:
1- وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، وهو القول المشهور، ومال إليه الشيخ الأعظم وجماعة من محققي أساتذتنا. وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية، وان لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة.
2- وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية. وهو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها.
3- التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها فلا يجوز. ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة، فلا بد ان تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها، فنقول: أولا - إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط - وهو المختار - فان الأصل يقتضي عدم الترجيح الا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة، أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ فان قلنا: ان دليل الأمارة كاف في الترجيح، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. والظاهر ان الدليل كاف في ذلك، لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، فان الظاهر ان بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي ان العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يبقون في حيرة من ذلك، وان كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فانه يستكشف منه رضى الشارع وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والظواهر.
وان قلنا: ان دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل جديد، فلا محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، الا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فانه أكد في الرسائل على ان المستفاد من الأخبار ان المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من جهة انه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجع. ثانيا - إذا قلنا بان القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير، فان الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد، فان احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح، لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع اما تعيينا واما تخييرا وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع. واما المرجوح فلا يحرز كونه معذرا ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. وعليه، فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. ثالثا - إذا قلنا بان القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور وان كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط - فلا بد ان نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب. فان استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كان. وان استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط، فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، اما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة وقد عرفت ان الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم.
إذا عرفت ما شرحناه فانك تعرف ان الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا، وذلك بناء على المختار من ان القاعدة هي التساقط فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين. واما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فان بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم. ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار وان كان الحق ان الأخبار تشعر بذلك، فهي تؤيد ما نقول، ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات.
والحمد لله رب العالمين.
______________
(1) قيل هو ميرزا حبيب الله الرشتي.
(2) الوسائل، كتاب القضاء الباب 9 من أبواب صفات القاضي، عن الاحتجاج.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(6) الكافي ج 1 ص 66 الطبعة الثانية بطهران سنة 1380.
(7) راجع عنه تعليقة الكافي ج 1 ص 66.
(8) الوسائل، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(9) الكافي ج 1 ص 67.
(10) الكافي ج 1 ص 67، والفقيه المطبوع بطهران سنة 1376 ص 318 والتهذيب في باب الزيادات من كتاب القضاء.
(11) يقصد الباقر والصادق عليهما السلام.



|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
عوائل الشهداء: العتبة العباسية المقدسة سبّاقة في استذكار شهداء العراق عبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة
|
|
|