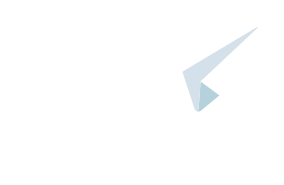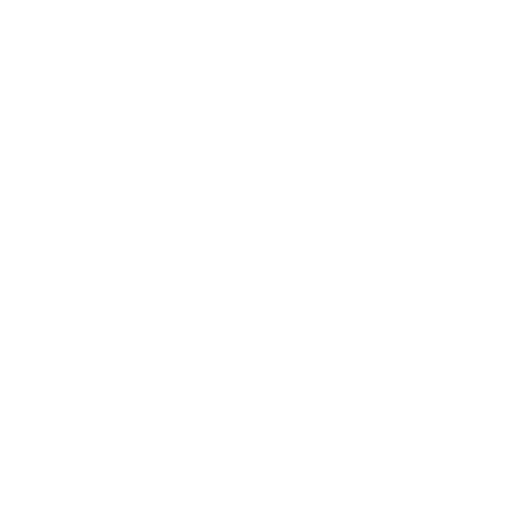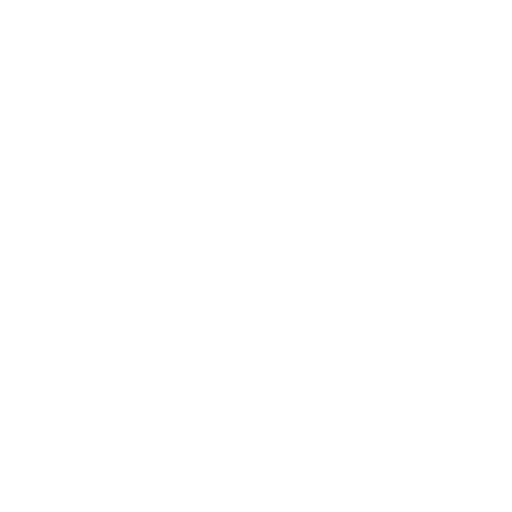التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
الحكمة (الصفات الثبوتية الفعلية)
المؤلف:
الشيخ جعفر السبحاني
المصدر:
محاضرات الاستاذ الشيخ جعفر السبحاني
الجزء والصفحة:
ص 226
24-10-2014
3917
إِنَّ الحكمة من صفاته سبحانه ، كما أَنَّ الحكيم من أَسمائه و قد تواترت النصوص القرآنية بذلك، فقال سبحانه :
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [النساء: 26] مشعراً بأنَّ العلم غير الحكمة.
إِنَّ الحكمة تطلق على معنيين : أحدهما ، كون الفعل في غاية الإِحكام و الإِتقان ، و غاية الإِتمام و الإِكمال. و ثانيها ، كون الفاعل لا يفعل قبيحاً و لا يخلّ بواجب.
قال الرازي : « في الحكيم وجوه :
الأول ـ إِنه فعيل بمعنى مُفْعِل ، كأليم بمعنى مُؤلم ، و معنى الإِحكام في حق الله تعالى في خلق الأَشياء ، هو إتقان التدبير فيها ، وحسن التقدير لها ففيها ما لا يوصف بوثاقة البنية كالبقة والنملة و غيرهما ، إلاّ أنَّ آثار التدبير فيها ـ وجهات الدلالات فيها على قدرة الصانع و علمه ليست بأَقل من دلالة السموات و الأَرض و الجبال على علم الصانع و قدرته. و كذا هذا في قوله: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7].
وليس المراد منه الحَسَن الرائق في المنظر ، فإِنَّ ذلك مفقود في القرد والخنزير ، و إِنما المراد منه حسن التدبير في وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة. و هو المراد بقوله : {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2].
الثاني ـ إِنَّه عبارة عن كونه مقدّساً عن فعل ما لا ينبغي ، قال تعالى : { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون: 115].
وقال : {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [الأنبياء: 16] » (1).
ونبحث فيما يلي عن كلا المعنيين واحداً بعد الآخر.
الحكيم : المتقن فعله :
قد عَرَفْتَ أنَّ الحكيم يُطلق على الفاعل الذي يعمل بإتقان و يُقدّر و يُدبِّر باتّزان و الله سبحانه حكيم بهذا المعنى.
وأوضحُ دليل على ذلك أنَّ فعله في غاية البداعة و الإحكام و الإِتقان فإِنَّ الناظر يرى أنَّ العالم خُلِقَ على نظام بديع ، و أنَّ كل نوع خُلق بأَفضل صورة تناسبه ، و جُهّز بكل ما يحتاج إليه من أَجهزة تهديه في حياته و تساعده على السير إلى الكمال. و إنْ شئت فانظر إلى الأَشياء المحيطة بك مما هو من مظاهر حِكْمِتِه تعالى.
فلاحظ العينَ مثلا فإِنَّ فيها ما يقرب من مائة و أربعين مليون مستقبل حساس للضوء تُسمَّى بالمخاريط والعصي ، وطبقة المخاريط والعصي هذه واحدة من الطبقات العشر التي تشكل شَبَكيّة العين ، و لا يتجاوز ثخانتها ـ بطبقاتها العشر ـ أربعة أَعشار المليمتر الواحد. و يخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون!
وهذا القلب وهو مضخة الحياة التي لا تَكِلَّ عن العمل ، فإِنه ينبض يومياً ما يزيد على مائة ألف مرة ، يضخ خلالها ثمانية آلاف ليتر من الدم ، و بمعدل وسطي يضخ ستة و خمسين مليون غالون على مدى حياة الإِنسان ، فترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة من دون حاجة لإِصلاح؟ ...
وأَمثال ذلك الكثير مما لا تستوعبه السطور بل ولا الزبر.
إنَّ معطيات العلوم الطبيعية عما في الكون أَفضلُ دليل على وجود الحكمة الإِلهية في الفَلَكيّات و الأَرضيات .ولا نطيل الكلام في الحكمة بهذا المعنى ، فإنها في الحقيقة من شعب القدرة التي استوفينا الكلام فيها. على أنَّه يمكن الإِستدلال على كونه حكيماً من وجهين آخرين غير ما مر :
الأول : إِنَّ إرادته سبحانه تعلقت بخلق كل شيء بأحسن نظام ، و إِلاّ فإِنَّ صدور فعل خارج عن الإِتقان و الإِحكام ، إمَّا لأَجل جهل الفاعل بالنظام الصحيح ، و إمّا لأَجل عجزه ، وكلا العاملين منفيان عن ساحته ، لسعة علمه لكلِّ شيء وسعة قدرته. فعدوله عن مقتضى العِلْم و القدرة الوسيعين يحتاج إلى دليل ، و ليس هو إلاّ كونه عابثاً و لاغياً ...
الثاني : إِنَّ أَثر كل فاعل يناسب واقع فاعله و مؤثره ، فهو كالظل يناسب ذا الظل. فالفاعل الكامل من جميع الجهات يكون مصدراً لفعل كامل ، و موجود متوازن أخْذاً بقاعدة مشابهة الظل لذي الظلّ.
الحكمة و الإِتقان في الكتاب و السنة إِنَّ توصيفه سبحانه بالحكمة بهذا المعنى ورد في الذكر الحكيم ، قال سبحانه : {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1].
وقد أشار الإِمام علي ( عليه السَّلام ) إلى الحكمة الإِلهية بمعنى
الإِتقان و الإِحكام بقوله : « قَدّر ما خَلَقْ فأحْكَمَ تقديرَه » (2).
وقوله : « مُبْتَدِعِ الخلائِقِ بِعِلْمِهِ ، و مُنْشئهم بحُكْمِهِ ، بلا اقتِداء و لا تعليم و لا احتذاء لمِثالِ صانع حكيم » (3).
ثم إِنَّ بعض المغرورين أثاروا شكوكاً حول حكمته تعالى ، و سألوا عن فوائد الأمور التالية و هي :
1 ـ الزائدة الدودِيّة.
2 ـ اللوزتان.
3 ـ ثديا الرجل.
4 ـ صيوان الأذن.
5 ـ الفضاء الوسيع.
ولكن هؤلاء اغتروا بما حصلوا عليه من علوم تجريبية ، و تصوروا أَنهم أحاطوا بأسرار العالم، مع أَنَّ الواقعيين من العلماء يعترفون بضآلة علومهم و قلة اطلاعهم على سُنَن الكون و رُموزه. قال سبحانه : {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].
وقال سبحانه : { يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الروم: 7].
هذا ، مع أَنَّ العلم الحديث كشف عن الفوائد الجمة لهذه الأمور التي استشكل فيها هؤلاء المغرورون و زعموا أَنَّها مضادة لحكمته سبحانه (4).
الحكيم : المنزَّه عن فعل ما لا ينبغي :
إِنَّ المعنى الثاني للحكمة هو التَنَزُّه عن فعل ما لا ينبغي ، و هي بهذا المعنى أَعمّ من العدل الذي نعرفه بعدَم الجور و الظلم ، و غيره. فالحكيم ـ بعبارة أخرى ـ هو الذي لا يفعل القبيح.
والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين و التقبيح العقليين...[وللتفصيل في مسألة التحسين والتقبيح راجع مبحث العدل ].
أفعال الله سبحانه معللة بالغايات :
ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله سبحانه ليست معللة بالأغراض و أنه لا يجب عليه شيء و لا يقبح منه شيء و استدلوا على ذلك بوجوه :
الوجه الأول :
لو كان فعله تعالى لغرض لكان ناقصاً لذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض لأنه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه و هو معنى الكمال (5).
وأجابت العدلية بأنّ أفعاله تعالى معللة بالمصالح و الحِكَمْ تفضلا على العباد فلا يلزم الاستكمال و لا وجوب الأصلح. و اختاره صاحب المقاصد و تبعته الماتريدية (6).
توضيح الجواب :
هل الغاية ، غاية للفاعل أو للفعل؟
إِنَّ الأشعري خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل ، و الغرض الراجع إلى فعله ، فالاستكمال موجود في الأول دون الثاني ، و القائل بكون أفعاله معلّلة بالأغراض و الغايات و الدواعي و المصالح ، إنما يعني بها الثاني دون الأول ، والغرض بالمعنى الأول ينافي كونه غنياً بالذات و غنياً في الصفات و غنياً في الأفعال ، و الغرض بالمعنى الثاني يوجب خروج فعله عن كونه عبثاً و لغواً ، و كونه سبحانه عابثاً و لاغياً فالجمع بين كونه غنياً غير محتاج إلى شيء ، و كونه حكيماً منزهاً عن العبث و اللغو ، بالقول باشتمال أفعاله على مصالح و حِكَم ترجع إلى العباد و النظام لا إلى وجوده و ذاته ، كما لا يخفى.
تفسير العلة الغائية :
العلة الغائية التي هي إحدى أجزاء العلة التامة ، يراد منها في مصطلح الحكماء ، ما تُخرج الفاعل من القوة إلى الفعل ، و من الإمكان إلى الوجوب ، و تكون متقدمة صورة و ذهناً و متأخرة وجوداً و تحققاً ، فهي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا بالفعل. مثلا : النجار لا يقوم بصنع الكرسي إلا لغاية مطلوبة مترتبة عليه ، و لو لا تصور تلك الغاية لما خرج عن كونه فاعلا بالقوة ، إلى ساحة كونه فاعلا بالفعل. و على هذا فللعلة الغائية دور في تحقق المعلول و خروجه من الإِمكان إلى الفعلية ، لأجل تحريك الفاعل نحو الفعل ، وسوقه إلى العمل.
ولا نتصور العلة الغائية بهذا المعنى في ساحته ، لغناه المطلق في مقام الذات و الوصف و الفعل ، فكما أنه تام في مقام الوجود ، تام في مقام الفعل ، فلا يحتاج في الإِيجاد إلى شيء وراء ذاته. و إلا فلو كانت فاعلية الحق ، كفاعلية الإنسان ، فلا يقوم بالإيجاد و الخلق إلا لأجل الغاية المترتبة عليه ، فيكون ناقصاً في مقام الفاعلية مستكملا بشيء وراء ذاته ، و هو لا يجتمع مع غناه المطلق..
هذا ما ذكره الحكماء ، و هو حق لا غبار عليه. و قد استغلته الأشاعرة في غير موضعه و اتخذوه حجة لتوصيف فعله عارياً عن أية غاية و غرض ، وجعلوا فعله كفعل العابثين و اللاعبين ، يفعل (العياذ بالله) بلا غاية ، و يعمل بلا غرض ولكن الاحتجاج بما ذكره الحكماء لإثبات ما قالته ، واضح البطلان ، لأن إنكار العلة الغائية بهذا المعنى ، لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح و حكم ينتفع بها العباد و ينتظم بها النظام ، و إن لم تكن مؤثرة في فاعلية الحق و عليَّته ، و ذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك ، و لا يصدر منه ما يضاده و يخالفه.
وبعبارة ثانية : لا يُعْنى من ذلك أنه قادر على أحد الفعلين دون الآخر ، و أنَّه في مقام الفاعلية يستكمل بالغاية ، فيقوم بهذا دون ذاك ، بل هو سبحانه قادر على كلا الأمرين ، و لا يختار منهما إلا ما يوافق شأنه ، و يناسب حكمته ، و هذا كالقول بأنه سبحانه يعدل و لا يجورُ ، فلسنا نعني من ذلك أنه تام الفاعلية بالنسبة إلى العدل دون الجور ، بل نعني أنه تام القادرية لكلا العملين. لكن عدله و حكمته ، و رأفته ورحمتهِ ، تقتضي أن يختار هذا دون ذلك مع سعة قدرته لكليهما.
هذه هي حقيقة القول بأن أفعال الله لا تعلل بالأغراض و الغايات و المصالح ، مع كون أفعاله غير خالية من المصالح و الحكم من دون أن يكون هناك استكمال.
الوجه الثَّاني :
ثم إنَّ أئمة الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلية في المقام و أنَّ المصالح و الحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل ، و أنَّها غير راجعة إلى الفاعل ، بل إلى العباد و النظام ، طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه. و إليك نص كلامهم :
فإن قيل : لا نسلم الملازمة ، و إِنَّ الغرض قد يكون عائداً إلى غيره.
قيل له : نفع غيره و الإِحسان إليه إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الإِلزام لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع و الإِحسان ، ما هو أولى به و أصلح ، و إن لم يكن أولى بل كان مساوياً أو مرجوحاً لم يصلح أن يكون غرضاً له (7).
وقد جاء بنفس هذا البيان « الفضل بن روزبهان » في رده على « نهج الحق » للعلامة الحلي و قال :
إِنَّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه و ذلك لأن ما يستوي وجوده و عدمه بالنظر إلى الفاعل أو كان وجوده مرجوحاً بالقياس إليه لا يكون باعثاً على الفعل و سبباً لإقدامه عليه بالضرورة فكل ما يكون غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل و أليق به من عدمه فهو معنى الكمال فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده ناقصاً بدونه (8).
يلاحظ عليه : أن المراد من الأصلح والأولى به ، ما يناسب شؤونه فالحكيم لا يقوم إلا بما يناسب شأنه كما أن كل فاعل غيره يقوم بما يناسب المبادي الموجودة فيه. فتفسير الأصلح و الأولى بما يفيده و يكمله ، تفسير في غير موضعه.
ومعنى أنه لا يختار إلا الأصلح و الأولى ليس بمعنى أن هناك عاملا خارجياً عن ذاته ، يحدد قدرته و مشيئته و يفرض عليه إيجاد الأصلح و الأولى ، بل مقتضى كماله و حكمته ، هو أن لا يخلق إلا الأصلح ، و الأولى و يترك اللغو و العبث فهو سبحانه لما كان جامعاً للصفات الكمالية و من أبرزها كونه حكيماً ، صار مقتضى ذلك الوصف ، إيجاد ما يناسبه و ترك ما يضاده ، فأين هو من حديث الاستكمال و الاستفادة و الإلزام و الفرض؟ كل ذلك يعرب عن أن المسائل الكلامية طرحت في جو غير هادئ و أن الخصم لم يقف على منطق الطرف الآخر.
والحاصل : إِنَّ ذاته سبحانه تامّة الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين : الفعل المقترن بالحكمة ، والخالي عنها ، و ذلك لعموم قدرته سبحانه للحسن و القبيح. ولكن كونه حكيماً يصده عن إيجاد الثاني و يخص فعله بالأول ، و هذا صادق في كل فعل له قسمان : حسن و قبيح. مثلا : الله قادر على إنعام المؤمن و تعذيبه ، و تام الفاعلية بالنسبة إلى الكل ولكن لا يصدر منه إلا القسم الحسن منهما لا القبيح ، فكما لا يستلزم القول بصدور خصوص الحسن دون القبيح (على القول بهما) كونه ناقصاً في الفاعلية ، فهكذا القول بصدور الفعل المقترن بالمصلحة دون المجرد عنها، و إنعام المؤمن ليس مرجوحاً و لا مساوياً لتعذيبه بل أولى به وأصلح لكن معنى صلاحه و أولويته لا يهدف إلى استكماله أو استفادته منه ، بل يهدف إلى أنه المناسب لذاته الجامعة للصفات الكمالية ، المنزهة عن خلافها. فجماله و كماله ، و ترفعه عن ارتكاب القبيح ، يطلب الفعل المناسب له و هو المقارن للحكمة ـ والتجنب عن مخالفه.
الوجه الثالث :
وهناك دليل ثالث للأشاعرة حاصله أن غرض الفعل خارج عنه ، يحصل تبعاً له و بتوسطه. و بما أنه تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداء ، فلا يكون شيء من الكائنات إلاّ فعلا له ، لا غرضاً لفعل آخر لا يحصل إلاّ به ، ليصلح غرضاً لذلك الفعل. و ليس جعل البعض غرضاً أولى من البعض (9).
و كان عليه أن يقرر الدليل بصورة كاملة و يقول : لو كان البعض غاية للبعض فإما أن ينتهي إلى فعل لا غاية له ، فقد ثبت المطلوب. أو لا ، فيتسلسل ، و هو محال. يلاحظ عليه :
لا يشك من أطلَّ بنظره إلى الكون ، بأنَّ بعض الأشياء بما فيها من الآثار ، خُلِقَ لأشياء أُخر. فالغاية من إيجاد الموجودات الدانية كونها في خدمة العالية منها و أما الغاية من خلق العالية فهي إبلاغها إلى حد تكون مظاهر و مجالي لصفات ربّها و كمال بارئها.
إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي ، نرى هناك أوائل الأفعال وثوانيها وثوالثها و ... فيقع الداني في خدمة العالي ويكون الغرض من إيجاد العالي إيصاله إلى كماله الممكن الّذي هو أمر جميل بالذات. ولا يتطلّب إيجاد الجميل بالذات غايةً سوى وجوده ، لأن الغاية منطوية في وجوده.
هذا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئي.
وأما إذا نظرنا إلى الكون بالنظر العام فالغاية للنظام الجملي [الجمالي] ليست أمراً خارجاً عن وجود النظام حتى يسأل عنها بالنحو الوارد في الدليل ، بل هي عبارة عن الخصوصيات الموجودة فيه و هي بلوغ النظام بأبعاضه و أجزائه إلى الكمال الممكن ، والكمال الممكن المتوخى من الإِيجاد ، خصوصية موجودة في نفس النظام و يعدّ صورة فعلية له ، فالله سبحانه خلق النظام و أوجد فعله المطلق ، حتى يبلغ ما يصدق عليه فعله ، كلا أو بعضاً ، إلى الكمال الذي يمكن أن يصل إليه ، فليست الغاية شيئاً مفصولا عن النظام ، حتى يقال : ما هي الغاية لهذه الغاية حتى يتسلسل أو يصل إلى موجود لا غاية له.
وبما أن إيصال كل ممكن إلى كماله ، غاية ذاتية لأنه عمل جميل بالذات ، فيسقط السؤال عن أنه لماذا قام بهذا ، لأنه حين أوصل كل موجود إلى كماله الممكن فالسؤال يسقط إذا انتهى إلى السؤال عن الأمر الجميل بالذات.
فلو سئلنا عن الغاية لأصل الإيجاد و إبداع النظام ، لقلنا بأن الغرض من الإيجاد عبارة عن إيصال كل ممكن إلى كماله الممكن. ثم إذا طرح السؤال عن الهدف من إيصال كل ممكن إلى كماله الممكن ، لكان السؤال جزافياً ساقطاً لأن العمل الحسن بالذات ، يليق أن يفعل ، و الفعل و الغاية نفس وجوده.
فالإيجاد فيض من الواجب إلى الممكن ، و إبلاغه إلى كماله فيض آخر ، يتم به الفيض الأول ، فالمجموع فيض من الفياض تعالى إلى الفقير المحتاج و لا ينقص من خزائنه شيء فأي كمال أحسن و أبدع من هذا ، و أي غاية أظهر من ذلك ، حتى تحتاج إلى غاية أخرى و هذا بمثابة أن يسأل لماذا يفعل الله الأفعال الحسنة بالذات ، فإن الجواب مستتر في نفس السؤال و هو أنه فعلها لأنّها حسنة بالذات و ما هو حسن بالذات ، نفسه الغاية و لا يحتاج إلى غاية أخرى.
ولأجل تقريب الأمر إلى الذهن نمثل بمثال : إذا سألنا الشاب الساعي في التحصيل و قلنا له لماذا تبذل الجهود في طريق تحصيلك؟ فيجيب : لنيل الشهادة العلمية ، فإذا أعدنا السؤال عليه و قلنا : ما هي الغاية من تحصيلها؟ يجيبنا : للاشتغال في إحدى المراكز الصناعية أو العلمية ، أو الإِدارية. فإِذا أعدنا عليه السؤال و قلنا ما هي الغاية من الاشتغال فيها؟ يقول : لتأمين وسائل العيش مع الأهل و العيال. فلو سألناه بعدها عن الغاية من طلب الرفاه و تأمين سبل العيش ، لوجدنا السؤال جزافياً لأن ما تقدم من الغايات و أجاب عنها غايات عرضية لهذه الغاية المطلوبة بالذات ، فإذا وصل الكلام إلى الأخيرة يسقط السؤال.
القرآن و أفعاله سبحانه الحكيمة :
والعجب من غفلة الأشاعرة عن النصوص الصريحة في هذا المجال يقول سبحانه : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ } [المؤمنون: 115].
وقال عز من قائل: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [الدخان: 38].
وقال سبحانه : {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27].
وقال سبحانه : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56] إلى غير ذلك من الآيات التي تنفي العبث عن فعله و تصرح باقترانه بالحكمة والغرض.
وأهل الحديث و بعدهم الأشاعرة الذين اشتهروا بالتعبد بظواهر النصوص تعبداً حرفياً غير مفوضين معانيها إلى الله سبحانه و لا مؤوّليها ، لا مناص لهم إلا تناسِ الآيات الماضية أو تأويلها و هم يفرون منه و ينسبونه إلى مخالفيهم.
عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة :
ومن الخطأ الواضح ، عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة و تصوير أن الطائفتين تقولان بأن أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض ، وهو خطأ محض كيف و هذا صدر المتألهين يخطِّئ الأشاعرة و يقول : إنَّ من المعطلة قوماً جعلوا فعل الله تعالى خالياً عن الحكمة والمصلحة ، و مع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات (10). و قال أيضاً : إِنَّ الحكماء ما نفوا الغاية و الغرض عن شيء من أفعاله مطلقاً بل إنما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة ، غرضاً زائداً على ذاته تعالى و أما ثواني الأفعال و الأفعال المخصوصة و المقيدة فاثبتوا لكل منها غاية مخصوصة كيف و كتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات و منافعها كما يعلم من مباحث الفلكيات و مباحث الأمزجة والمركبات و علم التشريح و علم الأدوية و غيرها (11).
وعلى ذلك فنظرية الحكماء تتلخص في أمرين :
1 ـ أن أفعاله غير متصفة بالعبث واللغو و أن هنا مصالح و حكماً تترتب على فعله ، يستفيد بها العباد ، و يقوم بها النظام.
2 ـ إذا لوحظ الوجود الإمكاني على وجه الإطلاق فليس لفعله غرض خارج عن ذاته ، لأن المفروض ملاحظة الوجود الإمكاني جملة واحدة و الغرض الخارج عن الذات لو كان أمراً موجوداً فهو داخل في الوجود الإمكاني و ليس شيئاً وراءه.
ويقولون : ليس الغرض شيئاً خارجاً عن الذات و إنما الغرض نفس ذاته ، لئلا يكون ناقص الفاعلية لأن الحاجة إلى شيء خارج عن ذاته في القيام بالفعل ، آية كونه ناقصاً في فاعليته ، و المفروض أنه سبحانه تام في فاعلية ، غني في ذاته و فعله عن كل شيء سوى ذاته (12).
ثم إِنَّ لهم بياناً فلسفياً ممزوجاً بالدليل العرفاني يهدف إلى كون الغرض من الخلق هو ذاته سبحانه و به فسروا قوله سبحانه :
{ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } و قوله في الحديث القدسي : « كنت كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعْرَفَ فخلقت الخلقَ لكي أُعرف » والله سبحانه هو غاية الغايات. و من أراد الوقوف على برهانهم فليرجع إلى أسفارهم (13).
البلايا و المصائب والشرور وكونه حكيماً :
إِنَّ مسألة البلايا و المصائب والشرور ، من المسائل المشهورة الذائعة الصيت في الحكمة الإِلهية ، و لها صلة بالمباحث التالية:
1 ـ إذا كان الدليل على وجود الخالق المدبر هو النظام السائد في الكون. فكيف يفسّر وجود بعض الظواهر غير المتوازنة العاصية عن النظام كالزلازل والسيول و الطوفانات ، فإنها من أبرز الأدلة على عدم النظام.
2 ـ لو كان الصانع تعالى حكيماً في فعله ، متقناً في عمله ، واضعاً كل شيء في محله ، منزّهاً فعله عمّا لا ينبغي ، فكيف تفسَّر هذه الحوادث التي لا تنطبق مع الحكمة سواء أفسرت بمن يصنع الأشياء المتقَنة أو من يكون فعله منزهاً عمّا لا ينبغي.
3 ـ إذا كان الخالق عادلاً و قائماً بالقسط فكيف يجتمع عدله سبحانه مع هذه الحوادث التي تبتلع النفوس البريئة في آن واحد ، و تخرّب الديار و تدمرها. إلى غير ذلك.
إِنَّ البحث عن الشرور ، ليس مسألة جديدة كشف عنها فلاسفة الغرب و منهم الفيلسوف « هيوم » الإِنكليزي ، كما ربما يتخيله بعض من لا خبرة له بالفلسفة الإِسلامية ، بل والإِغريقية ، فإن هذه المسألة قد طرحت بين القدامى من فلاسفة الإِغريق ، و المتأخرين من فلاسفة الإِسلام.
فقد اشتهر قول أرسطو : « إِنَّ الموجودات الممكنة بالقسمة العقلية في بادئ الإِحتمال تنقسم إلى خمسة أقسام :
1 ـ ما هو خير كله لا شرّ فيه أصلا.
2 ـ ما فيه خير كثير مع شرّ قليل.
3 ـ ما فيه شرّ كثير مع خير قليل.
4 ـ ما يتساوى فيه الخير و الشرّ.
5 ـ ما هو شر مطلق لا خير فيه أصلا ».
ثم صرّحوا بأنَّ الأقسام الثلاثة الأخيرة غير موجودة في العالم ، و إنما الموجود من الخمسة المذكورة هو قسمان (14).
وقد بحث الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي (ت 979 هـ ، م 1050 هـ ) عن مسألة الخير و الشر و المصائب و البلايا في كتابه القيّم « الأسفار الأربعة » في ثمانية فصول بحثاً علمياً ، كما بحث عنها الحكيم السبزواري في قسم الفلسفة من شرح المنظومة بحثاً متوسطاً. و قد سبقهما عدة من الأجلاّء كما تبعهما ثلة أُخرى من المفكرين الإسلاميين. و نحن نقتبس فيما يلي ما ذكره هؤلاء المحققون بتحليل و تشريح خاص فنقول :
إِنَّ مسألة الشرور و البلايا دفعت بعض الطوائف في التاريخ و حتى اليوم إلى الاعتقاد بالتعدد في الخالق ، و هو الاتجاه المسمى بالثَّنويّة ، حيث تصوّر أنَّ إله الخير هو غير إله الشَّر ، هروباً من الإِشكال المذكور ، و لأجل ذلك عرفوا بالثَّنوية. و بما أنَّهم يعتقدون بأنَّ الإِلهين مخلوقان للإِله الواجب الواحد ، فهم من أهل التثليث على هذا الإِعتبار.
وعلى كل تقدير فالإِجابة عن مشكلة الشرور تتحقق بوجهين :
اولا ـ تحليلها تحليلا فلسفياً كلياً.
الثاني ـ تحليلها تحليلا تربوياً مؤثراً في تكامل النفوس.
فعلى من يريد الإسهاب في البحث أنْ يلج البابين ، وهاك البيان :
البحث الأول ـ التحليل الفلسفي لمسألة الشرور.
حاصل هذا التحليل أنَّ ما يظنه بعض الناس من أنَّ هناك حوادث غير منتظمة ، أوْ ضارّة مدمّرة ، فإنما هو ناشيء من نظراتهم الضّيقة المحدودة إلى هذه الأمور. و لو نظروا إلى هذه الحوادث في إطار « النظام الكوني العام » لأذعنوا بأنها خير برمتها ، و يكون موقف المسألة كما قاله الحكيم السَبْزَواري :
ما ليس مَوْزوناً لِبَعْض مِنْ نَغَم ... فَفي نِظامِ الكُلِّ كُلٌّ مُنْتَظَم
هذا إجمال الجواب ، و أَما تفصيله فيتوقف على بيان أمرين :
الأَمر الأَول ـ النَّظرة الضيّقة إلى الظواهر :
إِنَّ وصف الظواهر المذكورة بأنَّها شاذّة عن النظام ، و أَنَّها شرور لا تجتمع مع النظام السائد على العالم أولا ، و حكمته سبحانه ـ بالمعنى الأعم ـ ثانياً ، و عدله و قسطه ثالثاً ، ينبع من نظرة الإِنسان إلى الكون من خلال نفسه ، و مصالحها ، و جعلها محوراً و مِلاكاً لتقييم هذه الأمور. فعندما ينظر إلى الحوادث و يرى أنَّها تعود على شخصه و ذويه بالإِضرار ، ينبري من فوره إلى وصفها بالشرور و الآفات. و ما هذا إلاّ لأَنه يتوجه إلى هذه الظواهر من منظار خاص و يتجاهل غير نفسه في العالم ، من غير فرق بين من مضى من غابر الزمان و من يعيش في الحاضر في مناطق العالم أو سوف يأتي و يعيش فيها. ففي النَّظرة الأَولى تتجلى تلك الحوادث شراً وبليّة. ولكن هذه الحوادث في الوقت نفسه و بنظرة ثانية تنقلب إلى الخير و الصلاح و تكتسي خلق الحكمة والعدل و النَّظْم. و لبيان ذلك نحلل بعض الحوادث التي تعد في ظاهرها من الشرور فنقول :
إِنَّ الإِنسان يرى أنّ الطوفان الجارف يكتسح مزرعته ، و السَيْل العارم يهدم منزله ، والزلزلة الشديدة تُزَعْزِعُ بُنيانه ، ولكنه لا يرى ما تنطوي عليه هذه الحوادث و الظواهر من نتائج إيجابية في مجالات أُخرى من الحياة البشرية.
وما أَشبه الإِنسان في مثل هذه الرؤية المحدودة بعابر سبيل يرى جرّافة تحفر الأرض ، أو تهدم بناءً مُحْدِثَةً ضوضاءَ شديداً و مُثيرة الغبار والتراب في الهواء ، فيقضي من فوره بأنه عمل ضار و سيء و هو لا يدري بأَنَّ ذلك يتم تمهيداً لبناء مستشفى كبير يستقبل المرضى و يعالج المصابين و يهيء للمحتاجين إلى العلاج وسائل المعالجة والتمريض.
ولو وقف على تلك الأَهداف النبيلة لقضى بغير ما قضى ، ولَوَصَفَ ذلك التهديم بأنه خير ، و أَنّه لا ضير فيما حصل من الضوضاء ، و تصاعد من الأَغبرة.
إِنَّ مَثَلَ هذا الإِنسان المحدود النظر في تقييمه ، مَثَل الخفاش الذي يؤذيه النور لأنه يَقبض بصره، بينما يبسط هذا النور ملايين العيون على آفاق الكون و يسهل للإِنسان مجالات السعي والحياة. أَفهل يكون قضاء الخفاش على النور بأنه شرٌ مِلاكاً لتقييم هذه الظواهر الطبيعية المفيدة؟ كلا ، لا.
الأمر الثَّاني ـ الظواهر حلقات في سلسلة طويلة :
إنَّ النظر إلى ظاهرة من الظواهر ، منعزلة عن غيرها ، نظرة ناقصة و مبتورة. لأنَّ الحوادث حلقات مترابطة متسلسلة في سلسلة ممتدة ، فما يقع الآن منها يرتبط بما وقع في أعماق الماضي و بما سيقع في المستقبل ، في سلسلة من العلل و المعاليل والأسباب و المسبَّبات.
ومن هنا لا يصحّ القضاء على ظاهرة من الظواهر بحكم مع غض النظر عما سَبَقَها ، و ما يلحقها ، بل القضاء الصحيح يتحقق بتقييمها جُملة واحدة والنظر اليها نظراً كلياً لا جزئياً. فإِنَّ كل حادثة على البسيطة أو في الجو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما سبقها أَوْ يلحقها من الحوادث. حتى أنَّ ما يهب من النسيم و يعبث بأوراق المنضدة التي أَمامك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما حدث أو سيحدث في بقاع العالم. فلا بد للمحقق أن يلاحظ جميع الحوادث بلون الارتباط و التَّشكل. فعند ذاك يتغير حكمه ويتبدل قضاؤه ولن يصف شيئاً بالشذوذ ، ولن يَسِمَ شيئاً بأَنَّه من الشرور.
إذا عرفت هذين الأمرين فلنأْتِ ببعض الأَمثلة التي لها صلة بهما :
1 ـ إذا وقعت عاصفة على السواحل فإنها تقطع الأشجار و تدمر الأَكواخ و تقلب الأثاث ، فتوصف عند ساكني الساحل بالشر والبلية ، ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على آثار حيويّة لمنطقة أُخرى.
فهي مثلا توجب حركة السُفُن الشِّراعيَّة المتوقفة في عرض البحر بسبب سكون الريح. و بهذا تنقذ حياة المئات من ركّابها اليائسين من نجاتهم ، و توصلهم إلى شواطئ النجاة ، فهي موصوفة عند ركّاب السفينة بالخير.
2 ـ إِنَّ الرياح و إِنْ كانت ربما تهدم بعض المساكن إلاّ أَنها في نفس الوقت تعتبر وسيلة فعالة في عملية التلقيح بين الإَزهار و تحريك السحب المولدة للمطر و تبديد الأدخنة المتصاعدة من فوهات المصانع والمعامل التي لو بقيت و تكاثفت لتعذرت أَوْ تعسّرت عملية التنفس لسكان المدن و القاطنين حول تلك المصانع. إلى غير ذلك من الآثار الطيبة لهبوب الرياح ، التي تتضاءل عندها بعض الآثار السيئة أو تكاد تنعدم نهائياً.
3 ـ الزلازل و إِنْ كانت تسبب بعض الخسائر الجزئية أو الكلية في الأَموال و النفوس ، إِلاّ أَنَّها توصف بالخير إذا وقفنا على أَنَّ علّتها ـ على بعض الفروض ـ جاذبية القمر التي تجذب قشرة الأرض نحو نفسها ، فيرتفع قاع البحر و يوجب ذلك الزلازل في مناطق مختلفة من اليابسة. فإنَّ هذا في نفس الوقت يوجب أَنْ تصعد مياه البحار و الأَنهار فتفيض على الأراضي المحيطة بها و تسقي المزارع و السهول فتجدد فيها الحياة و تجود بخير العطاء.
و يترتب على الزلازل آثار نافعة أُخرى يقف عليها الإِنسان المتفحص في تلك المجالات ، فهل يبقى مجال مع ملاحظة هذين الأَمرين للقضاء العاجل بأنَّ تلك الحوادث شرور و بلايا لا يترتب عليها أيّة فائدة؟.
إِنَّ عِلْمَ الإِنسان المحدود هو الذي يدفعه إلى أَنْ يقضي في الحوادث بتلك الأقضية الشاذة ، ولو وقف على علمه الضئيل و نسبة علمه إلى ما لا يعلمه لرجع القَهْقَرى قائلا : { رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 191]. و لأذعن بقوله تعالى : {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]. و قوله سبحانه : {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [الروم: 7].
و لهذا السبب نَجِدُ أنَّ العلماء الموضوعيين الذين لم تبهرهم منجزات العلوم ولم يغرّهم ما حصل لهم من التقدم ، يعترفون بقصور العلم البشري و يَحْذَرُون من التسرع في القضاء والحكم على الأشياء. كيف و هذا العالم الإِنكليزي الأستاذ (وليم كروكش) مكتشف إشعاع المادة ، والمخترع لكثير من أدوات التجارب الكيميائية قال : « من بين جميع الصفات التي عاونتني في مباحثي النفسية ، و ذلّلت لي طرق اكتشافاتي الطبيعية ، و كانت تلك الإِكتشافات أحياناً غير منتظرة ، هو اعتقادي الراسخ بجهلي » (15).
إلى غير ذلك من الكلمات المأثورة عن كبار المفكرين و أعاظم الفلاسفة والمعنيين بتحليل الظواهر الطبيعية ، فإنك تراهم يعترفون بجهلهم و عجزهم عن الوقوف على أسرار الطبيعة. و هذا هو المخ الكبير في عالم البشرية الشيخ الرئيس يقول : « بلغ علمي إلى حدّ علمت أني لست بعالم ».
تحليل فلسفي آخر للشرور :
قد وقفت على التحليل الفلسفي الماضي ، و هناك تحليل فلسفي آخر لمشكلة البلايا و المصائب و لعله أدق من سابقه ، و حاصله :
إِنَّ الشر أمر قياسي ليس له وجود نفسي و إِنما يتجلى عند النفس إذا قيس بعض الحوادث إلى بعض آخر ، و إليك بيانه :
إِنَّ القائلين بالثَّنوية يقولون إِنَّ الله سبحانه خير محض ، فكيف خلق العقارب السّامة والحيَّات القاتلة و الحيوانات المفترسة و السباع الضواري.
ولكنهم غفلوا عن أنَّ اتصاف هذه الظواهر بالشرور اتصاف قياسي وليس باتصاف نفسي ، فالعقرب بما هو ليس فيه أي شر ، وإنما يتصف به إذا قيس إلى الإِنسان الذي يتأذَّى من لسعته، فليس للشرّ واقعية في صفحة الوجود ، بل هو أمرُ انتزاعي تنتقل إليه النفس من حديث المقايسة، ولولاها لما كان للشرّ مفهوم و حقيقة. وإليك توضيح هذا الجواب.
إِنَّ الصفات على قسمين : منها ما يكون له واقعية كموصوفه ، مثل كون الإِنسان موجوداً ، أو أَنَّ كل متر يساوي مائة سنتيمتر. فاتصاف الإِنسان بالوجود والمتر بالعدد المذكور ، أَمران واقعيان ثابتان للموجود ، توجه إليه الذهن أَم لا. حتى لو لم يكن على وجه البسيطة إِلاّ إنسان واحد أو متر كذلك فالوصفات ثابتان لهما.
ومنه ما لا يكون له واقعية إلاّ أَنَّ الإِنسان ينتقل إلى ذلك الوصف ، أَو بعبارة صحيحة ينتزعه الذهن بالمقايسة ، كالكبر و الصغر ، فإِنَّ الكبر ليس شيئاً ذا واقعية للموصوف و إنما يُدْرَك بالقياس إلى ما هو أصغر منه.
مثلا : الأرض توصف بالصِغَر تارة إذا قيست إلى الشمس ، و بالكِبَر أخرى إذا قيست إلى القمر. و لأجل ذلك لا يدخلان في حقيقة الموصوف ، و إِلا لما صح وصف الأرض بوصفين متعارضين.
إذا عرفت انقسام الأَوصاف إلى القسمين ، فعليك تحليل مفهوم الشر على ضوء هذا البيان فنقول: إِنَّ كون العقرب موجوداً و ذا سمَّ ، من الأمور الحقيقية. و أما كونه شرّاً ، فليس جزءاً من وجوده ، و إِنما يتصف به سمّ العقرب إذا قيس إلى الإِنسان و تضرره به أو فقدانه لحياته بسببه ، وإِلاّ فانه يعدّ كمالا للعقرب و موجباً لبقائه. فإذا كان كذلك سهل عليك حلّ عقدة الشرور من جوانبها المختلفة.
أَما من جانب التوحيد في الخالقية و أنَّه ليس من خالق في صفحة الوجود إلاّ الله سبحانه و هو خير محض ليس للشر إليه سبيل ، فكيف خَلَقَ هذه الموجودات المتسمة بالشر ، فالجواب أنَّ المخلوق هو ذوات هذه الأشياء و ما لها من الصفات الحقيقية ، و أَما اتصافها بالشر فليس أمراً حقيقياً محتاجاً إِلى تعلق العلّة ، بل هو أَمرٌ قياسي يتوجه إليه الإِنسان ، عند المقايسة.
وإلى هذا المعنى تؤول كلمات الفلاسفة القدامى إذ قالوا :
« 1 ـ الشر أمرٌ عدمي ، و ليس أَمراً موجوداً محتاجاً إلى العلّة.
2 ـ الشَّر ليس مجعولا بالذات بل مجعول بالعَرَض.
3 ـ إذا تصفحت جميع الأشياء الموجودة في هذا العالم المسمَّاة عند الجمهور شروراً ، لم تجدها في أَنفسها شروراً ، بل هي شرور بالعَرَض خيْرات بالذات » (16).
ونحو ذلك الأخلاق الذميمة فإنها كلها كمالات للنفوس السَّبُعِيّة و البهيمية و ليست بشرور للقوى الغضبية و الشَّهَوِيَّة. و إِنما شِرِّيَّة هذه الأَخلاق الرذيلة بالقياس إلى النفوس الضعيفة العاجزة عنِ ضبط قواها عن الإِفراط و التفريط و عن سوقها إلى مسلك الطاعة الذي تناط به السعادة الباقية.
وكذلك الآلام و الأوجاع والغموم و الهموم فهي من حيث كونها إدراكات ، و من حيث وجودها أو صدورها من العلل الفاعلة لها ، خيرات كمالية ، و إِنما هي شرور بالقياس إلى متعلقاتها.
وأمَّا من جانب توصيفه سبحانه بالحكمة و الإِتقان في الفعل و العمل ، فليس في خلق هذه الحوادث و الموجودات شيء يخالف الحكمة ، فإنه سبحانه خلق العقارب والحيّات و الضواري و السباع بأحسن الخلقة و أعطاها ما يكفيها في الحياة {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50]. و إِنما تتسم هذه الحوادث و الموجودات بالشر ويتراءى أنها خلاف الحكمة من حيث المقايسة ، و هو أمر ذهني لا خارجي.
إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة و هي أَنَّ هناك عاملين دفعا الإِنسان إلى تصور أَنَّ الشَّر ، أَمرٌ عيني خارجي يعد إيجاده على خلاف الحكمة والعدل و أَنَّه عصيان عن النظم و هما :
1 ـ النَّظرة إلى الأَشياء من منظر الأنانية و تناسي سائر الموجودات.
2 ـ تصور أنَّ الشر له عينية خارجية كالموصوف ، و الغفلة عن أَنَّه أمرٌ عدمي يتوجه إليه الذهن عند المقايسة.
و قد حان وقت البحث عن التحليل التربوي للشرور الذي يسهّل التصديق بعدم كون إيجادها على فرض كونها أموراً عينية في الخارج ـ لأجل هذه الآثار التربوية ـ مخالفاً للحكمة والعدل.
البحث الثَّاني ـ التَّحليل التربوي لمسألة الشرور :
إِنَّ لهذه الحوادث آثاراً تربوية مهمة في حياة البشر المادية تارةً ، و في إزاحة الغرور و الغفلة عن الضمائر والعقول ثانياً. و لأَجل هذه الفوائد صحّ إيجادها ، سواء قلنا بأنّ الشرّ موجود بالذات ، كما عليه المعترض ، أو موجود بالعَرَض ، كما حققناه.
وإليك فيما يلي توضيح هذه الآثار واحدة بعد الأخرى.
أ ـ المصائب وسيلة لتفجير الطَّاقات :
إِنَّ البلايا و المصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات و تقدّم العلوم ورقي الحياة البشرية ، فها هم علماء الحضارة يصرّحون بأن أكثر الحضارات لم تزدهر إلا في أَجواء الحروب و الصراعات و المنافسات حيث كان الناس يلجأون فيها إلى استحداث وسائل الدفاع في مواجهة الأعداء المهاجمين ، أو إصلاح ما خرّبته الحروب من دمار و خراب. ففي مثل هذه الظروف تتحرك القابليات بجبران ما فات ، و تتميم ما نقص ، و تهيئة ما يلزم. و في المثل السائر : « الحاجة أُمّ الإِختراع ».
وبعبارة واضحة : إِذا لم يتعرض الإِنسان للمشاكل في حياته فإن طاقاته ستبقى جامدة هامدة لا تنمو و لا تتفتح ، بل نمو تلك المواهب و خروج الطاقات من القوة إلى الفعلية ، رهن وقوع الإِنسان في مهب المصائب و الشدائد.
نعم ، لا ندَّعي بأنَّ جميع النتائج الكبيرة توجد في الكوارث و إنّما ندَّعي أَنَّ عروضها يُهيء أَرضية صالحة للإِنسان للخروج عن الكسل. و لأجل ذلك ، نرى أنَّ الوالدين الذين يعمدان إلى إِبعاد أَولادهما عن الصعوبات و الشدائد لا يدفعان إلى المجتمع إلاّ أَطفالا يهتزون لكل ريح كالنبتة الغضّة أَمام كل نسيم.
وأما اللذان يُنشئان أولادهما في أجواء الحياة المحفوفة بالمشاكل و المصائب فيدفعان إلى المجتمع أَولاداً أَرسخ من الجبال في مهب العواصف.
قال الإِمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) : « ألا إِنَّ الشَّجرَةَ البَرّيّة أَصْلَبُ عُوداً ، و الرَّوائِعَ الخَضِرَةَ أرَقُّ جُلوداً ، و النباتاتِ البَدَويَّة أَقوى وَقُوداً و أَبطَأُ خُموداً » (17).
وإلى هذه الحقيقة يشير قوله سبحانه : {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } [النساء: 19].
وقوله تعالى : {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5، 6]. و قوله تعالى : {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 7، 8]. أي تَعَرَّض للنَّصَب و التعب بالإِقدام على العمل و السعي و الجهد بعدما فرغت من العبادة ، و كأنَّ النصر والمحنة حليفان لا ينفصلان و أَخوان لا يفترقان.
ب ـ المصائب و البلايا جرس إِنذار :
إِنَّ التمتع بالمواهب الماديَّة و الإِستغراق في اللذائذ و الشهوات يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية ، و كلما ازداد الإِنسان توغّلا في اللذائذ و النعم ، ازداد ابتعاداً عن الجوانب المعنوية. و هذه حقيقة يلمسها كل إِنسان في حياته و حياة غيره ، و يقف عليها في صفحات التاريخ. فإذن لا بد لانتباه الإِنسان من هذه الغفلة من هزّة و جرس إِنذار يذكّره و يوقظ فطرته و ينبهه من غفلته. و ليس هناك ما هو أَنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه و يتخلى عن غروره و يخفف من طغيانه. و نحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بصلة الطغيان بإحساس الغِنى ، إذْ يقول عز وجل : { كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى } [العلق: 6، 7].
ولأجل هذا يعلل القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب بأَنها تنزل لأَجل الذكرى و الرجوع إلى الله ، يقول سبحانه : { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ } [الأعراف: 94].
و يقول ايضاً : { وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 130].
هكذا تكون البلايا و المصائب سبباً ليقظة الإِنسان و تذكرة له ، ، فهي بمثابة صفع الطبيب وجه المريض المبنّج لإِيقاظه ، الذي لولا صفعته لانقطعت حياة المريض.
فقد خرجنا بهذه النتيجة و هي أَنَّ التكامل الأَخلاقي رهن المحن والمصائب ، كما أنَّ التفتح العقلي رهن البلايا و النوازل.
والإِنسان الواعي يتخذها وسيلة للتخلي عن الغرور ، كما يتخذها سلماً للرقي إلى مدارج الكمال العلمي ، و قد لا يستفيد منها شيئاً فيعدّها مصيبة وكارثة في الحياة.
ج ـ البلايا سبب للعودة الى الحق :
إِنَّ للكون هدفاً ، كما أنَّ لخلق الإِنسان هدفاً كذلك ، و ليس الهدف من خلقة الإِنسان إلاّ أَنْ يتكامل و يصل إلى ما يمكن الوصول إِليه. و ليس الهدف من بعث الأَنبياء و إِنزال الكتب إِلاّ تحقيق هذه الغاية السامية. و لما كانت المعاصي والذنوب من أَكبر الأَسباب التي توجب بعد الإِنسان عن الهدف الذي خُلق من أَجله ، و تعرقل مسيرة تكامله ، كانت البلايا والمصائب خير وسيلة لإِيقاف الإِنسان العاصي على نتائج عتوه و عصيانه حتى يعود إِلى الحق و يرجع إِلى الطريق الوسطى. و إِلى هذه النكتة يشير قوله سبحانه : {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]. و يقول سبحانه في آية الأخرى : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } [الأعراف: 96].
د ـ البلايا سبب لمعرفة النّعم و تقديرها :
إِنَّ بقاء الحياة على نمط واحد يوجب أنْ لا تتجلى الحياة لذيذة محبوبة ، و هذا بخلاف ما إذا تراوحت بين المُرّ و الحُلو و الجميل و القبيح ، فلا يمكن معرفة السلامة إِلاّ بالوقوف على العيب. و لا الصّحة إلاّ بلمس المرض ، و لا العافية إِلاّ عند نزول البلاء. و لا تدرك لذة الحلاوة إِلاّ بتذوق المرارة.
فجمال الحياة و قيمة الطبيعة ينشئان من التنوع و الإِنتقال من حال الى حال و من وضع إلى آخر. و لأجل ذلك نلمس أَنَّ خالق الطبيعة جعل الوديان إلى جانب الجبال ، و الأَشواك جانب الورود ، و الثّمار المرّة جَنْب الحلوة ، والماء الأَجاج جَنْب العَذْب الفُرات ، إلى غير ذلك من مظاهر التضاد و التباين التي تضفي على الطبيعة بهاءً وجمالا ، و كمالا و جلالا.
هذه هي الآثار التربوية للمصائب والبلايا ، و تكفي في تسويغ نزولها ، و تبرير تحقيقها في الحياة البشرية.
البلايا المصطنعة للأَنظمة الطاغوتية :
إِنَّ هناك من المِحَن ما ينسبه الإِنسان الجاهل إلى خالق الكون ، والحال أنَّها من كسب نفسه و نتيجة منهجه. بل الأَنظمة الطاغوتية هي التي سببت تلك المحن و أوجدت تلك الكوارث ، و لو كانت هناك أنظمة قائمة على قيم إلهية لما تعرض البشر لتلك المحن.
فالتقسيم الظالم للثروات هو الذي صار سبباً لتجمع الثروة عند ثلّة قليلة ، و انحسارها عن جماعات كثيرة ، كما صار سبباً لتمتع الطائفة الأولى بكل وسائل الوقاية والحماية من الأَمراض والحوادث و حرمان الطائفة الثانية منها. فهذه البلايا المصطنعة خارجة عن إطار البحث ، فلا تكون موقظة للفكر و لا مزكيّة للنفوس ، بل تهيء أَرضية صالحة للإِنتفاضات و الثورات.
إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة و هي أَنَّ الظواهر غير المتوازنة بحسب النظرة السطحية متوازنة بالقياس إلى مجمل النّظام و لها آثار اجتماعيَّة و تربويَّة ولا مناص في الحياة البشريَّة منها فلا تعد مناقضة للنَّظْم السائد و لا لحكمة الخالق و لا لعدله و قسطه سبحانه و تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ و قد ذكر الرازي هنا معنى ثالثاً و هو أنَّ الحكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم ، فالحكيم بمعنى العليم ، قال الغزالي : و قد دللنا على أنَّه لا يعرف الله إلاّ الله ، فيلزم أن يكون الحكيم الحق هو الله ، لأنه يعلم أصل الأشياء ، و هو (العلم بأصل الأشياء) أصل العلوم ، و هو علمه الأزلي الدائم الذي لا يُتصور زواله ، المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها الخفاء و لا الشبهة. (أسماء اللهُ الحُسْنى ، ص 279 ـ 280). أقول : و على المعنى الثالث تكون الحكمة من شعب علْمه.
2ـ نهج البلاغة ، الخطبة (91).
3 ـ نهج البلاغة ، الخطبة (191).
4 ـ لاحظ « الله خالق الكون » ص 370 ـ 378 ، تحت عنوان « الأعضاء الزائدة لماذا »؟
5 ـ المواقف ص 231.
6 ـ إشارات المرام ص 54.
7 ـ المواقف ، ص 333. و شرحه ، ج 8 ، ص 204.
8 ـ دلائل الصدق ، ج 1 ، ص 233.
9 ـ المواقف ، ص 332. و شرحه ، ج 8 ، ص 204.
10 ـ الأسفار ، ج 2 ، ص 280.
11 ـ الأسفار ، ج 7 ، ص 84.
12 ـ الأسفار ، ج 2 ، ص 263.
13 ـ لا حظ الأسفار ، ج 2 ، ص 263.
14 ـ الأسفار ، ج 7 ، ص 68.
15 ـ على أطلال المذهب المادي ، ج 1 ، ص 136.
16 ـ الأسفار الاربعة ، ج 7 ، ص 62.
17 ـ نهج البلاغة ـ خطبة 45.
 الاكثر قراءة في العلم و الحكمة
الاكثر قراءة في العلم و الحكمة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












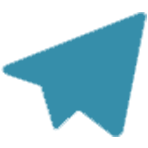
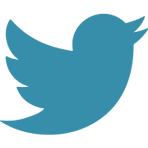

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)