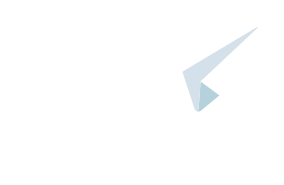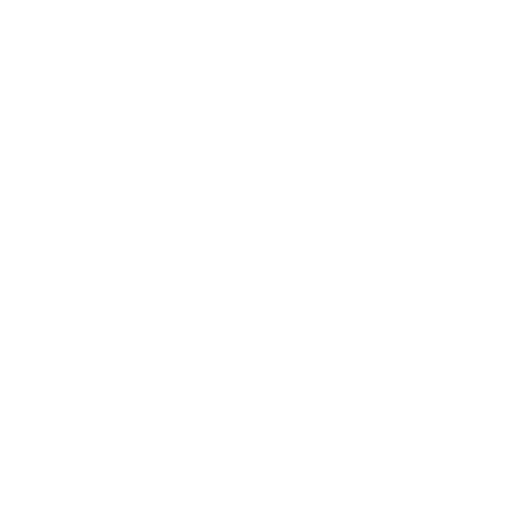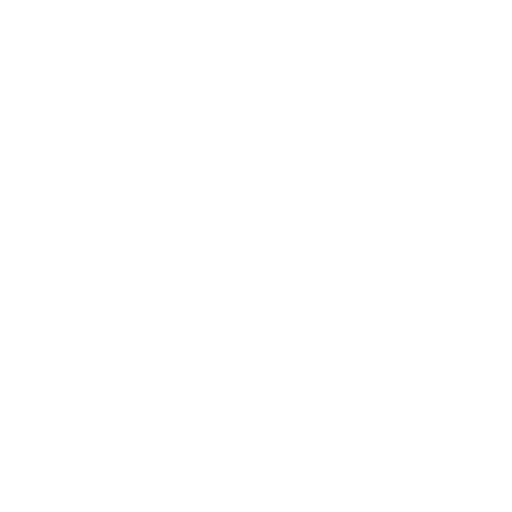التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
كيفية القدرة وتفسيرها
المؤلف:
محمّد آصف المحسني
المصدر:
صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية
الجزء والصفحة:
ج1- ص116-131
24-10-2014
3077
وهذه مسألة هامّة جداً ، وقد أصبحت من أهم معارك الآراء الفلسفية والأنظار الكلامية ، والتضارب فيها شديد جداً بحيث نسبت طائفة إلى الجهل والضلال ، وابتليت فرقة بالتكفير والتفسيق .
وتصوير النزاع في هذه المسألة :
أنّ الواجب الوجود هل يتمكن من ترك الفعل أو لا ؟ وإن شئت فقل : إنّ ما يصدر عنه هل هو واجب منه أم لا ؟ بل يمكنه الترك والفعل معاً ، فلا وجوب للفعل منه ، وإنّما الوجوب بعد تعلّق إرادته ، فإنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد .
وبكلمة أوضح بياناً : لا شك عند الموحّدين أنّ الله مختار في خلقه وفعله ، لكن هل اختياره من سنخ اختيار الحيوان ، الذي هو بمعنى له أن يفعل وله أن لا يفعل ، أم لا بل هو من سنخ آخر ؟
المتكلّمون على الأَوّل ، والفلاسفة على الثاني ، وحيث إنّ البحث عنه مهم جداً ، نبدأ بنقل ما أفاده الباحثون من الطرفين فيها ؛ حتى تتّضح المسألة المذكورة حقّ وضوحها ، ولنكن حين الاستدلال والاختيار على بصيرة تامّة من أمرنا .
فنقول : قال الفيلسوف الشهير في أسفاره (1) : إنّ للقدرة تعرفينِ مشهورين :
أحدهما : صحّة الفعل ومقابله أعني الترك .
وثانيهما : كون الفاعل في ذاته ، بحيث إنّ شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل .
والتفسير الأَوّل للمتكلمين والثاني للفلاسفة ، ومن المتأخّرين من ذهب إلى أنّ المعنيين متلازمان بحسب المفهوم والتحقّق ، وأنّ مَن أثبت المعنى الثاني يلزمه المعنى الأَوّل قطعاً؛ وذلك لأنّ الفاعل إذا كان بحسب ذاته بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، كان لا محالة من حيث ذاته ـ مع عزل النظر عن المشيّة واللامشيّة ـ يصح منه الفعل والترك ، وإن كان يجب منه الفعل إذا وجب المشية ، والترك إذا وجب اللامشيّة ، فلزوم الفعل ووجوبه من تلقاء دوام المشية ووجوبها، لا ينافي صحّة الترك على تقدير اللامشيّة، وكذلك قياس مقابله في الاعتبارين.
أقول : ما ذكره غلط وخبط ، فإنّ الصحة والجواز في الفعل ومقابله ، مرجعهما الإمكان الذاتي، وتحقّقه مستحيل فيه تعالى ؛ فإنّه وجوب بلا إمكان ، وإنّما يجوز تلك النقائص عند مَن يجعل صفاته زائدةً على ذاته كالأشاعرة ، أو يجعل الداعي على صنعه وإيجاده أمراً مبايناً ، فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد ؛ صفةً كانت أو داعياً ، جائز المشيئة واللامشيئة صحيح الفاعلية واللافاعلية ، وأمّا عند مَن وحّده وقدّسه عن شوائب الكثرة والإمكان ، فالمشية المتعلّقة بالجود والإفاضة عين ذاته بذاته ، بلا تغاير بين الذات والمشيئة خارجاً وذهناً ، بلا اختلاف حيثية تقييدية وتعليلية ، فصدق القضية الشرطية القائلة : إن شاء فعل ، لا ينافي وجوب المقدّم ، وضرورة العقد الحملي له ضرورة أزلية دائمة ، وكذا الشرطية القائلة : إن لم يشأ لم يفعل ، لا ينافي استحالة المقدّم امتناعاً ذاتياً ، وضرورة نقيضه ضرورة أزلية ، فعلم أنّ التفسير الثاني صادق عند الحكماء دون الأَوّل ، ولا تلازم بينهما إلاّ في القادر الذي يكون إرادته زائدةً على ذاته ، وأمّا الواجب فلكونه فوق التمام ، وبذاته البسيطة الحقة يفعل ما يفعل ، لا بمشيئة زائدة ، ولا بهمة عارضة ، لازمة أو مفارقة ، فهو بمشيئته وعلمه ورضائه وحكمته ، التي هي عين ذاته يفيض الخير ويجود النظام ، وهذا أتم أنحاء القدرة ، وأفضل ضروب الصنع ، ولا يلزم من ذلك جبر كفعل الماء في تبريده ... إلخ انتهى كلامه مع تغيير ما .
وقال الحكيم السبزواري : لا يلزمنها ـ أي القدرة ـ حدوث ما انفعل ، أي الحدوث الزماني في المقدور القابل للأثر ، خلافاً للمتكلّمين ، فاعتبروا في مفهوم القدرة انفكاك متعلّقها وقتاً ما عن الذات ـ ( وبعضهم اعتبروا في القدرة إمكان الترك إمكاناً ذاتياً ، وبعضهم إمكانه إمكاناً وقوعياً، والإمكان الوقوعي ما لا يلزم من فرض وقوعه محال ، والحال أنّ فيه محالاً كلّ المحال ؛ لأنّ عدم المعلول كاشف عن عدم علّته ، كعدم العقل الأَوّل أو عدم الفعل مطلقاً ؛ وبعضهم اعتبروا الوقوع في الترك ، وفيه : أنّه تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ) (2) ـ وقد عرّفوا قدرته بصحّة الفعل والترك ، وهو باطل ؛ إذ الصحّة هي الإمكان، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ، فالقدرة كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ... فالحق تعالى موجِب ـ بسكر الجيم ـ أي فاعل يجب فعله بقدرته وأخياره ، وهذا على مذهب الحكيم حيث يقول : الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وليس موجَباً ـ بفتح الجيم ـ أي فاعلاً يجب فعله لا بقدرته واختياره كالمضطر ، تعريض إلى مَن نسب إلى الحكماء إطلاقهم الموجب عليه بهذا المعنى ، بأنّه حرّف الكلمة عن موضعها (3) ... إلخ .
وقال المحقّق الطوسي قدّس سره في قواعد العقائد : والقادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل الفعل ولا يجب ، وإذا فعل فعلاً باعتبار ( اختيار ظ ) وإرادة لداع يدعوه إلى أن يفعل ، ويقابله الموجب ، وهو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ويجب أن يقارنه فعله ؛ لأنّه لو تأخّر الفعل عنه لَما كان صدور الفعل عنه واجباً ؛ إذ لم يصدر عنه في الحال المتقدّم على الصدور .
والمتكلّمون يقولون بأنّ الباري تعالى قادر ، إذا كان فعله حادثاً غير صادر عنه في الأزل، ويلزم القائل بالقِدم كون فاعله موجباً .
والحكماء يقولون : كل فاعل فَعل بإرادةٍ مختارٌ ، سواء قارنه الفعل في زمانه أو تأخّر عنه، وموضع الخلاف في الداعي ، فإنّ المتكلّمين يقولون : إنّه لا يدعو الداعي إلاّ إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده ، بعد الداعي بالزمان ، أو تقدير الزمان ، ويقولون : إنّ هذا الحكم ضروري والحكماء ينكرونه (4) انتهى .
قال الحكيم اللاهيجي في شوارقه : إنّه تعالى قادر مختار ، بمعنى أنّه يتمكّن من الفعل والترك ، بمعنى أنّه تعالى بحيث قد يتخلّف عنه الفعل ، فإنّ القدرة بهذا المعنى هو المتنازع فيه بين المتكلمين والحكماء ، وأمّا القدرة بمعنى كونه بحيث يصحّ منه فعل العالم وتركه بالنظر إلى ذاته تعالى ، أو بمعنى كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فمتفق عليه بين الفريقين... إلى أن قال : فالنزاع إذن ليس في معنى القدرة ، الذي هو المفهوم الشرطي ، بل في وجوب وقوع مفهوم المقدّم وعدم وجوبه (5) .
قال العلاّمة الحلي قدّس سره في ضمن كلام له : لزم خروج الواجب تعالى عن كونه قادراً، ويكون موجباً ، وهذا هو الكفر الصريح ؛ إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة إنّما هو هذه المسألة (6) !
قال في شرح المواقف : أي يصح منه إيجاد العالم وتركه ، فليس شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه ، وإلى هذا ذهب الملّيون كلّهم ، وأمّا الفلاسفة فإنّهم قالوا : إيجاده للعالم على النظام الواقع من لوازم ذاته ، فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور ... وأمّا كونه تعالى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فهو متّفق عليه بين الفريقين ... (7) إلخ .
قال القوشجي في شرح التجريد : ذهب الملّيون قاطبةً إلى أنّ تأثير الواجب في العالم بالقدرة والاختيار ، على معنى أنّه يصح منه فعل العالم وتركه ، وذهب الفلاسفة إلى أنّ تأثيره فيه بالإيجاب (8) انتهى .
وكذا الإصبهاني في شرحه مطالع الأنظار على طوالع الأنوار .
وقال بعض الفضلاء السادة في شرحه على نهج البلاغة : وقيل : هو ( أي القادر ) كون ذاته بذاته في الأزل ، بحيث يصحّ منه خلق الأشياء فيما لا يزال على وِفق علمه بها ، وهي عين ذاته ، وقيل : هي ـ القدرة ـ علمه بالنظام الأكمل من حيث أنّه يصحّ صدور الفعل عنه ، وقيل : هي عبارة عن نفي العجز عنه ، وقيل : هي فيض الأشياء عنه بمشيئته التي لا تزيد على ذاته ، وهي العناية الأزلية (9) انتهى .
تعقيب تحصيلي :
هذه نبذة من كلماتهم في المسألة ، وهي تدلّك على حقيقة القولين المذكورين دلالةً واضحة ، ولمزيد تنقيح البحث نذكر ما يستفاد من هذه التعابير ، وهو أُمور :
الأَوّل : إنّ البحث ليس بلفظي كما توهم ، ولا ملازمة بين القولين أصلاً كما زعم ، فإن المتكلّمين يعتبرون الصحّة التي هي الإمكان في تعريف القدرة ، والفلاسفة ينكرونها أشدّ الإنكار.
فالتعريف الأَوّل ـ وهو صحّة الفعل والترك ـ صحيح عند أصحاب الكلام ، وباطل بزعم أرباب الفلسفة ، وأمّا التعريف الثاني ـ وهو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ـ فهو ينطبق على كلا المسلكين ، فإنّ صحّة الشرطية لا تنافي ضرورة المقدّم وامتناع التالي ولا إمكانهما ، فالمتكلّم على الثاني والفلسفي على الأوّل .
الثاني : اعتراف الحكماء بصحة تعريف المتكلّمين ، في الذي كان إرادته زائدةً على ذاته ، وكان داعيه أمراً مبايناً ، فإنّ الفعل بالنظر إلى ذاته من حيث هي ممكن الصدور والترك ، والخلاف فيمَن كان إرادته وداعيه عين ذاته بلا فرق أبداً .
الثالث : ضرورة العالم بالنسبة إلى ذاته تعالى من حيث هي ذاته ، وعدم إمكان تخلّفه عنها ـ
سواء كان إمكاناً ذاتياً أو وقوعياً ـ فضلاً عن وقوع الترك ، كما ظهر من كلام الأسفار وشرح المنظومة ، فما تقدّم من الشوارق من أنّ القدرة ، بمعنى كونه بحيث يصحّ منه فعل العالَم وتركه بالنظر إلى ذاته ، أو بمعنى كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فمتفق عليه بين الفريقين ، ساقط جداً فإنّ فعل العالَم بالنسبة إلى ذاته تعالى ضروري عند الحكماء ، فأين الاتفاق؟ نعم التعريف الثاني متّفق عليه بينهما ...
الرابع : معنى اختيار الواجب عند الحكماء ، هو صدور الفعل عنه مقارناً للعلم والرضاء فقط ، ولا يعتبرون إمكان التخلّف فيه ولو إمكاناً ذاتياً ، بل يرون امتناعه كما مرّ ، وهذا بخلاف المتكلّمين ، فإنّهم يرون وقوع التخلّف شرطاً في مفهوم الاختيار ، كما يظهر من عبارة المحقّق الطوسي ، أو إمكان التخلّف إمّا ذاتياً أو وقوعياً ، كما نقله السبزواري عن بعضهم .
أقول : فالإيجاب عند الأَوّلين هو صدور الفعل من غير العلم والرضاء به ، وعند الآخرين صدوره بلا جواز تخلّفه ، فالحكيم إذا ادّعى أنّ الواجب القديم مختار يعني به : أنّه عالم بصدور فعله عنه ، وليس كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها .
قال خاتم الفلاسفة في أسفاره : فإذن ما يقال من أنّ الفرق بين الموجب والمختار : أنّ المختار ما يمكنه أن يفعل وألاّ يفعل ، والموجب ما لا يمكنه أن لا يفعل ، كلام باطل ؛ لأنّك قد علمت أنّ الإرادة متى كانت متساويةً لم تكن جازمةً ، وهناك يمتنع حدوث المراد إلاّ عند مَن نفى العلّية والمعلولية بين الأشياء كالأشاعرة ، ومتى ترجّح أحد طرفيها على الآخر صارت موجبةً للفعل ، ولا يبقى حينئذٍ بينها وبين سائر الموجبات فرق من هذه الجهة ، بل الفرق ما ذكرنا ، من أنّ المريد هو الذي يكون عالماً بصدور الفعل الغير المنافي عنه ، وغير المريد هو الذي لا يكون عالماً بما يصدر عنه ـ كالقوى الطبيعية ـ وإن كان الشعور حاصلاً ، لكن الفعل لا يكون ملائماً ، بل منافراً ، مثل المُلجَأ على الفعل فإنّ الفعل لا يكون مراداً له ... إلخ .
الخامس : محور النزاع ومناط البحث في المقام هو الداعي ، فإنّه إن ثبت زيادته على ذاته تعالى تمّ قول المتكلّمين ؛ إذ الفعل حينئذٍ بالنسبة إلى الذات من حيث هي ممكن الصدور واللاصدور ، كما ذكره في الأسفار وهو واضح ، أو لأنّ الداعي لا يدعو إلى المعدوم بالضرورة ، كما نقله العلاّمة الطوسي عن المتكلّمين ، بل ... عن التفتازاني (10) أنّه متّفق عليه بين الفلاسفة والمتكلّمين ، وعليه فإنكار الحكماء في قول المحقّق الطوسي المتقدّم ـ حيث قال : والحكماء ينكرونه ـ راجع إلى الداعي نفسه ، لا إلى عدم داعويته إلى المعدوم فتأمّل .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد بالداعي ـ كما يظهر من مسفوراتهم ـ هو إرادته التابعة للأغراض الزائدة على ذات الواجب ، كما عن الإمامية والمعتزلة ، والحكماء ينكرونه جداً ويقولون : إنّ الغرض من فعله ، نفس ذاته المقدّسة . والأشعريون ينكرون الغرض من أصله في أفعاله تعالى ، ولكنّهم يجعلون صفاته زائدةً على ذاته ، فيصح لهم إثبات اختياره من هذه الناحية ، كما اعترف به كلام الأسفار المتقدّم .
ومسألة تعلّل أفعاله بالأغراض الزائدة ، مسألة مهمة عويصة طويلة الذيل جداً ، ومع ذلك أُهملت في الكتب الكلامية ... لكنّ الشأن في الابتناء المذكور ، فإنّ الفعل ـ بناءً على زيادة الداعي على الذات ـ وإن كان ممكناً بالنسبة إلى الذات المذكورة ، من حيث الصدور واللاصدور ، كما ذكره في الأسفار ، وهو يبطل مذهب الفلاسفة من نفي إمكان الفعل بالنسبة إلى الذات ، لكنّه لا يثبت مذهب المتكلّمين ، ما لم يتحقّق مقدورية الداعي المذكور ، فإنّا لو فرضنا أنّ الداعي غير مقدور كان الفعل الصادر عنه ـ صدور المعلول عن علّته التامة ـ أيضاً غير مقدور ، فأين الاختيار ؟
وقد ذهب جمع كثير إلى إرجاع إرادته تعالى إلى العلم بالمنفعة والمصلحة ، ولعلّه المشهور بين العدلية ، ومن الواضح أنّ العلم ـ سواء كان عين ذاته ، أو زائداً عليها وقائماً بها من الأزل ـ غير مقدور للواجب .
وخلاصة المقال : أنّ مجرّد إمكان الفعل صدوراً وتركاً ، بلحاظ ذاته تعالى من حيث هي ، لا يفي بإثبات اختيار الواجب ، الذي يصرّ عليه المتكلّمون ، فإنّه بمعنى له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهذا إنّما يتحقّق في فرض مقدورية الدّاعي ، وأمّا ما ادّعاه شركاء الفن وغيرهم ، من الضرورة على أنّ الدّاعي لا يدعو إلاّ إلى معدوم ، فهو ممّا لا سبيل لنا إلى تصديقه ؛ إذ يمكن الالتزام بهذا الداعي ـ وهو علمه بما في الفعل من المصلحة ـ والقول مع ذلك بضرورة صدور الفعل عنه من جهة أدلة الحكماء الآتية ، فإنّ الله قديم الذات وقديم العلم ، فهو عالم أزلاً بأنّ الشيء الفلاني فيه مصلحة مثلاً ، فهذا العلم القديم بما أنه علّة يستلزم قِدم المعلول . نعم لو بنينا على قول الفلاسفة من نفي الداعي ، فلا يمكن أن نذهب إلى اختياره تعالى في أفعاله ، كما يرومه الكلاميون ...
السادس : الظاهر من كلام المحقّق الطوسي قدّس سره ، أنّ وقوع تخلّف الفعل عن الفاعل معتبر في مفهوم الاختيار ، لكنّه غير مدلّل ، بل الملاك هو إمكانه إمكاناً وقوعياً ، وأمّا نفس التخلّف خارجاً فهو غير معتبر ، نعم هنا شيء آخر وهو أنّ الممكن الوجود هل يمتنع قِدمه أو لا ؟ و... بحثه في مسألة حدوث العالم ، لكن القول بامتناعه لا يشهد على اعتبار التخلّف في الاختيار ؛ إذ استحالة قِدم الممكن في نفسه شيء ، ومنافاته لمفهوم الاختيار شيء آخر ، ولا ربط بينهما أصلاً.
هذا ما يتعلّق بجهات البحث وتصوير المدّعى ، ولنرجع الآن إلى بيان أدلّتهم فنقول : استدل الفلاسفة على دعواهم بوجوه ، وإليك بيانها وتوضيحها :
الأَوّل : إنّ الواجب كما تجب ذاته تجب صفاته ، فهو واجب في ذاته وصفاته ، وحيث إنّ القدرة من أوصافه تعالى ، فلا يعقل تفسيرها بالإمكان والصحّة .
أقول : هذه عمدة ما ينهدم به بناء المتكلّمين ، نعم الأشعري يعتذر بإمكان الصفات القديمة، القائمة بذاته تعالى ، الزائدة عليها ، وعدم وجوبها ، فهذا الوجه لا يهمّه كما هو واضح ، إلاّ أنّ الكلام في صحّة هذا الاعتذار ، و... أنّ لبّ القول بإمكان الصفات ، ليس إلاّ التزاماً بمذهب الماديين ، وأمّا الاعتزالي فيمكنه التخلّص من هذه العويصة ، بما يقول في غير هذا المقام ، أو يُنسب إليه من إنكار الصفات رأساً ، ونيابة الذات منابها في آثارها ، فمعنى كونه تعالى قادراً ، أنّ ذاته تفعل وتترك بلا إيجاب ذاتي .
أقول : ويرد عليه أنّ النيابة المذكورة عين قول الدهريين ... ، فالشبهة باقية على حالها ، ولا وزن لهذين الجوابين المذكورين ، فلابدّ الالتزام إمّا بإيجابه ونفي الإمكان عن قدرته ، أو بعدم وجوب قدرته .
والفلسفي يستريح بقبول الشقّ الأَوّل ، كما أنّ الأشعري والاعتزالي يبنيان على الثاني ؛ وحيث إنّ الإمامي يرى بطلان الشقّين معاً ، فيحتاج إلى طريق ثالث ، لكنّني لم أرَ ذكراً له في كتبهم الموجودة عندي ، بل هذه الشبهة قد أُهملت في الكتب الكلامية رأساً ، مع أنّها ذات أهمّية جداً ، ومغزاها أنّ القول بالاختيار المختار عند المتكلمين ، لا يجامع القول بعينية الصفات ، كما عليها الإمامية والحكماء .
والتحقيق في الجواب : أنّ القدرة ليست هي نفس صحّة الصدور واللاصدور كما في الحيوان ، فإنّ القدرة فيه من الكيفيات النفسانية ؛ لأنّها صفة قائمة بذوات الأنفس ، فكذا في الواجب ؛ وحيث إنّ كنه الواجب وذاته يمتنع الاكتناه والإحاطة بها ، استحال معرفة قدرته أيضاً، لكن يلزمها صحّة الفعل والترك ، فالقدرة ليست نفس الصحّة المذكورة ، لا في المخلوق ولا في الخالق ، بل هي صفة تستوجب الصحة المذكورة (11) .
فنقول : إنّ الله تعالى قادر لِما استخدمناه من الدلائل ، و... أنّ قدرته عين ذاته ؛ وحيث اتّفق الباحثون من المتكلّمين والحكماء ـ كاتّفاق العقل والنقل ـ على امتناع إدراك حقيقته وعرفان ذاته ، امتنع الإحاطة بحقيقة قدرته ، لكن نعلم أنّ الصحّة المذكورة من لوازم قدرته وشؤون سلطانه ، فإذن لا منافاة بين القول باختياره والقول بعينية صفاته ، فإذن لا يكون مانع من الالتزام بها . هذا ، وللمتكلم أن يرجع ويقول على سبيل النقض : إنّ تفسير القدرة بأن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، لا يجامع القول بعينية الصفات كما عليه الفلاسفة ؛ إذ مرجعها حينئذٍ إلى ضرورة المشيّة واللامشيّة ، وليست المشيّة عندهم إلاّ العلم بالعناية ، ولا نتعقّل من مفهوم العلم إلاّ الانكشاف والإراءة ، ولا يلتزم عاقل بأنّ الانكشاف نفس ذاته الواجبة ، وأنّ حقيقة الواجب هو الكشف ! فلابدّ أن يقولوا : إنّ الكشف لازم علمه تعالى .
لثاني : إنّ إرادته عين ذاته الواجبة فهي أيضاً واجبة ، وعليه فالفعل أيضاً واجب بالنسبة إلى ذاته ، ولا يمكن التخلّف أصلاً ؛ لأنّه من تخلّف المعلول عن علّته التامّة ، يظهر ذلك من الأسفار وحواشيها للسبزواري .
أقول : المنقول من معظم متكلّمي الإمامية ورؤساء المعتزلة ، أنّ إرادته تعالى هو علمه بما في الفعل من المصلحة والمنفعة ، ويعبّرون عنه بالداعي ، وعليه فيتوجّه عليهم أنّ علمه عين ذاته تعالى ، وتعلّقه بالأشياء ضروري ، فيكون تحقّق الفعل أيضاً ضرورياً ؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة .
وهذا هو الإيجاب الذي يدّعيه الفلاسفة ، وأمّا الأشاعرة فهم وإن يروا زيادة إرادته على ذاته ، لكنّهم يقولون بتعلّقها بأحد طرفي الفعل لذاتها ، فلا يتحقّق اختياره تعالى على مذهبهم أيضاً ، فالإرادة لازمة لذاته تعالى صادرة عنه بالإيجاب ، وهي لذاتها متعلّقة بأحد طرفي الفعل ، وهذا عين الإيجاب ، وما أجاب في المواقف (12) بأنّ الوجوب بالاختيار ، لا ينافي الاختيار ، فهو مزيّف بعدم تعقّل الاختيار له تعالى على هذا المسلك .
والإنصاف أنّ ما قاله المتكلّمون في إرادته تعالى ، يصام اختياره المفسّر بالصحّة المذكورة .
ثمّ إنّ عينية الإرادة مع الذات وإن توجب ضرورة الفعل وبطلان الصحّة المذكورة ، إلاّ أنّها لا تثبت قِدم العالم ؛ لأنّها ليست هي العلم فقط ، بل العلم بالمصلحة ، ولعلّها غير متحقّقة في الأزل، أو إنّ قِدم الممكن غير ممكن ، فإثبات قِدم العالَم موقوف على إمكان قِدم الممكن وتحقّق المصلحة ، كما لا يخفى .
لكن الذي يبطل هذا الوجه ، هو ما ذهبنا إليه من حدوث إرادته تعالى ، وعدم قِدمها ، ووجوبها، وعينيتها ، مع الذات الأحدية الواجبة ، فهذه العويصة المهمّة منحلة على أُصولنا بلا تكلف .
الثالث : إنّ الواجب الوجود واجب من جميع جهاته ، فكيف يعقل الصحّة في حقه ؟ ذكره صاحب الأسفار والسبزواري وغيرهما ممّن تقدّمهما .
أقول : إن أرادوا بذلك وجوب القدرة له تعالى ، وعدم إمكان انفكاكها عن الذات ، فهو ممّا لا خلاف فيه لأحد ، حتى من الأشعري القائل بإمكان صفاته ، فإنّه يرى ضرورة ثبوت القدرة الممكنة له تعالى ، وإن أرادوا بذلك إثبات وجوب القدرة في نفسها وأنّها واجبة ، فهذا وإن كان حقاً متيناً وبه اعتقد الإمامية ، إلاّ أنّ القاعدة المستدلّ بها لا تفي بإثبات ذلك ، كما يظهر لمَن لاحظها ، وإن أرادوا بذلك نفي إمكان أفعاله بالنسبة إليه تعالى ، وأنّها تصدر عنه تعالى ضرورةً ووجوباً ، ولا يعقل الإمكان في حقه مطلقاً سواء في أفعاله وأوصافه ، فهذا وإن كان هو مفاد القاعدة ، لكنّنا نردّه بأنّ القاعدة المذكورة باطلة لا أساس لها أبداً ...
الرابع : ما سلف في عبارة الأسفار وإليك بيانه الآخر ، قال : ثمّ إنّك إذا حقّقت حكمت بأنّ الفرق بين المريد وغير المريد ـ سواء كان في حقّنا أو في حقّ الباري تعالى ـ ... فإنّ إرادتك ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه ، لم تكن صالحةً لرجحان أحد ذينك الطرفين على الآخر ، وإذا صارت إلى حد الوجوب لزم منه الوقوع ، فإذن الإرادة الجازمة حقّاً يتحقّق عند الله ... إلخ .
أقول : هذا مأخوذ من كلام الرازي في محكي المباحث المشرقية ، كما نقله هو في بعض فصول بحث إرادة الله تعالى ، واللاهيجي أيضاً في مبحث إرادته تعالى من شوارقه ، وجوابه : أنّ الوجوب الناشئ من قِبل الإرادة والاختيار ، لا ينافي الاختيار بل يؤكّده ، وهذا خارج عن محل الكلام كما هو واضح للمبتدئين ، وأمّا وجوب الإرادة نفسها ...
الخامس : ما ذكره أيضاً صاحب الأسفار بقوله : وممّا يدلّ على ما ذكرنا ـ من أنّه ليس مَن شرط كون الذات مريداً وقادراً إمكان أن لا يفعل ـ أنّ الله تعالى إذا علم أنّه يفعل الفعل الفلاني في الوقت الفلاني ، فذلك الفعل لو لم يقع لكان علمه جهلاً ، وذلك محال ، والمؤدّي إلى المحال محال ، فعدم وقوع ذلك الفعل محال فوقوعه واجب ... مع أنّ الله مريد وقادر عليه .
أقول : وهذا التلفيق من مثله عجيب جداً ، أَلم يعلم أنّ هذا الدليل لو تمّت دلالته على مرامه ، لعمّ جميع الفاعلين من الحيوان وغيره ؟ فيبطل الاختيار رأساً ، ولا يصحّ تفسير القدرة بصحّة الصدور واللاصدور حتى في القادر ، الذي يفعل بداع زائد على ذاته ، وقدرة زائدة على ذاته ، مع أنّه صرّح ـ في غير مورد ـ بصحّة التفسير المذكور في غير الواجب .
وحلّ هذه الشبهة ، أنّ الله كما يعلم بصدور الفعل عن نفسه أو عن غيره ، كذلك يعلم بصدوره عنه اختياراً ، وأنّ تركه ممكن له ذاتاً ووقوعاً ، فلو فرضا عدم إمكان الترك للزم جهله تعالى وهو محال ، والمستلزم للمحال محال .
ثمّ إنّ هذه الشبهة مشهورة ذكرها الجبريون في قِبال العدلية ...
السادس : ما ذكره هو أيضاً ، من أنّ الفاعل قادراً ، إنّما يكون فاعلاً بالفعل حال صدور الفعل عنه ، وفي تلك الحال يستحيل أن يصدق عليه أنّه شاء أن لا يفعل فلم يفعل ... إلخ .
أقول : وهذا منه غريب وخبط عظيم ، فقد خُلط عليه محلّ البحث ؛ ولذا أصرّ على أنّ هذا الوجه يثبت مرامه ، ولا يدري أنّ الوجوب الناشئ عن الإرادة بعد تحقّقها اختياراً ، غير وجوب الفعل بالنسبة إلى ذات الفاعل ، كيف والأَوّل عامّ يشمل جميع الفاعلين ، والثاني خاصّ بمَن كان فعله لا لصفة زائدة ولا لداعٍ زائد ، كما صرّح به مراراً ؟ وإنْ كان اكتفى في بعض كلماته ، بصدور الفعل عن علم وإرادة في صدق المختار ، ولو في غير الله تعالى ، بل ادّعى أنّه لا يقال مثل هذا الفاعل في العرف العامّي ولا الخاصّي : إنّه فاعل غير مختار .
أقول : بطلانه واضح ؛ لأنّ إطلاق المختار على مثله اصطلاح فلسفي ، والعرف لا يقول له المختار قطعاً ، كما اعترف به ابن سينا وغيره أيضاً .
السابع : قد ثبت قِدم العالَم في طبيعيات الفلسفة ، وهو لا يمكن إلاّ عن مُفيض تام الفاعلية . نقله المحقّق الطوسي عن الحكماء في محكي شرحه على الإشارات ردّاً على الرازي .
أقول : هذا الوجه باطل صغرى وكبرى ...
الثامن : الاختيار بالمعنى الذي يعتقده المتكلّمون ، يستدعي زيادة الداعي الذي يفعل بوجوده ولا يفعل بعدمه ، وليكون الفعل بالنسبة إلى ذات الفاعل ممكن الصدور واللاصدور ، وهي ـ أي زيادة الداعي على ذاته ـ تستلزم الاستكمال المحال في حقّه تعالى . يستفاد من الأسفار والشوارق .
أقول : استلزام الاستكمال باطل جداً ...
وأعجب من ذلك ما ذكره ابن سينا على ما في الأسفار : عند المعتزلة أنّ الاختيار يكون بداعٍ أو بسبب ، والاختيار بالداعي يكون اضطراراً ، واختيار الباري وفعله ليس بداعٍ ، انتهى . وقَبِله صاحب الأسفار أيضاً فكرّره في كتابه .
أقول : وهذا الكلام عندي لا يستحقّ ردّاً ولا جواباً ؛ لأنّه مثل أن يقال : إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود !
التاسع : إنّ تعلّق القدرة بأحد الضدّين ، إمّا لذاتها بلا مرجّح فيستغني الممكن عن المرجّح ، فإنّ نسبة ذات القدرة إلى الضدّين على السوية ، فيلزم سدّ باب إثبات الصانع ؛ لجواز ترجّح وجود الممكن حينئذٍ على عدمه ، وأيضاً يلزم قِدم الأثر ؛ لأنّ الواجب وقدرته وتعلّقها أزلي مع أنّ أثر المختار حادث ، وإمّا لا لذاتها بل بمرجّح خارجي ، ولا يجب الفعل مع ذلك المرجّح وإلاّ لزم الإيجاب ، بل كان جائزاً هو وضدّه ، فيحتاج إلى مرجّح آخر ويلزم التسلسل في المرجّحات .
العاشر : إنّ إرادة الله وقدرته ، متعلقتان من الأزل إلى الأبد ، بترجّح الحادث المعين ، وإيجاده في وقت معيّن ، والتغيّر في صفاته محال ، فوجود ذلك الحادث في ذلك الوقت واجب ، فهو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار . نقلهما بعضهم عن الفلاسفة (13) .
الحادي عشر : إنّ ما لم يجب لم يوجد ، فلابدّ من أن يكون الله تعالى موجباً ـ بكسر الجيم ـ فإنّه موجِد ، وليس موجَباً ـ بفتح الجيم ـ كما زعم المتكلمون وينسبونه إلى الحكماء . يظهر ذلك من كلام السبزواري...
أقول : أمّا الوجه التاسع فنختار وجوب الفعل ، ولكن ليس هذا من الإيجاب المتنازع فيه ... ضرورة جريان هذا الوجوب في جميع الفاعلين ، بخلاف الثاني ، فإنّه لا يشمل الفاعل من الحيوان .
وبالجملة : الكلام في وجوب الفعل عليه من جهة وجوب إرادته له وجوباً ذاتياً ، لا في وجوبه الناشئ من تعلّق إرادته ، وإن كانت غير ذاته بل كانت ممكنةً أو حادثة ، وهذا ظاهر لا ستر عليه . وأجاب الناقل ومَن تبعه عنه بشيء أسخف من أصل الشبهة ، ولا يليق بنا أن نتعرّض له، ومنه ظهر بطلان الوجه الأخير أيضاً ، وأنّ الله تعالى على مذهبهم فاعل موجَب ـ بفتح الجيم ـ ولا يُستشم منه رائحة الاختيار له تعالى لا عقلاً ولا عرفاً ، فإصرار السبزواري وغيره على أنّه موجِب ـ بالكسر ـ لا موجَب ـ بالفتح ـ واستيحاشهم من التصريح بما هو صميم مذهبهم من إيجابه وعدم اختياره ، شيء عجيب جداً ، لا ندري ما الذي دعاهم إلى إخفاء مسلكهم في هذا المقام ؟
هذا كلّه بناءً على تمامية القاعدة القائلة : إنّ ما لم يجب لم يوجد في الأفعال الاختيارية المباشرية، وأمّا بناءً على عدم تماميتها فالأمر واضح ، وأمّا حديث لزوم التسلسل في المرجّحات ، فليس إلاّ دليلاً آخر على تلك القاعدة ونفي الأولوية ...
وأمّا الوجه العاشر فجوابه : أنّ قدرته متعلّقة بجميع التروك والأضداد ، فليس الترجّح مستند إليها ، وإلاّ لزم التناقض والجمع بين الضدين ، بل هو مستند إلى إرادته ، التي ليست هي إلاّ إحداثه ، وتعلّق الإرادة بهذا المعنى من الأزل محال ، بل تعلّق القدرة بالفعل قديم غير مستلزم للوقوع ، وتعلّق الإرادة حادث وموجب للوقوع لكنّها قابلة للتغيّر ، فافهم جيداً .
... وتعلّل أفعال الله بالأغراض ؛ إذ هذه المباحث لها اشتراك وارتباط شديد كما يعرفه الراسخون .
هذا ما استدلّ به أصحاب الفلسفة لإثبات مرامهم ، ولم ندع شيئاً منه مهملاً ، وقد دريتَ أنّ الإنصاف العقلي يحكم بعدم تمامية دلالة دلائلهم ، بل وبعضها خارج عن محلّ النزاع رأساً ، فحينئذٍ إن تمّ أدلة المتكلّمين على مذهبهم لَما كان بأساً ومانعاً من الالتزام به ، وكذا لو ثبت من الشرع ما يدلّ عليه ؛ إذ المسألة قابلة للتعبّد الشرعي ولا محذور فيه أصلاً ، فإنّ الاختيار وهو كيفية القدرة ، ممّا لا يتوقّف عليه حجّية كلام الشارع حتى يلزم الدور ونحوه ، فالآن نرجع إلى أدلّتهم ، فقد استدلّوا على مذهبهم بوجوه :
الأَوّل : لو لم يكن مختاراً للزم إمّا قِدم العالَم أو حدوث القديم ، وكلا الأمرين محال ، فيمتنع المقدّم المذكور بامتناع التالي .
بيان الملازمة : أنّ أثر الموجب لا ينفكّ عنه ، فهو وأثره مقارنان في الخارج ، فإذا لم يكن الواجب مختاراً جاز تأخّر فعله عنه ، ولوجب تحقّقهما ـ أي الله والعالَم ـ إمّا في الأزل أو في الحدوث ، وأمّا بطلان التالي فامتناع حدوث الواجب واضح ، كما أنّ حدوث العالم مبيّن ... وبالجملة : أنّ حدوث العالم دليل على اختيار خالقه .
الثاني : إنّ الإيجاب الذي اصطلح عليه الحكماء باسم الاختيار نقص ؛ لعدم تمكّنه حينئذٍ من الترك أو الفعل ، بل صدور أحد الطرفين واجب عليه ، والنقص عليه محال اتّفاقاً وعقلاً ...
الثالث : إنّه لو لم يكن مختاراً للزم أحد الأمور الأربعة : إمّا نفي الحادث بالكلّية ، أو عدم استناده إلى المؤثّر ، أو التسلسل ، أو تخلّف الأثر عن المؤثّر الموجب التام ، وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم .
بيان الملازمة : أنّه إمّا أن لا يوجد حادث أو يوجد ، فإن لم يوجد فهو الأمر الأَوّل ، وإن وجد فإمّا أن لا يستند إلى موجد أو يستند ، فإن لم يستند فهو الثاني ، وإن استند فإمّا أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي ، فإن لم ينتهِ فهو الثالث أي التسلسل ؛ وذلك لأنّه إذا استند إلى مؤثّر غير قديم ولا منتهٍ إليه ، فلابدّ هناك من مؤثّرات حادثة غير متناهية مع كونها مترتّبةً مجتمعة ، وهو تسلسل محال اتّفاقاً ؛ وإن انتهى فلابدّ قديم يوجب حادثاً بلا واسطة من الحوادث ؛ دفعاً للتسلسل فيها ، سواء كانت مجتمعةً أو متعاقبة ، فيلزم الرابع .
الرابع : إنّه تعالى لو لم يكن مختاراً لاستحال تغيّر الموجودات ، وتبدّل الكائنات بالمرة ، فإنّه يتبع تغيّر العلّة وتبدّلها ، وهو في حقّ الواجب مستحيل ، فثبت أنّه مختار .
الخامس : إنّه لو كان موجِباً لوجب تحقّق جميع الموجودات الممكنة ، في درجة واحدة ، بلا تقدّم وتأخر بينها ، فإنّها متساوية النسبة إلى العلّة ، أعني بها ذاته المقدسة ، والتخصيص الواقع يكون ترجيحاً بلا مرجّح ، بل ترجّحاً من دون مرجّح .
السادس : الآيات القرآنية الدالة على ذلك ، مثل قوله تعالى : {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ} [إبراهيم: 19]، وقوله : {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [النحل: 40]، وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ } [الحج: 14]، وقوله : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39]وأمثالها من الآيات الصريحة في المدعى .
السابع : الأخبار المتواترة عن النبي الأعظم وآله الكرام ( صلى الله عليه وعليهم أجمعين ) ، مثل ما ورد في أنّه يمحو ويثبت ، ويقدّم ويؤخّر وله البداء ، ونحو ذلك .
الثامن : الضرورة الدينية على اختياره ، بل تقدّم عن العلاّمة الحلي قدّس سره أنّه الفارق بين الإسلام والفلسفة ، بل ادّعى الجرجاني والقوشجي والأصبهاني اتّفاق المليّين قاطبةً على ذلك ...
هذا ما وقفنا عليه في كتبهم من الأدلّة على اختياره تعالى .
أقول : أمّا الوجه الأَوّل ، فهو موقوف على ثبوت أمرين ، الأَوّل : حدوث العالم كما هو ظاهر ، الثاني : إمكان أزلية الممكن ؛ إذ لو استحال وجود الممكن في الأزل ، وتحتّم مسبوقية الممكن بالعدم ، لَما كشف حدوث العالم عن الاختيار .
وبالجملة : حدوث العالم بمجرّده ، وإن كان يبطل قول الفلاسفة بقِدمه ، إلاّ أنّه لا ينفع المتكلّمين ما لم يحرز إمكان أزليته ، حتى يكون عدم تحقّقه مستنداً إلى إرادة الفاعل دون المانع في نفس المفعول ... ، فهذا الدليل ـ بما له من الاشتهار ـ غير تام ، وأنّ الحدوث لا يثبت الاختيار ، كما أنّ الاختيار أيضاً لا يدلّ على الحدوث ، خلافاً لِما توهّمه الرازي في محكي شرح الإشارات ...
وأمّا الوجه الثاني ، فأجاب عنه الفلاسفة بمنع عقد الوضع ، وأنّ صدور الفعل مع العلم والإرادة ليس بإيجاب ، وإن لم يكن هناك التمكّن من تركه ، بل ذكروا أنّه كمال الاختيار وأفضل أنحاء الصنع ، بل لا اختيار إلاّ لمَن يفعل لذاته بذاته ، وأمّا مَن يفعل لداعٍ زائد فهو مضطرّ في صورة الاختيار ، فالواجب ـ عزّ مجده ـ موجب بكسر الجيم لا بفتحه .
أقول : إنكار الإيجاب مع نفي التمكّن تناقض بحت وتهافت واضح ، ومهما قالوا في توجيهه وتصحيحه ، فلا يخلو هو من جهالة أو تجاهل أو إغفال ، ولا يكون الواجب على مذهبهم ، إلاّ موجَباً بفتح الجيم لا بكسره ، وتحريف الكلم عن مواضعه غير نافع ، فالصحيح أن يمنع عقد الحمل ، وأنّ الإيجاب المذكور ليس بنقص ، بل هو ممّا أثبته الأدلة العقلية...
وأمّا الوجه الثالث ، فإتمام شقّه الرابع موقوف على حدوث العالم بشراشره ، وإلاّ أمكن ردّه بوجود ممكن قديم مختار يؤثّر في الحوادث ، وهو معلول الواجب الموجب ، أو الالتزام بوجود حوادث غير متناهية على ما ذكره أرباب الفلسفة .
وبالجملة : هذا الوجه راجع إلى الوجه الأَوّل ولا مزية له غير الزيادة في العبارة .
وأمّا الوجه الرابع والخامس ، فصحّتهما موقوفة على بطلان ما ذكره الفلاسفة ، في ارتباط الحادث بالقديم ؛ إذ لو صحّ ما ذكروه لا يبقى مجال لهما ، على أنّ القابل في نفسه أيضاً قاصر عن التحقّق في مرتبة واحدة .
وأمّا الوجه السادس ، فيمكن أن يجاب عنه بأنّ مفاد الآيات المذكورة وقوع الفعل عند إرادته ، وهذا ممّا لا خلاف فيه لأحد ، وإنّما الكلام في تحديد إرادته وأنّها واجبة أو لا ، وهل للواجب قبل وجود الفعل تمكّن من تركه أو لا ؟ لكن الإنصاف أنّ القرآن ـ بظواهره لا بنصوصه ـ يدلّ على اختياره تعالى ، فإنّ مَن أُلقي عليهم خطابات القرآن ـ وهم عامّة الناس ـ لا يفهمون من بعض الآيات المذكورة وأمثاله إلاّ التمكّن المذكور ، لكن لا حجّية للظهور في قبال الأدلة العقلية، فهذا الوجه موقوف على عدم تمامية شيء من دلائل الفلاسفة .
وأمّا الثامن فالإنصاف أنّه غير بعيد ، فإنّ اختياره تعالى ـ بنحو يدعيه المتكلّمون ـ ممّا ارتكز في أذهان المسلمين ، رجالهم ونسائهم ، جاهلهم وعالمهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وهذا الارتكاز لا يكون مستنداً إلاّ إلى الدين وطريقة الشارع ، فالثابت من الدين هو ذلك ، ... وأنّ ما قيل في امتناعه وبطلانه كان مزيّفاً ضعيفاً ، فإذن يتعيّن تعييناً تعبّدياً لا عقلياً التديّن والاعتقاد بهذا المسلك ؛ لِما مرّ في فوائد المدخل من إقرار العقل بتصديق قول المعصوم .
خلاصة المقال في تنقيح المقام :
قد استبان ممّا ذُكر أنّ النظرية الفلسفة المذكورة لا تتمّ إلاّ بأُمور :
1 ـ كون إرادته عين ذاته ، وإلاّ كان الفعل بالنظر إلى ذاته المقدّسة ممكن الصدور واللاصدور.
2ـ كون الغرض من فعله نفس ذاته ، وإلاّ لكان وجوب الفعل بلحاظ ذلك الغرض دون ذاته .
3 ـ قِدم العالم إذا أمكن أزلية الممكن .
فإذا لم يثبت واحد من هذه الأُمور فقد انهدم بناؤهم من أساسه ، ولكن لا يلزم منه صحّة قول المتكلّمين ، كما يظهر من مراجعة ما سبق ، نعم إذا ثبت حدوث العالم وأزلية الممكن ، ثبت اختياره تعالى ؛ إذ عدمه في الأزل مستند حينئذٍ إلى إرادته تعالى ، فيكون الواجب متمكّناً من الفعل والترك ، فتأمل .
فمجرّد بطلان قول الفلاسفة لا يكشف عن صحّة قول المتكلّمين ، فإنّها موقوفة على إمكان صدور الفعل وعدمه بالنسبة إلى ذاته تعالى ، وإلى داعيه ، وعدم كون الإرادة واجبة ، نعم الوجوب الناشئ من الإرادة ـ المسمّى بالوجوب السابق ـ لا ينافي الاختيار ، فإذن اختياره تعالى وإن كان ثابتاً من جهة الشرع ... ، إلاّ أنّه غير ثابت من جهة العقل ...
هذا ، والذي يدلّ على احقية مذهبهم هو قاعدة الملازمة ... ، فإنّ القدرة الواجبة ـ التي تستلزم التمكّن وصحّة الصدور واللاصدور ـ ممكنة الثبوت للواجب ؛ لبطلان دلائل الفلاسفة ، فهي إذن ثابتة له ، فهو قادر مختار أي له أن يفعل وله أن لا يفعل .
ويمكن أن يستدلّ أيضاً ، بأنّ الاختيار بهذا المعنى كمال للقادر بلا شك ، وأنّ ما يزعمه أهل الفلسفة نقص له ، وحيث إنّه جامع لجميع الكمالات ، بل لا كمال إلاّ وهو معطيه ولا سبيل للنقص إليه ، فهو مختار بالمعنى الذي أثبته الكلاميون لا غير ، والله الهادي .
تنبيه :
اختياره بهذا المعنى وإن ادّعاه المتكلّمين بأجمعهم ، بل ... أنّه ضروري من دين الإسلام ، لكنّه لم يتديّن به ـ حقّ التديّن ـ إلاّ الطائفة الإمامية ، الذين أخذوا أُصولهم وفروعهم من آل محمد (صلى الله عليه وعليهم أجمعين ) ، فإنّ الاعتزاليين قالوا بالثابتات الأزلية ، والأشعريين بالقدماء الثمانية ، ولا شك أنّ الواجب بالنسبة إليها موجَب ، كما صرّح به أنفسهم ، فتأمل .
فأعظم الله جزاء الإمام الصادق من أئمة أهل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؛ حيث أدّب أتباعه على سلوك صراط الحق ونهج الصدق .
____________________
(1) الأسفار ، المجلد الثاني ، الفصل الأَوّل من الموقف الرابع ، ( الطبعة القديمة ) .
(2) هذه الجملة مذكورة في حاشية شرح المنظومة ، ونحن أدرجناها في المتن ، بين قوسين .
(3) شرح المنظومة / 172.
(4) شرح قواعد العقائد / 39.
(5) الشوارق 2 / 210 ـ 211.
(6) إحقاق الحق 2 / 116.
(7) شرح المواقف 3 / 41.
(8) شرح التجريد / 348.
(9) منهاج البراعة 1 / 309.
(10) تقدّم في الصفحة 81 من هذا الجزء .
(11) نقل العلاّمة قدّس سره في شرح قواعد العقائد / 40 : أنّ القادر عند أوائل المعتزلة مَن كان على صفة لأجله عليها يصح منه الفعل . ونفاة الأحوال قالوا : هو الذي يصحّ منه أن يفعل وأن لا يفعل .
أقول : الثاني باطل كما عرفت ، والأَوّل صحيح لكنّ الصفة نفس ذاته .
(12) شرح المواقف 3 / 69.
(13) شرح المواقف 3 / 44، 46.
 الاكثر قراءة في القدرة و الاختيار
الاكثر قراءة في القدرة و الاختيار
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












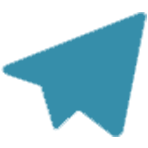
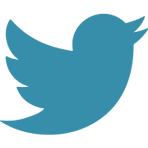

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)