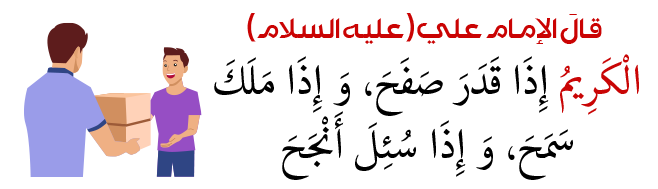
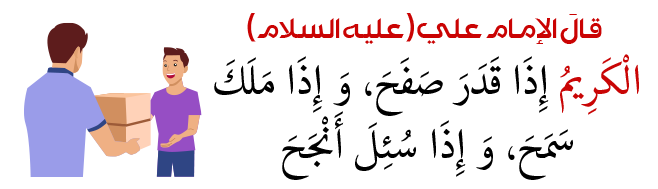

 تأملات قرآنية
تأملات قرآنية
 علوم القرآن
علوم القرآن
 التفسير والمفسرون
التفسير والمفسرون
 التفسير
التفسير
 مناهج التفسير
مناهج التفسير
 التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير وتراجم مفسريها
 القراء والقراءات
القراء والقراءات
 تاريخ القرآن
تاريخ القرآن
 الإعجاز القرآني
الإعجاز القرآني
 قصص قرآنية
قصص قرآنية
 قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
 سيرة النبي والائمة
سيرة النبي والائمة 
 حضارات
حضارات
 العقائد في القرآن
العقائد في القرآن
 أصول
أصول
 التفسير الجامع
التفسير الجامع
 حرف الألف
حرف الألف
 حرف الباء
حرف الباء
 حرف التاء
حرف التاء
 حرف الجيم
حرف الجيم
 حرف الحاء
حرف الحاء 
 حرف الدال
حرف الدال
 حرف الذال
حرف الذال
 حرف الراء
حرف الراء
 حرف الزاي
حرف الزاي
 حرف السين
حرف السين
 حرف الشين
حرف الشين
 حرف الصاد
حرف الصاد
 حرف الضاد
حرف الضاد
 حرف الطاء
حرف الطاء
 حرف العين
حرف العين
 حرف الغين
حرف الغين
 حرف الفاء
حرف الفاء
 حرف القاف
حرف القاف
 حرف الكاف
حرف الكاف
 حرف اللام
حرف اللام
 حرف الميم
حرف الميم
 حرف النون
حرف النون
 حرف الهاء
حرف الهاء
 حرف الواو
حرف الواو
 حرف الياء
حرف الياء
 آيات الأحكام
آيات الأحكام|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-20
التاريخ: 7-11-2014
التاريخ: 22-09-2014
التاريخ: 15-1-2016
|
بداية :
من البديهي أن الرسول المبعوث من قبل الله تعالى لابد له في دعوته من أجل قبول الناس لها من آية خارقة للعادة لتكون حجة على رسالته.
وهذا الأمر ليس قابلا للاستثناء منه ، بل هو صادق على كل رسول ، حتى من كان منهم معروفا بالصدق والأمانة قبل بعثته ، كنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله).
والحاجة إلى الآية إنما هي لدفع احتمال الكذب عن دعواه للرسالة حينئذ ولو لم يعرف عنه الكذب قبل ذلك ، لأن الرسولية منصب شريف ورئاسة عظيمة ، ربما يطمع فيها من كان معروفا بالصدق والأمانة ، ويخرجه ذلك عن الصراط المستقيم ، فيجازف ويدعي ، وليكن بعد ذلك ما يكون.
وهذا هو السر في انحصار طريق معرفة صدق دعواه بظهور المعجز على يده ، كما يظهر من أقوال المحققين ، كقولهم : وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده (١). وقولهم : طريق التصديق بالنبوة والإيمان بها ينحصر بالمعجز الذي يقيمه النبي شاهدا لدعواه (٢).
أدلة انحصار الطريق بالمعجزة :
ويشهد لصحة ما قلناه عدد من الآيات القرآنية ، نذكر منها :
١ - قوله تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ} [الحج : 52].
فالمستفاد منها هو أن لكل رسول ونبي آية قد أحكمها الله تعالى ، بحيث إذا حاول الشيطان أن يشكك قولهم ويوسوس لهم بحيث يكون ذلك مانعا من تحقيق أمنية النبي فإن النبي بواسطة تلك الآية ينسخ وسوسة الشيطان ويفشل سعيه.
وحيث إن كل نبي كان يتمنى نجاح دعوته وظهور رسالته فمن الطبيعي أن يكون لكل نبي آية محكمة تمنع من محاولات الشيطان تلك.
٢ - قوله تعالى : {بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ} [الأنبياء : 5].
وهذه الآية تدل على أن الرسل الأولين كانوا أصحاب آيات دالة على صدقهم في دعواهم. وإلا فلا يصح قولهم " كما ارسل الأولون ".
٣ - عدة آيات دالة على أن كثيرا من الرسل كان لهم آيات تدل على صدقهم ، كقوله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} [الإسراء : 101].
وقوله تعالى : {وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران : 49].
وقوله تعالى : {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً} [الأعراف : 73].
وقوله تعالى : {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ} [سبأ : 12].
وقوله تعالى : {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} [إبراهيم : 9].
وقوله تبارك وتعالى : {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء : 69].
وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى قد أعطى المعجزة للأنبياء ، ولم يكتف بكونهم عدولا صادقين ، ولا اكتفى بإخبارات النبي السابق عن ظهور نبي في اللاحق ، وذكره لعلامات تنطبق على شخص ما ، وذلك لأنه حتى لو وصلت هذه الإخبارات والعلامات للأمم اللاحقة على نحو التواتر إلا أنها لا تكون حجة على من لا يتدين بدين أصلا ، ولا يعتقد بنبوة ذلك النبي ، ولذا فلا يكون قوله حجة عليه.
المراد من الآيات والبينات :
الآية في اللغة هي العلامة الظاهرة. والبينة هي الدلالة الواضحة (٣).
ويراد من هاتين الكلمتين في القرآن الكريم ما كان معجزا وخارقا للعادة ، وقد أعطي للرسول ليثبت به رسالته. وأما البراهين التي هي لإثبات أمور أخرى غير الرسالة - كالأمور العقائدية والأحكام الشرعية - فيعبر عنها ب " الحجة ". وقد جاء في قصة احتجاج إبراهيم ببزوغ الشمس ثم أفولها ، وبزوغ القمر ثم أفوله وقوله * {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} [الأنعام : 76] ثم قوله {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [الأنعام : 79] ثم عقب ذلك بقوله تعالى : {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ} [الأنعام : 83].
ويؤيد أن المراد بالآيات في القرآن هو ما يستدل به على الرسالة هو جواب قومهم لهم بقولهم {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا} [إبراهيم : 10] الدال على أن الهدف هو إثبات الرسالة للرسل. فينكر قومهم عليهم ذلك بحجة أنه لو كانوا رسلا لله لما كانوا بشرا. تنوع المعجزة :
ويمكننا أن نعتبر أن المعجزة ترجع إلى نوعين :
الأول : ما كان من نوع أمور كانت شائعة في عصر ظهور ذلك النبي ، مما كان الناس قد برعوا فيه ، واعتبروا أنهم قد وصلوا فيه إلى الغاية القصوى.
الثاني : ما يكون تابعا للأديان في مدى صلاحيتها للبقاء في الأعصار ، فإذا كان الدين خاصا بعصر كانت معجزته خاصة بذلك العصر لا تتعداه ، وإذا كان مستمرا وخالدا كانت معجزته مستمرة وخالدة أيضا معه.
فأما بالنسبة للنوع الأول فإننا نلاحظ أن ما كان شائعا في عصر موسى هو السحر ، إذا فالحكمة تقتضي أن تكون المعجزة في ذلك العصر من النوع الذي ينسجم مع السحر ، فكانت عصا موسى - التي ألقاها فصارت ثعبانا يلقف ما يأفكون - من الحبال والعصي التي يخيل أنها تسعى ، ثم رجعت العصا إلى حالتها الأولى دون أن يبقى لتلك الحبال والعصي أثر. فعرفوا أن هذا أمر خارق للعادة ، وخارج عن قدرة البشر ، ولذا فقد سارع السحرة المهرة إلى الإيمان بنبوة موسى ، دون أن يلتفتوا إلى تهديدات فرعون لهم.
وقد حكى الله ذلك في كتابه الكريم بقوله : {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} [الأعراف : 117] {وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ } [الأعراف : 120 - 121].
وهكذا الحال في عصر عيسى ، الذي مهر الناس فيه في علم الطب ، ويقولون : إن فلسطين وسوريا كانتا مستعمرتين لليونان ، وفيهما نزلاء كثيرون ، وكان للطب
فيهما رواج باهر (4). ويقول بعض العلماء : إن في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من التوراة الرائجة اليوم تفصيلات مطولة في كيفية تطهير القروح والبرص والقوباء (5).
إذا ، فقد اقتضت الحكمة أن تكون معجزة عيسى من هذا القبيل ، مثل شفاء الأبرص والأعمى والأكمه وغير ذلك. وفي رواية عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) : إن الله بعث عيسى في وقت قد ظهرت فيه الزمانات ، واحتاج الناس إلى الطب ، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله ، وبما أحيا لهم الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ، وأثبت به الحجة عليهم (6).
وهكذا أيضا تكون الحال بالنسبة لنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن عصره كان متميزا بالأدب والبلاغة والفصاحة ، وبرع الناس في ذلك ، وأقاموا المواسم ، وعقدوا الندوات والمحافل للمفاخرة بالرقي فيه (7).
ويقول البعض : إنه كان يقدر المرء على ما يحسنه ، وبلغ من تقديرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من خيرة الشعر القديم ، وكتبوها بماء الذهب في القباطي ، وعلقت على الكعبة ، فكان يقال : هذه مذهبة فلان (8).
وفي تتمة الرواية المتقدمة عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) : إن الله بعث محمدا في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام - وأظنه قال : والشعر - فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم ، وأثبت به الحجة عليهم.
ومن هنا نرى أن معجزة نبي الإسلام اختصت بتفردها وتميزها في هذا المضمار ، فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة بالبيان والبلاغة ، وهو حجة دامغة على كل من برع ومهر في هذا الأمر ، وبشهادة هؤلاء يصير حجة على غيرهم ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
وأما بالنسبة إلى النوع الثاني فيختلف المعجز أيضا فيه باختلاف الأديان ، فما كان لدين موقت كان المعجز فيه موقتا ، وما كان لدين خالد كان المعجز فيه خالدا ، وذلك هو السر في كون المعجز لموسى (عليه السلام) أمرا مشاهدا يختص بالمشاهدين وبمن يعيش في ذلك العصر أو بعده بقليل ، بحيث يتسنى له أن يطلع على خبر تلك المعجزة عن طريق التواتر القطعي.
وذلك هو السر أيضا في كون معجزة نبي الإسلام أمرا عقليا يبقى ببقاء الدنيا لأنها لدين خالد باق كذلك. وبهذا احتج بعض المحققين على بعض أفراد اليهود حيث قال له : إن كانت شريعة موسى عامة لجميع البشر فحيث لم تكن معجزاته (عليه السلام) مشاهدة فلابد من الأخبار المتواترة الدالة عليها ، وهي مفقودة ، لأن عدد المخبرين في كل جيل لم يبلغ عددا يمنع العقل من تواطئهم على الكذب ، فحينئذ إذا لزم على الناس تصديقكم بما تخبرون به فلم لا يجب على الناس تصديق المخبرين الآخرين في نقلهم عن أنبيائهم ؟ ولم لا تصدقون الأنبياء الآخرين ؟! وأجاب : إن معاجز موسى ثابتة عند كل من اليهود والنصارى والمسلمين ، وأما معاجز غيره فلم يعترف بها الجميع فنحتاج إلى الإثبات.
فقال له : إن معجزات موسى لم تثبت عند المسلمين ولا عند النصارى إلا بإخبار نبيهم بذلك لا بالتواتر ، فإذا لزم تصديق المخبر الذي يدعي النبوة لزم الإيمان به. وأما القرآن الكريم الذي كان آية لنبوة رسول الإسلام كان إعجازه باقيا في كل زمان ، فصار حجة لجميع الناس في كل عصر (9).
الإعجاز لغة واصطلاحا :
لقد جاء في اللغة عدة معان لكلمة " المعجز " مثل : الفوت ، يقال : أعجزه الشئ ، أي فاته. وإحداث العجز ، يقال : أعجز فلان فلانا ، أي صيره عاجزا.
ووجدان العجز ، يقال : أعجز فلان فلانا ، أي وجده عاجزا (10).
وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف مختلفة باختلاف قيودها ، قال في تجريد الاعتقاد : المعجزة ثبوت ما ليس معتادا ، ونفي ما هو معتاد ، مع خرق العادة ومطابقة الدعوى (11).
وقال في البيان : هو أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق النواميس الطبيعية ، ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه (12).
وقال السيوطي : المعجزة أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدي ، سالم عن المعارضة (13).
وقال العلامة الطباطبائي : هو الأمر الخارق للعادة ، الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادة ، لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل (14).
ولا يبعد أن تكون جميع هذه التعاريف ناظرة إلى أمر واحد ، وإن قصر بعضها عن بيانه ، وهو أن المعجز أمر خارق للعادة لا لحكم العقل ، فلا يمكن الجمع بين النقيضين حتى بالإعجاز ، ويمكن جعل الشجرة تثمر حالا ، لأن تحقق الأثمار عادة يتوقف على شروط لا تتحقق عادة إلا بعد مضي زمان ، ولكن ربما تحصل هذه الشروط فورا بالإعجاز ، وهذا هو معنى خرق العادة.
ويشترط في المعجز أيضا مطابقته للدعوى ، فما روي عن مسيلمة من أنه تفل في بئر ليكثر ماؤها فذهب ماؤها أجمع ليس بمعجز.
ويشترط أيضا أن لا يكون هناك من يعارض مدعي النبوة فيما يتحدى به ، بحيث يستطيع غيره أن يأتي بمثل ما أتى به ، إذ لا يكون حينئذ ما أتى به ذلك النبي معجزا ، وقد تقدم ما يشير إلى ذلك.
إعجاز القرآن :
لا ريب في أن القرآن معجز خارق للعادة ، غير مقدور للبشر الإتيان بمثله ، ولا حتى الإتيان بمثل سورة من سوره ، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين وإن اختلفوا في وجه إعجازه.
وأما غير المسلمين - ممن كان ينكر إعجاز القرآن - فلربما يكون قد استدل على ذلك بأمور سخيفة توجب فضح المستدل بها ، كما حكاه القرآن الكريم عنهم بقوله : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل : 103].
فجهل هؤلاء قد دفعهم إلى دعوى سخيفة ، وهي أن هذا القرآن العربي - الذي بلغ الغاية في فصاحته وبلاغته - تعلمه النبي (صلى الله عليه وآله) من أعجمي لا يحسن العربية.
وكذلك ، فإن ما يدعيه بعض المستشرقين من أن القرآن من صنع محمد - حتى أن أحد من يعدونه من أصحاب الآراء الحرة ومن طلاب الحقيقة إذ لا يأخذ إلا بما تؤدي إليه دراسته وبحوثه في الشريعة الإسلامية ، وهو جرونيبادم مؤلف كتاب " حضارة الإسلام " - نص على أن القرآن لم يوح إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بأكمله ، بل كان يوحى إليه رؤي قصيرة ووصايا وأمثال وقصص ذات مغزى أو أحاديث في أصول العقيدة (15).
وإنه لعجيب حقا أن من له معرفة وتعمق في الآداب العربية وله ذوق سليم وإنصاف نجده يقول : إن هذا القرآن هو من صنع نبي أمي ، معروف بأنه لم يدرس عند أحد ، وهو يتحدى الناس كلهم أن يأتوا بمثله ، بل بعشر سور ، بل بسورة من مثله ، ثم يعجزون على مدى التاريخ ، وهم أبرع الناس وأعرفهم بهذا الأمر.
مع أن هذا المستشرق لم ينقل عن أحد أنه أتى بسورة من مثله ، فهل يكون قوله هذا " إن القرآن من صنع محمد " إلا تجاهل لهذه الحقيقة أو عدم توجه منه
إليها ؟! وقد قال تعالى وكلامه الصدق {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت : 49].
وينقل البعض أن بعضا آخر من هؤلاء المستشرقين في هذه العصور المتأخرة قد أعلنوا - بعد دراستهم للقرآن ولنبي القرآن - أن محمدا كان سليم الفطرة كامل العقل - إلى أن قال : - وبهذا كله وبما ثبت من سيرته ويقينه بعد النبوة جزموا بأنه كان صادقا فيما ادعاه ، ومن أنبائه بأنه رسول الله - إلى أن قال : - ولقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الباحثين الأجانب أن أعلن هذه الحقيقة : لو وجدت نسخة من القرآن ملقاة في فلاة ولم يخبرنا أحد عن اسمها ومصدرها لعلمنا بمجرد دراستها أنها كلام الله ، ولا يمكن أن تكون كلام سواه (16).
أدلة إعجاز القرآن :
ومما يدل على إعجاز القرآن هو هذا التحدي القاطع لكل العرب ولغيرهم بأن يأتوا بمثله ، قال تعالى :
١ - {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [هود : 13].
٢ - {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة : 23].
٣ - {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [يونس : 38].
فمع أنهم فصحاء وبلغاء وخطباء ، ومع هذا التحدي المطلق من دون تحديد وقت وزمان ولا اشتراط أن يكونوا ضمن عدد خاص ، ومع تكرار هذا التحدي
مرة بعد أخرى ، ومع أنهم كانوا في منتهى الحرص على إطفاء نوره وإخفاء أمره على ما شهد به التاريخ ، مع كل ذلك نرى أنهم لم يأتوا بسورة من مثله. فلو أنهم كانوا يقدرون على معارضته لما أحجموا عنها ، فإنها ولا شك كانت أهون عليهم من إعلان الحرب التي قتل فيها ساداتهم وأبناؤهم.
فهذا أدل دليل على عجزهم عن معارضته ، ولا نعني بالمعجزة إلا هذا ، وهو يدل على أن هذا القرآن من الله سبحانه. قال تعالى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس : 37].
إذا ، فالذي كان يمنعهم من الإقرار بنبوته (صلى الله عليه وآله) وبأحقية ما جاء به ليس إلا الهوى والحمية ، وليس هو الجهل والحيرة. وقد أشار الجاحظ إلى ذلك حيث قال :
بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) أكثر ما كانت العرب شاعرا وخطيبا ، وأحكم ما كانت لغة ، وأشد ما كانت عدة ، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته ، فدعاهم بالحجة ، فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والحيرة حملهم على حظهم بالسيف ، فنصب لهم الحرب ، ونصبوا له... الخ (17).
قال الله تعالى {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل : 14].
وقال سبحانه {إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا} [المدثر : 16].
معارضات القرآن :
قد نسب إلى البعض محاولته التصدي لمعارضته القرآن الكريم بعبارات ينبغي نقلها ليطلع عليها القارئ الكريم ويحكم هو بنفسه ، وقد أنهى الرافعي عدد
هؤلاء إلى تسعة أشخاص على ما في كتابه " إعجاز القرآن " ونحن نذكر ثلاثة من هؤلاء على سبيل المثال :
١ - مسيلمة الكذاب ، الذي تنبأ باليمامة في بني حنيفة على عهد رسول الله ، وزعم أن له قرآنا ينزل عليه ، ومن قرآنه هذا قوله - حين قال له عمرو بن العاص :
أعرض علي ما تقول - : يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين ، لا واردا تنفرين ، ولا ماء تكدرين ، يا وبر يا وبر ، يدان وصدر ، سائرك حفر نفر.
قال الخطابي : إنه كلام خال من كل فائدة ، لا لفظه صحيح ، ولا معناه مستقيم ، ولا فيه شئ من البلاغة ، وإنما تكلم هذا الكلام الغث لأجل ما فيه من السجع (18).
وقال مسيلمة - حول حيوان بري في مقابل كلامه السابق حول حيوان بحري - : الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له مشفر طويل ، وذنب أثيل ، وما ذلك من خلق ربنا بقليل (19).
وقد أحسن الخطابي في نقد هذا الكلام بقوله : يا فائل الرأي ، افتتحت قولك به " الفيل ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل " فهولت وروعت ، وصعدت وصوبت ، ثم أخلفت ما وعدت ، وعلى ذكر الذنب والمشقر اقتصرت ، ولو كنت تعرف شيئا من قوانين الكلام وأوضاع المنطق ورسومه لم تحرف القول عن جهته ، ولم تضعه في غير موضعه ، أما علمت يا عاجز أن مثل هذه الفاتحة إنما تجعل مقدمة لأمر عظيم الشأن ، فائت الوصف ، متناهي الغاية في معناه ، كقوله تعالى {الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة : 1 - 3] و {الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة : 1 - 3] فذكر يوم القيامة ، وأتبعها من ذكر أوصافها ، وعظيم أهوالها ما لاق بالمقدمة ؟ (20).
هذا بالإضافة إلى أن هذا النسق من الكلام أسلوبه مقتبس من القرآن الكريم ومعلوم أن اقتباس الأسلوب وتبديل كلمة بأخرى ليس مما يعارض به الأصل ، لأن للمعارضة شروطا ، منها : أن يأتي كل من الطرفين بأمر جديد محدث ، يساوي به الآخر ، أو يزيد عليه ، لا تقليد أحدهما الآخر ، والإتيان بمثل ما أتى به مع تغيير في الألفاظ. ومنها : أن يأتي أحدهما بأمر يكون فيه أدنى المشابهة للأصل ، كأن يكون كلاهما في مدح شئ أو ذمه ، وهكذا ، وذلك مثل ما حكي عن امرئ القيس وعلقمة بن عبدة ، اللذين تباريا في وصف الفرس ، فقال امرؤ القيس :
فللزجر الهوب وللساق درة * وللسوط منه وقع أهوج منعب (21)
وقال علقمة :
فعفى على آثارهن بحاصب * وغيبة شؤبوب من السد ملهب
فأدركهن ثانيا من عناه * يمر كمر الرائح المتحلب
وكانا قد حكما بينهما زوجة امرئ القيس ، فقالت لزوجها : علقمة أشعر منك.
فقال : وكيف ذلك ؟ قالت : لأنه وصف الفرس بأنه أدرك الطريدة من غير أن يجهده أو يكده ، وأنت مريت فرسك بالزجر وشدة التحريك والضرب (2٢).
ونحن نستبعد أن يكون مسيلمة قال تلك العبارات الواهية التي تشبه الهذيان ، سيما وأن راوي حديث " يا ضفدع " هو سعيد بن نشيط ، وهو مجهول لا يعرف على ما قيل (23).
مضافا إلى أن بعض العلماء قال : إنه قد وجدت في كتب السير والتاريخ كلمات أخرى غير ما عارض القرآن ، كلها موجزة غاية الإيجاز ، مع قوة وفصاحة ... الأولى : قوله لسجاح التميمية [امرأة مسيلمة] حين اجتمعت به : هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب ؟... الخ (24).
٢ - أبو الطيب المتنبي ، وقد ادعى النبوة في أول أمره ، وكان ذلك في بادية
السماوة ، وقيل : إنه تلا على أهل البوادي كلاما زعم أنه قرآن انزل عليه. وعن علي بن حامد أنه قال : نسخت واحدة منها (أي من تلك السور) وبقي في حفظي قوله : والنجم السيار ، والفلك الدوار ، والليل والنهار ، إن الكافر لفي أخطار ، امض على سنتك ، واقف أثر من قبلك من المرسلين ، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه ، وضل عن سبيله (25).
ولقد ادعى أمرا عظيما حين قال : إن الله قامع بك... الخ من دون استثناء منهم ، وذلك ما لم يحصل لمحمد (صلى الله عليه وآله) ، وقد قال الله تعالى {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات : 55].
هذا ، بالإضافة إلى أن الفلك ليس دوارا ، بل هو مدار فضائي تدور فيه النجوم.
وعن ابن خالويه النحوي أنه قال يوما في مجلس سيف الدولة : لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يدعى بالمتنبي ، لأن متنبي معناه كاذب ، ومن رضي أنه يدعى بالكذب فهو جاهل (26).
كان هذا هو بعض معارضات القدماء للقرآن ، وأما من المتأخرين فقد نقل عن :
٣ - أحد المسيحيين - وهو مؤلف رسالة " حسن الإيجاز " حيث ذكر أنه عارض سورة الحمد بقوله : الحمد للرحمن ، رب الأكوان ، الملك الديان ، لك العبادة ، وبك المستعان ، إهدنا صراط الإيمان.
وتخيل أن هذه العبارة وافية بجميع ما تضمنته سورة الحمد ، مع أخصريتها.
ولقد وقع هذا المتوهم بما وقع فيه مسيلمة من تقليد أسلوب القرآن الكريم ، وتبديل لفظ بلفظ آخر ، وقد سبق أن هذا ليس من المعارضة في شئ.
وأورد عليه بعض المحققين بأمور ، منها : أنه بدل قوله تعالى " الحمد لله " بقوله " الحمد للرحمن " ، وغفل أن ما يقتضيه الحمد هو المعنى الجامع لجميع صفات الكمال ، المفهوم من كلمة " الله ". وأما كلمة الرحمن فلا تناسب الحمد كما تناسبه
كلمة " الله " ، وحذف أيضا من الحمد " الرحيم " والآيتين الأخيرتين ، وتخيل أنه قد أتى بالأخصر ، مع أن الحذف المفوت لبعض المعاني ليس تلخيصا ، بل تفويت (27).
وجه إعجاز القرآن :
وبعد أن كان كل مسلم يجزم بإعجاز القرآن فإن معرفة وجه إعجازه تكون هي أمنيته الفضلى ، وقد اختلف في وجه إعجازه ، وأنه هل هو فصاحة القرآن وبلاغته ؟ أو هو حسن أسلوبه ؟ أو هما مع غيرهما مما تضمنه القرآن من الأحكام والأخلاق والسياسات والإخبارات الغيبية ، وتحققها على وفق ما أخبر به ، إلى غير ذلك مما ذكره المحققون من وجوه الإعجاز فيه ؟ أو من جهة صرف الله الناس ومنعه إياهم عن الإتيان بمثل القرآن مع قدرتهم عليه ، بحيث يكون الإعجاز في منعهم لا في نفس السور والآيات القرآنية كما ادعى البعض ؟
ولقد أجاد بعض الأساتذة هنا حيث قال : تكلم العلماء كثيرا عن إعجاز القرآن وأطالوا الكلام ، وربما خيل إلى واحد منهم أنه قد أدرك ما أراد ، ولكن هيهات ، أنى يكون له ذلك ، والمفروض أن القرآن إن أعجز العقول والقرائح فبالأولى أن يعجز الألسن - إلى أن قال : - أجل ، إن العالم يفهم المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه من لفظ القرآن وظاهره ، ويستحيل عليه أن يحيط علما بجميع معانيه وأسراره. وعلى هذا ، فإذا تحدث العالم عن أسرار القرآن فإنما يتحدث عن إعجاز ما فهمه هو من لفظ القرآن وظاهره ، لا عن إعجاز القرآن كما هو في واقعه (28).
ومن المحققين من اكتفى بنقل وجوه الإعجاز من دون أن يختار أحدها ، فقال : إعجاز القرآن قيل : لفصاحته ، وقيل : لأسلوبه وفصاحته ، وقيل : للصرفة ، والكل محتمل (29).
وقال القوشجي : اتفق الجمهور على أن إعجاز القرآن لكونه الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة ، والمراد بالفصاحة في عبارة المتن ما هو أعم منها ومن البلاغة ، وإطلاقها على هذا المعنى شائع. وقال بعض المعتزلة : إعجازه لأسلوبه الغريب ونظمه العجيب ، المخالف لما عليه كلام العرب في الخطب والرسائل والأشعار. وقال القاضي الباقلاني وإمام الحرمين : إن وجه الإعجاز هو اجتماع الفصاحة مع الأسلوب. - إلى أن قال : - وذهب النظام وكثير من المعتزلة والمرتضى إلى إعجازه بالصرفة ، وهي أن الله تعالى صرف همم المتحدين عن معارضته ، مع قدرتهم عليها (30).
والذي يبدو لنا هو أن احتمال الصرفة منفي ، لأنه لا يناسب ظواهر الآيات القرآنية الدالة على أن عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن إنما لخصوصيته في القرآن نفسه ، من الفصاحة والأسلوب وغيرهما من الامتيازات القرآنية ، وهي :
١ - قوله تعالى {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت : 51].
فيستفاد من هذه الآية - التي وقعت جوابا لقولهم {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ} [العنكبوت : 50] - أن القرآن هو تلك الآية التي يطلبونها ، وأنه كاف في ذلك ، ولا سيما ملاحظة تعبيره تعالى بأن الكتاب يكفيهم ، وإذا فالكتاب بنفسه هو الآية ، وليست الآية هي منعهم عن معارضته والإتيان بمثله ، كما هو مقتضى القول بالصرفة.
٢ - قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [النحل : 24] ونظيره قوله تعالى {فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ} [المدثر : 24].
والمستفاد من هذه الآية أنهم تعجبوا من حسن نظم القرآن وأسلوبه ، فقالوا : هو سحر ، أو أساطير الأولين ، فلو كان عدم تمكنهم من معارضته هو منعه تعالى لهم عن ذلك لكان المناسب أن يقولوا : إننا نتمكن من مجارات الآيات القرآنية ، لكننا مسحورون أو ممنوعون عن ذلك ، لا أن يقولوا : إنه سحر ، أو أساطير الأولين ، حيث إن معنى هذا هو أنهم قبلوا أنهم لا يقدرون على الإتيان بمثله ، لأنه أساطير الأولين أو سحر.
٣ - قوله تعالى {فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ} [هود : 14].
فهذه الآية تدل على أنه إذا كان الكلام القرآني خارجا عن قدرتهم فيكون إذا منزلا من قبل الله القادر ، لا أنهم إذا منعوا عن الإتيان بمثله كشف ذلك المنع عن كونه من الله تعالى ، ككشف العصا عن كون موسى (عليه السلام) نبيا.
فتلخص : أن ظواهر الآيات تؤيد قول من يقول : إن إعجاز القرآن ليس من جهة الصرفة والمنع. وثمة وجوه أخرى ذكروها لإبطال القول بالصرفة ، لم نذكرها اكتفاء بما ذكرناه من دلالة الآيات القرآنية نفسها على خلافها ، فمن أراد الاطلاع على سائر الردود فليراجع مظان وجودها. هذا كله بالإضافة إلى ضعف نفس ما استدلوا به على القول بالصرفة فإنهم قد استدلوا بوجهين :
الأول أن فصحاء العرب كانوا يعرفون المفردات القرآنية ، وكانوا أيضا قادرين على صياغة بعض الجمل التركيبية القرآنية ، مثل : الحمد لله رب العالمين ، وهذا معناه أنهم يقدرون على الإتيان بمثل السورة أيضا.
وأجيب عنه بأن حكم الجملة والسورة قد يخالف حكم الأجزاء.
الثاني : أن الصحابة كانوا عند جمع القرآن يتوقفون في إثبات بعض السور والآيات إلى أن يشهد الثقات على أنها من القرآن ، وقد بقي ابن مسعود مترددا في الفاتحة والمعوذتين.
وأجيب عنه بما تقدم منا من أن الجمع للقرآن إنما كان في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) (31)
مضافا إلى أن الإعجاز ليس مما يظهر لكل أحد.
المختار في وجه الإعجاز :
وأما ما نختاره في وجه إعجاز القرآن فهو يتلخص في أن التحدي لابد وأن يكون في أمر موجود في جميع السور القرآنية ، حتى السورة القصيرة منه. إذا فالقول بأن التحدي بالإتيان بمثله ناظر إلى الإخبارات الغيبية التي في القرآن ، أو حكاية قصص الماضين ، أو إشاراته إلى مكارم الأخلاق ، ونهيه عن رذائلها ، أو غير ذلك مما ذكروه ، مما لا يتأتى في كل سورة سورة منه ، ولا نجد ما يعجزون عنه مما هو مشترك بين جميع سور القرآن حتى القصار منها سوى جهة الفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب ، وهذا ما أعجزهم حتى عن الإتيان بسورة من مثله.
وذلك لا ينافي القول بأن القرآن الكريم كان معجزا لهم من نواح أخرى أيضا ، مثل إخباراته عن جملة من الحوادث المهمة ، والسير العجيبة التي وقعت من حين خلق الله آدم إلى حين مبعثه (صلى الله عليه وآله) ، مع أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ، وكل الناس كانوا يعرفون أنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين ، أو مثل إخباراته الغيبية التي تحققت على وفق ما أخبر به ، مما لا يمكن أن يقدر عليه البشر.
ولكن هذان الموردان ونظائرهما من موارد الإعجاز لا يعم مختلف سور القرآن ، إذ ليس في كل سورة إخبارات غيبية ولا قصص عن الماضين أو غير ذلك مما تقدم.
وما اخترناه في وجه إعجاز القرآن هو الظاهر من قوله تعالى {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء : 82].
فإن من تدبر القرآن يجد أنه لا اختلاف في آياته ولا تفاوت في سوره ، بل كل ما فيه في أحسن نظم وتأليف ، متضمن لأصح المعاني بأفصح الألفاظ ، من غير فرق في ذلك بين ما نزل في توحيد الذات وبين ما نزل في توحيد الصفات ، وكذا لا فرق بين ما أرشد به الناس إلى محاسن الصفات وبين ما هداهم به إلى مساوئها ، ولا فرق أيضا بين ما يبين الحلال والحرام وبين ما يحكي به القصص والأحوال.
وهذا بذاته يكشف عن أن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى.
وإدراك ذلك لا يتوقف على النبوغ في علوم المعاني والبيان والمحسنات البديعية ، بل هو في القرآن بحد أنه ربما يعرفه ويكتشف حسنه حتى من لم يكن من أهل تلك العلوم ولا من النوابغ فيها. نعم ، لو أراد شخص الاطلاع على محاسن القرآن تفصيلا فعليه أن يطالع ما الف من الكتب حول إعجاز القرآن ، ويتأمل ويتدبر ، مثل دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ، الذي قال في مدخل كتابه ما حاصله : إن من أراد الاطلاع على ما في القرآن من عظيم المزية وباهر الفضل وعجيب الوصف فينبغي له أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه (32).
ولا يخفى أن هذا التناسق العجيب في الأسلوب وهذا الإعجاز في فصاحته وبلاغته مختص بالقرآن الكريم ، حيث لا تفاوت بين أوله وآخره ، ولا بين آياته وكلماته ، وهذا بخلاف ما صدر من البشر ، من الخطب والمدائح والأهاجي. فلربما يوجد الاختلاف حتى في الخطب أو الأشعار ، بل وحتى القصيدة الواحدة والخطبة الواحدة للشاعر والخطيب الواحد. وكذا الاختلاف بين المدح والهجاء ، وبين ما يقوله في وصف الخمر وبين ما قاله في وصف الرياض ، فإن القدرة البشرية محدودة ، قد لا تصل إلى الكل في مستوى واحد وعلى نسق واحد.
خلاصة البحث :
فتحصل مما ذكرناه : أن النبي يحتاج في صدق دعواه إلى المعجز ، وأن أهم معجزات نبينا (صلى الله عليه وآله) هو القرآن الكريم ، وأنما يتحدى به الناس هو الإتيان بسورة واحدة تشبه سوره في الفصاحة والبلاغة والأسلوب. وهذا لا ينافي أن يكون القرآن معجزا من نواح أخرى. وأن من يتدبر القرآن يعرف أنه من الله تعالى ولو لم يكن له مهارة في الآداب والعلوم العربية المبينة لوجوه الفصاحة والبلاغة.
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
_____________________
(١) تجريد الاعتقاد للشيخ نصير الدين الطوسي : بحث النبوة.
(٢) تفسير البيان : ص ٢٨.
(٣) المفردات للراغب الإصفهاني : ص ٣٣ و ٦٨.
(4) تفسير البيان للإمام الخوئي : ص ٢٥.
(5) راجع مقدمة آلاء الرحمن للبلاغي : ص ٤. والقوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد ، جمعه : قوب.
(6) الوافي للفيض الكاشاني : ج ١ ص ٣٣.
(7) راجع مقدمة آلاء الرحمن : ص ٥.
(8) تفسير البيان : ص ٢٥ عن العمدة لابن رشيق.
(9) تفسير البيان : ص ٢٩.
(10) أقرب الموارد : مادة " عجز ".
(11) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص ١٩٦.
(12) تفسير البيان : ص ٢٠.
(13) الإتقان : ج ٢ ص ١١٦.
(14) الميزان في تفسير القرآن : ج ١ ص ٧٣.
(15) نقله عنه عبد الكريم الخطيب في كتاب " النبي محمد " : ص ٢٨٦.
(16) مناهل العرفان : ج ٢ ص ٣٣٢.
(17) نقله عنه السيوطي في الإتقان : ج ٢ ص ١١٧.
(18) بيان إعجاز القرآن للخطابي : ص ٥٥.
(19) بيان إعجاز القرآن : ص ٥٥.
(20) المصدر السابق : ص ٦٦.
(21) البيت في ديوانه هكذا : فللساق الهوب وللسوط درة * وللزجر منه وقع أهوج منعب
(2٢) بيان إعجاز القرآن : ص ٥٩.
(23) قال الذهبي في ميزان الاعتدال : سعيد بن نشيط لا يعرف مجهول.
(24) رسالة الإسلام : السنة ١١ ص ٣٢٥.
(25) إعجاز القرآن للرافعي : ص ١٨٤.
(26) المنتظم لابن الجوزي : ج ٧ ص ٢٦.
(27) تفسير البيان : ص ٧٠.
(28) فلسفة التوحيد والولاية للعلامة الشيخ محمد جواد مغنية : ص ١١٣.
(29) راجع تجريد الاعتقاد للشيخ نصير الدين الطوسي (رحمه الله).
(30) شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي : ص ٤٦٨.
(31) راجع بحث " من جمع القرآن ؟ " في هذا الكتاب.
(32) مقدمة دلائل الإعجاز : ص ٦.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|