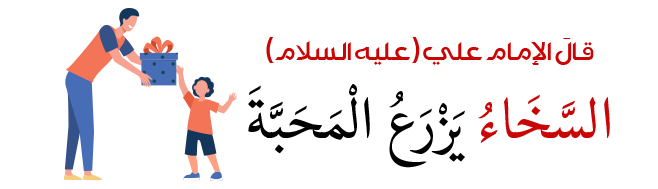
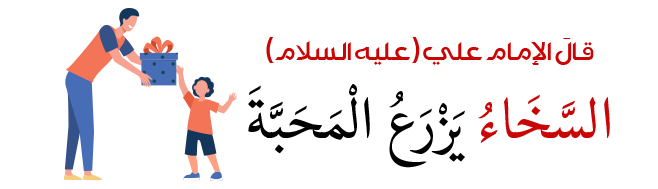

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-14
التاريخ: 4-10-2018
التاريخ: 2024-06-29
التاريخ: 2024-11-13
|
شرائط [وجوب الحج والعمرة] ثمانية: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة، ووجود الزاد والراحلة، والرجوع إلى كفاية، إمّا من المال، أو الصناعة، أو الحرفة، وتخلية السرب من الموانع، وإمكان المسير.
قولهم: إمكان المسير، هو غير تخلية السرب، لأنّ السرب الطريق، بفتح السين، وإمكان المسير ، يراد به، أنّه وجد القدرة من المال في زمان لا يمكنه الوصول إلى مكّة، لضيق الوقت ، مثال ذلك ، أنّ رجلا من بغداد، وهو فقير، استغنى ، ووجد شرائط الحج ، في أوّل ذي الحجّة ، أو كان قد بقي ليوم عرفة ، ثلاثة أيام ، أو أقل من ذلك ، والطريق مخلّى ، أمين ، فلا يجب عليه في هذه السنة الحج ، لأنّه لا يمكنه المسير بحيث يدرك الحج ، وأوقاته ، وأمكنته في هذه المدّة ، فإن وجد المال والشرائط ، ومعه من الزمان ما يمكنه الوصول ، وإدراك هذه المواضع في أوقاتها ، فقد أمكنه المسير ، فهذا معنى إمكان المسير.
ومتى اختل شيء من هذه الشرائط الثمان، سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب، هذا على قول بعض أصحابنا، فإنّهم مختلفون في ذلك، فبعض يذهب إلى أنّه لا يجب إلا مع هذه الشرائط الثمانية وبعض منهم، يقول: يجب الحج على كلّ حرّ، مسلم، بالغ، عاقل، متمكن من الثبوت على الراحلة، إذا زالت المخاوف والقواطع، ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه، وما يخلفه لعياله من النفقة.
وعبارة أخرى لمن لا يراعي الثماني شرائط ، بل يسقط الرجوع إلى كفاي، ويراعي سبع شرائط فحسب، قال: الحج يجب على كل حرّ، بالغ، كامل ، العقل، صحيح الجسم ، يتمكن من الاستمساك على الراحلة ، مخلّى السرب من الموانع ، يمكنه المسير، واجد للزاد والراحلة ، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد ، ولما ينفقه على نفسه ذاهبا وجائيا بالاقتصاد ، وإلى المذهب الأول ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في سائر كتبه إلا في استبصاره (1)، ومسائل خلافه (2) ، وإلى المذهب الثاني ذهب السيد المرتضى ، في سائر كتبه ، حتى أنّه ذهب في الناصريات ، إلى أنّ الاستطاعة التي يجب معها الحج ، صحّة البدن ، وارتفاع الموانع، والزاد، والراحلة فحسب، وقال رحمه الله: وزاد كثير من أصحابنا، أن يكون له سعة يحج ببعضها، وتبقى بعضا لقوت عياله، ثم قال رضي الله عنه: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه، بعد الإجماع المتكرر ذكره، أنّه لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه ، أنّ الحجّ يلزمه (3).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: والذي يقوى في نفسي، وثبت عندي، واختاره وافتي به، واعتقد صحّته، ما ذهب إليه السيد المرتضى، واختاره، لأنّه إجماع المسلمين قاطبة، إلا مالكا فإنّه لم يعتبر الراحلة، ولا الزاد، إذا كان ذا صناعة يمكنه الاكتساب بها في طريقه، وإن لم يكن ذا صناعة، وكان يحسن السؤال، وجرت عادته به، لزمه أيضا الحج، فإن لم يجر عادته به لم يلزمه الحج.
فأمّا ما ذهب إليه الفريق الآخر ، من أصحابنا ، فإنهم يتعلقون باخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يخصص بمثلها القرآن ، ولا يرجع عن ظاهر التنزيل بها ، بل الواجب العمل بظاهر القرآن ، وهو قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (4) ولا خلاف أنّ من ذكرنا حاله قادر على إتيان البيت ، وقصده ، لأنّه تعالى قال (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ولو لا إجماع المسلمين على إبطال قول مالك ، لكان ظاهر القرآن معه ، بل أجمعنا على تخصيص المواضع التي أجمعنا عليها ، وخصّصناها بالإجماع ، بقي الباقي ، فظاهر الآية على عمومها ، فمن خصص ما لم يجمع على تخصيصه ، يحتاج إلى دليل ، الا ترى إلى استدلال السيد المرتضى رضي الله عنه وقوله: (دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره ، أنّه لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه ، أنّ الحج يلزمه) فقد استدل بإجماع الفرقة ، وإجماع المسلمين ، بقوله (لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه أن الحج يلزمه) واستدل أيضا على بطلان قول مالك ، وصحة ما ذهب السيد إليه ، واختاره (5) بما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله سئل عن قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فقيل له: يا رسول الله ، ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة (6)
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : وأخبارنا متواترة عامّة في وجوب الحجّ ، على من حاله ما ذكرناه ، قد أوردها أصحابنا في كتب الأخبار ، من جملتها ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه تهذيب الأحكام (7) وفي الاستبصار فمما أورده في الاستبصار ، عن الكليني محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام ، وأنا عنده ، عن قول الله عزوجل : (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ، قال : نعم (8).
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قول الله عزوجل (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) من استطاع إليه سبيلا قال : أن يكون له ما يحج به ، قال : قلت من عرض عليه ما يحج به ، فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ، ولو يحج على حمار أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ، ويركب بعضا ، فليحج (9) موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال: قلت لأبي جعفر ، قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، قال: يكون له ما يحج به ، قلت : فإن عرض عليه الحج ، فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع ، ولم يستحيي ، ولو على حمار أجدع أبتر ، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (10).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: فجعل شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، هذه الأخبار عمدته ، وبها صدّر الباب في ماهية الاستطاعة ، وانّها شرط في وجوب الحج ، وهذه طريقته في هذا الكتاب ، أعني كتاب الاستبصار ، يقدّم في صدر الباب ما يعمل به من الأخبار ، ويعتمد عليه ، ويفتي به ، وما يخالف ذلك يؤخّره ، ويتحدّث عليه ، هذه عادته ، وسجيّته ، وطريقته في هذا الكتاب ، فمذهبه في الاستبصار ، هو ما اخترناه ، وقد رجع عن مذهبه في نهايته (11) وجمله وعقوده (12) واختار في استبصاره ما ذكرناه ، ثم قال رحمه الله: فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن أحمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، قول الله عزوجل: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، قال: يخرج ويمشي ، إن لم يكن عنده مركب ، قلت: لا يقدر على المشي ، قال: يمشي ويركب ، قلت: لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ، قال: يخدم القوم ويخرج معهم (13).
عنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، انّ حجة الإسلام واجبة، على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي عليه السلام، أكثرهم مشاة، ولقد مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم، فشكوا إليه الجهد والعياء فقال: شدوا أزركم، واستبطئوا ففعلوا ذلك، فذهب عنهم (14).
قال رحمه الله: فلا تنافي بين هذين الخبرين، والأخبار الأولة المتقدّمة، لأنّ الوجه فيهما أحد شيئين، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب، لأنّ من أطاق المشي، مندوب إلى الحج، وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز، مع انّا قد بينا انّ ما هو مؤكد شديد الاستحباب، يجوز أن يقال فيه أنّه واجب وإن لم يكن فرضا.
والوجه الثاني: أن يكونا محمولين على ضرب من التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، ألا ترى أنّه رحمه الله قد اعتمد على الأخبار الأولة ، في وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ، ونفقة طريقه ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته مدّة سفره وغيبته ، ولم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية ، إلا في خبر أبي الربيع الشامي ، فإنّ فيه اشتباها ، على غير الناقد المتأمّل ، بل عند تحقيقه ونقده ، هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها ، لا تنافي بينها وبينه وذلك أنّه قال أبو الربيع : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عزوجل: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فقال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له الزاد والراحلة ، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عن هذا ، فقال: هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا اذن ، فقيل له: فما السبيل ، قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ، ويبقى ببعض لقوت عياله (15).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: وليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه ، واخترناه ، بل ما يلائمه ويعضده ، وهو دليل لنا ، لا علينا ، بل نعم ما قال عليه السلام ، لأنّه قال: ما يقول الناس في الاستطاعة؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة ، قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إيّاه ، لقد هلكوا اذن ، ونحن نقول بما قال عليه السلام ، ولا نوجب الحج على الواجد للزاد والراحلة فحسب ، بل نقول ما قال عليه السلام ، لمّا قيل له: فما السبيل ، قال: فقال: السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ، ويبقي بعض ، يقوت عياله وكذا نقول ، وهذا مذهبنا الذي ذهبنا إليه ، لأنّه عليه السلام قال: السبيل ، السعة في المال ، ثم فسرها فقال: إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله. ولم يذكر في الخبر عليه السلام ويرجع إلى كفاية، امّا من صناعة ، أو مال ، بل قال عليه السلام: يحج ببعض ، ويبقي بعض يقوت عياله ، وهو الصحيح ، لأنّا أوجبنا الحج ، بأن يجد الزاد والراحلة ، ونفقته ، ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته ، من عياله ، وكذلك قال عليه السلام: يحج ببعض ، ويبقي بعض يقوت عياله ، يعني نفقة عياله ، فأمّا إن لم يبق ما يقوت عياله ، مدّة سفره ، وغيبته ، فلا يجب عليه الحج وهل هذا الخبر فيه ، ما ينافي ما قلناه ، أو يرجع به عن ظاهر التنزيل ، والمتواتر من الأخبار ، ولو وجد أخبار آحاد ، فلا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، ولا يترك لها ظاهر القرآن ، وإجماع أصحابنا ، فإنّهم عند تحقيق أقوال الفريقين ، تجدهم متفقين على ما ذهبنا إليه ، وأنا أدلك على ذلك ، وذاك أنّه لا خلاف بينهم ، أنّ العبد إذا لحقه العتاق ، قبل الوقوف بأحد الموقفين ، فانّ حجته مجزية عن حجة الإسلام ، ويجب عليه النيّة للوجوب والحجّ ، ولم يعتبر أحد منهم ، هل هو ممن يرجع إلى كفاية أو صنعة ، لأنّ العبد عندهم لا يملك شيئا فإذن لا مال له يرجع إليه ، ولا أحد منهم اعتبر رجوعه إلى صناعة ، في صحة حجّه ، وهذا منهم إجماع منعقد بغير خلاف.
وكذلك أيضا، من عرض عليه بعض إخوانه نفقة الحجّ، فإنّه يجب عليه عند أكثر أصحابنا أيضا، ولم يعتبروا في وجوب الحجّ عليه رجوعه إلى كفاية، إمّا من المال، أو الصناعة والحرفة، بل أوجبوه عليه، بمجرّد نفقة الحجّ، وعرضها عليه، وتمكنه منها فحسب.
وأيضا فقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، إلى ما ذهبنا إليه ، في مسألة من مسائل خلافه (16) مضافا إلى استبصاره (17) فقال: مسألة ، المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقة غير محتملة ، في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته ، فلا يجب عليه فرض الحج ، إلا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما ، لا يجب عليه فرض الحج ، وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه ، ثم قال في استدلاله على صحة ما صوّره في المسألة ، دليلنا إجماع الفرقة ، ولا خلاف أن من اعتبرناه ، يجب عليه الحج ، وليس على قول من خالف ذلك دليل ، وأيضا قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، والاستطاعة تتناول القدرة ، وجميع ما يحتاج إليه ، فيجب أن يكون من شرطه ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال: الاستطاعة الزاد والراحلة ، لمّا سئل عنها روى ذلك ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، ورووا أيضا عن علي عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في المسألة ، ألا ترى أرشدك الله إلى قوله رحمه الله ، ولا خلاف أنّ من اعتبرناه يجب عليه الحجّ ، وما اعتبر فيما صوّره في المسألة الرجوع إلى كفاية ودلّ أيضا ، بإجماع الفرقة على صحة ما صوّره في المسألة.
وأيضا ذكر مسألة أخرى ، فقال : مسألة ، الأعمى يتوجه عليه فرض الحج ، إذا كان له من يقوده ويهديه ، ووجد الزاد والراحلة ، لنفسه ولمن يقوده ، ولا يجب عليه الجمعة ، وقال الشافعي : يجب عليه الحج ، والجمعة ، معا ، وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحج ، وإن قدر على جميع ما قلناه ، دليلنا قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، وهذا مستطيع ، فمن أخرجه من العموم ، فعليه الدلالة (18) هذا آخر كلام شيخنا الا ترى أرشدك الله ، إلى استدلاله ، فإن كان يعتبر الرجوع إلى الكفاية ، على ما يذكره في بعض كتبه في وجوب الحج ، فقول أبي حنيفة صحيح ، لا حاجة به إلى الرد عليه ، بل ردّ عليه بالآية وعمومها ، ونعم ما استدل به ، فإنّه الدليل القاطع ، والضياء الساطع ، والشفاء النافع.
وقال أيضا في مبسوطة شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: مسألة ، إذا بذل له الاستطاعة ، قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ، ويخلف لمن يجب عليه نفقته ، لزمه فرض الحجّ ، لأنّه مستطيع (19) هذا آخر كلامه في مبسوطة ، وجعل هذا الكلام مسألة في مسائل خلافه أيضا (20) فهل يحلّ لأحد أن يقول ، انّ الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه الله ، ما يذهب إلى ما يذهب إليه المرتضى في هذه المسألة ، بعد ما أوردناه عنه ، وإن كان في بعض كتبه يقول بغير هذا ، فنأخذ ما اتفقا عليه ، ونترك القول الذي انفرد به أحدهما ، إن قلّدا في ذلك ونعوذ بالله من ذلك ، بل يجب علينا الأخذ بما قام الدّليل عليه من كان القائل به من .
وأيضا فقد بيّنا أنّه إذا اختلف أصحابنا الإمامية ، في مسألة ، ولم يكن عليها إجماع منهم ، منعقد ، فالواجب علينا التمسك بظاهر القرآن ، إن كان عليها ظاهر تنزيل ، وهذه المسألة فلا إجماع عليها ، بغير خلاف عند من خالفنا وذهب إلى غير ما اخترناه ، وإذا لم يكن له إجماع عليها ، قلنا نحن ، ظاهر التنزيل دليل عليها ، وعموم الآية ، ولا يجوز العدول عنه ، ولا تخصيصه ، إلا بأدلة قاطعة للأعذار ، إمّا من كتاب الله تعالى مثله ، أو سنّة متواترة مقطوع بها ، يجرى مجراه أو إجماع ، وهذه الأدلة مفقودة بحمد الله تعالى في المسألة ، فيجب التمسك بعموم القرآن ، فهو الشفاء لكلّ داء.
ومن شرط صحّة أداء حجة الإسلام وعمرته. الإسلام، وكمال العقل، لأنّ الكافر، وإن كان واجبا عليه، لكونه مخاطبا بالشرائع عندنا، فلا يصحّ منه أداءهما، إلا بشرط الإسلام، وعند تكامل شروط وجوبهما، يجبان في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب، مندوب إليه، وخصوصا لذوي اليسار والأموال الواسعة، فإنّهم يستحب لهم أن يحجّوا كلّ سنة.
ووجوبهما على الفور، دون التراخي، بغير خلاف بين أصحابنا.
وما يجب عند سبب، فهو ما يجب بالنذر، أو العهد، أو إفساد حج مندوب، دخل فيه، أو عمرة كذلك، ولا سبب لوجوبهما غير ذلك، وذلك بحسب النذر، أو العهد، إن كان واحدا فواحدا، وإن كان أكثر فأكثر.
فأمّا المفسودة، فإنّه يجب عليه الإتيان بحجة صحيحة، ولو تكرر الفساد لها دفعات.
ولا يصح النذر والعهد بهما، إلا من كامل العقل، حرّ، ومن لا ولاية عليه، فأمّا من ليس كذلك، فلا ينعقد نذره، ولا يراعى في صحة انعقاد النذر، ما روعي في حجة الإسلام، من الشروط.
وإذا حصلت الاستطاعة ، ومنعه من الخروج مانع ، من سلطان ، أو عدو ، أو مرض ، ولم يتمكن من الخروج بنفسه ، كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه ، فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع ، كان عليه اعادة الحج ، لأنّ الذي أخرجه ، انّما كان يجب عليه في ماله ، وهذا يلزمه على بدنه ، وماله ، ذكر هذا بعض أصحابنا في كتاب له ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته (21) وهذا غير واضح ، لأنّه إذا منع ، فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ، ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه ، لأنّه غير مكلّف بالحج حينئذ بغير خلاف ، وانّما هذا خبر أورده إيرادا ، لا اعتقادا.
فإن كان متمكنا من الحج والخروج ، فلم يخرج وأدركه الموت ، وكان الحج قد استقر عليه ، ووجب ، وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ، ما يحجّ به من بلده ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا ، فإن لم يخلف إلّا قدر ما يحج به ، وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك ، واستقرت ، وجب أن يحج به عنه من بلده ، وقال بعض أصحابنا : بل من بعض المواقيت ولا يلزم الورثة الإجارة من بلده ، بل من بعض المواقيت ، والصحيح الأول ، لأنّه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلمّا مات سقط الحج عن بدنه ، وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه ، لو كان حيا ، من نفقة الطريق من بلده ، فأما إذا لم يخلف إلّا قدر ما يحج به ، من بعض المواقيت ، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع ، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (22) وبه تواترت أخبارنا ، ورواية أصحابنا ، والمقالة الأخرى ذكرها وذهب إليها في مبسوطة (23) ، وأظنها مذهب المخالفين.
وإن خلف قدر ما يحج به عنه ، أو أقل من ذلك ولم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك واستقر في ذمّته ، كان ميراثا لورثته ، فهذا معنى قولنا وجبت الحجة واستقرت ، ووجبت وما استقرت ، لأنّ من تمكن من الاستطاعة ، وخرج للأداء ، من غير تفريط ، ولا توان ، بل في سنة تمكنه من الاستطاعة ، خرج ومات قبل تفريطه ، فلا يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه ، لأنّ الحجة ما استقرت في ذمّته ، فأمّا إذا فرّط فيها ، ولم يخرج تلك السنة ، وكان متمكنا من الخروج ، ثم مات ، يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه من بلده ، قبل قسمة الميراث.
ومن لم يملك الاستطاعة، وكان له ولد، له مال، وجب عليه أن يأخذ من ماله، قدر ما يحج به على الاقتصاد، ويحج، ذكر هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته (24) ورجع عنه في استبصاره (25) ورجوعه عنه هو الصحيح، وانّما أورده إيرادا في نهايته، لا اعتقادا، ثم قال في النهاية: فان لم يكن له ولد، وعرض عليه بعض إخوانه، ما يحتاج إليه من مئونة الطريق، وجب عليه الحجّ أيضا، وقال: ومن ليس معه مال، وحج به بعض إخوانه، فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وإن أبسر بعد ذلك (26).
قال محمّد بن إدريس : والذي عندي في ذلك ، أنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ، ما يحتاج اليه من مئونة الطريق فحسب ، لا يجب عليه الحجّ ، إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم ، ولم يكن له ما يخلفه نفقة لهم ، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره ، بشرط أن يملكه ما يبذل له ، ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعال ، وكذا أقول فيمن حج به بعض إخوانه ، بشرط أن يخلف لمن تجب عليه نفقته ، إن كان ممن تجب عليه نفقته وفي المسألتين معا ، ما راعى شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ، الرجوع إلى كفاية ، إمّا من المال ، أو الصناعة ،
وهذا يدلك أيضا على ما قدّمناه أولا.
_________________
(1) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة.
(2) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 2 (ولا يخفى ان ما في الخلاف موافق لسائر كتبه في اشتراط الرجوع الى الكفاية).
(3) الناصريات: كتاب الحج، مسألة 136.
(4) آل عمران: 97.
(5) الناصريات: كتاب الحج، مسألة 136 (ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي).
(6) الناصريات: كتاب الحج، مسألة 136 (ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي).
(7) التهذيب: كتاب الحج، باب وجوب الحج.
(8) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 2.
(9) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 3 و4.
(10) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 3 و4.
(11) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.
(12) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه.
(13) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة: ح د.
(14) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الاستطاعة، ح 6.
(15) الاستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الحج، ح 1.
(16) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 4.
(17) الإستبصار: كتاب الحج، باب ماهية الحج.
(18) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 15.
(19) المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج، ص 298.
(20) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 9.
(21) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.
(22) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.
(23) المبسوط: كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة.
(24) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.
(25) الاستبصار: كتاب المكاسب، الباب 26، ح 9.
(26) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج.



|
|
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|