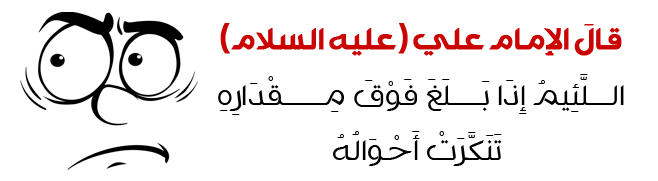
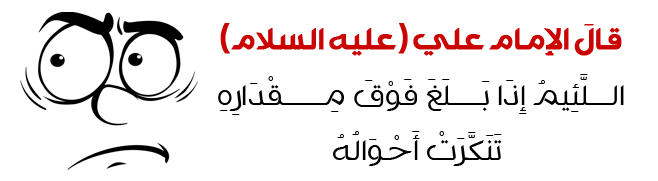

 الحياة الاسرية
الحياة الاسرية 
 المجتمع و قضاياه
المجتمع و قضاياه
 التربية والتعليم
التربية والتعليم |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-10
التاريخ: 14-6-2017
التاريخ: 2023-08-30
التاريخ: 11-2-2018
|
ـ الهدف الأساسي هو التكامل لبلوغ المعرفة.
ـ الأهداف الأساسية التي تشكل بالنسبة إلى الهدف الأول سياسات عامة، وهي:
1- إخراج الإنسان على نحو تدريجي من حب الدنيا.
2- إيصال النفس الإنسانية إلى الاطمئنان بعد المكابدة والأماريّة والتزلزل.
3- تقوية إرادة الإنسان وشد عزيمته للمساعدة في إخراجه من الجزع والطمع.
4- تعويد الإنسان على العدالة والإنصاف وعلى الشكر.
5- تعويد الإنسان على الصبر والتحمل والأناة.
6- تعويد الإنسان على البذل والعطاء
7- تعويد الإنسان على تحمل المسؤولية عن نفسه وأعماله.
8 - تعويد الإنسان على الإبداع والخلاقيّة وعلى القبول بنفسه وبالآخر.
9- تعويد الإنسان على التعبد بحكم الله وعلى الولاية والطاعة والانتظام.
10- تعزيز كرامة الإنسان والمحافظة عليها ورفع أسباب الذل على أنواعها (فقر - جهل - استضعاف..) بعد الحفاظ على حياته وسلامته.
وقد ذكر سبحانه جزءاً أساسياً من هذه السياسات في السياق القرآني الآتي:
إن الإنسان خُلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً، إذاً الإنسان ونتيجة ارتباطه بالدنيا وتعلقه بها خُلق هلوعاً، يمنع الخير ويجزع من الشر، لكن كيف يخرج الإنسان من هذه الحالة التي هي حالة اندكاك في الدنيا وتمنع من التطور والتكامل؟ يقول سبحانه تتمّة للسياق القرآني: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ} [المعارج: 22]: (الذين يعبدون الله) لكن هل جميع المصلين، لا، فقد حدد سبحانه من هم المصلون الذين يخرجون من هذه الحالة، أو هم خارجون عنها وهم بالتالي في طور التكامل والترقي:
أ- {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23]: (العبودية حالة دائمة وراسخة، وهناك مراقبة على الفعل وهناك ذكر دائم لله تعالى في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم).
ب- {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24، 25]، أي المنفقون، وقد ذكر سبحانه صفة الإنفاق مباشرة بعد الصلاة، وهذا ما يؤكد أهميتها ودورها في تحرير النفس الإنسانية من بوتقة العبودية للدنيا وللهوى، وما لها من دور في تقوية الإرادة وتثبت النفس.
ج- {وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} [المعارج: 26، 27]: (الرهبة والخشية من الله بعد تأكيد الغيب ويوم الدين. تقوى الله وخوف المعاد ودوره في البناء الذاتي). فالتقوى متلازمة مع الاعتقاد الفعلي الصادق بيوم الدين، وكلّما قوي الاعتقاد زادت التقوى والعكس صحيح.
د- {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7]: (دور الجنس، والعلاقة بالطرف الآخر، وأهمية حفظ الفرج الذي يمثل سوأة الإنسان، مع عدم القضاء على الشهوة ـ لحاظ الملكات المتفاوتة ـ وأهمية التكاثر والتناسل مع عدم التعدي عن الطبيعة وعن ما فرضه الله وأحله).
هـ- {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ} [المعارج: 32، 33]، الصدق، الوفاء، تحمل المسؤولية، الاستقامة العدالة كلها أمور تظهر من خلال عاملين سلوكيين هما أداء الأمانة والوفاء بالعهد، والقيام على الشهادة والثبات عليها.
وفي مقابل هذه السياسات أو الأهداف المرحلة إلى الهدف الأساسي، فإن السلوك في المقابل هو سلوك اختلال وانعدام توازن، ويعبر سبحانه عن ذلك في نفس السياق القرآني: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ} [المعارج: 36، 37]، أي أنهم تائهون يميناً وشمالاً في حين أن المؤمنين يسلكون طريقاً سوياً على صراط مستقيم: {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الملك: 22].
ويمكن أن يمثل مضمون ما ورد في هذه الآيات بمثابة السياسات الإجرائية الأساسية التي يجب التربية عليها وهي:
1- الصلاة (التي تعني الانتماء إلى المؤسسة التوحيدية).
2- المراقبة وعدم الغفلة والانتباه إلى العمل.
3- الإنفاق (على السائل عند طلبه وعلى المحروم دون الطلب).
4- بناء الواعظ الذاتي والوجدان وتقوية الضمير من خلال خوف المعاد والوقوف بين يدي الله تعالى.
5- حفظ الفروج (العفاف، الستر، الصيانة، الحياء).
6- فهم وضبط الحدود بين الطبيعي والشذوذ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المعارج: 30، 31].
7- أداء الأمانة وحفظ العهد ورعايته.
8- القيام على الشهادة والصدق فيها.
9- المحافظة على الصلاة (والانتظام عليها).
في الخلاصة نستنتج النظرية التربوية الآتية:
إن هدف الإنسان هو المعرفة من خلال العبودية التي تحقق التكامل، ويحصل ذلك بإخراجه التدريجي من الدنيا مع لحاظ كونه واحداً غير متعدد متفاعل الملكات في المناهج التربوية. ويتحقق التكامل الذي تصنعه العبودية بالصلاة والإنفاق والواعظ الذاتي والحياء، ومعرفة الحدود، وأداء الأمانة، وحفظ العهد والصدق في الشهادة والثبات عليها.
والعناوين الأخيرة هي التي يجب ترتيبها ووضع الأهداف والسياسات الإجرائية التفصيلية لها في برامج تربوية تلحظ الفروقات الفردية والقدرات الذاتية بحسب المستويات العمرية كما تلحظ الظروف التربوية.
وبالخلاصة فإن النظرية التربوية القرآنية تتقوم بما يأتي:
ـ الإنسان الواحد ذو الملكات المتعددة المتفاعلة المتضامنة التي تعيد في تفاعلها صيانة الإنسان الواحد.
ـ الهدف النهائي هو التكامل بالإخراج التدريجي من الدنيا، والاستقامة على الحق، وتنمية الملكات الفاضلة والقضاء على الرذائل.
ـ المسار التكاملي واحد يتم قطعه بالمراحل، مع رعاية الإنسان واحتضانه في كل المراحل مع مراعاة إمكاناته وقدراته (بلحاظ المنطق).
ويمكن اختصار هذه النظرية بالآتي: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: 79].
الهدف هو الربانية والضابطان هما:
علم الكتاب (المضمون الفكري الديني - أي الشريعة والكتاب -، الأحكام والتعاليم الإلهية).
ـ المنطق (مراعاة الحال، الظروف، الأوضاع الذات والخارج، ولحاظ الزمان والمكان والإنسان وخصوصيّاته......).
وهي المتضمنة أي النظرية في قوله تعالى: {وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [آل عمران: 164].
فالتزكية للنفس باعتبارها مؤثرة في العلم والفهم والدراية والتعليم لأمرين:
ـ الكتاب: (الفكر، المفاهيم، المبادئ).
- الحكمة: (إخراج الفكر إلى حيز الممارسة).
فالنظرية التربوية تقوم على:
ـ التزكية والتعليم للكتاب مع الحكمة التي تعني ضبط عملية التزكية بما يناسب الحق ومستويات الناس وكيفية طي المراحل في التزكية، وكذلك الحكمة التي تعني ضبط التعليم في مراحله ومستوياته، ورعايته للأحوال والأوضاع والمستويات والذهنيات والبيئة والظروف وغير ذلك.



|
|
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
|
|
مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن
|
|
|