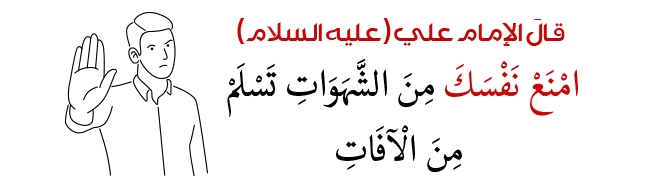
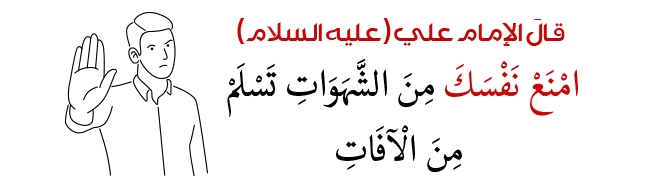

 الفضائل
الفضائل
 آداب
آداب
 الرذائل وعلاجاتها
الرذائل وعلاجاتها
 علاج الرذائل
علاج الرذائل 
 قصص أخلاقية
قصص أخلاقية|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2022
التاريخ: 18-6-2022
التاريخ: 21-4-2020
التاريخ: 5-6-2022
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على منجي البشريّة ومنقذها من الجهل والضلال محمّد وعلى آله الأطهار الأئمة الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
أمّا بعد:
قال الله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: {الرَّحْمنُ * عَلَّمَ القُرْآنَ * خَلَقَ الإنْسانَ * عَلَّمَهُ البَيانَ} (1).
الرحمن اسمٌ جامع من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وإنّه صفة عامّة، فإنّه رحمن على المؤمن والكافر، وبرحمانيّته ورحيميّته العامّة، يرزقهما في الدنيا، ويسخّر لهما ما في السماوات والأرض، وهداهما إلى الصراط المستقيم بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، وأمّا الرحيمية الخاصّة وأنّه الرحيم، فإنّها مختصّة بالمؤمنين، وإنّها قريبة من المحسنين، كما جاء ذلك في الآيات الكريمة والروايات الشريفة.
فإنّه برحمانيّته ابتدأ سورة الرحمن ليدلّ على أنّ المعلّم لا بدّ له من رحمة وشفقة على كلّ الطلاّب على السواء، ثمّ علّم القرآن قبل خلق الإنسان، وهذا يعني أنّ القرآن كان قبل الإنسان، ثمّ خلقه وعلّمه البيان، بيان ما جاء في القرآن، الذي هو مجموع ما جاء في الكتب السماوية وفيه كلّ شيء: {وَكُلَّ شَيْء أحْصَيْناهُ في إمام مُبين} (2).
{وَكُلَّ شَيْء أحْصَيْناهُ كِتاباً} (3).
وإنّما الله يعلّم الإنسان البيان بحجّته الباطنية (العقل السليم والفطرة السليمة) وبحجّيته الظاهريّة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) والإمام المعصوم (عليه السلام)، كما قال الله تعالى :{وَأنزَلـنا إلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نَزَلَ إلَيهِم} (4).
فخلق الإنسان كان بين علمين: علم القرآن وعلم البيان.
وهذا إنّما يدلّ على عظمة الإنسان وشرف العلم، وأنّه الأساس في كلّ شيء، (وبه يمتاز الإنسان عن باقي الحيوانات؛ لأنّ جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة والقوّة والشفقة وغير ذلك، وبه أظهر الله فضل آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وهو الوسيلة إلى السعادة الأبديّة إن وقع على مقتضاه، فالعلم الذي يفرض على المكلّف بعينه يجب تحصيله، وتجبر عليه إن لم يحصل. والذي يكون الاحتياج به في الأحيان فرض على سبيل الكفاية، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإن لم يكن في البلد من يقوم به اشتركوا جميعاً في تحصيله بالوجوب) (5).
ثمّ الرسول الأكرم الذي نزل عليه القرآن الكريم، قد خلّف وترك بعد رحلته (كتاب الله والعترة الطاهرة) الذين يفسّرون ويبيّنون ما جاء في القرآن، فإنّما يعرف القرآن من خوطب به، وإنّما نزل الكتاب في بيوتهم، فهم معدن العلم ومهبط الوحي وعيبة علم الله (عليهم السلام) أبد الآبدين.
ثمّ لن يفترقا (الكتاب والعترة) حتّى يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين، في قول الرسول الأعظم في عدّة مواطن: «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض» (6)، ولن تفيد التأبيد، أي أبداً لن يفترقا، وكلّ ما في القرآن إنّما هو عند العترة الطاهرة، وكذلك العكس، وهذا يعني أنّ القرآن على نحوين: قرآن علميّ (القرآن الصامت المدوّن)، وقرآن عيني (القرآن الناطق) وهم الذين تجسّد فيهم القرآن الكريم، كما كان النبيّ، وأنّه حينما سُئلت عائشة عن خلق النبيّ؛ لأنّ الله قد مدحه بخلقه في قوله :{وَإنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظيم} (7) فأجابت: كان خلقه القرآن أي كان يجسّد القرآن في سيرته وسلوكه، فتظهر الآيات القرآنيّة على أفعاله وأعماله.
وإذا لن يفترق الكتاب والعترة في النهاية، فكذلك لن يفترقا في البداية، ولمثل هذا قال النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «أوّل ما خلق الله نوري»، واشتقّ من نوري نور عليّ، ثمّ نور فاطمة الزهراء والأئمة (عليهم السلام)، فكانوا في عالم الأنوار والأرواح قبل خلق آدم، فجعلهم الله أنواراً بعرشه محدقين، فرتبة القرآن العيني وزان رتبة القرآن العلمي، وكما إنّهما في أصل الوجود متكافئان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر، كذلك في رتبة الوجود أيضاً لا يفترق أحدهما عن الآخر، فعند ثبوت وصف كمالي لأحدهما بالمطابقة، يحكم بثبوت ذلك الوصف للآخر بالالتزام، مثلا عند ثبوت تعدّد أنحاء الدعوة للقرآن العلمي، وأنّه يدعو الناس إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، يحرز بأنّ أنحاء دعوة القرآن العيني أيضاً كذلك، وكما أنّ القرآن العلمي يهدي للتي هي أقوم، كذلك القرآن العيني ـ أي المعصوم (عليه السلام) ـ يهدي للطريقة المثلى التي هي أقوم الطرق والعروة الوثقى التي هي أوثق العُرى» (8).
فالإنسان الكامل المعصوم (عليه السلام) ـ أي الإمام ـ قرآن عينيّ كما أنّ القرآن إمام علميّ، فلذا يدعو كلّ واحد منهما الناس إلى صاحبه، يعني أنّ القرآن يدعوهم إلى إمامة الإمام وإطاعته كما قال سبحانه :(يا أيُّها الذَّينَ آمَنوا أطيعوا اللهَ وَأطيعوا الرَّسولَ وَاُولي الأمْرِ مِنْكُمْ) (9)، كذلك الإمام الرضا (عليه السلام) يقول حول القرآن الكريم: «لا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا»، فكلّ ما في القرآن هو عند العترة الطاهرة، وكلّ ما عندهم هو في القرآن، فإنّهما لن يفترقا، في مبدئهما ومنتهاهما، ولا ينفكّان في الأوصاف الكمالية، وهما مظهران لله الذي ليس كمثله شيء، وإنكارهما والإعراض عنهما جاهلية، وهما ميزان الأعمال، وإذا كان القرآن العلمي يزداد غضاضة في كلّ عصر :{وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَألـْتُموهُ} (10).
فكذلك العترة الطاهرة، أئمّة الحقّ المعصومون (عليهم السلام)، وإذا كان القرآن مصاحباً للحقّ من مبدأ ظهوره وصدوره إلى منتهى نزوله وهبوطه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنّه حيّ لا يموت، فهو المظهر التامّ لله سبحانه، فهو في كلّ زمان جديد وعند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة، كذلك العترة الطاهرة (عليهم السلام)، وهما مظهران تامّان للاسم المهيمن، وحيث إنّ الإمام المعصوم قرآن ممثّل يوجد في كلماته محكمات ومتشابهات كالقرآن العلمي، فهما نور إلهي متنزّل من الله سبحانه، وإنّ الإنسان الكامل الإمام المعصوم إنّما هو ترجمان القرآن الكريم، فلا يصحّ الفرق بينهما بأن يقال: «حسبنا كتاب الله» أو: حسبنا ما جاء عن العترة الطاهرة، ويتمسّك بأحدهما دون الآخر، إذ كلّ واحد من دون الآخر بمنزلة تركهما معاً، فلا يجوز التفريط والإفراط فيهما، فكلّ واحد منهما جاهلية جهلاء، فالحياة العقلية اتّباعهما كما جاء في حديث الثقلين: «إنّي تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(11).
فخلق الإنسان إنّما كان بين علمين وبين قرآنين، وهذا إنّما يدلّ على كرامة الإنسان وفضيلته وشرافته على جميع المخلوقات :{وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ} (12).
ثمّ هدى الله الإنسان النجدين: نجد الخير ونجد الشرّ، وجعل فيه الاختيار والقدرة، فإمّا أن يكون كفوراً، وكان جهولا عجولا، وإمّا أن يكون شاكراً عالماً صبوراً.
وقد أتمّ الله الحجّة عليه، بحجّة ظاهرية، وهم الأنبياء والكتب السماوية والعلماء الصالحين، وبحجّة باطنية وهو العقل والفطرة :{وَللهِ الحُجَّةُ البالِغَةُ} (13).
فبعث الله (124) ألف نبيّ ـ كما جاء في رواياتنا ـ لهداية الإنسان وتربيته، وليقيموا بين الناس بالقسط، وليخرجونهم من الظلمات إلى النور.
فأوّل الأنبياء آدم أبو البشر (عليه السلام)، وآخرهم خاتم النبيّين وسيّد المرسلين محمّد (صلى الله عليه وآله).
فجاء بدين الإسلام الحنيف للناس كافّة، إلى يوم القيامة :{لِيُظْهِرَهُ عَلى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكونَ} (14).
والإسلام إنّما هو مجموعة قوانين إلهيّة ـ اُصول وفروع ـ وضعها الله سبحانه لسعادة الإنسان، وتعديل وتنظيم حياته الفردية والاجتماعية في كلّ المجالات والميادين، إلاّ أنّ الطابع العامّ على الإسلام أنّه مدرسة أخلاقية وجامعة تربويّة، فإنّ حدود الإسلام هي مكارم الأخلاق، حيث حدّده النبيّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) بفلسفة بعثته في قوله: «بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»، وبهذا حدّد حقيقة الإسلام والاُمّة المسلمة. فالإسلام مدرسة (مكارم الأخلاق)، وجهاده الأكبر جهاد النفس الأمّارة بالسوء، والعالم بالله العارف بدينه هو المحور في ساحة الجهاد الأكبر وعليه تدور رحاها، فالعلماء والصلحاء إنّما تشكّل سيرتهم امتداداً حقيقياً لصاحب الخلق العظيم محمّد (صلى الله عليه وآله)، فهم القدوة والنماذج الصالحة التي يجب على الأمّة التواصل معها والاهتداء بهديها.
وإنّ الله جلّ وعلا لم يمنّ على الإنسان، لا سيّما المؤمن بما تنعّم عليه من النعم الظاهرية والباطنية :{وَإنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللهِ لا تُحْصوها} (15).
إلاّ في موردين كما في كتابه الكريم:
الأوّل: ختم النبوّة بسيّد الأنبياء وأشرف خلق الله محمّد (صلى الله عليه وآله)، وإنّما أُرسل في عصر الجاهلية الأُولى لينقذ البشرية من الجهل والضلال، فكانت رسالته السماوية مطلع نور في اُفق الإنسانية، وإنّما جاء ليزكّي المؤمنين ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وهذا يعني أنّ حقيقة كمال المؤمن وبلوغه المقامات العالية والدرجات الرفيعة، حتّى يكون عند مليك مقتدر في مقعد صدق، إنّما هو بالتزكية والعلم، فيحلّق الإنسان بهذين الجناحين في آفاق السعادة الأبدية، وإنّما قدّمت التزكية ربّما لبيان أهمّيتها وعظمة رتبتها، وإلاّ فإنّ الإنسان لا بدّ له في سيره التكامليّ الإنسانيّ الإلهيّ من التزكية والعلم سويّةً ومعاً.
فالله سبحانه منّ على المؤمنين بهذه النعمة العظمى ـ في بداية الإسلام ونشره ـ في الجاهليّة الاُولى، الجاهليّة الجهلاء التي كانت عن جهل، كما في قوله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلى المُؤْمِنينَ إذْ بَعَثَ فيهِمْ رسولا مِنْ أنْفُسِهِمْ يَتْلو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمَهُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَإنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلال مُبين} (16).
الثاني: ظهور خاتم الأوصياء المهدي والقائم من آل محمّد (عليهم السلام)، فإنّه سيظهر بعد الجاهلية الثانية التي تكون عن علم :(أفَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلـهَهُ هَواهُ فَأضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلـْم) (17) ويكون ذلك في آخر الزمان، ليملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. فالله سبحانه وعد المؤمنين ومنّ عليهم بهذه النعمة العظمى، بأنّ الدين الإسلامي سيكون هو الحاكم على الأرض، وتكون الحكومة العالمية بيد المؤمنين عباد الله الصالحين، كما في قوله تعالى :{وَنُريدُ أنْ نَمُنَّ عَلى الَّذينَ اسْتُضْعِفوا في الأرْضِ وَنَجْعَلـْهُمْ أئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوارِثينَ} (18) ثمّ الآية الاُولى تبيّن سبب الرسالة الإسلامية ومحتواها :(يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمَهُمُ) فإنّها عبارة عن التزكية والتعليم.
ومن لطف الله سبحانه حيث خلق الإنسان، وكلّفه ليعرّضه إلى الثواب والنعيم الأبدي، قد أودع فيه الخمرة الاُولى ورأس المال الأوّلي لتزكيته وتربيته، وذلك عبارة عن (الإلهام) إلهام عامّ يتعلّق بالخير والشرّ، فعرّفه في فطرته وعقله وروحه ونفسه وقلبه، أوّلا التقوى والفجور، ثمّ كمّل وعضد ذلك الإلهام ببعث الأنبياء وأوصيائهم وورثتهم من العلماء الصالحين، فقال سبحانه: {فَألـْهَمَها فُجورَها وَتَقْواها * قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها * وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها} (19) وهذا من تمام الحجّة الإلهيّة البالغة، فتدبّر. فلا مفرّ بعدئذ يوم القيامة من حكومة الله جلّ جلاله، ولا يمكن الفرار من حكومتك.
فكلّ واحد بفطرته السليمة الموحّدة يعرف الخير من الشرّ، والصالح من الطالح، والسقيم من الصحيح، والباطل من الحقّ. ولا بدّ أن يتحرّك هو أوّلا في تهذيب نفسه وصيقلة قلبه، ثمّ لا بدّ له من إرشاد الحكيم ـ فإنّه كما ورد في الخبر الشريف: هلك من لم يكن له حكيمٌ يرشده ـ وهداية النبيّ إنّما تكون بمنزلة السائق والقائد، وكلامه الحقّ بمنزلة وقود لديمومة الحركة وتسريعها.
فخلاصة الإسلام وجوهريّته هو الأخلاق ـ تخلّقوا بأخلاق الله، كما عن الإمام الصادق (عليه السلام) ـ حتّى عُدّ الأخلاق وعلمه من أهمّ الواجبات الإسلامية؛ لأنّ الله إنّما يقسم في كتابه على ما كان بالغ الأهميّة، ولم يقسم على شيء كما أقسم على الأخلاق، فإنّه في سورة الشمس بعد أحد عشر قسماً، يشير إلى عظمة الأخلاق والتزكية في قوله تعالى: {قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها * وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها}.
ولولا حسن الخلق لما كان الإنسان ينتفع ـ كما هو المطلوب ـ من عقائده الصحيحة ـ علم الكلام ـ ومن صلاته وصومه وغير ذلك ـ علم الفقه ـ وهذه العلوم الثلاثة إنّما هي من علوم الآخرة كما ورد في الحديث النبويّ الشريف: «إنّما العلم ثلاثة: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنّة قائمة».
وقد ورد في الحديث الشريف: «إنّ الله يحبّ الكافر السخيّ، ويبغض المؤمن البخيل»،
أي إنّه يحبّ عمل الكافر وهو السخاء لا ذاته، كما إنّه يبغض عمل البخل حتّى لو كان ذلك من المؤمن، وما أكثر من كانوا يحملون صفات طيّبة كانت سبباً لهدايتهم وتوبتهم وتوجّههم إلى الله سبحانه، وكم من صالح في بداية أمره، إلاّ أنّه هلك وأصبح من الأشقياء ومن زمرة الظالمين، لما يحمل من صفات ذميمة، فحبط عمله وانحرف عن الصراط المستقيم، واستهواه الشيطان واستحوذ عليه {اللهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ وَالَّذينَ كَفَروا أوْلِيائُهُمُ الطَّاغوتُ يُخْرِجونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُماتِ} (20) ومن تفسيرها أنّهم يخرجونهم من نور الأخلاق الحميدة إلى ظلمات الأخلاق السيّئة.
وبنظري أهمّ العلوم إنّما هو علم الأخلاق، وإنّ جميع القيم والمثل العليا والعلوم النافعة، ترتكز على محور تزكية النفس. وإذا لم يتمّ غسل القلب وتطهيره من الصفات الذميمة والسجايا الرذيلة والخبائث النفسية، فإنّه لن يكون باستطاعة شيء حتّى العلم أن ينجّي الإنسان، بل من لم يهذّب نفسه، لم ينفعه العلم، وإنّما يكون عليه وبالا، ويكون هو الحجاب الأكبر، ولم يزدد بعلمه من الله إلاّ بعداً، ويسلب منه حلاوة المناجاة كما ورد في الروايات الشريفة... وحدّثنا سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد محمّد رضا الگلپايگاني (قدس سره) في درس خارج الفقه كتاب القضاء سنة 1401، قال :كان في السنين السابقة معمّماً وصل إلى درجة الاجتهاد، وحين الاحتضار وهو على فراش الموت، زاره زميله في الدراسة وكان من مراجع التقليد في زمانه، فأخذ يلقّن زميله بالشهادتين، إلاّ أنّ صاحبه كان يمتنع من ذلك، فتعجّب من أمره، وألحّ في تلقينه، ولكن ما كان من صاحبه إلاّ الإباء والامتناع، وفي آخر الأمر طلب ذلك المجتهد الشقيّ ـ الذي كان يتصارع مع الموت ـ القرآن، فجيء به، ففتح ذلك، ثمّ قال لزميله : يا هذا، هل تذكر أيّام تحصيلنا في بداية شبابنا؟ فقال له: نعم، أذكر ذلك. فقال له: مَن كان أعلم وأفهم من الآخر، أنا أم أنت؟ فقال له: أنت كنت أفهم منيّ لتلقيّ الدرس واستيعابه وحفظه. وهكذا كان يسأله عن سيره الدرسي، وصاحبه يقول: كنت أنت أعلم منيّ. فقال له في آخر الأمر: ولكن وصلت المرجعيّة إليك، ولم تصل إليَّ، وهذا يعني أنّ الله ظلمني. ثمّ بصق في القرآن الكريم ومات من دون الشهادتين.
نسأل الله أن يجعل عواقب اُمورنا خيراً.
ولا شكّ أنّه مات كافراً، وهذا نتيجة عدم التهذيب من اليوم الأوّل في كسب العلوم، فإنّ هدفه كان الوصول إلى الجاه والمقام الدنيوي. وكان سيّدنا الاُستاذ (قدس سره) يحدّثنا بهذه القصّة المرعبة والرهيبة لتصحيح النوايا من بداية الأمر، وإلاّ فإنّ ما يبطنه الإنسان مهما أراد إخفائه فإنّه يظهر عند موته، والعياذ بالله. نسأل الله حسن العاقبة، ولا بدّ للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، فهما نوران في قلبه لو وزن هذا على هذا لم يزدد أحدهما على الآخر.
وما أكثر الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تذمّ علماء السوء أصحاب الدنيا والجاه والمقام الذين لم يهذّبوا أنفسهم ولم يجاهدوها ـ وهو الجهاد الأكبر ـ ويقول أمير المؤمنين على (عليه السلام): «قصم ظهري اثنان: عالمٌ متهتّك، وجاهل متنسّك، فالجاهل يغشّ الناس بتنسّكه والعالم يغرّهم بتهتّكه» (21).
فلا بدّ من الأخلاق ومكارمها ومعاليها، وإنّما يحصل عليها الإنسان لا سيّما طالب العلم بالجهاد الأكبر، أي محاربة النفس الأمّارة بالسوء (بالتخلية والتحلية والتجلية التي تعدّ هذه المراحل الثلاثة خلاصة علم الأخلاق والسير والسلوك).
(فينبغي لطالب العلم ألّا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرّها في أوّلها وآخرها فيستجلب بما ينفعها، ويتجنّب عمّـا يضرّها لئلاّ يكون عقله وعلمه حجّة عليه فيزداد عقوبة) (22).
ثمّ العلم النافع الحقّ، إنّما هو معرفة سلوك الطريق إلى الله سبحانه وقطع عقبات القلب التي هي الصفات الذميمة، وهي الحجاب بين العبد وربّه سبحانه وتعالى.
قال الشهيد الثاني في كتابه القيّم «منية المريد في أدب المفيد والمستفيد»:
«اعلم أنّ العلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، والغرض من الشجرة المثمرة ليس إلاّ ثمرتها، أمّا شجرتها بدون الاستعمال، فلا يتعلّق بها غرض أصلا، فإنّ الانتفاع بها في أيّ وجه كان ضرب من الثمرة بهذا المعنى. وإنّما كان الغرض الذاتي من العلم مطلقاً العمل؛ لأنّ العلوم كلّها ترجع إلى أمرين: علم المعاملة، وعلم المعرفة. فعلم المعاملة هو معرفة الحلال والحرام ونظائرهما من الأحكام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة، وكيفيّة علاجها والفرار منها، وعلم المعرفة كالعلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، وما عداهما من العلوم إمّا آلات لهذه العلوم أو يراد بها عمل من الأعمال في الجملة، كما لا يخفى على من تتبّعها، وظاهر أنّ علوم المعاملة لا تراد إلاّ للعمل، بل لولا الحاجة إليه لم يكن لها قيمة» (23).
ثمّ الشهيد الثاني (قدس سره) في كتابه (المنية) بعد أن يذكر فضل العلم من القرآن الكريم والنبيّ الأكرم وأهل بيته الأطهار وما جاء في الكتب السالفة والحكم القديمة والدليل العقلي الدالّ على ذلك، وأنّ آداب العلم تارة باعتبار اشتراك المعلّم والمتعلّم فيها، واُخرى باعتبار ما يختصّ بالمعلّم، ثمّ ما يختصّ بالمتعلّم، فيقول في الآداب التي اشتركا فيها وهي قسمان: آدابهما في أنفسهما وآدابهما في مجلس الدرس، والقسم الأوّل فيه اُمور أوّلها: ما يجب عليهما من إخلاص النيّة لله تعالى في طلبه وبذله، فإنّ مدار الأعمال على النيّات، وبسببها يكون العمل تارةً خَزَفة لا قيمة لها، وتارةً جوهرة لا يُعلم قيمتها لِعِظم قدرها، وتارة وبال على صاحبه مكتوب في ديوان السيّئات، وإن كان بصورة الواجبات.
فيجب على كلّ منهما أن يقصد بعلمه وعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه، وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميّز عن الأشباه أو المفاخرة للأقران أو الترفّع على الإخوان ونحو ذلك، من الأغراض الفاسدة التي تثمر الخذلان من الله تعالى، وتوجب المقت، وتفوّت الدار الآخرة والثواب الدائم فيصير من :{الأخْسَرينَ أعْمالا الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبونَ أنَّهُمْ يُحْسِنونَ صُنْعاً} (24).
والأمر الجامع للإخلاص تصفية السرّ عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة.
ثمّ يذكر معنى الإخلاص وما ورد فيه من الآيات والروايات من الفريقين، لا سيّما في طلب العلم ويقول: هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص، عظيمة المقدار كثيرة الأخطار دقيقة المعنى صعبة المرتقى، يحتاج طالبها إلى نظر وتدقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامّة، وكيف لا يكون كذلك، وهو مدار القبول وعليه يترتّب الثواب، وبه تظهر ثمرة عبادة العابد، وتعب العالم وجدّ المجاهد.
ثمّ يتعرّض إلى الأمر الثاني وهو أنّ الغرض من طلب العلم هو العمل، ويبيّن ما يوجب غرور أهل العلم، وذلك من خلال الآيات والروايات.
ويقول: ولكلّ واحد منهما ـ الإخلاص والعمل ـ شرائط متعدّدة ووظائف متبدّدة بعد هذين، إلاّ أنّها بأسرها ترجع إلى الثاني ـ أعني استعمال العلم ـ فإنّ العلم متناول لمكارم الأخلاق وحميد الأفعال والتنزّه عن مساوئها، فإذا استعمله على وجهه، أوصله إلى كلّ خير يمكن جلبه، وأبعده عن كلّ دنيّة تشينه (25).
ثمّ يذكر التوكّل على الله والاعتماد عليه، ثمّ آدابهما واشتغالهما من الاجتهاد في طلب العلم، وألا يسأل أحداً تعنّتاً وتعجيزاً، وألا يستنكف من التعلّم والاستفادة ممّن هو دونه في منصب أو سنّ أو شهرة أو دين أو في علم آخر، ثمّ الانقياد للحقّ والرجوع عند الهفوة، ولو ظهر على يد من هو أصغر منه، ثمّ يتأمّل ويهذّب ما يريد أن يورده أو يسأل عنه، وألا يحضر مجلس الدرس إلاّ متطهّراً من الحدث والخبث، متنظّفاً متطيّباً في بدنه وثوبه.
ثمّ يذكر الآداب المختصّة بالمعلّم، كأن لا ينتصب للتدريس حتّى تكمل أهليّته، وألّا يذلّ العلم فيبذله لغير أهله، وأن يكون عاملا بعلمه، وزيادة حسن الخلق فيه، والتواضع وتمام الرفق وبذل الوسع في تكميل النفس، وألّا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيّة. ثمّ بذل العلم عند وجود المستحقّ وعدم البخل به، وأن يحترز من مخالفة أفعاله لأقواله وإن كانت على الوجه الشرعي، ثمّ إظهار الحقّ بحسب الطاقة، من غير مجاملة لأحد من خلق الله تعالى.
ثمّ يذكر الشهيد عليه الرحمة آداب المعلّم مع تلامذته بأن يؤدّبهم على التدريج بالآداب السنيّة، والشيم المرضيّة، ورياضة النفس بالآداب الدينيّة، والدقائق الخفيّة، ويعوّدهم في جميع اُمورهم الكامنة والجليّة، سيّما إذا آنس منهم رشداً، كدعوتهم إلى الإخلاص، وترغيبهم في طلب العلم والعمل به، وأن يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشرّ، وأن يزجره عن سوء الأخلاق وارتكاب المحرّمات والمكروهات، وأن لا يتعاظم على المتعلّمين، وإذا غاب أحدهم زائداً على العادة يسأل عنه وعن أحواله وموجب انقطاعه، وأن يستعلم أسماء طلبته وحاضري مجلسه وأنسابهم وكناهم ومواطنهم وأحوالهم، ويكثر الدعاء لهم، وأن يكون سمحاً ببذل ما حصّله من العلم، ثمّ صدّ المتعلّم أن يشتغل بغير الواجب قبله، وأن يكون حريصاً على تعليمهم باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أفهامهم وأذهانهم، وأن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الفنّ، وأن يحرّضهم على الاشتغال في كلّ وقت، ويطالبهم في أوقات إعادة محفوظاتهم وأن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل الدقيقة والنكت الغريبة، وأن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودّة واعتناء مع تساويهم في الصفات، وأن ينصفهم في البحث، وأن يقدّم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، وأن يوصي طلاّبه بالرفق فيما لو طلبوا فوق طاقتهم، وأن لا يقبّح العلوم التي لم يتعلّمها، وأن لا يتأذّى ممّن يقرأ على غيره ويحضر عنده، ثمّ يمدح من كان من أهل العلم بعد إكمال دراسته وأهليّته للاستفادة منه ويأمر الناس بالاشتغال عليه والأخذ منه.
ثمّ يذكر الشهيد آداب الدرس وهي عبارة عن ثلاثين أدباً، ثمّ يتعرّض إلى الآداب المختصّة بالمتعلّم وهي تنقسم كما مرّ ثلاثة أقسام: آداب في نفسه، وآداب مع شيخه، وآدابه في مجلس درسه.
والمقصود من رسالتنا هذه إنّما هو القسم الأوّل، فيذكر فيه اُموراً ثمانية (26)، إنّما اُشير إليها، متمسّكاً بعروة (خير الكلام ما قلّ ودلّ) طلباً للاختصار، كما أضفت عليها ثمانية اُخرى ليكون المجموع ستّة عشر خصلة وخُلق، لا بدّ لطالب العلم أن يراعيها في سيره الأخلاقي، مستعيناً بالله سبحانه، ومتوسّلا برسوله (صلى الله عليه وآله) وعترته (عليهم السلام)، والله تعالى خير ناصر ومعين (27).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الرحمن: 1 ـ 3.
(2) يس: 12.
(3) النبأ: 29.
(4) النحل: 44.
(5) آداب المتعلّمين جامع المقدّمات 2: 51.
(6) لقد ذكرت تفصيل مصادر الحديث الشريف بين الفريقين السنّة والشيعة والمقارنة بين القرآن والعترة في رسالة (في رحاب حديث الثقلين)، فراجع.
(7) القلم: 4.
(8) علي بن موسى الرضا والقرآن الكريم: 31.
(9) النساء: 59.
(10) إبراهيم: 34.
(11) المصدر: 41، عن مسند الإمام الرضا (عليه السلام) 1: 106.
(12) الإسراء: 70.
(13) الأنعام: 149.
(14) التوبة: 33.
(15) إبراهيم: 34.
(16) آل عمران: 164.
(17) الجاثية: 23.
(18) القصص: 5.
(19) الشمس: 8.
(20) البقرة: 252.
(21) منية المريد: 181.
(22) آداب المتعلّمين، جامع المقدّمات 2: 50.
(23) منية المريد، تحقيق رضا المختاري : 150، ويضمّ الكتاب على مقدّمة في فضل العلم من الكتاب والسنّة والأثر ودليل العقل، وعلى أبواب أربعة : الأوّل في آداب المعلّم والمتعلّم، والثاني في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، والثالث في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها، والرابع في آداب الكتابة وما يتعلّق بها، والخاتمة في مطالب مهمّة في أقسام العلوم الشرعيّة والفرعيّة وغيرها، وتتمّة الكتاب في نصائح مهمّة لطلاّب العلوم، فراجع، فإنّه قد أوصى السلف الصالح من علمائنا الأعلام بمدارسة ومطالعة هذا الكتاب القيّم ولو لعشر مرّات، بل قيل في كلّ سنة مرّة، حتّى من وصل إلى درجة الاجتهاد بل والمرجعيّة، فإنّه لا يستغني عن هذا الكتاب وعن الموعظة والنصيحة.
(24) الكهف: 103 ـ 104.
(25) المنية: 159.
(26) منية المريد: 224 ـ 233، أذكر خلاصة ذلك مع تصرّف وإضافات وبعض قصص العلماء في مراعاة الأخلاق وتهذيب النفس.
(27) خلاصة هذه الرسالة كانت على شكل محاضرات أخلاقيّة ألقيتها في حوزة الإمام الخميني (قدس سره) للطلبة الحجازيّين بقم المقدّسة، في شهر رمضان المبارك سنة 1416 ه.



|
|
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|