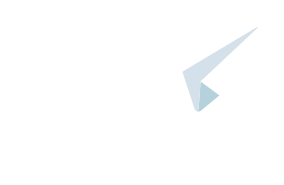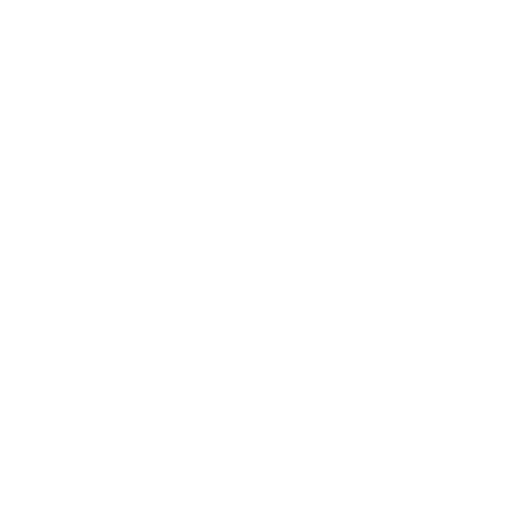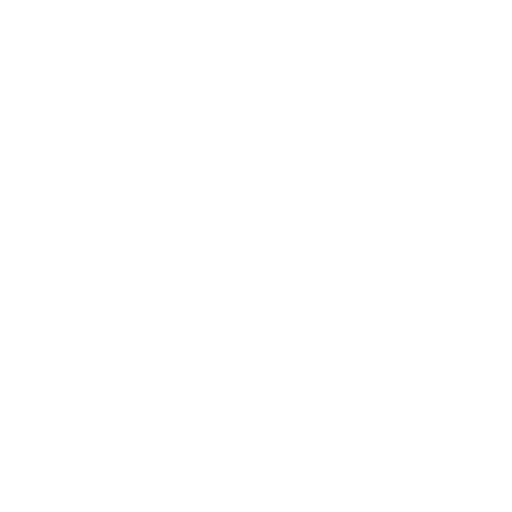1


الأدب


الشعر

العصر الجاهلي

العصر الاسلامي

العصر العباسي

العصر الاندلسي

العصور المتأخرة

العصر الحديث

النثر


النقد

النقد الحديث

النقد القديم


البلاغة

المعاني

البيان

البديع

العروض

تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
الإفراط في الصفة (المبالغة)
المؤلف:
إبن أبي الإصبع
المصدر:
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر
الجزء والصفحة:
ص16-19
25-09-2015
9974
وهو
الذي سماه قدامة المبالغة، وسماه من بعده التبليغ، وأكثر الناس على تسمية قدامة،
لأنها أخف وأعرف، ومن أناشيد ابن المعتز فيها: [كامل]
ملك تراه إذا احتبى بنجاده ... غمر الجماجم والصفوف قيام
وحد قدامة المبالغة بأن قال: هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال لو وقف عندها لأجزأت، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ما يكون أبلغ في معنى قصده، كقول عمرو بن الأهتم التغلبي [وافر]:
ونكرم جارنا ما دام فينا ... ونتبعه الكرامة حيث مالا
وأنا أقول: قد اختلف في المبالغة، فقوم يرون أن أجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه، ويحتجون بما جرى بين النابغة الذبياني وبين حسان في استدراك النابغة عليه تلك المواضع في قوله [طويل]:
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
فإن النابغة إنما عاب على حسان ترك المبالغة، والقصة مشهورة، والصواب مع حسان، وإن روى عنه انقطاعه في يد النابغة، وقوم يرون المبالغة من عيوب الكلام، ولا يرون من محاسنه إلا ما خرج مخرج الصدق، وجاء على منهج الحق، ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنى مبتكراً، أو يفرع معنى من معنى، أو يحلى كلامه بشيء من البديع، أو ينتخب ألفاظاً موصوفة بصفات الحسن، ويجيد تركيبها، فإذا عجز عن ذلك كله أتى بالمبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، لما فيها من التهويل على السامع، ويدعون أنها ربما أحالت المعاني فأخرجتها من حد الإمكان إلى حد الامتناع.
وعندي أن المذهبين مردودان.
أما الأول فلقول صاحبه: إن خير الكلام ما بولغ فيه، وهذا قول من لا نظر له، لأنا نرى أن أكثر الكلام والأشعار جارياً على الصدق، خارجاً مخرج الحق، وهو في غاية الجودة ونهاية الحسن وتمام القوة، كيف لا والمبالغة ضرب واحد من المحاسن، والمحاسن لا تنحصر ضروبها، فكيف يقال: إن هذا الضرب على انفراده يفضل سائر المحاسن على كثرتها؟ وهذا شعر زهير والحطيئة وحسان ومن كان مذهبه توخي الصدق في شعره غالباً ليس فوق أشعارهم غاية لمترق، ألا ترى إلى قول زهير [طويل]:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم
والى قول طرفة [طويل]:
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه في اليد
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود
والى قول الحطيئة [بسيط]:
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس
فإنك تجد هذه الأشعار في الطبقة العليا من البلاغة وإن خلت من المبالغة. والذي يدل على أن مذهب أكثر الفحول ترجيح الصدق في أشعارهم على الكذب ما روى عن الحرورية امرأة عمران بن حطان الخارجي أنها قالت له يوماً: أنت أعطيت الله عهداً ألا تكذب في شعرك، فكيف قلت [كامل مجزوء]:
فهناك مجزءة بن ثو ... ر كان أشجع من أسامه
فقال: يا هذه إن هذا الرجل فتح مدينة وحده، وما سمعت بأسد فتح مدينة قط. وهذا حسان يقول [بسيط]:
وإنما الشعر لبُّ المرء يعرضه ... على المجالس إن كيساً وإن حمقا
وإن أشعر بيتٍ أنت قائله ... بيت يقال إذا أنشدته: صدقا
على أن هؤلاء الفحول وإن رجحوا هذا المذهب لا يكرهون ضده، ولا يجحدون فضله، وقلما تخلو بعض أشعارهم منه، إلا أن توخى الصدق كان الغالب عليهم، وكانوا يكثرون منه، ومن أكثر من شيء عرف به، كما أن النابغة ومن شايعه على مذهبه لا يكره ضد المبالغة، وإلا فكل احتجاجاته على النعمان في الاعتذار جار مجرى الحقيقة، كقوله [طويل]:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ... وليس وراء الله للمرء مذهب
فعائب الكلام الحسن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على الإطلاق غير مصيب، وخير الأمور أوساطها، وكيف تعاب المبالغة وقد وجدت في الكتاب العزيز على ضروب: منها المبالغة في الصفة المعدولة من الجارية لمعنى المبالغة فإنها جاءت على ستة أمثلة: فعلان كرحمان، عدل عن راحم للمبالغة ولا يوصف به إلا الله تعالى، لأن رحمته وسعت كل شيء، وفعال معدول عن فاعل للمبالغة كقوله تعالى: (لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ)، (تَوَّابٌ رَحِيمٌ)، (عَلَّامُ الْغُيُوبِ)، (فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ)، وفعول عدل عن فاعل للمبالغة كغفور و شكور و ودود ، وفعيل عدل عن فاعل، كرحيم و حكيم و عليم و قدير و سميع و بصير ومفعل معدول عن فاعل كمدعس و مطعن ، ومفعال معدول عن فاعل للمبالغة كمطعام و مطعان .
والضرب الثاني من المبالغة وهو ما جاء بالصيغة العامة في موضع الخاصة كقولك: أتاني الناس كلهم، ولم يكن أتاك سوى واحد أردت تعظيمه، ومن هذا الضرب قول أبي نواس [سريع]:
وليس لله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد
ومن هذا الضرب في الكتاب العزيز قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فوعدهم سبحانه بجزاء غير مقدر، لمجيئه بالصيغة العامة تعظيماً له (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) والضرب الثالث من المبالغة إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة، والإخبار عنه مجاز، كقول من رأى موكباً عظمياً أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسه وهو يعلم حقيقة أن ما جاء جيشه، وقد جاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) فجعل مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه، وكقوله تعالى: (وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) فجعل نقله بالهلكة من دار العمل إلى دار الجزاء وجداناً للمجازى.
والضرب الرابع من المبالغة إخراج الممكن من الشرط إلى الممتنع، ليمتنع وقوع المشروط، كقوله تعالى: (وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ).
والضرب الخامس من المبالغة ما جرى مجرى الحقيقة، وهو قسمان: قسم كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة، كقوله تعالى: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) فإن اقتران هذه الجملة بيكاد صرفها إلى الحقيقة فانقلبت من الامتناع إلى الإمكان.
وقسم أتى بصيغة أفعل التفضيل، وهو محض الحقيقة من غير قرينة كقوله تعالى: (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا).
والضرب السادس من المبالغة ما بولغ في صفته بطريق التشبيه، كقوله تعالى: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ *كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ) فهذه ضروب ما ورد من المبالغة في الكتاب العزيز.
والمبالغة تأتي في الكلام على ضربين: ظاهرة ومدمجة، وكل ما قدمناه من مبالغات الكتاب العزيز من الظاهرة.
ومن المدمجة قوله تعالى: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ) فإن المبالغة أتت في هذه الآية مدمجة في المقابلة، والجواب: هذه المبالغة بالنسبة إلى المخاطَب إلى المخاطِب وقد جاء منها في سنة الرسول صلى الله عليه[وآله] وسلم ما لا يحصى كثرة، ولا يلحق بلاغة، كقوله عليه السلام مخبراً عن ربه أنه قال سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به وقوله في بقية هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . ففي هذا الحديث مبالغتان: أحداهما كون الحق سبحانه أضاف الصيام إلى نفسه دون سائر الأعمال لقصد المبالغة في تعظيمه وتشريفه، وأخبر أنه عز وجل يتولى مجازاة الصائم بنفسه، مبالغة في تعظيم الجزاء وشرفه، ونحن نعلم أن الأعمال كلها لله سبحانه ولعبده باعتبارين: أما كونها للعبد فلأنه يثاب عليها، وأما كونها لله تعالى فلأنها عملت لوجهه الكريم، ومن أجله فتخصيص الصيام من بينها بالإضافة إلى الرب سبحانه، وتخصيص ثوابه بما خصصه به إنما كان للمبالغة في تعظيمه والحض عليه، والمبالغة الثانية إخبار الرسول صلى الله عليه[وآله] وسلم بعد تقديم القسم لتأكيد الخبر بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ففضل تغيير فم الصائم بالإمساك عن الطعام والشراب على ريح المسك الذي هو أطيب الطيب على مقتضى ما يفهم من ريح المسك وريح تغير فم الصائم، وأتى المعنى بصيغة أفعل للمبالغة، فجمع هذا الكلام بين قسمي المبالغة المجازي والحقيقي.
ومن أمثله المبالغة في الشعر قول امرئ القيس [طويل]:
فعادى عداء بين ثور ونعجة ... دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل
فإنه أخبر عن هذا الفرس أنه أدرك ثوراً وبقرة وحشية في مضمار واحد، ولم يعرق، ومثله قول أبي الطيب [طويل]:
وأصرع أي الوحش قفيته به ... وأنزل عنه مثله حين أركب
وما يعاب من المبالغة إلا ما خرج به الكلام عن حد الإمكان إلى الاستحالة وأما إذا كان كقول قيس بن الخطيم [طويل]:
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ... لها نفذ لولا الشعاع أضاءها
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها ... يرى قائماً من دونها ما وراءها
فإن ذلك من جيد المبالغة إذا لم يكن خارجاً مخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة، وما سمعت ولا غيري بمستمع مثل قول أبي تمام [بسيط]:
تكاد تنتقل الأرواح لو تركت ... من الجسوم إليها حين تنتقل
فإنه لم يقنع في تصحيح المبالغة وقربها من الوقوع، فضلاً عن الجوار بتقديم كاد حتى قال: لو تركت؛ وهذا أصح بيت سمعته في المبالغة وأحسنه وأبلغه، وكقول شاعر الحماسة حيث بالغ في مدح ممدوحه بقوله [طويل]:
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره ... وما فوق شكري للشكور مزيد
ولو كان مما يستطاع استطعته ... ولكن ما لا يستطاع شديد
فإن هذا الشاعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصوره عن شكر بر هذا الممدوح، وفطن إلى أنه لو اقتصر على ذلك لقيل له: عجزك عن شكر هذا الرجل لا يدل على كثرة بره، وإنما يدل على ضعف مادتك عن الشكر إذ لا يلزم من عجز الإنسان عن شيء تعظيم ذلك الشيء على الإطلاق، لاحتمال أن يكون العجز لضعف في الإنسان فاحترس عن ذلك بقوله:
وما فوق شكري للشكور مزيد
ثم تمم المعنى بأن قال: للشكور أي للمبالغ في الشكر، لأن شكور معدول عن شاكر للمبالغة كما تقدم ثم أظهر عذره في عجزه مع قدرته بأن قال في البيت الثاني:
ولو كان مما يستطاع استطعته
ثم أخرج بقية البيت مخرج المثل السائر حيث قال:
ولكن ما لا يستطاع شديد
فهذا أبلغ شعر سمعته في هذا المعنى لجودة مفردات ألفاظه، وسهولة سبكه ومساواة لفظه لمعناه، ومتانة مبناه، وكثرة معانيه، وصحة المبالغة فيه؛ فإن قيل: لم بالغت في وصف هذا الشعر وهو عندك داخل في القسم المعيب من المبالغة لكونه أخرج الكلام من حد الإمكان إلى حد الامتناع حيث جعل شكر هذا الممدوح لا يستطاع؟ فإني أقول: ليس كل بر يمكن شكره، ولا يقوم المدح بحقه، فإنا لو قدرنا أن إنساناً فك إنساناً من الأسر واستنقذه من القتل لما وفى شكره ببره ولو كان أشكر الناس، واستنفد في شكره بقية عمره، لا سيما لو قدر أن ذلك الممتن ببقاء النفس أضاف إلى ذلك توابع إحسان، وعوارف امتنان، على ممر الزمان، فإن الشكر لا يقوم ببر ذلك الإنسان، ولو تجاوز فيه الشكور حد الإمكان، فقد وضح أن من البر ما لا يؤدي شكره، ومن هذا قول أبي نواس:
لا تسدين إلى عارفة ... حتى أقوم بشكر ما سلفا
وهذا سيد المرسلين الذي بعث بجوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد بقول لعظمة نعم ربه عليه: لا أحصى ثناء عليك . ومعلوم أن نعم الله سبحانه لا يقوم شكر جميع العباد بمعشارها، ولا كذلك نعم بعضهم على بعض لكن يشبه شكر أحدنا نعمة صاحبه إلى شكر الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة ربه كنسبة نعم بعضنا على بعض إلى نسبة نعم الله تعالى سبحانه على نبيه أو على عبد من عبيده، وإن كانت نعم الله تعالى على نبيه أعظم من نعمه على سائر خلقه، بدليل قوله تعالى: (وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) لأن بين بلاغة أحدنا وبين بلاغة الرسول كما بين نعمة أحدنا ونعمة الله سبحانه، وإذا وقع للقضية مثال واحد في الوجود علم إمكان وقوعها، وخرجت بذلك من حد الاستحالة والامتناع إلى حد الجواز والإمكان. والمذهب المرضي أن المبالغة ضرب من المحاسن إذا بعدت عن الإغراق والغلو، وإن كان الإغراق والغلو أيضاً ضربين من المحاسن إذا اقترنا، وعيبين إذا أطلقا، ألا ترى كل مبالغة وقعت في الكتاب العزيز كيف أتت على قسمين: قسم ممكن غير مقترن، وقسم غير ممكن لا يأتي إلا مقترناً، كقوله سبحانه: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ) وفي غير الممكن كقوله سبحانه: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ) الآية، لأن المبالغة فيها عرفية، معناه أن علم ذلك متعذر عندكم، وإلا فهو بالنسبة إلى علم الله سبحانه ليس بمبالغة، وقد قال امرؤ القيس في غير الممكن [طويل]:
من القاصرات الطرف لو دبَّ محول ... من الذر فوق الإتب منها لأثرا
ولأن قوة الشعر وضعفه وماءه ورونقه أمر خارج عن البديع جملة، والمحاسن بتة، قرب شعر في غاية الجودة ونهاية القوة مع كونه قد بلغ فيه قائله إلى حد الإغراق أو الغلو، ورب شعر في غاية الرداءة مع الخلو عن هذين الضربين، فإن الكلام يكون جيداً بدون البديع، ورديئاً مع وجوده، فإنكار المبالغة في الكلام القوي الجيد ما لا سبيل إليه.
وأما قول من قال: إن الكلام لا يحسن بدون المبالغة فإن لم يحمل كلامه على التقييد، وإلا فهو محال بين الإحالة، وأحسب قائل هذا ذهب إلى التمييز بين كلامين استويا في خفة مفردات الألفاظ وتوسط استعمالها وحسن تركيبها وخلو الكلام بعد التركيب عن العيوب جملة وتفصيلاً، وتماثلاً في جودة المعنى وتمامه، وكثرة الماء فيهما، وتحلياً من البديع بما أتى الطبع به عفواً من غير تكلف ولا تعسف، وقد بولغ في أحدهما مبالغة مرضية والآخر لم يبالغ فيه، فإن ما بولغ فيه أفضل من الآخر، وأكثر النقاد على أن خير الكلام ما كان متوسطاً بين الغلو والاقتصاد والسلامة والمتانة الغرابة والاستعمال والتصنع والاسترسال، وما أحسن قول البحتري فيما قدمته من هذا الكلام حيث قال يصف لفظ بعض الكتاب [خفيف]:
في نظام من البلاغة ما شك ... ك امرؤ أنه نظام فريد
وبديع كأنه الزهر الضا ... حك في رونق الربيع الجديد
حزن مستعمل الكلام اختياراً ... وتجنبن ظلمة التعقيد
وركبن اللفظ القريب فأدركـ ... ـن به غاية المرام البعيد


ملك تراه إذا احتبى بنجاده ... غمر الجماجم والصفوف قيام
وحد قدامة المبالغة بأن قال: هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال لو وقف عندها لأجزأت، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ما يكون أبلغ في معنى قصده، كقول عمرو بن الأهتم التغلبي [وافر]:
ونكرم جارنا ما دام فينا ... ونتبعه الكرامة حيث مالا
وأنا أقول: قد اختلف في المبالغة، فقوم يرون أن أجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه، ويحتجون بما جرى بين النابغة الذبياني وبين حسان في استدراك النابغة عليه تلك المواضع في قوله [طويل]:
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
فإن النابغة إنما عاب على حسان ترك المبالغة، والقصة مشهورة، والصواب مع حسان، وإن روى عنه انقطاعه في يد النابغة، وقوم يرون المبالغة من عيوب الكلام، ولا يرون من محاسنه إلا ما خرج مخرج الصدق، وجاء على منهج الحق، ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنى مبتكراً، أو يفرع معنى من معنى، أو يحلى كلامه بشيء من البديع، أو ينتخب ألفاظاً موصوفة بصفات الحسن، ويجيد تركيبها، فإذا عجز عن ذلك كله أتى بالمبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، لما فيها من التهويل على السامع، ويدعون أنها ربما أحالت المعاني فأخرجتها من حد الإمكان إلى حد الامتناع.
وعندي أن المذهبين مردودان.
أما الأول فلقول صاحبه: إن خير الكلام ما بولغ فيه، وهذا قول من لا نظر له، لأنا نرى أن أكثر الكلام والأشعار جارياً على الصدق، خارجاً مخرج الحق، وهو في غاية الجودة ونهاية الحسن وتمام القوة، كيف لا والمبالغة ضرب واحد من المحاسن، والمحاسن لا تنحصر ضروبها، فكيف يقال: إن هذا الضرب على انفراده يفضل سائر المحاسن على كثرتها؟ وهذا شعر زهير والحطيئة وحسان ومن كان مذهبه توخي الصدق في شعره غالباً ليس فوق أشعارهم غاية لمترق، ألا ترى إلى قول زهير [طويل]:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم
والى قول طرفة [طويل]:
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ... لكالطول المرخى وثنياه في اليد
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود
والى قول الحطيئة [بسيط]:
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ... لا يذهب العرف بين الله والناس
فإنك تجد هذه الأشعار في الطبقة العليا من البلاغة وإن خلت من المبالغة. والذي يدل على أن مذهب أكثر الفحول ترجيح الصدق في أشعارهم على الكذب ما روى عن الحرورية امرأة عمران بن حطان الخارجي أنها قالت له يوماً: أنت أعطيت الله عهداً ألا تكذب في شعرك، فكيف قلت [كامل مجزوء]:
فهناك مجزءة بن ثو ... ر كان أشجع من أسامه
فقال: يا هذه إن هذا الرجل فتح مدينة وحده، وما سمعت بأسد فتح مدينة قط. وهذا حسان يقول [بسيط]:
وإنما الشعر لبُّ المرء يعرضه ... على المجالس إن كيساً وإن حمقا
وإن أشعر بيتٍ أنت قائله ... بيت يقال إذا أنشدته: صدقا
على أن هؤلاء الفحول وإن رجحوا هذا المذهب لا يكرهون ضده، ولا يجحدون فضله، وقلما تخلو بعض أشعارهم منه، إلا أن توخى الصدق كان الغالب عليهم، وكانوا يكثرون منه، ومن أكثر من شيء عرف به، كما أن النابغة ومن شايعه على مذهبه لا يكره ضد المبالغة، وإلا فكل احتجاجاته على النعمان في الاعتذار جار مجرى الحقيقة، كقوله [طويل]:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ... وليس وراء الله للمرء مذهب
فعائب الكلام الحسن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على الإطلاق غير مصيب، وخير الأمور أوساطها، وكيف تعاب المبالغة وقد وجدت في الكتاب العزيز على ضروب: منها المبالغة في الصفة المعدولة من الجارية لمعنى المبالغة فإنها جاءت على ستة أمثلة: فعلان كرحمان، عدل عن راحم للمبالغة ولا يوصف به إلا الله تعالى، لأن رحمته وسعت كل شيء، وفعال معدول عن فاعل للمبالغة كقوله تعالى: (لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ)، (تَوَّابٌ رَحِيمٌ)، (عَلَّامُ الْغُيُوبِ)، (فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ)، وفعول عدل عن فاعل للمبالغة كغفور و شكور و ودود ، وفعيل عدل عن فاعل، كرحيم و حكيم و عليم و قدير و سميع و بصير ومفعل معدول عن فاعل كمدعس و مطعن ، ومفعال معدول عن فاعل للمبالغة كمطعام و مطعان .
والضرب الثاني من المبالغة وهو ما جاء بالصيغة العامة في موضع الخاصة كقولك: أتاني الناس كلهم، ولم يكن أتاك سوى واحد أردت تعظيمه، ومن هذا الضرب قول أبي نواس [سريع]:
وليس لله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد
ومن هذا الضرب في الكتاب العزيز قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فوعدهم سبحانه بجزاء غير مقدر، لمجيئه بالصيغة العامة تعظيماً له (وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) والضرب الثالث من المبالغة إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة، والإخبار عنه مجاز، كقول من رأى موكباً عظمياً أو جيشاً خضماً: جاء الملك نفسه وهو يعلم حقيقة أن ما جاء جيشه، وقد جاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) فجعل مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه، وكقوله تعالى: (وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) فجعل نقله بالهلكة من دار العمل إلى دار الجزاء وجداناً للمجازى.
والضرب الرابع من المبالغة إخراج الممكن من الشرط إلى الممتنع، ليمتنع وقوع المشروط، كقوله تعالى: (وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ).
والضرب الخامس من المبالغة ما جرى مجرى الحقيقة، وهو قسمان: قسم كان مجازاً فصار بالقرينة حقيقة، كقوله تعالى: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) فإن اقتران هذه الجملة بيكاد صرفها إلى الحقيقة فانقلبت من الامتناع إلى الإمكان.
وقسم أتى بصيغة أفعل التفضيل، وهو محض الحقيقة من غير قرينة كقوله تعالى: (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا).
والضرب السادس من المبالغة ما بولغ في صفته بطريق التشبيه، كقوله تعالى: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ *كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ) فهذه ضروب ما ورد من المبالغة في الكتاب العزيز.
والمبالغة تأتي في الكلام على ضربين: ظاهرة ومدمجة، وكل ما قدمناه من مبالغات الكتاب العزيز من الظاهرة.
ومن المدمجة قوله تعالى: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ) فإن المبالغة أتت في هذه الآية مدمجة في المقابلة، والجواب: هذه المبالغة بالنسبة إلى المخاطَب إلى المخاطِب وقد جاء منها في سنة الرسول صلى الله عليه[وآله] وسلم ما لا يحصى كثرة، ولا يلحق بلاغة، كقوله عليه السلام مخبراً عن ربه أنه قال سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به وقوله في بقية هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . ففي هذا الحديث مبالغتان: أحداهما كون الحق سبحانه أضاف الصيام إلى نفسه دون سائر الأعمال لقصد المبالغة في تعظيمه وتشريفه، وأخبر أنه عز وجل يتولى مجازاة الصائم بنفسه، مبالغة في تعظيم الجزاء وشرفه، ونحن نعلم أن الأعمال كلها لله سبحانه ولعبده باعتبارين: أما كونها للعبد فلأنه يثاب عليها، وأما كونها لله تعالى فلأنها عملت لوجهه الكريم، ومن أجله فتخصيص الصيام من بينها بالإضافة إلى الرب سبحانه، وتخصيص ثوابه بما خصصه به إنما كان للمبالغة في تعظيمه والحض عليه، والمبالغة الثانية إخبار الرسول صلى الله عليه[وآله] وسلم بعد تقديم القسم لتأكيد الخبر بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ففضل تغيير فم الصائم بالإمساك عن الطعام والشراب على ريح المسك الذي هو أطيب الطيب على مقتضى ما يفهم من ريح المسك وريح تغير فم الصائم، وأتى المعنى بصيغة أفعل للمبالغة، فجمع هذا الكلام بين قسمي المبالغة المجازي والحقيقي.
ومن أمثله المبالغة في الشعر قول امرئ القيس [طويل]:
فعادى عداء بين ثور ونعجة ... دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل
فإنه أخبر عن هذا الفرس أنه أدرك ثوراً وبقرة وحشية في مضمار واحد، ولم يعرق، ومثله قول أبي الطيب [طويل]:
وأصرع أي الوحش قفيته به ... وأنزل عنه مثله حين أركب
وما يعاب من المبالغة إلا ما خرج به الكلام عن حد الإمكان إلى الاستحالة وأما إذا كان كقول قيس بن الخطيم [طويل]:
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ... لها نفذ لولا الشعاع أضاءها
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها ... يرى قائماً من دونها ما وراءها
فإن ذلك من جيد المبالغة إذا لم يكن خارجاً مخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة، وما سمعت ولا غيري بمستمع مثل قول أبي تمام [بسيط]:
تكاد تنتقل الأرواح لو تركت ... من الجسوم إليها حين تنتقل
فإنه لم يقنع في تصحيح المبالغة وقربها من الوقوع، فضلاً عن الجوار بتقديم كاد حتى قال: لو تركت؛ وهذا أصح بيت سمعته في المبالغة وأحسنه وأبلغه، وكقول شاعر الحماسة حيث بالغ في مدح ممدوحه بقوله [طويل]:
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره ... وما فوق شكري للشكور مزيد
ولو كان مما يستطاع استطعته ... ولكن ما لا يستطاع شديد
فإن هذا الشاعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصوره عن شكر بر هذا الممدوح، وفطن إلى أنه لو اقتصر على ذلك لقيل له: عجزك عن شكر هذا الرجل لا يدل على كثرة بره، وإنما يدل على ضعف مادتك عن الشكر إذ لا يلزم من عجز الإنسان عن شيء تعظيم ذلك الشيء على الإطلاق، لاحتمال أن يكون العجز لضعف في الإنسان فاحترس عن ذلك بقوله:
وما فوق شكري للشكور مزيد
ثم تمم المعنى بأن قال: للشكور أي للمبالغ في الشكر، لأن شكور معدول عن شاكر للمبالغة كما تقدم ثم أظهر عذره في عجزه مع قدرته بأن قال في البيت الثاني:
ولو كان مما يستطاع استطعته
ثم أخرج بقية البيت مخرج المثل السائر حيث قال:
ولكن ما لا يستطاع شديد
فهذا أبلغ شعر سمعته في هذا المعنى لجودة مفردات ألفاظه، وسهولة سبكه ومساواة لفظه لمعناه، ومتانة مبناه، وكثرة معانيه، وصحة المبالغة فيه؛ فإن قيل: لم بالغت في وصف هذا الشعر وهو عندك داخل في القسم المعيب من المبالغة لكونه أخرج الكلام من حد الإمكان إلى حد الامتناع حيث جعل شكر هذا الممدوح لا يستطاع؟ فإني أقول: ليس كل بر يمكن شكره، ولا يقوم المدح بحقه، فإنا لو قدرنا أن إنساناً فك إنساناً من الأسر واستنقذه من القتل لما وفى شكره ببره ولو كان أشكر الناس، واستنفد في شكره بقية عمره، لا سيما لو قدر أن ذلك الممتن ببقاء النفس أضاف إلى ذلك توابع إحسان، وعوارف امتنان، على ممر الزمان، فإن الشكر لا يقوم ببر ذلك الإنسان، ولو تجاوز فيه الشكور حد الإمكان، فقد وضح أن من البر ما لا يؤدي شكره، ومن هذا قول أبي نواس:
لا تسدين إلى عارفة ... حتى أقوم بشكر ما سلفا
وهذا سيد المرسلين الذي بعث بجوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد بقول لعظمة نعم ربه عليه: لا أحصى ثناء عليك . ومعلوم أن نعم الله سبحانه لا يقوم شكر جميع العباد بمعشارها، ولا كذلك نعم بعضهم على بعض لكن يشبه شكر أحدنا نعمة صاحبه إلى شكر الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة ربه كنسبة نعم بعضنا على بعض إلى نسبة نعم الله تعالى سبحانه على نبيه أو على عبد من عبيده، وإن كانت نعم الله تعالى على نبيه أعظم من نعمه على سائر خلقه، بدليل قوله تعالى: (وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا) لأن بين بلاغة أحدنا وبين بلاغة الرسول كما بين نعمة أحدنا ونعمة الله سبحانه، وإذا وقع للقضية مثال واحد في الوجود علم إمكان وقوعها، وخرجت بذلك من حد الاستحالة والامتناع إلى حد الجواز والإمكان. والمذهب المرضي أن المبالغة ضرب من المحاسن إذا بعدت عن الإغراق والغلو، وإن كان الإغراق والغلو أيضاً ضربين من المحاسن إذا اقترنا، وعيبين إذا أطلقا، ألا ترى كل مبالغة وقعت في الكتاب العزيز كيف أتت على قسمين: قسم ممكن غير مقترن، وقسم غير ممكن لا يأتي إلا مقترناً، كقوله سبحانه: (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ) وفي غير الممكن كقوله سبحانه: (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ) الآية، لأن المبالغة فيها عرفية، معناه أن علم ذلك متعذر عندكم، وإلا فهو بالنسبة إلى علم الله سبحانه ليس بمبالغة، وقد قال امرؤ القيس في غير الممكن [طويل]:
من القاصرات الطرف لو دبَّ محول ... من الذر فوق الإتب منها لأثرا
ولأن قوة الشعر وضعفه وماءه ورونقه أمر خارج عن البديع جملة، والمحاسن بتة، قرب شعر في غاية الجودة ونهاية القوة مع كونه قد بلغ فيه قائله إلى حد الإغراق أو الغلو، ورب شعر في غاية الرداءة مع الخلو عن هذين الضربين، فإن الكلام يكون جيداً بدون البديع، ورديئاً مع وجوده، فإنكار المبالغة في الكلام القوي الجيد ما لا سبيل إليه.
وأما قول من قال: إن الكلام لا يحسن بدون المبالغة فإن لم يحمل كلامه على التقييد، وإلا فهو محال بين الإحالة، وأحسب قائل هذا ذهب إلى التمييز بين كلامين استويا في خفة مفردات الألفاظ وتوسط استعمالها وحسن تركيبها وخلو الكلام بعد التركيب عن العيوب جملة وتفصيلاً، وتماثلاً في جودة المعنى وتمامه، وكثرة الماء فيهما، وتحلياً من البديع بما أتى الطبع به عفواً من غير تكلف ولا تعسف، وقد بولغ في أحدهما مبالغة مرضية والآخر لم يبالغ فيه، فإن ما بولغ فيه أفضل من الآخر، وأكثر النقاد على أن خير الكلام ما كان متوسطاً بين الغلو والاقتصاد والسلامة والمتانة الغرابة والاستعمال والتصنع والاسترسال، وما أحسن قول البحتري فيما قدمته من هذا الكلام حيث قال يصف لفظ بعض الكتاب [خفيف]:
في نظام من البلاغة ما شك ... ك امرؤ أنه نظام فريد
وبديع كأنه الزهر الضا ... حك في رونق الربيع الجديد
حزن مستعمل الكلام اختياراً ... وتجنبن ظلمة التعقيد
وركبن اللفظ القريب فأدركـ ... ـن به غاية المرام البعيد
 الاكثر قراءة في البديع
الاكثر قراءة في البديع
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












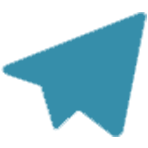
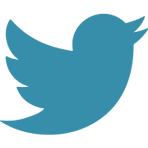

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)